أيّة لغة لعصر المعلومات؟
فئة : مقالات
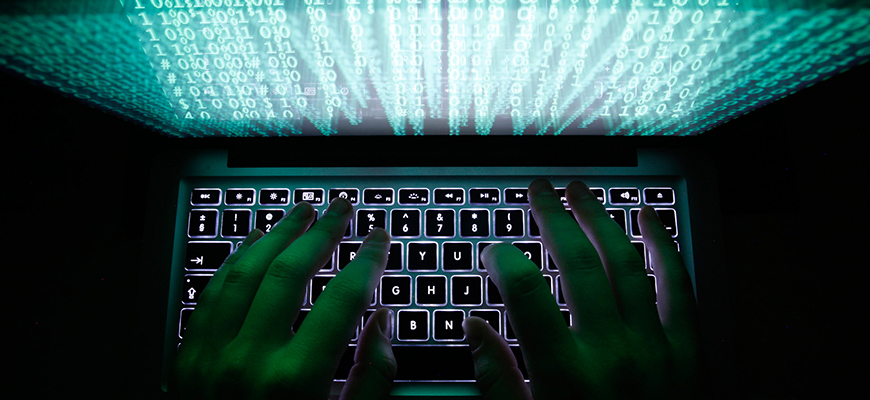
ليس من الضروري (ولا من المفروض أيضاً) أن يكون المرء عالماً لغوياً فذاً أو متضلّعاً في بنيات اللغة ووظائفها، حتى يتسنى له التسليم، ولو جدلاً، بأنّ عصر العولمة والثورة التكنولوجية وانفتاح الأسواق والاقتصادات وتطور الشبكات الألكترونية وتزايد مظاهر البثّ التلفزي العابر للحدود وغيرها، قد وضع الثقافة واللغة في المحك ولربما أكثر من أي وقت مضى.
والواقع أنّ هيمنة بعض لغات العالم على عمليات التبادل الاقتصادي والإنتاج المعرفي والتكنولوجي، وتنقل التيارات الرمزية على نطاق شبه كوني، واجتماعات المنظمات الدولية وملتقيات البحث والفكر وما سواها، هذه الهيمنة لم تعد مكمن إجماع عام حول حقيقتها المؤكدة، بل أضحت تقدم باعتبارها "تهديداً" للحق في التباين والاختلاف، و"خطراً" على "هويّات" الأفراد والجماعات بهذه المنطقة من العالم أو بتلك.
وسواء أكانت اللغة هنا وسيلة اتصال وتواصل وأداة تبليغ وتبادل للمعلومات والمعارف، أم كانت تعبيراً عن ثقافة، عن هويّة أو عن علاقات قوة، فإنها أصبحت في الحالتين معاً تسائل "الحق" ذاته، وتستفهم في مستقبل "الهويّات" إيّاها على ضوئه وتحت قوة محكه.
وعلى الرغم من كون التمييز أعلاه يبقى إجرائياً خالصاً، باعتبار اللغة أداة اتصال وتواصل، ومكمن تمثلات رمزية للأفراد والجماعات، فإنّ القائم الثابت راهناً أنّ الجانب الأول من المعادلة هو الموضوع أساساً في الميزان، بحكم عولمة الاقتصادات وانفجار الشبكات المعلوماتية وتعدد مصادر الأخبار والمعطيات وما سوى ذلك.
ليس من الغرابة في شيء إذن، بناء على هذا، أن تصبح اللغة الإنجليزية، وبكل المقاييس، لغة العولمة القائمة ولغة التيارات الرمزية المقتنية للشبكات ذاتها، بل قلْ لغة "الثقافة" السائدة شكلاً كما في الجوهر.
لا يتأتى "تفوّق" اللغة الإنجليزية، فيما يبدو، من تفوّق ما في بنيتها الداخلية أو توفرها على سمات مميزة لها عن باقي لغات العالم، ولكنه يتأتى لها كون الدولة الثاوية خلفها (الولايات المتحدة الأمريكية) انفردت دون سواها، بسلطان القوة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية وسلطان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وغيرها.
بالتالي، "فعولمة" اللغة الإنجليزية المتزايدة لدرجة أضحت معها لغة التخاطب العالمي ولغة المبادلات الكونية، إنما هو رديف منطقي وإلى حد بعيد، لعولمة في الاقتصاد والمال والأعمال والبحث والتكنولوجيا تدفع بها الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، وفي المنظمات الجهوية، وفي علاقاتها مع الدول والشركات.
تقول منظمة اليونسكو بهذا الصدد: "إنّه أضحى من الضروري أخذ المشكل اللغوي في الاعتبار فيما يتعلق بتكوين التجمعات الاقتصادية الجهوية الكبرى، كالنافطا والميركوزير والآزيان والاتحاد الأوروبي وغيرها. إنّ فكرة البنية اللغوية كحجر أساس للبناءات الجهوية بغرض تقوية التضامنات والحؤول دون الصراعات مهمّة للغاية، تماماً كما هو الشأن بالنسبة لمسألة منظومات بنى النقل والطاقة والاتصالات التي غدت ذات أهمية كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
ما من شك في أنّ تزايد مدّ العولمة اللغوية تزامن وتزايد بجهة التكتل الجهوي، والذي يعتبر في الآن نفسه رافعة للعولمة ذاتها، ووقوفاً في وجه طغيانها على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والأمني وما سواها.
وهو أمر لا يمكن تلمّس مظاهره الكبرى على مستوى السياسات اللغوية المعتمدة من لدن كل تجمع فحسب، بل أيضاً على مستويات أخرى تتجاوز البعد الترابي للمسألة أو طابعها الجغرافي الخالص، لتطال البعد الجيوستراتيجي والثقافي، كما نلاحظه في حالتي الفرنكفونية والإسبانوفونية والأنجلوفونية وغيرها.
ولئن غدت المسألة اللغوية، في عصر العولمة وانفجار التيارات الرمزية على المستوى الكوني، رهاناً كبيراً في العلاقات بين دول ومناطق العالم، فليس الباعث في ذلك كون اللغة باتت أداة اتصال وتواصل ووسيلة نقل للمعارف والمضامين، ولكن أيضاً لأنها تجرّ من خلفها رهانات ثقافية وهوياتية ضخمة، لا تختزل لحد الساعة إلا في مظاهر ثانوية غير ذات قيمة كبرى تذكر.
والسر في ذلك كامن بالأساس في أنّ اللغة لا تصلح فقط لتمرير المعلومات المصاغة خارجها، ولكنها تمارس أيضاً آثاراً على بنية المعارف المصاغة داخل نشاطات ذهنية ووفق تداخل اجتماعي بين مختلف المتدخلين...فليست الكلمات في حد ذاتها التي تعبر وتوجّه تمثلاً للعالم، ولكن أيضاً أنماط ترتيبنا للكلمات والجمل في الخطاب.
ومعنى هذا أنّ العولمة اللغوية متصاعدة المد لا تضع اللغة كأداة في المحك، بل في كونها أيضاً أضحت ملتقى حقيقياً للعلم والتقنيات، للتربية والثقافة والاتصال، وهو ما سينعكس حتماً على إمكانات الوصول للثقافة ونشرها وإعادة إنتاجها. العولمة اللغوية هنا ليست هدفاً (في حد ذاتها) بقدر ما هي (على الأقل بالنسبة لقطب العولمة الأوحد) وسيلة لبلوغ أهدافٍ محددة ومرامٍ مقصودة، تكون اللغة بداخلها الأداة والرافعة لا العكس.
والقصد من هذا القول إنّه لو سلّمنا بأنّ الثقافة (في التحديد الأمريكي لها) إنما هي سلعة كباقي السلع، ولو سلّمنا بأنّ "السياسة الثقافية" الأمريكية إنما تتمثل في الدفاع المستميت عن مصالح صناعاتها الثقافية، فإنه لن يتعذر التسليم بالتالي بأنّ اللغة في كلّ ذلك إنما هي عنصر لنشر منتجات الصناعات ذاتها وترويجها على نطاق واسع، وليست شيئاً آخر.
وعلى هذا الأساس، فاللغة الإنجليزية من هنا إنما تعولمت لأنها أولاً لغة القوة الكبرى في العالم، وثانياً لأنها أضحت في الآن ذاته لغة العولمة ذاتها، تفسح لها في المجال واسعاً، وتفتح لها الأسواق، ولا تتوانى في استقطاب الأفواه المستهلكة لما تنتجه وتعرضه في الأسواق ذاتها.
أضحى من شبه المؤكد أنّه لا يمكن فصل اللغة والثقافة عن التحولات الكبرى التي تعرفها منظومات المعلومات والمعرفة والاتصال. كما أضحى في حكم المؤكد أنّ الإشعاع اللغوي هو أيضاً وبالأساس من الإشعاع الثقافي، وأنّ إدراك هذا الأخير لا يمكن فصله عن الواقع الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والسياسي وما إلى ذلك.
بالتالي، فانبعاث وتكريس النظام التكنولوجي الجديد المتفرع عن ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال لا يبدو لنا مسائلاً للغة بقدر ما هو مسائل للثقافة أيضاً. ومعنى هذا أنّ اللغة لا تعدو هنا سوى كونها وسيطاً بين الثقافة والنظام ذاته، ولن يكون لها في ذلك من دور كبير يذكر، اللهم إلا ما تقدّمه لها الثقافة أو ما يتسنى لها ترويجه بداخل الشبكات.
ومعناه أيضاً أنّ الاندماج المتزايد للمعطى والصوت والصورة في منظومة واحدة موحدة، تتفاعل انطلاقاً من نقط متعددة... داخل شبكة كونية بالإمكان بلوغها دون تكاليف كبرى، هذا الاندماج إنما سيحول حتماً طبيعة الاتصال، وهذا الأخير سيدفع بدوره بجهة إعادة تشكيل الثقافة بشكل جذري، ما دام أنّ الذي نراه ليس هو الواقع، وما دام أنّ اللغة باتت أداة وسائل الإعلام والاتصال بامتياز.
فالثقافة، في ظل النظام التكنولوجي الجديد، إنما تخضع لتقنيات الإعلام والاتصال بغرض موسطتها، والثقافات ذاتها، باعتبارها تلك المنظومة التاريخية المشكلة من الاعتقادات والتمثلات والرموز، ستتحول جرّاء ذلك جذرياً وتدريجياً لتخضع بالمحصلة لإكراهات النظام ذاته (النظام التكنولوجي).
ليس ثمة من شك إذن أنّ بروز نظام الاتصالات الألكتروني الجديد (وفي صلبه شبكة الإنترنيت وثورة البث التلفزي الرقمي العابر للحدود وغيرها) ذي البعد الكوني، وتزاوج وسائل الإعلام وتزايد التفاعلية ضمنها... كلّ هذا قد حوّل ثقافاتنا، ومن شأنه أن يحوّلها إلى ما لا نهاية.
بالتالي، فمستقبل الثقافات واللغات إنّما يتحدد بمدى قدرتها على التواجد بهذا النظام، وبمدى قدرتها على تمرير المضامين والمعارف بداخله، إذ في مواجهة تقدم لغة كونية ضاغطة، فإنّ لغة كل بلد وثقافته إنما سيكونان صورة لما يراد لهما اليوم، وليس شيئاً آخر.
والمقصود هنا هو القول إنّ انفجار الوسائط الألكترونية (لا سيما المتعددة الأقطاب وشبكة الإنترنيت) سيكون من شأنه قلب مفهوم التواصل اللغوي المعتاد، وسيطرح بالحتم عدداً من الأسئلة المحورية حول العلاقات بين أنساق الرموز المختلفة نصوصاً وأصواتاً وأشكالاً وما سواها.
يقول مانويل كاسطيل ما معناه إنّ بروز هذه الشبكات (لا سيما المتعددة الأقطاب والإنترنيت) إنما تتوازى وتحطيم الحواجز والتمايزات بين وسائل الإعلام السمعية/البصرية والمكتوب، بين الثقافة الشعبية والثقافة العارفة، بين الفرجة والمعلومة، بين التربية وعملية الإقناع. كلّ تعبير ثقافي، القبيح والجيد، الأكثر نخبوية والأكثر شعبية، كلها تذوب في هذا الفضاء الرقمي الذي يربط في إطار نص تاريخي ضخم كل تعبيرات الذهن الماضية والحاضرة والمستقبلية.
لا تبدو اللغة، في هذا الإطار، مستقلة عن الثقافة، بل في صلبها ما دامت الثقافة ذاتها هي "نتاج عمليات تواصل"، لا على اعتبار أنّ كل أشكال التواصل ترتكز على عمليات إنتاج واستهلاك الرموز فحسب، بل أيضا لأنّ كلّ المجتمعات تعيش وتتحرك في محيط رمزي بهذه الطريقة أو تلك.
بالتالي، فالجديد، في نظام التواصل الجديد، المنظم حول الاندماج الألكتروني لكل أنماط الاتصال (حتى الحسي منها)، لا يتمثل فقط في كونه ينتج واقعاً افتراضياً، بل لأنه يبني لما يسميه كاسطيل بالافتراضية الواقعية، حيث اللغة في هذا المناخ التكنولوجي، ما هي إلا مجموعة رموز وبتات ألكترونية يتحدد بموجبها وجود نظام الاتصال من عدمه.
بيد أنّ اندماج مختلف التعبيرات الثقافية في نظام التواصل المندمج والمبني على إنتاج وتوزيع وتبادل الرموز الألكترونية المرقمنة، إنما هو ذو تبعات اجتماعية وثقافية ولغوية كبيرة تتحدد بموجبها حتماً طبيعة المجتمع المعلوماتي ذاته.
وعليه فإنّ حاضر ومستقبل اللغة والثقافة، في ظلّ عصر المعلومات، إنما يتحددان بمدى قدرتهما على تمثل سمات العصر ذاته وتوظيف آلياته وضبط نقط مداخله ورموزه: اللغة مطالبة بـ "المرور" إلى لغة العصر إياه، والثقافة مطالبة بأن "ترقى" بواقعيتها إلى مستوى الواقع الجديد (الواقع الافتراضي) الذي يقدم في كونه مستقبلها، بل "ومصيرها" كما يقول البعض.
من جهة أخرى، فلو تسنّى للمرء أن يسلّم بأنّ اللغات والثقافات قد أضحت مترابطة شبكياً (عبر برمجيات معلوماتية محددة) وخصائصها متجاوزة (ما دامت تترجم ببتات ألكترونية لا قيمة تذكر "للخصوصيات اللغوية" في ظلها) فإنه من المتعذر التسليم بمساواتها أمام الشبكات كما قد يشي بذلك الخطاب الرائج. إذ الثابت أنه بجلّ الشبكات الإعلامية والاتصالاتية المتوافرة في العالم، فإنّ اللغة الإنجليزية هي التي تهيمن على ما سواها من لغات، سواء في حجم وطبيعة المضامين المروجة، أو في نوعية المضامين ذاتها وقيمتها.
هي بهذه الشبكات (وبغيرها) اللغة/المركز، حيث تدور في فلكها عشرات "اللغات المحيطية" (فرنسية، إسبانية، عربية، صينية، هندية، ماليزية...إلخ) وتدور في فلكها مائة إلى مائتي لغة مركزية، تعتبر بدورها قطب المحور لأربعة آلاف إلى خمسة آلاف لغة هامشية.
قد يكون من تحصيل الحاصل القول إنّه مادامت الولايات المتحدة هي صاحبة السبق في إقامة النظام التكنولوجي الجديد وتكريس المجتمع المعلوماتي بنى ومضامين، فإنّه من تحصيل الحاصل أيضاً القول بـ"حقها" في أن تكون لغتها هي أداة النظام إيّاه وحاملة لوائه.
وهو أمر مشروع وموضوعي إلى حد ما، كما يقول البعض، لكنّ المفارقة بداخله إنما تكمن في أنّ الولايات المتحدة تستوظف السبق ذاته لتربط اللغة الإنجليزية "بنموذج في التربية والثقافة"، تبقى اللغات الأخرى بموجبه لغات ثانوية أو مقتصرة على دولة أو مجموعة دول، وفي البعض الآخر منها على "الاستعمال الشفوي البدائي" أو "الاستعمال عن قرب" أو الاستعمال الخاص أو ما سوى ذلك.
يبدو، في المحصلة النهائية، أنه في ظل هيمنة اللغة الإنجليزية على الاقتصاد الكوني والنظام التكنولوجي الكوني والمجتمع المعلوماتي "الكوني"... يبدو أنّ هذه الهيمنة لا تتماشى فقط، من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية مع طروحات الاستثناء الثقافي، بل ولا تتماشى إطلاقاً مع السياسات اللغوية "الوطنية" القائمة على الحمائية اللغوية، التي تعتبرها العولمة اللغوية عائقاً أمام سريان المعلومات وتنقل البيانات والمعطيات وما سواها. أي أنّ مد اللغة الإنجليزية قد يتعايش وبناء "اللغات المهمشة"، لكنه يبقى في حالة ممانعة كبيرة مع اللغات المركزية الأخرى.
يخال الأمر إذن كأنّ دفاع اللغات المركزية عن اللغات المهددة هو بالتأكيد من الدفاع عن ذاتها عوض أن "تستفرد" بها مجتمعة اللغة المهيمنة. ويخال الأمر أيضاً كأنّه لا مجال للحديث عن "حقوق لغوية" قد تدفع بها هذه الدولة أو تلك أمام مدّ العولمة وتقدّم المجتمع المعلوماتي، كائنة ما تكن السياسات اللغوية المعتمدة أو الاستراتيجيات الثقافية أو ما سواها.
ومعنى هذا أنّ اللغات المركزية (كالفرنسية والإسبانية والألمانية وغيرها) هي المهدّدة من لدن اللغة/المركز مادامت هذه الأخيرة هي المستعملة عالمياً (حتى داخل هيئات الاتحاد الأوروبي) التي تشكو من التهديد وتعمل على تجنّبه.
والتهديد المقصود هنا قد لا يطال وجود هذه اللغات كأدوات اتصال وتواصل ومكمن حمولات رمزية قائمة، لكنه قد يطال مكانتها وترتيبها بين اللغات، في حين قد تحتفظ العديد من اللغات المهمّشة على وظيفتها ومكانتها، إذا لم تكن كأداة للاتصال والتواصل، فعلى الأقل كمستودع لخصوصية ثقافية وهوياتية لن يبلغها التهديد كثيراً على المدى القصير والمتوسط.
من حكم الوارد إذن أن تتراجع المكانة الرمزية التي تمثلها بعض اللغات المركزية ببعض من الفضاءات الجهوية (الفرنكفونية بالأساس)، وذلك على الرغم من السياسات اللغوية التي تنهجها الدول والحكومات. ومن حكم الوارد أيضاً أنّ السياسات الهادفة إلى بناء "مجتمعات معلوماتية جهوية" على هذه الخلفية تبقى محدودة الأثر والأبعاد، إذ نموذج الاقتصاد والمجتمع "الكونيان" هما في الآن ذاته تكريس لنموذج في التربية والثقافة والفكر لا يقبل بـ "يالطا لغوية" تتوزع مناطق النفوذ بموجبها على خلفية من اللغة، أو من الثقافة.






