إليف شافاق... ورهانُ تقعيدِ العشق
فئة : قراءات في كتب
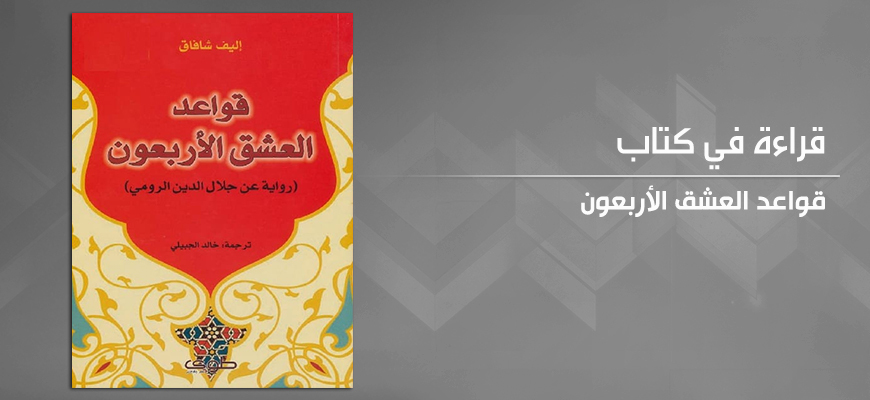
أن تُستدعَى قممٌ عرفانيةٌ من التاريخ الروحي الإسلامي إلى القرن الحادي والعشرين؛ وذلك بغاية إعادة كتابة حيواتِها الروحية ضمن آفاق سردية إبداعية، أمرٌ يحتاج إلى أكثر من سؤال؛ بل يقتضي وقفةً لها التأني علامة والتأمل الوئيدُ شرط فهم. أستحضر في هذا السياق، تمثيلا لا حصرا، أعمالا سردية دالة مثل رواية "هذا الأندلسي" لـ بن سالم حميش التي يضطلع فيها بتسريد حياة عبد الحق ابن سبعين (تـ 669 هـ / 1269م)، وكذا روايات عبد الإله بن عرفة الموسومة بـ "العرفانية"، واشتغاله السردي على محيي الدين بن العربي (تـ.638هـ / 1240م) في "جبل قاف"، وعلى أبي الحسن الششتري (تـ 668هـ / 1269م) في "بلاد صاد"، وأبي حامد الغزالي (تـ 505 هـ / 1111م) في "طواسين الغزالي"، ثم اشتغاله على أبي قاسم الجنيد (تـ 161ھ / 778م) في روايته الصادرة أخيرا بعنوان "الجنيد.. ألم المعرفة"؛ كما أستحضر رواية "زمن ابن عجيبة" لعبد الواحد العلمي التي اشتغل فيها على تجربة الصوفي المغربي أحمد بن عجيبة (تـ 1224 هـ / 1808م)، و"الأطلسي التائه" لمصطفى لغتيري، التي اشتغل فيها على تجربة أبي يعزى يلنور المشهور بمولاي بوعزة (تـ 572هـ / 1176م). ضمن هذا الاستحضار الرحب، أتأمل العمل الروائي الباذخ لإليف شافاق حول التجربة الروحانية الباذخة لجلال الدين الرومي، والموسوم بـ "قواعد العشق الأربعون"، وهو العمل الذي تزامنَ مع أعمال أخَرَ حول "مولانا" أو استثارها، مثل عمل الروائية الإيرانية نهال تجدد "الرومي: نار العشق"، أو عمل الروائية الفرنسية مورل مفروي عن كيميا "بنت مولانا جلال الدين الرومي"[1].
نعم، تختلف مستويات الاستحضار ومنطلقاته، كما تختلف لغة الحكي وطرائق التسريد وتقنيات الكتابة الروائية، مثلما تختلف توالجات التاريخي والسردي، التوثيقي والتخييلي في هذه الأعمال، لكنها تتقاطع في وجهةِ الاستحضار، وكأني بهذه الأعمال تقدم تأملا سرديا وإبداعيا في ما كان قد أشار إليه في عبارة نبوئية شهيرة الفيلسوف والمفكر الفرنسي أندريه مالرو - حسب ما يؤكده أدريه فروسار - لما قال: "القرن الواحد والعشرون سيكون صوفيًا أو أنه لن يكون"[2].
سأقصر التأمل، لا التحليل الشافي، على عمل إليف شافاق لاستجلاء بعض أبعاد الاستحضار المذكور. فقد صدرت رواية "قواعد العشق الأربعون" في طبعتها الأمريكية في فبراير 2010، وطبعتها الإنجليزية في يونيو من نفس العام، وبيع منها تو صدورها أكثر من مليون نسخة، ثم توالت ترجماتُها إلى أكثر من ثلاثين لغة، وتضاعفت بذلك مبيعاتُها، وحظيت صاحبتها بشهرة استثنائية، بل بولادة جديدة، روائيا، عقب هذا العمل السردي الاستثنائي.
لن أعود هنا، إلى بيان ما سميته في موضع آخر بـ "براعة السرد"[3] في "قواعد العشق الأربعون"، وهي براعة تجسدنت في عدة عناصر وشجت بين التمكن المبدِع من تقنيات الكتابة الروائية، من خلال تعديد الأصوات وتنويع خطوط الحكي وكسر خطية الزمن السردي، والالتفات إلى الكلي من خلال التقاط التفاصيل الشاردة، وبناء جدلية خلاقة بين التخييل والتاريخ، حيث تتحقق في الرواية تلك المعادلة الإبداعية التي لخصها أمين معلوف بقوله: "الروائي ليس مُلزَما بدقة التاريخ، لكن أعتقد أنه ملزم بعدم الكذب تاريخيا"[4]؛ وبين معالجة أسئلة الراهن الديني العالمي، والمتعلقة بصور الله في المعتقدات، والعلاقة بين المختلفين دينيا، وصلة الطقوسي بالروحاني، والإيديولوجي بالميتافيزيقي، والإيماني الشعائري بالإنسي الكوني في الأديان جميعها، وكذا طرح أسئلة العلاقة برتابة العالم الاستهلاكي ولا إنسانيته، والصلة بالعنف والمطلق والموت والذاكرة والمجهول وسؤال المعنى... من زاوية تستدعي تجربة عرفانية لها جاذبيتها الروحانية المخترقة للأمكنة والأزمنة واللغات والثقافات[5]، وتراهن على العشق كأفق أنطولوجي لإعادة صوغ العلاقة بين الإنسان والله والعالم.
أريد هنا أن أقف، بوجازة مفرطةٍ، عند نقطة أساس في عمل شافاق، وهو رهانها الجمالي في روايتها على نمط من أنماط الكتابةِ الصوفية، وهو الكتابةُ الحِكَميّة، والمتمثلة في جعل خطابها الحكائي يستند إلى لحظات بلورية تكثيفية للتأمل، مجدِّدَة لمسار السرد، مُمَفْصِلَة للحكايتين الرئيستين المتوازيتين في الرواية (حكاية إيلا روبنشتاين مع أسرتها في الزمن المعاصر، وتعيينا في ولاية ماساشوستس عام 2008، وحكاية جلال الدين الرومي مع ملهمه الروحي الدرويش شمس الدين التبريزي في القرن الثالث عشر ميلادي بقونية). وأعني بهذه اللحظات ما أطلقت عليه شافاق "قواعدَ العشق الأربعين". ولعل ما تضطلع به هذه "القواعدُ" من وظيفة في بنْيَنَة الحكي وفتحِه على أفق التأمل الصوفي المفتوح، هو الذي جعلها تتخذ منه "ثريا" تضيء مسارات النص، وعنوانا يفتح أفق انتظار القارئ على وعودٍ تأمليةٍ وجماليةٍ، بقدر ما يستثير فيه سؤالا مفتاحا: كيف يمكنُ للعشق المرادِفِ للتحرر من عقال العقل، والمعانِق لـ "جنون" الشغف المستعصي على كل تقفيص، أن نقيَّده في "قواعد"، بل ونقيّد تلك القواعد بعدد محصور ومحدود ومغلق؟
يكتشفُ القارئ، مأخوذاً ببهاءِ السردِ مع توالي صفحات الرواية، أنهُ إزاء "قواعد" لا كسائر "القواعد". ينخطفُ بلذةِ القراءةِ، وهو يستبطنُ أنهُ ليسَ إزاء "قواعد" بالمعنى المنطقي أو النحوي مثلا لـ"القاعدة". يكتشفُ أنهُ إزاءَ "إشراقاتٍ حِكَميةٍ" في صورةِ "قواعد مفتوحة"، وهي إشراقاتٌ تحيل على نمط من الكتابة الشذريةِ الصوفيةّ؛ ذلك أن الكتابة الحِكَمِيَّة، في النسقِ الصوفي، نمطٌ من الكتابة الشذرية الصوفية التي تندرج ضمنها أنماطٌ أخر مثل: "المخاطَبَة"، و"الوقفَة"، و"المشهَد"، و"الشَّطْحَة"..، وتتعيَّن "الحِكْمَة" في هذه الكتابةِ بوصفها إشراقاً ذوقياً يعبِّر عن ذاته في عبارات مكثَّفة، وصياغة مُحْكَمة، تتوسل الإيجاز والإجمال، وتطلبُ العام من الخاص، مثلما تلوذ أحيانا بالإشارة بدل العبارة.
وإذا كانت أنماطُ "المخاطَبة" أو "الوقفة" أو "المشهَد" أو "الشطحة" تتقاطع في كونها تصدر عنِ الصوفي، وهو منشدهٌ عن الرسومِ والحدودِ في حال محو وفناء، فإن "الحكمة" تصدر عنه، وهو في صحو فناء الفناء. كما تتميز "الحكمة" لدى أهل العرفانِ عن "الحكمة الفلسفية"، في كونها ليست نتاجَ تأمل وتعقل وجدال، بل هي نتاج تجربة ووجد وحال. إن الحكمةَ هنا ثمرة حبٍّ؛ "إذ لا حكمة بدون حب" كما ورد في القاعدة السادسةَ عشرة. لذا تعتبر الحكمةُ الصوفية "شذرَةً متماسكة" تصدر عن لحظة "الكمال" الصوفي بما هي جمع بين الأضداد؛ بينَ الصحو والبقاء برانيا، وبين الوجد وسكرِ المحبةِ جوانيا، تلك اللحظة الموسومة من لدن أبي قاسم الجنيد بالآية الكريمة: )وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ( (سورة النمل، الآية 88). بهذه المثابة تصدر "الحكمةُ" هنا عن نوع من "التفكُّر الواجد" إن صح التعبير، وهو ما يلائمُ "تجربةَ المُفارقة" التي تنبصمُ بها الحياة الروحية لجلال الدين الرومي، والتي وصفها ببلاغة المفكر الإيراني محمد رضا شفيعي كدكني في مقدمة كتابه "غزليات شمس تبريز...مقدمة واختيار وتفسير"، حيث كتب: "ها هنا أيضا نقطة غامضة وذات تناقض ظاهري paradoxical في حياته ووجوده، وهي من التناقض في الأوج. فهو (أي مولانا) من ناحيةٍ مفكر كبير، ومن ناحيةٍ أخرى، مجنون عظيم من مجانين العشق ومخبَّل. من ناحيةٍ يصوّر أعقد قوانين الوجود بأبسط بيان، ومن ناحية أخرى لا يَعُدُّ أيّ قانون ونظام في الدنيا ثابتا لا يتغير، ولا يقول بأبدية أية سنة (في رؤيته الجدالية)"[6].
في هذا الأفق، نفهم "قواعدَ العشق الأربعين" في رواية شافاق، إنها تتناصّ مع هذا الأسلوب الكتابي العرفاني، وتستلهم القول به وفيه. لذا، ورغم أن القواعد تبدو متقطعة وغير متسلسلة منطقيا، وتظهر مثل لمعات أو ومضات أو بوراق في مسار الحكي، فإن ذلك لا يعني استقلال كل قاعدة عن أخواتها، بل ثمة نسق ناظم ضامر، بموجبهِ تُنتِج تلك القواعدُ الدلالةَ التي ينتظم بها السرد في الرواية.
إن القواعد، بهذا الاعتبار، تنكتبُ من خلال مُقَطَّعَات تكسر التسلسل المنطقي والعقلي الذي يجعلُ اللاحقَ متصلا بالسابق اتصال السبب بالنتيجة، مما يوهم باستقلال كل قاعدة، في حين ينتظمها نسقٌ ضامر سُداه التجربةُ العشقية، وهذا واحد من خصائص الكتابة الحِكَمِيَّة الصوفية؛ ذلك أنها تتأسسُ على نسقيةٍ قوامها التشذير والتقطيع لا التسلسل المنطقي، على أن التشذير يختلف هنا عن التفتيت؛ "ذلك أن التشذير ليس إلغاءً للنسق، وإنما هو طريقة خاصةٌ في تقديمه"[7].
بهذا الفهم، لا تصبِحُ القواعد "تقنينا" ولا قولبةً أو تنميطا للعشق، فذاك متعارِضٌ والطبيعة المنفلتة والمتجددة والمتحركة للتجربة العشقية، وإنما تُضحي تلك القواعد منارات على طريق العشق، أو قل إشراقاتٍ تُمليها التجربة العشقية لاستيعاب لا نمطيتها، ولا نهائيتها، والإيمان بكونها مصدرَ كل حكمة تفتح على التجدد اللانهائي للعلاقة بين الإنسان والله والعالم. هكذا يغدو التقييدُ هنا أداة للإطلاق، أو قل يتضايفُ التقييدُ والإطلاق في دين العشق. لنصغ إلى الصوت السردي لشمس التبريزي في الرواية، وهو يقول: "و خلال هذه الرحلات والتجارب، رحتُ أجمعُ قائمة لم تُدَوَّن في أي كتاب، بل حفرت في روحي فقط. وقد أطلقتُ على هذه القائمة الشخصية "المبادئ الأساسية للصوفيين الجوالين في الإسلام"؛ وإني أعتبرها قائمة شاملة وموثوقة وثابتة كما هي قوانين الطبيعةِ، وهي تشكل مدونة "القواعد الأربعون لدين العشق"، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العشق، والعشق وحده"[8].
إن ما يجعل هذه القواعد أشبه بقوانين الطبيعة من حيث "وثوقُها وثباتها" دون تكونَ قواعدَ عقلية أو تفقدَ خاصية انبثاقِها من القلب وانحفارها في الروح، هو استيعابُ تلك القواعدِ للإطلاق من خلال التقييد، وذلك من خلال تأسيسها لمعرفة قلبية قوامُها الانفتاح على المطلق، واستيعاب التجدد واللانهائي، عبرَ بنودٍ هي منارات على طريق دين العشق المنشرح والمنفلت من كل عقال؛ ذاك ما تؤكده إحدى القواعد الأولى حين تجعل ممرَّ الطريقِ إلى الحقيقة هو القلب لا العقلُ، تقول: "إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب، لا من الرأس. فاجعل قلبك، لا عقلك دليلك الرئيسي. واجه، تحد، وتغلب في نهاية المطاف على "النفس" بقلبك. إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة ربك"[9].
وهو الأمر ذاته الذي تحسمهُ القاعدة الأخيرةُ بإعلانها النفور من التقسيمات العقلية، ومعلوم أن من خصائص الكتابة الحِكَمية الصوفية، كما أشرنا آنفاً، جمعُها بين الأضداد؛ ومن ثم استعصاء المعرفة الذوقية، التي تؤسس لها، على التصنيف والتقسيمات. "تقول القاعدة الأربعون: لا قيمة للحياة من دون عشقٍ. لا تسأل نفسك ما نوع العشقِ الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي...فالانقسامات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف...إنه كما هو نقي وبسيط.
"العشق ماء الحياة. والعشيق هو روح من النار.
يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء"[10]. (ص500).
في هذا الأفق المفتوح للعشق، حيث تذوب التقسيمات والأضداد، وحيثُ استلهام الكتابة الحِكَمِيَّة عند العارفين للعبارة عما ينقال والإشارة إلى ما لا ينقال من هذا الأفق، نفهم مدلولَ القاعدة في "قواعد العشق الأربعون"، وهو الأفق الذي تؤكده إيحائيةُ العددِ أربعين، بما هو رمز الأشُدِّ والأهلية لاستقبال "القول الثقيل" وانفتاح سماء النبوءة؛ أي رمز الانفتاح على المطلق، لا إقفال القول أو إغلاق المعرفة. إنه أيضاً استلهام العرفان اللّدني، لأن العشق الصوفي وهبي لا كسبي، ومناطهُ اللهف والشغف كما تعكسهما نشوةُ الرومي في حِلَق السماع، طلباً لمعنى هاربٍ، يشكِّلُ الجنونُ به والتوقُ الأنطولوجي لاستنفاده طريقَ العشق اللانهائي، حيث الله في مبتداه ومنتهاه، والإنسان في سفر دائم نحو اكتشاف نفسه، واستشفاف النفخة الإلهية الأزليةِ الكامنة في حسه ومعناه كيما يعيش وفقها، كما تؤكد ذلك القاعدة الرابعة والعشرون.
وعلى الإجمال، ليست هذه السطور إجابةً ضافية شافية عن سؤال الانجذاب إلى عمل شافاق، ثم إلى كل الأعمال السردية المستلهِمَة للإرث العرفاني الإسلامي والمتحاورة إبداعيا معه، بقدر ما هي فتحٌ لكوة التأمل في رهانٍ أسلوبي اتخذت شافاق منه، إلى جانب درامية حياة الرومي المكتوية بالعشق والشغف والشعر والموسيقى والسؤال...، أداةً لاستثارة ذاك العطش الأنطولوجي للمعنى الروحي الذي أضحى واحدا من علامات القرن الحادي والعشرين؛ عطش ينبجسُ من وسط إكراهات وتناقضات تُفجِّر "أزمة معنى" مازال العالمُ اليوم يتلكأ في التحديق فيها، مثلما كان يتلكأ الرومي في التحديق في "شمس".
[1]- لعل من الطريف تسجيلُ العناية الأدبية الأنثوية بجلال الدين الرومي والتي تحتاجُ إلى تأمل تساؤلي منسي، بدءا بالعناية الكبرى التي حظيت بها تجربة الرومي في أبحاث الألمانية آن ماري شيمل الموسوعية ثم الفرنسية إيفادي فيتراي ميروفيتش.
[2]- من هذه العبارة استوحى يونس إيريك جوفروا عنوان كتابه: 'l'islam sera spirituel ou ne sera plus' (Paris, Éditions du Seuil, coll. « La couleur des idées », 2009)؛ والذي صدرت ترجمته العربية بعنوان: "المستقبل للإسلام الروحاني"، ترجمة هاشم صالح، مراجعة أسامة نبيل نبض، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016.
[3]- الحراق، محمد التهامي، "إني ذاهب إلى ربي...مقاربات في راهن التدين ورهاناته"، دار أبي رقراق، الرباط، 2016، ص ص 361-365
[4]- أسبوعية "أخبار الأدب" المصرية، العدد 974، الأحد 26/03/2012م، ص.9
[5]- راجع: الحراق، محمد التهامي، "رشفة من قهوة مولانا"، ضمن مجلة "أفكار"، ع5/2016م، ص ص8-11
[6]- وردت ترجمة هذه المقدمة في: تدين، عطاء الله، "مولانا جلال الدين الرومي وشيخه تبريز...بحثا عن الشمس من قونية إلى دمشق"، ترجمة المكتب الفني للترجمة والنشر، لبنان، الناشر: الممر الثقافي، القاهرة، 2016، ص15
[7]- بلقاسم، خالد، "الكتابة والتصوف عند ابن عربي"، خالد بلقاسم، دار توبقال، الدار البيضاء، ط.1/2004م، ص224
[8]- شافاق، إليف، "قواعد العشق الأربعون"، ترجمة خالد الجبيلي، طوى للنشر والإعلام، 2012، ص61
[9]- "قواعد العشق الأربعون"، م.س، ص62
[10]- "قواعد العشق الأربعونم. س، 500







