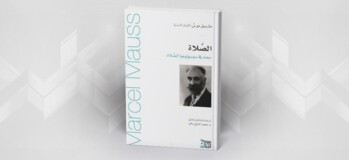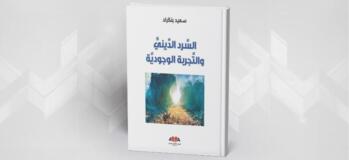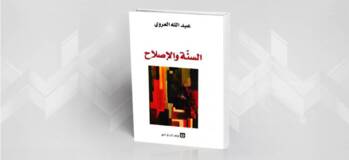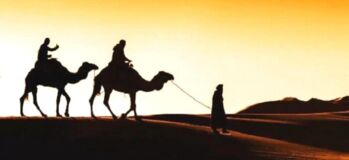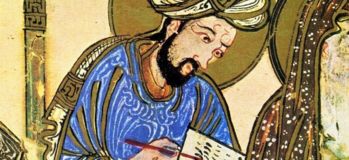اصطلام النار- وحدة الحكمة الفلسفية والملة الإبراهيمية
فئة : مقالات

اصطلام النار- وحدة الحكمة الفلسفية والملة الإبراهيمية
"النّارُ تُطهِّرُ كُلَّ شيءٍ"
غاستون باشلار(1)
- توطِئة:
لَقَد بُحِثَ في سؤال "ما الفلسفة؟" كثيرًا، وَإنَّها لَكَلِمَةٌ مُستَلَفةٌ مِنَ الإغريق، لكنَّ بَعضَ مَن تَفلسَفوا مِنهم بَعدَ ذلكَ – وَمَن هُم لَيسوا مِنهُم – قَد غَفَلوا عن مُقتَضَياتٍ هَذا الِاستِلَاف. وَأشكالُ هَذا الغُفلانِ في عَددِها تَساوي – إِلى حَدٍّ ما – عَددَ المَرّاتِ الَّتي طُرِحَ فيها السُّؤالُ: "ما الفلسفة؟". فَمِن مُقتَضَياتِ الِاستِلَافِ لِكَلِمَةٍ مَا – بِوصفها تَدُلُّ على مَفهومٍ – استِلَافُ تَاريخِ المَفهومِ في علاقَتِهِ بِذاتِهِ.
وَيُؤَرَّخُ عَادةً لِظُهورِ هَذِهِ الكَلِمَةِ بِظُهورِ "طاليس"، إلّا أنَّهُ في أحيانٍ كَثيرةٍ – وَغَيرِهِ مِمَّن تَفلسَفوا حَولَ الطَّبيعةِ مِثلَ أَنكسمَندرَ وَأَنِكسمانسَ وَإمبِذُقليِسَ وَهِرَقلِيطَ وَدِيمِقرِيطسَ وَسائِرِ فَلاسِفَةِ الذَّرَّةِ – قَد أَبقَوا وَفاءً لِمُقتَضَى أَسَاسِيٍّ لِكَلِمَةِ philo-sophy، وَهُوَ أنَّ حُبَّ الحِكمَةِ هُوَ حُبٌّ إرادَتُهُ تَعني اِصطِلامَ النَّار؛ أيِ الرُّكُوعَ تَحتَ وَطأَةِ مَا يَشِأُ الإحراقُ. وَالمُرادُ هُنا أنَّ حُبَّ الحِكمَةِ نَذِيرُ تَبَدُّلٍ كُلِّيٍّ لَهُ طَابعُ الإليثيا (الحَقيقةِ) كَتَكشُّفٍ وَتَجَلٍّ ذِي أَطوارٍ، هِيَ أَطوارُ اليَقينِ الثَّلاثة القُرآنيَّةِ: عِلمُ اليَقينِ الوارِد في الآية 5 مِن سُورَةِ التَّكاثُر "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ"، وَعَينُ اليَقينِ والآية 7 مِنهَا "ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ"، وَحَقُّ اليَقينِ في الآية 95 مِن سُورَةِ الوَاقِعَة "إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ".
وَفي هَذِهِ المَقالَةِ، سَنَعمَلُ على تَدعيمِ هَذا المَوقِفِ بِصِفتِهِ المَوقِفَ القادِرَ على الإقامَةِ داخِلَ كُلِّ التَّعاريفِ المُمكنَةِ لِلفَلسَفَةِ؛ لِأَنَّهُ لا يُعارِضُ تَعريفًا قَد سَبَقَ، وَلَا يُعيقُ آخَرَ قَد يُستَحدَثُ.
- أَصلِ الفَلسَفَةِ قَبلَ أن تَكونَ فَلسَفَةً
على اختلافِ ما ذهبَ إليه فلاسفةُ الطبيعةِ في رؤاهم، إلا أنه قد بَقِيَ مُشترَكٌ واحدٌ، وهو أنَّ السؤالَ كان موجَّهًا لِإيجادِ ما يُمكن أن يُستخرَجَ منه كُلُّ الطبيعةِ، بما فيه من كثرةٍ واختلافٍ مُتضادٍ ومُتناقضٍ. ونحنُ نذكرُ هذه النقطةَ لِنُجوِّزَ الابتداءَ من هيراقليطسَ تحديدًا، دون أن يعنيَ ذلكَ أنَّ ما نقدِّمُهُ من رؤيةٍ يُقصِي سابقيه؛ لأنَّهُ عندَ هيراقليطسَ وَقَعَتِ التسميةُ لأولِ مرةٍ لِمَن يضطَّلِعُ بالسؤالِ عمَّا يمكنُ استخراجُ كُلِّ الطبيعةِ منه، كما وَقَعَتْ تسميةُ الشيءِ المسؤولِ عنه. وقد كانَ المُضطَّلِعُ بالسؤالِ هو philo/المُحِبِّ الذي يَتلاءمُ وينسجِمُ ويُقِيمُ هارمونيا مع المسؤولِ عنه، وهو sophos/الحكمةِ، التي تدلُّ على أنَّ "الكُلَّ هو الواحدُ" (2) (يَدلُّ الواحدُ على معنى الشيءِ عينِهِ، ولا شأنَ لهُ بالكَمِّ). ومِنْ هذا يتبيَّنُ أنَّ حُبَّ الحكمةِ فيهِ تعويضُ الكُلِّ بالواحدِ، بل ويجوزُ المُبادلةُ بالقولِ إنَّ الواحدَ هو الكُلُّ. وبهذا، إنْ كانَ مُحِبُّ الحكمةِ في هارمونيا مع الواحدِ، فهوَ كذلكَ في هارمونيا مع الكُلِّ.
إنَّنا نستشفُّ هنا أولَ ظهورٍ لـالنارِ بصفتِها الخاصيةَ الأصيلةَ للحكمةِ؛ فأنْ يكونَ الكُلُّ أو المجموعُ هو الواحدُ هو إحراقٌ مُبدِّلٌ للموقفِ الأولِ الذي نجدُ أنفُسَنا فيهِ، ويُقِيمُ نفيًا مُتبادَلًا وتناقُضًا بينَهُما. وإنَّ سُلطانَ هذا الأصلِ للحكمةِ – بوصفها نارًا تحرقُ مُبدِّلَةً ما نحنُ فيهِ – أَمثِلَتُهُ كثيرةٌ عندَ المُتأخِّرينَ، من أمثالِ إدموند هوسرلَ والمنهجِ الفينومينولوجيِّ في تعيينِ امتيازِ الموقفِ الفلسفيِّ على نظيرِهِ الطبيعيِّ، بوصفهِ ينظرُ في إمكانِ المعرفةِ، حيثُ يَستلزِمُ الاضطّلاعُ بهِ استبعادًا وتغييرًا مُطلَقًا للموقفِ الطبيعيِّ (أيِ احتراقِهِ) (3). والأمرُ عينُهُ في تعريفِ هيغلَ للفلسفةِ بأنَّها "العالمُ مقلوبًا"، ففعلُ الإحراقِ – الذي هو خاصيةُ النارِ التي نَسَبْناها إلى الحكمةِ في معناها لدى هيراقليطسَ – ثاوٍ في مفهومِ القَلْبِ؛ لأنَّ القلبَ نفيٌ للموجودِ الحاضرِ، وإثباتٌ لشيءٍ مُختلِفٍ كُلِّيًّا عمَّا تمَّ استبعادُهُ ونفيُهُ. ومثالُ ذلكَ من نيتشهَ هو محاولةُ قَلْبِ القِيَمِ، حيثُ يجري استبدالُ مُسلَّماتٍ ميتافيزيقيَّةٍ مُعيَّنةٍ بأُخْرَى تُمثِّلُ ضِدًّا تامًّا لها. والأهمُّ من كلِّ ذلكَ أنَّ معنى الحكمةِ القائلَ إنَّ "الكُلَّ أو المجموعَ هو الواحدُ" يَبقى ثاوِيًا في كِلَا التعريفينِ: فالعالمُ الذي تقلِبُهُ الفلسفةُ، والموقفُ الذي تلفظُهُ الفلسفةُ بفعلِ الإحراقِ الذي يُبدِّلُ كلَّ شيءٍ، يُبقيانِ على الموضوعِ نفسِهِ؛ فالعالمُ هو ذاتُ العالمِ، والمعارفُ التي يتناولُها الموقفُ الطبيعيُّ هي ذاتُها التي يتناولُها الموقفُ الفلسفيُّ، أمَّا إذا عرَّجْنا فيمَنْ هم غيرُ هؤلاءِ، فيُمكِنُ اختزالُهُمْ كـأفلاطونيِّينَ باعتبارٍ مُعيَّنٍ، وهو أنَّ السؤالَ عن الماهيةِ/الإنيَّةِ قد بَقِيَ الشغلَ الأساسَ، وهذا الشغلُ لَرُبَّمَا يُعَدُّ الأكثرَ جلاءً لطابعِ الإحراقِ المُبدِّلِ الذي للحكمةِ، لسببينِ اثنينِ:
- أنَّ سؤالَ الماهيةِ/الإنيَّةِ يَنْبجِسُ في زمنٍ مُتأخِّرٍ من تاريخِ النفسِ (5).
- أنَّ انبجاسَهُ المُتأخِّرَ زمنيًّا علَّتُهُ الأساسيَّةُ هي الالتباساتُ والاحراجاتُ التي تُحيطُ بالفكرِ(6).
في النقطةِ الأولى، يتبيَّنُ أنَّ السؤالَ لهُ طابعُ الحدثِ الطارئِ، وهذا سليمٌ؛ إذِ الماهيةُ/الإنيَّةُ حينَ فُهِمَتْ – فُهِمَتْ كمثالٍ/eidos – كانتْ تأديةً لوظيفةٍ مُغايرةٍ للفكرِ، فصارَ يُعوِّضُ الكثرةَ بالوِحْدَةِ، والتبدُّلَ الذي يُصيبُ حقيقةَ شيءٍ بالهُوِيَّةِ التي سؤالُها على هذهِ الصيغةِ: "ما الذي يَجعلُ الشجاعةَ شجاعةً؟"، وبصيغةٍ عامَّةٍ يكونُ السؤالُ: "ما الذي يَجعلُ شيئًا ما هو هذا الشيءُ؟".
أمَّا النقطةُ الثانيةُ، فهي نتيجةٌ تُشيرُ إلى ضرورةِ إبدالِ ما عندَنا من موقفٍ تجاهَ الأشياءِ؛ وهُنا بالضبطِ نجدُ أنَّ التحوُّلَ إلى الحكمةِ/sophos – أيًّا كانتْ نتيجَتُهُ ونتاجُهُ – لا يُغادِرُ وعيَ ضرورةِ الإبدالِ والإحراقِ هذهِ. إنَّ الموقفَ الطبيعيَّ الذي يُقرِّرُهُ هوسرلُ للفكرِ يَنفي ذاتَهُ لحظةَ يَعِي ذاتهُ؛ لأنَّ انتهاءَهُ لِإحراجاتٍ غيرِ قليلةٍ تجاهَ ما قرَّرَهُ عنِ الأشياءِ سَيَعتمِلُ في الذاتِ اعتمَالَ العِلَّةِ، لإقامةِ نَقْلَةٍ نحوَ الحكمةِ/sophos بالاعتبارِ الذي ذكرناهُ لها؛ أيْ إقامةِ وِحْدَةٍ بينَ الكُلِّ أو المجموعِ والواحدِ (أيْ شيءٍ بعينِهِ)، يقول هيغلَ: «إنَّ الحاجةَ إلى الفلسفةِ تَنْبَعِثُ حينَ تَزولُ القُدرةُ على التوحيدِ، وتَمَّحِي من حياةِ البشَرِ، وحينَ تكونُ المتقابلاتُ قد فقدَتْ رباطَها الحيَّ وتفاعلاتِها» (7).
ونستخلِصَ أمرينِ من قوله هذا، وبالضبطِ مِنْ وضعِهِ لِكلمةِ "زوالٍ":
- أولُهُما: أنَّ الطبعَ الناريَّ للحكمةِ (المُحرِقِ والمُبدِّلِ) هوَ استعادةُ قُدرةٍ.
- وثانيهما: أنَّ ما نَجِدُهُ بِفَضلِ الطبعِ الناريِّ لها هوَ إعادةُ إحياءِ الكُلِّ أو المجموعِ عبرَ الواحدِ، بوصفهِ شيئًا قد سَبَقَ وكانَ. وعليهِ، فإنَّ طبعَ النارِ الذي للحكمةِ هوَ يُعيدُ العالمَ إلى نَفسِهِ.
- اصطِلامُ نَارِ الحِكمَةِ:
مِنَ البَدِيهِيِّ أن نُفَكِّرَ بِأَنَّ النَّارَ شَيءٌ لَا يُرادُ، أَو أنَّهَا بِذَاتِهَا كَفِيلَةٌ بِالإبعَادِ التَّامِّ عَنهَا؛ لِأَنَّ مسَاسَهَا بِنَا دُونَ الِابتِعَادِ عَنهَا يَعنِي تَبدِيلًا كُلِّيًّا لَنَا – أَي نَقلَنَا مِنَ الحَياةِ إلَى المَوتِ. فَكَيفَ تُحَبُّ وَيُنسَجَمُ مَعَهَا؟ إن أَخَذنَا بِالِاعتِبَارِ أنَّ العَالَمَ هُوَ سَلفًا مَيِّتٌ – كَمَا في الِاقتِبَاسِ المَذكُورِ مِن عِندِ هِيغلَ –، فَإِنَّ النَّارَ تَعنِي نَقلًا مِنَ المَوتِ إلَى الحَياةِ، إلّا أنَّ الأَلَمَ يَبقَى حَاضِرًا في الحَالَتَينِ، فَكَيفَ تُرَادُ وَتُحَبُّ الحِكمَةُ إذَا كَانَت نَارًا؟
في المُحَاوَرَةِ السَّابِعَةِ المَنسُوبَةِ إلى ِأَفْلَاطُونَ – وَالَّتِي تُقَرِّرُ مُونِيك دِيكُسو حَولَهَا بِالقَولِ إنَّهَا يَجِبُ أن تُعدّ– بِالنَّظرِ لِبَقِيَّةِ المُحَاوَرَاتِ – بِالقَدرِ الَّذِي تَتَقَاطَعُ فِيهِ مَعَ تِلكَ الَّتِي ثَبَتَ أنَّهَا مِن كِتَابَةِ أَفْلَاطُونَ (8) –، نَجِدُ أَثَرًا لِهَذِهِ العَلَاقَةِ بَينَ الحِكمَةِ وَالنَّارِ، حَيثُ سَعَى أَفْلَاطُونُ لِامتِحَانِ مُحَاوِرِهِ "دِينيس" لِلتَّأكُّدِ مِن أَنَّهُ "تَحتَ وَطأَةِ الفَلسَفَةِ – كَمَا تَحتَ تَأثِيرِ اللَّهَبِ –"، لَكِنَّهُ لَن يَكونَ كَذَلِكَ إلّا بِاستِيفَاءِ شَرطَينِ (9):
- وُجُودُ قَرَابَةٍ طَبيعِيَّةٍ مَعَهَا.
- النَّجَاةُ مِنَ التَّربِيَةِ الفَاسِدَةِ.
يُمَثِّلُ أَوَّلُ هَذَينِ الشَّرطَينِ سَابِقَ إِعتَادٍ وَأُلفَةٍ وَانسِجَامٍ؛ فَيَكونُ الوُجُودُ تَحتَ وَطأَةِ الحِكمَةِ قَابِلًا لِلاِحتِمَالِ. لَكِنْ لَا بُدَّ مِن وُجُودِ مَكسَبٍ مِن هَذِهِ التَّجرِبَةِ يَحمِلُ عَلَيهِ، وَلَن يَكونَ سِوَى تَجرِبَةٍ لِشَيءٍ مُختَلِفٍ تَمامًا لِكُلِّ مَا تمَّت تَجرِبَتُهُ قَبلَهُ – بِحَيثِيَّةٍ تَجعَلُ هَذِهِ التَّجرِبَةَ تَجرِبَةً لِلنِّعمَةِ وَاستِشرَارًا عَمِيقًا لِفَضلٍ، وَهُوَ أنَّ الحِكمَةَ – الَّتِي اصطُلِمَتْ – تُنجِي الِاصطِلامَ بِهَا مِن فَسَادٍ أُلحِقَ بِنَا. فَيَعنِي البَقَاءُ "تَحتَ وَطَأَةِ" الفَلسَفَةِ – أَوِ الحِكمَةِ – البَقَاءَ تَحتَ سُلطَانِ شَيءٍ سَبَقَ لِمَن يُحَاوِرُهُ حُبُّهُ. وَهَذَا مَا يُسَمَّى في الذَّوقِ الصُّوفِيِّ "اِصطِلامًا". يَقولُ ابنُ عَرَبِيّ في الفُتُوحَاتِ المَكِّيَّةِ:
"الِاصطِلامُ – في اِصطِلَاحِ القَومِ – وَلَهٌ يَرِدُ عَلَى القَلبِ، سُلطَانُهُ قَوِيٌّ فَيَسكُنُ مَن قَامَ بِهِ تَحتَهُ".
وَهُوَ أَثرُ هَيبَةِ شَيءٍ ويُشَبِّهُهُ بِالنَّارِ المُحِيطَةِ بِالفَردِ مِن جَمِيعِ الجِهَاتِ (10). وَيُمكِنُ – إن تَحَرَّجنَا مِن لَفظِ "القَلبِ" – أن نَستَبدِلَهُ بِ "الذَّاتِ". إنَّ البَقَاءَ تَحتَ وَطَأَةِ الفَلسَفَةِ – أَوِ الحِكمَةِ – هُوَ حُبُّهَا، وَقَد تَسَلَّطَ عَلَينَا فَصَارَ وَلَهًا بِهَا، فَنَعجِزُ – رَغمَ طَابِعِهَا النَّارِيِّ الَّذِي شَأنُهُ الإحرَاقُ – عَنِ الفِرَارِ مِنهَا أَوِ الِإدبَارِ عَنهَا. وَهَذِهِ العَلَاقَةُ الوَلهَةُ بِهَا هِيَ ذَاتُهَا مَا يَحمِلُ عَلَى اِستِكمَالِ الِاحتِرَاقِ بِهَا، وَاستِكمَالِ النَّجَاةِ مِنَ التَّربِيَةِ الفَاسِدَةِ (لَا تُمَثِّلُ التَّربِيَةُ الفَاسِدَةُ شَيئًا هُنا أَكثَرَ مِن نَقِيضِ الحِكمَةِ بِالمَعنَى الَّذِي ذَكَرنَاهُ – وَلَا بَأْسَ أن نَعتَبِرَهُ تَعبِيرًا عَنِ المَوقِفِ الطَّبيعِيِّ عِندَ هُوسرلَ).
- النَّارُ في النُّصُوصِ الإبراهيميَّةِ التَّوحِيديَّةِ:
لَقَد وَضَعنَا في بَدَايَةِ بَحثِنَا اِقتِبَاسًا لِـغَاستُون بَاشلار يَنسِبُ فِيهِ إلَى النَّارِ بِأَنَّهَا تُطهِّرُ كُلَّ شَيءٍ. وَبِالتَّأكِيدِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكونُ مِن خِلَالِ إحرَاقِهَا لِمَا يَجِبُ أَلَّا يُوجَدَ. وَبِالنَّظرِ لِلحِكمَةِ، فَإِنَّ مَا يَجِبُ أن يَتمَّ التَّطهُّرُ مِنهُ – أَو يَحرِقَ فينَا – هُوَ العَالَمُ كَمَا هُوَ عِندَ هِيغلَ (أَي مَا قَبلَ قَلبِهِ مِن خِلَالِ الفَلسَفَةِ)، وَزَوَالُ القُدرَةِ عَلَى التَّوحِيدِ بَينَ البَشَرِ، وَأَخِيرًا فُقدَانُ المُتَقَابِلَاتِ رِبَاطَهَا الحَيَّ وَتَفَاعُلَاتِهَا.
وَفي القُرآنِ، تَتَّخِذُ النَّارُ رَسمِيًّا صُورَةَ مَرحَلَةٍ أَقَامَ فِيهَا إبرَاهِيمُ فَترَةً بَعدَ أن أَلقَاهُ فِيهَا قَومُهُ، لَكِنَّهَا كَانَت بَردًا وَسَلَامًا. وَنَلتَمِسُ فِيهَا أَكثَرَ البَدَاهَاتِ حَولَ النَّارِ بِوصفهَا أَمرًا مُؤذِيًا – كَمَا يَأتِي في الآيَاتِ 68-69-70 مِن سُورَةِ الأَنبِيَاءِ:
"قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70)".
فَالقَومُ – رَمزُ المَوقِفِ الطَّبيعِيِّ – وَإبرَاهِيمُ – رَمزُ الحِكمَةِ –، وَالصِّرَاعُ بَينَهُمَا لَيسَ شَيئًا أَكثَرَ مِنَ التَّنَافُرِ الكَائِنِ بَينَ المَوقِفِ الطَّبيعِيِّ وَالحِكمَةِ، لَكِنَّ مَن هُوَ في النَّارِ – أَوِ الحِكمَةِ – لَا يَجِدُ في المُحرِقِ مَا يَحرِقُ عَلَى الحَقِيقَةِ، بَل هِيَ بَردٌ وَسَلَامٌ – كَإِشَارَةٍ إلَى لَذَّةِ عَمَلِيَّةِ الِاصطِلامِ، الَّتِي بِحَسَبِهَا يَتمُّ تَجَلِّي الحَقِيقَةِ. أمّا الخُسران الذي وُضَعَ فيه القومُ، فهو البقاءُ خارِجَ أُفُقِ الحقيقة.
- الحقيقةُ كَتَجَلٍّ وَتَمَرحُلٍ في مَرَاتِبِ اليَقينِ:
لَقَد بَلَغنَا في مَبحَثِنَا هَذَا النُّقطَةَ الأَكثَرَ حَسمًا، حَيثُ يَجدُرُ بِنا أن نُنوِّهَ إلى أنَّ حُصولَ اليَقينِ لَيسَ حُصولَ مَا عَلَيهِ بُرهَانٌ عَقلِيٌّ – كَمَا يَتَصَوَّرُ بَعضُهُم –، بَل هُوَ أَمرٌ أَكثَرُ جَوهَرِيَّةً: فَاليَقينُ هُنا نِتَاجُ تَقَاطُعٍ يُشبِهُ – إلَى حَدٍّ كَبِيرٍ – تَجرِبَةَ القِدِّيسِ أُغُسطِينُوس حِينَ اعتَبَرَ مَعرِفَةَ حَقِيقَةِ الذَّاتِ أَمرًا يَحدُثُ بِالتَّنَاسُبِ مَعَ مَعرِفَةِ الإلَهِ، كَمَا يَقولُ في "اِعتِرَافَاتِهِ": "بِمَا أنَّنِي أَعلَمُ مَا في نَفسِي بِإِنَارَةٍ مِنكَ".
فَالذَّاتُ الَّتِي تَصطَلِمُ الحِكمَةَ – بِقَدرِ مَا تَصطَلِمُهَا – تَقطَعُ طَرِيقًا في نَفسِهَا؛ لِأَنَّهَا تَنتَمِي لِلكُلِّ أَوِ المَجمُوعِ الَّذِي يَضمُّهُ الوَاحِدُ. وَهَذِهِ الشَّاكِلَةُ مِنَ اليَقينِ تَكونُ بِقَدرِ مَا يَتمُّ الِاقتِرَابُ مِنهُ عَلَى جِهَةِ الِاصطِلامِ – أَوِ الوُجُودِ "تَحتَ وَطَأَةِ الفَلسَفَةِ" –؛ فَهُوَ حُصولُ تَجَانُسٍ بَينَ الذَّاتِ وَالحَقِيقَةِ، كَتَجَانُسِ النَّارِ مَعَ اللَّهَبِ.
1 - عِلْمُ اليَقِينِ:
إِنَّ الِاصْطِلَامَ، كَمَا قَرَّرْنَا، كُلَّمَا بَقِينَا تَحْتَ سُلْطَانِهِ نَكْسِبُ تَجَلِّيًا لِلْحَقِيقَةِ يَكُونُ عَلَى دَفَعَاتٍ أَوْ دَرَجَاتٍ. وَبِمَا أَنَّ الْعَلَاقَةَ مَعَ الْحَقِيقَةِ غَايَتُهَا التَّجَانُسُ وَالِالْتِئَامُ مَعَهَا بِاعْتِبَارِهَا الْكُلَّ أَوِ الْمَجْمُوعَ (بِاعْتِبَارِهِ وَاحِدًا)، فَهُوَ تَمَرْحُلٌ فِي يَقِينٍ تُمَثِّلُ سَابِقَ التَّجْرِبَةِ بِهِ أَوِ الِاعْتِيَادَ وَالْأُلْفَةَ مَعَهُ، وَالَّذِي سَمَّاهُ أَفْلَاطُونُ «قَرَابَةً طَبِيعِيَّةً» - قَبَسًا مِنْهُ يَنْبَغِي اسْتِكْمَالُهُ — وَنُحَدِّدُهُ هُنَا بِوصفِهِ أَوَّلَ مَرَاتِبِ الْيَقِينِ، وَهُوَ عِلْمُ الْيَقِينِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَيَعْنِي إِخْبَارًا عَنْ شَيْءٍ لَكِنْ مَعَ فَقْدِ الصِّلَةِ بِمَا تَمَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ. وَهَذَا الْفَقْدُ لِلصِّلَةِ لَيْسَ تَامًّا (يَضْرِبُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِثَالًا عَلَى ذَلِكَ، فَيَقُولُ: «مَثَلُ مَنْ أُخْبِرَ أَنَّ هُنَاكَ عَسَلًا وَصَدَّقَ الْمُخْبِرَ» (12))، بِفَضْلِ تَصْدِيقِ الْمَرْءِ لِلْمُخْبِرِ. وَلَا يَعْنِي التَّصْدِيقُ امْتِثَالًا لِلْمُخْبِرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، بَلْ نَعْتَبِرُهُ دَلَالَةً أَنْثْرُوبُولُوجِيَّةً لَهُ، بِوصفهِ فِعْلَ اقْتِسَامٍ أَوْ مُقَاسَمَةٍ لِلْمُخْبِرِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَيُخْبِرُنَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ بِإِمْكَانِ أَنْفُسِنَا أَنْ تَجِدَ نَفْسَهَا ذَاتَ عَلَاقَةٍ بِمَا يُخْبِرُ عَنْهُ. فَهَذَا الْقَبَسُ الْأَوَّلُ أَمْرٌ يَسْتَعْصِي عَلَى التَّنَاوُلِ الْمَعْرِفِيِّ حَتَّى تُبَلَّغَ حَقِيقَتُهُ بِذَاتِهِ. فَالِاقْتِسَامُ بِدَوْرِهِ لَيْسَ تَامًّا؛ لِأَنَّ الْمُخْبِرَ هُوَ فِي نِهَايَةِ أَطْوَارِ مَرَاتِبِ الْيَقِينِ (نَعْنِي أَنَّهُ حَاصِلٌ عَلَى حَقِّ الْيَقِينِ، وَفِي التِئَامٍ تَامٍّ وَمُكْتَمِلٍ مَعَ الْحِكْمَةِ). وَبِهَذَا، فَإِنَّ التَّمَرْحُلَ فِي مَرَاتِبِ الْيَقِينِ هُوَ تَمَرْحُلٌ فِي مَسْلَكٍ يَعْلَمُهُ الْمُخْبِرُ حَقَّ الْعِلْمِ. وَالْمُخْبِرُ الَّذِي يَمْلِكُ حَقَّ الْيَقِينِ، فَإِنَّ تَصْدِيقَهُ وَمُقَاسَمَتَهُ مَا عِنْدَهُ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الِاقْتِرَابِ نَحْوَ حَقِّ الْيَقِينِ، أَوْ هُوَ الْحِكْمَةُ وَقَدْ وُجِدَ مَنِ اكْتَمَلَ تَلَاؤُمُهُ وَانْسِجَامُهُ مَعَهَا.
لَكِنْ يَبْقَى سُؤَالٌ مُعَالَجَتُهُ ضَرُورِيَّةٌ: إِذَا كَانَ عِلْمُ الْيَقِينِ أَوِ الْقَرَابَةُ الطَّبِيعِيَّةُ تُمَثِّلَانِ قَبَسًا مِنَ الْحِكْمَةِ، فَمَا الَّذِي هُوَ كَفِيلٌ بِأَنْ يَدْفَعَ بِالتَّمَرْحُلِ إِلَى أَقْصَاهُ فِي مَرَاتِبِ الْيَقِينِ أَوِ الْوُجُودِ تَحْتَ وَطْأَةِ الْحِكْمَةِ؟ نَحْنُ مُنتبِهُونَ تَمَامًا إِلَى أَنَّنَا فِي بَلْوَرَةِ تَلَاحُمٍ بَيْنَ الْحِكْمَةِ وَاللَّاهُوتِ. لِذَا سَنَأْتِي بِإِجَابَتَيْنِ فِي شَأْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا تَقُولَانِ الشَّيْءَ نَفْسَهُ. فَفِي مُحَاضَرَتِهِ «مَا الْفَلْسَفَةُ؟»، يَقُولُ هَايدِجَرْ إِنَّهَا: «تَمَسُّنَا فِي كَيْنُونَتِنَا الْخَاصَّةِ» (13). وَفِي سِيَاقِ اللَّاهُوتِ، يَقُولُ بَاوَلْ تِيلِيشْ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ «أَقْصَى هُمُومِ النَّفْسِ» (14). وَمَا دُمْنَا قَدْ أَقْرَرْنَا سَابِقًا بِأَنَّ فِعْلَ الضَّمِّ يَنْتَمِي لِلْحِكْمَةِ وَالْإِلَهِ التَّوْحِيدِيِّ عَلَى السَّوَاءِ، فَإِنَّ التَّمَرْحُلَ لِاصْطِلَامِ أَطْوَارِ الْيَقِينِ هَذِهِ — أَوِ الْوُجُودَ تَحْتَ وَطْأَةِ الْحِكْمَةِ — لَا يَنْفَصِمُ عَنْ أَنْ يَهُمَّ الَّذِي يَتَمَرْحَلُ (الذَّاتَ كَمَا هِيَ مَعْنِيَّةٌ بِنَفْسِهَا). فَلَا تَعُودُ هُنَاكَ قَرَابَةٌ طَبِيعِيَّةٌ مَعَ شَيْءٍ مَا، بَلْ تَغْدُو طَبِيعَةُ الذَّاتِ مُنْتَمِيَةً إِلَى الْحِكْمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ — الَّذِي هُوَ الْكُلُّ أَوِ الْمَجْمُوعُ — يَشْمَلُهَا؛ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ.
2 - عَيْنُ الْيَقِينِ:
فِي هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ التَّمَرْحُلِ فِي مَرَاتِبِ الْيَقِينِ، لَا يَعُودُ الْأَمْرُ مُنَاطًا بِتَجَلٍّ لِانْتِمَاءِ الذَّاتِ إِلَى الْحِكْمَةِ، بَلْ بِضَرُورَةِ الْإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهَا. (يُمْكِنُ أَنْ نَتَخَيَّرَ هُنَا مَا شِئْنَا مِنَ التَّعْرِيفَاتِ بِشَأْنِ الْفَلْسَفَةِ، وَكَمِثَالٍ لَوْ أَخَذْنَا تَعْرِيفَ هُوسِرْلَ بِشَأْنِ الْمَوْقِفِ الطَّبِيعِيِّ، يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الذَّاتَ هُنَا تَكُونُ فِي وَعْيٍ بِضَرُورَةِ التَّخَلِّي عَنِ الْمَوْقِفِ الطَّبِيعِيِّ.) وَهِيَ مَرْحَلَةُ مُعَايَنَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يَتِمُّ اصْطِلَامُهُ وَتَسَلُّطُهُ عَلَى الذَّاتِ، بِفَضْلِ سَابِقِ مَحَبَّةٍ وَقَرَابَةٍ صَارَتْ وَلَهًا بِالْمَحْبُوبِ وَالْقَرِيبِ. إِنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ يُبَاعِدُ الذَّاتَ — عَبْرَ الِاصْطِلَامِ — عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ غِيَابِ تَوْحِيدٍ بَيْنَ الْبَشَرِ، وَفِقْدَانِ الْمُتَقَابِلَاتِ رِبَاطَهَا الْحَيَّ وَتَفَاعُلَاتِهَا، وَهُوَ الْوُجُودُ تَحْتَ وَطْأَةِ الْحِكْمَةِ بِعَيْنِهِ، كَالْبَوَّابَةِ الَّتِي يَجْرِي مِنْ خِلَالِهَا تَوْكِيدُ جَدَارَةِ الِانْتِقَالِ نَحْوَ انْسِجَامٍ تَامٍّ مَعَ الْحِكْمَةِ، بِحَيْثُ تَوْجَدُ وَحْدَهَا دُونَ إِلْغَاءِ غَيْرِهَا، بَلْ غَيْرُهَا هُوَ مَوْضِعٌ لَهَا. إِنَّ هَذَا شَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ: مِنْ تَصْرِيحَاتٍ مَعْرُوفَةٍ عَنْ هَايدِجَرَ عَنِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ «لَا يُفَكِّرُ»، أَوْ مِنْ خِلَالِ ظَنِّ الْفَلَاسِفَةِ — فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ — أَنَّ لَهُمُ الْحَقَّ فِي النَّظَرِ فِي عُلُومِ غَيْرِهِمْ، بَيْنَمَا لَا يَجُوزُ الْعَكْسُ. فَأَيُّ عِلْمٍ سِوَى الَّذِي مِنْ شَأْنِ الْحِكْمَةِ هُوَ عِلْمٌ بِمَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ؟ وَلِهَذَا الْمَنْظُورِ وَجَاهَةٌ نُقِرُّهَا؛ لِأَنَّ الذَّاتَ — كَشَيْءٍ يَنْتَمِي لِلْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ الْكُلُّ — إِنَّمَا تَغْدُو عَلَاقَتُهَا بِجُزْئِيَّاتِهِ (بِالنَّظَرِ لِهَذِهِ الْكُلِّيَّةِ)؛ فَالْحِكْمَةُ مَوْقِفٌ لَيْسَ بِمَقْدُورِ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا مَوْقِفُ الْكُلِّ مِنْ نَفْسِهِ، أَمَّا غَيْرُهَا فَهُوَ مَوْقِفُ الْجُزْءِ مِنْ نَفْسِهِ.
3 - حَقُّ الْيَقِينِ:
تَدُلُّ كَلِمَةُ «حَقّ» عَلَى الِانْتِمَاءِ، مِثْلَمَا نَقُولُ: «هَذَا حَقُّ كَذَا»، وَنَعْنِي بِذَلِكَ مَا يَعُودُ لِشَيْءٍ مَا بِصِفَتِهِ مُقَوِّمًا لَهُ. إِنَّ حَقَّ الْيَقِينِ إِذًا هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ الْيَقِينُ، وَمَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْءُ هُوَ حَقِيقَتُهُ. فِي هَذَا الْمُسْتَوَى، فَإِنَّ الْمُصْطَلِمَ بِالْحِكْمَةِ — أَوِ الذَّاتَ الَّتِي تَحْتَ وَطْأَتِهَا — قَدْ صَارَتْ مُنْتَمِيَةً لَهَا، بِوصفهَا تَنْتَمِي لِحَقِيقَتِهِ؛ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ تَعْنِي أَنَّ الْوَاحِدَ هُوَ الْكُلُّ أَوِ الْمَجْمُوعُ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ.
وَإِذَا كَانَ جَوَازُ الْمُبَادَلَةِ بَيْنَ الْمُصْطَلِمِ بِالْحِكْمَةِ، وَبَيْنَ «فِيلُو» (Philo) و«سُوفُوس» (Sophos) — أَيْ مُحِبِّ الْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ نَفْسِهَا - يَغْدُو هُنَا بَيِّنًا بِفَضْلِ هَذَا الِانْتِمَاءِ، وَبِمَا أَنَّ فِي الِاصْطِلَامِ سُلْطَانًا لِلشَّيْءِ الْمُصْطَلَمِ (الْحِكْمَةِ) عَلَى الْمُصْطَلِمِ بِهِ وَالْوَلَهَ بِهِ، فَإِنَّهُ هُنَا يَحْدُثُ أَنْ تُكَرِّسَ الذَّاتُ نَفْسَهَا لَهُ كُلِّيًّا، فَيَحْدُثُ الِامْتِثَالُ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْحِكْمَةِ. وَكَلِمَاتٌ مِنْ قَبِيلِ «هَارْمُونِيَا» وَ«انْسِجَام» وَ«تَلَاؤُم» لَيْسَتْ أَكْثَرَ مِنْ تَعْبِيرَاتٍ خَجُولَةٍ عَنْ عَمَلِيَّةِ التَّكْرِيسِ. فَفِي مَرْتَبَةِ حَقِّ الْيَقِينِ، تَكُونُ الذَّاتُ — إِذن — قَدْ كُرِّسَتْ لِمَا اصْطَلَمَتْهُ. وَبِمَا أَنَّ فِعْلَ الضَّمِّ هُوَ فِعْلُ الْحِكْمَةِ وَالْإِلَهِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ التَّوْحِيدِيِّ، فَإِنَّ الذَّاتَ تَكُونُ قَدْ ضُمَّتْ إِلَيْهِ، أَوِ اكْتَمَلَ قَهْرُهَا عَبْرَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
استحالةُ التَّفلسُفِ دُونَ الإلهِ الإبراهيميِّ التَّوحيديِّ:
عَبرَ الجَذرِ المَشترَكِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ – بَينَ الفَلسَفَةِ وَالإيمَانِ التَّوحيدِيِّ – يَغدُو التَّفلسُفُ ضَربًا مِنَ التَّعبُّدِ، لِأَنَّ فِعلَ "القَهرِ" هُوَ نَفسُهُ فِعلُ "الفَلسَفَةِ" الَّتِي تَجعَلُ مِنَ العَالَمِ مَقلُوبًا لأجلِ توحيدِه عبر ضُمُّ الكَثرَةَ إلَى الوَاحِدِ. فَكَمَا يَقولُ القُرآنُ عَنِ النَّارِ الَّتِي أَصبَحَتْ بَردًا عَلَى إبرَاهِيمَ، تَجعَلُ الحِكمَةُ – بِطَابِعِهَا النَّارِيِّ – مِنَ الفِكرِ مَحرَابًا لوحدَانِيَّةَ الحَقِيقَةِ، لِهَذَا، لَا يُمكِنُ لِلفَيلسُوفِ أن يَبلُغَ حَقَّ اليَقينِ إلّا بالانتماء للـ"الوَاحِدِ القهّار" – لَيسَ كَفِكرَةٍ مَجَرَّدَةٍ – بَل كَخِبرَةٍ يصطَلِمُ تحتها وجوده، فَالفَلسَفَةُ – بِهَذَا المَعنَى – هي فعلٌ غايتُه بلوغُ الوحدانيّة الإبراهيميّة، ولئن نعتَ هيدجر في مرّة أصلَها بأنّه مُلحِد فهذا الإلحاد إباءٌ وامتناع عن الانتماء لأي شيء لا يضُم أو يقهر الكُلَّ أو المَجموع عبرَ وفي وبالواحِد (بلغةٍ إبراهيميّة يمكن القول أنّها إلحادٌ بأسماء الآباء)، إنّ الإيمان الإبراهيمي هو صيرورة فعلِ التوحيد للمُتاقبِلات. أمّا عودَة الحياة لتنافرها قبلَه، فهو انكشاف قيّوميّة إله هذا الإيمان على الكُلّ مِن خلاله وَحدَهُ.
خَاتِمَةٌ تَوحِيدِيَّةٌ:
نأمل أن تكون هذه المَقَالَةُ مِحرَاقا لما غَطّى عَلى الفَلسَفَةِ والإيمان، يُظهِرَ أَنَّهُمَا وَجهَانِ وشيئان ينطلقان مِن أصلٍ واحِد:
- الفَلسَفَةُ: اِصطِلامٌ نَارٍ تجعَلُ الذَّاتَ تنتمي إلى الواحد.
- الإيمَانُ: اصطلام نارٍ يَجعَلُ الواحد محيطا طاغيا على الذَّاتِ (الواحِد-القهّار).
وبشكليِّ الانتماء هذين للفلسفة/الإيمان لا تعودُ ثمَّ ثنائيّة نظر وعمل؛ لأنّ الانتماء لا يَخُصُّ جزءًا مِن الذّات، وإنّما يخُصُّ كُليّتها فالواحِد الذي يضُم والواحِد القهّار شأنه مُلاشاةُ الفوارِق.
وَبِهَذَا، فَالتَّفلسُفُ لَيسَ إلّا صَلَاةَ من صلواتِ الإيمان الإبراهيمي. وَمَا النَّارُ إلّا رَمزٌ لِهَذِهِ الوَحدَةِ الَّتِي تَأتَلِقُ – كَالشَّمسِ – فَتُذِيبُ سَطوَة أي اسم يمنعُ الواحِد من أن يضُمَّ ويقهر، لِتَبقَى الحَقِيقَةُ وَحدَهَا:
"كُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ إلّا وَجهَهُ" – القُرآنُ (سُورَةُ القَصَصِ: 88).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- باشلار، غاستون. (1984). النار في التحليل النفسي (نهاد الخياط، المترجمة). دار الأندلس. (ص 94).
2- هايدجر، مارتن. (2015). الفلسفة والهوية والذات (د. محمد مزيان، المترجم). منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف. (ص 16).
3- هوسرل، إدموند. (2007). فكرة الفينومينولوجيا (فتحي إنقزو، المترجم). المنظمة العربية للترجمة. (ص 31).
4- هايدجر، مارتن. (2003). كتابات أساسية (جزئين) (إسماعيل المصدق، المترجم). المشروع القومي للترجمة. (ص 17).
5- ريكور، بول. (بدون تاريخ). الوجود والماهية والجوهر عند أفلاطون وأرسطو (مجموعة مترجمين، المترجمون). المركز الوطني للترجمة. (ص 15).
6- ريكور، بول. (بدون تاريخ). الوجود والماهية والجوهر عند أفلاطون وأرسطو (مجموعة مترجمين، المترجمون). المركز الوطني للترجمة. (ص 15).
7- هيغل، جورج فيلهلم فريدريش. (2007). في الفرق بين نسق فشته ونسق شلنغ في الفلسفة (ناجي العونلي، المترجم). المنظمة العربية للترجمة. (ص 125-126).
8- ديكسو، مونيك. (2010). أفلاطون: الرغبة في الفهم (حبيب الجربي، المترجم). المركز الوطني للترجمة. (ص 38).
9- ديكسو، مونيك. (2010). أفلاطون: الرغبة في الفهم (حبيب الجربي، المترجم). المركز الوطني للترجمة. (ص 37).
10- ابن عربي، محي الدين. (بدون تاريخ). الفتوحات المكية (8 أجزاء) (الجزء الرابع). دار صادر. (ص 183).
11- ديكسو، مونيك. (2010). أفلاطون: الرغبة في الفهم (حبيب الجربي، المترجم). المركز الوطني للترجمة. (ص 37).
12- ابن تيمية، تقي الدين أحمد. (بدون تاريخ). مجموعة الفتاوى (20 جزءًا) (الجزء العاشر). دار ابن حزم. (ص 363).
13- هايدجر، مارتن. (2015). الفلسفة والهوية والذات (د. محمد مزيان، المترجم). منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف. (ص 12).
14- تيليتش، باول. (2007). بواعث الإيمان (سعيد الغانمي، المترجم). دار الجمل. (ص 7).