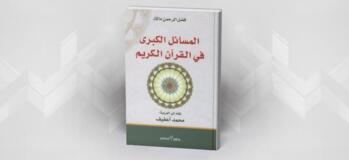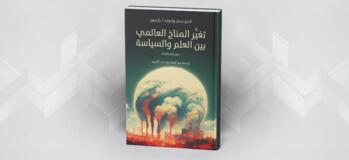الأبعاد السوسيولوجية للمجال وللزمان
فئة : ترجمات
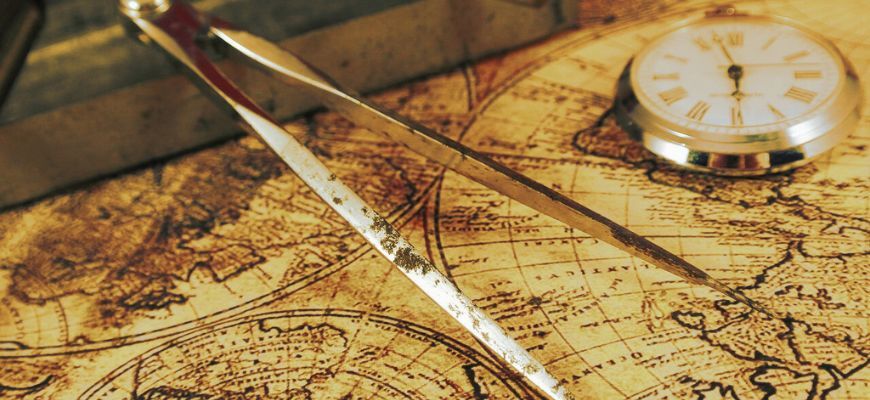
الأبعاد السوسيولوجية للمجال وللزمان[1]
ل دي ميكيلا لوتسي
ترجمة: محمد شهيد[2]
الفئتان المفاهيميتان
المجال والزمان مفهومان استثنائيان، بنيت حولهما حياة الإنسان وتاريخ المجتمعات[3]. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت التصورات والتمثلات المرتبطة بهما في تغيرات عميقة مع مرور الوقت، حيث يكون الإدراك متوافقا مع التغيرات الواقعة والناتجة عن النشاط الإنساني. فهذان العنصران يمثلان إذن، الإحداثيات الرئيسة التي يكتسب من خلالهما الوجود الإنساني معنى، ويترك آثارا لا تمحى داخل التدفقات الزمنية، والتي لن يكون لها أي معنى من دونهما. فالمجال والزمان هما سببا ونتيجة لأكثر التمثلات خصوصية: فتاريخ الإنسان بوصفه "فردا" فريدا وغير قابل للتكرار؛ لأنه مرتبط بشكل وثيق بتاريخ الإنسانية عن طريق مجتمعه في إطار ممأسس وداخل سيرورة تاريخية متطورة باستمرار[4].
وبالتالي "فالمسوح المجالية le scansioni spaziali" هي التي تُعرف العلاقات الاجتماعية وبراديغمات القيم، التي تتأسس عليها كل جماعة من خلال المقارنة والتكييف المستمر. وعلى الرغم من هذا، فإنه لم يتم اعتبار المجال والزمان عناصر أساسية للنظرية السوسيولوجية إلا في الآونة الأخيرة؛ ففي "الماضي" كان ينظر إليهما كبيئات يتم فيها إنتاج السلوك الاجتماعي وليسا كأجزاء مندمجة في سيرورات الإنتاج، فقد بقيا عنصرين محايدين في سيرورات الإنتاج دونما مشاركة مباشرة في دينامية المجتمع؛ أي كبنيتين مجردتين ومعزولتين. وحالة الحياد هذه لا تمس الفرد فقط، بل حتى المجتمعات المرجعية، على الرغم من كون البيان (تقصد البيان الشيوعي) أقر بشكل صريح بكون المجال والزمان يمكن اعتبارهما في الآن ذاته نماذج للأنشطة الجماعية ولمستويات الإدراك ولقياس التغير الاجتماعي[5].
مع مرور السنوات، انتقلنا من التمثلات الإحصائية الأحادية البعد التي كانت ملتصقة بعنصري المجال والزمان، إلى إعادة تعريفهما مع المجتمع المعاصر كمكونات جوهرية للثقافة؛ لأنهما يضفيان صبغة "الموضوعية" على المؤسسات القادرة على إعطاء التوجه والقيم للأنشطة الجماعية؛ فالمجال والزمان أضحيا أجزاء مندمجة في السيرورات التاريخية والثقافية، التي تمنحهما التجانس والانفهامية "intelligibilità"، حيث لا يمكن أن نستحضر واحدا منهما دون الآخر، على الرغم من دلالات وخصائص كل واحد المتعددة والمتمايزة، إذا كنا لا نريد المخاطرة بالمعنى ووجود وحضور الفرد في التاريخ[6]. "ليس كما في المجتمعات المعاصرة، حيث أصبحت العلاقة بين المجال والزمان واضحة جدا: فثقافة الحاضر التي تعبر عما بعد-الحداثة تؤدي إلى إضفاء المجالية spazializzazione على الزمن. ومرئي كذلك في اللغة، حيث يتم استعمال عبارات مجالية بشكل متزايد أكثر من المراجع الزمنية؛ كالنزعة المحلية Localismo، الكونية globalizzazione، الهجرة، الترحال nomadismo؛ كلها استعارات مجالية تحوي مفهمة جيدة للمجال الفزيقي وللمجال الاجتماعي[7]".
في الواقع، المجال هو مجال فيزيقي، حيث يعبر عن الفعل الإنساني كمجال اجتماعي من خلال علاقة مع مجموعة من القيم، التي تُعرف وتوجه إحداثيات الأفراد في إطار علاقات فيما بعضهم البعض من خلال السياق الاجتماعي[8]. ومن جهته الزمان هو ميثاق، مبدأ لتنظيم النشاط الجماعي ومعيار مقيد لمشاركة الفرد في المجتمع. لذلك ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار "الزمان كفئة منطقية وربما سوسيولوجية لا يمكن اعتباره كالمجال، على الرغم من كونهما يشكلان عنصرين مرجعيين، مؤسِسين وعامين للتجربة الإنسانية؛ فبالمقارنة مع المجال، الزمان من ناحية هو أكثر انتشارا، ومن ناحية أخرى هو أقل سهولة في تعريفه وقياسه وإدراكه من خلال الحواس[9]". فالزمان لا يحضر ككيان موحد في حد ذاته، لكن في التحليلات السوسيولوجية، تعددية في الأزمنة الفردية تحيل على كل من الفرد وعلى الأزمنة الاجتماعية، وتعكس بنينة strutturazione المجتمع. هذا الشرط هو الموضوع الذي كتب عنه كاستلز "كل زمن في الطبيعة هو كالمجتمع (...) هو زمن محلي، والمجال هو الزمن المشكل [10]cristallizzato"، يعني هذا أن المجال يعكس تنظيم المجتمع ونتائج تخطيط الزمن وليس العكس. وفي هذا الصدد، يؤكد أنتوني جيدنز "الفصل بين المجال والزمان شرط لمسافة مجال-زمنية غير منتهية، مقولة (فرضية) لتقطيع دقيق في النطاقات الزمنية والمجالية[11]". المجال والزمان إذن؛ يقدمان نفسيهما كوجهين لعملة واحدة، ضمن سيرورة دياليكتيكية، تأخذ بعدا أنطولوجيا في المسوح التقليدية للأحداث[12].
المجال، المجالات
من وجهة نظر سوسيولوجية المجال "لا يحوي شيئا ثابتا وموضوعيا، مثل الفيزيقي أو الجغرافي الذي هو: حاوية بسيطة للظواهر، قاعدة أو حامل محايد بالنسبة إلى الأفعال. ففي هذه الحالة كان سيفقد التأثيرات المتبادلة المحتملة بين المجال والمجموعات الإنسانية. ومن الناحية التخطيطية Schematizzando يمكننا القول إن المجال يتخذ شكلا ملموسا عند الفاعل الاجتماعي؛ لأنه يحدد النقط، المسافات، القوى الضرورية للتجوال فيه. فالمجال يمكن من معلمة مادية للأحداث التي تدور فيه. ومع ذلك يمكن أن يكون لها ترميز مجرد؛ بمعنى وظيفة الشكل أو الخطاطة اللذين من خلالهما يتم التقاط/ صيد الحقائق[13]".
بهذه العبارات لا يمكن تقييد وضبط المجال في تعريف واحد لا لبس فيه، فإقامة تصنيف صلب لسماته وخصائصه الغنية مطلب صعب؛ لأن هذه المتغيرات هي العناصر الأساسية التي تحدده[14]، وإذا ما أضفنا عناصرا خارجية مرتبطة بحقيقة تاريخية، فإننا سنجد أنفسنا أمام كيان أكثر تلونا caleidoscopica ومراوغة.
ولهذا السبب تحديدا، وجب تأويل المجال بالضرورة في المجتمع المعاصر على ضوء خصائص المرحلة الحالية: تزايد وسهولة الحركية[15]؛ فالانطباع الذي يحصل للمرء هو أن المجال أضحى فجأة وبطريقة سحرية أصغر أكثر، فنتائج ذلك أن الوجود أضحى بدوره يدور في سياقات مجالية مقيدة أكثر فأكثر. فإدراك المجال على المستوى المفاهيمي وما بعده عرف تحولا جذريا، فاليوم من الممكن الوصول إلى أمكنة جد معزولة في بضع ساعات، بفضل تطور وسائل النقل، بينما كان في القرن السادس عشر حسب المؤرخ برودل عرض البحر الأبيض المتوسط أسبوع وطوله شهر[16]. ومن جهته سلط الضوء على هذا تومسون Thompson حين يؤكد أن "التحول في المسافة هو القاعدة الصحيحة لتعريف "تكثيف الزمان-المجال"، حيث زمن النقل تقلص بشكل كبير، علاوة على تطور وسائل التواصل التي جعلت من مدد الإرسال تساوي عمليا الصفر. فالعالم يبدو صغيرا: لم تعد الجهات/ الترابات (جمع تراب) مجهولة، بل أضحى عالما مُستكشفا بالكامل ومرسوما بدقة على الخرائط الجغرافية وتحت تهديد التدخل الإنساني"[17].
المجال يتم تحييده/ إلغاؤه إذن؛ لأن الانكماش الزمني يعطي للمجال تقريبا بعدا غير محسوس، كما استفاض في هذا المعطى زيجمونت باومن في نصه حول المواطن/ الفرد الكوني "المجال هو رواسب(سدمات) الزمن الضرورية لإلغائه، حينما تصبح سرعة حركة رؤوس الأموال والمعلومة تساوي سرعة انتشار الإشارة الإلكترونية؛ فإلغاء المسافة عمليا يكون لحظيا، ويفقد المجال ماديته، قدرته على إبطاء، فرملة أو مقاومة الحركة. فهذه هي الميزات التي يتم اعتبارها خصائص للحقيقة؛ لأن هذه السيرورة تُفقد المحلية località القيمة[18].
هذه السيرورة المرتابة parossistico تذوب/ تُفقد المادية دلالاتها تدريجيا لصالح البعد الافتراضي؛ فالكل يفقد جوهره لصالح السيولة التي تحيط بكل جوانب حياة الأفراد والجماعات[19]. فالمظهر الأول لهذه الظاهرة الساحقة هو تفكيك disgregazione الأنظمة التقليدية المبنية من طرف الإنسان[20]، فلا يمكن اليوم إغفال تنقل الناس، الحركيات، السلع ورؤوس الأموال من نقطة إلى أخرى في العالم، بشكل لا يمكن تصوره في عقود أخرى، حيث بفضل التقدم التقني والقدرات الخيالية لبنية الاتصال، أصبحت شبكات العلاقات أكثر كثافة. فهي تتجاوز وتعيد في الآن ذاته التفاعلات التي كان ينظر إليها باعتبارها عفا عنها الزمن، كالمحليات مثلا بوصفها تمثلات لمجتمع أكثر تقليدانية.
يحدد هذا التجاوز تغيرات جوهرية؛ أولاها ما يعرفه أنتوني جيدنز في مؤلفة عواقب الحداثة[21]، من خلال عبارة التشظي disembedding؛ أي تفكك الأنظمة الاجتماعية، كتعبير عن "فصل للعلاقات الاجتماعية عن السياقات المحلية للتفاعل، مع إعادة بنينة من خلال أقواس زمان-مجالية غير محددة/ غير معرفة[22]". لذلك، فعبارة التشظي في المجتمع الحديث تفسر كيفيات "استئصال tirati fuori" العلاقات الاجتماعية و"اقتلاعها sradicati" من السياقات الاجتماعية للتفاعل وربطها بأبعاد زمان-مجالية بعيدة[23]. فالمجتمع يتمدد في المجال وفي الزمان، حيث يفقد الناس بشكل مباشر قدراتهم على ضبط أفعالهم. ومن جهته حدد أنتوني جيدنز ميكانيزمين للتفكك: خلق الشعارات الرمزية "كوسيلة للتبادل التي يمكن أن تتنقل بين الأيادي دونما مراعاة للخصائص الخاصة للأفراد وللجماعات التي تستعملها في وضعية خاصة[24]"، ثم مأسسة معرفة-خبرة "أنظمة التنفيذ التقنية أو للكفاءة المهنية التي تنظم المجالات الواسعة في بيئات مادية واجتماعية[25].
يعرف المجتمع المعاصر ظهور عالم جديد كل يوم-عيد [26]un’epifania. إنه عالم يتم بناؤه وتفكيكه كل يوم، ويقدم نفسه من جديد في أشكال جديدة ومتغيرة، عالم متوازن من خلال ما هو كائن ومما نوده أن يكون، ومن ذلك المحتمل أن يكون في بعد خالد ومتجانس. إنها بالتأكيد مرحلة انتقالية، حيث لا شيء مؤكد وكل شيء محتمل. فمكان الهبوط ممكن بشكل مثالي، الإشارات ملاحظة ومدركة، ولكن لا شيء يبدو كما يبدو على السطح.
المجتمعات المحلية
يعيد ويعدل تكثيف الزمان-المجالي كتابة العلاقات الاجتماعية؛ بمعنى المجالات التي يتم فيها زرع هذه العلاقات. فإنه رغم ذلك سمك الأنسجة العلائقية للتجمعات-التقاربات يستمر في التواجد بشكل دائم في نقط خاصة من المجال[27]. بالنسبة إلى سوسيولوجيين هذه أعراض على استمرار المجتمعات المحلية وأهميتها. ومن خلال هذا المنظور، تم إجراء تحليلات سوسيولوجية جديرة بالاهتمام حول مجتمعات محلية، حيث سنوات العشرينيات من القرن الماضي أجرى روبرت ليند Robert S. Lynd بحثا حول إقليم صغير ينعت تقليديا ب ميدلتاون Middletown، وانتهت الدراسة إلى الكشف عن تواجد بعض الصور النمطية الملتصقة بالحياة الأمريكية في هذا الإقليم، لذلك فتسليط الضوء على اللامساواة الواضحة في شروط الحياة دحض فكرة أن الحركية الاجتماعية ارتفعت في المجتمع الأمريكي إبان تلك المرحلة[28].
وبعد مسافة العقد من الزمن، أعيد البحث في إقليم ميدلتاون من أجل تسليط الضوء على التغيرات العميقة التي طرأت في البنية الاجتماعية، التي نتجت بسبب عوامل خارجية أعادت تعديل وضعية القوة الجغرافية للمحلي[29]، كما استتبعت دراسة ليند دراسات أخرى.
بعد الحرب، قام الأنثربولوجي الأمريكي إدوارد، س، بانفيلد بتحليل جماعة صغيرة تسمى لوكانا Lucana تابعة لإقليم بوتينتزا Potenza، حيث خلص أنه حقيقة التقهقر-التخلف الواضحة تتمظهر من خلال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي يصفها الباحث تقليديا بـ "الجبل الأسود Montegrano" وساكنة الجبل الأسود[30]"Montegranesi". فحتى إذا ما كانت جماعة Lucana صغيرة الحجم، فإنه يُفترض نظريا وجود كثافة للعلاقات بين الساكنة، بانفيلد كشف عن عدم وجود حياة جمعوية vita associativa، معزيا أسباب هذه اللامعيارية anomalia إلى "العائلية اللاأخلاقية familismo amorale"؛ أي من خلال هذه الخاصية الثقافية الخاصة، ساكنة الجماعة الصغيرة يحاولون تعظيم المزايا الاقتصادية المادية واللامادية لخلاياهم العائلية فقط. الشئ الذي يلغي الحاجة المحتملة لاستثمار الطاقة والموارد في سلع جماعية. المونتغريون إذن يتفاعلون وفق هذه القاعدة العامة "تعظيم المزايا المادية والفورية لعلائلاتهم النووية، مفترضين أن الكل يتصرف بنفس الطريقة[31]".
عكس ذلك؛ أجرى سوسيولوجيين تحليلات سوسيولوجية حل المدن، كجورج زيمل في بداية القرن العشرين، راسما صورة- بروفايل الفرد في حياة المدن[32]، مفترضا أن إنسان الميتربول يتفاعل مع المحفزات من خلال العقل وليس القلب؛ فالعادة هذه تحفز عنده سيرورة عقلنة للتفاعلات الفردية، الشيء الذي يفتح طريق/إمكانية التكيف النفسي، وبأي طريقة سيكون الانفصال عن الآخرين. إنه الشرط الذي يجعل الحياة الاجتماعية ممكنة[33].
وكذلك في عشرينيات القرن الماضي، بتريم سوركين وكارل، ش، زيميرمان[34] أوضحا ست خصائص لتعريف المجتمع الحضري: انطلاقا من نوع البيئة إلى الحجم، من درجة تجانس الساكنة إلى أنماط المدن، من التعددية الاجتماعية إلى التنضديد stratificazione[35]. أما بالنسبة إلى السوسيولوجي المعاصر أرنالدو بايناسكو Arnaldo Bagnasco المدينة هي مجتمع محلي ويمكن اعتبارها وسيلة/ أداة لربط التفاعلات عن بعد[36]. وعكس ذلك بالنسبة إلى الأنثروبولوجي الأمريكي يولف هانرز Ulf Hannerz المدينة أو بالأحري المكان المحتمل للعثور فيه على شيء حين تبحث عن شيء آخر[37].
وبنظر ساسكي ساسن تؤكط في مؤلفها المدينة الكوننية وعكس الميتروبولات[38] "بعدما كانت مراكز عصبية-عقدية اقتصادية ولأنشطة بنكية دولية [...] تؤدي اليوم أربع وظائف جديدة: تلك الخاصة بـ "غرف الأزرار stanze dei bottoni" للاقتصاد العالمي؛ تلك المكاتب المميزة للمجتمعات المالية وللشركات الثالثية المتقدمة terziario avanzato[39]، والتي نزعت من الصناعة ريادتها في القطاع الاقتصادي؛ أمكنة الإنتاج (والابتكار) لنفس الشركات والاقتصادات؛ وأخيرا أسواق البيع والشراء لنفس المنتوجات والابتكارات (...) فتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية وعلى التمدين كان مذهلا. وفي يومنا هذا هناك مراقبة خيالية للموارد المتمركزة في المدن الكبرى، بالإضافة إلى المجتمعات المالية والشركات الثالثية المتقدمة التي ترتكز على تعديل التوجه الاجتماعي والاقتصادي. فنتيجة كل هذا هو ولادة نوع جديد من التمركزات الحضرية agglomerato urbano والتي تسمى بالمدن الكونية[40]".
واستحضارا لنص ساسكي ساسن حول المدن الكونية، يرى مانويل كاستلز في "المدينة الكونية أنها ليست مكانا/ لامكانا non è un luogo، ولكنها سيرورة، السيرورة التي من خلالها مراكز الإنتاج واستهلاك الخدمات المتقدمة والمجتمعات المحلية التابعة، تتمركز في شبكة عالمية تستند على تدفقات للمعلومات[41]". لذلك حدد كاستلز أنماط جديدة للمجال داخل المدينة التي تُعرف مجال التدفقات "الأمكنة التي تُفرغ من دلالاتها الثقافية، التاريخية والجغرافية ويُعاد إدماجها في شبكات وظيفية أو في ملصقات الصور، الشيء الذي يحفز مجال التدفق، الذي يعوض مجالات الأمكنة[42]". مجال التدفق يتشكل تحديدا من خلال ممارسات اجتماعية تهيمن على المجتمع الشبكي/ التشبيك la società in rete وتعبر عن السيرورات التي تهيمن على الحياة الاقتصادية، السياسية والرمزية "أقصد بالتدفقات تلك اللحظات/ اللقطات sequenze للتبادل وللتفاعلات المقصودة-الغائية finalizzate، المتكررة والمبرمجة بين المواقع الفيزيقية المفككة والمشغولة من طرف الفاعلين الاجتماعيين داخل البنيات الاقتصادية، السياسية والرمزية للمجتمع[43]".
داخل المدينة، يمكننا أن نرى كيف للأبعاد الزمنية والمجالية أن تتقاطع باستمرار، حيث بإدماجهم مع عوامل أخرى يعطون حياة متعددة النتائج، فلهم القدرة على ترسيم الحدود، تحديد وتعريف المجالات الفيزيقية والاجتماعية للعلاقات المتبادلة التي تتطور على مستويات متعددة، والتي تكتسب خصائصا خاصة حسب السياق[44]. إننا نشهد علاقات متبادلة متعددة المستويات، والتي هي أيضا انعكاس عن التوجه السياسي، لنفكر في حقيقة، باعتبارها مجتمعا محليا، أيضا كمكان خاص للنشاط السياسي للحكومة وكموضوع للنشاط السياسي وكشيء للنشاط الحكومي[45]. وعلى الرغم من ذلك، فحتى داخل هذه الأنسجة العلائقية الممأسسة والمعرفة أيضا، لا يبدو البعد المجالي سهل الفهم والتحديد، فداخل المجال الفيزيقي تتعايش مجالات أخرى عديدة، لذلك فهذا المجال الاستثنائي يكون نتيجة لتراكم العديد من المجالات المتعددة التي تتعايش سياقيا[46]. بين المجال الفيزيقي والمجالات الأخرى ذات الدلالات المتعددة، حيث في الفجوات المتبادلة يكتب تاريخ الفرد وتاريخ الجماعة في لحظات تاريخية متعددة[47]. فتفاعلات الأفراد داخل هذه الحاويات الاجتماعية contenitori sociali تختلف من حيث الكثافة والكيف/النوع.
البعد المجال-زماني في العلاقات الاجتماعية
يفترض البعد المجال-زماني في سيرورة للتفاعل وللإنتاج في المجتمع بالمعنى الواسع، أهمية بالغة في تكوين الفرد في إنسانيته، وبوصفه شخصا اجتماعيا. مع ما ينتج عن كل ذلك من نتائج "تتحقق العلاقات الاجتماعية في المجال والزمان، وتنظم من خلال البنيات المجالية-الزمانية للسياق، لكن العلاقة بين البعد المجالي للتجربة وإطارات الحقيقة حيث تتم، تتمثل كعلاقة مزدوجة المعنى، فالدينامية المعرفية conoscitive والعلائقية تكشفان الاتجاهات والإشارات المتغيرة حسب السياق، مع العلم أن الأزمنة والمجالات التي تنظم الاجتماعي تفصح عن إشارات مختلفة لاحتياجات جديدة للهوية، للتخطيط وللتجارب التي يمكن أن تتحقق[48]".
أدى التطور في تكنولوجيات المعلومات الجديدة (الهاتف، المكالمة-الفيديو، المراسلات...) وظهور الإنترنيت إلى إحداث ثورة في طريقة النظر على التوالي لكل من المجال والزمان[49]. ففي الحقيقة بفضلهم تم اختزال الأزمنة بفعل السرعة التي تتخلل كل سيرورة وبفضلهم تقلصت المسافات بشكل كبير[50]. إضافة إلى ذلك، تكنولوجيات المعلومات الجديدة تعمل على اقتلاع العلاقات الاجتماعية من سياقاتها، الشيء الذي يفقدها المراجع المجالية والزمانية ويطور بدل ذلك أقواسا زمانية-مجالية غير محددة. فمآل هذا الفصل الزمان-مجالي هو عولمة تدفقات المعلومات[51]. لذلك يضطر الأفراد أيضا للعيش في بعد كوني، من خلال إلغاء نقط المراجع التقليدية المعروفة جيدا، فالحدود الذهنية والوجودية تتمدد؛ لأن الحدود الفيزيقية والاجتماعية تلغى وتلغى إلى أن تختفي[52].
مرة أخرى أنتوني جيدنز يسلط الضوء على الكيفيات التي تؤثر بها التكنولوجيات المتقدمة التي تخدم التواصلات المتدفقة بطرائق دلالية على العلاقات الاجتماعية. حين يؤكد أنه "العلاقات الاجتماعية العالمية التي تربط بين محلياتها البعيدة مع بعضها البعض تحيل على حيوات تتشكل من خلال الأحداث التي تقع على بعد آلاف الكيلوميترات[53]". إذن ما الذي يمكننا فعله من أجل إعادة توجيه أنفسنا، من أجل استعادة تملك هوية قسمت إلى قطع صغيرة بتركيبات متعددة؟ داخل تشكل سيرورات من التقطيع وإعادة التركيب، التجزيئ وإعادة تخصيص التجربة. فإدراك الزمان-المجال ينطلق من تحليل السياقات المختلفة والمتطورة والمتحركة باستمرار، والتي تغذي المحتوى السوسيولوجي المهتم والمتجه نحو استيعاب تعددية أشكال المجال واحتياجات الزمن التي تعبر عن توازنات صعبة اليوم، لذلك نستعيد استعارة "النهر" التي قدمها جوياو Guyau[54] "الزمان والمجال لا يشكلان إحداثيات من أجل قراءة "قاع النهر ‘letto del fiume" وفقط، وإنما أيضا لما "يتدفقciò che scorre" داخله ويعدل مجراه، مع الوعي بما في هذا التدفق بالتحديد، مع إغنائه تدريجيا بعناصر جديدة. قدرة الانفعالات الاجتماعية effervescenze socialiالجديدة، شكل الاجتماعية socialità، التخطيط، الهويات الفردية والجماعية، دوافع إعادة التملك التي تقع أساسا داخل الأزمنة والمجالات البين-نسيجية interstiziali[55]".
في المجتمع العاصر إذن؛ المجال والزمان يأخذان دلالات جديدة تماما مقارنة مع التصور الأصيل والتقليدي[56]. فالتطور التكنولوجي والسهولة المذهلة في خلق روابط بين الأفراد في كل زوايا الكون، يؤدي إلى نزع مادية المجال، داخل تدفق زمني أضحى جوهريا ووشيكا أكثر وأكثر. فنحن نعيش ونتفاعل في حاضر متجانس وأحيانا منعزل، حيث المشاهد الزمنية تلغى كي تعود في أبعاد غير معتادة ضمن سيرورة معقدة ومبالغ فيها[57]. وعلى الرغم من ذلك، فالزمن له مركزيته في حياة الإنسان.
الزمان: أي تعريف؟
تستعمل مقولة الزمان في اللغة المشتركة واليومية بشكل كبير، للدرجة التي قد تُغيب معناها الأصلي، الحقيقي والعميق[58]، في القرن الرابع شكك القديس أجوستين المصطلحات غير الرسمية، حول إمكانية قياس الزمان من خلال وحدات للقياس محددة سلفا، وفي مؤلفه "الاعترافات" يسائل: "ما هو الزمن إذن؟ [...] الماضي والمستقبل: لكن هاتان الفئتان الزمنيتان بأي معنى توجدان، مادام الماضي لم يعد موجدا، والمستقبل لم يوجد بعد؟ والحاضر من جهته إذا بقي حاضرا ولم يتلاش في الماضي لن يكون زمنا. لكن الخلود إذا كان حاضرا، لا بد له أن يمر إلى ماض، فبأيّ معنى يمكننا أن نقول إنه موجود؟ [...] فلا الماضي ولا الحاضر يوجدان، ونقول بشكل غير صحيح هناك ثلاثة أزمنة، وحتى نكون أكثر دقة يمكننا القول هناك ثلاثية في هذا المعنى: حاضر لما هو مضى، وحاضر لما هو حاضر، وحاضر لم سيكون مستقبلا. نعم، هؤلاء الثلاثة بالطبع لهم معنى بالنسبة إلى الذات، ولكن لا يمكن أن نراهم حين يكونون في مكان آخر: حاضر الماضي هو الذاكرة، الحاضر هو الإدراك، المستقبل هو المتوقع. [...] من هنا يبدو لي الزمن ما هو إلا امتداد[59]". الزمن إذن، لا يمكن قياسه أو تكميمه إلا في ذوات أولئك الذين يدركونه، أولئك الذين "يعيشون في أرواحهم توقعا للمستقبل وذكرى للماضي[60]". الزمان شكل دائما لغزا للإنسان يصعب اختراقه وتفسيره بشكل دقيق[61]. وربما يفسر هذا التطلعات والجهود التي بذلها الإنسان عبر تاريخه، لقياسه وحصره في مشاهد تقليدية من أجل الهيمنة عليه. هذه المحاولات تظل مشروعا غير ناجح بالكامل وليس مكتملا بشكل مرضي تماما. إلياس في محاولته حول الزمن، محيلا عن القديس أجوستين، كتب: "قال شيخ حكيم إذا لم يسألوني ما هو الزمن فأنا أعرف، ولكن إذا سألوني فأنا لا أعرف"[62].
سر الزمان كان دائما فاتنا للإنسان، حيث أنتج العديد من الدارسين أفكارا جديرة بالاهتمام حول هذا المفهوم. عرف جاليلو الزمن، باعتباره وسيلة لتوجيه الذات في العالم الاجتماعي، لتنظيم التجمع بين الناس[63]. بالمقابل نيوتن يعتبر الزمن كطريقة وحداتية للنظر في الظواهر، تابعا لخصوصية الوعي الإنساني أو حسب نوعيات الحس والعقل الإنساني[64].
هذا الفكر وجد تعبيره بشكل أكثر سلطوية في فلسفة كانط، الذي في دراساته يعتبر الزمن والمجال كممثلان لتوليف/ لتركيب مسبق، فبالنسبة إلى كانط الزمن نوع من الشكل الفطري للتجربة، وبالتالي فهو واقعة ثابتة للطبيعة الإنسانية ويتناقض مع المنطق العام ومع المنطق المتعالي المسؤول عن دراسة الأشياء دون الرجوع إليها؛ لأنه يرجح إمكانية معرفتها[65]. كتب كانط في مؤلفه نقد العقل الخالص: "الزمان ليس سوى شكل من أشكال الحس الداخلي، لحدسنا نحن ولحالتنا الداخلية. في الواقع، الزمن لا يمكن أن يكون تحديدا ظواهر خارجية: فهو لا ينتمي لا إلى الشكل ولا إلى المكان وما إلى ذالك، ولكن بدل ذلك فهو يحدد علاقة التمثلات في حالتنا الداخلية. وبشكل أكثر دقة؛ لأن هذا الحدس الداخلي ليس له شكل، فإننا نبحث على تعويض هذا الخلل من خلال تشبيهات وتمثيلات لسلاسل زمنية، من خلال خط يمتد إلى ما لانهاية، حيث تعددية الشكل هي ذات بعد واحد. ومن خصائص هذا الخيط نجادل في كل خصائص الزمان، سوى هذه: كون أجزاء الخيط متزامنة، إذن فأجزاء الزمن هي دائما متتالية. ونتيجة هذا، أن تمثيل الزمن هو بحد ذاته حدس، إذ يمكن التعبير عن جميع علاقتة من خلال حدس خارجي"[66].
لا وجود للزمن إذن، سوى لحدس إنساني ضروري، الذي يستعمله الإنسان من أجل توجيه نفسه في العالم الخارجي كي يفهمه، لذلك الزمان ياخذ دلالة بسيكولوجية، ومن دونها يصير من الصعب حقا وربما مستحيلا إقامة صلات وعلاقات مع العالم الخارجي. وبهذا المعنى، تكون الأفكار المقدمة من طرف البسيكولوجيا والبيولوجيا مساهمة مهمة نظرية وعملية، وفي كلمة واحدة، الزمان بالنسبة إلى البسيكولوجيا يشكل الطريقة الفردية لعيش اللحظة، إذن فهو مكون مهم للشخصية. البسيكولوجيا في الواقع تركز على الإدراك الفردي لتجربته الزمنية. فالزمن النفسي هو "زمن الوعي عند الشخصية، التي تشعر أنها ناضجة أو غير ناضجة، صغيرة أو كبيرة، قادرة أو غير قادرة على التعامل مع التوترات والأحداث الحاسمة، مع المخاطر والتحديات[67]". وبالمقابل البيولوجيا، الزمان هو تعبير عن دورات وإيقاعات الفرد، فهو المدة المخصصة لكل كائن حي من خلال شفرته الجينية. فالزمن البيولوجي هو "زمن الإيقاعات الحيوية، الذي ينكشف خطيا على شكل "نمو crescita" وعلى شكل "شيخوخة invecchiamento": النمو الذي يمكن أن يكون قصيرا، والشيخوخة التي يمكن أن تكون بطيئة"[68].
كل التعاريف يمكنها أن تكون إلهاما لمقاربة منهجية لدراسة الزمان. فالزمان في الواقع، يمكن دراسته بدءا من تقسمه إلى لفئتين مختلفتين: الزمان الفيزيقي والاجتماعي[69]. الزمن الفيزيائي هو الذي يمكن قياسه بكثير من الدقة؛ لأنه يمكن تقطيعه إلى وحدات صغيرة عديدة. لكن بالمقابل بالنسبة إلى الزمن الاجتماعي "الزمان" له خاصية: المؤسسة الاجتماعية، منظم للأحداث الاجتماعية، لأنماط التجربة[70]؛ فالساعات هي عناصر مندمجة في النظام الاجتماعي الذي لا يمكن أن يشتغل بدونها[71].
هذا الفصل بين الزمن الفيزيائي والزمن الاجتماعي هو مرتبط بشكل وثيق بنمو العلوم الفيزيائية. ففي الواقع، بالقدر الذي اكتسبت به هذه العلوم التفوق، أضحى الزمن الفيزيائي هو زمن بشكل متزايد النموذج الأولي للزمان بشكل عام. ووفقا لنظام القيم، فإن الطبيعة موضوع الدراسة للعلوم الفيزيائية، فهي تشكل عند الإنسان جوهر النظام، أي بمعنى ما، فهي أكثر واقعية من عالهم الاجتماعي، حيث يبدو أقل تنظيما وأكثر عشوائية. ويتم تقييم الزمن الفيزيائي والزمن الاجتماعي بناء على ذلك، فالزمن الفيزيائي يُمثَل في كميات معزولة، ويمكن قياسها بدقة كبيرة وحيث الكميات يمكن دمجها في حسابات رياضية مثل نتائج لقياسات آخرين. ومن ناحية أخرى، لكن الزمن الاجتماعي على الرغم من أهميته المتزايدة باستمرار في الحياة الاجتماعية للإنسان، كموضوع نظري أو بشكل عام كموضوع للبحث العلمي، يبدو خاليا تقريبا من المعنى[72]. نحن أمام فئتين منقسمتين، متمايزتين ومتقابلتين لمفهوم يبدو أنه يمتلك سمات التفرد وذي طبيعة ستاتيكية، فحسب هذا التصور لا يمكن اعتبار وتعريف الزمان إلا من خلال سيرورة تمييزه.
حلل ربرت، ك، مرتون وبتريم سوروكين مفهوم الزمان من خلال التمييز بين الزمن الكمي والزمن الكيفي[73]. أو بشكل أدق مع بتريم سوركين الذي حدد لاحقا، بين الزمن الأسترونومي-الفلكي، وبين الزمن الاجتماعي أو السوسيو-ثقافي: "الزمن الاجتماعي عكس الزمن الفلكي، هو زمن كيفي وليس كميا صرفا"[74].
وبهذا المعنى، يمكن أيضا إقامة مسافة بين الزمن الذاتي والزمن الموضوعي. فالزمن الذاتي "يشكل المبدأ البنيوي للوعي الذاتي للفرد؛ أي حجر الزاوية لذاتيته. ففي الواقع، بنية الوعي للذات للفرد-الذات التي تتشكل من خلال تطابق هويته مع زمنيته، والتي يُعبر عنها في عقدة الماضي من خلال الذاكرة، للحاضر من خلال الانتباه، للمستقبل من خلال التوقع. [...] الزمن الموضوعي مناقض للزمن الذاتي، لأنه يبدو منسوبا للمجال، لأنه يشترك مع المجال في التعددية وفي السمات الخارجية. فالزمن والمجال الموضوعيان يشكلان إحداثيات لحقيقة إمبريقية، ويظهران تجانسها، وبالتالي كميتها وقياسيتها"[75].
يحيل الزمن الموضوعي والذاتي إلى تيارين فكريين متعارضيين؛ الأول يستند على فكرة الزمن واقعة-حقيقة موضوعية للخلق الطبيعي، في إشارة لتسلسل منتظم. وفي هذه الحالة الزمن لا يميز عن غيره من الأشياء الطبيعية إلا من خلاله كونه واقعة غير محسوسة. في هذا التيار نعثر دون شك على ممثله الأكثر شهرة الذي هو نيوتن[76]. أما التيار المعاكس، فيعتبر الزمن مكونا ذاتيا، يحفز التجارب والإدراكات، مشيرا إلى فكرة أن الزمن طريقة للنطر في الظواهر بشكل وحدوي، تبعا لخصوصية الوعي الإنساني أو حسب تعددية الحس وأنماط العقل الإنساني، ويتم وضعه إذن في جميع التجارب بشكل مسبق؛ بمعنى أنه الزمن شكل فطري للتجربة، وبالتالي فهو حقيقة ثابتة من حقائق الطبيعة الإنسانية. ومن أشهر ممثلي هذا التيار هم أجوستين، كانط وهايدجر[77].
ومع ذلك في النظريتين معا، يوصف الزمان باعتباره واقعة طبيعية؛ ففي الأول هو واقعة موضوعية توجد بشكل مستقل عن الإنسان. وفي الآخر يعتبر الزمان فكرة ذاتية مسجلة في الطبيعة الإنسانية. هذا التمييز ليس محايدا وليس ضارّا أيضا كما قد يبدو للوهلة الأولى. ففي الواقع "يكون البعدان محسوسين في تنوعهما، عندما يتمزق الاتصال بين المجتمع والثقافة. ولهذا السبب يبدوان اليوم وكأنهما يواجهان بعضهما ويمثلان مشاكل. لكن في الحقيقة، هما خارج الزمان fuori del tempo مثل العلاقة الرمزية، ولكن نمطية، بين الحلقة الفردية والحلقة الممأسسة، الشيء الذي أدى في الحداثة إلى تضخيم تناقضاتهم. فالزمن الذي تدرسه السوسيولوجيا اليوم يوجد في الماكرو وفي الميكرو: إنه منتوج اجتماعي وخلق فردي. إنه عامل منظم ومعيار للفعل، إنه بناء فردي من خلال سيرورات انتقائية مثل الذاكرة، التي تنتج الزمن الذاتي بامتياز، على الرغم من استحضار حيوات وتجارب جماعية"[78].
قياس الزمان
تعني دراسة الزمان فهم كيف يتحول الزمن الطبيعي والإيقاعات الأسترونومية والبيولوجية المحددة من طرف المجتمعات الإنسانية والمبنية اجتماعيا إلى قواعد وتوجهات، والتي تعكس أنماط الإنتاج، إلى قيم هيمنة في مختلف المجتمعات التاريخية، إلى احتياجات المجموعات المتعايشة. وفهم كيف من جهة أخرى احتياجات الأزمنة الاجتماعية أن تتطور بشكل مختلف، أن تعاش وتحل من طرف الفرد من خلال استخدام استراتيجيات جد مختلفة[79]. إذن ليست الحالة كذلك هنا، فتعريف الزمان وتمثيله بطريقة لا لبس فيها هي إشكالية صعبة حقا، أو حتى على الأقل قياسه، فالناس غالبا ما يخلطون "الزمن مع سرعات الحركات، مثلما في الحقيقة توجد حركات مختلفة وسرعات مختلفة من خلالها يمكن قياس الزمن، حيث نأتي لنقول إنه يمكننا القبض على الزمن من خلال قياس الحركات والسرعات المحتملة. لكن في الحقيقة الزمان موجود بشكل مستقل عن الحركات والسرعات، بشكل مستقل تماما عن الأشياء التي تنتج وتتنقل في الزمن، الزمان ليس حركة الأجسام التي تعيش في الزمن. فالناس يدركون الزمن من خلال الحركة، التتالي-الدورية، المسوح. لكن في الحقيقة لا علاقة للزمان بالحركة أو بالمسح الدوري أو بالتتالي. فبالنسبة إلى السرعة: كل هذه الأشياء لا تشكل سوى إشارات غير كاملة، نسبية وتقريبية نستخدمها لقياس الزمن تبعا لحاجاتنا.. الترددات والمسوح الإيقاعية ليسوا سوى مقياس ذاتي للزمان: فنقط المراجع هي جزئية وغير قابلة للتغيرinterscambiabili التي خلالها يمكن إجراء قياسات[80]".
وعلى الرغم من ذلك، الفيزيائيون يقولون أحيانا إنهم يقيسون الزمن بدقة، مستخدمين علاقات رياضية يشكل فيها قياس الزمن دورا مهما ووحدة ملموسة. لكن هذه المحاولات ليست سوى نتائج جزئية لتشيؤ لا يمكن السيطرة عليه أو تدجينه[81] addomesticare. الزمان ليس معادلة رياضية، حتى لأكثر هذه المعادلات تطورا مجتمعة مع أدوات قياس الأكثر جرأة المبنية من طرف الإنسان قادرة على إعطاء تمثلات دقيقة للبعد الزمني. فالزمان بحث مستمر في تأرجح بين الفيزيائي والميتافيزقي.
لا يمكن للإنسان أن يرى الزمن، أن يشعر به، أن يسمعه، أن يتذوقه ولا أن يلمسه. فهل يمكن هذا الأمر بالنسبة إلى مطلب قياس شيء لا يمكن إدراكه بالحواس؟ ساعة على سبيل المثال أو يوم. إنه غير مرئي. لكن هل الساعات لا تقيس الزمن بالقوة؟ تساعدنا الساعات بالتأكيد لقياس شيء ما. فالساعات هي مشاهد/ لقطات لأحداث اجتماعية معممة تبني نماذج من اللقطات/ المشاهد الموحدة والمتكررة مثل ساعات ودقائق، والتي هي لقطات عامة واجتماعية معروفة، والتي تمكننا من توجيه اللقطات الأخرى بين مختلف الأفعال الإنسانية، لقياسها، لتذكر الماضي، وللتخطيط أيضا للمستقبل[82]. لكن الساعات ليست هي الزمن، الساعات "لا تسجل، لا تشير إلى الزمن. إنها ليست سوى ميكانيزمات مبنية من طرف الإنسان لتساعده في أغراضه. كل الوسائل التي ابتكرها-تخيلها الإنسان من أجل قياس الزمن. من الشمس إلى الساعات الرمليةclessidre، من الساعات الشمسية إلى الشموع candele، من عقارب الساعات إلى ذبذبات الموجات الصغيرة للساعات الأتوماتيكية. كلها لها خاصية التقدم بسرعة ثابتة؛ أي التنقل بين مسافات متساوية بأزمنة متساوية[83]".
الساعة بوصفها لها خاصية "الحاوية الزمنية"، فهي مرسل معلومات إلى الناس الذين يطلبونها، بنفس طريقة الجرائد؛ فالجرائد هي الحامل الفيزيقي للمعلومات إلى القراء. فالرموز المخلوقة من طرف الإنسان، تتمظهر في دائرة -مقسمة quadrante إلى دقائق وساعات – في التواريخ المتغيرة للأجندات. إنها ليست بالزمن[84]. من خلال الساعات كل فرد من مجموعة إنسانية يرسل رسالة إلى آخر من أعضائها. في الواقع، الساعة كجهاز تم إعداده كي يعمل داخل المجموعة كمرسل للمعلومات؛ أي كوسيلة منظمة للسلوك. لذلك تشكل الساعات عند الإنسان وسيلة ليوجه نفسه في توالي اللقطات الاجتماعية والطبيعية، حيث هو منخرط فيها، فهي بمثابة أدوات من أجل تنظيم السلوك. فالذي تتواصل به الساعات من خلال رمزيتها –انقسامها إلى دقائق وساعات- هو ما نسميه تقليديا بالزمن[85]. فالساعة إذن تشغل وظيفة عملية، مثل الأدوات الأخرى التي استعملها الإنسان عبر تاريخه من أجل تلبية حاجاته. "الأيام، الساعات، الثواني وجميع التقسيمات الأخرى للحركة يتتابعون وفق خط موحد وأحادي الإتجاهunidirezionale. داخل هذا التنظيم، فكل يوم، كل ساعة وكل ثانية هي فريدة وغير قابلة للمعاودة-التكرارirripetibile. لكن مدة كل واحدة منهم هي دائما ثابتة[86]".
إن الزمن الذي يستطيع الإنسان قياسه وتحديده من خلال قواعد مشتركة، ليس هو سوى سيرورة ميكانيكية وذات بعد عملي صرف، والتي من دونها سيكون صعبا جدا بناء حياته وتجربته. حيث يتفاعل دائما وفق هذا النموذج، في ظل انعدام وجود إمكانيات أخرى، لذلك فعل هذا وبأدوات متعددة. فعلى سبيل المثال لجأ الإنسان إلى أدوات لقياس الزمن في لقطات عامة، كأي سلسلة من الطبيعة، كالمدflusso والجزرriflusso في البحار، كالنبض المتكرر أو كشروق وغروب الشمس مثلما هو الأمر بالنسبة للقمر.
في المجتمع المعاصر، لا يمكن قياس مدة قسمةsegmento من الحياة إلا بشكل غير مباشر إلا إذا ما تمت مقارنتها بمدة قسمة أخرى. ومن أجل هذا، لا بد من إطار مرجعي مبني من خلال لقطات الأحداث ليمنح الأجزاء المتكررة مددا موحدة اجتماعيا[87]. إنها الوظيفة التي تشغلها الأجندةcalendario، والتي يجب أن تضمن النظام والانتظام كي تعطي الانضباط والمعنى للعلاقات البين-إنسانية[88]. "إن المؤسسة الأولى التي اخترعها الإنسان من أجل الاستقرار والحفاظ على النظام الزمني هي الأجندة، فالأجندة هي المسؤولة مبدئيا على خلق كل النماذج الزمنية التي من خلالها تقريبا جميع المجتمعات، المؤسسات الثقافية والجماعات الاجتماعية تكون قادرة على إدخال بعض النظام في حياتهم [...] الأجندة مسؤولة عن الاستقرار والانتظام الزمني وفق تقويم سنوي، شهري وحتى الأسبوعي. ولكن لا يمكنها ذلك، أي أن تعزز الانتظام الزمني على مستوى الوحدة الماكروسكوبية نسبيا، فهي خاصية حياة الحداثة، ولن تكون ممكنة من خلال ابتكار مؤسسة أخرى: كالساعة"[89].
الأجندة والساعة هما اختراعان مذهلان للحياة الإنسانية؛ فقد وفرا الأدوات الضرورية من أجل إعطاء نسقية sistematicità للفعل الإنساني ومعنى لوجوده. فإن لم تكن الإيقاعات الحياتية متوافقة- متطابقة مع اللقطات الزمنية والمعروفة على ذلك النحو، لما كان للإنسان وعي بذاته وبالواقع الذي بناه بنفسه ويستعمله. مع العلم أن المعرفة بالزمن التي توفرها الأجندات والساعات تعتبر عند الإنسان بداهةscontato، والتي نادرا ما يفكر فيها حيث فسبب هذا يتفاعل بالتعجب، في حالة لم يعط الآخرين عناصر للقياس الزمني المحددة والمقبولة تقليديا والمعترف بها بوصفها مكسبا.
في المجتمعات الأكثر تطورا، يبدو بديهيا أن يعرف الرجل عمره، مع العلم أن المجتمعات الأكثر بساطة هناك ناس لا يمكنهم إعطاء إجابة دقيقة حول سؤال عمرهم. هذا يبدو شيئا تافها وسخيفا بالنسبة إلى الذين يعتبرون أنه أمر عادي وطبيعي استعمال مسوح زمنية معترف بها ثقافيا كما هي. ومع ذلك، فإن لم تكن أجندة لريبرتوار المعارف الاجتماعية لمجموعة ما، فسيكون من الصعب على أي شخص حساب عدد سنوات حياته[90]. كتب إلياس في "محاولة حول الزمن" أنه "في هذه المجتمعات، معرفة الزمن الأجندي والساعاتي هي كأداة لتنظيم العلاقات البين-إنسانية وكأداة تمكن الفرد من توجيه ومعرفة عمره، وتصبح عند الناس الذين هم أعضاء في تلك المجتمعات بداهات، والتي يتم التفكير فيها ناذرا، فإنهم لا يتساءلون عن سبب التعايش الذي كان قائما بين الناس الذين ينتمون لمراحل تطور أكثر بدائية-أولية دون الحاجة لساعات أو لأجندات[91]".
إن حركة الشمس من نقطة إلى أخرى في الأفق، حركة عقارب الساعات من نقطة إلى أخرى في القرص المُمَعلم. كلها أمثلة على نمط تكرار اللقطات، والتي يمكن أن تكون وحدات مرجعية وأداة لمقارنة قطع الأحداث مع لقطات أخرى، والتي تتكرر تواليا، والتي لا تكون مترابطة بشكل مباشر[92]. في الواقع، وعلاقة "بالعلاقة"، يجب أن يأخذ هذا المفهوم الاهتمام؛ لأنه من خلاله الميكانيزم العلائقي بين القطع الزمنية الموحدة يسطيع الإنسان أن يشغل موقعه داخل مدار التدفق، أن يحمي ويحافظ على ذاكرته وينقلها. كتب إلياس "عبارة الزمان تشير إذن إلى "علاقات" للمواقع والقطع في لحظتين أو أكثر للأحداث المتحركة باستمرار والقابلة للإدراك. هذه العلاقة هي نتيجة لمعالجة تصوراتية قام بها الإنسان العارف، ويعبر عنها في رمز تواصلي comunicabile، مفهوم "الزمن" داخل مجتمع يمكن من النقل، من إنسان إلى آخر ومن خلال نماذج صوتيةfonetico مدركة، فهو صورة قد تكون معاشة. ولكن لا يمكن إدراكها من طرف حواس الذاكرة[93]".
مفهوم "الزمن" الذي أنتجته تحليلات، لا تزال مستمرة في إنتاج تأملات ونظريات، تجسد نتائج لإشكالات ليست بالوحيدة. فأحيانا لا نلمح حتى حلول معقولة ومتقاربة بشكل عام. إنه سؤال صعب حله؛ لأنه على سبيل المثال يرتبط بحقيقة أن الزمن شيء للتأمل ويعتبر كذلك موضوعا في الآن ذاته. بهذا التصور، يحضر الزمان في أشكال إدراك متعددة ومتناقضة، أحيانا واضحة ودقيقة. وأحيانا غامضة ومنقسمة. ولكنها متداخلة لدرجة أنه ما يقارب الثلاثين قرنا من البحث الفلسفي وأربعة قرون من البحث العلمي فشلوا في حله.
من دون شك، يمكن التعبير عن الزمن من خلال دالة متصلة قابلة للقياس وأحادية البعد. لكن في الآن ذاته هي مركبة من نتائج امتداد الماضي وامتداد المستقبل في نقطة حدودية، والتي في حد ذاتها خالية من الامتداد، فمن هنا تظهر الطبيعة المزدوجة للزمن: فهو تارة حاضر أزلي، وتارة حاضر يحدد فقط من خلال لقطات الماضي ولقطات المستقبل. ووفق هذا النموذج الزمن يتمظهر من خلال تعددية الأبعاد التي تحويه حسب اللحظات التاريخية والصراعات. فيكفي أن نفكر في المرحلة المعاصرة ذات خاصيتي التسارع واختزال اللقطات الزمنية، حيث يتم التضحية بـ "القبل" وبـ "البعد" فوق مذبح altare[94] الحاضر المهيمن والخالد. في الواقع، "في شروطنا المعاصرة، عدم القدرة على تقديم مشروع للتفكير في المستقبل (في الحدود القصوية للفكر)، فاللاقدرة تصبح زمنا، لا قدرة للعيش (في) زمن أصيل، الشيء الذي يشكل هوسا، مركزية اجتماعية للحظية وللفورية. فالكل ينبغي أن يكون الآن وفورا، فالحاضر يخيم على العالم الاجتماعي"[95].
إنه الحاضر دون أبعاد وفي الآن ذاته مفارق- متناقض؛ فالزمن الذي نعتبره موضوعا (لا يمكن أن يكون إلا في الحاضر)[96]. ومن أجل جعل هذا الكيان قابلا للفهم وللتحكم فيه، لم يكن للإنسان سوى اللجوء إلى التعاريف الجزئية، فالزمن إذن مُؤنسن في إطارات سمات القيم وفي عناصر وخصائص وظيفية. فقد عُرف الزمن في الحقول الفلسفية والعلمية على أنه: الزمن الابتكاري، ستاتيكي، دينامي، عميق، عابر، ممتد، تراجيدي، حقيقي، متخيل، ذاتي، كوني إلخ. هذا الاندفاع نحو إلصاق الصفات يفضح عجز الإنسان على السيطرة على مادة قوس-قزحية اللون ومتعددة الأوجه[97]. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن تجاهل الزمن رغم تجلياته المتناقضة "فمع تسارعات وارتباكات التغيرات الاجتماعية للحداثة المتأخرة، الزمن يصبح حقيقة مركبة ومتناقضة، مصدرا للتوقعات وللكبح mortificazioni، ومنه يكون الميل إلى تحليله –وفق مؤشرات السوسيولوجيا الإيجابية- من خلال صيغ ثنائية، إلا أنها تدور حول فكرة الندرة والحدود: أولا الزمن الموضوعي (مفروض من طرف إيقاعات اجتماعية) والزمن الذاتي (مكبحٌ بسبب استحالة القيام بخيارات قيمية)؛ ثانيا الزمن الكمي (خطي وغير مرن) والزمن الكيفي-النوعي (يستند على الانتقاء والخيار)؛ وثالثا الزمن الصديق (حامل للفعل وللإنتاج) والزمن العدو (مبني على إعادة انتاج وتفكيك بنيات التجارب الجديدة)[98]".
لاحظ إميل دوركايم أن الفرد الوحيد والمعزول قد لا يتنبه لمرور الوقت، وقد يجد نفسه أيضا غير قادر على قياس مدته، لكن الزمن يصبح بمثابة مركب لا يمكن تجاوزه في حياة داخل مجتمع، الشيء الذي يعني أنه جميع الناس متفقون حول الأزمنة والمدد ويعرفون جيدا الاتفاقات-المواثيق التي يخضعون لها[99].
الزمن إذن تركيب رمزي عالي المستويات، التركيب الذي يمكن من خلاله ربط مواقع لذلك سيصبح فزيقيا طبيعيا ولذلك سيصبح اجتماعيا ولمسارات الحياة الفردية، التي تمتزج وتربط باستمرار. "في الاستعمال الحالي، فهو مفهوم عالي التركيب والتعميم، ذو طبيعة قادرة على اقتراح عبارة أساسية على قدر كبير من المعرفة الاجتماعية فيما يتعلق بمناهج قياس اللقطات الزمنية وقياس انتظامها[100]". ويترتب على ذلك أن الناس لا يمكنهم تجاوز الإحساس بأن الزمن يمر، لكنه ببساطة هو مجرد إحساس؛ لأن المرور من زمن إلى آخر ليس سوى تدفق طبيعي لحياتهم أو لتغير المجتمع أو لتدفق الطبيعة ذاتها، في بعد مجالي ذي هندسة متغيرة، نحو إلهام بحث واعيا بذاته وواعيا بما سيصبح.
خلاصة
المجال والزمان هما بعدان أنطولوجيان، ينشبكان وينفصلان باستمرار، ومن خلالهما يقيس الإنسان نفسه باستمرار، مدفوعا برغبته لإعطاء معنى للعالم حوله قبل نفسه.
الكيانان معا، بمعانيهم الكثيرة ونماذج التصورات التي افترضناها، يمثلان شيئا واحدا -رحلة-. وبالتالي تحديا للإنسان الحبيس لعدة تعاريف ونماذج، المتحررة كل مرة من أي سمة إنسانية كي تجدها نفسها على الفور موضوعية لفتوحات وأسئلة جديدة.
إن إدراك وتمثل المجال والزمان ليس أكثر من مجرد أوتاد piètre وضعها الإنسان في طريق بحثه عن ذاته وعن هويته، مع العلم بعدم وجود شيء مؤكد ومطلق على الإطلاق، ولكن فكل مرحلة هي مليئة بالشكوك وبالحقائق الجزئية، في بعد متزايد السيولة وبعيد المنال، واحتمال قوي أنه حقيقة ذهنية "اليوم يمكننا القول لسنا ما نحن عليه، ولسنا نحن ما نريده".[101]
[1] - Dimensioni sociologiche Dello Spazio E Del Tempo In: RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE CON PEER REWIEV, novembre 2015 anno X n° 20, DOI: 10.7413/18281567073, pp. 91-114
[2]- مختبر المجتمع المغربي: الديناميات والقيم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة/ المغرب. وقسم السوسيولوجيا والفلسفة بجامعة بادوفا/ إيطاليا.
[3] I. Vaccarini, Il dibattito teorico sulla globalizzazione, in Globalizzazione e contesti locali: una ricerca sulla realtà italiana, a cura di V. Cesareo, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 46-59
[4] E. Galavotti, Spazio e tempo nei filosofi e nella vita quotidiana, Lulu, 2013, pp. 56-58
[5] A tal proposito, si veda G. Mandich, Spazio e tempo: prospettive sociologiche, FrancoAngeli, Milano, 1996
[6] Z. Bauman, In Search of Politics, Polity Press, Cambridge, 1999, trad. it., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 146 e 147
[7] C. Marchetti, Lo spazio della società, in Tempo, spazio e società. La ridefinizione dell’esperienza collettiva, a cura di D. Pacelli e C. Marchetti, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 141
[8] G. Scidà, Glocalizzazione e spazio dell’uomo, in Ragionare la globalizzazione, a cura di G. Scidà, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 217-229
[9] V. Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche, Vita e Pensiero, Milano, 1998, p. 203
[10] M. Castells, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, Milano, 2002, p. 471
[11] A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 59
[12] A tal proposito, si veda S. Cavell, Conditions handsome and unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, University of Chicago Press, Chicago, 1990, trad. it., Condizioni ammirevoli e avvilenti: la costituzione del perfezionismo emersoniano, Armando editore, Roma, 2014
[13] Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche, cit., p. 211
[14] P. Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 18
[15] J. Urry, Mobility and proximity, in «Sociology», 36 (2), 2002, pp. 255-274
[16] A tal proposito, si veda F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, Bompiani, Milano, 2012
[17] J. B. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 56 e 57
[18] Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 124
[19] A tal proposito, si veda Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006
[20] P. Fantozzi (a cura di), Politica, istituzioni e sviluppo: un approccio sociologico, Rubettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 173-176
[21] A. Giddens è stato ideatore della “terza via” per Tony Blair, oltre al testo the consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1990, trad. it. Le conseguenze della modernità cit., ha scritto anche altri importanti testi, tra cui La costituzione della società, Edizioni Comunità, Milano, 1990 e L’Europa nell’età globale, Laterza, Bari, 2008
[22] Giddens, Le conseguenze della modernità cit., p. 32
[23] P. Perulli, La città. La società europea nello spazio globale, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 38
[24] Giddens, Le conseguenze della modernità cit., p. 32
[25] Ivi, p. 37
[26] un’epifania: هو يوم عيد كاثوليكي يعتقد في ظهور الطفل يسوع للحكمائ اللذين قدموا ليعبدوه، ويتم الاحتفال به في الثقافة الكاثوليكية بتحضير وتناول كعكة الملك.
[27] Bauman, La solitudine del cittadino globale cit., pp. 123-127
[28] R. S. Lynd, H. M. Lynd, Middletown: A study in Modern American Culture, Harcourt Brace e Worlds, New York, 1929
[29] Id., Middletown in transition: A study in Cultural Conflits, Harcourt Brace e Worlds, New York, 1937
[30] E.C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, 1958, trad. it. Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 40
[31] Ivi, p. 101 ; si veda anche Id., Una comunità del mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 1961
[32] G. Catalano, Spazio e tempo in Simmel. Da Sociologia a la metropoli e la vita dello spirito, in Simmel e la cultura moderna. Volume 1, a cura di V. Cotesta e M. Bontempi e M. Nocenzi, Morlacchi editore, Roma, 2010, pp. 195-214
[33] A tal proposito, si veda G. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, Petermann, Dresden, 1903, trad. it., La metropoli e la vita dello spirito, Armando editore, Roma, 1996
[34] P. Sorokin, C.C. Zimmerman, Principles of Rural Urban Sociology, Hanry Holt & Co., New York, 1929, pp. 560- 574
[35] P. Guidicini, Nuovo manuale per le ricerche sociali sul territorio, FrancoAngeli, Milano, 1998, pp. 128-132.
[36] A. Bagnasco, La ricerca urbana fra antropologia e sociologia, in Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, a cura di U. Hannerz, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 9-68 ; si veda anche Id., Tracce di Comunità, Il Mulino, Bologna, 1999
[37] U. Hannerz, Esplorare la città: antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna, 2001, p. VII
[38] A tal proposito, si veda G. Osti, Sociologia del territorio, Il Mulino, Bologna, 2010
[39] وهي نمط من الشركات التي تحيل على الثورة الصناعية الثالثة أو ما بعد المجتمع الصناعي، وترتكز هذه الشركات على اقتصاد الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات وعلى اقتصاد الإعلام الجديد والخدمات الاستشارية ومعالجة المعلومات إلى قطاع التعليم العالي المتقدم.
للمزيد انظر:
Momigliano F. e Siniscalco (1980), Terziario totale e terziario per il sistema produttivo, in aa.vv., Il terziario nella società industriale, Milano, F. Angeli.
[40] S. Sassen, Città globali, Utet, Torino, 1997, p. 4
[41] Castells, La nascita della società in rete cit., p. 445
[42] Ivi, p. 434
[43] Ivi, p. 473
[44] Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche cit., pp. 214-217
[45] A tal proposito, si veda G. Borelli, La città: bisogni, desideri, diritti. La governance urbana, FrancoAngeli, Milano, 2009
[46] G. Mascheroni, Le comunità viaggianti. Socialità reticolare e mobile dei viaggiatori indipendenti, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 25-27
[47] C. Marchetti, Spazio, in Il linguaggio della società. Piccolo lessico di sociologia della contemporaneità, a cura di P. Malizia, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 173
[48] D. Pacelli, L’esperienza del sociale. L’emergenza persona fra relazioni comunicative e condizionamenti strutturali, Edizioni Studium, Roma, 2007, p. 124
[49] P. Giovannini, Teorie sociologiche alla prova, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 63
[50] S. Mugano, Gli abitanti di aree degradate perdono la fluidità e le interconnessioni spaziali e sociali?, in La città: bisogni, desideri, diritti. Dimensioni spazio temporali dell’esclusione urbana, a cura di M. Bergamaschi e M. Colleoni e F. Martinelli, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 75-86
[51] G. Gili, La comunicazione globale tra new media e old media, in Ragionare la globalizzazione cit., pp. 133-135
[52] G. Mulè, Confini e globalizzazione, in Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla realtà italiana cit., pp. 175-178
[53] Giddens, Le conseguenze della modernità cit., p. 7
[54] A tal proposito, si veda J. M. Guyau, La genesi dell’idea di tempo, a cura di D. Pacelli, Bulzoni, Roma, 1994
[55] Pacelli, Marchetti, Tempo, spazio e società cit., p. 18
[56] G. Catalano, Reti di luoghi, reti di città, Rubettino editore, Soveria Manelli, 2005, pp. 46-48
[57] U. Pagano, L’uomo senza tempo. Riflessioni sociologiche sulla temporalità nell’epoca dell’accelerazione, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 52-54
[58] Cesareo, Sociologia: concetti e tematiche cit., pp. 203-210
[59] S. Agostino, Confessionum libri XIII, in Le confessioni, Agostino, Rizzoli, Milano, 1974, p. 14-26
[60] Ivi, p. 28
[61] C. Hammond, Il mistero della percezione del tempo, Einaudi, Torino, 2013
[62] N. Elias, Saggio sul tempo, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 7
[63] L. Lunetti, Riconoscimento delle virtù eroiche al servo di Dio Galileo Galilei, in Scienza, coscienza e storia nel caso Galileo, a cura di S. Sperafico, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 118-126
[64] W. Lewin, W. Goldstein, For the Love of Physics. From the End of the Rainbow to the Edge of Time. A Journey Through the Wonders of Physics, Free Press, New York, 2011; trad. it, Fisica. Dall’arcobaleno ai confini del tempo, Dedalo, Bari, 2013, p. 72
[65] J. Hersch, L’étonnement philosophique: une histoire de la philosophie, Gallimard, Paris, 1993 ; trad. it. Storia della filosofia come stupore, Mondadori, Milano, 2002, pp. 148-167
[66] I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Reclam Philipp Jun, 1781¸trad. it., Critica della ragion pura, UTET, Novara, 2013, Estetica Trascendentale, Sez. II, p. 63
[67] P. Donati, Tempo sociale, famiglia e transizioni, in Tempo e transizioni familiari, a cura di E. Scabini e P. Donati, Vita e Pensiero, Milano, 1994, p. 68
[68] Ibidem
[69] Pagano, L’uomo senza tempo cit., p. 23
[70] Cesareo, Sociologia, concetti e tematiche cit., p. 83
[71] G. Gasparini, Tempi e ritmi nella società del Duemila, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 17-19
[72] Pacelli, Tempo e analisi sociologica, in Tempo, spazio e società cit., pp. 61-70
[73] P. Sorokin, R.K. Merton, Tempo sociale: un’analisi funzionale e metodologica, 1937, in Tempo e società, a cura di S. Tabboni, FrancoAngeli, Milano, 1990, pp. 35-46
[74] P. Sorokin, Il tempo socioculturale, in Tempo e società cit., p. 38
[75] I. Vaccarini, Il dibattito teorico della globalizzazione, in Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla realtà italiana cit., pp. 47 e 48
[76] I. Newton, Principi matematici della fisica naturale, (1687), Utet, Torino, 1989
[77] M. Heidegger, Sein und Zeit, M. Niemeyer, Tubingen,1963 ; trad.it., Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976
[78] Pacelli, Tempo e analisi sociologica, in Tempo, spazio e società cit., p. 30.
[79] A tal proposito, si veda C. Leccardi, Sociologie del tempo: soggetti e tempo della società dell’accelerazione, Laterza, Bari, 2009
[80] M. De Paoli, La relatività e la falsa cosmologia, Manni editori, San Cesario (Le), 2004, pp. 169 e 170
[81] A. Perulli, Il tempo da oggetto a risposta, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp. 27-31
[82] A. R. Calabrò (a cura di), I caratteri della modernità: parlano i classici. Marx, Engels, Durkheim, Simmel, Weber, Elias, Liguori editore, Napoli, 2004, p. 76
[83] G. Delle Donne, Il tempo, questo sconosciuto, Armando editore, Roma, 2006, p. 82
[84] Calabrò, I caratteri della modernità cit., pp. 75-78
[85] A tal proposito, si veda D. Calonico, R. Oldani, Il tempo è atomico. Breve storia della misura del tempo, Hoepli, Milano, 2013
[86] Delle Donne, Il tempo, questo sconosciuto cit., p. 82
[87] A tal proposito, si veda Gasparini, Tempi e ritmi nella società del Duemila cit.
[88] L. Coser, I maestri del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna,1997, pp. 176-177
[89] E. Zerubavel, Ritmi nascosti. Orari e calendari nella vita sociale, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 61
[90] G. Gasparini, La dimensione sociale del tempo, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 20-22
[91] Elias, Saggio sul tempo cit., pp. 12 e 13
[92] Delle Donne, Il tempo, questo sconosciuto cit., pp. 81-85
[93] Elias, Saggio sul tempo cit., p.17
[94] استعارة من المعجم اللاهوتي، والتي تحيل فيه على الطاولة الحجرية أو التلة التي يتم فوقها تقديم القرابين للآلهة.
[95]. Pagano, L’uomo senza tempo cit., p. 84
[96] C. Mongardini, La cultura del presente. Tempo e storia nella tarda modernità, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 27- 31
[97] V. Cotesta, Esiste un paradigma sociologico della globalizzazione?, in Ragionare la globalizzazione cit., pp. 45-68
[98] Pacelli, Tempo e analisi sociologica, in Tempo, spazio e società cit., pp. 35-36
[99] E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Edizioni di Comunità, Milano, 1963.
[100] Elias, Saggio sul tempo cit., p. 52
[101] E. Montale, Ossi di seppia, Mondadori, Milano, 2011