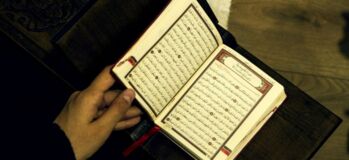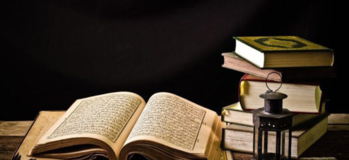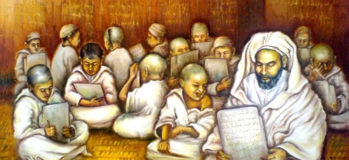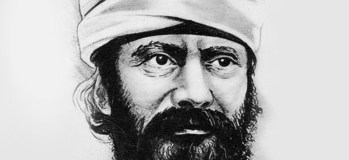الإسلام لا يعرقل الديمقراطية: الانتقال الديمقراطي السريع في إندونيسيا
فئة : قراءات في كتب

الإسلام لا يعرقل الديمقراطية: الانتقال الديمقراطي السريع في إندونيسيا
(قراءة في كتاب الديمقراطية والإسلام في إندونيسيا)
محمد الرضواني[1]
الديمقراطية والإسلام في إندونيسيا. الدين.. الثقافة.. الحياة العامة، مؤلف جماعي، تحقيق ميرجام كونكلر وألفرد ستيبان، صدر طبعته الإنجليزية عام 2013، وترجمته العربية عام 2016، من طرف محمد عثمان خليفة عيد، يقع في 357 صفحة.
يأتي الكتاب حسب المحررين من أجل سد فراغ قلة المراجع المتناولة للتحول الديمقراطي في البلدان الإسلامية، أو ذات الأكثرية الإسلامية، مثل إندونيسيا التي عرفت انتقالا ديمقراطيا سريعا منذ الإطاحة بنظام سوهارتو عام 1998، وأصبحت اليوم مدهشة للمراقبين على مستوى التحول الديمقراطي.
فخضوعها للاستعمار الهولندي لفترة طويلة، وانتشار الحركات الانفصالية فيها، وتنوع أنظمتها السياسية منذ استقلالها عام 1945، وشساعة إقليمها وانفصاله الذي يتشكل من حوالي 17000 جزيرة، وتنوعها اللغوي بـ 700 لغة حية، وتعدد أديانها بحوالي ست ديانات، وهيمنة الجيش على الحكم لمدة 33 سنة منذ عام 1965 حتى عام 1998، وتزايد العنف فيها، والتفاوت الاقتصادي في توزيع الثروة؛ إذ يعيش أزيد من نصف السكان تحت خط الفقر... لم يمنع إندونيسيا من تحقيق انتقال ديمقراطي مبهر، لدرجة صنفتها "فريدم هاوس" في مجال "الحقوق السياسية" منذ عام 2006 في نفس مرتبة الهند البلد الأشد رسوخا في الديمقراطية على مستوى الدول النامية؛ وعلى المستوى الاقتصادي التحقت بكل من الصين والهند والبرازيل بين عامي 2006- 2010 ضمن أسرع الاقتصادات نموا.
انطلاقا من هذه المعطيات، تعد إندونيسيا سياسيا واقتصاديا نموذجا عن الدول الصاعدة، جديرا بالملاحظة والدراسة.
يقدم الكتاب تحاليل عميقة متنوعة لعلماء السياسة والقانون، وعلماء الدين وعلماء أنثروبولوجيا، يبلغ عددهم 11 متخصصا، وهو ما يمنحه الكثير من الجدة والشمولية والمقاربات المتنوعة والمتكاملة.
كتاب معبر عن نموذج ناجح للانتقال الديمقراطي الحديث، أو ما يسمى بالانطلاقة الثانية في إطار الموجة الثالثة للديمقراطية، ولاسيما أن الانتقالات في هذه المرحلة كثيرا ما شهدت تراجعا ديمقراطيا، أو فشلا في الانتقال أو بطئا فيه، وزيادة عدد الدول المصنفة ضمن المنطقة الرمادية بين السلطوية والديمقراطية؛ نموذج واقعي، يمكن أن يسائل الكثير من الأطروحات النظرية حول الانتقال الديمقراطي. فكثيرا ما تقدم الاختلافات الإثنية والعرقية والدينية، والتباينات الفئوية، كأسباب مباشرة لفشل ترسيخ الديمقراطية في عدد من البلدان على رأسها البلدان العربية. وتحليل هذا النظام وخلاصاته تكشف لنا أن الواقع الإثني أو الديني المتعدد ليس عنصرا حتميا لتبرير العجز الديمقراطي. كما يكشف عن بعض الوصفات الناجعة على مستوى الإصلاحات، كاللامركزية المتقدمة، والتوافق بين القوى، ومحاربة الأفكار المتطرفة ... لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإنجاحه.
أولا- إندونيسيا: التحول السريع نحو الديمقراطية
أكد كل من ويليام ليدل (William Liddle)، وسيف المجني (Saiful Mujani) انطلاقا من تناولهما للتحول الديمقراطي في إندونيسيا اعتمادا على المنظور النظري للتحول الديمقراطي الذي قدمه كل من خوان خوسيه لينز (Juan Linz) وألفريد ستيبان (Alfred Stepan) .. أن التحول الديمقراطي بدأ في هذا البلد منذ عام 1998، تاريخ تنحي سوهارتو عن الحكم نتيجة الانهيار الاقتصادي الكبير وما تبعه من تظاهرات شعبية كبيرة في عموم البلاد. ووصل الانتقال الديمقراطي ذروته في عام 2004 مجسدا بذلك تحولا سريعا نحو الديمقراطية، حيث استطاع هذا البلد تحقيق المتطلبات الأربعة التي وضعها لينز وستيبان المميزة للمرحلة الأولى لعملية الدخول الديمقراطي المتمثلة في: اتفاق كاف لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة؛ ووجود حكومة منتخبة عن طريق انتخابات شعبية حرة؛ وتمتع الحكومة المنتخبة بالسلطة الكافية لتشريع السياسات؛ وعدم وجود سلطة غير السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال هذه المدة. مع التأكيد أن المتطلبات الثلاثة الأولى تحققت في السنة الأولى في إندونيسيا عام 1999، وتحقق المطلب الرابع القائم على إنهاء التدخل العسكري في الشؤون السياسية للبلاد بانتخاب البرلمان الرابع بعد ثاني انتخابات حرة عام 2004، حيث انتخب جميع أعضاء البرلمان عن طريق انتخابات ديمقراطية حرة، واضعا بذلك حدًّا لتواجد أعضاء من الجيش في البرلمان، وكذلك انتخاب رئيس الدولة ونائبه مباشرة من طرف الشعب للمرة الأولى في تاريخ إندونيسيا.
ودخلت إندونيسيا بعدها مرحلة ترسيخ الديمقراطية التي تتميز بثلاث خصائص حسب الإطار النظري المعتمد في التحليل. وقد خلص الباحثان بعد التركيز على جملة من المؤشرات من الحياة السياسية الإندونيسية إلى تحقق هذه الأبعاد الثلاثة المتمثلة في: "البعد التوافقي" تجاه الديمقراطية، حيث اقتناع المجموعات السياسية المؤثرة في إندونيسيا بعدم اللجوء إلى الانقلاب على النظام الديمقراطي المنتخب، سواء باللجوء إلى العنف أو طلب التدخل الأجنبي، إن تعلق الأمر بالأحزاب والحركات الإسلامية أو تعلق الأمر بالوطنيين المناوئين للديمقراطية، أو بالحركات الانشقاقية، حيث تراجعت النزعة الانفصالية؛ والبعد السلوكي المجسد في الموقف العام، حيث اقتناع أغلبية الرأي العام بأن أي تغيير يجب أن يتم في ظل المعايير الديمقراطية الثابتة، بالرغم من وجود أزمة اقتصادية وسياسية؛ فالأزمة لم تؤدّ في إندونيسيا إلى الاستثناء والخروج عن القواعد الديمقراطية، بل ثمة تأييد شعبي قوي ومتزايد للديمقراطية منذ 1999، بينته العديد من الاستطلاعات والبحوث الميدانية؛ والبعد الدستوري الذي تجسد من خلال وضع دستور جديد وسلسلة من الضوابط الأفقية والعمودية التي تلزم النظام الديمقراطي باحترام القانون والاستجابة لمطالب الشعب وليس فقط للأغلبية، إذ اقتنعت القوى الرسمية وغير الرسمية في إندونيسيا بضرورة حل النزاعات السياسية في إطار القانون والمؤسسات الديمقراطية.
ولكون الديمقراطية الراسخة نظاما متعدد الأبعاد، يشمل قيام القواعد الديمقراطية في جملة من الجبهات، فإن إندونيسيا استطاعت تعزيز ديمقراطيتها وامتدادها إلى مجالات تعد أساسية وجوهرية للحديث عن أي ترسيخ للديمقراطية، متمثلة أساسا في خمس جبهات: الأولى المجتمع المدني، حيث حرية تكوين الجمعيات وحرية الاتصال؛ الثانية المجتمع السياسي، حيث سيادة المنافسة الانتخابية الحرة الشاملة؛ والثالثة سيادة القانون والتمسك بالمبادئ الدستورية؛ والجبهة الرابعة، قيام أجهزة الدولة على المبادئ البيروقراطية القانونية العقلانية؛ والخامسة، قيام المجتمع الاقتصادي على السوق المؤسسية الحرة.
على الرغم من نجاح إندونيسيا في ترسيخ الديمقراطية، إلا أنها لا زالت تعرف العديد من التحديات الحقيقية أو المحتملة على مستوى الجبهات الخمسة.
ثانيا- تنامي التوافق الديمقراطي وأهميته في الانتقال
من خلال تتبع مختلف تطورات الخطاب الديني في إندونيسيا قبيل إعلان الاستقلال عام 1945 بعد استسلام اليابان، إلى محطة التعديلات الدستورية بعد سقوط سوهارتو، مرورا بمحطة منتصف الخمسينيات أثناء تأسيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الإندونيسي.. درس "ميرجام كونكلير" Mirjam Kunkler)) مختلف التطورات السلوكية والخطابية التي جعلت الديمقراطية التعددية خطابا مشتركا ومتوافقا عليه بين العلماء والحركات والأحزاب والفاعلين المسلمين، وبين العلمانيين في إندونيسيا، وتوصل إلى ثلاث خلاصات أساسية، هي:
- ساهم المفكرون المسلمون في نقاش حقيقي حول الوضع الصحيح للإسلام والشريعة الإسلامية في مجتمع متعدد الأديان مثل إندونيسيا.
- ارتباط المناقشات الدينية بتساؤلات ملموسة من الواقع، ولاسيما مع وجود تفاعل مكثف بين المجالس المحلية للمنظمات الإسلامية في إندونيسيا ومجالسها للشورى.
- تأثير الخلفية التعليمية للعلماء التي تزاوج بين التعليم الإسلامي التقليدي المحلي والفلسفة الأوروبية، مكنتهم من ربط واقعي بين اللاهوت والمشاكل اليومية.
وفي نفس الإطار، درس القس اليسوعي فرانز ماغنيس سوسينو (Franz Magnis-Suseno) الأستاذ الجامعي في الفلسفة، العلاقة بين الأغلبية السنية والأقليات المسيحية؛ وذلك بالتركيز على دور سياسات الدولة في تحقيق التسامح الديني في إندونيسيا من خلال تطبيق الدولة للتشريعات المناسبة، وتطبيق مواد الدستور التي تنص على الهوية غير الإسلامية للبلاد منذ عام 1945، والتي تأكدت في جل الدساتير الأخرى، حيث نص الدستور على خمسة مبادئ عرفت بـ "بنكاسيلا" التي اعتبرت بمثابة عقيدة وطنية لإندونيسيا، من بينها النص على الإيمان بإله واحد، وحرية الدين والعبادة.
وإذا كان هذا التسامح استمر لفترة طويلة، فإنه منذ التسعينيات عرفت البلاد استبعاد المسيحيين من المناصب العامة، والهجوم على الكنائس بشكل عنيف وواسع أدى إلى تدمير الآلاف منها، واندلاع حربين أهليتين بين عامي 1999 و2002 ، خلفت أزيد من 8000 قتيل.
غير أن دخول إندونيسيا مرحلة التحول الديمقراطي، أدى إلى تطورات إيجابية على مستوى العلاقات بين الأقليات المسيحية والأغلبية المسلمة، قوامها الإيمان بمفاهيم التعددية والتوافق الوطني، وتراجع توظيف الدين في الانتخابات، والتقارب بين المنظمات الكبيرة المسلمة والمسيحية.
لذلك يؤكد هذا القس أن التعصب الحقيقي هو القائم بين الأغلبية السنية التي تبلغ حوالي 85% من نسبة السكان والأقليات المذهبية المسلمة، كالطائفة الأحمدية، وأن ما يهدد التسامح في إندونيسيا ليس الحركات الدينية، وإنما تقاعس الدولة عن تطبيق القانون لمواجهة أعمال العنف، والتساهل تجاه الجماعات الإسلامية "المهرطقة".
وبالفعل يخلص سيدني جونز (Sidney Jones) بعد تناوله لتعامل حكومات إندونيسيا مع الحركات الإسلامية المتطرفة منذ عام 1998، إلى أن هذه الحركات امتلكت قدرة كبيرة على زعزعة التجربة الديمقراطية في السنتين الأوليين من الفترة الانتقالية؛ ولاسيما مع رهان بعض أفراد من الأجهزة الأمنية على استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية. لكن دون أن تشكل تهديدا معرقلا لترسيخ الديمقراطية، وأن التهديد الحقيقي للديمقراطية الإندونيسية ليس الإرهاب، وإنما التعصب الذي ينتشر من الأطراف الراديكالية الهامشية إلى الاتجاه السائد.
ثالثا- معضلة علاقة السلطة السياسية - المؤسسة العسكرية: نجاح
في تحدي حقيقي
انسحاب الجيش من الحياة السياسية وسيطرة الحكومة على المؤسسة العسكرية يعد من المؤشرات الحديثة لقيام الانتقال الديمقراطي وتعزيزه. وقد لعبت المؤسسة العسكرية دورا مهما سياسيا واقتصاديا في إندونيسيا، ولاسيما بين عامي 1966- 1998، حيث مثلت العمود الفقري لنظام سوهارتو، مشاركة في الحكم والمؤسسات السياسية، ومهيمنة ومستفيدة من امتيازات اقتصادية، ومالكة لإمكانية استخدام حق النقض والاعتراض على القرارات التي تمس مصالحها.
وعلى الرغم من سقوط نظام سوهارتو عام 1998 ، ظل الجيش حاضرا في البرلمان، ومستمرا في استفادته من حق النقض، وظل يوصف بالمؤسسة الأكثر تهديدا للتحول الديمقراطي في مرحلته الأولى.. أمور دفعت أحد أهم المنظرين الديمقراطيين ألا وهو لاري ديموند إلى تصنيف النظام الإندونيسي ضمن الأنظمة "الهجينة" أو "الملتبسة" في عام 2002.
غير أن التخوفات من هذه المؤسسة، لم يمنع من لعبها دورا مهما في الانتقال الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق دون موافقتها، حيث استخدمت حق النقض ضد استخدام السلطة من طرف سوهارتو ضد المتظاهرين، وهو ما اعتبر نوعا من التأييد الضمني لتغيير النظام، لكن عارضت بعد ذلك جملة من الإصلاحات التي تمس مصالحها.
وسيشكل عام 2002 منعطف تحول في العلاقات المدنية العسكرية الإندونيسية، حيث كانت بداية تراجع العسكر في الحياة السياسية، وتقليص دوره في استخدام حق النقض، وتوافق النخب المدنية على الإصلاحات الديمقراطية، وتطبيق سلسلة من التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2004، والتي أشرت بشكل واضح على تقليص الوزن السياسي للجيش وفقده لتمثيله في البرلمان، ولدور الوسيط في الصراعات التي تنشأ بين القوى المدنية.. مثل هذه التطورات دفعت لاري دايموند إلى مراجعة تصنيفه وترتيب إندونيسيا عام 2004 ضمن خانة "ديمقراطية منخفضة الجودة".[2]
لكن دون أن يعني ذلك بلوغ درجة متقدمة في سيطرة السلطة المدنية على العسكر، إذ إن إندونيسيا مازالت تعرف بعض المعوقات في هذا الصدد؛ من قبيل غياب مبادئ المساءلة القانونية لضباط الجيش، وعدم حل مشكلة تمويل الجيش خارج الميزانية، واستمرار دوره المؤثر في أقاليم معينة كمحافظة "بابوا"، واستمرار تمتعه بالامتيازات.
رابعا- التكامل الوطني: الفسيفساء المجتمعي غير معرقل للانتقال الديمقراطي
عرفت إندونيسيا بين عامي 1998- 2000 سلسلة من الأحداث كانت تنذر بخطر التفكك، مع تزايد انتشار العنف، وتعبئة الانفصال في عدد من المناطق، ولاسيما أنها عرفت استفتاء في عام 1999 تحت إشراف الأمم المتحدة، تمخض عنه استقلال تيمور الشرقية التي احتلتها إندونيسيا عام 1975، مما أدى إلى تصاعد دعاوى الانفصال في إقليمي "آتشيه" و"بابوا"، ودعاوى الاستقلال في عدد من المقاطعات.
غير أن ما يميز التجربة الإندونيسية هو استطاعتها تجنب آثار مثل هذه النزوعات، حيث تراجعت نزعة الانفصال لصالح تنامي التكامل الوطني، مكذبة تكهنات السياسيين والعلماء. ويرجع الكاتب إدوارد أسبينال (Edward Aspinall) التكامل الوطني واستمرار الدولة إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها: تنازلات قادة إندونيسيا الوطنيون في ما يخص تسيير الشؤون الداخلية إلى النخب المحلية والمعارضين المحليين المحتملين، والتي أخذت شكل الحكم الذاتي وتعزيزه في مرحلة الانتقال الديمقراطي، أو ما سمي بلامركزية "البيغ بانغ - الانفجار العظيم"، حيث نقلت الحكومة صلاحيات واسعة إلى الحكومات المحلية في الأقاليم؛ وثانيها: سياسة القوة المطبقة تجاه أولئك الذين كانوا يسعون إلى الخروج عن الدولة، حيث لجأت القوات الإندونيسية إلى تدابير قاسية جدا لقمع الانفصاليين، سواء العنفيون منهم أو اللاعنفيون في عدد من المناطق، مثل بابوا وآتشي؛ وثالثها: التكوين المؤسساتي لإندونيسيا في عهد سوهارتو القائم على تقسيم البلاد، بالرغم من تكونها من 17.000 جزيرة إلى أقاليم في دولة وحدوية عوض دولة فيدرالية، متميزة بإعطاء التفوق للبنى السياسية المركزية والهوية الوطنية على الهويات المناطقية، هذا التكوين المؤسساتي الذي طبق في عهد سوهارتو بلور نموذج الدولة الوحدوية الإندونيسية، واقتناع العديد من الجماعات به بشكل ضعف من التعبئة العرقية القومية. وساهم كل ذلك في تحقيق التقدم الديمقراطي واستمرار الدولة.
خامسا- دولة القانون وإصلاح القضاء: حكامة قريبة المنال
استطاع سوهارتو من خلال جملة من الإجراءات والقوانين إيجاد قضاء مدني، وقضاة مدنيين معينين من طرف الدولة يبتون في مختلف القضايا، وإيجاد محكمة عليا تمارس صلاحيات النقض على جميع المحاكم بما فيها المحاكم الإسلامية، استطاعت فرض تطبيق الخطوط العامة لفكر القانون المدني على الشريعة الإسلامية، "وصارت الشريعة الإسلامية تعامل بنفس طريقة القوانين الأخرى، واعتبر قضاة المحاكم الإسلامية عناصر في نظام قانوني وطني موحد. وأيا ما يمكن للمرء أن يقوله في أثر الشريعة في الحياة الخاصة لأي فرد، فإنها قد أضحت قانونا وضعيا في حياة العامة".[3]
لذلك، فإن صعود تنظيمات تهدف إلى إدراج الشريعة الإسلامية أو روح الشريعة في عدد من المناطق، ولاسيما في عهد الانتقال الديمقراطي، كفرض اللباس "الإسلامي" للذكور والإناث من موظفي الخدمة المدنية، وتلاوة آيات قرآنية قبل إتمام الزواج... يعبر بشكل كبير على وجود تنوع بشأن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في الأقاليم والمناطق والمدن، بشكل يصعب من الوصول إلى رأي ثابت بشأنها في الاستفتاءات العامة، وفي الانتخابات.
غير أن إندونيسيا عرفت في عهد سوهارتو فسادا كبيرا في قطاع القضاء، وعدم استقلاليته عن الحكومة، وغياب أية محاسبة للحكومة من طرف المؤسسات القضائية.. شكلت تحديات حقيقية أمام الانتقال الديمقراطي بعد سقوط النظام السابق، حيث تطلب الأمر ضرورة إصلاح هذا القطاع وتطبيق دولة القانون من خلال جملة من الإصلاحات، على رأسها دسترة الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والنص على حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، وتأسيس المحكمة الدستورية عام 2003، وإعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمحاكم عام 2004، أفرزت إعطاء المحكمة العليا السلطة المطلقة على الإدارة القضائية، وإجراءات فعلية لوضع حد لفساد القضاء، أو ما يعرف "بالمافيا القضائية" الموروثة عن النظام السابق.
هذه الإصلاحات القضائية ساهمت بالفعل في خلق ثقافة قضائية جديدة، وبناء أسس أساسية للاستقلال القضائي عن الحكومة؛ غير أن الإصلاحات في هذا الإطار بالرغم من أهميتها، تعد غير مكتملة، وتتطلب إصلاحات أخرى نظرا لاستمرار معوقات تعترض استكمال إصلاح النظام القضائي الإندونيسي، متمثلة أساسا في استمرار الفساد في معظم المحاكم يعيق التقدم نحو سيادة القانون؛ واللامركزية والفوضى القضائية. فإذا كانت اللامركزية أدت إلى تقريب الحكومة من الشعب، وإلى إيجابيات مهمة، فإنها أدت بالمقابل إلى فوضى على مستوى القضاء وضعف الحكامة في هذا المجال؛ إضافة إلى وجود قضاة خارجون عن القانون يدعمون الفساد المؤسسي في الأجهزة القضائية.
لذلك، فالمهمة المستقبلية للإصلاح تتمثل في تجاوز مختلف هذه العقبات، ومراجعة القوانين على مستوى المناطق التي فشلت فيها المحكمة العليا لحد الآن.
سادسا: ملاحظات
إن غنى مقاربات الكتاب، وتناوله لنظام سياسي جدير بالتحليل لما يقدمه من معطيات واقعية مهمة على مستوى تنظير الانتقال الديمقراطي، لا يمكن أن ينفي جملة من النواقص التي يمكن تسجيلها على الكتاب، يمكن التشديد على ما يلي:
- التركيز على نظام سياسي واحد، وتغييب المقارنة مع نماذج أخرى بشكل لا يسعف على بناء خلاصات موضوعية حول أدوات الانتقال وتعزيز الديمقراطية.
- إغفال كلّي لأطر نظرية الديمقراطية التوافقية، ولاسيما تلك التي قال بها أحد روادها الرئيسيين أرنت ليبهارت الذي قدم أفكار مهمة حول تحقيق الديمقراطية في الدول المتعددة الأعراق والأجناس والأديان.[4]
- عدم تخصيص دراسة لمختلف العوامل المساهمة في انهيار النظام السابق، والاكتفاء بتحليل فترة الانتقال الديمقراطي وتعزيز الديمقراطية في إندونيسيا. فنظريا يقتضي الأمر دراسة مختلف هذه العوامل، من أجل بناء نتائج موضوعية وتسجيل درجات التميز عن النظام السابق، ومدى استمرارية بعض الممارسات والبنيات.
- إغفال تناول البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى دورها في الانتقال الديمقراطي؛ فمستوى التعليم وانتشاره، ومعدل الدخل، والتحضر، وتزايد عدد مستخدمي الإنترنيت، لا نجد لها أي تناول في الكتاب، بالرغم من أهميتها. فعلى سبيل المثال تزايد عدد الصحفيين المستقلين، وتأسيس الصحيفة الإلكترونية "ماليزيا كيني" (Malysiaakini) ساهما بشكل كبير في نقل الأخبار وانتشارها بعيدا عن رقابة السلطة، وخلق فضاء عام يتيح التعبير عن الآراء المعارضة، مما سمح بفضح تجاوزات النظام السابق وفساد أجهزته، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ووحشية الشرطة، وفساد القضاء، وسوء الإدارة المالية في "بنك إسلام ماليزيا".[5]
- إغفال تناول دور العوامل الخارجية في الانتقال الديمقراطي في إندونيسيا؛ فعلى سبيل المثال تسجل بعض الدراسات التأثير الكبير الذي مارسه الدعم الخارجي لمراقبة الانتخابات في هذا البلد في تحقيق نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ولاسيما تلك الانتخابات التأسيسية التي تمت في بداية الانتقال الديمقراطي عام 1999، فالتعاون بين المراقبين الدوليين والمحليين، وإرسال عدد كبير من المراقبين الدوليين المنتمين إلى منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية، شكل ضغطا على سلطة الانتقال في إجراء انتخابات يثق فيها العالم، وساهم في ترسيخ دور لا يمكن إنكاره لمنظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، بشكل ساعد على بناء الثقة في هذه العملية وإشراك المزيد من المواطنين في النشاط السياسي.[6]
[1]- أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بالكلية المتعددة التخصصات الناضور.
[2]- ميرجام كونكلر وألفرد ستيبان، الديمقراطية والإسلام في إندونيسيا. الدين...الثقافة...الحياة العامة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2016، ص 182
[3]- المرجع نفسه، ص 256
[4]- أرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة حسن زينة، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد - بيروت، الطبعة الأولى، 2006
[5]- "لاري دايموند" و"مارك بلاتنر"، تكنولوجيا التحرر: وسائل الإعلام الاجتماعي والكفاح في سبيل الديمقراطية، ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 2013
[6]- أريك س. بيورنلوند، ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة. مراقبة الانتخابات وبناء الديمقراطية، ترجمة نادية خيري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2013، ص 305-327