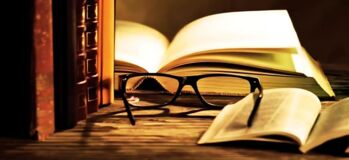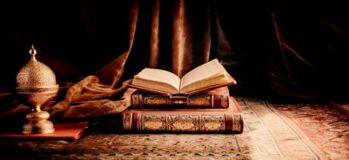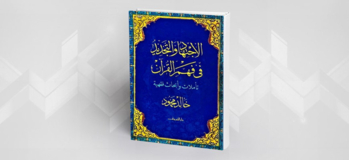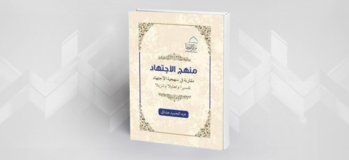الاجتهاد سؤال لم ينته بعد
فئة : مقالات

الاجتهاد سؤال لم ينته بعد
البحث في موضوع الاجتهاد في الثقافة الإسلامية، بالإمكان تقسيمه إلى مرحلتين؛ مرحلة ما قبل النصف الأخير من القرن التاسع عشر، ومرحلة ما بعد النصف الأخير من القرن التاسع عشر، فتجدد الاجتهاد في فهم الواقع ومتغيراته في العالم الإسلامي، بدأ بشكل فعلي مع أواخر القرن 19م مع كل من الطهطاوي (1801 - 1873م) وجمال الدين الأفغاني (1838 - 1897م) والكواكبي (1854 - 1902م) ومحمد عبده (1889 ـ 1905م)، وعلى طول الفترة التي تفصلنا عن محمد عبده حتى اللحظة الراهن؛ طرحت الكثير من الرؤى ووجهات النظر، وتشكلت الكثير من المشاريع الفكرية التي أغنت المكتبة العربية الإسلامية، بغض النظر عن المشارب الفكرية لتك المشاريع التي تباينت وجهات نظر النقاد والقراء في تقييمها.
الطاقة التي تمنح الشريعة فعل التجدد
الاجتهاد، مخزون الطاقة الأثري الذي أورث الشريعة المرونة والتجدد والاستمرار، وأمد الأمة بثروة زاخرة من الأحكام العملية والنظريات الحقوقية التي وجهت حياتنا الخاصة والعامة ردحاً من الزمن. فالاجتهاد درب من دروب التجديد في حركة الأمة، وفي المنظومة الثقافية الإسلامية، يبدأ من الفقه ويمتد لمختلف مجالات المعرفة بمختلف أنواعها، خصوصاً أن المتتبع للكتابات ولمختلف ما ينشر في المكتبة العربية والإسلامية، يلاحظ أن موضوع الاجتهاد شغل رواد النهضة ورجال الإصلاح منذ أواخر القرن التاسع عشر ومروراً بالقرن العشرين؛ فكل الذين ألفوا وكتبوا في مختلف ميادين الفكر والمعرفة كان هدفهم بشكل مباشر أو غير مباشر، العمل على بسط فكر ومعرفة وثقافة تستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة، ولا يعني ذلك أن كل المتدخلين والفاعلين في الشأن الفكري والمعرفي يشتركون في نفس الفكر والتصور والتوجه؛ فموضوع الاجتهاد والدعوة إليه بوصفه مفهوماً ومصطلحا تبناه المختصون في المعرفة والعلوم الشرعية، والكثير منهم من خريجي الجامعات والمؤسسات الدينية مثل: الأزهر والقرويون والزيتونة، ولم يكن فقههم مثل فقه الكثير من الذين وقفوا عند فقه الأحكام فقط، وإنما كان فقههم يجمع بين فقه الواقع وفقه الأحكام، وهو الأمر الذي جعلهم يظهرون بكونهم مجتهدي الأمة، في مقابل فئة أخرى من خريجي المؤسسات الدينية اكتفوا بالبقاء على مضامين المدونة الفقهية كل حسب مذهبه، ومنهم من أنكر كثيراً وحذر من الاجتهاد والمجتهدين بشكل علني أو بشكل يبحث لنفسه عن دليل وحجة تمنع الاجتهاد.
الاجتهاد موضوع قديم وجديد في الثقافة الإسلامية، قديم بالنظر لمختلف القامات العلمية التي قالت بكلمتها في مختلف القضايا، على طول تاريخ الثقافة الإسلامية، وجديد بالنظر لمقتضيات الحاضر المتجدد، والمتحول والذي يختلف عن الزمن القديم في كل شيء. صحيح أن أمر الاجتهاد يتسع ويضيق بين فترة زمنية وأخرى، إلا أنه لم ينقطع ويختفي بالمرة. عندما يحضر أمر الاجتهاد في مقدمة المجتمع، فذلك يفسح المجال للعناية بمختلف الآراء ووجهات النظر، والحوار فيما والنظر إلى ما هو فيه مصلحة للصالح العام؛ وذلك بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وعندما يكون المجتمع أمام الاجتهاد، يعطي عموم الناس بظهورهم للمستقبل، ويقبلون على ماضيهم وينسون حاضرهم، وقد نشبه هذه المسألة بالعربة والحصان، الحصان يتمثل في الاجتهاد الذي يجر ويأخذه المجتمع إلى مقامات أفضل مما هو عليه، مقامات الرقي والازدهار... وعندما يكون المجتمع أمام فعل الاجتهاد، فهي حالة العربة أمام الحصان؛ إذ تتوقف الحركة والمسير.
المجتمعات التي يتقدمها العلم والمعرفة والسؤال، حالها يكون أفضل بكثير من المجتمعات التي لا تولي اعتبارا للمعرفة ولسؤال البحث العلمي؛ فالتنمية في مختلف المجالات تقترن بالعلم والمعرفة، وإلا فإنها ستكون تنمية مغشوشة جسدا بدون روح، ستكون تنمية تابعة مستوردة ولا قدرة لها على الإبداع وعلى تجديد ذاتها؛ لأنها تفتقد القدرة على الإمساك بمختلف المعلومات اكتشافا واستيعابا وإبداعا وتجديدا... يحظى ذوو الاجتهاد والابتكار في مختلف مجالات المعرفة، بالعناية بأفكارهم ومخترعاتهم النظرية منها والعملية، والتقنية منها وغير التقنية، من لدن المجتمع في المجتمعات التي تعلي من قيمة الاجتهاد، وفي المجتمعات التي لا تولي قيمة للاجتهاد تجد فيه مختلف الأفكار ومشاريع الاختراع على الهامش، ولا أحد يهتم بشأنها إلا فيما هو نادر.
تيارات الاجتهاد
الذين يقولون بالاجتهاد بالإمكان تقسيمهم إلى فئتين؛ الأولى: تقف عند القول بالاجتهاد ولا تعمل به، وهي الفئة الغالبة، والثانية: وهي التي تنظر إلى الاجتهاد نظرة حضارية، نتيجة وعيها بالتغيرات الثقافية والاجتماعية ذات الطابع العالمي التي صاحبت القرن العشرين وما بعده، وهي تغيرات لها أثر بليغ على موضوع الاجتهاد من جهة طبيعة الإشكالات والقضايا التي تتطلب الأخذ باجتهاد ينسجم ويتوافق مع السياق الاجتماعي والثقافي، وهو سياق يتميز بنظم ومؤسسات وقوانين عالمية ومواثيق دولية منظمة لطبيعة العلاقة بين الدول والأمم؛ فالاجتهاد من هذا المنظور هو حالة اجتماعية وحضارية فالانتفاع بثمراته وفوائده متوقف على مقدمات ضرورية من أبرزها الخروج من التفكير من منطلق الثنائيات من قبيل (أصالة -معاصرة/ علمانية-أسلمة/...) والانفتاح على روح العصر بنفس نقدي، واستيعاب التراث في سياقه التاريخي.
تعود مشكلة تقلّص الاجتهاد وقلة المجتهدين إلى تقلص دائرة الاهتمام والاشتغال بمختلف العلوم، فضلا على اتساع التيار الذي لم يتبنّ مقولة الاجتهاد بشكل حضاري، وهو تيار يجمع بين اتجاه توفيقي واتجاه القطيعة مع التراث، وقد استحدث مصطلحات ومفاهيم بديلة عن الاجتهاد من قبيل المعاصرة والتحديث والتجديد، وهذا الاستبدال جيد من جهة الانفتاح على روح العصر، وسلبي من جهة القطيعة مع مفهوم الاجتهاد بوصفه مفهوما حضاريا، وهذا التيار الفكري في أغلبه تلقى تكويناً عصرياً في الفلسفة والعلوم الإنسانية، وبالتالي فهو لا يفكر داخل سياق مدونة الفقه وأصول الفقه، واشتغل بشكل كبير على قضايا فكرية تتعلق بسؤال تبيئة واستيعاب مختلف القضايا والأفكار في الفكر والفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية.
الاجتهاد وفكرة الثنائيات
فكرة الاجتهاد ينبغي النظر إليها بمعزل عن ثنائية الأصالة والمعاصرة؛ فالقائلون بالأصالة همهم يدور حول امتلاك وضبط مختلف متون معارف العلوم الشرعية كما هي في مضامينها مع تغييرات طفيفة، لا تخرج عن مدارتها الكبرى، فهي بالنسبة لهم بوعي أو بدونه تعبر عن الدين وليس وجه من وجوه فهم الفكرة الدينية، والحقيقة أن مختلف المضامين المعرفية ينبغي قراءتها وفهمها وفق سياقاتها التاريخية والمعرفية، بدل نزعها من سياقتها واسقاطها على الواقع الذي نحياه اليوم وهو واقع مخالف. أما القائلون بالمعاصرة، فهم يدورون حول سؤال مفاده كيف نحيا ونعيش حضارة العصر؟ وهو سؤال معرفي تترتب في الإجابات عليه اتجاهات معرفية متعددة، فهل المعاصرة تعني الانخراط في كل ما هو يعود للعصر الحديث، والقطيعة من كل ما هو أصيل، والإقبال على هذه الخطوة سيترتب عليه الارتماء في أحضان تفكير الآخر، دون وعي بمقدمة وبدايات المعاصرة، التي لم تقطع مع كثير من مقومات الأصالة. ونقد نسعى نحو المعاصرة دون أن نفرط فيما هو أصيل، وهذه خطوة ينبغي أن تحذر ألا تسقط في دائرة التوفيق ما بين الأصيل والمعاصر دون خلق ولا إبداع. المعاصرة إذن في جزء هي وعي بالذات وبالآخر، وهي مسألة تتحقق مع النقد والإبداع والاجتهاد.
الجامعات في العالم الإسلامي تدرس العلوم الشرعية في كليات الشريعة وكليات وشعب الدراسات الإسلامية، ولكن لا ينبغي أن نغفل أن هذه الكليات سابقة الذكر لا تستحضر بالشكل الكافي العلوم الإنسانية على مستوى المنهج، في الفهم والتحليل من جهة تدريس الطلاب، بقدر ما هي منجذبة بشكل كبير إلى ضبط المتون والأقوال، ولديها نوع من الفصل ما بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية؛ فالغاية من هذه الطروحات الفكرية هي إنعاش وتقوية الاجتهاد الفقهي بتحرير الاجتهاد من الدائرة الفقهية القديمة، وربطه بالدائرة الأوسع، وهي دائرة الحضارة وإشكالاتها ومقتضياتها في الزمن الحديث. ففقيه اليوم بالضرورة يكون قريباً من السوسيولوجيا والتاريخ... ليس من باب التخصص، ولكن من باب المعرفة العامة والكلية.