الاعتراف والسيرة وإشكاليات الهوية الأنثوية
فئة : مقالات
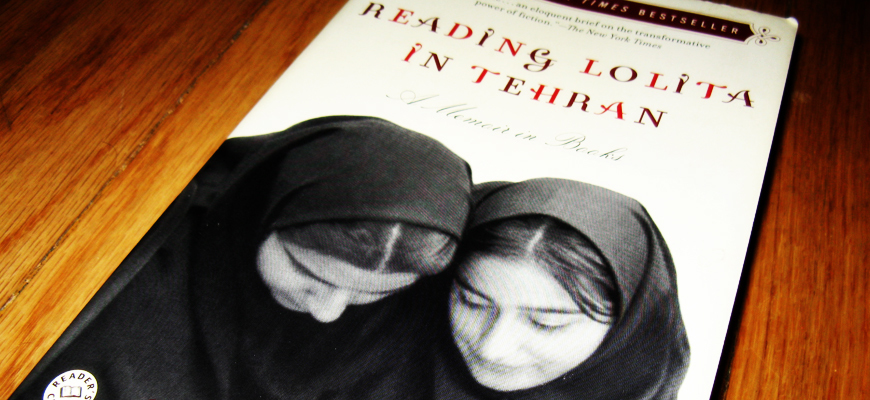
كشفت آذر نفيسي في سيرتها "أن تقرأ لوليتا في طهران" جانبا مهما من معاناة المرأة في ظل الثورة الإسلامية وحكم الجمهورية، عبر مسيرتها الشخصية وما تعرضت له في ظل ذلك الحكم. وسلطت الضوء على واقع مجحف بحق المرأة في الربع الأخير من القرن العشرين، راصدة لنا تدهور أوضاع المرأة وعودتها إلى الوراء في الوقت الذي كانت فيه الحركات النسوية في العالم آخذة بالصعود والتقدم نحو الأمام. وقسّمت نفيسي كتابها على أربعة فصول، وجاء عنوان الفصل الأول "لوليتا"، والفصل الثاني "غاتسبي" مركزة على عملين مهمين الأول لنابوكوف، والثاني لفيتزجيرالد، أما الفصل الثالث، فعنونته بـ "جيمس"، والرابع بـ "أوستن" لتقف عبر هذين الفصلين على أهم أعمال كل من هنري جيمس، وجين أوستن. فما علاقة هذه الأعمال السردية ومؤلفيها بإيران والثورة الإيرانية وبالكاتبة نفسها وما سعت لتقديمه عبر سيرتها هذه؟!
عادت نفيسي من أمريكة إلى إيران حاملة أفكارها الليبرالية معها، ومتشبعة بالثقافة الغربية لتصطدم بواقع بدا إيقاع التغيير فيه سريعا، لتجد نفسها محاصرة في إطار الجامعة ومتهمة مع أمثالها بالغربنة، ومع محاولاتها لتلافي المواجهة والتحايل على الأوضاع القائمة وتقديم أفكارها بأقل الخسائر الممكنة، لم تسلم في نهاية المطاف منها. فقد اضطرت إلى الاستقالة من الجامعة بعد أن ضُيّق عليها الخناق، وأصبحت محكومة بطقوس مهلكة تتحكم بهندامها وتصرفاتها وحتى إيماءاتها، وقُيدت حركتها عبر التجسس عليها وعلى زوارها، وتحديد نشاطاتها، والمماطلة في منحها استحقاقاتها بالتثبيت بوصفها أستاذة في القسم.
وهكذا وقبل أن تستقيل نفيسي من الجامعة وتغادر طهران مرة أخرى كان لا بد من أن تلجأ إلى وسيلة تتحايل فيها على الواقع وتعريه في آن عبر الأعمال السردية التي اختارتها لتكون موضوع محاضراتها، متكئة في ذلك على التأويل المزدوج لتلك الأعمال. فقد قرأت تلك الأعمال السردية بصحبة طلابها من منظور إيراني، كما قامت بسبر الواقع الإيراني، وما يحدث فيه من خلال تلك الأعمال. وبذلك، جعلت من الأعمال السردية مكافئا سرديا لسيرتها لترصد في نهاية المطاف واقع الجمهورية الإيرانية في ظل الثورة الإسلامية من منظور سردي وعبر رؤيتها الشخصية.
بدأت الكاتبة سيرتها على طريقة الاسترجاع (الفلاش باك) من لحظة استقالتها من الجامعة في خريف 1995 واتخاذها القرار بإطلاق العنان لنفسها إشباعاً لرغبة في روحها لتحقيق أحد أحلامها، وافتتاح صف خاص في منزلها، اختارت له سبع طالبات من أفضل طالباتها، ومغادرتها لطهران بعد عامين من إنشاء الصف، وعبر تأمل الصورتين الملتقطتين لها مع طالباتها في آخر ليلة لها في طهران فتحت الذاكرة على الأحداث التي مرت بها في تلك المرحلة.
الفضاء المفتوح والفضاء المغلق
انسحبت آذر نفيسي من الواقع الذي حوصرت به في إطار الجامعة التي تحولت إلى فضاء مغلق في ظل التقلبات السريعة والمفاجئة في الجمهورية الإسلامية، بعد أن أصبحت الجامعات هدفا لانتقادات المتشددين الذين صار شغلهم الشاغل فرض قوانين جديدة أكثر صرامة، فراحوا يطالبون بفصل الذكور عن الإناث في الفصول الدراسية، وبمعاقبة الأساتذة الذين لا يلتزمون بالتعليمات والضوابط الجديدة. ولم تسلم من ذلك الجامعة الأكثر ليبرالية في ذلك الوقت، وهي جامعة "العلامة الطباطبائي" التي تعمل فيها نفيسي. ونالت الطالبات الحظ الأوفر من المضايقات، فإذا ما أسرعت إحداهن لتلحق بالدرس عوقبت على الهرولة، وإذا ضحكت في الممرات عوقبت على الضحك، ومن الطبيعي أن تطالها العقوبة إذا ما ضبطت وهي تتحدث مع شخص من الجنس الآخر، يضاف إلى ذلك التفتيش اليومي في أثناء الدخول إلى الجامعة بعد إغلاق البوابة الخضراء الفسيحة، واستبدالها بفتحة صغيرة تدخل منها الطالبات وتفضي إلى غرفة صغيرة داكنة للتفتيش(ص 21-22، 55).
تشرح ياسي، إحدى الطالبات اللاتي اختارتهن نفيسي في صفها الخاص، ما كان يحدث لها في غرفة التفتيش، فتقول: "سيتحققون مني أولا للتأكد من أن ملابسي مناسبة وغير مخالفة؛ لون معطفي، الطول الصحيح لجبتي(زيّي الموحد)، سمك غطاء رأسي، شكل حذائي، ثم الأشياء التي في حقيبتي، والآثار التي قد تبدو على وجهي من مساحيق التجميل (حتى الأخف منها)، وحجم خواتمي ومستوى الإثارة فيها! كل هذا يجب التأكد منه قبل أن أدخل حرم الجامعة، الجامعة التي يدرس فيها الذكور الذين تنفتح لهم وحدهم تلك البوابة الخضراء بمصراعيها الهائلين وشعاراتها وأعلامها، ومنها يدخلون كالفاتحين على الرحب والسعة"،(ص55). والحال هذه، فقد جاءت القوانين الجديدة كما هو الحال في المجتمعات الشرقية أيا كانت توجهاتها، سواء أكانت عشائرية أم ليبرالية أم دينية أم غير ذلك مجحفة بحق المرأة، وتصب في مصلحة الرجل، لتبقى قضية الذكورة والأنوثة القضية الأكثر تعقيداً. فقد أغلقت الأبواب في وجه الإناث، ليتم تمريرهن عبر ممر ضيق يفضي إلى غرفة مظلمة يتعرضن فيها للإهانة والتفتيش، بينما شرّعت الأبواب في وجه الذكور ليدخلوا دخول الفاتحين المنتصرين، وبذلك تحولت الجامعة إلى فضاء مغلق في وجه الإناث، وفضاء مفتوح في وجه الذكور. وبدا أن الثورة التي شاركت فيها النساء وعلّقت عليها آمالها مخيبة للآمال.
ولم يشفع وضع المرأة أيا كانت من تعرضها للمضايقات ولعملية التفتيش، فحتى الكاتبة نفسها تعرضت للتفتيش، رغم استقالتها، وذلك بعد أن فرض قانون الحجاب بالقوة على الجميع في أماكن العمل والأماكن العامة، وملاحقة تطبيقه من قبل جماعة حماية الأخلاق. فعندما ذهبت ذات يوم مع صديقة لها إلى وزارة التعليم العالي لتصديق شهادتها، فتشتا من الرأس إلى القدم، وشعرت نفيسي حينها بأن ذلك التفتيش كان الأسوأ من بين كل التحرشات الجنسية التي تعرضت لها في حياتها. فقد طلبت منها المفتشة أن ترفع يديها إلى الأعلى وراحت تفتشها بهوس وهي تمر على كل قطعة من جسدها، ثم التقطت منديلا ورقيا وطلبت منها تنظيف وجهها من القناع الذي تضعه، وعندما اعترضت نفيسي لأنها لم تكن تضع شيئا على وجهها، بادرت المفتشة بنفسها للقيام بالمهمة وراحت تمسح وجه نفيسي بشدة وعنف بدون جدوى إلى درجة تسببت في أذية بشرتها ما جعلها تشعر بحرقة تجتاح وجهها،(ص280-281).
تحول الفضاء المفتوح/الجامعة إلى فضاء مغلق في وجه النساء بفعل القوانين الاعتباطية المجحفة بحق المرأة، لتجد نفسها محاصرة في كل مكان، تتربص بها أعين جماعة حماة الأخلاق. وبدا وكأن الثورة قد أنجزت وعدها ولم يبق أمامها سوى ملاحقة امرأة لا تلتزم بتلك القوانين. وتحول دور الجامعة من مؤسسة أكاديمية تهتم بنشر العلم والمعرفة، وتقدّر الكفاءات العلمية، إلى رقيب أخلاقي أقصى اهتماماته ينصب على لون شفاه النساء، أو معاقبتهن على خصلة شعر يتيمة قد تطيش من تحت الحجاب. وكان من المتعذر على نفيسي التي نشأت في جو ليبرالي منفتح أن تستمر في العمل في ظل هذا الجو القاتم المغلق الذي لا يهتم بكفاءتها في أداء واجباتها التعليمية، ولا يتيح لها حرية تعليم الأدب بالطريقة التي تراها مناسبة، بعد أن أصبح الشغل الشاغل للمسؤولين في الكلية هو حذف كلمة "نبيذ" من قصة لهمنغواي، أو إصدار قرار بمنع تدريس "برونتي" لأنها تتغاضى عن فعل الزنا،(ص24)، معرضين الأدب للمحاكمة الأخلاقية والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة وليس إبداعا تخييليا لا يمكن النظر إليه على أنه حقيقة.
استقالت نفيسي مجبرة من منصبها في الجامعة بعد أن تحولت إلى فضاء مغلق، بحثا عن فضاء مفتوح فلم تجد سوى البيت، الذي ناضلت النساء من أجل الخروج منه عندما كن يقبعن في حريم، ملاذا لها. فوحده البيت يتيح للمرأة أن تنزع فيه حجابها وتتحدث وتضحك وتتزين وتناقش الأفكار والموضوعات والأدب بحرية بدون أن تطالها أعين الرقباء، معرضة إياها للعقاب. ولعل المفارقة تكمن هنا تحديدا فالبيت الذي شكل فضاء مغلقا عاشت فيه المرأة زمنا طويلا وهي تحلم بمغادرته، وتحايلت عليه بشتى الوسائل مطلقة العنان للخيال ليحملها خارجه إلى الفضاء المفتوح، عادت إليه مرة أخرى بوصفه ملاذا هذه المرة وفضاء مفتوحا يتيح لها فعل ما لا يمكنها فعله في ظل نظام شمولي راح يحصي على المرأة حركاتها وسكناتها وحتى أنفاسها. فما لا يمكن فعله في الجامعة صار متاحا في البيت لتنعكس الآية ويصبح البييت المعادل الموضوعي للجامعة، ففيه تمارس نفيسي عملها بحرية مطلقة، وتناقش مختلف القضايا مع طالباتها في صفها الخاص بدون أي تحفظات.
وهكذا انسحبت نفيسي من واقع لا ترضاه إلى دنيا الخيال، عبر قراءتها ومناقشتها مع طالباتها لبعض الأعمال السردية التي اختارتها، لكنها كانت تعرف كيف تقفل راجعة إلى أرض الواقع، ليقوم الأدب بدور علاجي بالنسبة إليها، يمنعها من الوقوع فريسة العصاب أو المرض النفسي بحسب فرويد. وربما لو لم تفعل ذلك لآلت إلى مصير مظلم في ظل ذلك النظام الشمولي، بقيمه ومبادئه التي تتعارض مع قيمها ومبادئها وثقافتها، والذي وجدت نفسها في مواجهة معه رغما عنها، بعد أن منعت من مغادرة البلاد لمدة أحد عشر عاما. ومن غرفة المعيشة صنعت نفيسي مع طالباتها عالمهن وصومعتهن الخاصة، مبتدعات لكون شخصي مستقل يسخر من "واقع الإيشاربات السود والوجوه المذعورة لتلك المدينة التي تدبّ بعشوائيتها"،(ص15). وكانت الثيمة الأساسية في صفهن هي رصد العلاقة بين الخيال والواقع، وبين الكتابة والحياة. وعبر هذه الثيمة قرأن كلاسيكيات الأدب الفارسي، وحكايات "ألف ليلة وليلة"، وكلاسيكيات الأدب الغربي مثل "مدام بوفاري"، و"كبرياء وهوى"، و"ديزي ميللر"، و"ديسمبر الكاهن"، والعمل الأهم الذي قرأنه ربما يكون "لوليتا".
لم تقف نفيسي مع طالباتها عند "لوليتا" فقط، بل وقفت عند تجربة نابوكوف في مجمل أعماله، لتتوصل عبر هذه التجربة إلى المقارنة بين النظام الشمولي الذي يعاني منه الفرد عند نابوكوف، والنظام الشمولي في كنف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكما فعل بطل نابوكوف في روايته "دعوة لقطع العنق" فاحتمى بفعل الكتابة، متخذا منها سبيلا للهرب والصمود، رافضا أن يكون مثل الآخرين؛ كان على الذين يعيشون في كنف الجمهورية أن يدركوا مدى القسوة المأساوية اللامعقولة التي يرزحون تحتها، وكان عليهم أن يدسوا الملهاة في قلب المأساة، وأن يسخروا من تعاستهم كي يبقوا على قيد الحياة، ولهذا السبب أصبح الأدب جزءا جوهريا في حياتهم، ولم يعد مجرد رفاهية، بل غدا ضرورة من ضرورات الحياة. ولعل قدرة نابوكوف على خلق حرية مطلقة، عبر كتاباته وحياته، حتى حينما يُستلب منه حقه في الاختيار، هو ما جعل نفيسي وطالباتها يتعلقن به. ولعل هذا الأمر تحديدا هو الذي دفع نفيسي إلى إنشاء صفها الخاص، فقد كانت الجامعة هي حلقة الوصل الوحيدة بينها وبين العالم الخارجي، وبعد أن قُطعت هذه الصلة، أصبحت على شفا حفرة من الفراغ الذي يهدد بابتلاعها، إن لم تخلق لنفسها كمانها الخاص الذي سينقذها، والذي تمثل في ذلك الصف،(ص44-45).
لوليتا وطهران
منذ اللقاء الأول لنفيسي مع طالباتها في صفها الخاص، في غرفة معيشتها، شرحت لهن الهدف من ورائه، وكان على كل طالبة أن تحتفظ بدفتر مذكراتها الخاص الذي تسجل فيه ملاحظاتها بشأن كل عمل، والبحث في الصلة بين تلك الأعمال والنقاشات حولها، وبين الحياة الشخصية والتجربة الاجتماعية لكل طالبة. كما شرحت لهن آلية انتقائها للمجموعة القائم على فرضية اهتمامهن بدراسة الأدب، دون النظر إلى خلفياتهن الاجتماعية أو الإيديولوجية. أما اختيارها للأعمال السردية فكان من منطلق إيمان كتّابها العميق بالطاقة الهائلة للأدب في إعادة صياغة الواقع. فقد كان نابوكوف في التاسعة عشر من عمره عندما اندلعت الثورة الروسية، ولم يكن يسمح لنفسه بالتأثر بأصوات الرصاص التي كانت تتناهى إلى سمعه، أو بصور المحاربين الدمويين التي تتراءى له عبر النافذة، مواصلا كتابة قصائده الصوفية،(ص36-37). وفي ضوء تجربة نابوكوف تطلب نفيسي من طالباتها أن يخضن هذه التجربة فتقول: "فدعونا نجرّب بعد سبعين عاما من ذلك الحدث، ما إذا كان إيماننا الحقيقي بالأدب جدير بأن يجعلنا نعيد صياغة هذا الواقع المظلم الذي خلقته لنا ثورة أخرى"،(ص37).
أنشأت نفيسي صفها الخاص في خضم تلك الأجواء، محاولة الهرب من تفرس عين رقيب أعمى، ولو لسويعات قليلة كل أسبوع. ورغم ما آلت إليه الدولة من قمع بمختلف وسائل الترهيب وبث الذعر، لم تستطع الحول دون اقتناص لحظات يعبر من خلالها المرء عن وجوده وأنه بشر يحيا ويتنفس. وتشير نفيسي إلى أنهن كن مثل لوليتا يحاولن النأي بأنفسهن بحثا عن مساحات صغيرة من الحرية. وكن مثلها أيضا في تمايلهن طربا بتمردهن، عبر إظهار خصلات شعر صغيرة من تحت الإيشاربات، أو إطالة الأظافر، أو تعديل ملابسهن القاتمة المتشابهة بتلوينها جزئيا بلون آخر، أو الاستماع لموسيقا ممنوعة، أو الحب. وبذلك استطعن العيش في فضاءات مفتوحة خلقنها من بين الشروخ التي ظهرت بين غرفة المعيشة التي تشكل الشرنقة الواقية لهن، وبين عالم الرقيب الذي ينتظرهن في الخارج،(ص48).
لم تبتعد نفيسي عن الواقع لتنكفئ على نفسها، ولم تنشئ صفها الخاص وتمارس فيه مهنتها في دراسة الأدب ومناقشة قضاياه مع طالباتها بهدف التسلية، والترويح عن النفس في ظل الجو الخانق الذي سيطر على طهران، بل كانت لها أهداف واضحة منذ البدء، وكان الصف الذي أنشأته هو لون أحلامها الذي هيّأ لها انسحابا مثمرا من الواقع الذي استحال إلى منطقة معادية. ولم يكن بالإمكان التعامل مع لوليتا بعيدا عن واقع طهران وقراءتها وفق نظرية الفن للفن، بل كانت لوليتا حاضرة في طهران، وطهران حاضرة في لوليتا، وعبر التأويل المزدوج الذي اتكأت عليه نفيسي مع طالباتها في قراءة "لوليتا" أُعيد إنتاج هذا العمل فلوّنت لوليتا طهران بلون مختلف، واستطاعت طهران أن تعيد التعريف بلوليتا حتى خلقت منها "لوليتا" مختلفة، "لوليتا" خاصة بكل واحدة منهن،(ص16). فكيف تجلت تلك العلاقة بين لوليتا وطهران؟ ولماذا لوليتا في طهران؟ وما علاقة لوليتا بطهران؟ تساؤلات تطرحها نفيسي نفسها طالبة من القارئ أن يتخيلها مع طالباتها وهن يقرأن لوليتا في طهران.
لعل مأساة لوليتا لا تكمن في اغتصاب فتاة في ربيعها الثاني عشر على يد عجوز قذر فحسب، بل في مصادرة شخص لحياة شخص آخر. وتشير نفيسي إلى أن الرواية مع ذلك تبدو متفائلة تدافع عن الجمال والحياة اليومية بكل المتع الطبيعية التي حرمت منها لوليتا، مثلما حرمت منها طالبتها ياسي. وترى أن نابوكوف قد ثأر للجميع من أصحاب نظرية الأنا في حياتهم، عبر تقديمه لشخصية هومبرت، فاضحا أولئك الذين يفرضون وجودهم ويتسلطون على حياة الآخرين، وبذلك يكون قد ثأر من خطيب ياسي الأخير، ومن الأستاذ الذي لا يرى فرقا بين المرأة المسلمة والمرأة المسيحية، سوى أن الأولى عذراء محبة لبيتها ووفية لزوجها، والثانية لا يمكن أن يقال بحقها الكثير سوى أنها ليست عذراء. ومن آية الله الخميني نفسه الذي فرض وجوده وتسلط على حياة طهران،(ص56-57، 60).
إن تأكيد نفيسي على أنها لم تكن وطالباتها لوليتا، كما لم يكن أية الله الخميني هومبرت، وليست الجهورية الإيرانية هي ما أطلق عليه هومبرت إمارة البحر التي يملكها، وأن لوليتا لم تكن رواية نقدية للجمهورية الإسلامية في يوم من الأيام؛ إلا أن هذا لا يمنع من وقوفها ضد أي وجه من أوجه الشمولية. ولذلك سنجد تماهيا بين لوليتا وطهران، وبين لوليتا ونفيسي وطالباتها، وبين أية الله وهومبرت.
صادر هومبرت حياة لوليتا، محاولا إلغاء ماضيها وتاريخها، جاعلا منها ما يريده هو لا ما هي عليه. ومنذ البداية يقرر أن ما امتلكه بجنون ليس لوليتا وإنما ما صنعه منها، معتقدا أنه صنع منها لوليتا أخرى أكثر إمتاعا. وتجلت سيطرته عليها من تغييره لاسمها وإطلاقه عليها اسما يحاكي رغباته وأهوائه، ليحل اسم لوليتا محل اسمها الحقيقي "دولورس" الذي يعني في اللغة الإسبانية ألم. سلب هومبرت لوليتا تاريخها الحقيقي ليضع مكانه التاريخ الذي يريد، محاولا مسخها وتشويهها لتتحول إلى نسخة تجسد حبيبته "أنابيل لاي" وحبه الضائع الفتي غير المتحقق. إذ لا تظهر لوليتا عبر ماضيها، وإنما عبر ماض خيالي مفترض ابتدعه الراوي الذي يقحم نفسه في حياتها في محاولة لامتلاك هومبرت لها، لكن لوليتا كانت تملك ماضيا حقيقيا يخصها، ولم تفلح محاولات هومبرت في سرقة تاريخها بجعلها يتيمة منقطعة الجذور، إذ كان يظهر ماضيها بين الحين والآخر عبر لمحات بسيطة، في مقابل هوس هومبرت بماضيه الخاص الذي يلقي بظلاله الكاملة على الرواية.
يكشف ماضي لوليتا عن موت والدها وأخيها وكذلك أمها التي يوافيها الأجل لاحقا. ولا يعاودها هذا الماضي على شكل حلم ضائع، وإنما مثل فراغات ونقص في شيء ما، لتتحول بذلك إلى نموذج مزيف لحلم شخص آخر يحاول تحقيقه بشخصها، وترى نفيسي أنها تشبه في ذلك طالباتها تماما، فهن لا يمتلكن تصورا واضحا عن أنفسهن، ولم يكن بإمكانهن صياغة ذواتهن إلا عبر عيون الآخرين الذين كن يكرهن ويزدرين، ولا يعشن حياتهن ويسلب منهن ماضيهن ليصبحن نموذجا مزيفا لحلم الآخرين. وينسحب الأمر نفسه على ماضي إيران الحقيقي الذي غدا أمرا ثانويا بالنسبة إلى أولئك الذين استحوذوا عليه، تماما مثلما أصبح ماضي لوليتا ثانويا بالنسبة إلى هومبرت،(ص63،65-66، 69).
والحال هذه فإن ما عانت منه لوليتا، ونفيسي وطالباتها، هو ما تعانيه المرأة في الشرق الأوسط عموما، فحتى هذه اللحظة ما تزال المرأة تعيش وفق تصورات الآخر/الذكر عنها وليس وفق تصورها عن ذاتها، ومنذ لحظة الولادة تبدأ بالتشكل وفق تصورات الآخرين وأحلامهم، وغالبا ما تنصاع لهذه الأحلام والتصورات، وإذا حدث وحاولت الخروج على هذه التصورات لتحقق حلمها هي لا أحلامهم، فإنها تصطدم بالمحيط الذي يحاصرها ويقمعها. وبذلك تصبح حياتها مشوهة لأنها لا تعيش حياتها، وإنما الحياة التي أريدت لها. ولانتزاع جزء من حريتها وعيش حياتها التي تريد تلجأ إلى التحايل بشتى الوسائل، عبر الأحلام والخيال والتمرد والمواجهة في بعض الأحيان. وكما فعلت نفيسي بإنشائها لصفها الخاص.
سُلب ماضي لوليتا وحاضرها لتعيش حياة ليست حياتها، ولتتحول إلى ضحية مرتين، إذ لم تسلب منها حياتها فحسب، بل سلبت منها قصة حياتها أيضا. وحتى لا تتحول نفيسي مع طالباتها إلى لوليتا ويصبحن ضحية للمرة الثانية، بعد أن سلبت حياتهن التي يرغبن في عيشها بسبب النظام الشمولي الذي راح يلاحقهن، كان الصف الخاص الذي منحهن امتلاك قصتهن والتعبير عنها بعيدا عن أعين الرقباء،(ص74-75).
لم يكتف هومبرت بسلب لوليتا ماضيها ومسخه، وحرمانها من حياتها، والتعبير عنها، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ راح يوظف مهارته في الخطابة، ومن خلال تلاعبه بالألفاظ، في تحويل الضحية إلى جلاد، محاولا كسب تعاطف المتلقي معه، وهكذا يبرئ هومبرت نفسه ويورط ضحيته، وهذا الأسلوب تحديدا كان دارجا ومألوفا في الجمهورية الإسلامية. فبعد أن أضرم أتباع الخميني النار في دور السينما، جاء تصريحه مراوغا، قائلا: "نحن لسنا ضد السينما، وإنما نحن ضد البغاء!"،(ص77). محاولا بذلك كسب التأييد وتحويل المجرمين إلى حماة للأخلاق، وبدل معاقبتهم كافأهم على عملهم.
ترى نفيسي أن هومبرت وغد وشرير لا يختلف عن أي ديكتاتور آخر لا يعنيه الآخرون وحياتهم في شيء، وجلّ اهتمامه يتمركز حول وجهة نظره الشخصية عن الآخرين. فقد سرق هومبرت طفولة لوليتا ولم يكترث بأحاسيسها ومشاعرها، بل لم يكن يعرف شيئا عما يمكن أن يدور في خلدها. ولم يدرك أن كل ما أرادته هو أن تحيا حياة طبيعية. ولعل المشكلة لا تقف عند هذا الحد فقد تعامل بعض النقاد مع لوليتا بالطريقة نفسها التي تعامل بها هومبرت معها، لأنهم لا ينظرون إلا إلى أنفسهم وما يرغبون برؤيته. فبعض الرقباء والنقاد المسيسين يفعلون الشيء ذاته، يقتطعون ويحذفون صفحات من الكتب، ثم يعيدون صياغتها وفقا لوجهات نظرهم. وهذا ما حاول أن يفعله أية الله الخميني بحياة الإيرانيين، والنساء تحديدا، إذ سعى إلى تحويلهم إلى نماذج من صنع خياله، والأمر نفسه فعله بالأدب،(ص87-88-89).
وعندما رحل الخميني الذي خلق من نفسه أسطورة، لم يحزن الناس عليه بقدر حزنهم على موت الحلم. ففي المجتمعات الشرقية المحكومة بالقيم البطرياركية والعشائرية والأنظمة الشمولية ما تزال الشعوب تعلق آمالها وأحلامها على الحاكم الفرد الديكتاتور والبطل المخلّص، ولذلك تتأثر هذه المجتمعات كثيرا برحيل قادتها، ونجدها تسهم بشكل أو بآخر في صياغة شخصية الديكتاتور، وتؤسطره إلى درجة التقديس، وعندما ينهار هذا الديكتاتور لأي سبب كان يحدث نوع من التخبط والذعر والوقوع في الفراغ الذي خلفه غيابه؛ لأن الشعوب في المجتمعات الشرقية ما تزال تؤمن بالخلاص الفردي، ولذلك تستبدل ديكتاتورا بديكتاتور جديد، وفي الوقت الذي تنتظر فيه الشعوب من الديكتاتور أن يحقق أحلامها، يسعى هو إلى تحقيق حلمه الخاص، محاولا تفصيل الواقع في ضوء معطيات حلمه، كما فعل الخميني وغيره من صناع الأساطير العظماء أمثال هتلر وستالين وغيرهم. وترى نفيسي أن الخميني نجح مثل هومبرت في تدمير الواقع والحلم معا،(ص410)، فقد دمر واقع البلاد وشعبه بعد أن زج بالبلاد في حرب دامت ثماني سنوات مع العراق ليحقق حلمه الذي لم يتحقق، إضافة إلى كل الجرائم والقتل والتعذيب التي رافقت محاولة تحقيق ذلك الحلم في تحويل نظام الحكم من سلطة إمبراطورية مستبدة إلى سلطة لاهوتية شمولية، كان لمعاناة المرأة فيها حصة الأسد.
معاناة المرأة الشرقية في ظل الأنظمة الشمولية
لم يعد خافيا على أحد أن الأنظمة الشمولية تخضع لحكم الحزب الواحد بإيديولوجية معينة، سواء أكان الحزب دينياً، أم قومياً، أم يسارياً، ويُحتكر فيها النشاط السياسي للبلد بأكمله بالحزب الحاكم ممثلا برأسه أي الحاكم، ولا يسمح بوجود أية معارضة لذلك الحكم، وتكون إيديولوجية الحزب الحاكم هي المحرك الأساسي للدولة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما تُوظف السياسة الخارجية للبلد لخدمة مصالح الحزب الحاكم. ويُسخّر الإعلام بمختلف أشكاله للترويج لفكر الحزب أيضا، وتستعين هذه الأنظمة بالوسائل القمعية الوحشية المتمثلة في أجهزة الأمن والمخابرات لمواجهة معارضيها أو المختلفين معها فكرياً أو عقائدياً سواء أكانوا أفراداً أم أحزاباً سياسية أم جماعات ثقافية، ففي ظل هذه الأنظمة لا مجال لوجود معارضة أيا كان نوعها.
وقد اصطلح الناقد العراقي د. عبد الله إبراهيم على تلك المجتمعات المحكومة بالأنظمة الشمولية "المجتمعات التأثيمية" مشيرا إلى أنها مجموعات بشرية محكومة بنسق متماثل من القيم الثابتة أو شبه الثابتة، تستند في تصوراتها عن نفسها وعن غيرها إلى مرجعيات عقائدية أو عرقية ضيقة، وتتحكم بها روابط دينية، أو عرقية، أو عشائرية، أو مذهبية. وهي مجتمعات أبوية يتصاعد فيها دور الأب الرمزي من الأسرة، وينتهي بالأمة. وتفتقد هذه المجتمعات للشراكة التعاقدية في الحقوق والواجبات بين أفرادها، وتخشى من التغيير في بنيتها الاجتماعية، معتقدة أنه يهدد قيمها الخاصة. ولذلك تجدها تؤثم أفرادها حينما يقدّمون أفكارا جديدة، ويتطلعون إلى تصورات مغايرة، ويسعون إلى حقوق كاملة، فكل جديد عندها نوع من الإثم، وربما يمكننا القول كل ما يخالفها نوع من الإثم. إن هذه المجتمعات، التي تعتصم بهوية ثقافية قارة لا تعرف التحول ولا تقر به، وهي مجتمعات لاذت بتفسير مغلق للنصوص الدينية، وصارت مع الزمن خاضعة لمقولات ذلك التفسير أكثر من خضوعها للقيم الثقافية والأخلاقية والروحية للنصوص الدينية الأصلية، أنتجت تصورات ضيقة عن مفهوم الحرية والمشاركة، فعدتهما ممارستين ينبغي أن تمتثلا لشروط النسق الثقافي السائد، وأن تخلصا الولاء لشروط البنية الثقافية القائمة، ليغدو مفهوم الحرية مقيدا بالولاء والطاعة، وليس مشروطا بالمسؤولية الهادفة إلى التغيير. وبناء عليه يعد أي خروج على مبدأ الطاعة والولاء للنسق السائد ضلالة تهدف إلى التخريب،( إبراهيم، عبد الله: المطابقة والاختلاف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2004، ص330)، وينبغي محاسبة الخارجين على النسق ومعاقبتهم من أجل مصلحة الأمة.
والحال هذه فإن الأفراد الذين يعيشون في ظل هذه المجتمعات التأثيمية، التي تحكمها أنظمة شمولية أيا كانت مرجعيتها، ولا يمتثلون للنسق الثقافي السائد فيها، محكوم عليهم بالمعاناة سواء أكانوا رجالا أم نساء. ولكن معاناة المرأة في ظل مثل هذه المجتمعات تبدو أكثر حدة، ولا سيما إذا كانت تحكمها أنظمة شمولية على خلفية دينية، وثقافة ذكورية كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا ما كشفت عنه آذر نفيسي في كتابها. فقد أشارت إلى الطبيعة العشوائية للأنظمة الشمولية وتدخلها في حياة الناس، واقتحام أكثر التفاصيل حميمية وخصوصية، وفرض خيالاتها المريضة القاسية على حياتهم، ومن ذلك اقتحام بيت نفيسي ومصادرة الطبق اللاقط، وإمكانية معاقبة ابنتها في المدرسة على وضع شريط حذاء ملون، أو الركض في فناء المدرسة، أو لعق الآيس كريم في العلن، مستنكرة أن يكون هذا هو حكم الإسلام، (ص117).
عمل النظام الشمولي في إيران على تقييد حرية المرأة، وإعادة وضعها ضمن قوالب ارتآها لها، فاستن قوانين أسهمت في حجبها وتقييدها ماديا ومعنويا. وقد تجلى ذلك في التقييد الجسدي، والتقييد الذهني، والتقييد الاجتماعي. وعندما سعت المرأة للانعتاق من هذه القيود التي فرضت عليها، نُظر إليها على أنها مارقة ومتمردة تهدد الثورة الإسلامية والجمهورية، ولا بد من أن تلقى العقاب المناسب. فتعرضت للاعتقال والسجن والإعدام، وانتهك عرضها ماديا، عبر اغتصابها، ومعنويا، عبر اللغة. وفرض عليها الحجاب المعنوي قبل المادي، لتجد نفسها محاصرة حتى في غرفة نومها. فقد جاءت نصيحة المتحدث باسم البرلمان آنذاك السيد هاشمي رفسنجاني لتحث النساء على ارتداء ملابس مناسبة في أثناء النوم، حتى إذا ما تعرضت بيوتهن للقصف، فلا تراهن عيون الغرباء وهن غير محتشمات،(ص267). إن مجتمعا يحكمه نظام شمولي بمرجعية دينية وعقلية ذكورية، لا يُستبعد فيه التفيكر بمظهر النساء بعد موتهن بدل التفكير بموتهن، وضرورة حمايتهن من الموت، يمثل سجنا حقيقيا تقبع فيه النساء أينما وجدن سواء أكن في البيت أم في الشارع أم في الجامعة أم في العمل.
عاشت النساء قبل الثورة الإيرانية في ظل قوانين كانت تعد الأكثر تطورا في العالم فيما يتعلق بحقوق المرأة، فكن يمشين في الشوارع بحرية، ويتمتعن بمخالطة الجنس الآخر، وينخرطن في سلك الشرطة، وقد يصبحن قائدات طائرات. لكن المرأة في ظل الثورة لم تعد تتمتع بمثل هذه الحقوق، ففي ضوء القوانين الجديدة بدا أنها تعود إلى الوراء إلى عهد الجدات، وليصبح عهد الأمهات أكثر حرية من عصر البنات. ووجدت الشابات أنفسهن محاصرات في حريم كانت أمهاتهن قد تخلصن منه ولم يخضعن له أو يعشن فيه. وليطمس التاريخ الشخصي لكل فتاة، وتمسخ هويتها، بعد أن أسبغ النظام على الجميع صفة "نساء مسلمات"،(ص50-51). وفي هذه الأجواء ظهرت معاناة المرأة.
عانت المرأة في ظل النظام الشمولي في إيران من التقييد الجسدي بعد أن فُرض "الجادور" رسميا على النساء، واتهمت النساء اللواتي لا يضعن الحجاب بأنهن بغايا أو أتباع للشيطان، وتعرضت من لا تمتثل لارتدائه للعقاب، فكان على المرأة أن تختار مضطرة بين ارتداء الحجاب وبين الجلد أو حتى القتل إذا لم تمتثل للأمر، ص(226،257). ولم تسلم حتى النوافذ التي تطل منها المرأة على الفضاء المفتوح من الحجب، فقد فرض عليها الحجاب أيضا، وتركها عارية بدون الستائر أمر غير مقبول في دولة إسلامية فلا بد للنوافذ أن ترتدي سترها،(ص17). ولم يقتصر الأمر على تقييد المرأة بالحجاب، بل قيدت حركتها أيضا، فصارت الهرولة فعلا تعاقب عليه النساء، فقد تعرضت نسرين للعقاب عندما رفع السيد نهوي تقريرا عنها إلى اللجنة التأديبية، بعد أن ضبطها متلبسة بالهرولة على الدرج حينما تأخرت عن المحاضرة، وكان عليها أن توقع على ورقة اعتذار تتعهد فيه بألا تعود إلى الركض في مباني الجامعة مرة أخرى حتى حينما تكون متأخرة عن المحاضرة، والاختيار بين الإذعان والتوقيع أو فصلها من الجامعة،(ص482). وحرّم الباليه والرقص، وخيرت الراقصات بين التمثيل والغناء، ثم طال التقييد صوت المرأة الذي ينبغي أن يحجب أيضا لأنه مثل شعرها يثير الغرائز، ولا بد له من أن يكون مخفيا، فمنع الغناء. وكان من الطبيعي أن يتبع تقييد الجسد تقييد الروح، فصار الحب واحدا من المحرمات أيضا،(ص184).
خلف تقييد الجسد والروح ورغبات المرأة آثارا سلبية؛ إذ صارت المرأة تجهل نفسها وجسدها، ولا تعرف سوى ما يريده الآخرون منها، وحتى عندما يتعلق الأمر بمشاعرها وأحاسيسها وعلاقتها بالرجل، تجد نفسها تتخبط لأنها لا تعرف ماذا تريد تحديدا لجهلها بنفسها من جهة، وجهلها بالرجل من جهة أخرى، فنسرين تجهل ما هي السعادة، ولا تستطيع الإجابة عن سؤال هل هي سعيدة، لأنهم لم يعلموها ذلك، وما تعلمته هو أن المتعة من أكبر الكبائر، وأن الجنس للتناسل فقط، ولذلك تشعر بالذنب لمجرد شعورها بالاهتمام برجل،(ص495). ولم تكن طالبات نفيسي الأخريات أفضل حالا، فجميعهن يميزن بين ما يسمينه الحب الروحي والنظري على أنه خير، وبين الجنس على أنه شر، مؤكدات على الانسجام الروحي بين العاشقين، وأن الجنس ليس مهما في العلاقة بين الرجل والمرأة، فهن يجهلن أجسادهن، تلك الأجساد التي قيل لهن بأنها ينابيع الإغراء،(ص503، 505).
لحق التقييد الجسدي، الذي كبل الجسد والروح معا، تقييد ذهني عاق العقل والفكر برفض النظام الشمولي لأي تفكير أو توجه أو تنظيم لا ينسجم مع توجهاته. فصودرت الأفكار في الجامعات، وضُيّق على الكتاب وتحديدا الكاتبات، إذ اعتقلت روائية بتهمة نشر البغاء، وحوكمت وزيرتان سابقتان بالإعدام بعد الثورة بتهمة ارتكاب المعاصي ونشر البغاء أيضا. وتعرضت نفيسي نفسها للإهانة التي تنتهك عرضها لفظيا عندما وجدت على مكتبها ظرفا في داخله ورقة كتب عليها: "الزانية نفيسي يجب أن تطرد" بعد أن صارت هذه اللغة هي لغة الصحف الرسمية والإذاعة والتلفاز ولغة رجال الدين بهدف تشويه سمعة الخصوم وتدميرهم،(ص230،316-317،432).
كما حلت آلية التعليم التي تعتمد على الحفظ الصم ولا تشجع على إبداء الآراء، بل تسفهها، لتأتي إجابات الفتيات في الامتحان نسخة طبق الأصل، وعندما غضبت نفيسي من طالباتها بسبب الإجابات المتطابقة، دافعت إحداهن عن نفسها وعن زميلاتها موضحة لنفيسي أن لومها ليس في محله، قائلة: "كان عليك أن تضعي في حسابك الجو الذي أتينا منه. فمعظم البنات لم يستمعن في حياتهن لأي تشجيع على أي شيء يفعلنه، ولم يقل لهن أحد بأنهن كفوءات أو لا بد أن يكون لهن تفكيرهن المستقل. وها أنك تأتين لتصطدمي بهن وتتهميهن بخيانة مبادئ لم يقل لهن أحد بأنها ذات قيمة"،(ص368).
أما من يشك في انتمائه لجماعات أو أحزاب معارضة فكان مصيره سوداويا، ولحق هذا الأمر بعدد كبير من النساء اللواتي اعتقلن بتهمة عدم الولاء، ومن ذلك ما تعرضت له نسرين التي سجنت وهي طالبة في الثانوية، وحملت في ذاكرتها قصصا مروعة عما تتعرض له السجينات السياسيات من انتهاكات، فقد كانت تُزوج الفتيات العذراوات من السجانين قبل إعدامهن، لاعتقادهم بأن المرأة إذا ما قتلت وهي عذراء فسوف تدخل الجنة، ولذلك كانت تلك الفلسفة والعقلية المهترئة تحكم على النساء في حياتهن بالإعدام، فلم تكن ترحمهن في حياتهن، ولا تسمح للرحمة أن تحل بهن بعد مماتهن. وكشفت عن الفساد في السجن فقد اعتقلت إحدى الفتيات بتهمة ملفقة تتعلق بالأخلاق، وكان ذنبها الوحيد هو جمالها، وقد احتجزت لمدة تجاوزت الشهر، وتناوبوا على اغتصابها مرات عديدة، فكان يتركها سجان ليستلمها آخر،(ص354).
وتعرضت مهشيد التي كانت ترتدي الحجاب عن قناعة، وكان والدها من المتحمسين للثورة لتجربة السجن أيضا، فقد سجنت لمدة خمس سنوات بسبب انضمامها إلى أحد الأحزاب الإسلامية المنشقة، ثم حرمت من العودة إلى الدراسة عامين كاملين بعد إطلاق سراحها. وكانت قد خرجت من تجربة السجن معطوبة بعد أن حصل لديها عجز في إحدى الكليتين، لتعيش بقية حياتها بكلية واحدة. لتتحول حياتها إلى كوابيس تراودها بين الحين والآخر،(ص28).
وجاء التقييد الاجتماعي ليعيد المرأة إلى الوراء، فبعد أن ارتفع سن الزواج في إيران من تسع سنوات إلى ثلاثة عشر عاما ثم ثمانية عشر عاما، وكانت المرأة تستطيع اختيار شريك حياتها بنفسها، كما فعلت والدة نفيسي التي كانت واحدة من بين ست نساء انتخبن للبرلمان في عام 1963، وفي الستينيات لم تكن تشعر نفيسي بفرق كبير بين حقوقها وحقوق النساء في دول الغرب الديمقراطية، وتزوجت من الرجل الذي تحب عشية اندلاع الثورة، جاءت الثورة لتعيد عجلة الزمن إلى الوراء ولترتد القوانين إلى ما كانت عليه قبل عهد الجدات، وكان أول قانون تم إلغاؤه قبل بضعة أشهر من إقرار الدستور هو قانون حماية الأسرة الذي يضمن حقوق المرأة في البيت والعمل. وخفض سن الزواج إلى تسع سنوات مرة أخرى، وأصبحت عقوبة الزنا والبغاء الرجم بالحجارة حتى الموت،(ص431-432) وغيرها من القوانين التي جاءت لتزيد من معاناة المرأة في ظل هذا النظام الذي يعتمد على إقصاء الآخر.
ومع هذه العودة إلى الوراء والقوانين الجديدة التي سُنّت، لم يعد بإمكان المرأة تقرير مصيرها واختيار شريكها، أو مغادرته إن لم يكن مناسبا، وصار لزاما عليها أن تقبع في ظل رجل، وفق الطريقة التقليدية في الزواج. وتعرضت لمختلف أنواع العنف الجسدية والمعنوية من قبل الزوج، بعد أن وقف القانون إلى جانبه فلم يجد أن الاعتداء الجسدي أو المعنوي على المرأة هو سبب كاف للطلاق، وفي حالات كثيرة عنّف القاضي الزوجة التي جعلت زوجها يضربها، آمرا إياها أن تعيد النظر وتفكر مليا في الأخطاء التي ارتكبتها فأدت به إلى الاستياء منها وضربها،(ص452). وهذا ما حدث لـ "آذين" إحدى طالبات نفيسي التي كانت تتعرض لمختلف أنواع العنف المادي والمعنوي، فقد كان زوجها يضربها مخلفا الكدمات على جسدها، ويهينها بالكلام الجارح، إذ يشبهها بالسيارة المستعملة القديمة التي لن تجد راغبا بها بعد الطلاق، بينما يمكنه هو في أي وقت أن يتزوج امرأة صغيرة طازجة غير مستعملة، إضافة إلى تهديدها بحرمانها من ابنتها التي سيحكم له القضاء بحضانتها،(ص451،474).
محاولات للانعتاق
إن ضروب التقييد السابقة التي لحقت بالمرأة لم تمنعها من محاولة الانعتاق منها، وإعادة النظر في العديد من القضايا التي ربما كانت تبدو من المسلمات بالنسبة إليها، حتى وإن عرضها ذلك للعقاب. فمهشيد المقتنعة بالحجاب والتي كانت تحاول أن تصون معتقدها أمام كل ما يواجهها من أفكار مضادة، تزعزع إيمانها بعد أن أصبح رجال الدين في السلطة، وعبرت في مذكراتها عن انتقادها لرؤسائها في العمل الذين لا ينظرون في عينيها، وعن فرض الحجاب على طفلة في السادسة من عمرها ومنعها من اللعب مع الأولاد، وعلى الرغم من أنها ظلت ملتزمة بحجابها إلا أنها كانت تشعر بالألم لأنها مطالبة بارتدائه، ووصفته بالقناع الذي تجبر المرأة على الاختفاء خلفه،(ص547). وتعبر جدة نفيسي عن استيائها من تحويل الحجاب، الذي هو بمثابة رمز مقدس للعلاقة بينها وبين الله، إلى أداة بيد السلطة التي جعلت من النسوة اللواتي ارتدينه رموزا وشعارات سياسية. فقد أفسد الحجاب(الجادور) المغزى السياسي الذي ألصق به، وأصبحت النساء ترتدينه باستخفاف كبير،(ص176، 321).
وكان الرقص في قاعة المحاضرات تعبيرا صريحا عن رفض القيود التي فرضت على النساء، إذ راحت ساناز بالرغم من ثوبها الأسود الفضفاض وغطاء رأسها، تتمايل على أنغام أغنية راحت نفيسي وطالباتها يدندنها مع التصفيق لتشجيعها، وبدت ساناز وهي ترقص وفي كل خطوة تخطوها، وكأنها تحرر جسدها طبقة إثر طبقة من ثقل القماش الأسود،(ص438-439).
ومثّل التحرر بالحكاية أحد أهم أشكال الانعتاق، فقد ركزت نفيسي في صفها الخاص على هذا الجانب، عبر مناقشتها للأعمال السردية التي تنطوي على حكايات، نتعلم منها ألا نستسلم ونذعن للقيود والحدود المفروضة علينا، فكل حكاية تمنحنا القوة والقدرة على تجاوز قيود الواقع، ولذا فهي تمنحنا الحرية التي يحرمنا الواقع منها، ولذلك كان أول عمل أدبي ناقشته مع طالباتها هو "ألف ليلة وليلة" وحكايات شهرزاد لشهريار، وكان السؤال الأهم الذي تفرضه مناقشة هذا العمل هو: "كيف يمكن لهذه الأعمال الخيالية العظيمة أن تساعدنا وتنير لنا طريقنا كوننا نساء سقطن في شرك من الظروف القاسية؟" في محاولة لإيجاد العلاقة بين الفضاءات المفتوحة التي تمنحها الروايات، والمساحات المغلقة التي تضيق بالنساء،(ص37، 84). وقد عملت تلك الحكايات على تعزيز الثقة بين نفيسي وطالباتها، وجعلتهن يتبادلن الأسرار الشخصية، ويتحدين الواقع القمعي الذي ينتظرهن خارج غرفة المعيشة، وجعلتهن يثأرن لأنفسهن من أولئك الذين استبدوا بحياتهن.
إن الإحساس بالانعتاق الذي أمّنه صف نفيسي لطالباتها هو الذي جعل ميترا تحس بأنها تعلو عن أرض الواقع، تاركة خلفها زنزانتها الرطبة المظلمة التي تحيا فيها، كلما ارتقت سلمة لتصل إلى السطح، فتنعم ببضع سويعات في الشمس والهواء والفضاء المفتوح، وما إن ينتهي الدرس حتى تعود إلى زنزانتها مجددا. وكانت نفيسي تطمح من خلال صفها إلى أبعد من ذلك، وأن يكون الانفصال عن الواقع من أجل العودة إليه بتجدد ونشاط واستعداد تام للمواجهة،(ص101). والإحساس السابق نفسه، أي الانعتاق، هو الذي دفع نسرين إلى الكذب على والدها والتحايل عليه بحجة تطوعها مع مهشيد للقيام بترجمة بعض النصوص الإسلامية إلى اللغة الإنكليزية، من أجل حضور الصف أيضا،(ص34).
وحضرت السخرية من العقلية الذكورية، المتكئة على مرجعية دينية، التي تتحكم بمصير النساء، بوصفها نوعا من الرفض لتلك العقلية وقيمها، مظهرة هشاشتها، ومحاولة الانعتاق منها. فأخو ساناز الذي كان في التاسعة عشر من عمره يحاول إثبات رجولته عن طريق التلصص على أخته ومراقبة تصرفاتها ومكالماتها الهاتفية. ورجال ملتحون يخافون الله لا يتورعون عن التحرش بالفتيات في الحافلات الصغيرة. ولا يقيم عم نسرين التقي الورع حسابا لصلة الدم ويتحرش بها جنسيا، تاركا يداه تمرّان على ساقيها وتفاصيل جسدها بينما يعطيها دروسا في اللغة العربية، ما يجعلها تسخر من النفاق والتظاهر بالتقوى التي يدعيها بعض المسؤولين والناشطين في الجمعيات الإسلامية. (ص32، 50،86-87). كما تسخر أيضا من الرجال الذين يثارون لمجرد النظر إلى مجرد خصلة شعر أو رؤية جزء صغير من المرأة متسائلة بسخرية لاذعة: "أي رجل هذا الذي يُثار جنسيا لمجرد النظر إلى خصلة من خصلات شعري؟ أي رجل هذا الذي يجنّ جنونه لمرأى إصبع من قدم امرأة؟.. يا إلهي!.. إن إ؟صبع قدمي سلاح فتّاك!"،(ص122). وتمضي في سخريتها من هؤلاء الرجال فتقترح أن تبتر أعضاؤهم التناسلية لكبح جماح الشهوة تأثرا بكتابات نوال سعداوي وحديثها عن الختان والعنف ضد النساء لكبح جماح الشهوة لديهن،(ص123).
وحلّ التضامن النسوي بين نساء من مختلف الاتجاهات ليعبر عن رفضهن للنظام الشمولي الذي كبّلهن وصادر حياتهن. إذ نجد فريدة ومينا تقفان على طرفي نقيض حينما يتعلق الأمر بالسياسة، ففريدة ماركسية مخلصة لانتمائها، ومينا ملكية متزمتة، وقد جمعهما معا حقد لا حدود له على النظام الحالي، بالإضافة إلى انضمام نفيسي ذات التوجه العلماني لهما،(ص339).
لقد عمقت الثورة الإيرانية الوعي لدى النساء وجعلتهن أكثر وعيا بمشكلاتهن حتى الشخصية منها. وعلى الرغم من مغادرة نفيسي لإيران في نهاية المطاف إلا أن إيران لم تغادرها إذ ظلت تحمل في ذاكرتها أدق التفاصيل، وتتابع آخر التطورات يحدوها الأمل بالتغيير، وتشعر بالسعادة لرؤية النساء وهن يرتدين إيشاربات زاهية الألوان، وجلابيبهن أقصر بكثير مما كانت عليه، ومساحيق التجميل تظهر على وجوههن، وسيرهن بحرية مع رجال ليسوا بالضرورة من المحارم،(ص569). وهي تتابع ما يجري على الساحة الإيرانية تقول: "أتصفح كتابات الطلبة والشباب ورجال الثورة السابقين، أمر على الشعارات والنداءات المطالبة بالديمقراطية، فأحس بأنني مؤمنة الآن بأن من سيصوغ مستقبلنا هو هذه الرغبة الحقيقية لشباب إيران اليوم"،(ص570).
-نفيسي، آذر: أن تقرأ لوليتا في طهران، سيرة في كتاب، تر: ريم قيس كبة، منشورات الجمل، بغداد-بيروت، ط1، 2009.
-إبراهيم، عبد الله: المطابقة والاختلاف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2004.






