التقنية ضد الديموقراطية
فئة : قراءات في كتب
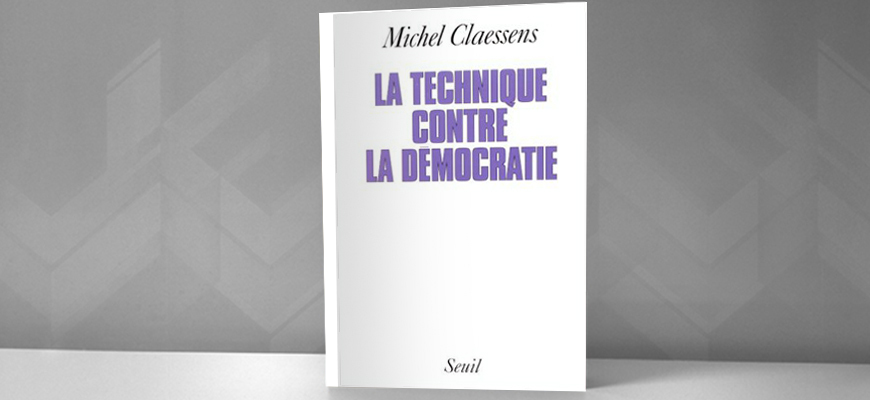
التقنية ضد الديموقراطية
ميشيل كلايسنس، منشورات سوي، باريس 1998، 214 ص.
قد يبدو تاريخ نشر هذا الكتاب قديما إلى حد ما، أو متجاوزا في بعض مضامينه، قياسا إلى ما كتب ونشر من حينه حول الموضوع. لا نتصور أن الأمر كذلك بالمرة، إذ الأفكار الكبرى التي طرحها صاحب الكتاب من حوالي عقد ونصف من الزمن، لا تزال ذات راهنية قوية بالنظر إلى علاقة التكنولوجيا بالمجتمع وبالثقافة بوجه عام، وبالمسألة الديموقراطية على وجه التحديد.
يقول كلايسنس في هذه الجزئية، موضحا أطروحة الكتاب الجوهرية: "لقد سيطر على المواطنين، مع تطور المواد الغذائية المحولة جينيا، وزرع الخلايا ومجتمع الإعلام، سيطر عليهم الانطباع بأنهم باتوا حقيقة بإزاء تطور لا يستطيعون التحكم فيه بالمرة".
ويتابع القول: إنه "على الرغم من الوفرة الضخمة في المعلومات، فإن مجتمعنا أصبح يواجه عطبا عميقا في التواصل على المستوى العلمي، وهو ما يؤدي إلى خصاص كبير فيما يتعلق بالحوار الديموقراطي المرتبط بتطبيقات العلوم وتطور التقنيات، لدرجة تدفعنا لطرح السؤال التالي: هل بات الإنسان حقا في خدمة التقنية؟".
بموازاة ذلك، يرى الكاتب بأن الديموقراطية التشاركية والتقدم التقني اللذين لطالما ارتبطا وتناسقا لحد التماهي، قد باتا اليوم يعيشان حالة انفصال وانفصام، جراء عدم قدرة المجتمعات (أفرادا وجماعات) على مراقبة مخرجات البحث العلمي ومترتبات الإبداع التكنولوجي.
وإذا كان ثمة من جهة تتحمل المسؤولية في ذلك، فإن للعلماء أنفسهم نصيبا كبيرا منها. ويتمثل ذات النصيب، بنظر الكاتب، في تقوقع هؤلاء حول حقولهم المعرفية، وانشغالهم فرادى أو مجموعات، في مشاريع ذاتية دون تنسيق كبير فيما بينهم، وتجاهلهم شبه المطلق للتواصل العمومي، وهو ما يؤدي صوبا إلى تعميق القطيعة بين العلم والمجتمع.
صحيح، يتابع الكاتب، أن للعلماء مطلق الحرية في اختيار المواضيع التي يودون الاشتغال عليها، أو تحديد التجارب التي يراهنون على تفعيلها، لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية الاجتماعية التي يجب عليهم أن يستحضروها عند كل ذلك.
وعلى هذا الأساس، فليس من المبالغة حقا القول بأن كتاب كلايسنس إنما يدفع باتجاه ضرورة إعادة تحديد الإشكاليات الكبرى التي تؤطر العلاقة بين العلم والتقنية والمجتمع، وصياغة "عقد أخلاقي حقيقي" من أجل إحياء المصالحة بين العلم والتقنية من ناحية، والديموقراطية والمجتمع من ناحية ثانية.
ولهذا الاعتبار نرى أن الكتاب، حتى وإن تم تقسيمه منهجيا إلى ثلاثة فصول مستقلة كبرى، فإنها تبرز مع ذلك كمحاور للنقاش متساوقة، لا كطروحات أكاديمية جاهزة، تصب في معين التكريس النظري الجاف لجدلية العلاقة بين التقنية والديموقراطية:
+ في المحور الأول، يقدم الكاتب رأيه في مسألة استقلالية التقنية، ويرى أن هذه الاستقلالية "إنما هي مجرد سراب تدفع به الممارسات ومنهجيات العمل السائدة بعالم البحث العلمي"، إذ لو تسنى للتكنولوجيا أن تحتل مكانة مركزية في ظل المجمع التقنو/علمي السائد، فلأنها (التكنولوجيا)، إنما "تتغذى من عالم العلم وتمنح المهارات التطبيقية للتقنية".
بمعنى أنه إذا كانت التكنولوجيا تقدم نفسها كانصهار عضوي بين العلم والتقنية، فإنها لا تقتصر على ذلك، إذ هي فضلا عنه، علم تطبيقات المعارف العقلانية والتقنية، ومن ثمة الشاهد على الزواج بين المختبر والمصنع.
في الوقت ذاته، فإذا كانت التقنية تسهم حقا في الرفع من منسوب سعادتنا ورفاهنا، فإنها تستوجب منا مقابل ذلك، مجهودا مستمرا في التكيف مع ما تستنبته من مخرجات متجددة، قد تكون في العديد منها، عصية على إدراكاتنا ومتجاوزة لقدراتنا على استبعاد تعقيداتها.
بموازاة ذلك، يلاحظ الكاتب أن هذه التكنولوجيات، إنما تضم من بين ثناياها خزانا ضخما للموارد، لكنه مكمن خطر أيضا، إذ غالبا ما تلجأ إليه السلطات لاستغلال مواصفات المواطنين الذين، يملؤون معين الخزان إياه؛ أي قواعد وبنوك معطياته. بالتالي، فهي أدوات مهمة تمكن السلطات من بلوغ أهدافها السياسية، من خلال ممارسة رقابة حقيقية على المجتمع، ومن ثمة على الديموقراطية (تقنيات التواصل عن بعد، شبكات التجسس، تتبع الأثر من خلال البرامج المعلوماتية...إلخ).
المفارقة هنا، بنظر صاحب الكتاب، أن المجتمع الخاضع لرقابة التقنية، يتحول هو بدوره إلى مختبر للتقنيات، على اعتبار أن هذا الأخير هو مشتل للأحلام والتطلعات والانتظارات، وهو الحال مع ظاهرة الإنترنيت دون شك، لكنه الحال ذاته مع ظاهرتي زرع الخلايا الجينية والبيوتكنولوجيا وما يتفرع عنها مجتمعة.
بالإضافة إلى ذلك، يتابع المؤلف، فإن بعض التكنولوجيات (لا سيما تلك المرتبطة بعلوم الأحياء) لا تحيل فقط على مخاطر تسليع الإنسان من خلال تسليع خلاياه وأعضائه، بل ومن شأنها أيضا الوقوف بوجه المصالحة بين الأبعاد الأخلاقية في إجازة هذه التكنولوجيات، وبين المصالح العلمية والصناعية التي تراهن على تطبيقاتها.
بالتالي، فإن خضوع المجتمع لقانون التطور والتنمية لا يرهن هذا الأخير فحسب، بل يضعه بالتدريج رهن إشارة النقلات التكنولوجية التي تنهل منه فلسفتها وديناميتها. بمعنى، يقول الكاتب، إن "العلم والصناعة اليوم هما اللذان يصيغان القانون، لدرجة باتت قيمنا تحدد في ظل ذلك، وفق معارفنا العلمية والتقنية، كما لو أن مجتمعنا قد نعى إلى الأبد إمكانية الرقابة الديموقراطية على التطورات التقنو/علمية، وقبل بصورة نهائية أن يتكيف مع التقنية لا أن يخضعها لحاجياته وقيمه".
+ بالمحور الثاني، يعتقد الكاتب بأن "تقوية المراقبة على التقنية، إنما يمر عبر تغيير بعض ممارساتها، وذلك في أفق تقريب عالم العلم والتقنية من عالم المجتمع والديموقراطية". وبحكم أن التطور يقع في قلب انشغالات المجتمعات الصناعية، فإنه يرتكز بتحصيل حاصل، على قطبين أساسيين اثنين: البحث العلمي الموجه لإنتاج المعرفة، والتطور التكنولوجي المتمحور حول تحقيق وبلوغ السلطة.
لكن المفارقة هنا، إنما تكمن في أنه خلال دورات التطور التقني، فإن الانطباع السائد هو أن التقنية هي التي تقود تطورها وتحدد حركتها وديناميتها. ومكمن الخطر هنا أن هذه الدورات غالبا ما تشتغل في مشارف مجهول من المتعذر حقا توصيف ملامحه الكبرى، لا سيما في ظل ما يسمى ب"المجازفة التكنولوجية الكبرى"، حيث التباين عميق بين تعقد النظم التقنية وقدرة الإنسان على التحكم فيها.
ومعنى هذا أن البحث العلمي الذي كان موجها منذ القدم لفهم العالم واكتشاف قوانين الطبيعة، وكان يثوي خلفه هواة ومتطوعين، ولم يكن فضلا عن ذلك، مهنة في حد ذاتها، لم يعد كذلك بالمرة اليوم، إذ بات موجها لخدمة الاعتبارات الاقتصادية أو الصناعية أو حتى المجتمعاتية، وأضحى الباحثون عمالا لدى المركبات الصناعية/العسكرية، أو موظفون لدى الدولة. فكان من نتائج وتبعات هذا التحول أن تراجع البحث لفائدة التطبيق، وتم تثمين المهارات والخبرات عوض المعارف والمضامين؛ أي إن العلم قد بات خاضعا لحل المشاكل العملية والعابرة، وتنكر لوظيفته الأولى المتمثلة في التأمل ومحاولة فهم الظواهر الطبيعية والبشرية والكونية وما سواها.
لقد تشظى عالم العلم وتصدع، يقول الكاتب، وبات عبارة عن تقطيعات و"مجموعات بحث"، لكل منها أدواتها ولغتها وفضاؤها المستقل، فبات العلم عبارة عن مجالات بحث مستقلة، منغلقة على نفسها، ولربما متنافسة في ما بين بعضها البعض. هذا الوضع لا يساعد فقط العلماء على الاشتغال في ما بينهم أو التنسيق في ما بين مشاريعهم، بل لا يترك للمستوى السياسي أو للمجتمع سبلا كبيرة لمراقبة المخرجات أو النظر في مدى مطابقتها للحاجيات.
لا بل إن من شأن هذا التشتت أن يفرز إبداعات جديدة واكتشافات غير مسبوقة، قد لا يعلم عنها المجتمع شيئا، وتأخذ السياسيين وهيئات الرقابة والتنظيم و"المجمعات الأخلاقية" على حين غرة، فيضطروا للتحرك بالسرعة القصوى لتأطير هذه الإبداعات أو الاكتشافات، وقد لا ينجحون دائما، بحكم تعذر مواكبة القانون لتطور العلوم والتقنيات.
إن طريقة الاشتغال هاته لا تحرم المجتمع فقط من إمكانيات معرفة وتملك ما تفرزه البحوث والمختبرات، بل تحول أيضا دون سبل مراقبة تطور العلوم والتقنيات. العالم هنا هو الذي من المفروض أن ينصح المجتمع ويتواصل معه حول ما يقوم به أو ما وصل إليه من اكتشافات. إن له في ذلك مسؤولية حقيقية، حتى وإن تخفى خلف الادعاء بأن هذا ليس من اختصاصه، أو خلف القول بأن التطبيقات التي تطال بحوثه لا يجب أن تخضع للمساءلة، إعمالا لقول هايدغر إن "العلم لا يفكر"، أو لقولة دومينيك بيسطر الذي يعتقد بأن "العالم المنشغل بالبحث الصرف، بداخل العلم الصرف، لا مسؤولية عليه: ثمة سياج فاصل بينه كعالم، وبين الاستخدامات التي تخضع لها أعماله".
لكن هذا الاعتقاد يتضمن بعضا من عناصر محدوديته، إذ كيف لعالم يدعي تطوير العلم وتحسين عيش المجتمع، أن ينسب لنفسه الموجب، ولا يتواني في التبرؤ من السالب؟
وعليه، فإن تطلع العلوم والتقنيات لحل المشاكل الكبرى الراهنة، لا بد لها أن تتحمل بالمقابل، واجبات ومسؤوليات ما تقوم به أو ما تفرزه بالمختبرات ومراكز البحوث.
+ أما المحور الثالث، فيتعرض فيه للكاتب لضرورة التركيز على فكرة الرقابة المباشرة على التقنية من لدن المستويات الديموقراطية، وتجنب التمييز بين التقنيات المهمة والتقنيات غير المهمة.
إن المواطنين (سياسيين وخبراء وعلماء) لا يمكنهم، في ظل التسارعات التقنو/علمية الكبرى وتزايد منسوب تعقدها، إلا أن يعترفوا بعدم قدرتهم ليس فقط على استشراف نتائج هذه التسارعات، بل أيضا على مجرد فهمها واستيعاب مضامينها. ولا يمكنهم بالآن ذاته، أن يسهموا في تحديد القرارات المرتبطة بالاختيارات التقنو/علمية، والتي تؤثر على حياتهم، وعلى بقائهم أيضا.
ومع ذلك، فإن الكاتب يلح على أن غياب أو تجاهل بعد التواصل العمومي معهم من شأنه أن يعمق الشرخ القائم من زمن بعيد، بين التقنية والمجتمع والثقافة.
إن جانب التواصل العمومي المقصود هنا، لا يحيل فقط على اعتبارات محددة، من قبيل تقاسم المعرفة أو التفكير في الأخلاقيات والبعد الديموقراطي لعمليات البحث والتطوير، ولكن أيضا على الاعتبار الذي مفاده أن التواصل في حد ذاته هو قيمة أخلاقية وديموقراطية... وإلا فإن المواطن سيضطر لتحميل العلماء، كل العلماء، مسؤولية المشاكل الكبرى التي تهدد حياته وبقاءه.
ومع ذلك، يبقى السؤال معلقا: كيف للمستويات الديموقراطية أن تراقب المجال التقنو/علمي ووفق أية مقاييس؟ وكيف لها أن تعرف مسبقا ما سيتم اكتشافه وتطبيقه؟ وإذا كان هذا الأمر ممكنا من ذي قبل، فكيف له أن يقوم أو يستقيم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم في المكان (شبكات عالمية، تحولات كونية) وفي الزمن (توالي الأجيال)؟
من المتعذر ذلك حقا، يلاحظ الكاتب، لكن الطموح، في أفق مراقبة ديموقراطية للتطورات التقنو/علمية، هو أن تتم ممارسة التقييم الاجتماعي لهذه التطورات لمعرفة ما الذي قد يفيد المجتمع، وما الذي قد يضر به أو يهدد وجوده وبقاءه.
المقاربة هنا مقاربة تطويعية للعلم والتقنية، ومقاربة تواصلية وتربوية في الآن معا، إذ بقدر الأضرار التي قد تحملها المنتجات المحولة جينيا مثلا، بقدر منافعها في محاربة الندرة والجوع.






