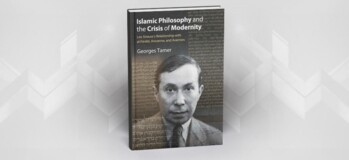الخطاب والإيطيقا في فلسفة ليفناس
فئة : مقالات

يطرح لفناس في كتابه الرئيس "الكلية واللامتناهي"، الأسئلة الإشكالية الآتية: هل بإمكاننا أن نؤسس موضوعية وكونية الفكر على الخطاب؟ أليس الفكر ذاته سابقًا على الخطاب؟ ألا يكون فكر ما، وهو يتحدث، مثيرًا لما قد فكر فيه الآخر قبلًا؛ إذ إن كليهما يسهمان في الأفكار المشتركة؟ غير أن كتلة الفكر، وجب أن تجعل اللغة بوصفها علاقة بين الكائنات مستحيلة، وذلك لأن الخطاب المنسجم واحد؛ حيث يمضي الفكر الكوني بالتواصل، فلا يمكن لعقل أن يكون آخر بالنسبة إلى عقل ما. إذن، كيف يمكن لعقل أن يكون أنا أو آخر، ما دام أن كينونته ذاتها تقوم على العدول عن التفرد؟[1].
يزعم لفناس أن الفكر الأوروبي قد قاوم دائمًا، كنزعة شكية، فكرة كون الإنسان مقياس كل شيء، مع العلم أن هذه الفكرة تحمل فكرة الانفصال الإلحادية، وهي إحدى أسس الخطاب، ويرى بأن الأنا الحاس بالنسبة إليها لا يقدر أن يؤسس العقل، وأن الأنا يتحدد بالعقل.
لن يصير المفكرون المنفصلون عقلانيين، إلا بقدر ما تظهر أفعال تفكيرهم الشخصية والخصوصية كلحظات خطاب وحيد وكوني
لا يتوجه العقل، وهو يتحدث بضمير المتكلم، إلى الآخر؛ فهو يناجي نفسه، وبالمقابل؛ فهو لن يبلغ الشخصية الحقيقية، ولن يجد الطابع السيادي للشخص المستقل، إلا إذا صار كونيًّا. وهكذا، فلن يصير المفكرون المنفصلون عقلانيين، إلا بقدر ما تظهر أفعال تفكيرهم الشخصية والخصوصية كلحظات خطاب وحيد وكوني، كما لن يكون هناك عقل في الفرد المفكر، إلا بقدر ما يلج هو ذاته في خطابه الخاص؛ حيث إن الفكر، بالمعنى الإيتيمولوجي للكلمة، يفهم المفكر، من حيث إنه سيشتمل عليه[2].
غير أن جعل المفكر لحظة من الفكر، معناه الحد من انسجام الوظيفة الإيحائية للغة، والذي يترجم انسجام المفاهيم؛ ففي هذا الانسجام يحلق الأنا الوحيد للمفكر، وهكذا ستعود وظيفة اللغة إلى إلغاء (الآخر)، لتقطع مع هذا الانسجام، وبذلك عينه، تكون أساسًا لا عقلانية، إنها نتائج غريبة؛ إذ تتوخى اللغة إلغاء الآخر، بجعله مطابقًا للمماثل! والحال، أن اللغة في وظيفتها التعبيرية، تحافظ على الآخر الذي تخاطبه، تحديدًا، وتناديه أو تستدعيه.
من المؤكد؛ أن اللغة لا تقوم باستدعائه ككائن متمثّل ومفكر فيه، لهذا؛ فإن اللغة تبني علاقة لا تقبل الإرجاع إلى علاقة الذات- الموضوع (وحي الآخر)؛ ففي هذا الوحي، يمكن للغة كنسق للعلامات، فقط، أن تتأسس. ليس الآخر المنادى ممتثَلا، وليس هو معطى، ولا هو خاص، من خلال جانب ممنوح للتعميم سلفًا؛ إذ إن اللغة، بعيدًا عن افتراض الكونية والعمومية، تصير ممكنًا فقط.
تفترض اللغة وجود المتحاورين، والتعدد أيضًا، ولا تفاوضهم تقديمًا لبعضهم البعض، أو للمساهمة في الكونية، على الصعيد المشترك للغة؛ إذ إن تفاوضهم، كما نعبر عنه في الحين، "حسب لفناس": هو إيطيقي[3].
يحافظ أفلاطون على الفرق بين النظام الموضوعي للحقيقة؛ هذا الذي ينبني من غير شك في الكتابات، بكيفية لا شخصية، وبين العقل في كائن حي "خطاب حي وحيوي": "خطاب قادر على الدفاع عن نفسه، وله معرفة بهؤلاء الذين يجب أن يخاطبهم، أو الذين يجب أن يلتزم الصمت تجاههم"[4].
إذن؛ هو خطاب ليس سياقًا لمنطق داخلي مصطنع سلفًا؛ بل تأسيسًا للحقيقة داخل صراع ما بين المفكرين، مع مواجهة كل مخاطر الحرية، وتفترض رابطة اللغة التعالي، والانفصال الجذري، وغرابة المتحاورين، وانكشاف وحي الآخر لذاتي، بعبارة أخرى، تتحدث اللغة هناك؛ حيث تفتقد الرابطة ما بين حدود العلاقة، هناك، حيث يجب أن يتأسس الصعيد المشترك فقط. يؤكد لفناس أن اللغة تتموضع في هذا التعالي؛ فهكذا يكون الخطاب تجربة تعبر عن شيء ما غريب تمامًا، (معرفة) أو (تجربة) محضة، صدمة الدهشة.
وحده الغريب تمامًا يمكنه أن يهذبنا، لا يوجد سوى الإنسان الذي يقدر أن يجعلني غريبًا تمامًا، ومعاندًا لكل نمط، ولكل نوع، ولكل طبيعة شخصية، ولكل تصنيف، وبالتالي، حدا لـ"معرفة" تلج في النهاية إلى ما وراء الموضوع، إنها غرائبية الغير، هي حريته عينها!. وحدها الكائنات الحرة، بإمكانها أن تكون غريبة عن بعضها البعض.
إن الحرية التي هي (مشتركة) لديهم، هي بالضبط من يفرقهم، وتقوم (المعرفة المحضة)، اللغة، في العلاقة مع كائن ما، والذي هو بمعنى من المعاني؛ ليس على صلة بذاتي؛ أو، بالأحرى، ليس على صلة بذاتي إلا بقدر ما يكون بشكل تام على صلة بذاته (καθ’αυτο)؛ أي مع كائن يتموضع فيما وراء كل صفة، وبالتالي، يجب بالضبط أن يصنفها؛ أي أن يرجعها إلى ما يكون، بالنسبة له، مشتركًا مع كائنات أخرى، مع كائن هو، بالتالي، عار تمامًا[5].
يرى لفناس؛ أن الأشياء لا تكون عارية، سوى من خلال المجاز، حينما تكون مجردة عن الزخرفة: الحيطان العارية، والمناظر العارية لا تحتاج إلى زخرفة، عندما تتلاشى داخل اكتمال الوظيفة التي لأجلها قد صنعت، فعندما تخضع بطريقة جذرية لغايتها الخاصة؛ فإنها تختفي فيها، فهي تختفي تحت الشكل. إدراك الأشياء الفردية؛ هو أمر يدل على أنها لا تتلاشى كليًّا؛ إنها تبرز، إذن، لذاتها، فتحدث ثقبًا في أشكالها، فلا تقبل الانحلال في علاقات تربطها بالكلية، وهي دائمًا، من خلال بعض الجوانب، تشبه تلك المدن الصناعية؛ حيث إن الكل يتكيف مع هدف إنتاجي ما، لكنها، وهي مفعمة بالأدخنة، وبقايا المتلاشيات والحزن، وما تزال توجد من أجل ذاتها.
إن العري، بالنسبة إلى شيء ما، هو؛ فائض كينونته المضاف لغايته، فهي عبثيته، لا جدواه، والتي لا تظهر بذاتها إلا بالنسبة للشكل الذي تبث فيه، والذي ينقصها، هو ذلك الشيء، دائمًا، غموض، ومقاومة، وقبح ما. وبالتالي؛ فإن التصور الأفلاطوني، الذي بحسبه تتخذ الشمس المشرقة مكانها خارج العين التي ترى، والموضوع الذي تضيئه، يصف بدقة إدراك الأشياء، وليس للموضوعات نور خاص؛ فهي تتلقى نورًا مستعارًا.
يدخل الجمال حينها غائية جديدة، غائية جوانية، في هذا العالم العاري. إن الكشف بالعلم وبالفن، هو أساسًا إضفاء الدلالة على العناصر، وتجاوز الإدراك، وهو كشف عن شيء ما، معناه إضاءته بواسطة الصورة؛ أي إيجاد موضع له داخل الكل بإدراك وظيفته أو جماله.
تفترض اللغة وجود المتحاورين، والتعدد أيضًا، ولا تفاوضهم تقديمًا لبعضهم البعض، أو للمساهمة في الكونية، على الصعيد المشترك للغة
يستنتج لفناس؛ أن عمل اللغة شيء آخر؛ إذ تقوم على الدخول في علاقة مع عري متجرد من كل شكل، لكن له معنى بذاته عينها (καθ’αυτο)؛ وهو دال قبل أن نسلط عليه الضوء، فلا يظهر بوصفه متجردًا (من المعنى) ضمن ازدواجية قيم متناقضة؛ (كالخير والشر، والجمال والقبح)؛ بل كقيمة إيجابية دائمًا، وعريّ كهذا هو الوجه، وليس عري الوجه؛ هو ما يمنح لذاتي لأني كشفت عنه، والذي يكون، بهذا الأمر، ممنوحًا لي أنا، ولسلطتي، ولعينيَّ، ولإدراكي، في نور خارجي عنه؛ حيث يستدير الوجه تجاهي، ذاك هو عريه بعينه، فهو يكون بذاته، وليس بالإحالة إلى نسق ما[6].
من المؤكد؛ أن العري يمكن أن يكون له معنى ثالثًا، أيضًا، خارج لا معقولية الشيء الفاقد لنسقه، أو أن له دلالة وجه تخترق كل شكل: هو عري الجسد المحسوس في الحياء، وهو ظاهر للغير في النفور والرغبة، وهو وحده كائن عار بوجهه تمامًا، وقادر أيضًا على أن يتعرى من غير حياء.
غير أن لفناس، يرى أن الفرق ما بين عري الوجه الذي يستدير تجاه الأنا، وبين الكشف المستضيء بشكله، لا يفصل ببساطة بين نمطي المعرفة"، فالعلاقة مع الوجه ليست معرفة للموضوع، وتعالي الوجه، هو في الآن ذاته؛ غيابه عن هذا العالم، الذي يدخل فيه، واغتراب كائن ما، وشرط غربته، تعريه أو تصعلكه.
الغرابة التي هي حرية، هي كذلك؛ الغرابة البئيسة، وتمثل الحرية مثالًا آخر للمماثل؛ الذي هو دائمًا مستقرٌّ في الكينونة، ويحظى دائمًا بإقامته.
الآخر الحرّ؛ هو كذلك الغريب، عري وجه يمتد داخل عري الجسد، الذي يعاني من البرد، والذي يشعر بعار عريه؛ فالوجود (καθ’αυτο) في العالم بؤس، إذن، ثمة صلة بيني أنا وبين الآخر فيما وراء البلاغة.
هذه النظرة التي تتضرع وتطلب، والتي لا يمكن أن تتضرع إلا لأنها تطلب، محرومة من كل شيء؛ لأن لها الحق في كل شيء، وهي التي تعرف بالعطاء، كما لو أننا "نهب للعطاء الأشياء المستفهم عنها"، هذه النظرة هي ظهور الوجه بوصفه وجهًا، فعري الوجه فاقة؛ إذ إن الاعتراف بالغير؛ هو اعتراف بالجوع، والاعتراف بالغير؛ هو عطاء، إلا أنه عطاء للسيد وللمولى؛ لذلك الذي نعامله كـ (أنتم) في بعد العلو[7].
في هذا الحلم، يكون العالم المملوك لذاتي، كعالم ممنوح للمتعة، ومرئيّ من وجهة نظر مستقلة عن الموقف الأناني. إن (الهدف) ليس مجرد موضوع لتأمل هادئ، أو بالأحرى؛ إن التأمل الهادئ يتحدد بالعطاء، وبإلغاء الملكية الغير قابلة للمصادرة، وحضور الآخر يعادل وضع غبطة تملكي للعالم موضع مساءلة، وهو ما يعني، حسب لفناس: أن مفهمة الحسي تستند، سلفًا، على هذه القطيعة في اللحم الحي لجوهري ولبيتي، وفي انسجامي مع الغير، الذي يهيئ نزول الأشياء إلى درجة التجارة الممكنة، هذه التعرية الأولية تشترط التعميم الأخير عبر المال، فالمفهمة: هي التعميم (La généralisation) الأول، وهي شرط الموضوعية، وتتطابق الموضوعية مع إلغاء الملكية الغير القابلة للمصادرة، وهو ما يفرض ظهور الآخر. ومشكل التعميم كله يطرح هكذا، كمشكل للموضوعية، مشكل الفكرة العامة والمجردة لا يمكن أن يفترض الموضوعية بوصفها مبنية؛ فالموضوع العام ليس موضوعًا حسيًّا؛ بل هو، فقط، مفكر فيه بقصدية العمومية والأمثلة، ذلك أن نقد النزعة الاسمية للفكرة العامة والمجردة، لم يتم، فيما يرى لفناس، تجاوزه، ورغم ذلك، ما زال من الواجب قول ما تعنيه قصدية الأمثلة (Idealité)، والعمومية (Généralité)، "الانتقال من الإدراك إلى المفهوم، ينتمي إلى تأسيس موضوعية الموضوع المدرك".
لا يجب أن نتحدث عن قصدية أمثلة تغطي الإدراك، والتي من خلالها يتطابق كائن الذات المنعزل مع المماثل، ويتجه إلى العالم مُعْليًا للأفكار؛ فعمومية الموضوع ملازمة لحِلم الذات المتجهة نحو الغير، فيما وراء المتعة الأنانية والمنعزلة، وهي تتشظى، إذن، في الملكية الخاصة للمتعة، وفي تجمع خيرات هذا العالم[8].
إذن؛ فالاعتراف بالغير هو مقابلته، عبر عالم الأشياء المملوكة، لكنه، في الآن عينه، تأسيس للمجتمع والكونية بالعطاء.
إن اللغة كونية؛ لأنها العبور عينه للفرداني نحو العام، ولأنها تمنح أشياء نمتلكها للغير. والتكلم؛ هو إرجاع العالم مشتركًا، وخلق أمكنة مشتركة، لا تحيل اللغة قط إلى عمومية المفاهيم؛ بل هي تصير قواعد التملك مشتركة، وتلغي ملكية المتعة غير القابلة للمصادرة، والعالم ليس في الخطاب؛ هو ما يكون في الانفصال، ما عندي أو كل ما هو معطى لي، إنه ما أمنحه أنا، القابل للإبلاغ (Le communicable)، المفكر فيه، الكوني.
إذن، ليس الخطاب مواجهة مرضية بين كائنين، بتغييب الأشياء والآخرين، وليس الخطاب حبًّا، وتعالي الغير الذي هو رفعته، علوه، سيادته، يشمل بمعناه العيني؛ بؤسه، وتشرده، وحقه كغريب، إنها نظرة الغريب، والأرملة واليتيم، والتي لا أقدر الاعتراف بها إلا بالعطاء أو بالامتناع، فأنا حر في أن أعطي، وأن أمتنع عن العطاء، غير أنه لا بد من المرور من خلال تدخل الأشياء. والأشياء ليست، دائمًا، كما هي عند هيدغر، أساس المكان، وجوهر كل العلاقات التي تؤسس حضورنا في العالم (وتحت السماء، برفقة البشر، وفي انتظار الآلهة).
يخلص لفناس في نهاية تحليله، إلى الفكرة الآتية، والتي من خلالها تعد الإيطيقا هي فلسفة أولى، بما هي فلسفة للوجه والعطاء، وهي: أن صلة المماثل مع الآخر، واستضافته له، وهي الواقعة الأخيرة، والتي تحدث الأشياء فيها ليس كما نبنيها؛ بل كما نمنحها أو نعطيها[9].
[1]- Emmanuel Lévinas. Totalité et Infini: Essai sur l’éxtériorité. Martinus Nijhof. 1971. P 69.
[2]- Ibid; p70.
[3]- Ibid; p70.
[4]- Phèdre; 276 a.
[5]- lévinas; p71.
[6]- Ibid; p71.
[7]- Ibid; p73.
[8]- Ibid; p74.
[9]- Ibid; p75.