السميائيات وتأويل النص الديني
فئة : مقالات
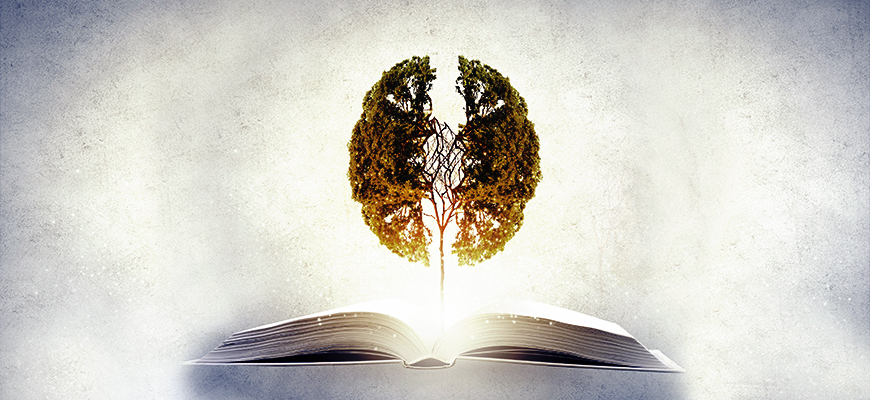
السميائيات وتأويل النص الديني*
تُعنى السميائيات بتحليل الخطاب بمفهومه الواسع، ما يشمل مجموع منتجات السلوك الإنساني ويُصَنف ضمن المضاف الثقافي في حياة الناس، يدخل ضمن ذلك النصوص بكل أنواعها والمفاهيم المعزولة والأحكام المسبقة ومرويات التاريخ وما نسجته الذاكرة الفردية والجماعية من حِكَم وأمثال وأقوال مأثورة، وبما فيها أيضا أشكال العمران وحالات العيش والطقوس الاجتماعية. فهؤلاء يُسَرِّبون أحلامَهم وآلامَهم إلى وقائع من طبائع شتى تُعشش فيها مجمل التمثلات التي تُعد الأساس الذي يقوم عليه جزء كبير من مضمون الأخلاق والسياسة والإيديولوجيا والدين.
لقد كانت عودة السميائيات إلى العلامة ذاتها، أي إلى التجربة الرمزية، مدخلاً مركزياً من أجل التعرف على هوية الإنسان باعتباره كائناً يأتي إلى العالم من خلال ممكنات اللغة في المقام الأول، فداخلها يولد وداخلها ينمو ويضمحل، وهو من يُضَمِّنها رؤاه لهذا العالم أيضاً. إنه يعي ذاته ويعي عالمه وفق آليات التقطيع المفهومي فيها، ما يشمل المظاهر والأبعاد والخصائص والنوعيات. وهي صيغة أخرى للقول، إنّ الوقائع الفعلية لا تتم في عراءٍ أو داخل فضاء غُفل، بل هي طبقات دلالية من طبيعة تراتبية لا تكشف عن جوهر الأشياء، بل تغطي على بعضها بعضاً في الكثير من الحالات.
وذاك هو المبدأ الذي استندت إليه مجمل التعريفات التي حاولت تحديد جوهر اللسان ونمط اشتغاله وطريقته في إنتاج الدلالة والتنويع من تجلياتها. ومن هذا المبدأ انطلقت كلُّ التصورات النظرية القديمة والحديثة حول اللسان، وهو الإرث المعرفي ذاتُه الذي تبنته السميائيات ووسعت من مجالات تطبيقه. إنّ اللسان في كل هذه التقاليد ليس مدونة، أي مجرد تتابع عرضي لكلمات الغاية منها تقديم غطاء لما يَمْثُل حافياً في الطبيعة. إنه، على العكس من ذلك، يقدم وجوداً جديداً تكتسب داخله الأشياء والكائنات ذاكرة تنزاح بها عن إحالاتها على واقع مادي محدود في الشكل والدلالة. وهي طريقة رمزية استطاع من خلالها الإنسان أن يوسع من حجم الوجود ويملأه بدلالات، هو ما يتداوله الناس حقاً، وهو أساس تصوراتهم للمتعة والألم والحياة والموت. إنّ اللغة تَخْلق وتُحيي وتُميت ما تشاء من الكائنات والأشياء.
وهو ما يعني أنّ العلامة هي في المقام الأول أداة رمزية موجهة لتنظيم تجربة فعلية لا أفق لها خارج اللغة. إنها دال يحيل على مدلول في انفصال عما تقوم اللغة بتمثيله. أو هي ماثول مرتبط بموضوع استناداً إلى صيغة رمزية هي ما يجعل الإحالة قابلة للاستمرار في الذاكرة بعيداً عن قاعدة التمثيل المباشر. إنّ العلامة، في الحالتين معاً، لا تقوم بالكشف عن موضوعها من خلال تقديم نسخة موازية له هي صورة لما يمكن أن يدركه المتلقي، بل تُعيد صياغته ضمن سيرورات الرمز. يتعلق الأمر بمعنى الأشياء في اللغة لا الأشياء ذاتها. ذلك أنّ التمثيل الرمزي ليس استنساخاً حرفياً لعالم، بل هو في الأصل تقليص لكل أشكال الحشو والتعدد والتنوع للاحتفاظ بما يمكن أن يشكل صورة ذهنية عامة تستوعب كل النسخ الممكنة.
استناداً إلى ذلك لا يَنْتُج عن التمثيل الرمزي (بكل أسناده) معنى حرفي يمكننا من تَبَيُّن وجودنا في عالم بلا ذاكرة، بل يمكننا ذلك من إدراج هذا العالم كلَّه ضمن تجربة إنسانية متعددة الأبعاد والواجهات. وهي طريقة أخرى للقول إننا لا نعين ولا نسمي، بل نُنْتِج معانيَ مرتبطة بسياقات لا حول ولا قوة للأشياء داخلها عدا أنها مثيرات يُعاد تعريف الكون من خلالها ضمن علاقات مستحدثة في الذاكرة الثقافية، لا في الوجود الطبيعي: ما علاقة الصراحة أو الوقاحة أو الفضيحة بالشمس، وما علاقة الحرير بالنعومة والحليب بالصفاء: فهذه ليست سوى ما يمكن أن ينتج عن "إحساس يُعدّ وعياً بمقاومة دالة على ذات منفصلة عن محيطها"[1] بتعبير بورس، أي ما يطلق عليه الفينومينولوجيون "الاصطدام" بكونه هو الدليل على أننا موجودون في العالم من خلال انفصالنا عنه.
ومن هذه الزاوية وجب النظر إلى التأويل باعتباره جزءاً من التسمية والوصف والتعيين. ذلك أنّ التمثيل ليس نقلاً أميناً، بل هو ذاته صيغة تأويلية لما وقع فعلاً (لحادث). لذلك يتحدد دور العلامة في تخليص العين مما يشدها إلى أفق محاصر بأشياء وكائنات وظواهر، لكي يفتح أمامها أفقاً لمعانٍ تنتشر في كل الاتجاهات. وذاك هو المبدأ الذي يؤكده بورس حين يعتبر العلامة "شيئاً تفيد معرفتُه معرفةَ شيء آخر"[2]. فهذا معناه أننا لا نكتفي بإنتاج ما يمكننا من تعقل محيطنا، بل نطلق العنان لسيرورة تدليلية تتم داخل النص الثقافي بممكناته وإكراهاته. وسيكون مصدر جزء من هذه الدلالات هو الذات التي تَعْرِض أفقها على أفق نصي لا يمكن أن يوجد خارج من يحتضنه. ذلك أنّ "الأنا التي تأتي إلى النص هي ذاتها مزيج من النصوص"، كما كان يقول بارث[3].
وعلى هذا الأساس، لن يكون "خلاصنا" في العودة إلى ما يمكن أن تكشف عنه الوقائع من "حقائق" تستقر عليها العين، بل مصدره قدرتنا على الإمساك بالتعدد فيها استناداً إلى ما تقوله اللغة عنها. فالـمَعنى موجود في اللغة لا خارجها، فهي "نسق يوضح نفسه بنفسه" بتعبير إيكو[4]. وتلك هي طبيعة اللغة وتلك طريقتها في تمثيل العالم، إنّ التعدد الدلالي الذي يحكم تعيين العالم هو القاعدة، أمّا وحدانية المعنى فاستثناء عرضي، أو إحالة على أكثر المناطق ضحالة في الذات الإنسانية، أو على وجود موحش يشكو من خصاص في الدفء الإنساني.
تُعدّ هذه المبادئ في شموليتها محددات مركزية استندت إليها السميائيات بهدف صياغة تصوراتها حول قراءة النصوص والبحث في ما يمكن أن تقوله أو تغطي عليه، أي ما يُصنف ضمن التأويل، وهو نشاط معرفي انحازت إليه السميائيات واعتبرته منطلقاً مركزياً لتحديد معنى أو معاني الوقائع التي تسائلها. فهذا النشاط ليس شيئاً آخر سوى "صب تعبير في تعبير آخر"[5]، كما كان يقول بورس، فنحن لا نراكم المعاني في الفضاء السلوكي الخام، بل نفعل ذلك من خلال الوسائط الرمزية التي تبلورت داخلها كل أشكال هذا السلوك. بعبارة أخرى، إننا نبني سياقات هي أساس المعاني وهي ما يمنحها أشكال تحققاتها.
وهي صيغة أخرى للقول، إننا لا نستمد المعاني من أنفسنا، بل نستوحيها من بناء الوقائع ذاتها، فهذا البناء هو الذي يهدينا إلى ما تُفرزه القراءة أو توحي به. فلا شيء يُستعار من خارج ما يقوم التمثيل الرمزي بالكشف عنه، أي ما يُصَنِّفه السميائيون، وصنفه الهرموسيون قبلهم، ضمن سيرورات التدلال التي تبحث عن معاني الوقائع في ما اختفى في تفاصيل الموصوف في اللفظ، أو في ما استوطن وقائع المعيش اليومي، أو أُعيدت صياغتُه في العين استنادا إلى نمط التمثيل البصري فيها. ذلك أنّ الجسد "الحاس" ذاته يملك ذاكرة، فهو مستودع لانفعالات هي أصل الأهواء التي تَعْلَق بالأحكام التي يُصدرها الناس.
ومع ذلك، فإنّ التأويل ليس ممارسة حرة لا تكترث لإكراهات المنطوق الحرفي. ذلك أنّ المعنى في النص ليس طاقة حدسية، بل هو إفراز لترابطات قائمة بين مكونات ثلاثة هي أساس مجمل التنويعات التي تلحق وجوده وتلقيه، ما يعود إلى الحاضن الثقافي العام، ما يسميه إيكو الموسوعة، تلك الذاكرة العامة التي يمتح منها الناس قدراً كبيراً من أحكامهم ومواقفهم، أي مجموع ما تراكم من خبرات ومعارف مشتركة؛ وما يأتي به قارئ تحركه الرغبة في "الفهم"، فهم ذاته من خلال فهم النص. إنه لا يكتفي بالتعرف على ما هو مُثبت في بنية مستقلة بمعناها ومبناها، بل يأتي بمعان إضافية هي جزء من محيط مشترك بينه وبين عوالم النص.
بعبارة أخرى، إنه ليس مجرد محفل يقرأ، بل هو في الجوهر سؤال يضعه الوعي الثقافي على النص، أو هو أفق لا يمكن، في عُرْف الهرموسية الفلسفية مثلاً، أن يتحقق إلا في مواجهته بأفق آخر هو ما تقترحه عوالم النص صراحة أو توحي به. وهو ما يعني أنّ القول ليس غُفلاً، ولن يكون الـمَقول مجرد كَمَّ خَبَري محايد، فمصدر الفائض من المعنى مستمد من هذا وذاك في الوقت ذاته ضمن سياقات ثقافية هي ذاكرة النص وممكنات تأويله.
وبهذا الترابط لن يكون سبيلنا إلى حقائق "الواقع" هو ما تصطدم به حواسنا، بل يمر عبر سلسلة من "الوسائط" هي ما يشكل جسراً ضرورياً بين ما يُبنى في "الرمز"، وبين ما يحيل أو يوهم بحقيقة عينية لا أحد يشكك فيها. وهي صيغة أخرى للقول إنّ مآل العلامات هو الفعل ولا شيء غيره، ففي الممارسة وحدها تنحل العلامات لتصبح عادة، بتعبير ش. س . بورس[6]. ومن هذه العادة تنبثق أشكال سلوكية جديدة تودع في المفاهيم ومن خلالها تتعمم.
والحاصل أنّ التداول في أمر النصوص لا يمكن أن يتم في انفصال عن السيرورة الثقافية التي يتشكل داخلها المعنى ويصبح "قادراً على التدليل"، بتعبير كريماص، إنها وحدها قابلة للتحديد، ومن خلالها يتحدد حجم المعنى في النص، فهي مستودع الحياة وبؤرتها، وشكل من أشكال وجودها المجرد في الذاكرة. يتعلق الأمر بخطاطات الفعل في الذهن قبل أن يصبح واقعاً، وبما يَبْنيه المتخيل ويحتفي به الناس باعتباره حقيقة لا أحد يشكك فيها. وفي جميع الحالات، فإنّ الأساسي في النص ليس الكم المعنوي الموضوع للتداول، بل النسق الذي يبرره ومن خلاله تتحدد المسارات التأويلية الممكنة والمستبعدة أيضاً. أي إمكانية استثمار الطاقات الدلالية في الحيز الزمني الفضائي الحاضن للفعل الإنساني.
يصدق هذا على كل النصوص، بما فيها النصوص الدينية التي يُقال إنها تشتمل على معنى أصلي أودعته هناك ذات إلهية لا أحد منا يُدرك سرها. وهذا ما كشفت عنه كل المحاولات التي كانت ترغب في استعادة زمنية ولت لا شاهد عليها سوى المعاني التي تضمنتها نصوص تَضِن في الغالب بأسرارها. يدخل ضمن ذلك ما قام به الفيلولوجيون والهرموسيون القدامى وهم يبحثون عن النص الهوميري الأصلي في الإسكندرية وبيرغام، مروراً بترجمة النصوص المقدّسة وملاءمتها مع محيطاته الجديدة (الفولغات وغيرها من الكتابات التي هاجرت من نصها الأصلي لتسكن لغات جديدة)، وانتهاء بالهرموسية الرومانسية التي اعتقدت في وجود معنى أصلي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال نشاط تأويلي يقود إلى وضع اليد على ما كان يوده المؤلف ويفكر فيه.
واستناداً إلى هذا المبدأ أيضاً تحدث الناس في التقليد المسيحي عن المعاني الأربعة للكتابة المقدّسة. فالنص الديني يتشكل في تصور هذا التقليد من تراتبية دلالية تقود من معنى حرفي، أي ما تقوله الكلمات بشكل مباشر، إلى معنى مجازي يتمحور حول ألوهية وإنسانية السيد المسيح (الإيمان)، ثم إلى معنى أخلاقي هو الذي يعلمنا كيف نتصرف في الحياة ونتبع سلوكاً يرضي الله ويرضينا (السلوك)، لكي يستقر في النهاية على معنى باطني يشير إلى ما يجب أن نأمله ونترجاه من الله (الغاية من الوجود).
فهذه النصوص يمكن أن تسلم لقارئها استناداً، إلى طبيعة اللغة وحدها، معانيَ ليست مرئية من خلال العلاقات الموصوفة بشكل مباشر في النص، إذ لا وجود لوحدة من وحدات اللسان يُمكن أن تشتمل على طاقة تعيينية خالصة، ذلك أنّ جزءاً كبيراً من دلالاتها هو من المضاف الإيحائي، ووحدها السياقات المقامية والثقافية قادرة على تحديد طبيعته ومداه. وعلى هذا الأساس، فإنّ الفجوة الفاصلة بين قارئ يأتي إلى النص محملاً بأحكام وتصنيفات ثقافية متنوعة، وبين نص يحتوي، بطبيعته، على الضمني والاستعاري والموحى به، هو ما يحدد الآليات الأساسية لسيرورات التأويل التي تثيرها القراءات المتعددة.
بعبارة أخرى، هناك بالإضافة إلى قصد النص، وهي حقيقة لا يمكن التغاضي عنها، مقاصد أخرى لا يمكن لمضمراته أن تستقيم بدونها. فالنص يتضمن، بحكم إكراهات البناء الفني، استراتيجية تأويلية تستوعب القارئ ضمن فرضياتها، ذلك أنّ عمليات البناء تُسقط، بضرورة "النقص التمثيلي" ذاته، توجيهات تأويلية هي الأساس الذي تقوم عليه حالات استقبال النص، ما كان يسميه أصحاب جماليات التلقي "اللاتحديد" أو "البياض"؛ ومعنى ذلك أنّ النص يولد في أحضان القارئ، "والعلامة توكل للمؤول مهمة الإتيان ببعض من معانيها"[7]. وفي جميع هذه الحالات لم يعد قصد المؤلف مجدياً في البحث عن دلالات النص، فوحده التفاعل بين النص والقارئ يمكن أن يقود إلى التعرف على المعاني وتنويع تجلياتها في النفس.
وهي صيغة أخرى للقول إنّ تدبر أمر النصوص لا يقود إلى استنباط قاعدة من نص خالص، فهذا يفترض أنّ النص مكتفٍ بذاته وقادر على التدليل استناداً إلى مخزون دلالي مفصول عن الكلمات. إنّ الذي يؤول لا يستعيد نسخة، بل يصب النص الأول في لغة موازية تُعدّ في نظره معادلاً كليّاً للنص الموضوع للتأويل. وهذا أمر منافٍ لطبيعة المعنى وترفضه اللغة، فهي لا تشتمل على مرادفات، بل تنتظم ضمن سياقات قد تتشابه في الجذر الدلالي، ولكنها تنزاح عنها من خلال مضافات دلالية تخصص أو تعمم أو تدقق. فالكلمة التي تشرح ترسم حقلاً دلالياً، ولكنها لا يمكن أن تكون موازية في المعنى لتلك التي تحلّ محلها.
فأن يكون المعنى في النص وحده معناه أنّ السلف لم يتركوا لنا نحن الخلف شيئاً يمكن أن نقوله عن نصوص لم تُسَلم لحد الآن سوى جزء بسيط من أسرارها. وهذا ما يؤكده تاريخ تلقي النصوص. فالنص في جوهره مبني لكي يكون جزءاً من الموسوعة التي أفرزته، ولكنه منفتح لكي يكون قادراً على استيعاب الكثير من المعاني التي ستحتضن حالات تلقيه استقبالاً، بما فيها تلك التي لا يتضمنها قصده الأول، "هناك دائماً حالة توسط بين ما قاله المؤلف وبين ما كان يود قوله"[8]. وجزء كبير من هذا التوسط مبني استناداً إلى المشترك الإنساني الكوني الذي يوحد بين سكان الكوكب الأرضي في تصوراتهم للحياة والموت وتدبير شؤون انفعالات موزعة على صالح وطالح ورغبة وطرق في إدراك أبعاد الكون وألوانه وأشكاله. ما يشبه "آدم البهيمي"[9] الذي ننحدر منه جميعاً، حقيقة أو مجازاً.
والحاصل أنّ قراءة النص قد تكون غايتها هي تلك القاعدة السلوكية أو ذاك الحكم المقاصدي، ولكنها لا يمكن أن تتم دون استحضار موقف مسبق هو حاصل تربية وتثقيف وانتماء. قد يتعلق الأمر بتبرير لسلوك في حاجة إلى غطاء ثقافي، أو هي محاولة لاستنباط حكم راسخ في النفس، قبل أن تؤكده النصوص. وهو ما تكشف عنه الأحكام المتنوعة، بل والمتناقضة أحياناً، فالنص الديني الواحد يسلم مواقف يطبعها التشدد والتعصب، والاعتدال والتسامح في الوقت ذاته. إنّ الذي يحرم ويحلل لا يفعل ذلك دائماً استناداً إلى ما يقوله النص، بل يفعل ذلك انطلاقاً من قناعاته وموقفه من نفسه ومن الآخرين. بعبارة أخرى، إنّ التشدد والاعتدال ليسا في النص، بل هما في نفس المتشدد أو المعتدل.
ويمكن أن نقدم في هذا السياق مثالين على نوعين من الوقائع الدينية: ما له علاقة بالنصوص التي تداول في شأنها الأصوليون من أجل استنباط أحكام وقواعد للفعل، وما له علاقة بالنصوص ذات الطابع القصصي. إنّ الأمر في هذا السياق يتجاوز ما يُصنف ضمن المحكم وما يعود إلى المتشابه، لأننا في الحالتين معاً في حاجة إلى استحضار قصد آخر يستوعب "إشارات" أو "دلالات" أو "اقتضاء" يقود إلى تنشيط ذاكرة النص لتجاوز العبارة، أي المعنى الحرفي (المقصود أصالة)، لكي نبحث في سياقات مصاحبة أو ملازمة للعبارة دون أن تكون جزءاً منها.
في ما يتعلق بالحالة الأولى تُعدّ التصنيفات الدلالية التي قدمها الأصوليون دالة في هذا المجال. فالنص الشرعي يدل من خلال عبارته، أو إشارته أو دلالته، أو اقتضائه. وفي كل حالة من هذه الحالات يسلم النص مدلولاً يتجاوز المرئي في الملفوظ بشكل مباشر. مع إمكانية الاستقرار على المعنى الأول، باعتباره المعنى الأصل، في حالة تعارضه مع ما يأتي من سياقاته. هناك فصل ضمني بين قصد الله، وبين قصد اللغة أو قصد المؤول، حتى وإن كان الثاني يُبنى استناداً إلى ما يقترحه الأول، بالإيحاء أو التضمين، أو بحكم حالات الإثبات أو النفي المصاحبة لكل معرفة.
وهو ما يعني وجود تفاوت صريح بين المنطوق المباشر، وبين ما يمكن أن يتسرب إليه من دلالات ليست مقصودة أصالة أو تبعاً، كما يقولون. وهي صيغة أخرى للقول إنّ القصد الأصلي، والمقصود به الذات الإلهية، ليس في ما تقوله الجملة بشكل مباشر فقط، إنه موزع بين محيط لغوي له طرائقه في تسليم معانيه، وبين ذاتية قارئ يبحث في هذا المحيط عما يمكنه من "إضافة" معنى هو حاصل قناعة تسير في اتجاه التشدد أو الاعتدال. هناك في كل حالات هذه النصوص قصد آخر أقوى من قصد التلفظ هو قصد اللغة ذاتها. ولكنه قصد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قصد القارئ، فهو الذي يمكن أن يدفع بالنص نحو استيعاب سياقات متعددة، أو يُبقي عليه ضمن القصد الأول باعتباره أصل التشريع.
فما هو أساسي في جميع الحالات ليس النصَ في ذاته، بل السياقات التي تحتويه. بعبارة أخرى، ليس هناك مضمون سابق، إنّ المضامين تُبنى استناداً إلى المفترض من المواقف المسبقة. ولو لم يكن الأمر كذلك لما حُلل هنا ما حرمه الآخرون هناك استناداً إلى النص نفسه؟ فلا يمكن للنص أن يقول هنا شيئاً يمكن أن يلغيه في مكان آخر. وهذا التفاوت هو الذي جعل شيخاً كالفيزازي يغير مواقفه ويحلل ما سبق أن حرمه، ويبرر ما سبق أن أفتى ببطلانه وفساده؛ وهو الذي فضل، من على منبر قناة الجزيرة، كلبه على الإنسان الغربي، دون أن تمنعه هذه القناعة من امتطاء طائرة هي من صنع هذا الغربي ومنتج من منتجات فكره المارق.
وهو ما تثبته مثلاً الحالة التي يتحدث فيها الأصوليون عن إشارة النص، الذي هو في عرفهم دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعاً، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق من أجله. فقوله تعالى "أُحل لكم ليلة الصيام الرفثُ إلى نسائكم"، لا تعني حسب منطوق الجملة سوى شيء واحد هو جواز مباشرة الرجال لنسائهم ليلة الصيام، ولكنه دال بالإشارة وحدها على جواز الإصباح جُنباً. فلا شيء في الآية يدل على هذا المعنى سوى "البياض" الذي لم يُخْفه الإثبات أو يلغيه. فبما أنّ التوقيت مفتوح من حيث وجود كلمة "ليلة" التي تغطي فترة زمنية تمتد من المغرب إلى الفجر، فإنّ الإصباح جُنباً أمر مباح. دون أن ننسى أنّ الإباحة هنا تُسقط بالضرورة التحريم الذي من المفترض أنه كان سائداً من قبل، وهو تقدير يُستخرج من الآية التي تقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة 183): لقد أبيح لكم ما كان محرماً على غيركم من قبل.
ومقولة أسباب النزول في هذا السياق بالغة الأهمية، بل هي التي ستحدد طبيعة النشاط الذي يقوم به الشارح للنصوص. قد لا يتعلق الأمر في هذه المقولة بجزء من دلالة الملفوظ، فنحن أمام سياق خارجي؛ ومع ذلك، فإنه يشير إلى سياق ممكن، أو مقام يُقَيد المعنى أو يُطلقه. فلا يمكن في الكثير من حالات التواصل تحديد معنى جملة ما دون العودة إلى ما يقود إلى انتقاء هذا المعنى دون ذاك. إنّ الأمر يتعلق بإكراهات إبلاغية، أو بإمكان سياقي داخلي، وفي الحالتين معاً، فإنه دال على تعددية محتملة قد تشمل النصوص الدالة على معنى حرفي، نص قطعي الدلالة (قُرأت الآية "علم آدم الأسماء كلها" باعتبارها دالة على أنه أقدره على منح الأشياء أسماء). فهذه الإكراهات رافد أساسي في تفسير النص. وهو ما يعني أنها ليست سوى رهان تداولي يحاول تحديد السياقات المسؤولة عن المعاني من قبيل رفع اللبس وتجنب الغموض، والفصل بين المطلق والمقيد.
لذلك لا تصنف هذه الحالات ضمن التأويل، بالمعنى الهرموسي للكلمة، فالمعنى المقصود فيها موجود على مرمى حجر، إنه ظاهر ومِلْك اليد رغم الغطاء الحرفي. نحن أمام ما يطلق عليه الاستعمال، استعمال النص وليس تأويلَه، ذلك أنّ الاستعمال مرتبط بغاية نفعية، استنباط حكم أو إرساء قاعدة للفعل. فكل ما يمكن أن نصل إليه هو حاصل تقدير لا يشكك في المقاصد الأصلية للنص، ولا يعيد بناء علاقاته الداخلية، إنه يكتفي بالكشف عن مسكوت عنه، أو عن معنى مفترض من العبارة (إنّ الذي أفتى بجواز مضاجعة جثة زوجته لم يؤول نصاً، بل انطلق من غيابه. إذا لم يكن هناك نص يحرم، فإنّ الحلال ممكن).
وتلك ليست هي الحالة التي تقدمها مجموعة أخرى من الوقائع الدينية، ويتعلق الأمر بمجمل المحكيات التي روت قصصاً عن الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين وعن شعوب سادت ثم بادت. فتلك النصوص من طبيعة أخرى، إنها تُصنف ضمن خطابات عادة ما تُبنى استناداً إلى ميثاق تخييلي، لا يصف حقيقة موضوعية، بل يعيد بناء بعض شروطها بشكل تصويري. ما يمكن أن يتخذ شكل تمثيلات مشخصة تحاكي الحياة، ما يسميه البعض "العبرة" أو "الموعظة". وفي جميع الحالات، لسنا أمام برهنة عقلية قائمة على حجج عقلية، بل أمام "المحتمل"، والمحتمل لا يشير إلى علاقة مع الواقع، بل إلى ما يعتقد الناس أنه واقع حقاً. وهذا معناه أنّ القصة لا يمكن أن تشكل تماثلاً مع حقائق مودعة في واقع قابل للمعاينة، إنها لا تستثير سوى قصص أخرى، أو تسقط مفاهيم هي وجهها المشخص (قصص تحكي عن الصبر والشجاعة والكرم وقوة الإيمان أو ضعفه).
لذلك لن يكون أفق التخييل شبيهاً بأفق التاريخ، فما يُبنى في القصة، كل أنواع القصص، ليس وقائع من التاريخ، بل زمنية نسيها هذا التاريخ ولم يلتفت إليها، لأنها لا تحكي وقائع في الزمن، بل تشير إلى حالات تستشعرها النفس. لذلك لن يكون أفق التخييل سوى انفعالات لا يمكن أن تستقيم إلا ضمن مفاهيم تحكي تاريخ القلق والخوف والرهبة وضياع جزء من ذاكرة الإنسان على الأرض. إنّ بناء المفاهيم من خلال التشخيص ذاته هو الذي يمكن أن يُفسر بعضاً من الشرط الإنساني على الأرض.
وتلك هي قصة يوسف في البئر، ويونس في بطن الحوت، ونعل موسى، والنار التي كانت برداً وسلاماً على إبراهيم، وغيرها من الحالات المروية في أفق استثارة مضامين استعارية تحاكي من خلالها حالات النفس، والاستئناس والرسالة وحرقة المعرفة الجديدة. إنّ الجب ليس جباً إلا في الذاكرة البرانية، أمّا في الوجدان فهو شبيه بالظلام والقبر والموت والاندحار نحو حالة بدئية هي الولادة والبعث الجديد، تماماً كما هو بطن الحوت مفراً أو مهرباً أو خوفاً من رسالة لو وُضعت على الجبال لتصدعت من خشية الله. وكذلك الأمر مع النار، فهي نشاط كيماوي في المقام الأول هو ما يمنحنا الدفء أو تحرق كل شيء في طريقها، ولكنها تأكل القلوب أيضاً، إذا اشتد العشق فيها أو استبدت بها الغيرة، أو تكون إحالة على تجربة استئناسية أليمة ينفصل فيها الإنسان عما تعلم وما انتمى إليه. وهذا الترابط هو الذي جعلته الثقافة دالاً على انفعالات من طبائع مختلفة تشمل الحقد والغيرة والحب في الوقت ذاته. تُعَد النار الأولى جزءاً من تجربتنا الواقعية، وهي ما يمكن أن يتسرب إلى اللغة باعتباره بعداً حرفياً فيها، أمّا الثانية فبناء استعاري لا يأخذ من الأولى سوى عمقها الرمزي الذي تتحقق داخله روابط وعلاقات جديدة.
وتلك هي طبيعة التعبيرات المجازية، إنها لا تحاكي حقيقة، بل تشير إلى "تجربتنا الداخلية للعالم، وتشير أيضاً إلى سيرورات انفعالاتنا"[10]، فما لا تستطيع اللغة تسميته ووصفه بشكل مباشر، وما لا يستقيم ضمن إكراهات قوانين الكون، ببعديها الاجتماعي والطبيعي، تلتقطه أشكال وصيغ استعارية عادة ما تكون هي بؤرة المعاني والغاية النهائية من وقائع القصة. لذلك، فإنّ التقاط البعد الاستعاري للنار وتأويلها باعتبارها دلالة على تمزق داخلي بين ما تعلمه الإنسان من محيطه وبين رغبة في التعرف على حقيقة جديدة تنزه الله عن التجسيد والتبدل والظهور والاختفاء، هو في واقع الأمر فتح لسيرورة تأويلية تعيد تنظيم عناصر النص وفق إسقاطات تأويلية تبحث في المرئي من خلال الحدث القصصي المشخص عن مفاهيم مجردة. إنّ التأويل في هذه الحالة لا ينفي عن الله هذه القدرة على كل شيء، بل يصبها في ما يمكن أن يتم مجازياً داخل الذات "المبلوة" بألم هو جزء من آلام كل المؤمنين الذين أعلنوا عن ميلاد نسق ثقافي جديد لم يتحقق دون عناء[11].
إنّ الاحتفاء بهذا التفاوت بين السجلات الدلالية هو أداتنا لاستعادة ما تخبئه الحكايات وما تُخفيه حالات التشخيص في النصوص القصصية الدينية. فهذه ليست في غالب الأحيان سوى وجه خفي تَجَسَّد في وقائع تُخفي قلقاً ورغبة في استعادة ما مضى أو خوفاً مما سيأتي. إنها تحتاج إلى تدَبُّر يُخلصها من شكل التجلي للإمساك بالجوهر التجريدي فيها، فهو المضمون الصامت لما تقوله الكلمات جهراً. إنّ المروي في هذه النصوص ليس في الغالب من الحالات سوى غطاء، أو ما يسميه بول ريكور "المعرفة المزيفة" التي تشخص حقاً حالات قلق لم يكن المتاح المعرفي قادراً على تفسيرها.
لا يتعلق الأمر بالتشكيك في صدقية القصة، فذاك أمر يخص المؤرخين وغيرهم من الحفريين، بل هو محاولة في البحث في وجهها الاستعاري. إننا لا نلغي قدرة الله على الإتيان بمعجزات هي جزء من ملكوته، ولكننا نحاول، استناداً إلى ثقافتها الأرضية، التوسيع من هذا الملكوت لكي نجعله شاملاً لكل أشكال التعبير، الحقيقي والمجازي. ويبدو أنّ ربط الناس بين الكلمات وبين ما تقوم بوصفه، هو الذي يدفعهم إلى الاعتقاد أنّ الحكايات هي تسجيل لوقائع فعلية، لا مجرد استعارات كبرى، أو تمثيل مجازي، كما هي حال الأساطير والكثير من الخرافات.
* نص المداخلة الذي ألقي بالندوة المصغرة حول "المناهج الأدبية وفهم النص الديني" بصالون جدل الثقافي التابع لمؤسسة مؤمنون بلا حدود للدارسات والأبحاث/ الرباط، 20 فبراير 2016
[1] C S Peirce: Textes anticartésiens, présentation et traduction Joseph Chenu, éd Aubier,1984,p.78
[2] انظر أومبيرتو إيكو: التأويل بين السميائيات والتفكيكية، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية 2004، ترجمة سعيد بنكراد ص 120
[3] R Barthes: S/Z, éd Seuil,1970, p16
[4] Umberto Eco: La structure absente, éd Mercure de France, 1970, p.66
[5] انظر Umberto Eco: Les limites de l’interprétation, éd Grasset,1992, p.300
[6] أومبيرتو إيكو: العلامة، تحليل المفهوم وتاريخه، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 2007، ص 237
[7] Umberto Eco: Lector in Fabula, éd Grasset1985, p.72
[8] Georges Gusdorf: Les origines de l’herméneutique, éd Payot 1988, p.227
[9] أومبيرتو إيكو: دروس في الأخلاق، ترجمة سيعد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 2010، ص 122
[10] أومبيرتو إيكو: التأويل بين السميائيات والتفكيكية، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية 2004، ترجمة سعيد بنكراد، ص 158
[11] انظر مقالنا: السرد الديني والتجربة الوجودية، قصة إبراهيم نموذجاً، علامات العدد 39، 2013






