العيش بالتفلسف: الوجه الجديد للفلسفة
فئة : قراءات في كتب
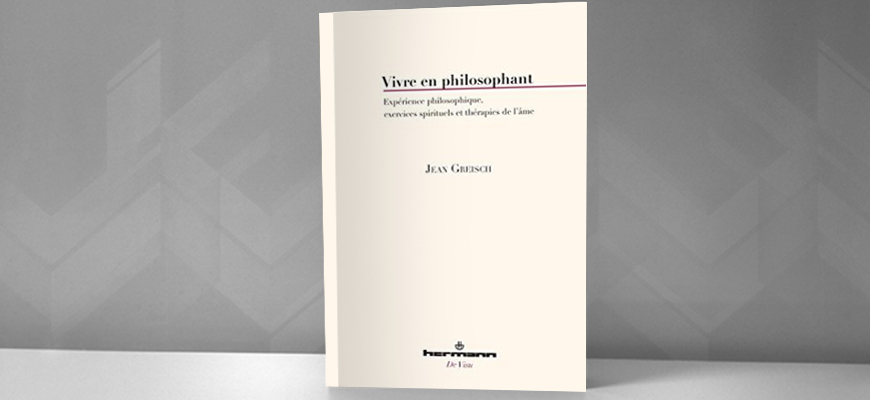
بهذا الكتاب: «العيش بالتفلسف: تجربة فلسفية، تمارين روحية وعلاجيات النفس»[1]، يتحفنا جون غرايش بمبحث دار مع الزمن وفق بداهة العَوَد الأبدي وهو «العلاج بالفلسفة» الذي كان طباً روحيّاً في الأزمنة العريقة وأصبح طبّاً فلسفيّاً مع المحاولات والتأويلات المعاصرة مع ميشال فوكو[2] وبيير هادو[3] وأندري جون فولكه[4] ومارتا نوسبوم[5]، إلخ. في أكثر من 500 صفحة، يتناول غرايش بالدرس والتحليل والمقارنة التاريخية أهم الوجوه الفكرية التي جعلت من «الطب الفلسفي» ليس فقط الموضوع المباشر للبحث، لكن أيضاً الدافع والمحفّز: في الوقت نفسه المنهج والمضمون، اللوحة والفكرة، المجال والوسيلة، إلخ. يتركَّب الفهرس من ثلاثة عشر فصلاً موزَّعة على الشكل التالي:
مقدمة عامة حول الفارق المنهجي والجوهري بين الفلسفة والتفلسف.
الفصل الأول: في فائدة التقديم للفلسفة أو عدم فائدته.
الفصل الثاني: الفلسفي وما يفوق الفلسفي: الإدماج الفلسفي ومفاعيله.
الفصل الثالث: الطب التجانسي لدى سقراط وصيدلية أفلاطون.
الفصل الرابع: الوضع الأرسطي للحكمة العملية وعلاج الرغبات.
الفصل الخامس: علوم الجراحة لدى أبيقور أو كيف نتخلَّص من الآراء الجوفاء والرغبات الشعواء.
الفصل السادس: تنشيط العقل: العلاج الرواقي.
الفصل السابع: «العمل من أجل صحة العالم» (ماركوس أورليوس).
الفصل الثامن: التطهير الشكي: العيش بلا أحكام جاهزة.
الفصل التاسع: عزاء الفلسفة (بوئثيوس).
الفصل العاشر: «المرض تجاه الموت» والتعافي منه (سورين كيركيغارد).
الفصل الحادي عشر: قلق في الحضارة والطبيب-الفيلسوف (فريدريش نيتشه).
الفصل الثاني عشر: «علاج المشكلات الفلسفية كما تُعالَج الأمراض» (لودفيج فتغنشتاين).
الفصل الثالث عشر: من الفهم السقيم إلى الفهم السليم (فرانتس روزنتسفايغ).
الاطلاع على الفهرس يُنبئ عن غزارة في المادة وقوة في الفكرة، بالمقارنة مع مبحث لم نعره اهتماماً كافياً، على الرغم من أنّنا نحيا عصراً سقيماً وهشّاً، وعنيتُ بذلك «التداوي بالفلسفة» أو الطب الفلسفي. كان هذا مبحث القدماء في سبرهم لأغوار النفس وانفعالاتها من أفلاطون إلى ديكارت، وأضحى اليوم الضرورة والمهنة أمام المحنة التي يجابهها الإنسان المعاصر: الألم، العنف، الإرهاب، الموت... كيف تساهم الفلسفة في اجتراح طب فلسفي يأخذ بالعناية والرعاية الإنسان في وحدته الذاتية والأنطولوجية؟ لمباشرة هذا العمل العيادي في فحص الأعراض والعمل الطبي في تشخيص العاهات والأمراض، يضع غرايش على طاولة التشريح منظومة الفلسفة من وجهة نظر انعكاسية (réflexivité)، بمعنى: كيف تنظر الفلسفة إلى ذاتها وأدواتها؟ هل هي نسق من المعارف والمعاجم، لها مدارس ومذاهب، وفي هذه الحالة نتكلَّم عن "الفلسفة" بهوياتها النظرية والفكرية والإيديولوجية؟ أم هي القُدرة على التفكير في ما يصدم الوعي أو يصطدم به على سبيل الحدس أو الإدراك، ونتكلَّم هنا عن "التفلسف" بهوايته في التأمُّل والتفقُّه وتدبير المعيش؟
تدبيرات فلسفية في مداواة العاهات الإنسانية: التفلسف بين نمط المعرفة ونمط الوجود.
في المقدمة العامة والفصلين الأول والثاني، كان اهتمام غرايش منصبًّا على هذا الفارق الجوهري، الإبستمولوجي والأنطولوجي معاً، بين الفلسفة والتفلسف، والأشكال التي اتَّخذها في التحوُّل التاريخي للخطاب الفلسفي. لقد كان الخيار في هذا الفارق بين المذهب والمنهج، أو بين "الفكرة" وقد تجسَّدت في منظومة أو مدوَّنة أو تيَّار فكري، و"الطريقة" في سلوك نمط معيَّن من المعيش، يقوم على ما سمَّاه بيير هادو «التمارين الروحية» (exercices spirituels) بما توفره من أدوات التأمُّل والاستبطان والزهد، وطرائق «استملاك الذات». لقد كان السؤال الذي راود جمهور الفلاسفة: هل نتحدَّث عن الفلسفة بوصفها «فن العقل»، وعن الفيلسوف «فنان العقل» (artiste de la raison)، شريطة أن نفهم "الفن" بالمعنى العريق لكلمة "تكنيه" (technè) وهي الأداة أو الوسيلة في تشييد منظومة متكاملة من المقولات والمفاهيم؟ أم نتحدَّث عن الفلسفة بوصفها الميل الطبيعي والروحي نحو التحلّي بالحكمة وعن الفيلسوف باعتباره "محب الحكمة أو صديقها" تبعاً لبعض الاشتقاقات في الكلمة «فيلوسوفيا» (philosophia)؟
إذا كان الغرض تشكيل طب فلسفي يأخذ بالعناية الوحدة الذاتية والأنطولوجية للإنسان، فإنّ «صيوان الحكمة» (بتعبير أبي يعقوب السيجستاني) تليق به ليسكن فيها ويحتمي بها، وليس «فن العقل»، بمعنى الطريقة الروحية في العيش بالتفلسف وليس النمط العقلي في تركيب الأنساق النظرية المجرَّدة. المسألة هي قضية معيش وحكمة عملية (phronèsis) بالمعنيين الأفلاطوني والأرسطي؛ تعتبر الإنسان وحدة أنطولوجية ووجدانية لا يمكن اختزالها في عقل مفكّر أو تخمين مدبّر. بهذا المعنى، جاء تحديد التفلسف على أنّه «أسلوب في العيش» (style de vie)، يدل على «طريقة جديدة في قيادة الحياة أو إدارتها» (ص11). باعتماده على نصوص هادو حول التعريف العريق لظاهرة التفلسف، عمد غرايش إلى النظر في التفلسف على أنّه طريقة في العيش تبتغي السلوك العملي، قبل أن تكون مسلكاً نظريّاً متشعّباً من التحاليل والتراكيب العقلية المجرَّدة والمعقَّدة.
لا شك في أنّ هذه العمليات العقلية المركبة لا يستغني عنها الإنسان في إدراكه لنظام العالم ومنطق الطبيعة، لاستخلاص قانون محايث أو مبدأ فاعل، غير أنّ ما لفت انتباه القدماء ليس «ما-بخارج» الإنسان من ظواهر قابلة للجرد والوصف والتصنيف، وإنّما «ما-بداخل» الإنسان من أحكام قابلة للتصحيح ورغبات قابلة للضبط وانفعالات تتطلَّب السيطرة والعقل، العقل بالمعنى الحرفي لكلمة «الحَجْر»، أي بالمعنى المألوف والحسي في كلمة «العِقال» الذي يحجر فرار الدواب وشرودها بوصفه الحبل المتين الذي يشدُّها إلى إسطبلها وعلفها، وبالقياس حَجْر أو منع الذهن من التيهان وسقوطه في العمى والخبل. فعن حق إذن، اختار القدماء الحديث عن «طب روحاني» تستأثر به الفلسفة من أجل الولوج في «غَوْر الأمور» (بتعبير الحكيم الترمذي)، وليس غائراً سوى النفس التي بين جنبي الإنسان، المعلوم والمجهول في الوقت نفسه، التي تقتضي علماً خاصاً في معرفة أوجهها المشرقة والمعتمة وأسرارها الغائرة، وتستدعي طبّاً خاصاً في علاج كلومها وأسقامها.
ليس هذا العلم مجرَّد «علم النفس» بأجهزته الوضعية الثقيلة، سليلة العلم التجريبي الإيجابي منذ حُمَّى الوضعية في القرن التاسع عشر؛ إنّه قبل كل شيء «علم فلسفي» يدرس «الطابع الباروكي» (المنكسر، الملتوي، المبهم، المتطرف، المتفاقم...) للنفس عبر الأحكام والتمثُّلات والظنون والأوهام، والكيفية التي يتمُّ بها علاج المفرط فيها، المتضخّم، المتفاقم من أجل تحكُّم حكيم ورصين في الذات، استملاك الإنسان لذاته. بهذا المعنى، تتَّخذ الفلسفة صورة تجربة مفتوحة على التمارين والتدابير الروحية، أو لنقل بأنّ التفلسف، تجربة فلسفية، تقترن بأسلوب في العيش يُدمج كينونة الإنسان في رُمَّتها؛ وبتمرين روحي ليس مجرَّد تدابير زهدية عنيفة في استماتة الذات، وإنّما ممارسات عملية في السلوك الحكيم، حصرها غرايش في ممارسات نبيهة: 1) أن نتعلم كيف نعيش بميزان العقل والاقتصاد العاطفي في سياسة الذات على أساس «كأنّك تعيش أبداً» (كما جاء في الأثر)؛ 2) أن نتعلم كيف نتحاور بميزان اللسان والاقتصاد التواصلي في سياسة الوجود مع الآخر على أساس «إمكانية أن يكون الآخر على حق» (غادامير)؛ 3) أن نتعلم كيف نموت بميزان التأمُّل والتذكُّر في سياسة العلاقة بالنهايات القصوى على أساس «كأنّك تموت غداً»؛ 4) أن نتعلم كيف نقرأ بميزان الفهم في استخلاص معانٍ وتجارب كامنة في نظام العالم.
كانت هذه الممارسات محط اهتمام ثلة من الفلاسفة الذي أعادوا تحيين «الطب الروحاني» في طبعات فلسفة منقَّحة أمثال مارتا نيسبوم وتأكيدها على علاجية الرغبة وأشكال الازدهار الذاتي؛ بيير هادو وأساسيات التمارين الروحية في الممارسة الفلسفية؛ ميشال فوكو وطبائع التذويت (subjectivation) أو الانهمام بالذات عبر الاهتمام بالآخر؛ وأخيراً فولكه والطب الفلسفي في تقويم العقل ورأب التصدُّع الذاتي. الأمر الأساس والمشترك بين هذه الطبعات المعاصرة للطب الفلسفي الآتي من غياهب الطب الروحاني العريق هو الاستعمال الحصيف للاستعارة الطبية بوضع العلل الذاتية في سياق المداواة الروحية، لأنّ الاستعارة الحية "طبية" في مدلولها، لكن الأدوات المستعملة لا تأخذ عن المعجم الطبي مصطلحاته سوى على سبيل التجوُّز؛ بحكم أنّ الوسائل روحية بالمعنى الواسع لكلمة "الروح"، معنى جمالي وخلقي وفني، وليس بالمعنى الحصري، الميتافيزيقي أو الديني. تُبرز هذه الوسائل العلاجية رغبة الإنسان في التفلسف بالمقارنة مع حجم النوازل التي يتكبَّد مفاعيلها: ألم، قلق، جرح، عنف، إرهاب، موت...
فهو لا يلتمس، إزاء هذه الظواهر المبهمة والباروكية، الأنساق الفلسفية الكبرى ذات المعطيات الموضوعية والترتيبات الأكاديمية، وإنّما يميل إلى التفلسف القائم على دوافع الدهشة والاستفهام بالمعنى الأرسطي (thaumazein) أو دواعي الجزع بالمعنى النيتشوي. عندما نتأمَّل في النماذج التي أخذها غرايش في صياغة كتابه، فإنّنا نجد أنّها كانت تميل أكثر إلى "التفلسف" بالإشارات العابرة والاستعارات الحية والطابع الشعري للأسلوب، منه إلى امتهان "الفلسفة" بالتراكيب العقلية والمفهومية المجرَّدة. لذا، نصادف في كتاب غرايش أسماء سقراط وأبيقور وماركوس أورليوس وبوئثيوس وكيركيغارد ونيتشه وفتغنشتاين، بمعنى الفلاسفة الذين رفضوا التقيُّد بالفكرة المجرَّدة على حساب الاستعارة الحيَّة والصورة الملتبسة للوجود. لأنّ أقرب وسيلة إلى التجربة الإنسانية هي النظر في المعيش المباشر بما يستشعر به الإنسان في ذاته من لفحات هذا المعيش من جهة، ومن نفحات الكينونة التي يتواجد بها. عندما نتحدَّث عن الطب الفلسفي، لا نقصد فقط علاج الأسقام من تمثُّلات خاطئة وانفعالات مفرطة، لكن نقصد أيضاً المنهج السليم في تفادي الوضع السقيم، بمعنى الكيفية التي يحافظ بها الإنسان على صحة جسدية وعقلية مُثلى (optimale). فالمسألة "احترافية" من حيث العلاج والتداوي بطرائق دقيقة وتجانسية، و"احتراسية" من حيث تفادي الأسقام والنوبات.
لقد كانت للفلسفة تحديدات متعدّدة، من إدراك الوجود على ما هو عليه بالمعنى الأرسطي إلى إدراك الحقيقة بوصفها تطابق الأشياء والعقل بالمعنى اللاتيني والسكولائي المتداول (veritas est adaequatio rei et intellectus)، والالتباس في التحديد من عين الغموض في الأسماء، على اعتبار أنّ الاسم «فلسفة» نفسه يتعذَّر ترجمته (intraduisible) في لغات العالم تقريباً، فاحتفظ بمنطوقه الحرفي منذ نشأته في اللسان اليوناني العريق؛ وازداد الغموض والالتباس مع الممارسة الفلسفية نفسها في شكل «تفلسف»، بحكم أنّ هذه الممارسة انتقلت من الأبنية النظرية (الفلسفة، إذاً) إلى الاستعمالات التداولية الخاصَّة بكل فيلسوف يقوم بطرح الأسئلة وأشكلة المعطيات انطلاقاً من سياقه ورؤيته للعالم، وبكل إنسان عادي يتعرَّض لمصادفات الوجود بأساليب الجزع الذي جعله نيتشه أصل التفلسف. فلأنّ الإنسان كائن جزوع، فهو كائن يتفلسف؛ أي أنّه لا يتفلسف فقط بدوافع الفضول والبحث والاستفهام. والجزع يُبرّر طريقة طبية في المعالجة من أجل التخفيف من وطأة الارتياع والتوجُّس، ومداواة الميول المفرطة والعُقد المتينة التي تتحوَّل إلى معتقدات ثابتة آيلة نحو الانغلاق والإطباق.
فص حكمة طبّية في كلمة فلسفية: «الجسذات» وأسئلة التعثُّر والعثور.
عندما نفكّر مليّاً في النماذج التي اختارها غرايش، نُدرك أنّ الفلاسفة الذين تخلّوا عن الأنساق الكبرى نحو التأمُّلات النبيهة في المعيش، كانوا يشتركون كلهم في الطريقة التي تتمُّ بها معالجة ما سمَّاه هايدغر «الهُمْ»، الأمر الذي يستقطب في ذاته الاهتمام والانتباه، لأنّه دليل الوَقْع على النفوس والقَرْع في الأسماع والدَهْش أمام الأعين. الإنسان الجزوع هو الأنموذج الأمثل في الطب الفلسفي، لأنّه كائن-من-أجل-الموت، ولأنّه كائن-مُعطى-للألم، بمجموع الميول النفسية المتفاقمة: هواجس، أحقاد، نزوات، رهبات، إلخ. لهذا الغرض، انصبَّ اهتمام الفلاسفة القدماء على معالجة كلوم النفس والأمر المتفاقم من ميولها، خصوصاً مع المدرسة الرواقية التي جعلت من الطب الفلسفي المنهج العملي البارز في معالجة اختلالات النفس واعتلالات المعيش، بتحويل التوتُّر (gr. tonos) من السلبي في الانفعالات والميول المحمومة إلى الإيجابي في الأمر الذي ينتظم وفق أوتار الكينونة بجمعها ولمّها في الذات وتوجيهها نحو (lat. tendere, fr. tendre vers) غايات سامية.
يتعلَّق الأمر بسياسة الاقتصاد العاطفي للإنسان من التبعثر أو الكاوس (chaos) إلى الانتظام باستراق اللحظات السانحة (kaïros)، دون أن تنتهي هذه السياسة بالإطباق على الانتظام وتحويله إلى جبرية في الفعل والاعتقاد. معظم الرسائل الفلسفية للقدماء (الأبيقورية، الرواقية) كانت تُشدّد على الطريقة التي نسوس بها الذات نحو انتظامها العملي ومعالجة ما سماه سقراط بالانهمام بالذات (souci de soi) الآيل نحو المعرفة الحقَّة بالذات (gr. gnôthi seauton)، وتكون هذه المعرفة الحقَّة بالولوج في الذات واستخلاص الكنوز المعرفية القابعة فيها، ويكون الاستخلاص بطريقة عيادية، تلبَّس فيها سقراط وظيفة أمه القابلة المسماة بالتوليد (maïeutique). توليد العلم من صُلب الجهل بهذا العلم المكنون في قرارة الذات. ثم جاءت المحاولة الأفلاطونية في تحرير الوعي من الجهل الذي يتَّخذ أمثولة له (allégorie) في الكهف الذي يشتمل على فواعل (actants) مترابطة: أشخاص مقيَّدون بالسلاسل، ظلال وأنوار ملتبسة، ضباب وغموض، طريق سري يُرى منه ضوء خافت لا ينفك عن التعاظم كلما اقترب منه الشخص القابع في الكهف.
ما شخَّصه سقراط في معرفة كامنة في الإنسان عن غير دراية منه، تقتضي تمارين زهدية للتوصُّل بها، وقف أفلاطون عند معرفة جليَّة يكون السبيل إليها بالإقلاع عن عادات الكهف وحقائقه المزوَّرة، وتعويد النفس الارتقاء إلى الحقائق الأزلية مثلما نُعوّد العين بالتدريج على رؤية الأنوار الساطعة. الارتقاء عبارة عن تذكُّر (anamnèsis) والتذكُّر من وحي الذاكرة والصوت، أي الترياق الذي يقي من سُم الكتابة (graphê)، لأنّه عقَّار فاعل ضدَّ ما يُنغّص على النفس ارتباطها المباشر بذاكرتها الأصلية والحيَّة في عالم الفكرة الناصعة (eidos)، بعيداً عن أصنام (eidolon) الحروف الثابتة. بهذا الجدل الصاعد نحو الفكرة الناصعة، يكون أفلاطون قد حسم طبَّه الفلسفي لصالح انتعاش النفس بالأصل الذي صدرت عنه. بالموازاة مع هذا الجدل الصاعد، يُشدّد أرسطو والرواقيون على جدل نازل، يرتبط أكثر بمسمَّيات الأرض والطبيعة (phusis)، لأنّ الزهد الروحي في ترويض الذات وشق جيوب الذاكرة لاستخلاص صور الأصالة القابعة فيها، لا ينفك عن نوع من الزهد الجسدي في التحكُّم في الذات تبعاً لأمثولة العربة الأفلاطونية.
أكثر من مجرَّد نفسٍ ذات جوهر أصيل وخالد، نستشف في العيادة الأرسطية-الرواقية الاهتمام بما يمكنني تسميته «الجسذات»، مركَّب يُبرز الالتحام الصارم بين البَشرة التي تسمَّى بها الإنسان بشراً، مُستقطبُ الإدراكات والانطباعات، والذات التي لا يمكن اختزالها إلى مجرَّد نفس بالمعنى الميتافيزيقي للكلمة. لكي يكون للطب الفلسفي مشروعية نظرية، لا بُدَّ من الجمع بين الكثيف واللطيف في هذا المسمَّى «الجسذات»: مداواة كلوم الجسد عبر المعاناة التي تدلُّه على المعنى، وكلوم الذات في تصوُّرها للأشياء، بتصحيح الأحكام وإدراج الميزان والاعتدال في المتفاقم من انفعالاتها ورؤيتها «الباروكية» للعالم. النماذج التي تناولها غرايش بالقراءة والتحليل تميل كلها إلى التأمُّل في هذا «الجسذات» في تفاقمه الأنثروب-أنطولوجي: مع بوئثيوس (Boethius, Boèce) في التماسه عزاء الفلسفة وهو يواجه الأيام الأخيرة قبل تنفيذ الحكم عليه بالإعدام؛ ومع نيتشه في تحويله الأسئلة الفلسفية الكبرى من الحقيقة/الزيف إلى الصحة/المرض، مُحدثاً منعطفاً بارزاً في الأزمنة المعاصرة بالانفتاح على هذا المسمَّى «الجسذات»، الذي سيجد معالجة مركَّبة ومختلفة المناهج والوظائف مع ميرلوبونتي، فوكو، دولوز ودريدا.
بوئثيوس أولاً، لأنّه رمز التعثُّر الذي وصل إلى العثور. كان أفلاطون، وبشكل تهكُّمي، قد عيَّر في طاليس اشرئباب عُنقه نحو السماء إلى درجة سقوطه في البئر. تعثَّر ولم يعثُر على الأمر الذي كان يبحث عنه، إذا جاز لنا استعادة التعليق الهايدغري على القصة الطريفة التي أوردها أفلاطون. لم يكن الأمر كذلك مع بوئثيوس، لأنّه «تعثَّر» بتقهقره الرهيب من عضو في مجلس الشيوخ الروماني وخطيب شهير إلى سجين في زنزانة ينتظر حتفه القريب بعد طرده من حُظوة السلطان؛ لكنه «عَثر» على فص الحكمة الفلسفية التي جاءت إليه متجسّدة في امرأة حسناء تواسيه في ألمه واغتمامه. أصبحت الفلسفة الممرّضة التي تداوي الكئيب والمتوجّس من دنو موته العنيف، تسكب في فمه جرعات من العقاقير الفلسفية الكفيلة بالتخفيف من حدَّة الاكتئاب والقلق: «منذ البداية، كانت الفلسفة تكتسي دور الطبيب. لا نتفاجأ بأنّ سمات كثيرة خاصَّة بالأنموذج الطبي، من كل المدارس المتنوعة، تتواجد في "عزاء الفلسفة"» (ص318).
فتح بوئثيوس حواراً مع الفلسفة، مونولوجًا مع ذاته، لأنّه كان بحاجة إلى كلمات تواسي الكلوم، ولم يكن بحاجة إلى أفكار تنير الدروب، لأن لا درب بعد تنفيذ الحكم عليه بالإعدام. أحدث تحويلاً جذرياً في «الجسذات» الذي يتأمَّل في اندحاره على عتبة الشهرة والحُظوة، والتأسُّف على ما فات من التفريط في العناية بهذا «الجسذات» بالوسائل الروحية والتهذيبية. لكنه وجد في «الذات» التي كوَّنها بالخطابة والبلاغة والسياسة ما يواسي «الجسد» العليل والمسجون في الزنزانة وتنشيطه بالذاكرة الحيَّة الآتية من غياهب الممارسات الخطابية والفكرية. تعاضُد وحدة «الجسذات» هو ما يُعطي للعزاء الفلسفي قيمته العلاجية والروحية، في ظروف قاسية من السقوط والانهيار.
نيتشه ثانياً، لأنّه العاثر على كنوز فلسفية في صُلب تعثُّره الأكاديمي والشخصي. لم يكن يرى في الفلسفة «مهنة» تُوفّر للمتعلّم ما يسدُّ بها حاجياته وهمومه المعيشية، بقدر ما رآها بوصفها «محنة» التواجُد في العالم، لكائن جزوع، منهمك في مصاريف النهم وتصاريف التخلُّص من نفايات العقل والجسم معاً. أمام هذه المفرطات الأنطولوجية التي تُنسي الإنسان الغاية التي وُجد لأجلها وهي إكمال الوجود بإكمال المعرفة بالوجود، فإنّ المهام التي تقع على عاتق الفلسفة هي تلبُّس أدوار العلاج بالاستعارة الطبية الحيَّة التي لا تُختزَل إلى معجم أو أسلوب، لكن تُلتمَس على وجه الضرورة في تقييم الحياة ومعالجة المعيش. أمام مصائب «الجسذات»، ينبغي سؤال فلسفيّ-طبيّ يقول فحوى المعاناة التي يتكبَّدها الإنسان في توصُّله بالمعنى.
لتحقيق هذا البرنامج الفلسفي-الطبي، لا بد من إزاحتين: الأولى هي تحويل المسائل الفلسفية الكبرى منذ 2500سنة من برادايم (Paradigm) الحقيقة/الخطأ إلى برادايم الصحة/المرض؛ والثانية هي تحويل مهام الفيلسوف إلى المعالجة والمداواة بالمقارنة مع حجم العلل الحضارية والأسقام الوجودية. إنّه برنامج طموح دفع نيتشه ثمنه انهياراً عصبياً وتعثُّراً وجودياً، لكنه وجد ضالَّته بأن خرج من النفق حاملاً أفكارًا خلَّدته في الأجيال اللاحقة بوصفه فيلسوف المعاول الفلسفية بلا منازع، مبشّراً بقدوم الفيلسوف-الطبيب الذي يقول: «من تألَّم تعلَّم» (gr. mathein pathos) تبعاً للشعار العريق سليل الطب الروحاني (ص383). ما يهمُّ الفيلسوف هو «صحة العالم» تبعاً لفكرة ماركوس أورليوس، والكيفية التي يجلب بها الفيلسوف هذه الصحة من عُمق العلة، مثلما يعثُر في صُلب تعثُّره: «أين هم أطباء النفس الجُدد؟» يتساءل نيتشه في الفقرة 52 من «الفجر». المهام هي بلا شك علاجية على خُطى الطب الروحاني العريق، لكن بأساليب مغايرة تُدرج المكونات الجوهرية للإنسان كلها، تحت طائلة ما سمّيناه بـ«الجسذات».
لا عجب في ذلك، ما دام نيتشه افتتح عصره الحيوي (بارادايم الحياة) بالإشارة إلى «نسيان الجسد» في الفلسفات السابقة عليه، من فرط انهمامها بأسئلة الحقيقة والمطابقة بين العقل والأشياء. جاء الاهتمام المعاصر بهذا الجسد في تمفصله الملتبس بالذات في قضايا تخص الإدراك والإحساس والمعيش والألم والمكابدة. ما سنَّه نيتشه أنطولوجيّاً، دعَّمه فتغنشتاين منطقيّاً، بأنّ الفلسفة هي مسألة أشكال الحياة (Lebensform) الواجب تنظيمها في مفاتيح لغوية هي لُعب ومهارات (Sprachspiel) تُبرز الكيفية التي يتمُّ بها تعزيم الخطاب الفلسفي من عفاريته الميتافيزيقية، وإنزال التفلسف من المجالات المفارقة نحو التُربة الواقعية للقول العادي الحي. الفلسفة قيمة تداولية تُبيّن الطريقة الماهرة والذكية في معالجة الأسئلة، هنا والآن، بوسائل تجانسية تختار الميزان الدقيق للسان والاعتدال في الطرح، فيما وراء الاختلال أو الاعتلال الذي يشوّش التمثُّل أو الأمر الماثل أمام الذات (Darstellung)، ولم يخطئ فتغنشتاين عندما فاقم من خطورة هذا التشويش قائلاً: «كم هو عسير عليَّ أن أرى ما هو أمام عينيَّ!».
ما يمكن لمسه من المحاولة الفذَّة التي قام بها غرايش بعد سلسلة من التأليفات الجديرة حول الهيرمينوطيقا والفينومينولوجيا وفلسفة الدين، هو إعادة التفكير في الفلسفة بشكل انعكاسي (réflexivité)، ترى شرطها المعرفي وتقوم بمساءلة أدواتها وأساليبها. معالجة القضايا الكبرى مرهون بمعالجة الذات الفلسفية نفسها، ليس فقط فلسفة الذات، لكن أيضاً ذات الفلسفة: المهام الكبرى، الأسئلة الحاسمة، المفاهيم الفاعلة، وهذا الكتاب دليل واف وشاف حول الطريق نحو الفلسفة طبّاً روحيّاً ونهجاً علاجيّاً.
[1] Jean Greisch, Vivre en philosophant. Expérience philosophique, exercices spirituels et thérapies de l’âme, Paris, Hermann, coll. « De Visu », 2015, 507 pages.
[2] Michel Foucault, L’herméneutique du sujet, Paris, Gallimard/Seuil, 2001.
[3] Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Bibliothèque des Etudes augustiniennes, 1992.
[4] André-Jean Voelke, La philosophie comme thérapie de l’âme. Etudes de philosophie hellénistique, Paris-Fribourg, Cerf, 1994.
[5] Martha Nussbaum, The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton, N-Y, Princeton University Press, 1994.






