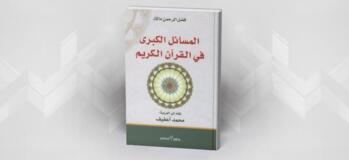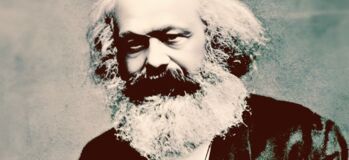الفكر المركب في مواجهة الأزمات الراهنة (قراءة في كتاب التفكير الشامل لإدغار موران)
فئة : قراءات في كتب
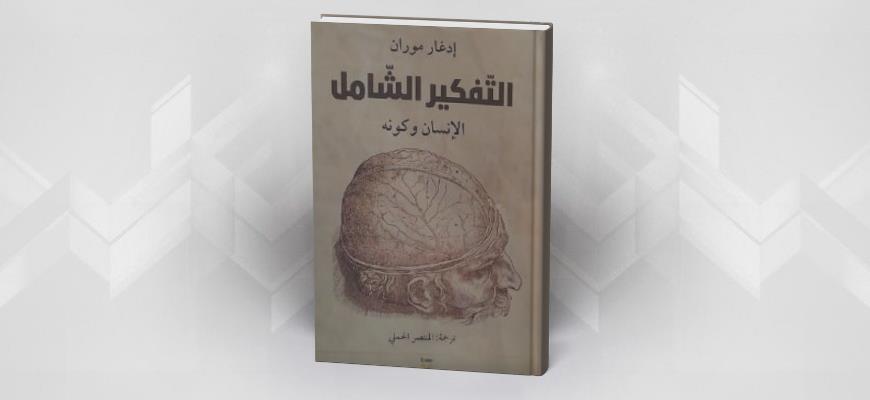
الفكر المركب في مواجهة الأزمات الراهنة
(قراءة في كتاب التفكير الشامل لإدغار موران)
تقديم
إدغار موران Edgar Moran من مواليد 1921، هو اسم كبير في الفلسفة والسوسيولوجيا، وغني عن التعريف؛ إذ عُرف في العالم العربي بفيلسوف التركيب والتعقيد، وظل يمارس تأثيره الحيوي على الثقافة العالمية منذ عقود وما زالت اندفاعاته مستمرة حتى اليوم، ولإبراز فرادة أدائه الفكري نستشهد بما عبّر عنه السوسيولوجي مشيل فيفيوركا[1] Michel Wieviorka، حينما رأى في موران وصديقه المقرّب ألان تورين[2] Alain Touraine أنهما يمثلان معا رموز السوسيولوجيا الفرنسية الأكثر شبابا من الناحية الفكرية؛ لأنه يتميّز بفكر عميق ومتجدد كله أصالة، يتجلى ذلك في حضوره المتميّز فلسفيا في عصرنا، وهو ما سيبدو في هذا المؤلف المتوسط في حجمه والضخم في تأثيره واتساع آفاقه.
إن كتاب "التفكير الشامل: الإنسان وكونه"[3]، عمل ينمُّ عن ثقافة واسعة لفيلسوف شامل، وهو مجموع بحوث قدّمها موران في مناسبات علمية وملتقيات أكاديمية وازنة، إذ تتنوع موضوعاته وتتفرع عناوينه، لكنها تجتمع كلها من أجل فهم الإنسان في تركيبته وتنوعه، كما يساهم بكيفية خلاقة في حثّنا على التفكير الكامل غير المجزأ، ويربطنا أيضا مباشرة بالواقع العلمي الراهن عبر التفكير في أبرز الفرضيات المفسرة للحياة والاجتماع البشري. إنه ليس مجرد كتاب، وإنما رواية مشوقة من فيلسوف جبار يختصر فيها السرديات الكبرى لحضارتنا والاتجاهات المفسرة لنشوء كوننا وسيرورة عالمنا المشترك.
1- طبيعة الأزمة الراهنة
يستشعر إدغار موران أزمة عميقة قد أوقعت بالوجود البشري الراهن، ويراها أزمة تخص الحضارة والمجتمع، وأزمة كوكب، وأزمة بشرية عاجزة عن الوصول إلى مرتبة الإنسانية الحقة؛ إذ يرجعها إلى أسباب متنوعة ومصادر مختلفة، كلها تجعل الجنس البشري يعيش في لحظة ما قبل العقل البشري؛ أي إننا لم نطأ بعد لحظة عقلانية حقيقية، وكل ما نعيشه فعلا هو مجرد عجرفة فارغة وغرور بشري كبير.
إن عنوان أزمة الوضع البشري الأول يتمثل في اضطراب علاقتنا بالطبيعة، وضياع ما يربطنا بها من أصالة ونقاء؛ ذلك أن العقل الغربي قد انتبه بكيفية متأخرة كعادته إلى واقع طمس أواصر الإنسان الخلاقة بطبيعته الأم، وهي علاقة توجد في معظم الحضارات العريقة. إن أول من فاقم علاقة البشرية بالطبيعة هي الأديان النكوصية، التي تبنت رؤى ارتكاسية، ويخص موران بهذا الشأن الدين المسيحي أساسا؛ لأنه ذهب إلى الاعتقاد في أناجيله المختلفة أن الإنسان هو كائن مخلوق، خلقه الله على صورته تماما، ويعني ذلك أن الإنسان قد حظي بخلق تفضيلي ومنفصل تماما عن صيرورة جميع الكائنات الحية الأخرى التي تعيش في الأرض، والتي ينتظرها الفناء النهائي، مقابل الخلود الأبدي للبشرية في عالم أرقى.
وخلال القرن السابع عشر، ستتبنى الحضارة الغربية فلسفيا ونظريا هذا الفصل بكيفية واضحة لا غبار عليها؛ إذ رغم مجهودات اليونان في تطعيم هذه العلاقة، وخاصة مع أرسطو الذي سيحدُّ الإنسان بالحيوان العاقل، رغبة منه في ردم الهوة بين الحياة البشرية والحياة الطبيعية، وابتداع جسور طرية لصلتنا بعالمنا الخارجي، فإن ديكارت ظل لاهوتيا عن الأصالة، وعزز الموقف المسيحي بالأدلة، ذلك أنه سيدافع على أن الإنسان مختلف تماما عن الحيوان، هذا الكائن الحي الذي اعتبره مجرد آلة صماء بلا عقل أو روح، فإيمانه المطلق بالعقل والتفكير كماهية إنسانية حجب عليه عناصر كثيرة، وشوش في نظر إدغار موران أكثر من غيره على علاقة البشرية بالطبيعة الخارجية.
وأكثر من هذا، فديكارت لم يكتف بهذا الفصل القاسي، وإنما دعا أيضا إلى استعباد الطبيعة والسيطرة عليها، [4] من خلال العلوم العملية، التي ستمكن الحضارة من السيطرة على الحياة الطبيعية والاجتماعية. إن نظرية السيادة الديكارتية تحمل في طياتها كل مسارات النمو الاقتصادي والتجاري والرأسمالي الذي يعيشه العالم والذي ابتلع في الوقت نفسه الثقافة الغربية كليا، ومنذ ذلك العصر إلى حدود بداية السبعينيات من القرن الماضي، حيث سينتبه الغرب لأول مرة للعلاقة الحميمية بين الإنسان والطبيعة، وهو ما جسده الوعي الأيكولوجي ونظريات البيئة.[5]
أما المدخل الثاني للأزمة، فيختصره موران في الفكر الاختزالي التبسيطي الذي أضحى هو السمة المميزة للحضارة، وهيمن على مجريات الحياة البشرية؛ ذلك أننا أصبحنا اليوم نعيش في عالم يتهدده الهوس الاستحواذي على الفرد والمجتمع عبر ضبط الأرقام والإحصاءات والبيانات الكمية، أو ما يطلق عليه "الفصام الكمي"، حيث يتم اختصار الثقافة والحياة في مجرد أرقام وإحصاءات، كما سبق ونبه الألماني هوسرل من قبل، الذي ذهب بعيدا، حينما رأى أن عمق أزمة الثقافة والعلوم الأوروبية تكمن في نسيان عالم العيش اليومي، والاستقرار على عالم الرمز الصوري الذي اعتبرته الحضارة هو العالم الحقيقي. إن هذا الوضع في نظر موران جعلنا اختزاليين تبسيطيين، وعاجزين عن التفكير الأصيل، الذي يتصف بالشمولية والتركيب.
ثم ثالثا، أن الأزمة تخص العلم والتعليم، والعلم يقصد به الفيلسوف العلم الإنساني أو العلوم الإنسانية والاجتماعية في مقام أول، التي صارت أقل تفكرية في مسارها وأكثر علمية في نزعتها مقارنة بما كانت عليه في الماضي[6]. ورغم جهود بعض التخصصات النادرة مثل علم النفس الاجتماعي، الذي يحاول المصالحة بين الفرد والمجتمع، بسبب انتباه العلماء لأحداث حاسمة في القرن العشرين، فدعت، ردًّا على ذلك، إلى إعادة النظر في الحدود القائمة بين النفسي والاجتماعي، ومع ذلك إن هذه الكوكبة العلمية صارت مجزأة، والتواصل بينها غدا محدودا جدا، مما جعلها تمضي في تفكيك فكرة الإنسان. إنها تفكّك العلاقة بين الفرد والمجتمع، فالنزعة المسيطرة في عالم السوسيولوجيا مثلا تعتبر أن الأفراد خاضعين بكيفية مطلقة للحتمية والضرورة مثل الدمى والآلات الخاضعة لقوانين اجتماعية وعادات ثابتة لا تتزحزح.
ونفس الواقع يسرى على علم الاجتماع البيولوجي، الذي يحمل ثقة زائدة في فهم المجتمعات البشرية بناء على فهمه للمجتمعات الحيوانية على مستوى الجينات بالخصوص، ذلك أنه يماثل بين أداء المجتمعات البشرية والمجتمعات الحيوانية؛ خاصة جماعات الشمبانزي، إذ يعتبرها موران مماثَلة محدودة وتبخيسية؛ لأنها تلغي المنظور النوعي والمتميز للمجتمع البشري[7]. فرغم أن البشر ينتمي من الناحية البيولوجية للعالم الطبيعي، وتحديدا لفئة الرئيسيات والثدييات، إلا أن هذا المنظور يظل عاجزا في تعريفه، إن الإنسان هو منظومة من الخلايا المنظمة، وهي بنات خلايا أخرى حية ظهرت على الأرض قبل أزيد من أربع ملايير سنة. لذلك، فالبشرية كائنات معقدة تحمل في داخلها تاريخ الحياة الأولى.
2- متاهة التاريخ
منذ اكتشاف أمريكا عام 1492، ركبت البشرية آمالا لا حدود لها، حيث كان أكثر متشائم في الماضي واثق من أن الغد لا بد أنه أفضل من اليوم، فإنسان التنوير مثلا كان متلهفا لزخم الحياة القادمة، باختصار يمكن القول إن فكرة تقدم التاريخ كانت لها أهمية قصوى في القرون السالفة. أما اليوم، فهناك عقبتان أساسيتان في وجه هذا المنظور، الذي أصبح كلاسيكيا ينتمي للتقاليد، أولا أنه لم يعد المستقبل عصرا ذهبيا قمينا بالإعجاب كما تصوره الناس سابقا في التطور الاقتصادي والنمو التقني والازدهار الاجتماعي؛ ذلك أن قانون التقدم كما أقرته فلسفات التاريخ كان الغد أفضل دائما بلا شك من حيث الرخاء والرفاهية مقابل الحاضر، مثلما تنبأ ماركس مثلا بحلول نظام الاشتراكية في المجتمعات القادمة التي ستضمن حياة الحرية والرخاء، فتم تصور المستقبل باعتباره فترة ذهبية قادمة، لكن هل ما زال هناك من يعتقد بهذا التصور اليوم؟ هل ما يزال بيننا من يصدق المستقبل؟
وتمثلت العقبة الثانية في سمة اللا متوقع أو عالم الاحتمالات البعيدة، التي غدت تسم المستقبل، حتى إنها جعلت فلسفات التاريخ عاجزة مع قوانينها أمام الحاضر المرتبك والمستقبل الملغز، كما جعلت هذه الظاهرة تجار علم المستقبليات يقتربون من الإفلاس؛ لأن المستقبل عند موران قد لفظ أنفاسه الأخيرة مع أحداث ضخمة لا أحد توقعها.[8] ونخص بالذكر هنا أحداث مايو 1968 التي شكلت ثورة الشباب والعمال في فرنسا وفي دول أخرى فأدت إلى إرباك السياسات ومعها التفكير، ثم سقوط جدار برلين في ألمانيا عام 1989 وانهيار النظام السوفياتي، ثم أحداث 11 شتنبر عام 2001 في أمريكا، حينما تعرض برجي التجارة في منهاتن للهجوم والتدمير، فنتجت عنه أحداث أخرى غير متوقعة تمثلت في الهجوم على العراق. ثم تلتها بعد ذلك أزمة 2008 الاقتصادية العالمية، التي فاجأت الخبراء الذين كانوا مطمئنين تماما للأوضاع الاقتصادية العالمية، بل ومتأكدون من أن لا شيء سيء يمكن أن يقترب من الاقتصادات والمنظومات المالية لعالمنا. ولازال العالم حتى اليوم منبهرا من أحداث الربيع العربي في 2011، التي تفجرت مثل الشلالات التي تتبع الزلازل، وما تلاها من سقوط أنظمة سياسية ما اعتقد أحد من قبل أنها ستنهار بتلك السهولة وبتلك المشاهد السّاخرة، وأخرها سقوط نظام الأسد في سوريا قبل نهاية العام الماضي، دون أن ننسى وباء 2019 الذي ما زالت آثاره سارية حتى اليوم، ولا أحد خطر بباله ولا توقعها، وأبرز من استوعب قلق اللا متوقع هو ذلك التعبير المدهش الذي أورده موران، بقوله: "كنا نريد الوصول للهند فاكتشفنا أمريكا".
كل هذه الأحداث غير المتوقعة هشمت قوانين التقدم التاريخي، وجعلت بضاعة الشركات المتاجرة في المستقبل رخيصة ومحدودة الإقبال، أو على الأقل صارت التوقعات قطاعية مشتتة، تخص كل قطاع على حدة، ولم يعد هناك محفز للتوقع الكلي الشامل. ومع ذلك يقترح موران مفهوم الانحراف، باعتباره القانون الأكثر ملاءمة في تفسير تقدم التاريخ البشري، الذي لا يتقدم في ظله التاريخ كما يتقدّم النهر الكبير، وإنما يسير بطريقة منحرفة ومتعرّجة مثل سرطان البحر، ولذلك يصعب التنبؤ بمآلاته؛ لأنه يقوم على الإبداع والابتكار، الذي لا أحد في الماضي استطاع التكهن به؛ لأنه ذو طبيعة ملغزة ومستقبله غامض إلى أبعد الحدود، لذلك على الفكر أن يبقى متأهبا ومحترسا في عالم أصبح كله مخاطر بعد أن فقد أمانه.
3- رؤية مركبة للوضع البشري
في مقابل التفكير التبسيطي والاختزالي للوجود البشري، يقدم موران الفكر المركب كنموذج علاجي للأزمات العالمية ومخاطرها التي لم يعد أحد معفي منها. والمركب Complexus هو المترابط والمنسوج بإحكام. أما التفكير المركب أو المعقد، فهو تفكير يقوم بالربط من خلال التحديد السياقي؛ أي من خلال الوصل بالسياق من جهة، ومحاولة فهم ما معنى منظومة ما من جهة ثانية. إن التفكير المركب عمل تجديدي في الفلسفة، يماثل ما قام به ديكارت في فلسفة القرن السابع عشر، حيث يقودنا موران عبر منهجه الخاص لعلاج الأزمات المتشابكة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وفي المعرفة في العصر الراهن.
أول ملاحظة مهمة يسجلها موران في فهمه للإنسان، هو استبعاده لهذا المفهوم نفسه (أي الإنسان)، وتعويضه في المقابل بمفهوم الكائن البشري؛ لأن مفهوم الإنسان يحيل على الفرد ويقصي نهائيا المجتمع، كما أنه ذو حمولة ذكورية تستبعد من الاعتبار الجانب الأنثوي. أما الكائن البشري، فهو ذو أبعاد خصبة ومتنوعة، وثالوثي المنزع؛ إذ يشمل الفرد والمجتمع والنوع البشري. وفي هذا الصدد، يقصي موران التقابل القديم بين الفرد والمجتمع، أو يقدم أحدهما عن الآخر، كما ينتقد التعليم والفلسفات التي تفصل بين هذه العناصر في بحث الكائن البشري، ومثال ذلك في دراسة الدماغ التي تقوم بها علوم الأعصاب منفصلة عن الدراسة السيكولوجية التي تتم في علم النفس، حيث يتم فصل العلوم الحقة عن العلوم الإنسانية والاجتماعية في تحليل نفس المكوّن؛ ذلك أن الكائن البشري هو في نفس الوقت فرد ومجتمع ونوع، فالجزء موجود في الكل، والكل بدوره موجود في الأجزاء. لهذا لا يمكننا الفصل بين الفردي والاجتماعي والبيولوجي؛ لأن كل واحد لا يستطيع العمل منفردا دون الآخر، حيث تقبع تفاعلات مركبة وراء هذه الأقانيم الثلاثة للوجود البشري، والتعليم الراهن ملزم باستيعاب هذا الثلاثي في مناهجه وبرامجه... إن المعرفة الملمة بالكائن البشري بكل ثرائه المركب، هي أحد العناصر الضرورية ليس لفهم الكائن البشري فقط، وإنما من أجل تحسين العلاقات بين البشر؛ لأنها في المقام الأول روابط بين الشعوب والأديان وعلاقات في الشركة والجامعة والثانوية...
يذهب موران إلى أنه باعتبارنا كائنات بشرية، فنحن متّحدون مع كوننا، كما أننا جزء لا يتجزأ من عالمنا الطبيعي الفيزيائي والبيولوجي الكوني، غير أننا كائنات تتميز عنه بثقافتنا ووعينا وهويتنا البيولوجية والأنثروبولوجية الخاصة المزدوجة، وبهويتنا البيولوجية الكونية أيضا. وتبعا لذلك فالكائن البشري هو فرد اجتماعي بدون ريب، حيث توجد بيننا وبين المجتمع علاقة مركبة ومتميّزة، فالمجتمع من جهته يعمل على تكييفنا مع سيرورته وأعرافه، ومع ذلك فالأفراد قادرون بدورهم على تحويل المجتمع عن طريق الاختراعات والابتكارات والثورات، فالمجتمع يتحقق بواسطة الفرد، والأفراد تتحقق ماهيتهم بواسطة المجتمع، فالمتأمل يلاحظ حاجة الطفل منذ صغره للأبوين وللحنان والاهتمام، وإذا كبر وترعرع؛ إذ يكبر معه هذا الشعور فيتوسّع ليشمل حاجته للوالدين والحزب والأصدقاء ثم الوطن، [9] ذلك أن العيش الطبيعي في نظر إدغار موران هو حركة دائمة ينتقل بفعلها الكائنات البشرية من الأنا إلى النحن ثم من النحن إلى الأنا بكيفية دائمة.
إن الفكر المركب يتبنى فكرة أن الكائن البشري ليس مجرد كائن عاقل كما تصورته الفلسفة القديمة Homosapiens أي إنه يحمل عقلا يميزه، فهناك بعد ثاني يتمثل في العته والهذيان، الإنسان الهذياني Homodemens والمجنون مثل هتلر ونابليون، بالإضافة إلى أنه إنسان صانع Homofaber؛ أي إنه يصنع الأدوات ويستخدمها. إن الإنسان كائن تقني بامتياز، لكن هذا البعد العلمي والتقني المتطور الذي أبداه في العصر الحديث لا يقصي بالضرورة الجانب الأسطوري والديني في طبيعته؛ لأن الكائن البشري بقدر ما تزيد سلطته على العالم بقدر ما يتعزز عجزه وقلة حيلته في مواجهة الموت والألم، ولذلك يصبح الدين في العالم الراهن ذي طبيعة جوهرية.
لقد سجلت الأديان حضورها المكثف في العصر الراهن، سواء في العالم الغربي الذي عادت الأديان إلى الظهور والانتشار من جديد خاصة في أوروبا الشرقية بسبب إخفاق الشيوعية وفشل وعودها بتحقيق فردوس في الحياة الدنيا، أو العالم الشرقي الذي يأخذ فيه الدين أبعادا خاصة، حتى أنها تُعرّف مجتمعاته بأنها مجتمعات متدينة بالهوية والتاريخ، حيث العقيدة الدينية أهم من الخبر والحرية، غير أن الدين في حد ذاته كدين لا يعني التخلف ويحمل ما هو سلبي بالضرورة، إلا إذا كانت هذه المعتقدات عائقا أمام العيش المشترك وقواعده التي أقرها العصر وتوافق حولها معلمو البشرية وتم تدوينها في معاهدات وإعلانات عالمية، إن موران يرى أن الوازع الديني والأسطوري مذهل في الإنسان مثل الجانب التقني؛ وبالتالي يتعين عدم الفصل بين الإنسان المتدين والإنسان المتولوجي والإنسان الصانع، إذا أردنا فهما شملا ورؤية مركبة للكائن البشري غير مجزأة ولا منقوصة.
4- مطلب الحياة الشاعرية
بناء عليه، فالإنسان هو ليس كائنا عاقلا وحسب، وإنما هو كائن بشري متنوع، يجمع بين العقل والجنون، صانع ولاعب، كائن ديني وميثولوجي، إنه ثراء خاص يميّزنا، ويتعيّن على العلم والتعليم والسياسات أن تأخذ هذا التنوع بعين الاعتبار، وألا تقصي فينا كل شيء رائع وبالتالي تبقي فقط على ما هو كمي اقتصادي في تقدير البشرية مثلها في ذلك مثل الكائنات الحية الأخرى، كما يقتضي هذا الوضع أن يعيش الإنسان حياة شاعرية مختلفة عن المألوف؛ إذ يميز موران في السياق بين الحياة النثرية والحياة الشعرية؛ ذلك أن حياة النثر لا تسمح للكائن البشري القيام إلا بما يضمن له البقاء على قيد الحياة، من تناول الطعام بكيفية عادية إلى حاجة التناسل مثلما يتناسل الحيوانات، ثم الخوض في العمل وهكذا دواليك، في وضعية تخدم الدولة والمجتمع وتنسى حاجيات الفرد. وبخلاف ذلك، تكتسب الحياة الشاعرية التي ينشدها الفكر المركب أهمية خاصة؛ إذ يرى موران أنه على الإنسان أن يسكن الأرض بكيفية أكثر شاعرية، ويعيش أيامه بطريقة شاعرية، إنها طريقة الوجود التي تجعلنا نشعر بالجمال والجودة في العيش؛ إذ لا تتوقف عند هاجس البقاء فقط، وإنما تطمح إلى تحقيق الازدهار الذاتي، عبر العيش وفق أجود ما هو شاعري في الحياة، سواء في الزواج والحب، أو في الشغل، أو عند الدراسة ووقت الفراغ، وفي علاقتنا بالمجتمع والأصدقاء، ولذلك على الفكر السياسي[10] ألا يبقى كلاسيكيا ويتجاهل بالتالي حاجيات الكائن البشري الشاعرية، التي هي وحدها ترفعنا إلى مصاف الإنسانية الخالدة.
إنها دعوة جادة يوجهها موران للتعليم الراهن، من أجل توحيد المعارف الآتية من العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الطبيعية، وتجاوز استمرارها في الانشغال منفصلة مثل جزر، بغية توفير أجود بيئة لفهم الكائن البشري، ولا سيما الانفتاح على الأدب، الذي تكالبت عليه النخب التكنوقراطية والمجتمع الصناعي، من خلال تنقيصها من أهميته ودفعه في اتجاه وضعية يكون هامشيا على مجريات التعليم والحياة الاجتماعية، وهكذا حرمان الكائن البشري من وسيلة خلاقة من وسائل المعرفة.
يرى موران أن الروايات العظيمة بإمكانها أن تطلعنا على ما لا يقدر أي علم آخر أن يطلعنا عليه؛ لأنها تقدم لنا كائنات بشرية تعيش داخل عالمها الذاتي ومشاعرها وأحاسيسها وعواطفها وأفكارها وبيئتها ووسطها الاجتماعي كما نجده في أعمال بالزاك الكبيرة، أو في رواية الحرب والسلام لتولتسوي، أو لدى أدباء كبار مثل دوستويفسكي وبروست؛ إذ حان الوقت للتوقف عن اعتبار الروايات الخالدة مجرد مصدر للمتعة الجمالية، وإنما هي وسيلة بارعة لفهم الكائن البشري وتذهن العالم الذي نعيش فيه. فيمكننا أن نرى الواقع بوضوح بين المتخيل والواقعي الذي تطرحه الرواية، وسنستطيع عيشه بأفضل ملاءمة، وتحصيل إضاءات وإشراقات بشأن الكائنات البشرية، وخاصة الحاجة للاعتراف به كما عند هيجل وبعده أكسيل هونيث.
إن الكائن البشري هو رغبة في الاعتراف، كل شخص بحاجة للاعتراف به من طرف الآخرين، وهو ما تترصده باحترافية الأعمال الأدبية والفنية، التي تكشف لنا عن حقائق ومعاني كانت ثاوية بالفعل في أعماق كل واحد فينا، دون أن نعي ذلك خاصة في سنوات الكائن البشري قبل نضجه واتساع مداركه، فالسينما تمكننا من تفهم أصناف أخرى من الناس يحتقرهم معظمنا في الواقع، مثل المتسولين وبائعات الهوى وغيرهم، وكذلك الحال مع الرواية، خذ نموذج رواية الأب الروحي لثنائي مارلون براندو وآلباتشينو؛ إذ تصور الحبكة أشخاصا مجرمين، حيث تشخص تفاصيل جرائمهم كلها، ولا تخفي أي شيء أو تستثني فعلا ما مما اقترفوه بحق المجتمع أو الآخرين، غير أن الرواية تصورهم من جهة ثانية بصفتهم بشرا مثلنا جميعا، يشعرون بمشاعر الأبوة، والصداقة، ولهم زوجات أو عشيقات يكنون لهم كل معاني الحب، ولهم ذكرياتهم الخاصة وماضيهم المجيد، ورؤيتهم للعالم وللغد، وأمالهم في أنهم سيعيشون في اليوم التالي سعادة وفرحة...
هل يُعقل أن نلغي كل ما قام به الشخص من تصرفات وإنجازات كريمة تجاه البيئة والمجتمع بمجرد أن يقترف مخالفة أو جريمة، فعندما نقوم بذلك كما هو الواقع، فإننا نلغي وجوده تماما، هل هذه عدالة؟ لذلك يقول فريدريك هيجل "إذا سميت شخصا ارتكب جريمة واحدة في حياته مجرما، فإنني أكون بذلك قد محوت تماما من حياته كل الجوانب المشرقة الأخرى، لاكتفائي بالتسليم بهذا الجانب الإجرامي دون سواه"، فالمجرم ليس مجرما وحسب، وإنما هو كائن بشري.
الخاتمة
إن الفكر المركب الذي يدعو إلي تبني أسسه موران، يرى في الحضارة المعاصرة أنها ما زالت حضارات تعيش في عصور ما قبل تاريخ العقل البشري، رغم ما نعقده تقدما هائلا بسبب العجرفة وميولات التمركز التي يروجها العالم الغربي والأمريكي خاصة؛ إذ يدعو إلى إعادة النظر في المعرفة وفي مصادرها وفي الذات العارفة، من أجل تأسيس المعرفة الشاملة القائمة على الفكر المركب، الذي يرمي إلى تقويض أسس التفكير الاختزالي الذي يهيمن على اللحظة الراهنة؛ فالكائن البشري ما زال غير مكتمل، ويحتاج إلى تفكير منفتح ومركب وأكثر شمولا للتحضير للمستقبل الذي يشي بمخاطر جمة وغير متوقعة.
[1]- مشيل فيفيوركا ولد عام 1946، هو سوسيولوجي فرنسي بارز في بحوث العنف السياسي والإرهاب والحركات الاجتماعية والأقليات، كان قد شغل منصب رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بين عامين 2006 و2010، من مؤلفاته العنف في فرنسا (1999).
[2]- ألان تورين (1925-2023) أحد كبار السوسيولوجيين الفرنسيين في القرن العشرين، انشغل بالتحولات التي عرفتها أوروبا خاصة مع نتائجها في القرن الماضي، من خلال اهتمامه بالمجتمع الصناعي، من مؤلفته: كتاب نقد لحداثة (1992).
[3]- إدغار موران، الفكر الشامل، الإنسان وكونه، ترجمة المنتصر الحملي، الصفحة سبعة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 2022
[4]- رونيه ديكارت، مقال في المنهج، ترجمة محمود محمد الخضيري، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1968، ص. 191
[5]- إدغار موران، الفكر الشامل، نفس المصدر، ص. 21
[6]- نفس المصدر، ص. 11
[7]- نفس المصدر، ص. 19
[8]- نفس المصدر، ص. 97
[9]- نفس المصدر، ص. 28
[10]- نفس المصدر، ص. 35