الفلسفة والدين: مكابدة العقل المرهقة
فئة : مقالات
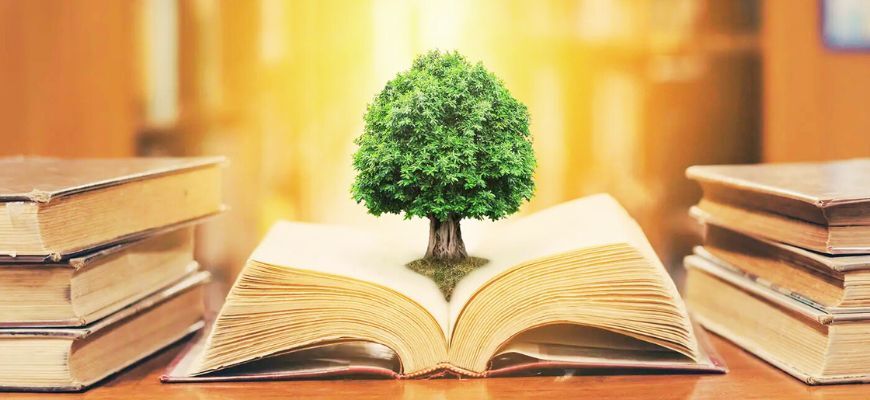
الفلسفة والدين: مكابدة العقل المرهقة
1- في طبيعة الدين الملتبسة: مقاربة منهجية - إبستمولوجية
يدخل الدين، في واقع التحليل السيكولوجيّ، حيّز العادات الذهنيّة الفوقية التي تمارس سطوتها على السلوك الإنساني بطريقة آليّة لا شعورية، ليتحّد مع كينونته الأصيلة مشكّلا أحد أبعاد الشخصية، بتوريات مختلفة ومتنوعة يقف الضمير على رأسها، أو لنقل في لغة التحليل النفسي "الوعي" أو "الشعور".
لا يتواءم التوصيف هذا مع التعريف الكلاسيكي لمفهوم الدين من منظور علماء الدين والمتفكرين في الخطاب الديني القائم على أساس "تفرقة واضحة بين الفكر الديني والدين؛ أي بين فهم النصوص وتأويلها، وبين النصوص في ذاتها".[1]
تفترض مقاربة الدين إذن، تسويغًا معرفيًّا يتعامل مع مفهوم الدين كنوع من تراث ثقافي يندمج في ظاهرات النشاط الإنساني على مرّ التاريخ، إلا أنّ الميلاد الأول للفكر الديني، وأعني به مطلق دينٍ سماويّ، سيتكلل في اللحظة التي عرف فيها الإنسان أنّ منطوقًا ما فوق سماويّ، يتخطى حدود مداركه في الزمان والمكان، قد اعتلن للتعبير عن مقدسٍ إلهي. وقد تهافت الباحثون في الدين، الدين الإسلامي على وجه الخصوص، لتبيان مجال الفاعلية الخاص بالنصوص الدينية بعيدًا عن مدى فاعلية العقل البشري والخبرة الإنسانية، إلى درجة التساؤل عن بعض المواقف التي كانت تصدر عن الرسول (النبي محمد) ما إذا كانت محكومة بالوحي، أم كانت محكومة بالعقل والخبرة.
على الرغم من ذلك، لا ينكر أحد أنّ للإسلام وجهه الإيمانيّ الكلي العام الذي تقدم به إلى الناس بوصفه "وحياً إلهيًّا يحمل إليهم حقيقة كلّية شاملة لا تختص بناس دون ناس ولا بقوم دون قوم"[2].
وإذا كانت مقاربة الدين، "من خارج" أي خارج الانتماء إلى أي منظومة دينية كانت، أمر شائك ومعقّد، فإنّ الالتفات إلى المشاعر التي ترتبط بالدين قد تدلل على مدى سطوته على البشر. يمكن اختصار هذه المشاعر بثلاثة: الأول، شعور المحبة الذي يربط الإنسان بالإله؛ الثاني، شعور الكراهية تجاه عدو الله والإنسان (إبليس الذي طُرد من الجنة). أما الثالث والأقوى بين السابقين، فهو شعور الخوف، (الخوف من غضب الإله).
فالدين إذا، على المقلب الآخر من كونه منظومة من الأفكار والمبادئ والقيم والبنى العقائدية والمسلمات النظرية، لا يسهل تحديد ماهيته ولا تعريفه في قالب حصري. فطبيعته أشبه بكتلة هلامية غير واضحة المعالم من المعتقدات والتصورات والغايات والخيالات البشرية المضخمة على مرّ العصور، تسعى أن تسكب نفسها في إطار فكري واضح متماسك البنيان، قد يتخذ عدة تسميات منها: "الذهنية الدينية"، "الفكر الديني"، "الأيديولوجيا الغيبية"، "التراث الديني"، "المنظومة الدينية"...
على هذا الاعتبار الذي قد يبدو إلحاديًّا أكثر من كونه موضوعيًّا، تقوم مهمة الدين أو وظيفته الذرائعية على تحويل مادته الهلامية الغامضة إلى منظومة فكرية، غالبا ما تنتج مفاهيمها وتصوغ ذاتها على قاعدة الخلط بين ما هو "ديني" أو ما فوق بشريّ، أو قدسي، وبين ما هو وضعيّ أو إنساني بحت؛ إذ يؤمن إشباعًا نفسيًّا من شأنه أن يقدم إجاباتٍ يقينية مطلقة عن الأسئلة الميتافيزيقية المستعصية الكبرى (المصير، الموت، خلود النفس، علة الوجود الإنساني، الغاية من الوجود...) وغيرها من الإشكالات الوجودية الكبرى، التي لا تجيب عنها الفلسفة بطبيعة الحال، بل تكتفي، بحسب قول الفيلسوف كارل ياسپرز، بطرح الأسئلة، الواحد تلو الآخر، والتي تدفع بالإنسان "خارج نطاق المألوف الجامد المتستر وراء وثوقية غير مبرّرة".
2- هل يستنفر العقل الفلسفيّ إزاء الأفكار الدينية التي لا يجوز فصلها عن محمولاتها العملية ولوازمها التطبيقيّة؟
ينبري المشتغلون في الدين، في كلّ مرة يتصدون فيها للإجابة عن طبيعته، للقول إنّه، في العموم، إلهيّ الوجود بشريّ الفاعلية، فهو من حيث وجوده رسالة من الله إلى الإنسان، ولا تحقق للغاية الإلهية من دون العنصر البشريّ.[3]
وتتحول العلاقة الموجبة، بدورها، بين إله سماويّ وكائن بشريّ، إلى إشكالية من نوع آخر، بين الدين بشقّه النظري، والتديّن بجانبه التطبيقي، حيث لا يمكن تناول أحدهما بمعزل عن الآخر، خاصة في ظلّ تعدد "الصّلات التديّنية المنتسبة إليه في إطارٍ من التطابق، التقارب، التباين، التعارض، التنافر، وصولا إلى التناقض والتضاد...ذلك أنه لا شيء غير الدين، بوصفه منظومة مفاهيم نظرية، يُنسب إليه هذا المقدار الهائل من المصاديق المتعدّدة من جهة ما تشترك به ومن جهة ما تختلف عليه، في ظلّ ادعاء كلّ مصداق منها أنه المطابق له والمتماهي مع حقيقته".[4]
على هذا الاعتبار، يمكن القول إنّ أيّ محاولة لوضع الجانب التطبيقي العملاني للدين على بساط البحث الفلسفيّ أمر غير جائز؛ لأنّ العقل الفلسفيّ بوصفه ملكة كليانية لها أدواتها الخاصة ومراتبها الذهنية من حاسة وفاهمة، بحسب التعبير الكانطيّ، سيكون مرهونًا باستقراء الجزئيات المحددة في زمان ومكانٍ محددين بهدف الوصول إلى حقائق عقلانية شاملة لن تفي الدين حقه، خاصة لمن تماسف مع الدين وجعل منه موضوعًا عينيًا قابلا للدراسة؛ أي عاينه من خارج تجربة الإيمان الحقيقيّة.
قد تكون مسألة التوحيد مثلا، في الدين الإسلاميّ، كعقيدة إيمانية خالصة، مستعصية على الفهم عند الذات التي لم تنشأ على التسليم بمثل هذه العقيدة. أما فيما يخص مسائل أخرى، من قبيل مسألة الخلق على وجه المثال، فإنها قابلة للنقاش الفلسفيّ؛ لأنها لا تتعلق بجوهر الدين بشكلٍ مباشر، وإنما تقع على إحدى ذاتياته التي تقبل الانفتاح على ذات قبالته تتموضع في الخارج الموضوعي، وتخضع بدورها لتغيرات عالم الظاهر، الذي منه تنطلق عملية التفكر والبحث.
وبالعودة إلى مسألة الخلق، يقدم لنا التراث اليهودي، والمسيحي أسطورة بداية الكون عند زمنٍ متناه في الماضي وليس بعيدًا جدًّا، وحجة الدين في ذلك، هي فلسفية بامتياز، وهي الشعور أنه من الضروريّ أن تكون هناك علّة غيبية أولى لتفسير وجود الكون. هذه الفكرة بالذات، لم تكن محببة في التراث الفلسفي الإغريقيّ القديم (أرسطو ومعظم الفلاسفة اليونان)؛ لأنها توحي بتدخل ربّاني أكثر مما ينبغي. هذا السجال، بين شيئية الكون أي جانبه الصوري والمادي، وبين روحانيته الكامنة في علته الغائية، يفتح شهية العلماء على نقد كل من الفكر الديني والفلسفي على حد سواء، في إيدان لزمن تسيّد المعرفة العلمية على الساحات العالمية المعرفية والثقافية، كما صرّح بذلك العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ، في كتابه "تاريخ موجز للزمان"، في استعارته من الفيلسوف الألماني الفذ إيمانويل كانط إحدى نقائض العقل التي تتساوى فيها الحجج ونقيضاتها قوة ومنطقًا، كالإيمان بأنّ الكون له بداية في الزمان، والإيمان بالدعوى النقيضة من أن الكون قد وُجد دائمًا.[5]
تقتضي غائية العلم، في الكثير من الأحيان، أن تستنزل كل من الفلسفة والدين في تعاليهما، لكنها لا تستطيع أن تمنع العلم نفسه من الانزلاق في آتون الميتافيزيقا، عندما يقف على حدود أي استعصاءٍ تجريبيّ (فيزياء الكوانتم خير مثال على ذلك، والكثير من العلماء أقروا بعجز الفيزياء أمام الميتافيزياء، اذكر على سبيل المثال لا الحصر: بريجيت فالكينبورغ في كتابها ميتافيزيقا الجسيمات، فرنر هايزنبرغ في كتابه الفيزياء والفلسفة، ....)
3- إشكالية العلاقة العضوية بين الثابت الدينيّ كمنظومة عقائدية تتصف بالثبات والتعالي، وبين المتغيّر الفلسفيّ الخاضع للتحولات الظرفية المعقدة
يبدو الحديث، للوهلة الأولى، عن علاقة الدين بالفلسفة قضية مستهلكة من فرط تناولها على مدار قرون خلت، إلى درجة يمكن القول فيها، أنّه ما من فيلسوف لم يكن ممسوسًا بهمّ ديني، وما من باحث في الدين لا تشوبه شائبة الفلسفة؛ ذلك التشابك الهميّ، لا يمنع في المقام الأول من القول إنّ إجراءات الفصل الحاد بين المفهومين، إنما تقوم على نخبوية الفلسفة بالضدّ من عمومية الدين. فالمجال الذي يتأطر فيه الحديث عن أنه "ليس ثمة فلسفة بلا ميتافيزيقا"، على ما يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر، إلا أنها ميتافيزيقا من نوع مغاير عن الإيمان الميتافيزيقي بالوعود الدينيّة التي تعقد على آمالٍ إنسانيّة تصاحبها لوازم طقسية محددة.
ولئن يجنح الكثير من المفكرين والباحثين إلى زج الدين في دائرة الفكر الميتولوجي الذي يشكل العصب الرئيس لكل الأديان. فالميتولوجيا، هي "دين بالقوة"، كما يذهب المفكر السوري صادق جلال العظم في كتابه نقد الفكر الديني؛ إذ تحتوي على عناصر التعزية والمواساة الضرورية لكل دين.
وإذا كان في هذا الاعتبار من تجنّ على الدين بوصفه ميتولوجيا بالقوة؛ إذ يقصي منه جانبه المتعالي إلى حدّ الإلغاء الكليّ، فإنّ الرابط العضوي الذي يجمعه بالفلسفة والفنّ قد يخفف من تهمة الميتولوجيا الملاصقة للتفكير الديني، في ثالوثية غير مقدسة. ففي الفلسفة، تلعب الميتولوجيا دورًا بارزًا في تفسير الوجود وتعليل الظواهر والأحداث الكونية. أما في الفنّ، فإنها استجابة جمالية لكلّ ما يقع تحت مدارك الإنسان تاركًا في نفسه أثرًا شعوريًّا يتجلى في تعبيرات فنية خلاقة ومبدعة.
قد تكون الميتولوجيا أحد الروابط الخفية التي تجمع الإرث التاريخي للدين والإرث التاريخي للفلسفة، فإنّ عنصر الاشتراك الثاني لهذين الكيانين، هو التطلع نحو الحيّز التأمّلي، وقابلية الانفتاح على ممكنات التأويل الهائلة التي تستلزم أدواتٍ منهاجية وعدة مفاهيمية تعين الذات في عملية التفسير والتأويل، وتخلق فضاءً آمنا للاشتغال العقليّ في بحثه عن حقيقة متعالية، ترانسندنتالية، مجاوزة تريح الكائن الإنسانيّ من أشدّ لحظاته المحبطة، عندما تقلقه أسئلة الفلسفة، وتريحه إجابات الدين.
على اعتبار كهذا، تصعب المقارنة بين الخطاب الديني كترسانة مغلقة من المسلمات العقائدية والبنى الإيديولوجية الصارمة التي لا تقبل النقد ولا المساءلة في أصولها، وبين الخطاب الفلسفي العقلاني كخطاب معرفي، نسقي، منطقي محكم في إطار من القضايا والأفكار والمفاهيم السائلة التي تقبل النقد والمساءلة والدحض والتجاوز.
قيل الكثير في العلاقة التنافرية التاريخية بين الثابت الديني، اللاتاريخي، المافوق زمني، وبين المتحوّل الفلسفي الخاضع لتبدلات التاريخ الوضعي البشريّ، وما يترافق معه من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ... ما يسمح بالقول إنّ الهوية الدينية لأي مؤمن تنمّ عن نزوع لديه، إلى إبراز مسوّغات تفوقه على غير المؤمن من خلال إظهار مدى ضلاله وحياده عن صراط الحق المستقيم، مثلما تهدف إلى توكيد الذات المنتمية إلى ما يتجاوز كل ما هو دونيّ- دنيوي.
من الطريف مثلا، أن يسخر بعض أئمة الدين من عقول الفلاسفة الذين أضلهم إبليس من حيث لا يدرون. يقول الإمام جمال الدين ابن الجوزي، صاحب كتاب تلبيس إبليس إنّ "السوفسطائية، والدهرية، والطبائعية، وأديان الشرق الأقصى، والمسيحيّة، وعلم الكلام، وفرقة المعتزلة... هي من أعمال إبليس ونتيجة لتلبيسه على المفكرين والعلماء".[6]
وقد حكي عن مصالحات تاريخية حصلت بين الدين والفلسفة مع القديس أوغسطين وتوما الأكويني والفارابي وابن سينا وابن رشد وسواهم ممّن وظفوا العقل في خدمة النقل عبر الانفتاح على ممكنات التأويل المتنوعة وقابليات الفهم المختلفة، إلا أن التأويل في فضائه اللامتناهي، وعلى الرغم من تلك المصالحات المعقودة لتوائم الديني مع الدنيوي، قد انقلب في بعض الأحيان ليخلق ساحة للصراعة الإقصائي، بين من أعمل عقله لتمييع الدين كي يتلاءم ثباته الفوق - زمني مع تاريخية العيش في واقع زمني محدّد، ما أدى إلى انبلاج الأحكام والأعراف والقواعد السلوكية التي تحدد رزمة المسموحات والممنوعات في كل دين (كما هو حاصل في علم اللاهوت، وعلوم الشريعة، وعلم أصول الفقه...)
إلا أن التلاقي الأرحب بين الدين والفلسفة قد يلقي بظلاله على المسطح الإطيقيّ الذي تندرج فيه القيم الأخلاقية المتعالية كغايات تقصد لذاتها وليست وسيلة لتحقيق غايات أخرى. فالخير والشرّ مثلا، والحق والواجب، والعدالة والفضيلة وغيرها من المفاهيم الأخلاقية، هي غايات كبرى يسعى الإنسان إلى بلوغها لتحقيق كماله الأخلاقي، سواء أكان مصدرها دينيًّا ام فلسفيًا أم وعيَا ذاتيًّا يستنبطه الضمير الفرديّ من أعماقه.
وإذا كان الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط قد ميز بين التعاليم الأخلاقية التي تقوم على مبادئ التجربة الإنسانية البحتة، وبين القوانين الأخلاقية التي لا تُلتمس في طبيعة الإنسان، ولا في ظروف العالم الذي وُجد فيه، بل لا بد من البحث عنها بطريقة قبلية في تصوّرات العقل الخالص وحدها، فإن ضرورة إعداد فلسفة أخلاقية خالصة نقية نقاءً تامًّا من كلّ ما يتّصل بعلم الإنسان أو الأنثروبولوجيا، لا يتنافى مع إمكانية تحقيقها كقاعدة سلوك عملية. وهنا تكمن مهمة الفلسفة المتمأسسة على ميتافيزيقا الأخلاق، في الخلط بين المبادئ الخالصة القبلية والمبادئ التجريبية البعدية.[7]
خلاصة القول، مهما يكن من أمر الدين في بعده النظريّ، كجوهر "مقفل على ذاته، لا يختلف ولا يتخلّف، فيه حال استغناء عن تقوّمه بالموضوعات"، والكلام هنا لفياض[8]، فإنّه من العسير فصله عن شقه التطبيقي المغاير لأصول المعاملات (الزواج، الطلاق، التجارة، الإرث)، أقصد به جانبه الأكثر نبلا، وهو الجانب الأخلاقي، الذي تستمد منه الأديان كافة طاقاتها الروحية.
ختام القول، أرقى ما في الأديان، لعلها التجارب الصوفية التي لا تبرهن عن شيء بطبيعتها، وإنما هي تعميق ذاتي للدين، تحوّله من عقيدة جامدة إلى إحساسات ذاتية، تشحن ذلك القحط الداخلي بحرارة عاطفية متدفقة، يبلغ بها الوجد الصوفي أصفى مراتب الحلولية التي بها يندمج مع الروح الكونية الكلية، أو مع "الإله" بتعبير المؤمن.
وعلى الجانب الآخر، تقف الفلسفة مع فيلسوف الهدم فريدريش نيتشه، على النقيض من كلّ التباشير الدينية، والوعود الواهمة بالحرية والسعادة، في قوله إن الفلسفة ليست: "تأسيسا لديانة ولا تبشيرًا بحقيقة، ولا وعدًا بالحرية والسعادة، بل هي نبشٌ في الأسس، وتعرية للأصول، وإزالة للأقنعة، وفضح الأوهام..."
[1]- د. نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، الطبعة الثانية، سينا للنشر، جمهورية مصر العربية، 1994، ص 31
[2]- حسين مروة وآخرون، دراسات في الإسلام، دار الفارابي، بيروت ط. 3، 1985، ص 66
[3]- حبيب فياض، فلسفة التديّن، الطرق إلى الله في عالم متحوّل، دار الفارابي، الطبعة الأولى، بيروت- لبنان2023، ص149
[4]- المرجع نفسه، نفس الصفحة.
[5]- ستيفن هوكينغ، تاريخ موجز للزمان، من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، دار التنوير، بيروت- لبنان الطبعة الأولى 2016، ص 32
[6]- الدكتور صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة السادسة، 1988، ص 56
[7]- إيمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة وتقديم د. عبد الغفار مكاوي، راجع الترجمة د. عبد الرحمن بدوي، منشورات الجمل، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، 2014، ص 25-27
[8]- المصدر السابق نفسه، فلسفة التدين، ص 150






