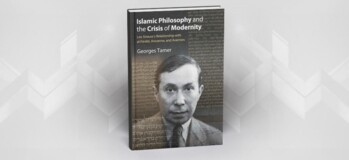المسيح بين النصّ والتأويل
فئة : مقالات

تبدو الحاجة إلى وجود ذات عليا يستمد منها الفرد مكوّنات وجوده وماهيته أمرًا شديد الأهمية، فانعدام الذات العليا عند غالبية البشر يعنى انعدام الشخصية الإنسانية التي يتطلب وجودها وجود الإرادة والقيمة الإلهية الأسمى، وبدونها لا محلّ لوجوده، ويمكن القول إن ثمة حاجة إلى كائن أسمى، وهي حاجة يواكبها قلق معرفي، ويصاحبها عجز عن تحقيق التماهي الكامل مع العالم بمكوناته، مع الرغبة المتنامية في تجاوز إشكاليات النفس والوجود والتطلع إلى عالم القداسة المفارق، وفي ظل العجز البشري عن تحقيق التماهي مع العالم بشتى مكوناته الإبستمولوجية، وفي ظل التطورات السوسيولوجية وما يصاحبها من تباين في الدوافع السلوكية وتعدد في الأنماط السياسية أصبحت الإحالة الدائمة على الله والتعويل عليه حيلة دفاعية للتعايش. ومع الرغبة في تجاوز إشكاليات النفس والوجود كان التطلع الدائم إلى هذا العالم الإلهي المتسامي عن العالم الأرضي.
لكن الله في عالمه المفارق لم يكن يشبع ذلك الاحتياج لــ "إله أكثر قربًا"، ويمكن القول إن المسيح عيسى بن مريم قد أغلق الهوة التي تفصل الإنسان عن الله، إذ تلاقى العالمان وضاقت المسافات إلى أقصى حد ممكن، وأصبحت "الفرصة مواتية لتكريس علاقة أكثر قربًا بين الإنسان والله، علاقة حرة يبدو فيها الإنسان حاضرًا بكل احتياجاته في هذا العالم."[1]
ويؤدي النص المقدس وظيفة مهمة في تأكيد وجود الله، وتأكيد اهتمامه بالإنسان، وينظر المؤمنون إلى النص المقدس باعتباره كلام الله، عن طريقه يتحقق الخلاص ويصل الإنسان إلى السعادة الروحية، بكل ما يتناوله من قصص وموضوعات للوحي تؤلف، كما يقول اسبينوزا، الجزء الأكبر من الكتاب، فتحتوي القصص على معجزات وروايات تقص وقائع غير مألوفة في الطبيعة.[2] ويحرص العقل الديني في سعيه إلى تبرير منطلقاته الإيمانية على تكريس اليقين وتأكيده، من خلال ما يسميه اسبينوزا أعمال الله، التي تعني الخروج الظاهر على نظام الطبيعة، فالله لا يفعل في الطبيعة مادامت تسير على نظامها المعتاد، وبالعكس تبطل فاعلية الطبيعة وعللها الطبيعية عندما يفعل الله، فالمؤمنون "لا تبدو لهم قدرة الله أحق ما تكون بالإعجاب إلا إذا تصوروا قدرة الطبيعة وكأنها مقهورة على يد الله."[3] ومن ثم، كان لابد من إبراز حضور الله فاعلاً أوحدًا يمكنه إبطال قوانين الطبيعة، ومن ضمنها قوانين الحياة والموت.
وقد حرصت المرجعيات الفقهية، في تناولها لإشكالية صلب المسيح، على نفي ألوهية المسيح والتأكيد، في الوقت نفسه، على نبوّته وما جاء به من معجزات تمّ إرجاعها إلى قدرة الفاعل الأوحد، أي الله، واحتاج فضّ الاشتباك إلى نوع من الحذر نظرًا لطبيعة المعجزات التي جاء بها المسيح، فهو يحيي الموتى، ويشفي الأكمه والأبرص، وكلها من صفات الله، ومن ثم كان لابد أن يكون الله فاعلاً محوريًا في قصة المسيح، بينما المسيح مجرد وسيط تتمثل فيه قدرة الله، التي تجلت في ثلاثية الصلب والموت والرفع.
اتفقت المرجعيات الفقهية فيما بينها على وقوع الصلب ومن ثم الموت من الناحية الشكلانية فقط، فقد غيَّر تدخل الله مسار الأحداث إلى منحى مختلف، ليُصلب شخص آخر ويموت بدلاً من المسيح الذي رُفع حيًا إلى السماء، واتسق ذلك مع ما تواتر من أخبار تؤكد وقوع حادثة الصلب بشكل بات متمفصلاً في الوعي الجمعي، فأصبح نفي وقوع الصلب يحمل تشكيكًا ضمنيًا في مسألة ظهور المسيح ونبوّته، وهو ما يتّسق أيضًا مع فاعلية الله الذي تدخّل في اللحظات الأخيرة لإنقاذ نبيه، وتمظهر ذلك في الطروحات الفقهية التي اتفقت على الخطوط العريضة واختلفت في التفاصيل. وهو ما تجلّى بوضوح في سياق تفسير الآية 157 من سورة النساء، إذ يقول تعالى: "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ".
ويعود الاختلاف في التفاصيل إلى طبيعة تناول القرآن لقصّة المسيح، من حيث أسلوب التعميم وعدم الاكتراث بسرد التفاصيل، وهى سمة كما يلاحظ "بسّام الجمل"، تنسحب على الخطاب القرآني النازع إلى إلغاء المرجعيات التاريخية وعدم الاهتمام بتعيين الأسماء وتحديد الأمكنة والأزمنة، وهو ما واجهه المفسرون بالسعي إلى ضبط الوقائع وتعيين المطلق من الأسماء والتدقيق الزمني للأحداث، أي "إعادة تشكيل الظروف التاريخية لأسباب النزول".[4]
ويقدم الطبراني (ت360هـ)، في هذا السياق، تفسيريْن متناقضيْن وقلقيْن بعض الشيء، يقول في الأول، عن تعليق ابن عباس عن قَوْلَهُ تَعَالَى: "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ"، يقول: قال ابنُ عبَّاس: "وَذَلِكَ أنَّهُ لَمَّا مُسِخَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ سَبُّواْ عِيْسَى وَأمَّهُ، فَمَسَخَ اللهُ مَنْ سَبَّهُمَا قِرَدةً وَخَنَازِيْرَ، فَزِعَتِ اليَهُود وخَافَتْ دعْوَتَهُ، فَاجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فثَارُواْ إلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ، فَهَرَبَ مِنْهُمْ وَدخَلَ بَيْتًا فِي سَقْفِهِ روْزَنَةٌ، أيْ كُوَّةٌ، فَرَفَعَهُ جِبْرِيْلُ عليه السلام إلَى السَّمَاءِ، وَأمَرَ يَهُوديًّا مَلِكُ الْيَهُود رَجُلاً يُقَالُ لَهُ طِيْطَانُوسُ أنْ يَدخُلَ الْبَيْتَ فَيَقْتُلَهُ، فَدخَلَ فَلَمْ يَجِدهُ، فَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ شَبَهَ عِيْسَى عليه السلام، فَلَمَّا خَرَجَ إلَى أصْحَابهِ قَتَلُوهُ وَهُمْ يَظُنُّونَ أنَّهُ عِيْسَى، ثُمَّ صَلَبُوهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَتَلْنَاهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ وَجْهَهُ وَجْهُ عِيْسَى وَجَسَدهُ جَسَد صَاحِبنَا، فَإنْ كَانَ هَذا عِيْسَى فَأَيْنَ صَاحِبُنَا؟ وَإنْ كَانَ هَذَا صَاحِبُنَا فَأَيْنَ عِيْسَى؟ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ وَاخْتَلَفُواْ فِيْهِ، ثُمَّ بُعِثَ عَلَيْهِمْ طَاطُوسُ بْنُ اسْتِيبَانْيُوسُ الرُّومِيُّ فَقَتَلَ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيْمَةَ".
وفي قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ"، أي ومَا قَتَلُوا عيسَى وما صَلَبُوهُ ولكن ألْقَى اللهُ على طِيْطَانُوسُ شَبَهَ عِيْسَى فقتلوهُ، وَرُفِعَ عِيْسَى إلى السَّماءِ. ووفقًا لذلك فقد ألقى الله شبه المسيح على وجه طيطيانوس الذي كان يطارده فقُتل بدلاً من المسيح الذي رفع حيًا إلى السماء. وفي الثانية يقول: قال الحسنُ: "إنَّ عِيْسَى عليه السلام قَالَ لِلْحَوَاريِّيْنَ: أيُّكُمْ يَرْضَى أنْ يُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي فَيُقْتَلَ فَيَدخُلَ الجَنَّةَ؛ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْحَوَارِيِّيْنَ فَقَالَ: أنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ شَبَهَ عِيْسَى، فَقُتِلَ وَصُلِبَ، وَرَفَعَ اللهُ عِيْسَى إلَى السَّمَاءِ"[5].
ويأتي الاختلاف بين الروايتين، فيما يخص شخصية المصلوب، نتيجة عدم التفات الخطاب القرآني إلى التفاصيل، كما أسلفنا، وتبدو المفارقة في سقوط اسم التلميذ المخلص، في حين ورد اسم المجرم "طيطانوس".
ويعطي البغوي (ت 416هـ) تفسيرًا مقتضبًا لا يخرج فيه عن دائرة إلقاء شبه المسيح على غيره فيقول: "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ" وذلك أنّ الله تعالى ألقى شَبهَ عيسى عليه السَّلام على الذي دلّ اليهود عليه، وقيل: إنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبًا فألقَى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه.[6]
وتبدو نزعة الانتقام من الواشي غالبة على المفسرين، ويتضح الميل إلى الردّ الكامل لاعتبار المسيح، وتحقّق المعجزة هنا دورين مهمين الأول هو إنقاذ المسيح، والثاني هو الانتقام من الواشي أيًّا كان شخصه.
ويقدم الماوردي ثلاثة تأويلات دفعة واحدة إذ يقول: "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ" فيه ثلاثة تأويلات: أحدها أنهم كانوا يعرفونه فألقى شبهه على غيره، فظنوه المسيح فقتلوه، وهذا قول الحسن وقتادة ومجاهد ووهب والسدي. والثاني: أنهم ما كانوا يعرفونه بعينه، وإن كان مشهورًا فيهم بالذكر، فارتشى منهم يهودي ثلاثين درهمًا، ودلّهم على غيره مُوهِمًا لهم أنه المسيح، فشُبِّهَ عليهم. والثالث: أنهم كانوا يعرفونه، فخاف رؤساؤهم فتنة عوامِّهم، فإن الله منعهم عنه، فعمدوا إلى غيره، فقتلوه وصلبوه، ومَوَّهُوا على العامة أنه المسيح، ليزول افتتانهم به.[7] وهذه التأويلات تجعل المسألة أكثر غموضًا وتناقضًا، ففي التأويل الأول يكرّر الماوردي مسألة إلقاء الشبه على غير المسيح، وفي الثاني يطرح إمكانية قتل آخر خطأً ظنًا منهم أنه المسيح المقصود، وهو أمر مستبعد، فكيف يكون المسيح بكل ما أثاره من صخب وما أتى به من معجزات مشهورًا بالذكر فقط، وكيف يجهل مجتمع صغير هيئة الرجل الأكثر شهرة فيه، ألم يكن هناك واحد ممن شهدوا المحاكمة ومسيرة المسيح في طريق الآلام ورفعه على الصليب نهارًا كاملاً يعرف أن المصلوب ليس المسيح، والأمر نفسه ينطبق على التأويل الثالث الذي يفترض جهل الناس بهيئة المسيح، وإن كان الماوردي هنا يطرح إمكانية عدم إلقاء شبه المسيح على شخص آخر.
أما ابن كثير (ت774ه) فيعود مجددًا إلى كون المصلوب ألقي عليه شبه المسيح، وأنه من تلاميذه الذين قرروا فداء معلمهم، فيقول: "فلما أحس بهم، أي المسيح، وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي، وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شابًا منهم، فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو، وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سِنَة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى: "إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ" (آل عمران: 55) فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه، ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه، وتبجّحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك، لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح، فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون، فإنهم ظنوا كما ظن اليهود، أن المصلوب هو المسيح بن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال: إنه خاطبها.[8]
ويتجاهل التأويل هنا بدهيات إنسانية مفروغ منها، فكيف تعجز أُمّ مثل مريم العذراء عن التعرّف على هيئة وجسد ابنها الأوحد، ويبدو التجاهل محاولة لتجاوز التفصيلات والانطلاق نحو النتائج.
أما الفيروز آبادي (ت 817هـ)، فيعود مؤكدًا على رواية الطبراني بأن الله ألقى بشبه المسيح على وجه طيطانوس الذي كان يطارده إذ يقول: "وبقولهم: "إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ" أهلك الله صاحبهم طيطانوس "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ" ألقي شبه عيسى على طيطانوس فقتلوه بدل عيسى "وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ" في قتله "لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ" من قتله "مَا لَهُمْ بِهِ" بقتله "مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ" ولا الظن "وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" أي يقينًا ما قتلوه "بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ" إلى السماء. ويعتمد السيوطي رواية الطبراني الثانية فيقول: "أخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين، فخرج عليهم من غير البيت ورأسه يقطر ماءً، فقال: إن منكم من يكفر بي اثني عشر مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، فقام شاب من أحدثهم سنًا، فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب، فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب، فقال: أنا. فقال: أنت ذاك، فألقى عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود، فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه.[9]
يؤدي التأويل هنا وظيفة تربوية في تثمين الفداء والتضحية، وعلى قدر الإيثار يكون الجزاء، فالحواري الصغير كان الأكثر شجاعة ورغبة في فداء سيده، فكان جزاؤه أن يبعث في نفس درجته ومكانته، فالمسيح كان سينجو في كل الأحوال دون حاجة إلى تضحية من حوارييه، لكن يبدو أن درسًا أخيرًا في الفداء كان مطلوبًا، ويمكن أن نلاحظ وجه الشبه مع ملابسات تضحية علي بن أبي طالب يوم اجتمع القوم من قريش لقتل النبي، فنام عليّ في فراشه وكان غلامًا صغيرًا أيضًا. وقد كان الفداء في الحالين مطلوبًا، لكنه لم يكن شرطًا للنجاة، فالمسيح رُفع من روزنة البيت إلى السماء، والنبي محمد مرّ أمام أعدائه دون أن يروه بعدما أغشاهم الله.
وهكذا لم تخرج المرجعيات الفقهية عن مسلّمة نجاة المسيح ورفعه حيًّا إلى السماء وإن اختلفت حول ملابسات حادثة الصلب وتحديد هوية الشخص المصلوب، ونلحظ اتفاقًا يوافق الحالة المزاجية العامة في مخالفة المسيحيين حول صلب المسيح، وتأكيد قدرة الله، فالمسيح لا حول له ولا قوة في مواجهة مكائد أعدائه حتى تتدخل إرادة الله فيلقى الشبه على غيره، ويرفع هو إلى السماء.
ولعل الاختلاف في التفاصيل يرجع إلى طبيعة التفسير نفسه، فقد انهمك بحكم مادته في استهداف النص رأسيًا من جهة الدلالة اللغوية متجاوزًا العلاقات الأفقية للنص مع الاجتماع والتاريخ، لكنه حين يعود للاصطدام بالنص نفسه في موضع آخر فإنه يضطر إلى إعادة تأويل النصوص بغرض التكييف بينها وبين الواقع. وقد تم، في سبيل ذلك، استخدام جميع أدوات التأويل اللغوية والأصولية التي وفّرتها المنظومة التقليدية ومن بينها النسخ، "كما استخدم منهجية التفسير بالرواية بعد أن صارت بحسب الأصول الشافعية نصًا مرجعيًا يستطيع محاورة النص القرآني بالتخصيص والتقييد"[10] وهو ما جرى عند اصطدام فرضية "عدم صلب المسيح" بالآيتين 33/ 34 من سورة مريم "وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا * ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ" (سورة مريم 33 - 34) فالنصّ يحدّد بشكل صريح الأطوار التي ستمرّ بها حياة المسيح ابتداءً من الميلاد مرورًا بالموت وانتهاءً بالبعث في الآخرة مثل سائر بني البشر. لقد قامت المنظومة الفقهية بتوظيف أدوات التأويل باعتبار أن استعمال الماضي في "وُلِدْتُ" واستعمال المضارع في "أَمُوتُ" و"أُبْعثُ" يتسق مع السياق الفقهي، فإن ميلاده قد حصل سابقًا، وأما موته وبعثه فسيأتيان فيما بَعدُ. وبالتالي يكون قوله "ويوم أموت" ليس معناه أنه قد مات، وإنما معناه أنه عند موته، فصيغة المضارع تعني الاستقبال في هذا المقام، وذلك بعد نزوله وقتله للدجال كما ورد في الأحاديث، فإنه يسلم من الموت على غير الإيمان بالله، فقد قال "ويوم أبعث حيًا"، وليس معناه أنه قد بعث يوم القيامة وقال القرطبي (ت671هـ): "... "والسلام علي"، أي السلامة علي من الله تعالى. قال الزجّاج ذكر السلام قبل هذا بغير ألف ولام فحسن في الثانية ذكر الألف واللام. وقوله: "يوم ولدت" يعني في الدنيا. وقيل: من همز الشيطان كما تقدم في آل عمران، ويوم أموت يعني في القبر، ويوم أبعث حيًا يعني في الآخرة، لأن له أحوالاً ثلاثة: في الدنيا حيًا، وفي القبر ميتًا، وفي الآخرة مبعوثًا، فسلم في أحواله كلها."[11]
بالتالي كان افتراض عودة أخرى للمسيح يحل إشكالين رئيسيين، الأول: تفسير معنى الوفاة الواردة في آيات القرآن، والثانية حسم مسألة رفع المسيح حيًا باعتبارها مسألة مؤقتة، فهو مثل غيره من الأنبياء، ومنهم النبي محمد، سوف يموت ويبعث يوم القيامة، فالنزوع إلى تمجيد النبي محمد ومكانته بين الأنبياء يقتضي عدم تمييز المسيح وحده دون سائر البشر بعدم الموت، وبالتالي كان الاتفاق على عودته أمرًا لا جدال فيه.
نعود إلى ابن كثير الذي يلخّص الاتفاق بين الفقهاء على عودة المسيح شرطًا من أشراط الساعة، فيقول في تفسيره للآية: "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" (النساء 159)، فقد اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في قوله "موته" على قولين: القول الأول: أنّ الضمير يعود إلى عيسى بن مريم عليه السلام، وعلى هذا يكون معنى الآية، أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلاّ سيؤمن بعيسى عليه السلام، وذلك قبل موته، أي عيسى، فإنه إذا نزل من السماء، وقتل الدجال، فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلاّ الإسلام، وحينها يؤمن أهل الكتاب به، قبل موته، عليه السلام، ويعلمون أنه حقّ، وأنه لم يمت من قبل. فالكلام في الآية عن علامة من علامات الساعة، وشرط من أشراط يوم القيامة، سيكون بعد نزول عيسى، وأنه قبل أن يموت في ذلك الزمان سيؤمن به أهل الكتاب. وقد ورد ما يؤيّد هذا القول من قول أبي هريرة رضي الله عنه بعد روايته للحديث الدال على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فعن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدلاً فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَد حَتَّى تَكُونَ السَّجْدةُ الْوَاحِدةُ خَيْرًا مِنْ الدنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" (النساء 159) (البخاري 3192 مسلم 220).
أما القول الثاني فهو: أن مرجع الضمير إلى الكتابي نفسه، وعلى هذا يكون معنى الآية، أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى، عليه السلام، وأنه حق، وأنه لم يمت، وذلك عندما يعاين سكرات الموت، ويرى الحقائق والبراهين، فعند موت ذلك الكتابي سيعلم أن ما كان عليه هو الباطل، لكن لا ينفعه ذلك الإيمان حينئذ. وبناءً على القولين السابقين فليس في الآية دليل أو إشارة على موته، عليه السلام، وإنما الكلام، في القول الأول، على أمر غيبي سيحصل في المستقبل، وهو بلا شك سيموت، عليه السلام، لكن بعد نزوله كما سبق. ويشير القول الثاني إلى أن المراد بقوله "قبل موته"؛ أي موت الكتابي نفسه. وقد رجح الطبري وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير القول الأول، قال ابن كثير: "وقوله تعالى: "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" (النساء 159)، قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، أي قوله تعالى: "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته"، يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام. وعن ابن عباس قال: الآية "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته"، أي قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وعن قال: قبل موت عيسى، والله إنه لحي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يعني بذلك قبل موت صاحب الكتاب، ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه علم الحق من الباطل لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، في الآية، قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى، وقال ابن عباس: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. وعن ابن عباس، قال: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام، ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير،ـ في رأى ابن كثير، هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن كذلك، وإنما شبّه لهم، فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه، وإنه باقٍ حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، ولهذا فإن قوله تعالى: "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته" يعني قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن وافقههم من النصارى أنه قتل وصلب، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض.[12]
ويأتي التأكيد على قيام المسيح بكسر الصليب إمعانًا في تأكيد ضلال النصارى، من وجهة النظر الفقهية، ويبدو الحسم الواضح بين البنية التقريرية للنص والبنية التأويلية الواردة بالتفاسير شرطًا أساسيًا للمحافظة على الاتساق العقدي الرامي إلى التفرد والاختلاف مع الآخر، فالأبواب موصدة أمام نقاط التقاطع والاتفاق الجوهرية كلها، وهو ما سعت المنظومة الفقهية إلى التأكيد عليه والترويج له بشكل دائم بهدف ترتيب العلاقات مع الآخر وبناء أسباب قوية تؤكد جدوى الرسالة الجديدة وأهميتها وفقًا لرؤية العقلية الفقهية.
وعليه، فإن البُعد الرومانسي لفكرة الله في المسيحية، حيث أصبح تجسد الله علامة فارقة تغيرت معها الصورة النمطية للإله المتعالي، لم تكن تتفق مع ميل المؤسسة الفقهية إلى الصعود بالألوهية مرة أخرى إلى عوالم المفارقة المطلقة، ليصبح المسيح مجرّد رسول من المطلق تمثّلت فيه قدراته ليس إلّا.
[1] سامح إسماعيل: الله والإنسان، دراسة في الجبر والاختيار، القاهرة، دال للنشر ومؤمنون بلا حدود، 2014، ص ص 11 ــ 12
[2] اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم حسن حنفي، القاهرة، دار وهدان للنشر، د.ت، ص 243
[3] المرجع نفسه، ص 221
[4] بسّام الجمل: أسباب النزول علمًا من علوم القرآن، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي ومؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ط2، 2013، ص ص 186-187
[5] الإمام الحافظ العلامة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: التفسير الكبير، مصنّف ومدقّق، سورة النساء.
نسخة منشورة على موقع التفسير، مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي،
- http://www.altafsir.com/indexArabic.asp
[6] الحسين بن مسعود البغوي: معالم التنزيل، مصنف ومدقق، سورة النساء، موقع التفسير، مصدر سابق.
[7] على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي: النكت والعيون، مصنف ومدقق، سورة النساء، موقع التفسير، مصدر سابق.
[8] الحافظ عماد الدين بن كثير: تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد على الصابوني، المجلد الأول، بيروت، دار القرآن الكريم، 1981، ص ص 455ـــ 457
[9] مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: تفسير القرآن، مصنف ومدقق، سورة النساء، موقع التفسير، مصدر سابق.
[10] عبد الجواد ياسين: الدين والتدين ــ التشريع والنص والاجتماع، بيروت، دار التنوير، 2012، ص ص84ــ 85.
[11]محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، نسخة مدققة ومراجعة، موقع التفسير، مصدر سابق.
[12] ابن كثير: مصدر سابق، ص ص 457ــ 458