المقاربة الثقافوية العلمانية/ والدينية: مقاربة تضليلية تعطل تشخيص واقعنا
فئة : مقالات
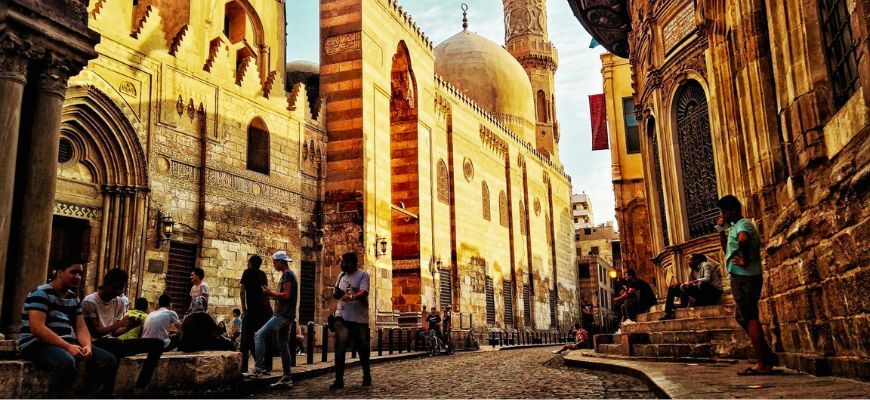
المقاربة الثقافوية العلمانية/ والدينية: مقاربة تضليلية تعطل تشخيص واقعنا*
في السياق العربي تقوم المقاربة الثقافوية على تفسير كل شيء في المجتمع والدولة، بالثقافة السائدة فيهما، وغالبا ما تختزل هذه الثقافة في المجتمعات العربية الإسلامية، إلى الدين الإسلامي تحديدا، ولاتعترف المقاربة الثقافوية بالأفراد، إلا بوصفهم منتمين إلى ثقافة ما، أو إلى إحدى الجماعات العضوية التي تتضمنها تلك الثقافة. فاختزال المقاربة الثقافوية للسياسة والاقتصاد وغيرهما في الثقافة، على الصعيد المعرفي التفسيري، يترافق مع ردّها الفرد إلى الجماعة التي ينتمي إليها، لهذا فالمقاربة الثقافوية في السياق العربي لا تعترف بالفرد بوصفه فردا، ولابوصفه شخصا يستحق الاحترام القانوني والأخلاقي، الحريات والحقوق الأساسية. فماهي أبرز السمات الملازمة للمقاربة الثقافوية العربية؟ أليست المقاربة الثقافوية يوتوبيا تعمل على تعطيل تشخيصنا للواقع العربي؟ ألا تعكس مرونة هذه المقاربة واجهة لمختلف التوجهات الإيديولوجية؟ أتعبر هذه المقاربة الشمولية على نوع من أحادية التفكير يرسم برزخا لرؤى لا تلتقي؟
يخص هذا الإشكال جزءا من فحوى كتاب "في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية، نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية"، للدكتور حسام الدين درويش، الذي نشرته مؤسسة مؤمنون بلاحدود، الجزء الذي يسائل المقاربة الثقافوية.
إذ ينبه درويش أننا غالبا ما نعرف الثقافة تعريفا شمولياً دون تحديد مضمون واضح للقيم والأفكار المؤسسة له، ولا للعلاقات القائمة بينها، وهو مفهوم لامعياري مادام لا يقيم تفاضلا بين الثقافات أو الجماعات أو الأفراد، فهو سمة إنسانية عامة، لكن الأمر لا يعني غياب الاختلاف المشكل لهذه الثقافة، بل إنه يغيب بالأساس في آلية قراءة الوضع العربي ككل، مما يجعله نموذجا يوتوبيا يرتبط بصورة ذهنية لاتعكس واقعا، ولمرونة هذا النموذج يسهل توظيفه ايديولوجيا في مختلف القراءات، حيث يتم اختزال الثقافة في دين ما، واختزال هذا الدين في نصوص أو ممارسات أو ايديولوجيات معينة. إنها نوع من الاختزالية المركبة، وهو أمر ناتج عن تشخيص لمشكلة يعاني منها المجتمع، مما يفرز نتيجتين متناقضتين، الثقافوية العلمانية التي ترفع شعار الإسلام هو العائق والثقافوية الإسلامية التي تطرح الإسلام هو الحل، والغائب هنا بالدرجة الأولى هو البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المشكل للمشكلة بالأساس، مما يجعلنا نتخبط في أعراض المشكل عوض التوجه صوب المشكل.
يركز درويش على أن المقاربة الثقافوية هي مقاربة جوهرانية ماهوية، مادامت تعتبر الدين جوهرا تابثا لا يتغير عبر الزمكان، الأمر الذي يخلق تغافلا عن التمايز الذي يخلقه التدين، وهو تغافل واعٍ يعبر عنه بالقول إنه نوع من الانحرافات التي لا تعكس جوهر الدين الحق، مما يبرهن على أن الثقافوية هي رؤية ماضوية تعكس أصلا نقيا ماهويا فوق تاريخي، وهي نفس الرؤية الثقافوية العلمانية، الاختلاف يكمن فقط في أن هذه الأخيرة تعتبر الأصل أصل سلبي وجب التخلص منه، والثانية تتغنى بهذا الأصل وتتمسك باسترجاعه لحل الاشكالات المعاصرة في سياقها العربي.
إن استحضار هذا الماضي سواء لتأكيد ضرورة إزاحته، أو مطلب استرجاعه يدخلنا في باب الاغتراب عن واقعنا، المحمل بمشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية يتم التغاضي عنها عبر التغني بالماضي المجيد، فوهم الأصل هو أصل تفكير المقاربتين.
إن الثقافوية تتسم بطابع الدوغمائية اللاهيرمينوطيقية، فكل اتجاه يركز على ما يخدم تقييمه للدين، فنصير أمام عملية تكفير ثنائية، تكفير علماني/تكفير ديني، الجامع بينهما غياب الإقرار بالاختلاف، مما ينتج أحادية الفهم الثقافوي أو الذهنية التكفيرية أو الإقصائية في خطابات الثقافويين.
في الحقيقة أن هذه الاختلافات تتأسس على مضامين النصوص الدينية المؤسسة لهذا الدين، المرتبط بالأساس بعلاقتها بالسياق السياسي المنتمية إليه، وهنا نصير أمام علاقة شائكة تجمع بين الثقافة والسياسة وتبعية أحدهما للآخر، مما يجعل المقاربة تعكس منظورا ميكانيكيا لاجدليا بسيطا يتبنى التعميم القائل إن الثقافة هي التي تنتج السياسة، وليس العكس. إنها بالأساس رؤية ثقافوية اختزالية بين السبب والنتيجة، أو بين الثقافة والسياسة. إن الرؤية الثقافوية تتسم ببعد لاأخلاقي يتمثل في تحويلها المجرم إلى ضحية والضحية إلى مجرم، أو في المساواة بينهما، أو ما أسماه درويش الاحتقار الذاتي الجمعي، فتتفنن الضحية في صورتها الجمعية في خلق تبريرات لتعمق احتقار ذاتها، فتصبح السلطة السياسية ضحية في الثقافة/ المجتمع، مع أنها هي الفاعلة، المقاربة الثقافوية تعمل على تبرئة السلطة، رغم أن تسلطها هو أساس المشكل، لكن المقاربة الثقافوية تميل كفة الاتهام نحو الشعب، العوام لقيمهم المتخلفة والرجعية (منظور العلمانيين مثلا)، أو قيمهم المنحلة التي لا تعكس الماهية أو الأصل الديني الحق، لهذا وجب حصر هذه الثقافة ومحاربتها، ألا تعتبر هذه القراءة أشبه بإطلاق أحكام أخلاقية في ميدان معرفي، فهل يستقيم الأمر؟
في الرد على هذا المحاججة المفترضة –يجيب درويش- ينبغي الانتباه إلى أن الرؤية الثقافوية تتضمن عددا من المفاهيم المعيارية الكثيفة؛ أي المفاهيم التي تعكس وصفا وتقييما، فالقول إن الثقافة هي السبب المفسر للسياسة، وتخلف المجتمع هو المسؤول عن طبيعة النظام الاستبدادي القائم، بكل سلبياته، يتضمن وصفا وتحليلا، وبعدا تقييميا/ أخلاقيا/سياسيا، لكن أليست المقاربة الثقافوية تتبنى رؤية تمايز كل من الدراسات السياسية والثقافية؟.
القول بعدم قابلية أو جاهزية المجتمعات العربية لتبني الديمقراطية، هو موقف سياسي يدعم الاستبداد السياسي عبر تسويغ مبرارات ثقافية ترفع عنه حرجية مواجهة المشكل الفعلي وترجعها لثقافة السائدة. مما يجعل الثقافوية نزعة إيديولجية، فمثلا الثقافوية العلمانية تحاول التملص من مواجهة الوضع السياسي لتواجه الثقافوية الدينية، وترجع كامل المشكل لتمسك هذه الأخيرة بالأصل اليوتوبي، فهي ترفع شعار الديمقراطية، لكنها لا تواجه الأمر سياسيا بل تسير باتجاه التركيز على الثقافة، فأولوليتها العلمانية وليس الديمقراطية، وهنا يشير درويش للصورة المتوهمة عن العلمانية بماهي استبعاد تامّ للدين وحصره في الحيز الخاص للفرد، حيث ترسم الدولة بماهي الإطار المعادي للدين، فلا مجال لتصالح مع الثقافة الدينية في المجال العام والمجال السياسي، رغم أن الأنظمة السياسية العربية تركز في كثير من المناسبات على استخدام الدين لتبرير سياستهم، وهنا يكمن التناقض، فالثقافويون العلمانيون يعترضون على استغلال الدين/الثقافة للسياسة، ولايعترضون على استخدام السياسة للدين/الثقافة، فالخطر لايكمن في استغلال السياسة للدين، بل في استغلال رجال الدين والثقافة الدينية للسياسة. إنها ثقافوية إيديولوجية لاتقبل بأي إمكانية للتعايش مع أعدائها، فالساحة الثقافوية ساحة لتفريغ الشحنات النقدية للمتدينين والعلمانيين على حد سواء، هذا التفريغ النقدي أو لنقل نوعا من الصراع المفتعل يخدم بالدرجة الأولى السلطة الاستبدادية، ويعمل بالمقابل على تعطيل تشخيص الواقع العربي الإسلامي، فما السبيل لإزاحة هذا الصراع الوهمي؟.
إن أي نقد لثقافوية العربية يجب حسب درويش، أن يأخذ بعين الاعتبار البعد السياسي-الاقتصادي وتأثيراته الكبيرة، في هذه المجتمعات وثقافاتها. إن هذه المقاربة الشمولية تجعل الفرد يقزم دوره إلى مجرد انفعالات غير فاعلة، وهي صورة مرتبطة باعتبار أن الثقافة سبب في حين إنها نتيجة، لكن ألم تفلح الثورات العربية في تجاوز المقاربة الثقافوية التقليدية؟ ألا تخضع هذه المقاربة لمنطق الصيرورة التاريخية؟
على عكس الثقافوية التقليدية ذات المضمون العام والمرن والجذاب، فإن الثقافوية الجديدة أقل جاذبية وشعبية، لهذا فهي قليلة الاستقطاب نوعا ما، أو ربما لازالت تعمل على تغدية هذا الاستقطاب. فهي تجذر مسألة التضليل بشكل أكثر حدة، إذ ترى أن المشكلة الأساسية التي ينبغي تركيز الانتباه عليها هي الإسلام/ المحافظ/المتخلف، لكن أليس الدين هو من يضفي الشرعية على الأنظمة الاستبدادية؟
بما أن المقاربة الثقافوي لاتاريخية، فإن سيرورتها بالضرورة تنم عن مسار أكثر دوغمائية، وهو ما عكسته الثقافوية الجديدة التي تمنح منتميها حق التخيير بين القبول بالنظام الاستبدادي أو العيش في كنف حرب مدمرة، أو التخويف بفوبيا حكم الإسلاميين المحافظين/المتخلفين، فلا خيار خارج هذا التخيير، فتصير الثقافوية الجديدة أكثر شمولية وأقل شعبية، فهي قد تعلن تبنيها للقيم الإنسانية ظاهريا، لكنها تنهج في الواقع أحادية التفكير، حيث ترفض وتصنف وتقيم المنتمين إليها انطلاقا من رؤية تقزيمية لاأخلاقية، فهي تحاكم المختلف لكنها ترفض أن تخضع لنفس التقييم. إنها تحاول أن تركز على نقد الثقافة بوصفها تحمل مضامين منحطة أو متخلفة، هذا النقد الذي يحمل تقييما لاأخلاقية تحمل الضحايا/الأفراد المنتمين لهذه الثقافة المسؤلية عن الحيف والاستبداد الممارس في حقهم وتبرئ بالمقابل السلطة السياسية.
إن هذا التشخيص الذي يقدمه الكاتب حسام الدين درويش من خلال كتابه "في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية، نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية"، لمختلف المقاربات الثقافوية يحمل في الواقع أهمية وكذا راهنية كبرى، أولا لأنه يقرأ الواقع العربي خارج النموذجين المعتادين: الثقافوية الدينية والثقافوية العلمانية، رغم أنه لم يتحامل على الاتجاه الأول لأن الساحة العربية الاسلامية تكفلت في أغلب الأحيان بهذا الأمر، بل وجه انتقاده الكثيف للمقاربة الثقافوية العلمانية التي تدعي تبني القيم الغربية الهادفة لتحقيق الديموقراطية والحريات، لكن ممارستها لا تهدف سوى لتكفير أي تفكير خارج خنذق مفهومها للعلمانية، مما يعكس توجها إيدولوجيا أحادي الرؤية والتوجه يرفض الدين كواقع ثقافي، لكنه يقبل به كأرضية تمأسس السلطة السياسية، مما يحيلنا على مقاربة ثقافوية انتهازية نوعا ما، تساهم بوعي أو لاوعي في خلق تمويه يغدي السلطة السياسية ويعمق الجرح العربي، الأمر الذي يجعلنا ندور في حلقة مفرغة تدور رحاها وفق مقاربة ثقافوية لاواقعية ولاتاريخية، ثم عملية طرح المعطى السياسي والاقتصادي كعامل مسؤول وفاعل في هذا الوضع الاسلامي العربي له جانب من المعقولية التي غالبا مانتجنب الخوض فيها.
* يأتي هذا المقال في إطار قراءة في كتاب د.حسام الدين درويش "في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية، نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية" الذي أصدرته دار مؤمنون بلاحدود.






