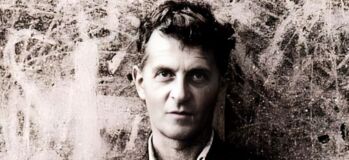المنعطف الميتافيزيقي للفلسفة التحليلية المعاصرة: «سول كريبكة» نقد «سول كريبكة» لنظرية الأوصاف، محاضرات التسمية والضرورة: ج2
فئة : ترجمات
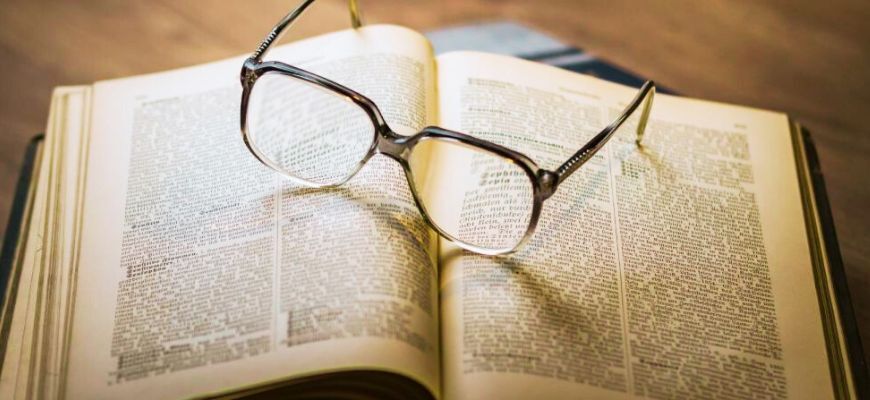
المنعطف الميتافيزيقي للفلسفة التحليلية المعاصرة: «سول كريبكة»
نقد «سول كريبكة» لنظرية الأوصاف، محاضرات التسمية والضرورة: ج2
سبق أن أشرنا إلى تعرُّض نظرية الأوصاف لبعض الانتقادات التي أظهرَت شيئًا من عيوبها، وقد ألمح «فريجة» بالفعل إلى أحد هذه العيوب في وقتٍ مُبكِّر، وهي مشكلة «تفاوت الأوصاف» في تحديدها لمعنى الاسم، يقول «فريجة»:
- "تتفاوت الآراء فيما خصّ معنى أسماء العَلَم الأصيلة، مثل «أرسطو». يمكن، على سبيل المثال، اقتراح ما يلي: أرسطو هو تلميذ أفلاطون ومُعلِّم الاسكندر الكبير. من يُسلّم بهذا، سيفهم معنى العبارة "وُلِدَ أرسطو في استاجيرا" بشكل مختلف عمَّن يفهم معنى الاسم «أرسطو» على أنه: الاستاجيري مُعلِّم الإسكندر الكبير. فطالما بقي المُسمَّى واحدًا، تظل هذه التفاوتات في المعنى مقبولةً، لكن يجب تفاديها في منظومة العِلم الاستدلاليّ، ولا ينبغي ظهورها في اللغة المثالية."[1]
بحسب «فريجة» إذن، ثمَّة شيء من الضعف أو عدم التماسك في لغتنا؛ بعضهم يأخذ الاسم «أرسطو» بمعنى، وبعضهم الآخر بمعنى آخر. وليس هذا كل ما في الآمر، حتى المُتكلِّم الواحد عندما يُسأل: "أي توصيف تتخذه بديلًا عن الاسم؟" فستجده ما أحرز جوابًا؛ هو في الواقع يعرف عن صاحب الاسم أشياء، لكنه يشعر أن أي أمر محدد يعرفه عنه، إنما يُعبِّر عن صفةٍ إمكانيةٍ فيه. إذا ما أردنا بالاسم «أرسطو»: الرجل الذي علَّمَ الإسكندر الكبير. فقولنا "أرسطو كان مُعلِّم الإسكندر الكبير" هو مجرد تحصيل حاصل Tautology، وليس الأمر كذلك بالطبع، بل قولنا هذا يخبر عن أمر وقع، وهو أنَّ أرسطو قد علَّم الإسكندر الكبير، وهذا مما يمكن أن نكتشف كذبه. (وليس تحصيل الحاصل – بالتعريف – بخبرٍ جديد، ولا هو مما يمكن أن نكتشف كذبه). وهكذا، فلا يمكن أن يكون "كَوْنه مُعلِّم الإسكندر الكبير" جُزءًا من معنى الاسم.
للتغلُّب على هذه المشكلة يقترح «جون سيرل» في مقالته (أسماء العَلَم)[2] أنَّ معنى الاسم ليس وصفًا مُحدّدًا واحدًا، وإنما هو «رُزمة» أو «عائلة» (على طريقة فتجنشتين) من الأوصاف التي تُحدّد موضوعًا مُعيَّنًا. وفقًا لهذه الرؤية، فإن المُشار إليه بالاسم إذًا، لا يُحدّده وصفٌ وحيد، وإنما رُزمة ما أو عائلة ما من التوصيفات، ومن ثمَّ أصبحت النظرية تُدعى بنظرية الرُزمة من الأوصاف Theory of Cluster Descriptions.
ثمَّة مُشكلاتٌ فنيّة أُخرى أظهرتها انتقاداتُ «بيتر ف. ستراوسن» و«كيث دونيلان» لنظرية الأوصاف في صورتها الكلاسيكية، غير أنَّها في غاية التعقيد، وأمَّا النقد الأشهر لنظرية الأوصاف (في صورتَيها، التقليدية والمُعدَّلَة) فجاءَ من الفيلسوف والمنطقي الفذّ «سول كريبكة». في محاضراته بجامعة برينستون عام 1970م، والتي نُشِرَت (مجموعةً) فيما بعد بعنوان «التسمية والضرورة»، ألقى «كريبكة» ثلاث محاضرات كانت بمثابة قنبلة هزَّت كيان الفلاسفة آنذاك، يصف «ريتشارد رورتي» المشهد قائلًا:
"عندما نُشِرَت هذه المحاضرات (مجموعةً) أوّل مرَّة، فإنها أخذت الفلسفة التحليلية على حين غرّة، وقلَبت كلَّ شيء. والناس بين مغتاظ مهتاج، ومنتعش مبتهج، وحائر مُنذهل، ليس فيهم واحدٌ غير مُبال...فمنذ «كانط» كان الفلاسفة يفتخرون بتجاوز (الواقعية الساذجة) Naïve Realism لـ«أرسطو» والحس السليم، في هذه النظرة الساذجة، هناك طريقة صحيحة لوصف الأشياء، تتوافق مع ماهيَّة الأشياء في ذاتها، ومع جوهرها الحقيقيّ. العلماء بشكل خاص، كما يقول الفلاسفة، يميلون إلى تبنِّي وجهة النظر غير التأمُّليّة هذه. إنهم يعتقدون أنهم يكتشفون أسرار الطبيعة، لكن الفلاسفة يعرفون أنهم [أي العلماء] في الحقيقة يُشكِّلون الأشياء من خلال تركيب مجموعة متنوّعة من الحدوس، أو يتنبؤون بحدوث الإحساسات، أو يتذرَّعون بأدوات للتعامل مع تدفُّق الخبرة، أو أي شيء آخر براغماتي مُتمحوِر حول الإنسان...هذا الموقف المتعالي تجاه الحس السليم وأرسطو والعلم، قد تقاسمه أناسٌ متباينون مثل راسل وبرجسون، ووايتهيد وهوسرل، وجيمس ونيتشه، وكارناب وكاسيرر... وإلى أن جاء «كريبكة» كان الاستثناء الوحيد تقريبًا لهذا الإجماع هو الكاثوليك والماركسيون. فبين المجمَعَين الفاتيكانيّين حاول التوماويّون الجُدد Neo-Thomists أن يشرحوا أن وجهة النظر الأرسطية ’الساذجة‘ هي الاعتقاد البديهي السليم للإنسان العادي، وأنَّ الذاتية الديكارتية، والمثالية الكانطية المتعالية، والتجريبية الوضعية هي على التوالي، أشكالٌ خبيثة من هرطقة جنونية حديثة. ولكن لم يستمع إليهم أحد، وبعد التحديث Aggiornamento استسلم التوماويون الجُدد تمامًا. واعتاد الماركسيون القُدامى، الذين تأثروا بكتاب "المادية والنقد التجريبي" لـ «لينين» على الاحتجاج ضد «راسِل» بأنه لم يكن إلا نُسخة إنجليزية أحدث من «الشكلية البرجوازية» التي شخَّصها «هيجل» في «كانط»، لكنَّ أحدًا لم يستمع إليهم أيضًا، وبعد اكتشاف ماركس الشاب، الإنسانيُّ البراغماتيّ، استسلموا أيضًا. فقط عندما بدا أن الجدلية التي بدأها «كانط» قد بلَغَت ذروتها في القبول العالمي لبراغماتية «فتجنشتين» و«كواين»، حينئذٍ فقط، فجَّر «كريبكة» قنبلته!» (Rorty, 1980)[3] يعترف «كريبكة» بالفضائل والمزايا الواضحة التي تتمتَّع بها نظرية الأوصاف، وقدرتها المذهلة على حلّ الألغاز المنطقية والفلسفية التي تنشأ من النظرية التقليدية في التسمية، إلا أنه يأتي بعد ذلك ليقول: "ورغم كل شيء، أظنني مُتيقِّنًا من بُطلان وجهة نظر «فريجة» و«راسِل»".[4] إنها كلماتٌ مُحيّرة من فيلسوفٍ حادّ النظر.. فما هي الدواعي والمُبررات التي يقدّمها «كريبكة» لهذا الرفض؟ ثمة مفهوم في غاية الأهمية لتأصيل اعتراضات «كريبكة» على نظرية الأوصاف، ألا وهو مفهوم ’’العالَم المُمكن‘‘.
العوالم المُمكنة Possible Worlds:
«العوالم الممكنة» هي تقنية منطقية يستخدمها الفلاسفة التحليليون على نطاق واسع منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وخاصةً بعد أن قنَّنها «كريبكة» في عمله الصوري بالمنطق الجِهَويّ Modal Logic من خلال نظرية النموذج Model Theory عام 1960. والعوالم الممكنة عند «كريبكة» هي «فضاء من الاحتمالات» المُجرَّدة؛ إذ لا تختلف نوعيًا عن الأمثلة البسيطة التي نجدها في المُقررات الدراسية لحساب الاحتمالات، فمثلًا، إذا رُمي نردان عاديان (فلنرمز لهما بالنرد x والنرد y) وأظهرَ كلٌ منهما رقمًا مختلفًا، فإن لكل نرد منهما احتمالاتٌ سِتَّة ممكنة، وبالتالي، هناك سِتَّة وثلاثون احتمالًا ممكنًا لكِلا النردَين معًا، طالما اقتصرنا فقط على الأرقام الموجهة إلى أعلى، حتى وإن كانت واحدة من هذه الأرقام السِتَّة ستظهر في النهاية. وجميعنا تعلَّمنا كيف نحسب الاحتمالات المختلفة (مُفترضين تساوي النسبة في جميع الاحتمالات). الآن، في قيامنا بهذه التمارين المدرسية – يقول كريبكة – فإننا كنا نتعامل مع مجموعة من «العوالم الممكنة» المُصغَّرة، فحالات النرد السِتَّ وثلاثون هي (حرفيًا) سِتَّة وثلاثون «عالَمًا ممكنًا» طالما أننا نتجاهل كل شيء حول هذا العالَم ما عدا النَّردَين وما يُظهرانه فقط. واحدٌ فقط من هذه العوالم الممكنة هو العالَم الفعلي – أي العالَم الذي يتطابق مع الحالة التي سيقع عليها النَّردَين بالفعل. فالعوالم الممكنة إذن كما يستخدمها «كريبكة» لا تعدو كونها «فضاء الاحتمالات» الخاص بالتمارين المدرسية ولكن بعد أن تضخَّم. إنها «سيناريوهات افتراضيَّة» لِما كان يمكن أن يكون عليه الحال في العالَم، تصوُّرات مُجرَّدة لِما «كان من الممكن» أن يحدث في ظرف مُعيَّن ضد-فِعليّ Counter-Factual Situation، وهذه «التصوُّرات» أو «السيناريوهات»، إنما نتواضع عليها فقط. إنَّ «كريبكة» لَيرفض التعامل مع «العوالم الممكنة» بأي معنىً آخر كما يفعل «ديفيد لويس» مثلًا في زعمه بواقعية «العوالم الممكنة»، إذ يصف «كريبكة» هذه النظرة التي يقترحها «ديفيد لويس» بأنها تُصوِّر لنا العوالم الممكنة على أنها "بُلدان غريبة وكواكب بعيدة" أو "شيء يشبه مُحيطنا، ولكنه من بُعد مُختلف" ويُعلّل «كريبكة» الخطأ في هذه النظرة على أنه سوء فهم سبّبه مصطلح "العوالم". ولذلك يقترح إمكان استبداله بتعبير "الحالات الممكنة للعالَم" أو "التواريخ الممكنة للعالَم" أو "الظروف الضد-فعليَّة" تجنُّبًا لذلك الالتباس الذي قد يحدث أحيانًا.[5]
يُحلّل «كريبكة» المضمون العام لنظرية الأوصاف في سِتّ أطروحات هي كالآتي[6]:
1. لكل اسم، وليكن [س]، ثمَّة رُزمة أو عائلة من الصفات المكافئة له، سمِّها عائلة الصفات φ حيث يعتقد [أ] أن [س] هو φ.
2. يعتقد [أ] أن إحدى هذه الصفات φ – أو بعضها معًا، بحسب نظرية الرزمة من الأوصاف – تنتقي موضوعًا مُحددًا بفرادة.
3. إذا استوفى موضوعٌ مُحدد، وليكن [ج]، أغلب هذه الصفات φ، أو الأغلبية المُرجَّحة منها، يكون [ج] حينها هو المُشار إليه بـ [س].
4. إذا لم تستوفي الصفات φ موضوعًا مُحدّدًا بفرادة، فإن [س] لا تُشير.
5. العبارة «إذا وُجِدَت [ج] فإن [ج] لديها أغلب الصفات φ» هي عبارة يعرفها المُتكلِّم [أ] قبليًا A priori.
6. العبارة «إذا وُجِدَت [ج] فإن [ج] لديها أغلب الصفات φ» هي عبارة تُعبِّر عن حقيقة ضروريةNecessary (في عُرف المُتكلِّم [أ]).
ويقبل «كريبكة» بالأطروحة الأولى بوصفها تعريفًا بالنظرية فقط لا أكثر، وأمَّا بقيَّة الأطروحات من 2 حتى 6 فجميعها كاذبة، وإليك تعليل ذلك.
يُنوِّه «كريبكة» أولًا بأنَّ ثمَّة وجهين لهذه النظرية[7]، ولكلّ واحدٍ منهما فضائله التي لا توجد في الآخر، فمن ناحية، يمكن اعتبارها نظريةً في «معنى» أسماء العَلَم فقط، حيث تُعدّ الأوصاف مُتكافئة منطقيًا ومُترادفة لغويًا مع الاسم العَلَم، ومن ناحيةٍ أُخرى، يمكن اعتبارها نظريةً في «الإشارة» فقط، حيث نتوسَّل بالأوصاف لتحديد المُشار إليه بالاسم، من دون أن نتقيَّد بها كمُرادف للاسم العَلَم، وحين تؤخذ النظرية بالوجه الأول، فإنها تُعطي حلولًا بارِعة لمشكلة العبارات الوجودية، والأسماء الفارغة، وتقارير الهُويَّة التي تحتوي على أسماء مختلفة ذات إشارة مُشتركة، كما سبق أن رأينا في الجُزء الأوَّل من هذا البحث، ولكنها حينئذٍ ستفشل تمامًا – كما سنرى – في تفسير الإشارة. وأمَّا إذا اتخذناها كنظريةً في الإشارة فقط، فإنها لتفقد كثيرًا من بريقها وجاذبيتها، فلا يعود بإمكانها أن تحُلّ مشكلة العبارات الوجودية والأسماء الفارغة وتقارير الهُويَّة التي تحتوي على أسماء مختلفة ذات إشارة مشتركة، وأمَّا الجمع بين الاثنين معًا (اتخاذها نظريةً في معنى الأسماء وفي الإشارة) فيُفاقم الأمر سوءًا، كيف ذلك؟
إذا اتُّخِذَت نظريةُ الأوصاف (بصورتها التقليدية أو المُعدَّلَة) بوصفها نظريةً في إشارة الأسماء العَلَم، فإن الأوصاف المُحدِّدة التي يُفترض بها أن تُحدّد إشارة الاسم، يمكنها أن تُشير إلى الشخص الخطأ، لمجرَّد أنَّ المُتكلِّم لديه اعتقادات خاطئة حول صاحب الاسم الحقيقيّ! على سبيل المثال، الكثير من الناس حتى اليوم يعتقدون - خطأً - بأن «أينشتاين» هو ’’الرجل الذي اخترع القنبلة النووية‘‘. فإذا كان التوصيف السابق مُحدّدًا لإشارة الاسم «أينشتاين» بالنسبة إلى أولئك الناس، فإنه رغم ذلك قد يصدق على «أوبنهايمر» فعليًا أكثر من سِواه، فهل نقول حينئذٍ (بحسب الأطروحات 2-3) أنَّ النّاس كانوا – بالفعل – يُشيرون إلى «أوبنهايمر» بدلًا من «أينشتاين»؟ هل يعني ذلك أن أيًّا كان مَنْ اخترع القنبلة النووية فهو «أينشتاين»؟ قطعًا لا، واقع الحال هو أنَّ أولئك النَّاس لديهم اعتقادات خاطئة حول «أينشتاين»، وأنهم كانوا يقصدونه هو بالفعل كلَّما ذكروه بالاسم. ولنعطي مثالًا آخر لتتضح الفكرة أكثر: جميعنا يعرف أنَّ «هتلر» هو ’’الدكتاتور النازي الذي أباد الملايين من اليهود في موبقة لن ينساها التاريخ‘‘. والآن، يمكننا أن نتصوَّر ظرفًا ضد-فعليّ (أو حالةً ممكنة للعالَم)، حيث ارتكبَ شخصٌ آخر هذه الموبقة التاريخية المُفجعة، فهل سنقول عن ذلك الشخص أنه «هتلر»؟ ومن ناحيةٍ أُخرى، كان من الممكن (في ظرفٍ ضد-فعلي) لـ «هتلر» ألا يقوم بأيّ من هذه الأعمال الشنيعة، كان يمكنه أن يمضي أيامه في سكينة بمدينة النمسا مثلًا، فهل سنقول حينئذٍ أنَّ ذلك الرجل ليس هو «هتلر»؟ قطعًا لا، إنَّ «هتلر» هو نفسه وليس غيره، حتى ولو لم يلج حقل السياسة من الأساس. يبدو إذَن أنَّ ما نعرفه عن المُسمَّى (أو حامِل الاسم) ليس كافيًا بذاته لتفسير الإشارة.
هناك مُشكلةٌ مماثلة أيضًا تواجه الأطروحة (4) من النظرية، إذا ما اعتُبِرَت كنظرية في إشارة الأسماء، وهي مشكلة انعدام الماصدَق الذي يُحدّده التوصيف... لأننا إذا افترضنا أنَّ الاسم «موسى» يُشير إلى الشخص الذي يستوفي توصيفًا مُحدّدًا (أو أكثر) مثل ’’نبي العبرانيّين، الرجل الذي أخرج اليهود من مصر..‘‘ وإلخ من الأعمال التي ينسبها الكتاب المُقدَّس إلى «موسى»، فمن الممكن ألا يكون «موسى» قد قام بأيٍّ من هذه الأعمال التي ينسبها إليه الكتاب المُقدَّس، كان من الممكن (في ظرفٍ ضد-فعليّ) أن يقضي «موسى» أيّامه مُرفَّهًا في البلاط الملكيّ بمصر، حتى يموت بسلام. فإذا اكتشفنا يومًا أن أيًّا من هذه الأعمال المنسوبة إلى «موسى» لا تصدُق على أحد (أي إنها لم تحدث)، فهل نقول حينئذٍ (بحسب الأطروحة 4) أنَّ «موسى» غير موجود؟ بالطبع لا. إنه لِمن الخطأ أن نعتقد ذلك. فالكثير من الباحثين في حقل الدراسات التاريخية اليوم، يعتقدون أنَّ جميع القصص الواردة عن «موسى» في الكتاب المُقدَّس إنْ هي إلا أساطير، لكنها تتحدَّثُ عن شخصٍ حقيقيّ! ونفس الأمر فيما يتعلَّق بشخصية النبي «يونان – يونس»، فالكثير من الباحثين يرجحون أنَّ «يونان – يونس» شخصيةٌ حقيقية، ولكنه لم يمكث في بطن حوت 3 أيام ولم يذهب إلى مدينة نينوى، والأمثلة كثيرة. إن خطأ الأوصاف المُحدّدة – كما في حالة الشخصيات التاريخية الشهيرة – لا يُعطي سببًا كافيًا لنفي وجود الشخص (أو الشيء) المُسمَّى.
وماذا لو اعتُبرَت نظريةً في معنى الأسماء؟ ربما تحتفظ النظرية بالكثير من مزاياها كنظرية في معنى الأسماء، نظرًا لقدرتها على تحليل العبارات الوجودية، والأسماء الفارغة، والأسماء المشتركة إشاريًا، غير أنَّ المسألة ليست بهذه البساطة أيضًا؛ لأنه – كما سبق وأشرنا – إذا افترضنا بأن الاسم «هوميروس» يترادف مع الوصف ’’مؤلِّف الإلياذة‘‘ كما هو معروف لدى الجميع، فبناءً على ذلك، إذا كان الاسم «هوميروس» يعني: مؤلِّف الإلياذة، فإن قولنا: ’’هوميروس هو مؤلِّف الإلياذة‘‘ لا يكون سِوى تحصيل حاصل Tautology كأننا نقول: ’’هوميروس هو هوميروس‘‘. رغم أنَّ واقع الأمر يُنافي ذلك، فنحنُ نُخبر عن واقعةٍ تاريخية. ولا يقدّم اقتراح «سيرل» حلًّا للمشكلة كما قد يبدو من الوهلة الأولى، تظل المشكلة كما هي مهما تعدّدت الأوصاف، ففي النهاية، ينبغي لهذه الرزمة أو العائلة من الأوصاف (مجتمعة) أن تكون مُرادفًا للاسم (على فرَض أن بإمكان رُزمة ما من الأوصاف أن تكون مُرادفًا لاسم). يبدو أنَّ الأسماء العَلَم لا يمكن أن تتساوى منطقيًا مع التوصيفات بأيّ شكلٍ كان، وإنَّ «راسِل» نفسه (ويا للعجب) لَيؤكد على ذلك، على العكس مِمَّا اعتقده «فريجة» من أنَّ الأسماء العَلَم مُتساوية منطقيًا مع الأوصاف المُحدَّدة؛ حتى أنَّ «فريجة» قد اعتبرها [أي الأوصاف المُحدَّدة] أسماء أعلامٍ مُركَّبة[8]. وفي نقده لوجهة نظر «فريجة» هذه، يُضيف «راسِل» ثلاث مُلاحظات أُخرى – بالإضافة للمشكلة التي ذكرناها آنفًا – تُميِّز أسماء الأعلام عن الأوصاف المُحدَّدة، وهي كالآتي:
i الاسم رمز بسيط بينما الوصف المُحدَّد رمز مُركَّب، ونُسمِّي الرمز بسيطًا إذا كان مؤلفًا من أجزاء (والأجزاء هنا حروف) ليس كل جُزء منها رمزًا في ذاته، ونُسمِّي الرمز مُركَّبًا إذا كان مؤلفًا من أجزاء (والأجزاء هنا كلمات) لكل جُزء منها معنى ودلالة. ففي القضية ’’هوميروس مؤلف الإلياذة‘‘ نجد أن «هوميروس» اسم عَلَم ورمز بسيط، بينما ’’مؤلِّف الإلياذة‘‘ وصف مُحدَّد ورمز مُركَّب.
ii يرتبط الاسم بمُسمَّاه ارتباطًا مُباشرًا بينما الوصف المُحدَّد ليس كذلك، لأننا حين نستخدم الاسم استخدامًا صحيحًا يجب أن نُشير به إلى شيء جُزئي في الواقع، وكذلك «هوميروس» يمكنك فهم معناه إذا كنت رأيت هذا الشاعر أو سمعته أو قرأت له. لكن يمكننا فهم الوصف المُحدَّد حتى لو لم نكن سمعنا بمن يُشير إليه، يمكنك فهم ’’مؤلِّف الإلياذة‘‘ متى عرفت كيف تُستخدم كلمة مؤلِّف في اللغة، وأن الإلياذة كتاب في أدب الأساطير الإغريقية.
iii الاسم رمز تام بينما الوصف المُحدَّد رمز ناقص، ونُسمِّي الرمز تامًّا حين يفيد معنى تامًّا في ذاته ولا يعتمد فهمنا له على كلمة أُخرى تُعطيه معنى، وأسماء الأعلام جميعها من هذا النوع، لكننا نُسمِّي الرمز ناقصًا، إذا لم يُعط في ذاته معنىً تامًّا وإنما يكتسب هذا المعنى في سياق مُعيَّن. و’’مؤلِّف الإلياذة‘‘ وحدها تُثير نقصًا في المعنى، لأن قراءتنا لهذه العبارة أو سماعنا بها يُثير عِدَّة أسئلة مثل: من هو؟ ماذا تُريد أن تقول عنه؟[9]
قد يبدو في هذه الملاحظات التي أبداها «راسِل» أنه يتنكَّر لنظرية الاوصاف، بَيْد أنَّ «راسِل» يعود بعد ذلك فيقرّر أنَّ أسماء الأعلام الحقيقية هي أسماء الإشارة فقط، مثل: هذا، ذلك، هنا، الآن.. وأمَّا الأسماء الأعلام المألوفة في اللغة العادية (مثل هوميروس، أرسطو، زيد، علي)، هي في الواقع أوصاف مُتخفِّيَة أو مُختصرة.[10] يقول «راسِل» في مقالته (المعرفة بالعيان والمعرفة بالوصف):
’’الحدود العامة، وحتى الأسماء الخاصة [أي أسماء العَلَم] هي في الواقع أوصاف؛ بمعنى أن الفكرة التي في عقل شخص يستخدم اسم العَلَم بشكلٍ صحيح، يمكن عمومًا التعبير عنها بوضوح في حال حلَّ الوصفُ محلَّ الاسم.‘‘[11]
إنَّ الاختلاف الذي بين «راسِل» و«فريجة» هو اختلافٌ في الدَّرَجة فقط لا في النَّوْع، إنه خلافٌ اصطلاحيّ حول ما يصحّ أن نُطلق عليه «اسم عَلَم» بالمعنى الدقيق، وليس خِلافًا جوهريًا بوجه عام، فبينما يقبل «فريجة» بأسماء العَلَم المألوفة في اللغة العادية، ويتخذ من الأوصاف المُحدَّدة معنىً لها مُتساوٍ معها منطقيًا، يخالفه «راسِل» فقط في تصنيف الأسماء العَلَم العادية على أنها "أسماء عَلَم" ولكنه يتفق معه في تحليلها إلى أوصاف.[12] ومع بيان هذه الملاحظات السابقة، يبدو إذًا أنَّ نظرية الأوصاف تفقد صلاحيَّتها حتى من حيث هي نظرية في معنى الأسماء.
قُلنا إن الأطروحة (1) هي تعريف بالنظرية، وتبيَّن لنا أنَّ الأطروحات (من 2-4) كاذبة بما تقدَّم من الأمثلة المضادة لها، ويبدو أنَّ نظرية الأوصاف تفشل كنظرية في معنى الأسماء العَلَم وكنظرية في الإشارة أيضًا، وبالتالي تتداخل جميع هذه المُشكلات السابقة إذا ما التزمنا بالنظرية بوجهيها معًا، أي كنظرية في معنى وإشارة الاسم. بقيت الأطروحتان (5-6) فما القول فيهما؟ لا يتخلَّف «كريبكة» عن رفضهما أيضًا. وجدير بالملاحظة هنا أنَّ الأطروحتين مُتلازمتان بحسب التقليد التحليليّ الذي وضعه «كانط»، فلا ضرورة إلا في المعرفة القَبْليَّة. ويبدو أنَّ الأطروحتين (5-6) تفترضان مُسبقًا معرفةَ المُتكلِّم [أ] بالنظرية قَيْد النقاش، نظرية الأوصاف بوصفها نظريةً في التسمية، فإنَّ الغالبيَة العُظمى من النَّاس – لا الفلاسفة – يستخدمون الأسماء دون عِلْم بأيّ صفات فريدة مُحدِّدة للمُسمَّى، فلو سألنا رجل الشارع عن «نجيب محفوظ» مثلًا، لعلَّه سيقول: ’’إنه روائيّ..‘‘ ذلك أنه بالكاد قد سمع عنه، وبالطبع ليست "روائيّ" صفةً مُحدِّدة أو فريدة بأي وجهٍ كان، وما تعنيه هذه المُلاحظة هو أنَّ جهل النَّاس بنظرية الأوصاف لا يُمثِّل دليلًا ضد هذه النظرية، لأنه إذا استوعبَ الرجل العادي هذه الأطروحات (من 1-4)، فسيعتقد أيضًا بالأطروحَتَين (5-6)، ذلك أنهما لازمتان منطقيًا من الأطروحات السابقة.
إلا أنَّ «كريبكة» لا يُسلِّم بالاستخدام الشائع للمفردتين "ضروري" Necessary و"قبليّ" A priori في التقليد التحليليّ منذ «كانط»؛ ذلك التقليد الذي يستخدم الضروري – القبلي بالتبادل، فقد اعتاد الفلاسفةُ منذُ «كانط» على الاعتقاد بوجود ارتباطٍ منطقيٍّ وثيق بين المفهومَيْن، حيث تنحصر الضرورة في المعرفة القَبْليَّة، وأنَّ كل ما نعرفه قبليًّا يكون ضروريّ.[13] أما «كريبكة» فلا يتوانى عن خَرق ذلك التقليد! فعنده أنَّ مفهوم «الضرورة» يتميَّز نوعيًا عما هو «قبليّ» ولا يجب الخلط بينهما؛ فالقَبليّ مفهوم إبستمولوجي، ويُعبّر – بحسب التعريف الشائع – عمَّا نعرفه قبلَ التجربة، بينما الضرورة تنتمي إلى مجال الميتافيزيقا في المقام الأوَّل، حتى وإن كان لها بعض الاستخدامات المعرفية فيما يتصل بالمنطق. يقول «كريبكة»:
’’نحن نسأل عن صدق أمر مُعيَّن أو عن كذبه. فإن كان أمرًا كاذبًا، فهو بالطبع ليس ضروريّ الصدق. وإن كان صادقًا، هل كان بالإمكان أن يكون خِلاف ذلك؟ هل من الممكن، بهذا الاعتبار، أن يكون العالَم مُختلفًا عمَّا هو عليه؟ إذا كان الجواب بالسَّلْب، فهذا الأمر الواقع، المُخبِر عن العالَم، هو امر ضروري، إذ لم يمكن خِلافه. وإذا كان الجواب بالإيجاب فهو أمر إمكاني. وهذا، في نفسه ولنفسه، لا يتأثر بمعرفة أي أحد لأي شيء. والأطروحة أطروحة فلسفية حتمًا، وليستْ من لوازم التعريف.‘‘[14]
ويتقدّم «كريبكة» بأمثلة مضادة تُبيّن الاختلافَ بين المفهومَيْن. على سبيل المثال نقول: إنَّ المتر الواحد يُحدّده طول (ع)، حيث (ع) هي مسطرة معدنية اِستُخدمَت عام 1791م في تحديد النظام المتري، وهي محفوظة بمتحف الأوزان والقياس العالَمي في مدينة سيفر بالقرب من باريس. والآن، فإن قولنا ’’المسطرة (ع) طولها متر‘‘ يعبّر عن معرفة قَبْليَّة، بمقتضى التعريف فقط، ولكن لنسأل: هل كَوْنُ (ع) طولها متر، هو حقيقة ضرورية؟ بالطبع لا؛ لأنه من الممكن أن يختلف طول المسطرة المعدنية (ع) مع الوقت. حسنًا، قد نستطيع تهذيب التعريف بأن نتفق على أنَّ المتر الواحد يجب أن يكون طول (ع) عند الزمن صفر (زº). هل هي إذن، حقيقةٌ ضرورية أن يكون طول (ع) مترًا واحدًا عند (زº)؟ من يرى أنَّ كل ما نعرفه قبليًّا هو ضروريّ سيقول: ’’هذا تعريف المتر، وبمقتضى التعريف فإن (ع) طولها متر عند الزمن صفر (زº) حقيقة ضرورية‘‘. لكن ليس هنالك ما يوجب ذلك الاستنتاج؛ لأن الشخص نفسه يستطيع أن يقول: ’’إذا ما عرَّضنا المسطرة المعياريَّة (ع) إلى الحرارة عند الزمن صفر (زº) فلن يكون طولها مترًا واحدًا‘‘. ففي الواقع، ليس هنالك ما يُوجب على أيّة مسطرة معدنية أن تتخذ طولًا مُعيَّنًا بأي شكلٍ كان.
ونجد واحدًا من الأمثلة الواضحة حول هذه التفرقة بين «الضرورة» و«القبليَّة» لدى «ألفِن بلانتنجا»، فالمرءُ منَّا يعرف أنه موجود (قبليًّا) في حين أنَّه يعرف أنَّ وجوده هذا مُعطىً إمكانيّ؛ يقول «بلانتنجا»: ’’وحدها البلادةُ الفائقة ما قد يمنعني من معرفة أنّني موجود قَبلْيًّا، رغم كونها قضيةً إمكانيّةً‘‘.[15] ومن الأمثلة الأُخرى التي يُدرجها «كريبكة» في هذه المسألة، أنَّ معظمنا يعتقد قبليًّا بتعريف لنقطة غليان الماء أنها تُساوي: 100 C° (درجة مئوية)، إلا أنَّها ليستْ حقيقةً ضرورية؛ فالمسألة تعتمد على الضغط الجوّي، فعلى سبيل المثال؛ يغلي الماء على قِمَّة جبل إفرست عند 69 C° درجة مئوية، بسبب أنَّ قِمَّة جبل إفرست تُعَد أعلى قِمَّة جبل في العالَم، حيث يكون الضغط الجوّي قليلًا للغاية.
هذه الأمثلة وغيرها تدلُّ على عدم وجودِ تلازمٍ منطقيٍّ بين مَفهومَيْ «القبلي» و«الضروري». فليس ثمَّةَ، إذًا، ما يمنع من وجود حقائقَ قَبْليَّةً إمكانيَّةً. والعكس كذلك، فإذا صحَّ القول إنَّ هناك ما نعرفه قبليًّا مما ليس بضروريّ، فبالمثل أيضًا، ليس كل ما نعرفه بَعديًّا يكون إمكانيًّا، ثمَّة ضروريَّات بَعديَّة يُجيزها «كريبكة»، وهي تُمثِّل نُقطة التحوّل الحاسمة في التقليد التحليليّ المُتأخِّر، ومفتاحها هو التفرقة التي يُقيمها «كريبكة» بين «الإمكان الإبستمولوجي» Epistemic Possibility و«الإمكان الميتافيزيقي» Metaphysical Possibility، وسنأتي إلى شرحها لاحقًا.
والآن، بعدَ أن انفكَّ الارتباط بين «الضرورة» و«القَبْليَّة» وتبيَّن افتراق الواحدة منهما عن الأُخرى، يبدو إذًا أنَّ الأطروحة (6) كاذبة بوضوح سافِر! فعلى سبيل المثال: إذا ما تبنَّيْنا للاسم «أرسطو» توصيفًا مثل: مُعلِّم الاسكندر الأكبر، أو مؤلِّف كتاب الميتافيزيقا، أو رائد عِلم المنطق، أو مجموع ما سَبَق معًا (باعتبارها عائلة أو رُزمة من الأوصاف)، فمن البيِّن تمامًا أنَّ أيًا من هذه الأعمال التي يتَّصف بها «أرسطو» إنما تُعبّر عن أمور إمكانية بوضوح. كان من الممكن ألا يُعلِّم «أرسطو» الإسكندر الكبير، في ظرفٍ ضد-فعليّ كان يمكن لـ «ديوجينس الكلبي» مثلًا، أن يكون مُعلِّم الاسكندر، ليس ثمَّة من قَدَرٍ منطقيّ يُحتِّم على «أرسطو» أن يُمارس التعليم أصلًا (اللهمَّ إلا إذا سلَّمنا بالحتمية التاريخية، وهذه مسألةٌ أُخرى). وبنفس المعنى، كان يمكن ألَّا يؤلِّف أرسطو كتاب الميتافيزيقا، كما كان يمكن لفيلسوف آخر أن يضطّلع بتأسيس علم المنطق. في ظرفٍ ضد-فعليّ، لو لم يلتق «أرسطو» بـ «أفلاطون» لكان من الممكن ألَّا يُمارس الفلسفة من الأساس، إنَّ كَوْن «أرسطو» قد قام بأيٍّ من هذه الأمور هو أمر عارِض عليه بطبيعة الحال، فليسْت العبارة ’’إذا وُجِدَت [ج] فإن [ج] لديها أغلب الصفات φ‘‘ حقيقةً ضرورية كما تزعم الأطروحة (6) من نظرية الأوصاف.
ماذا عن الأطروحة (5)؟ فلنعُد إلى مثال «أينشتاين» ونقوم بتعديل بسيط حتى نكتشف كذبها: لنفترض أنَّ المُتكلِّم [أ] كان يعتقد - خطأً - بأن «أينشتاين» هو ’’مُخترع القُنبلة النووية‘‘ وأنَّ اعتقاده بذلك كان على نحوٍ قَبْليّ (على سبيل التعريف مثلًا)، ثمَّ حدثَ أن قرأ المُتكلِّم [أ] بالصدفة عن السيرة الذاتية لـ «أوبنهايمر» في إحدى الكتب أو المجلَّات الموثوقة، فاكتشف الخلط الذي وقع فيه بين الرجلين «أينشتاين» و«أوبنهايمر»، ومن ثمَّ عدَّل اعتقاده حول «أينشتاين» ليجعله ’’الرجل الذي اكتشفَ نظرية النسبيَّة‘‘. والآن، هل يصحّ أن نقول بأن اعتقاد المُتكلِّم [أ] أن ’’أينشتاين هو الرجل الذي اكتشفَ نظرية النسبيَّة‘‘ يُعبِّر عن حقيقة قَبْليَّة؟ بالطبع لا، فقد اكتسبَ هذه المعلومة بالخبرة من خلال قراءة إحدى الكتب أو المجلَّات.. ولنفس السبب، لا يُعتبر اعتقاد [أ] بأي شيء حول «أوبنهايمر» حقيقةً قَبْليَّة. وفي العموم، لا تُمثِّل الأوصاف معرفةً قبليَّةً بأي شكل؛ وذلك لسبب بسيط: إنَّ الأوصاف المُستخدمه في تحديد المُشار إليه بالاسم دائمًا ما تكون «قضايا تركيبية» تُخبر عن وقائع، مثل الأعمال الشهيرة التي قام بها صاحب الاسم أو ما يُنسَب إليه.. ومن المعلوم أنَّ القضايا التركيبية لا تُعرَف قَبْليًّا.[16]
صرامة التحديد Rigidity of Designation والمُحدِّدات الصارِمَة Rigid Designators:
تُمثِّل الاعتراضات السابقة أسبابًا قوية للشكّ في معقولية نظرية الأوصاف، ومن ناحيةٍ أُخرى، تستدعي إعادةَ النظر في نظرية التسمية التقليدية التي تفترض أنَّ أسماء العَلَم تُشير إلى مُسمَّياتها مُباشرةً، لا بواسطة "أوصاف" نعرفها عن المُسمَّى ونُحدِّد من خلالها المُشار إليه بالاسم. ثمَّة سِمَة فريدة تتميَّز بها الأسماء، تُظهر الأمثلة المضادة أنَّ أسماء الأعلام إذا استُخدِمَت بشكلٍ صحيح فإنها تُشير إلى المُسمَّى بغض النظر عن أيّ اعتبارات ذات صِلَة بما يعرفه المُتكلِّم عن ذلك الشيء أو الشخص المُسمَّى، وبغض النظر حتى عن أيَّة صِفَة يتصف بها المُسمَّى. ليس للأسماء مُحتوىً نظريّ Connotation كما يقول «جون ستيوارت مِل»، وإنما دلالةٌ خارجية Denotation؛ ويوضح «مِل» هذه المسألة بمثال جيّد؛ إذ يقول:
"عندما نستعمل الاسم «دارتماوث» لكي نصف مكانًا ما في إنكلترا، فلعَلَّهُ يُطلَق عليه هذا الاسم لأنَّه يقع عند فم النهر الذي يُدعى «دارت». ولكن حتى لو غيَّر النهر مجراه، حيث لم يعد المكان واقعًا عند فم النهر «دارت»، فإننا نستطيع أن نستمرَّ بإطلاق «دارتماوث» على نفس المكان، ولا حرجَ علينا، حتى وإن كان الاسم يُوحي بأنَّ المكان يقع عند فم «دارت»".[17]
أمَّا الأوصاف المُحدِّدة Definite Descriptions، فهي وإن كانت حدود إشارية Referential Terms، إلا أنَّها تُشير على نَحوٍ عَرَضيّ غير مُباشر Indirect كما يقول «مِل»[18]، وعِلَّة ذلك أنها لا تُفيد معنىً تامًّا كما لاحظ «راسِل»، على عكس الأسماء العَلَم، فهي تدلُّ على موضوعها مُباشرةً.
تبَلْوَرت هذه الفكرة لدى «كريبكة» في أطروحة «صرامة التحديد» Rigidity of Designation، وهي تحتل موقعًا مركزيًّا من فلسفته، حيث يُميِّز «كريبكة» بين نوعين من الدلالة في اللغة، فثمَّة حدود Terms في اللغة تُحيل إلى موضوعها بصرامة، أي: تنتقي شيئًا مُحددًا في جميع العوالم الممكنة، وفي المقابل، هناك حدود لا تُحدّد موضوعها بصرامة، أي: من الجائز أن تُحيل إلى أشياء مُختلفة في بعض العوالم الممكنة. وحدسيًا، يبدو أنَّ الأسماء العَلَم تنتمي إلى النَّوع الأوَّل (المُحدّدات الصارمة) Rigid Designators، فلا يمكن لـ «طه حسين» ألا يكون «طه حسين» في أي عالمٍ مُمكن، إنَّ الاسم «طه حسين» ينتقي الشخص عينه في جميع العوالِم الممكنة، وفي المقابل، فإنَّ توصيفًا مُحدّدًا مثل ’’مُؤلِّف كتاب في الشعر الجاهليّ‘‘ لا ينتقي الفرد عينه في جميع العوالم الممكنة، فهو (مُحدِّد غير صارِم) Non-Rigid Designator لأنه حتى ولو كان «طه حسين» هو بالفعل مَن ألَّفَ كتاب (في الشعر الجاهلي)، إلا أنه كان من الممكن أن يؤلِّفه شخصٌ آخر، ليس ثمَّة من ضرورة تُحتِّم على ’’مؤلِّف كتاب في الشعر الجاهليّ‘‘ أن يكون «طه حسين» بالذات، ففي ظرفٍ ضدّ-فِعليّ كان يمكن لـ «طه حسين» ألَّا يُمارِسَ التأليف من الأساس.
إنَّ الفرق الدقيق بين أطروحة «المُحدِّدات الصارِمة» وأطروحة «الأوصاف» يتمثَّل في حقيقة أنَّ الأوصاف تفشل تمامًا في تحديد الشروط (الصحيحة ماصدَقيًّا) Extensionally Correct التي بموجبها نستطيع أن نَصف الظروف الغير-فِعليَّة للعبارات؛ إليك مثلًا هذه العبارة:
(1) كان أرسطو مُولَعًا بالكلاب.
إنَّ فهمنا لهذه العبارة على نحو مُلائم ينطوي على فهم للماصدَق الصحيح لحدودها، والذي بموجبه يتحقّق شَرطَين: (أ) تكون العبارة صادقةً بالفعل، و(ب) يُمكننا أن نصف كل مسارٍ ممكن، مُغاير للمسار الفِعليّ في جوانب دون أُخرى، بحيث تكون العبارة (1) كاذبة. وبالنسبة إلى أطروحة «الأوصاف» فإن (1) يمكن تحليلها إلى:
(2) كان آخر عظماء فلاسفة اليونان المُتقدِّمين مُولَعًا بالكلاب.
وإن هذه بدورها ينبغي تحليلها إلى:
(3) شخصٌ واحدٌ على الأقل كان الأخير بين عظماء فلاسفة اليونان المُتقدِّمين، وأي شخص مُماثل كان مُولَعًا بالكلاب.
هنا، تتطابق شروط الصدق الفِعليَّة للعبارة (3) مع ما ذُكِر في العبارة (1)، من حيث الماصدق الصحيح الذي تُعيِّنه حدودهما، وأمَّا ضد-فِعليَّا، فإن شروط صدق (3) قد تتباين بشكل واسع مع (1) من حيث نطاق الماصدَق الذي تُعيِّنه حدودهما؛ إنَّ أطروحة «الأوصاف» لتجعل من وَلَع أي شخصٍ آخر معيارًا لصدق (1). أما أطروحة «المُحددات الصارمة» فلا تُسلِّم بالتكافؤ المنطقي بين (1) و(3)، فهي تقبل بـ (1) فقط، ومن ثمَّ فهي تستوفي الشَّرطَين (أ) و(ب)، فـ «أرسطو» وأسماء الأعلام عمومًا هي التي تُعيِّن موضوعًا مُحدَّدًا في جميع الحالات الممكنة للعالَم.
رؤية جديدة للنظرية التقليدية في التسمية:
سبق أن أشَرنا (في الجُزء السابق من هذا البحث) إلى ثلاث مُشكلات [أو قُل ألغاز؟] تواجه النظرية التقليدية في التسمية، وهي بالترتيب: (1) تفسير لكيفيَّة تحقُّق الإشارة: كيف نستطيع من خلال نُطق كلمة أو وضع علامة على ورقة، أن نُشير إلى شيءٍ بعيد، أو أن نُشير بالفعل إلى أي شيء على الإطلاق؟ (2) ظاهرة اشتراك اسمَين في إشارة واحدة Co-designative Names: كيف يمكننا فهم عبارات الهوية مثل ’’هسبر هو فوسفور‘‘؟ (3) مشكلة الأسماء الفارغة Empty Names والعبارات الوجودية: كيف يمكننا فهم العبارة ’’إنَّ كائن العنقاء غير موجود‘‘؟
بالنسبة إلى المسألة الأولى، يقول «كريبكة»[19]:
"ما هي الصورة الحقيقية لما يجري؟ لعلَّ الإشارة لا تحصل أصلًا! فعلى كل حال، نحنُ لا نعرف حقًّا أي الصفات التي نتوسَّلُ [بها] في تحديد الشخص صادقٌ [عليه]، وأيّها ليس به. ولسنا ندري أيَّها ينتقي موضوعًا فريدًا. فبالفعل، ما الذي يجعل من استعمالي لـ«شيشرون» اسمًا له؟ إنَّ الصورة التي تؤدّي بنا إلى نظرية رُزمة التوصيفات هي شيء من هذا القبيل: المرء معزول في غُرقة؛ قد تختفي بالكامل جماعة المتكلمين الآخرين، وكل شيء آخر؛ فيُحدّد المرء الإشارة لنفسه بأن يقول ’’أُريد بـ «غودل» الرجل، أيًا كان، الذي أثبت لا تمامية الأرثماطيقا‘‘. الآن، لك أن تفعل ذلك إن أردت. ليس في البيّن ما يحول دونه. تستطيع ببساطة أن تلتزم التحديد المذكور. لكن عندها، إذا كان هذا ما تُريد، فإن كان «سميث» هو مكتشف لا تمامية الأرثماطيقا، فإنك إنما تُشير إليه؛ إذ تقول ’’فعل «غودل» كذا وكذا..‘‘. ليس هذا ما يقوم به أكثرنا. أحدهم، فلنقُل، طفلٌ ما قد وُلِدَ. ويطلق عليه أهله اسمًا ما. ويخبرون به أصدقائهم، ويلتقيه أُناسٌ آخرون. وبمختلف أصناف الكلام ينتشر الاسم من صِلَة إلى صِلَة كما لو أنها سلسلة، ثم إنك تجد مُتكلّمًا في الطرف الأخير من السلسلة، قد سمع، مثلًا، بـ«ريتشارد فاينمان»، في السوق أو في محلّ آخر، تجده يُشير إلى «فاينمان» وإن لم يسعه أن يتذكَّر عمَّن كان قد سمع عن «فاينمان» أو مِمَّن. هو يعرف أن «فاينمان» كان فيزيائيًا مشهورًا، وثمَّة مسار من التواصل ينتهي، في المآل، عند الرجل ايّاه [أي «ريتشارد فاينمان»] يصل إلى المُتكلِّم. المُتكلِّم عندها، عندما يُشير بالاسم، إنما يُشير إلى «فاينمان» وإن لم يسعه تحديده بفرادة. هو لا يَعرف ما هو مِبيان فاينمان. ولا يعرف نظرية فاينمان في إنتاج الزوج وإفنائه. وليس هذا فحسب: بل هو يصعب عليه حتى تمييز «غيلمان» عن «فاينمان». وهكذا، فليس به حاجة ليعرف أيًا من هذه الأمور. بل عِوَضًا عنه، فإن سلسلة تواصل ترجع إلى «فاينمان» نفسه قد ترسَّخت بفعل عضوية المتكلّم في الجماعة التي نقلت الاسم من صِلَة إلى صِلَة. ولا حاجة، من ثمَّ، إلى طقس خاص يقوم به في مكتبته، قوامه: أُريد بـ«فاينمان» الذي قام بكذا وكذا، وكذا وكذا...".
على الرغم من أنَّ «كريبكة» يُبدي تحفُّظًا على وصف التفسير البديل الذي يُقدمه لنا عن كيفيَّة تحقُّق الإشارة بأنه «نظرية»، فالتشخيص الذي يُزوّدنا به – كما يقول[20] – هو أقل تحدُّدًا بكثير مما تقتضيه مجموعة حقيقية من الشروط الضرورية والكافية لبيان الإشارة. وعلى الرغم من قناعته بأنَّ ما قدّمه لا يعدو أن يكونَ مُجرَّد ’’صورة أفضل‘‘ لما يجري فعليًّا، أقول على الرغم من ذلك، دُعِيَت –لاحقًا– هذه «الصورة» التي روَّج لها «كريبكة» باسم «النظرية السببية في الإشارة» Causal Theory of Reference. فبالنسبة إلى المسألة الأولى إذًا، لدينا سلسلةٌ تاريخية تبدأ من حدث التسمية Baptism، وتمتدُّ - سببيًا - بالتواصل من شخصٍ لآخر في مجتمع اللغة، حتى تصل إلى المُتكلِّم المُستعمل الحالي للاسم. وبفعل هذه السلسلة السببية (الخارجيَّة) يُشير الاسم إلى مُسمَّاه، بغض النظر عن أي اعتقادات (داخلية) لدى المُتكلِّم حول الشيء المُسمَّى.
ويعترف «كريبكة» بأنَّ الأوصاف يمكن أن تُستعمل في حدث التسمية أحيانًا، كأن نقول ’’سأدعو هذه المجرَّة التي إحداثياتها هي كذا [...] وكذا [...] باسم «رجُل القنطور»‘‘ مثلًا أو ’’سأدعو النجم الذي يظهر في المساء بالاسم «هسبر»‘‘ وغيرها من الأمثلة... غير أنَّ الأوصاف الواردة في هذه الحالة لا تعدو أن تكون "تثبيتًا للإشارة بعلامةٍ عَرَضيَّة" وليستْ شرطًا مُحقِّقًا لها بأي حال.[21]
أما المسألة الثانية، وهي: لُغز الأسماء التي تشترك في إشارة واحدة Co-designative Names، كيف يمكننا فهم عبارات الهُويَّة من قبيل: ’’هسبر هو فوسفور‘‘؟ لنستحضر التفاصيل مرَّةً أُخرى.
أطلق اليونانيون في زمن «هوميروس» على كوكب الزُّهرة اسم "هسبر"، الذي يعني في الأصل (كوكب المساء)؛ ذلك لأنهم دائمًا ما يرونه في المساء. وأما في الصباح، فقد أسموه "فوسفور" والذي يعني في الأصل (جالِب النور، أو جالِب الفجر)، وقد اعتقدوا أنهم يُشاهدون نَجمين أو كوكبين مُختلفين، وربطوا في أساطيرهم هذين الاسمين بإلَهين مُختلفين بالتوازي معهم.. وقد أدرك علماء الفلك في بلاد ما بين النهرين في تلك الفترة أنه كان نفس الجسم السماوي الذي تتم رؤيته بالفعل، أحيانًا في الغرب في المساء، وأحيانًا في الشرق في الصباح، فربطوا الكوكب بإلَهتهم "عشتار". وبحلول العصور الكلاسيكية، كان اليونانيون قد تبنُّوا نفس الرأي، حيث ربطوا الكوكب بالإلَهة المُقابلة لهم، "أفروديت".
والآن، فإن اكتشافًا تجريبيًا كهذا سنُعبّر عنه بعبارة:
(أ) هسبر هو فوسفور.
فهل تتساوى هذه العبارة – منطقيًا – مع قولنا:
(ب) هسبر هو هسبر. [؟]
ثمَّة وَجْهان لهذا اللغز، وهما مُتداخلان، أحدهما إبستمولوجي، والآخر ميتافيزيقي. فمن ناحية إبستمولوجيَّة، لنا أن نسأل: كيف يمكن أن نشرح الاختلاف المعرفي بين الاعتقاد بـ (أ) والاعتقاد بـ (ب)؟ لأنه، بحسب مبدأ الاستبداليّة Substitutivity[22] لـ«لايبنتز»، إذا كانت x متطابقة مع y في كل شيء، ولا يمكن التمييز بينهما، فإن x وy هما الشيء نفسه، بحيث أنَّ ما يصدُق على x يصدُق كذلك علىy والعكس صحيح، فيمكن أن تحلّ إحداهما محلَّ الأُخرى في أيّ عبارة دون أن يطرأ تغيير على صدق أو كذب العبارة. ورغم حدسيَّة ذلك المبدأ، إلا أنه لا يسعنا أن نُطبّقه في حالة الاعتقاد، إذ يمكن لـ «هوميروس» مثلًا أن يعتقد بأمور صادقة عن هسبر من قبيل (أنَّه كوكب يظهر في المساء)، ولا شكَّ أنَّ هذا صادق في ذلك السياق، كما يمكنه أيضا أن يعتقد بأمور صادقة عن فوسفور مثل (إنَّ فوسفور يظهر في الصباح)، ويكون ذلك الاعتقاد صادقًا أيضًا، ومع العلم بأنَّ «هوميروس» لا يعرف أن هسبر وفوسفور هما الشيء نفسه، فلا يسعنا أن نُطبّق مبدأ الاستبداليّة في هذه الحالة؛ إذ لا تصدُق العبارة التالية:
(ج) يعتقد «هوميروس» أنَّ هسبر يظهر في الصباح.
ومن ناحية ميتافيزيقية، لنا أن نسأل عن الوضع الميتافيزيقي الذي تُعبّر عنه العبارَتين: هل العبارة (أ) صادقة ضرورةً أم إمكانًا؟ بالنسبة إلى (ب)، فهي حقيقة ضرورية بلا شك، فالشيء هو نفسه، ونفي هذه العبارة يقود إلى التناقض، وبحسب مبدأ الاستبدال مرة أُخرى، فإن (أ) مُتكافئة منطقيًّا مع (ب) بالفعل؛ إذ لا يمكن التمييز بين هسبر وفوسفور، فهما متطابقين. ومع ذلك، يعتقد الكثير من الفلاسفة بأن (أ) تُعبّر عن حقيقة ممكنة، وحُجَّتهم هنا أنَّ (أ) اكتشاف تجريبي، وكل ما هو تجريبي فهو ممكن وعارِض، فقد كان من الممكن ألا نكتشف أنَّ هسبر هو فوسفور! أمَّا (ب)، فهي حقيقة منطقيَّة لا شأن لها بما يجري في الواقع، وم ثمَّ فهي ضرورية. فما الذي يجري هنا؟ يتناول «كريبكة» وَجْهَي المسألة على نحوٍ مُستقلّ، في محاضرات «التسمية والضرورة» يُركّز «كريبكة» الجانب الميتافيزيقي من المسألة، وهو ما يهمّنا أكثر نظرًا لارتباطهِ بصميم هذا البحث. أمَّا الجانب الإبستيمولوجي من المسألة، فيتعرَّض له تفصيلًا في موضعٍ آخر.[23]
وفيما يتعلَّق بالجانب الميتافيزيقيّ، لا يرى «كريبكة» اختلافًا بين العبارة (أ) والعبارة (ب) من حيث الوضع الميتافيزيقي اللذان تُعبِّران عنه، فكلاهما ضروريَّتان، غير أنَّ الفلاسفة الذين يعتقدون بإمكانية العبارة (أ) اختلط عليهم التمييز بين «الإمكان الإبستيمولوجي» Epistemic Possibility و«الإمكان الميتافيزيقي» Metaphysical Possibility. فإن «اكتشافنا» أنَّ هسبر هو فوسفور كان من الممكن ألَّا يحدث حقًّا، كان من الممكن ألَّا نحصل على مُشاهدات فَلَكيَّة دقيقة تُصحّح لنا اعتقادنا، غير أنَّ «من الممكن» هنا إنما تُعبِّر عن حالتنا المعرفية[24] لا عن واقع الأشياء؛ لأنه، في ظرفٍ ضدّ-فِعليّ، إذا لم نحصل على مُلاحظات فلَكيَّة دقيقة، فلا يعني ذلك أنَّ هسبر ليس هو فوسفور، بل ببساطة، يعني ذلك أننا نمتلك اعتقادات خاطئة حولَ شيءٍ واحدٍ نُسمِّيه باسمَيْن مُختلفين. وإنَّ تعليل هذه المسألة ليعود بنا إلى «أطروحة الصرامة»: تنتقي المُحدِّدات الصارِمة شيئًا مُعيَّنًا في جميع العوالِم الممكنة كما رأينا، وبناءً على ذلك، فبما أنَّ «هسبر» و«فوسفور» هما مُحدِّدات صارِمة، وبما أنّهما الشيء نفسه – في واقع الأمر – فلا يمكن لـ «هسبر» ألَّا يكون «فوسفور» في أيِّ عالَمٍ مُمكن؛ إذ إنهما يُحدّدان شيئًا مُتطابقًا مع نفسه في جميع العوالِم الممكنة. ثمَّة قاعدة منطقية يمكن استنتاجها إذن: إنَّ عبارات الهُويَّة التي تُطابقُ بين مُحدِّداتٍ صارِمة، إذا صدَقَت فإنها صادقة بالضرورة.
الفكرة إذًا، أنَّه ليس شرطًا علينا أن نعرف قبليًّا صدقَ عبارات الهُويَّة التي تُطابق بين الأسماء (أو المُحدِّدات الصارِمة Rigid Designators بوجهٍ عام)، ولا يترتَّب على ذلك أن هذه العبارات مُمكنة ميتافيزيقيًّا في حال ما إذا صدَقَت. وهكذا يُجيز لنا «كريبكة» الضرورة بَعديَّا A posteriori Necessity، على عكس ما اعتقدَ التقليدُ التحليليّ منذ «كانط» بأنَّ كل ما هو تركيبيّ بَعديّ لابدَّ أن يكون إمكانيًّا عارِضًا، وكل ما هو قَبْليّ تحليليّ لابدَّ أن يكون ضروريًّا. وهذه هي نُقطةُ التحوُّل الحاسمة التي غيَّرت مسار الفلسفة التحليليَّة منذ الربع الأخير للقرن العشرين.
قبل أن نتعرَّض لمشكلة الأسماء الفارغة Empty Names، ينبغي أن نتوقَّف قليلًا لنستخلصَ ما يلزم منطقيًّا من نتائج مِمَّا قد طرحناه حتى الآن.
عودة إلى الميتافيزيقا (نتائج مُباشرة):
الماهَويَّة العلمية Scientific Essentialism
تتكامل أطروحة «صرامة التحديد» مع «النظرية السببية في الإشارة»، بالتوازي مع سقوط «نظرية الأوصاف»، لاستعادة الصِّلَة المُباشرة بين اللغة (التسمية) والواقع (الشيء)، وبالتضافر مع أطروحة «الضرورة البَعديَّة» A posteriori Necessity والتمييز بين الإمكان المعرفي والإمكان الميتافيزيقي، نجد بين أيدينا مُسوّغًا منطقيًّا للتمسُّك بالرؤية الماهَويَّة Essentialism مرَّةً أُخرى. فبعد انفكاك «الضرورة» عن المعرفة القَبليَّة وعن اللغة، وبيان الوضع المنطقي المميَّز لأسماء الأعلام من حيث هي غير قابلة للاختزال إلى أوصاف، نستطيع الآن أن نتكلَّم عن «الأشياء» التي تُشير إليها الأسماء، من حيث هي جواهر Substances لا عن «حزمة صفات» Bundle، ونستطيع أيضًا أن نتساءَل عن الصفات «الضرورية» التي تتَّصف بها هذه الأشياء ونُميّزها عن الصفات «العَرَضيَّة» دون أن نخشى الاتهام بأنّنا نخلط بين الأشياء وطُرُق توصيفها المختلفة كما يزعم التوصيفيّون. أضف إلى ذلك أنَّ «النظرية السببية في الإشارة» تنطبق بمضمونها على الأسماء بإطلاق اللفظ، لا على أسماء الأعلام فقط، فالصلة السببية التي تربط تاريخيًا بين الاسم العَلَم والفرد المُسمَّى، هي ذاتها الصِلَة التي تربط بين الأسماء العامة والنوع المُسمَّى؛ فالتسمية لا تختلف في الحالتين.
بدايةً، لا يشترط «كريبكة» في معرفة الماهيَّة معاييرًا «كيفيَّة» محضة، وبدلًا من ذلك يُزوّدنا بمعايير أدق.
1) ضروريَّةُ المنشأ كمعيار لتحديد هُويَّة الأفراد Individuals: لا يمكنُ للشيء أن ينشأ من أصل مُختلف ويكون هو نفسه.
فمثلًا، هل كان يُمكن للمَلِكَة «إليزابث الثانية» أن تُولَد لأبَوَيْن مُختلفين عن أبوَيْها الحقيقييّن؟ لنفترض أن تعريف (الوالِدَين) هو: الشخصان اللذان نجد في أنسجتهما مصدر البُوَيْضة والسائل المنويّ. والآن، نستطيع أن نتصوَّر عالَمًا ممكنًا، حيث يُنجِب فيه شخصان آخران فتاةً تُشبه في ملامحها الخارجية الملكة «إليزابث الثانية» كما نعرفها بالفعل، إلى الحدّ الذي لا نستطيع معه التمييز بينهما. وليكن اسمها «إليزابث*» أيضًا، بَيْد أن والدَيْها هما السيد والسيّدة «ترومان» مثلًا. الآن نسأل: هل هذه الفتاة هي «إليزابث الثانية»؟ نستطيع أن نتخيَّل هذه الـ«إليزابث*» وقد أصبحت – بحيلةٍ ما – ملكةً لبريطانيا، ويمكن أن نتخيَّل أيضا «إليزابث الثانية» الفعليّة وقد وُلِدَتْ لوالِدَيْها الحقيقيين في العالَم نفسه (بالتعريف المذكور للوالدين) ولكنها، ولأسبابٍ سياسيةٍ ما، لم تصل إلى العرش يومًا وعاشت فقيرةً ومعوزة، والآن نسأل: هل يمكن أن تكون هذه الـ«إليزابث*» الملكة، هي نفسها «إليزابث الثانية» الحقيقية؟ لا يبدو ذلك قابلًا للتصوُّر؛ إذ كيف يمكن لشخصٍ يولد لأبَوَيْن مختلفين، من بُوَيْضة وحيوان منويّ مختلفين بالكامل، أن يكون هذه المرأة بعينها؟
ولا تقتصر المسألة على الأشخاص فقط، بل لنا أن نتحدَّث أيضًا عن الأشياء الماديَّة من قبيل الطاولات والكراسي وغيرها. لنفترض أن لدينا طاولة x مصنوعة من خشب (الزان) مثلًا، ولها صفات خارجية مُعيَّنة، لونها بُنِّي داكن، ناعمة الملمس، ثقيلة وصلبة، إلخ... هل كان يمكن للطاولة x أن تُصنع من (البلاستيك)، أو من أي مادة أُخرى غير التي صُنِعَت منها؟ نعم يُمكن، لكن لنفترض أنها صُنِعَت من خشب (الزان) بالفعل. والآن، لنفترض أنَّ لدينا طاولةً أُخرى y تُشبه في مظهرها الخارجيّ الطاولة x تمامًا، على نحو يتعذَّر معه التمييز بينهما، ولكنَّ y في حقيقتها صُنِعَت من (البلاستيك)، ولنفترض أنّنا ولسببٍ ما لم نتمكَّن من معرفة أنَّها مصنوعة من (البلاستيك)، هل يمكن للطاولة y أن تكون هي نفسها الطاولة x؟ هذا ما لا يمكن تصوُّره.
2) البنية الداخليَّة كمعيار لتحديد هُويَّة الأنواع الطبيعية Natural Kinds: ينبغي للشيء أن يكون حائزًا على بنيةٍ داخليَّة كشرط لوجوده.
ما الذي يُميِّز «الذهب» كعنصر طبيعي؟ ربما يقول البعض: إننا نعرف الذهب من لونه الأصفر اللامع. فهل هذا صحيح؟ ألا يمكن أن نكتشف أن الذهب ليس بأصفر؟ يمكن من حيث المبدأ أن نتخيَّل ظرفًا ضد-فِعليّ، حيث اعترى حواسنا خللٌ ما، أو لنفترض أنَّ هنالك وهماً بصريًّا سبَّبته ظروف مناخية مُعيَّنة على مستوى العالَم لحقبة زمنية طويلة، مما جعلنا نرى الذهبَ باللون الأصفر طوال هذه الفترة. والآن، في عالَم مُمكن كهذا، لنفترض أنّ هذه الظروف المناخية قد تبدَّدت فجأة وعادت الأمور إلى طبيعتها، فتبيَّن أن الذهب في حقيقة الأمر لونه أزرق! هل سنجد، من جرَّاء ذلك الاكتشاف العجيب، إعلانًا في الجرائد يقول: ’’لقد تبيَّن أن ليس هنالك ذهب، الذهب ليس موجودًا...!‘‘. يبدو أنَّ إعلانًا مُماثلًا ليس في البيِّن أن يحدث، بل على العكس، ما سيُعلَن هو، أنَّ الذهب رغم أنه كان يبدو أصفر، إلا أنه في الواقع قد تبيَّنت زُرقته. ومردُّ ذلك إلى أمرين: (أ) أننا نستعمل المُفردة «ذهب» لنوعٍ مُعيَّن من الأشياء لدينا صِلَةٌ سببيةٌ تربطنا به. (ب) أنَّ ذلك النوع الذي ندعوه «ذهبًا» لديه بنية داخليَّة مُحدَّدة نعرفه من خلالها، وهي حيازته على «العدد الذرّي 79». لكن لنستبعد ظرفًا ممكنًا كهذا بوصفه خيالًا بعيد الاحتمال. ثمَّةَ نوع من المعادن يشترك مع «الذهب» في صُفرته بالفعل، أنه «بيريت الحديد» Iron Pyrites، وهو ما يُطلق عليه أيضًا «ذهب الحمقى» Fool’s Gold، فكثيرًا ما تعذَّر تمييزه على عُمَّال المناجم، فيخالونه ذهبًا. إنَّ ما يُميِّز عنصر «الذهب» عن «ذهب الحمقى» هو اكتشافنا للبنية الداخليَّة التي يتكوَّن منها النوع الأول، وهي حيازة «العدد الذرّي 79»، والتي تختلف عن التركيب الكيميائي لـ«ذهب الحمقى» ثمَّة تجربة فكرية شهيرة قدّمها «هيلاري بوتنام» تتقاطع مع أغراضنا هنا: فلنتخيَّل عالَمًا ممكنًا، حيث يوجد كوكبٌ مُماثل لكوكبنا الأرض الذي نعيش فيه، وليكن اسمه «الأرض التوأم» مثلًا، ولنفترض أنَّ الناس الذين يعيشون على كوكبنا الأرض هنا لهم نُسَخٌ مُتطابقة من النواحي الفيزيائيّة والبيولوجيّة والنفسيّة على الأرض التوأم، وأنَّ هذه الأرض التوأم تُشبه كوكبنا في كل شيء تقريبًا، فيما عدا جانب واحد فقط، وهو أنَّ السائل الذي يُسمَّى «ماء» في كِلا الأرضَيْن، ليس له التركيب الكيميائي نفسه، فعلى كوكبنا الأرض يتكوَّن الماء من ذرَّتا هيدروجين وذرَّة أوكسُجين H₂O، بينما «ماء» الأرض التوأم يتكوَّن من تركيب كيميائي آخر مُعقَّد وليكن رمزه المختصر xyz، ومع ذلك ينبغي مُلاحظة أنَّ كل الصفات الظاهرية لـH₂O موجودة في xyz أيضًا، فهو مادة عديمة اللون والرائحة، توجد في الأنهار والبحار وتسقط على هيئة أمطار، ويستخدمها الناس للشُّرب. والآن لنتخيَّل أننا في عام 1750م، حيث لم يكن لدينا (نحنُ وسُكَّان الأرض التوأم) علم بالكيمياء، وبذلك نكون غير قادرين على إدراك الاختلاف بين «الماء» H₂O و«الماء التوأم» xyz. والآن لنسأل: هل كِلا السَّائلَين متطابقان أم لا؟ للإجابة عن ذلك السؤال، يمكننا أن نتخيَّل اثنين من المُتكلّمين هما «يوسف» على أرضنا و«توأم يوسف» على الأرض التوأم، وكل واحد منهم هو نُسخة دقيقة من الآخر، يُفكّر أحدهما في الماء عندما يُشاهد السائل H₂O ويُفكّر الآخر في الماء عندما يُشاهد السائل xyz، ويشتركان معًا في الاعتقادات والانطباعات النفسية ذاتها حول ما يُسمّيه كل منهما «ماء»، ويشتركان أيضًا فيما ينسبانه للماء من صفات. ورغم كل ذلك، فمن الواضح أنهما لا يُشيران إلى الشيء نفسه، فلفظة «ماء» لدى كل منهما لها ما صدَق مُختلف، فأحدهما يُشير إلى H₂O والآخر يُشير إلى xyz.
يتضح من هذه الأمثلة (وغيرها ممّا يُقدّمه «كريبكة» في المحاضرة الثالثة من التسمية والضرورة) أنَّ العبارات التي يُحكى فيها عن اكتشافاتٍ علميةٍ من النوع الذي يُخبر عن الشيء ما هو؟ إذا ما صدقت فهي صادقة بالضرورة، وأنَّ الصفات الضرورية المُخبرة عن ماهيَّة الشيء، هي مُحدداتٌ صارِمة Rigid designators. فمع عِلمنا بصدق العبارة ’’الذهب هو العنصر ذي العدد الذرّي 79‘‘ فلا يمكن إذن ألَّا يكون الذهب هو «العنصر ذي العدد الذرّي 79»، وأي شيء آخر يشترك مع الذهب في مظهره الخارجي لن يكون ذهبًا، لربما يكون «ذهب الحمقى»، كما أنَّ الماء لا يمكنه ألَّا يكون «المُركَّب الكيميائي H₂O» وأي شيء آخر يشترك مع الماء في مظاهره العامة لن يكون ماءً، لربما يكون أيضًا «ماء الحمقى» المُركَّب كيميائيًّا من xyz. وعلى رغم من أنه كان من الممكن ألَّا نكتشف أيًّا من هذه الأمور (أن الذهب هو العنصر ذي العدد الذرّي 79 وأنَّ الماء هو المُركَّب الكيميائي H₂O)، إلا أن «إمكانيةً» كهذه هي إبستمولوجية، وليست ميتافيزيقية. وما يعنيه ذلك هو، ببساطة، أنه في ظرفٍ ضد-فِعليّ مُماثل كان من الممكن لنا ألَّا نحصل على الأدلَّة المُلائمة لتحقيق هذه الاكتشافات... كان من الممكن أن تكون أدلَّتُنا «كيفيَّة» ومن ثمَّ فهي عِرضة للخطأ، وليس هذا ظرفًا لا يكون فيه الماء هو المُركَّب H₂O أو الذهب ليس هو العنصر ذي الرقم الذرّي 79. ففي النهاية، ينبغي للشيء أن يكون حائزًا على بنيةٍ داخليةٍ كشرط لوجوده، وليس شرطًا أن نعرفها قبليًّا، فلا مانع في إمكان اكتشاف الماهيَّة تجريبيًّا، وهذه هي الماهَويَّة العلمية.
الأسماء الفارغة Empty Names والكائنات الأسطوريَّة: حُجَّتان فلسفيَّتان
ماذا عن الأسماء الفارغة الدالَّة على كائنات أسطورية؟ ما الذي يُقوله «كريبكة» بصددها، تعويضًا عن التحليل القائم على الأوصاف؟ يُقدِّم لنا «كريبكة» حُجَّتان فلسفيَّتان، أولاهما ميتافيزيقية، والثانية إبستمولوجية. تتكامل الحُجَّتان معًا لتأكيد نتيجة مفادها: أنه ما من سبب كافٍ لادعاء وجود (أو حتى إمكان وجود) أي كائناتٍ أسطورية من قبيل «العنقاوات» أو «الغيلان» وما شابه، وحتى إذا ما اكتشفنا يومًا وجود كائنات تتصف بالصفات نفسها التي تخبرنا بها الأسطورة، فليس ثمَّة ما يُبرّر الاعتقاد بأن ما اكتشفناه هو نفسه هذه الكائنات الأسطورية!
بالنسبة إلى الحُجَّة الميتافيزيقية، فهي كالآتي:
(1) كما أنَّ هنالك فرقا بين الذهب الحقيقيّ وذهب الحمقى، فكذلك هناك أجناسٌ حقيقيَّة وأجناسٌ أُسطوريَّة.
(2) وكما أنَّ حديد البيريت ليس ذهبًا حقيقيًّا، فإن العنقاوات (أو ما شابهها من كائنات خيالية) جنسٌ أسطوريٌّ غير حقيقيّ.
(3) وكما أنّه لا يمكن تعريف الذهب ببساطة على أساس مظهره الخارجي فقط، فكذلك لا يمكن تعريف العنقاوات على أساس مظهرها الخارجي؛ إذ ينبغي لها أن تمتلك بنيةً داخليةً لتتحدّد ماهيتها من خلالها.
(4) فبالنسبة إلى أي جنسٍ افتراضيّ من الأجناس الخيالية المتنوعة التي قد تُشبه العنقاء في مظاهرها الخارجية كما تصفها لنا الأسطورة، لا يمكننا أن نحسم أي واحدٍ منها قد يكون هو العنقاء، طالما أنَّ الأسطورة لم تُزوّدنا بمعرفة للبنية الداخلية التي لجنس العنقاء؛ إذ يمكن لهذه الأجناس الخيالية أن تشترك جميعها في المظاهر الخارجية التي تصفها لنا الأسطورة عن العنقاء، ومع ذلك، فبعضها قد يمتلك بنيةً داخليةً كالتي للزواحف، أو البرمئيات، أو الثديّيات. فأيّها إذًا كان يمكن أن يكون هو العنقاء؟
النتيجة: ليس ثمَّة جنسٌ حقيقيٌّ أو مُمكن، نستطيع أن نقول عنه أنه هو العنقاء.
أما الحُجَّة الإبستمولوجية، فهي أسهل:
(1) إذا ما حصلنا على حكاية تصف مادةً لها المظهر الخارجي الذي للذهب، فلا يمكننا أن نجزم بناءً على ذلك أنها تتحدث عن الذهب، لعلَّها تحكي عن «ذهب الحمقى». أمَّا تحديد المادة محلّ النقاش فيتم كما في حالة أسماء العَلَم: من خلال ارتباط الحكاية – تاريخيًّا – بمادةٍ ما. فإذا ما تتبّعنا الرابطة التاريخية فقد يتبيَّن أنَّ المادة محلّ النقاش هي الذهب، أو ذهب الحمقى، أو شيء آخر.
(2) إذا صحَّ ذلك، فإن مجرد اكتشاف حيوانات لها نفس الصفات التي تُنسَب للعنقاوات في الأسطورة، لا يكفي بذاته للاعتقاد بأن هذه هي الحيوانات التي تتحدَّث عنها الأسطورة. لعلَّ الأسطورة اختلقت هذا الكائن من لا شيء، وصادف أن وجدنا حيوانات لها المظهر نفسه! في هذه الحالة لا يسعنا أن ندَّعي أن عنقاء الأسطورة وُجدت حقًّا؛ إذ ينبغي أن نؤسّس لرابطة تاريخية بين الأسطورة وهذه الحيوانات.
النتيجة: في حالة عدم تحقُّق شرط الارتباط التاريخي هذا، فإنَّ أي اكتشاف تجريبي لجنس من الحيوانات، يُشبه العنقاء كما تصفها الأسطورة، لن يُشكّل بذاته دليلًا كافيًا للاعتقاد بوجود هذه الكائنات.
ثمَّة تداعياتٌ ميتافيزيقيَّة أُخرى للأطروحات التي قدَّمها «كريبكة»، سنتعرَّض لأهمَّها في الجُزء الثالث من هذا البحث.
انتهى الجُزء الثاني.
[1] Gotlob Frege, ‘’On Sense and Nominatum’’, translated by Herbert Feigl in Readings in Philosophical Analysis (ed. By Herbert Feigl and Wilfried Sellars) Appleton Century Crofts, 1949, p. 86
[2] John R. Searl, ‘’Proper Names’’, Mind 67 (1958), 166-73
[3] See: https: //rb.gy/4jvfea
[4] صول كريبكة "التسمية والضرورة"، ترجمة وتقديم: محمود يونس. دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، ص: 105
[5] المصدر نفسه، ص: 86-92
[6] المصدر نفسه، ص: 159
[7] المصدر نفسه، ص ص: 108-109
[8] د. محمود فهمي زيدان "في فلسفة اللغة". دار النهضة العربية. ص ص: 14-15
[9] المصدر نفسه، ص ص: 17-18
[10] سبق أن أشرنا إلى ذلك الإبهام في موقف «راسِل» من الأسماء العَلَم في الجُزء الأوّل من هذا البحث، الهامش رقم 19
[11] برتراند راسِل "التصوُّف والمنطق ومقالات أُخرى". ترجمة عبد الكريم صالح وهالة سليمان عمران، دار الفرقد الطبعة الأولى 2016، ص: 283
[12] إنها لَمسألة مُحيّرة حقًّا أن يتخذ «راسِل» من أسماء الأعلام المألوفة أمثلةً في نقده لوجهة نظر «فريجة»، بدلًا من أسماء الإشارة التي اعتبرها "أسماء الأعلام الحقيقية". ويبدو أنَّ دواعي التخلُّص من مقولة (الجوهر) هي الأساس الذي يُفسِّر ذلك الموقف المُحيِّر لـ «راسِل» تجاه أسماء الأعلام المألوفة.
[13] سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في نهاية الجُزء الأول من هذه السلسلة.
[14] صول كريبكة "التسمية والضرورة". ص: 113
[15] The Nature of Necessity, P: 8
[16] في حدود ما أعلم، يبدو أنَّ «كانط» هو الاستثناء الوحيد لهذا الحُكم، فهو الوحيد الذي دافع عن هذه الدعوى القائلة بوجود حقائق تركيبية قبلية، وقد رُفِضَت هذه الدعوى فيما بعد من جميع الفلاسفة اللاحقين تقريبًا.
[17] John S. Mill, A System of Logic. Ed: 8 (1881), P: 36
[18] Ibid, P: 35
[19] صول كريبكة "التسمية والضرورة" ص ص: 184-185
[20] صول كريبكة "التسمية والضرورة" ص: 187
[21] المصدر نفسه، ص ص: 189-190
[22] ويُسمَّى أيضًا "قانون لايبنتز" Leibniz Law أو "مبدأ لا تمايُز المتطابقات" Principle of indiscernibility of Identicals
[23] ناقش «كريبكة» هذه المسألة من الناحية الإبستمولوجية في مقالته A Puzzle about Belief المنشورة بكتاب Philosophical Troubles; collected papers.
[24] صول كريبكة "التسمية والضرورة" ص: 199-201