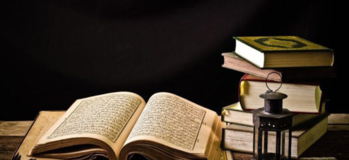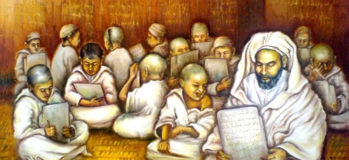النسخ في دائرة المعارف القرآنيَّة
فئة : ترجمات

النسخ في دائرة المعارف القرآنيَّة
تأليف: د. جون بيرتون
ترجمة: د. عبد الكريم محمد عبد الله الوظّاف
مقدمة المترجم
نُشرت هذه المقالة في دائرة المعارف القرآنيَّة Encyclopaedia of the Qur'ān، والصادرة عام 2006، من الصفحة 11-19، من المجلد الأول، عن دار بريل.
دائرة المعارف القرآنيَّة هي موسوعةٌ مكونةٌ من خمسة مجلداتٍ وملحقٍ. تحتوي الدائرة على مجموعةٍ من المقالات الأكاديميَّة باللغة الإنجليزيَّة، والتي تهتم بكل المواضيع التي تخص القرآن، بالاعتماد على التراث العلميّ الغنيّ؛ فهي أشبه بقاموسٍ موسوعيٍّ للمصطلحات القرآنيَّة والمفاهيم والشخصيات وأسماء الأماكن، والتأريخ الثقافيّ، والتفسير؛ معروضةٌ بشكلٍ موسعٍ، مع مقالات عن أبرز المحاور والمواضيع في الدراسات القرآنَّية. وهنا أُقدم لكم ترجمة لمقالة عن النسخ، كتبها جون بيرتون John Burton.
وهو: جون جارارد بيرتون بيغ، مستشرقٌ بريطانيٌ ومحاضرٌ في الفن والعمارة الهنديَّة في كلية الدراسات الشرقيَّة والأفريقيَّة Oriental and African Studies. وكان محررًا ومساهمًا غزير الإنتاج في الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلاميَّة Encyclopaedia of Islam ما بين 1960 و1995. وُلِد جون في ويستكليف أون سي، إسيكس في 19 ديسمبر (كانون الأول) 1921. وعلى الرغم من أنه التحق بصفته عازفًا للبوق في الكليَّة الملكيَّة للموسيقى Royal College of Music؛ إلا أن دراسته توقفت بسبب الحرب العالميَّة الثانية. خدم في الهند وبورما، وأنهى الحرب بصفته قائدًا في فوج بنادق جوركا الأول التابع للملك جورج الخامس. وبعد أن أصبح يُجيد اللغتيْن الهنديَّة والنيباليَّة؛ التحق عند عودته إلى إنجلترا بصفته طالبًا ناضجًا في كلية وادهام Wadham College، أكسفورد لدراسة اللغة السنسكريتيَّة. وبعد تخرجه في عام 1950، التحق بمدرسة الدراسات الشرقيَّة والأفريقيَّة بوصفه محاضرًا مؤقتًا في النيباليَّة. وبقي في كلية الدراسات الشرقيَّة والأفريقيَّة لأكثر من ثلاثة عقود، وعمل لاحقًا محاضرًا في اللغة الهنديَّة، وأصبح مهتمًّا بشكل مُتزايدٍ بالتأريخ والعمارة الهنديَّة الإسلاميَّة. وكان آخر منصبٍ له هو محاضرٌ في قسم الفن والآثار في جنوب آسيا، واستمر في الكتابة والتدريس لعدة سنوات بعد تقاعده الرسمي. له عدة أعمال، منها كتاب العمارة الإسلاميَّة الهنديَّة: الأشكال والأنماط والمواقع والمعالم Indian Islamic architecture: forms and typologies, sites and monuments (2007). توفي في 2005م.
وأخيرًا.. إليكم الترجمة العربيَّة للمقالة.
النسخ هو: مفهومٌ بارزٌ في مجالات تفسير القُرآن والشريعة الإسلاميَّة، والذي سمح بالتوفيق بين التناقضات الظاهرة في الأحكام الشرعيَّة. وعلى الرغم من المؤلفات الضخمة التي أنتجها المسلمون حول هذا الموضوع على مر القرون، فقد أبدى العلماء في الغرب اهتمامًا تأريخيًّا ضئيلًا بتحليل تفاصيل "النسخ". فعلى سبيل المثال، على الرغم من إدراكهما لهذه التفاصيل؛ فقد أخفق ثيودور نولدكه وفريديريش شوالي F. Schwally في استكشاف التمييز المهم الذي أُجري عند تطبيق نظريات النسخ على القُرآن. ولفهم هذا التطبيق، فمن المهم التمييز بين القُرآن بوصفه مصدرًا والقُرآن بوصفه نصًّا، والفرق هو الآيات التي أُزيلت من النص، والتي يظل جوهرها مصدرًا إثباتيًّا للعقيدة (جون بيرتون، جمع القُرآن، J. Burton, Collection, 233). وبالنظر إلى مسألة العلاقة بين القُرآن والسُّنَّة - المُمارسة التي داوم عليها النَّبِيّ مُحَمَّد كما هو في الحديث الصحيح - فإن المعلومات غير الكافية قد شوشتْ على إغناز غولدتسيهر (الدراسات المُحَمَّدية، Muhammedanische Studien, 2/20) إلى حد تحريفٍ غير مقصودٍ لأهميَّة الموقف الذي تبناه الفقيه الكلاسيكيّ الشافعيّ (ت. 204هـ/820م). وفي الآونة الأخيرة، أدى تركيز جوزيف شاخت J. Schacht على الاختلاف بوصفه فئةً مُعترفًا بها في الحديث والسُّنَّة، فضلًا عن تكهناته بشأن أصل وطبيعة الحديث، إلى التقليل من دور القُرآن وتفسيره وعلاقته المُتصَوّرة بالسُّنَّة بوصفها عوامل مهمةً لتطور الفقه (الأصول، Origins, 95-97).
ويعترف الفقه الإسلاميّ الكلاسيكيّ بمصدريْن رئيسيْن للأحكام الشرعيَّة: القُرآن والسُّنَّة. بالإضافة إلى ذلك، اعتُرِفَ بمصدريْن ثانوييْن بعد النبوة: القياس المُستمد من أحد المصدريْن الرئيسيْن، وإجماع الفقهاء المُؤهلين. ولا ينطبق النسخ على أيٍّ من المصدريْن الثانوييْن، ولكن على الوثائق التي تستند إليها فحسب. ولأن النسخ من اختصاص المُشرِّع وحده، فيُمكن القول إنه لابد أن يكون قبل وفاة النَّبِيّ الذي كان واسطةً في وضع الشرائع الواردة في القُرآن والسُّنَّة.
وتفسير النسخ كـ "إلغاء تشريعٍ فقهيٍّ" غير كافٍ للمصطلح العربيّ "النسخ" الذي يتضمن، عند تطبيقه على القُرآن، إشارةً إلى "الحذف"، رغم أنه يُشير عادةً إلى "الاستبدال". وقد يكون مقصود النسخ خارج الإسلام أو داخله. وعند ظهوره، عدّتْ المسيحيَّة نفسها أنها حلتْ محل اليهودية، بينما رأى الإسلام نفسه، بالوحي، أنه أزاح كلَ من سبقه كتعبيرٍ عن الإرادة الإلهيَّة (الغزّاليّ، المستصفى، 1/111). ولكلٍ من الوحي التأريخيّ مدةً مُحددةً مُسبقًا [سورة الرعد: 38]، وإن كان الإسلام، الذي كان المقصود منه أن يكون آخر سلسلة الوحي هذه، سيستمر حتى يوم القيامة [سورة الأحزاب: 40].
ومثل المسيح، جاء مُحَمَّد ليُؤكد التوراة، وليحل بعض ما كان قد حَرُم مِن قَبل [سورة البقرة: 286؛ وسورة آل عِمران: 50]. فعلى سبيل المثال، أُمر النَّبِيّ بالإعلان بحل طعام المسلمين لليهود [سورة المائدة: 5]. والواقع أن بعض عناصر الشريعة اليهوديَّة كانت مقصودةً كعِقابٍ؛ فُرِضَتْ عليهم بسبب ذنوبهم [سورة النساء: 160؛ وسورة الأنعام: 146].
وبالنسبة إلى علماء المسلمين، كان نسخ اليهوديَّة والمسيحيَّة بالإسلام واضحًا، وإن كان النسخ الداخليّ أقل وضوحًا. وكان لا بد من الدفاع عن هذا الأخير بقوةٍ في سياق الاستعانة بقياس النسخ الخارجيّ وبالآيات القُرآنيَّة، وبالإشارة إلى حالات النسخ المزعومة. فعلى سبيل المثال، رُوي عن الصحابي سَلَمة بن الأكوع (ت. 74هـ/693م) أنه قال: "لما نزلت هذه الآية: )وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدية طَعَامُ مِسْكِينٍ( [البقرة: 184]، كان من أراد أن يُفطر ويفتدي [خلال شهر رمضان] حتى نزلت الآية التي بعدها [)فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ( [سورة البقرة: 185]]، فنسختها". (مسلم، الصحيح، كتاب الصيام). وفي مثالٍ آخر، عندما سأل رجل عن قيام الليل، سألته زوج النَّبِيّ عَائشة: "ألستَ تقرأ: يا أيها المزمل؟ قام نبِيّ الله وأصحابه حولًا، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء. حتى أنزل الله، في آخر هذه السورة، التخفيف. فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضةٍ" (مسلم، الصحيح). وفي هاتين الحالتيْن من النسخ المزعوم، يُزعم أن إحدى القواعد سُحبتْ واستُبدلتْ بقاعدةٍ لاحقةٍ؛ رغم أن الآيات المُستبدَلة بقيتْ في النص.
وتطلب سورة البقرة: 180 من المسلمين تقديم وصيَّةٍ لوالديهم وأقاربهم، بينما ينص مقطعٌ آخر [سورة النساء: 11-12] على أن الحصص في التركة يجب أن تُنتقل تلقائيًا إلى ورثة المسلم. واحترامًا للمبدأ الشرعيّ الذي يتضمن عدم جواز استفادة أحدًا مرتين من تركةٍ واحدةٍ؛ فَقَدَ الآباء وأفراد الأسرة المُقربون الآخرون الحق في الاستفادة المنصوص عليها في سورة البقرة: 180.
فالأرامل، اللاتي وردتْ أسماؤهن في سورة النساء: 12، خسرن النفقة والسكن لمدة اثني عشر شهرًا الممنوحة في سورة البقرة: 240. وبالنسبة إلى بعض الفقهاء الكلاسيكيين، فإن آيةً من القُرآن هنا تنسخ آيةً أخرى. ويزعم آخرون أن أحكام سورة البقرة: 180، وسورة النساء: 11-12، ليس بينهما تعارضٌ بأي حالٍ من الأحوال، ولكن استبعاد الوالديْن والأرامل من استحقاقهم المزدوج قد سُوِي بإعلان النَّبِيّ، "لا وصيَّة لوارث". وهنا يُنظر إلى تصرف النَّبِيّ على أنه نسخٌ للقُرآن.
لقد أصبح الكثيرون يُعدّون أقوال وأفعال النَّبِيّ مصدرًا ثانيًا للتنظيم الإسلاميّ الذي كان، كالقُرآن، خاضعًا لعمليَّة التغيير نفسها (الحازميّ، العدّ، ص23). فعلى سبيل المثال، أعلن مُحَمَّد، "نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النَّبِيّذ إلا في سقاءٍ؛ فاشربوا في الأسقيَّة كلها، ولا تشربوا مُسكِرًا" (مسلم، الصحيح، كتاب الجنائز).
إن الآيات القُرآنيَّة المُتعلقة بتغيير اتجاه الصلاة لا تُوضح نوع هذا النسخ [سورة البقرة: 142-150]. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تغيير الاتجاه المُشار إليه كان حالةً من النسخ الخارجيّ. ورأوا أن النَّبِيّ كان مُلزَمًا بأمر الله لليهود باستقبال القُدْس عند الصلاة، حتى نُسِخَ ذلك بالآية القُرآنيَّة. وفسر آخرون عبارة )وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا( [سورة البقرة: 143] على أنها إشارةٌ إلى التوجه إلى القُدْس، ورأوا أن التغيير كان بمثابة نسخٍ داخليٍّ، حيث ألغى حكمٌ قُرآنيٌّ حكمًا آخر (النحّاس، الناسخ، ص15). ولاحظ بعض العلماء الآخرين صمت القُرآن بشأن قِبلة الصلاة السابقة، وافترضوا أن الصلاة نحو القُدْس قد أدخلها النَّبِيّ ثم غيّرها القُرآن لاحقًا.
نظريَّة النسخ عند الشافعيّ
امتدتْ مهمة النَّبِيّ لأكثر من عشرين عامًا؛ لذلك لم يكن هناك ما يُثير الدهشة في نظريَّة أن تعليماته لمجتمعه يجب أن تُظهِر علامات التطور. ولم تُبدَ مقاومةٌ تُذكر لنظريَّة أن إحدى مُمارسات النَّبِيّ يُمكن أن تَنسخ أخرى. ولقد كان أبسط وسيلةٍ للرد على رأي الخصم بالنسبة للعلماء الذين تولوا استنباط الشريعة من مصدريها في القُرآن والسُّنَّة كانت التأكيد الصريح على أن هذا الرأي، وإن كان صحيحًا في وقت ما، فإنه قد نُسخ منذ ذلك الحين. ولقد كانت الحاجة إلى تنظيم الاستناد إلى المصدريْن، وعلى وجه الخصوص إلى نظريَّة النسخ، هي التي دفعت العالِم الشافعيّ (ت. 204هـ/820م) إلى تأليف كتابيه (اختلاف الأحاديث) و(الرسالة)، وهما أقدم كتابيْن بقيا عن المنهج الفقهيّ. ومن السمات الرئيسة لعمل الشافعيّ هو العناية بإعادة تعريف مصطلح "السُّنَّة" لقصره على الأقوال والأفعال المنقولة عن النَّبِيّ وحده. ولقد فسّر آخرون المصطلح بالمعنى الأقدم والأوسع، ليشمل مُمارسة المرجعيات الأخرى، بالإضافة إلى النَّبِيّ.
وقد سعى الشافعيّ إلى إقناعهم بأن الله قد خص النَّبِيّ وحده بالسُلطة في إصدار الأحكام الشرعيَّة. وقد جمع من القُرآن أدلةً على أن الله شدد على الطاعة المُطلقة لنبيه (على سبيل المثال سورة النساء: 13، 65). وفي سياق الاستشهاد بسلسلةٍ من الآيات التي تربط أوامر مُحَمَّدٍ ونواهيه بالإرادة الإلهيَّة، والتي بلغت ذروتها في آيةٍ ربطت مشيئة مُحَمَّد بالمشيئة الإلهيَّة [سورة النساء: 80]؛ نجح الشافعيّ في تغطية شخصيَّة النَّبِيّ الفريدة التي تُشكل محورًا وشريكًا في عمليَّة الوحي الإلهيّ.
إن أولئك الذين أنكروا أيّ دورٍ للسُّنَّة في بناء الشريعة فعلوا ذلك على ضوء أن القُرآن يحتوي على كل ما هو مطلوب، وأن عدة رواياتٍ حول سلوك النَّبِيّ موضوعةٌ عليه. وقد سعى الشافعيّ إلى إقناع هؤلاء العلماء بأن القُرآن نفسه هو الذي أمر بالرجوع إلى السُّنَّة النبويَّة (الرسالة، ص79-105). ولم تكن النتيجة مجرد تأكيده أن القُرآن يفرض التمسك بسُّنَّة النَّبِيّ، بل كانت رفع مرتبة السُّنَّة كشكلٍ آخر من أشكال الوحيّ (الأم، 7/271)، مُوضحةً ومُكمِلةً للقُرآن، وأنه لا تتناقض معه مُطلقًا. وأنه لا تَنسخ آيةً قُرآنيَّة إلا آيةٌ أخرى، وهذه الآيات لا يُمكن إلا أن تَنسخ آياتٍ قُرآنيَّة أخرى. وعلى المنوال نفسه، لا يُمكن نسخ مُمارسة إرشادية النَّبِيّ إلا بتبنيه لمُمارسةٍ أخرى. وعلى نقيض مُمارسة العلماء الذين كانوا على استعداد للاعتقاد بأن عقائدهم تنسخ عقائد أعدائهم دون أي دليل يدعم هذا الادعاء؛ أكد الشافعيّ أن الأحاديث التي تُوثق كل حالةٍ فعليَّةٍ للنسخ قد بقيت. وبالتالي، كان على المرء أن يُظهر أن إحدى السُّنَّتيْن تتبع الأخرى زمنيًا لتحديد أيهما نُسِخَتْ. ورغم أن الشافعيّ عرَّف "النسخ" بأنه "الترك" (الرسالة، ص122)؛ إلا أنه أضاف أن أي حكمٍ لا يُنسخ إلا إذا صدر حكمٌ بديل عنه، كما حدث في حالة تغيير القِبلة (الرسالة، ص106-113). وبذلك، فإن "النسخ" بالنسبة له يُشير في واقع الأمر إلى "الإبدال".
النسخ والمعرفة الإلهيَّة
في نظر بعض العقول، فإن نظريَّة نسخ آيةٍ من القُرآن لآية أخرى تُوحي بأن الإرادة الإلهيَّة تتغير والمعرفة الإلهيَّة تتطور، وكل هذا يتعارض مع المبادئ العقائديَّة الأساسيَّة. أجاب أولئك الذين سمحوا بأن تنسخ بعض آيات القُرآن بعضها الآخر بأن أي مسلمٍ لا يعترض قط على نظريَّة أن الإسلام قد نسخ المسيحيَّة واليهودية. وأن النسخ الخارجيّ من هذا النوع هو حقيقةٌ مُعترفٌ بها، وهي حقيقةٌ أشار إليها القُرآن، وبالتالي يُمكن قبولها. وإذا كان الله يُكيّف أحكامه مع الظروف المُختلفة السائدة في العصور المُختلفة، كما هو واضح في تغيير الشرائع التي أُنزِلَت على الأنبياء المُختلفين؛ فإنه قد يُكيّف أيضًا الأحكام المُناسبة للمراحل الأوليَّة من وحيٍ واحدٍ لمواجهة التغييرات التي حدثت في سياق الوحي (الغزّاليّ، المستصفى، 1/111). وعلاوةً على ذلك، كانت هناك أدلةٌ تأريخيَّةٌ على حدوث ذلك. فعلى سبيل المثال، أُمر المسلمون في مكة بالصبر في مواجهة الهجمات اللفظيَّة والجسدية من أعدائهم. وعندما هاجر المجتمع المسلم إلى المدينة المنورة، أُمروا بالرد على العنف بالعنف. وحلتْ القوة العدديَّة والاقتصاديَّة للإسلام المدنيّ محل ضعف الإسلام المكيّ. وفي ظل هذه الظروف المُتغيِّرة، يُمكن استبدال الصبر بالانتقام [سورة البقرة: 191، 216؛ وسورة طه: 130؛ وسورة الروم: 60؛ وسورة المُزمل: 10].
وأكد علماء الكلام المسلمين أن الإرادة الإلهيَّة ذات سيادةٍ ولا تحدها أي قوةٍ في الكون. فالله قد يأمر أو ينهى عما يشاء، وكذلك فإن العِلم الإلهيّ لا حدود له وهو فوريٌّ. فمنذ الأزل، يعلم الله ما ينوي أن يأمر به، ومتى يأمر به، والمدة المُحددة لكل أمرٍ، واللحظة الدقيقة التي يعتزم فيها إبطاله. وهناك انسجامٌ تامٌ بين الإرادة الإلهيَّة والعِلم الإلهيّ. فالإرادة الكاملة لا تتغير، والعِلم الكامل لا يتطور. ففي حالة صيام شهر رمضان، أصبح الصيام إلزاميًا. وفي حالة قيام الليل، أصبح الالتزام اختياريًا. وفي حالة تغيير القِبلة، طُلب من المسلمين أن يتوجهوا إلى مكة بعد أن طُلب منهم أن يتجهوا إلى القُدْس. وفي كل حالةٍ، كان الحُكم السابق مُناسبًا لوقته، وكان النسخ اللاحق مُناسبًا لوقته أيضًا (الشافعيّ، الرسالة، ص117-137).
ولكن الظروف البشريَّة تتغير، والعِلم البشريّ يتطور. وعندما يأمر البشر بعضهم بعضًا ثم يُدركون العواقب غير المتوقعة؛ فإنهم مُلزَمون بسحب الأمر. إن افتقارهم إلى البصيرة الكاملة غالبًا ما يضطرهم إلى إعادة التفكير (البداء، القُرطبيّ، الجامع، 2/64)، وهذا لا يجوز على الله وفقًا لعِلم الكلام السُّنِّيّ الكلاسيكيّ.
وعندما يحدث النسخ، قد يشعر الناس بالتغيير، ولكن هذا التغيير من منظورٍ بشريٍّ ليس إلا تغييرًا. فيرسل الله أنبياءه بأوامره، والمؤمن الحقيقي هو الذي يُطيع [سورة النساء: 65]. وينبغي على المسلمين أن يقتدوا بالموقف المثالي الذي تبناه إبراهيم وابنه عندما كان كلاهما - في الأعمال والأدبيات الإسلاميَّة - على استعدادٍ للمُضي قُدمًا في التضحيَّة.
الأدلة القُرآنيَّة
إن الادعاء بأن النسخ، الذي يُفهم على أنه إلغاء حكمٍ شرعيٍّ، مُتجذِرٌ بقوةٍ في الوحي ومُرتبطٌ بالجذر القُرآنيّ "ن-س-خ" بوصفه مصطلحًا تقنيًا. فالجذر موجود في ما لا يقل عن أربع آياتٍ؛ تَعامل معها المُفسِّرون الكلاسيكيون بوصفها سياقاتٍ غير مترابطةٍ ظرفيًا؛ لذلك فُسِرتْ بشكلٍ مُستقل. وقد حال ذلك دون العلماء أن يتفقوا على أصلٍ وتعريفٍ لا لبس فيه لكلمة "نسخ" وأدى إلى ظهور مجموعةٍ من نظرياتٍ مُتضاربةٍ للنسخ.
فـ )نُسْخَتِهَا( في سورة الأعراف: 154، تُشير إلى الألواح والآيات، و)نَسْتَنْسِخُ( في سورة الجاثية: 29، تُشير إلى الكتاب. وإن الجمع بين الاستخدام اليومي، "نسخ الكتاب"؛ يُنتج عنه مفهوم "التكرار". وجوهر هذا الفهم هو تعدد النصوص. وقيل إن هذا الاستخدام الدنيويّ مرادفٌ لـ "نقل الكتاب" (نسخ الكتاب)، والذي يحمل معنى إضافيًا، وهو "الإزالة"، وبالتالي "النقل" أو "الاستبدال" كما في عبارة "نسخت الشمس الظل"، (وهو أصلٌ يرفضه بعضهم، انظر: القُرطبيّ، الجامع، 2/61). وعبارة )فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ( [سورة الحج: 52] لا يُمكن أن ينتج إلا معنى "الطمس". وقد توازى هذا مع الاستخدام اللغويّ "نسخت الريحُ الآثارَ" (راجع: القُرطبيّ، الجامع، 2/61؛ والغزّاليّ، المستصفى، 1/107). وفي هذا الاستخدام، يَحمل النسخُ بوصفه "إزالةً" دلالةً على "الإلغاء".
وفي الآية )سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى # إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ( [سورة الأعلى: 6-7]، والآية )مَا نَنْسَخْ مِنْ آية أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا( [سورة البقرة: 106] أدخلتا نظريَّة أن الله قد يجعل نَّبيّه ينسى مواد لم يكن من المقصود أن تظهر في الشكل النهائيّ للنص (جون. بيرتون، جمع القُرآن، J. Burton, Collection, 64). وقد يتعزز هذا التفسير بالإشارة إلى قول الله: )وَإِذَا بَدَّلْنَا آية مَكَانَ آيَّة( [سورة النحل: 101]. وقد أضيف مفهوم "الحذف" إلى قائمة المعاني المُتزايدة المُخصصة للنسخ (القُرطبيّ، الجامع، 2/62). ووفقًا لإحدى الروايات، أن رجلًا قام من الليل ليقرأ سورةً من القُرآن؛ فلم يقدر على شيءٍ منها، وقام آخر؛ فلم يقدر على شيءٍ منها، وقام آخر؛ فلم يقدر على شيءٍ منها، فغدوا على رسول الله، فقال أحدهم: قمتُ الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القُرآن؛ فلم أقدر على شيءٍ منها، فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله، فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله، فقال رسول الله: "إنها مما َنسخ الله البارحة" (القُرطبيّ، الجامع، 2/63). وفي روايةٍ أخرى، يقول الصحابي ابن مسعود: أقرأنيّ رسول الله آيَّة، فحفظتها وكتبتها في مصحفي، فلما كان الليل رجعتْ إلى مضجعي؛ فلم أرجع منها بشيءٍ، وغدوت على مصحفي؛ فإذا الورقة بيضاء، فأخبرت النَّبِيّ فقال لي: "يا ابن مسعود، تلك رُفعت البارحة" (نولدكه، تأريخ القُرآن، Nöldeke, GQ, 1/47, 2/44).
وبالتالي، أُضفيَ الطابع الرسميّ للنسيان غير القابل للاسترداد بوصفه "نسخًا"، وهو تفسيرٌ أكثر إرضاءً لاختفاء مواد الوحي. ورغم أن غالبيَّة العلماء عدّوا النسيان أحد آليات النسخ التي تُؤثر على القُرآن؛ إلا أن هناك من سعى إلى إبقاءه مُنفصلًا عن النسخ. ووفقًا لإحدى الروايات، إن رسول الله صلى بالناس يومًا الصبح؛ فقرأ: )تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ( [سورة الفرقان: 1] فأسقط آية، فلما فرغ قال: أفي المسجد أبي بن كعب، قال: نعم، ها أنا ذا يا رسول الله، قال: فما منعك أن تفتح عَلِيّ حين أسقطتُ؟ قال: خشيت أنها نُسخت، قال: "فإنها لم تُنسخ" (سحنون، المدونة الكبرى، 1/107).
الاعتراضات العقائديَّة على التفسير
واجه بعض العلماء صعوبةً في قبول آليَّة النسخ بوصفها جديرةٌ بالله. ولقد ذهب بعضهم إلى حد تقديم قراءاتٍ مُختلفةً للإشارة إلى النسخ في النص المُقدس (الطبريّ، التفسير، 2/478). وكانت إحدى المعوقات الخاصة هي )مَا نَنْسَخْ مِنْ آية أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا( [سورة البقرة: 106]. واعترض بعضهم على أنه لا يُمكن الذهاب إلى القول بتفضيل جزءٍ من النص المُقدس على جزءٍ آخر، وبذلك، فإن )بِخَيْرٍ مِنْهَا ( لا يُمكن أن تكون إشارةً إلى القُرآن. وينطبق العدّ نفسه على سُّنَّة النَّبِيّ في نسخ القُرآن؛ لأنه لا يُمكن عدّ أي حديثٍ أفضل أو حتى مُماثلًا لآيةٍ إلهيَّةٍ. لقد زعم أنصار النسخ أن الله لم يكن يُشير إلى نص القُرآن، بل إلى الأحكام التي ينقلها النص (الغزّاليّ، المستصفى، 1/125؛ وراجع: الطبريّ، التفسير، 2/471-472). ورغم أنه من حيث الجَمال، لا يُمكن عدّ أي آيةٍ قُرآنيَّةٍ أفضل من أخرى، وبالتأكيد لا يُوجد حديثٌ أجمل من آيةٍ قُرآنيَّةٍ، ويُمكن عدّ المحتوى الفقهيّ لآيةٍ واحدةٍ - أو حتى حديثٍ - أفضل من الحُكم الوارد في آيةٍ أخرى. وكان من غير السهل تفسير السبب الذي جعل الله في هذه الحالات لا يكتم النصوص المنسوخة لتجنب الالتباس (الطبريّ، التفسير، 2/472).
قراءاتٌ مُتغيِّرة
إن نظريَّة نسيان أجزاء من النص المُقدس كانت غير مقبولةٍ لدى بعض الناس، ويتضح ذلك في إجراءيْن تُبنيا لتجنب هذا التفسير. وكبديلٍ تفسيريٍّ، اقتُرِحَتْ مجموعةٌ من القراءات المُختلفة للآيات محل النظر. ففي المقطع )مَا نَنْسَخْ مِنْ آية أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا( [سورة البقرة: 106]، تُركز الانتباه على الكلمة التي قرأها غالبيَّة العلماء )نُنْسِهَا(. وقد دعمت هذه القراءة )سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى # إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ( [سورة الأعلى: 6-7]. كما اقترح أن كلمة )نُنْسِهَا( يجب تفضيلها على كلمة )تَنْسَى( (الطبريّ، التفسير، 2/474-475). وكلتا الإشكاليتيْن، نسيان مُحَمَّد من تلقاء نفسه وإنساء الله له، يُمكن الالتفاف عليها بقراءة "نَنسْأَ" (الطبريّ، التفسير، 2، 476-478). إذن، فالآية 106 من سورة البقرة تَذكر عمليتيْن من عمليات الوحي: النسخ والتأجيل. فقد يُشير تأجيل النسخ، بمعنى "تأجيل الوحي من الأصل السماويّ إلى تمثيله الأرضيّ في القُرآن، والذي قيل إنه حدث في حالة قيام الليل التي غيرها نزول الوحي في سورة المُزمل: 6 من إلزاميَّة إلى اختياريَّة (الشافعيّ، الرسالة، ص108). أو يُمكن أن يُشير تأجيل إزالة مقطعٍ من القُرآن بترك المقطع في النص رغم طمس الحكم الذي يتضمنه (الطبريّ، التفسير، 2/478). وعلى نحوٍ عام، يُعتقد أن معنى الفعل "نسأ" زمنيٌّ؛ لكن قيل أيضًا إنه يحمل دلالةً ماديةً، "الإبعاد"، كما يُبعِدُ الرجالُ الحيوانات الغريبة بعيدًا عن الحوض المُخصص لحيواناتهم (الزمخشريّ، الكشاف، في تفسيره لسورة البقرة: 106؛ وراجع: الطوسيّ، التبيان، 1/395). وإذا نُقِلتْ إلى السياق القُرآنيّ، فقد تُبعدُ الآيات من النص حتى من الذاكرة البشريَّة، فقد يَنسى الأفراد. ودعمًا لهذا التفسير، استُشهِدَ برواياتٍ زعمتْ أن بعض السور كانت في الأصل أطول مما هي عليه في نص القُرآن الراهن. حتى الآيات التي زُعم أنها نزلت ولم تجد مكانًا في النص النهائيّ - مثل آيات ابن آدم وبئر معونة (انظر: جون بيرتون، المصادر، J. Burton, Sources, 49-53) - استُشهِدَ بها، على ما يبدو من الصحابة القلائل الذين لم ينسوها تمامًا (الطبريّ، التفسير، 2/479-480).
وفي سياق نهجٍ آخر، ليس من الضروري حتى اللجوء إلى قراءاتٍ مُختلفةٍ؛ لأن الكلمة العربيَّة "نسيان" يُمكن تفسيرها على أنها تعني "إزالة شيء" أو نقيضها، "ترك شيء حيث هو" (الطبريّ، التفسير، 2/476). وقد يُشير هذا إلى أن الآيات كانت في الأصل السماويّ، لكنها لم تُنزّل، أو أن الآيات تُركتْ في نص القُرآن ولم تُلغَ أو تُزال. وبمجرد التأكد من حدوث الاستبدال؛ لا يهم ما إذا كانت صياغة الحُكم المهجور قد مُحِيتْ أو ما إذا كانت قد تُركتْ في القُرآن. وتُصبح المقاطع التي استُبدلتْ أحكامها غير قابلةٍ للتطبيق أو أُزيلتْ فعليًا (الطبريّ، التفسير، 2/472).
النسخ والفقه
لجأ الفقهاء لنظريَّة النسخ باستمرارٍ لحل التناقضات الظاهرة بين المُمارسة الشرعيَّة في مُختلف مناطق العالَم الإسلاميّ وبين كل هذه ومصادرها المُفترضة في الوحي. ولم يكن "النسيان" و"الحذف" موضع اهتمام الفقهاء الذين ركزوا على "الاستبدال" المُشتق من )وَإِذَا بَدَّلْنَا آية مَكَانَ آيَّة( [سورة النحل: 101] وفرضوها على )مَا نَنْسَخْ مِنْ آية أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا( [سورة البقرة: 106]. ولم تكن المعوقات التي واجهت المُفسِّرين وعلماء الكلام محل اهتمامٍ كبيرٍ من جانب الفقهاء، الذين أعلنوا أن "النسخ" مصطلحٌ تقنيٌّ له معنى واضحٌ الآن للجميع (الجصَّاص، الأحكام، تفسير سورة البقرة: 106). واستشهد مُعظمهم بـ )نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا( [سورة البقرة: 106] كدليلٍ على أن حدوث النسخ يأتي في صورة "الاستبدال"، وهو التفسير الذي سبق أن قدّمه أقدم المُفسِّرين (أمثال الفراء، المعاني، 1/64-65). والواقع أن النسخ، بوصفه استبدالًا، أصبح مسرحًا للتطور الأكثر حيويَّة لنظريات النسخ.
النوع الثالث من النسخ
أُضيف نوعٌ ثالثٌ إلى تفسير الفقهاء للنسخ بأنه "نسخ حكمٍ مع بقاء التلاوة". ويرد ذكر سورة المائدة: 89: )فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ( بوصفها طريقة للتكفير عن الحنث في اليمين. ويُقال إن الصحابي ابن مسعود (ت. 33هـ/653م) احتفظ في مصحفه الخاص بالقراءة الأصليَّة "فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعة". ولا يزال يُشار إلى قراءته الشاذة في زمن الفقيه أبي حنيفة (ت. 150هـ/767م). ورغم أن كلمة "متتابعة" لم تُوجد في نص القُرآن الذي كان شائع الاستخدام؛ فقد تُبُنِيَ الحكم في المذهب الحنفيّ (السرخسيّ، الأصول، 2/81). وهذا يُوضح النوع الثالث من النسخ الذي نُسِخَ فيه نص الوحي القُرآنيّ، ولكن ليس حكمه.
وتتضمن الآيتان 15-16 من سورة النساء عقوبة للسلوك الجنسيّ غير المشروع. ويجب معاقبة كلا الزانييْن بعنفٍ غير مُحددٍ واحتجاز الأنثى تحت الإقامة الجبريَّة مدى الحياة )أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا(. وكان يُعتقد أن السبيل الآخر قد وُجِدَ في الآية الثانية من سورة النساء، والتي فرضتْ عقوبة مائة جلدةٍ على الزناة من الذكور والإناث. بيد أن أحد الصحابة روى أن النَّبِيّ أعلن، "خذوا عني، خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" (الشافعيّ، الرسالة، ص129). وتُظهِر روايات الصحابة الآخرين أن النَّبِيّ وسَعَ العقوبات المزدوجة لتشمل الذكور، بينما يذكر عددٌ منهم أنه رجمَ بعض الجناة دون جلدهم (مالك، الموطأ، الحدود، حد الزنى). وعلى ضوء هذه المواد؛ خلص بعضهم إلى أن هذا كان مثالًا لنسخ القُرآن بالسُّنَّة.
بيد أن الغالبيَّة العظمى من العلماء عدّوا فرض الرجم كعقوبة للزنى مثالًا لنسخ آيةٍ من النص المُقدس، رغم أن الحكم الذي تحتويه ظل ساريًا. فعلى سبيل المثال، سمع عالِم المدينة المنورة مالك بن أنس (ت. 179هـ/795م) أن عقوبة الرجم كانت في "كتاب الله"، والذي فهمه في هذه الحالة على أنه التوراة. ولقد ذَكر أن النَّبِيّ استشار الأحبار، وأن حكم الرجم موجودٌ بالفعل في التوراة. وبإشارةٍ صريحةٍ إلى "كتاب الله"؛ فرض مُحَمَّد الحُكم. وفسَّر علماء آخرون مصطلح "كتاب الله" على أنه إشارةٌ إلى القُرآن، وشعروا بالحيرة لأنهم لم يتمكنوا من العثور على مثل هذا الحكم بين صفحاته. وحث الخليفة الثانيّ عُمر بن الخطَّاب (حكم 12هـ/634م-22هـ/644م) المسلمين بشدّةٍ على عدم تجاهل "آيَّة الرجم" التي زعم أنها نزلتْ على مُحَمَّد، وعلّمها لأصحابه، وتُليت معه في الصلوات المكتوبة: "الشيخ والشيخة إذا زنيا؛ فارجموهما البتة". ولقد أصر عُمر على أن النَّبِيّ وخليفته أبا بكر (حكم 11هـ/632م-13هـ/634م) وهو نفسه قد طبقوا هذا الحكم عمليًا، وزعم أن الخوف من اتهامه بإضافة شيء إلى النص المُقدس هو السبب الوحيد الذي منعه من كتابة "الآية" في القُرآن. وقد صرّح عددٌ لا يحصى من العلماء في القرون التالية، بكل ثقةٍ، بأن آيةً بصيغةٍ مُماثلةٍ أو مُشابهةٍ كانت موجودةً ذات يوم في النص القُرآنيّ. ومن هذا، استنتجوا أنه يُمكن نسخ آيةٍ من القُرآن دون أن يُفسِد هذا صحة الحكم الذي تحتويه (الغزّاليّ، المستصفى، 2/124).
ولم يُحلل الشافعيّ هذه المواد من وجهة نظر أولئك الذين رأوا هذا نسخ القُرآن بالسُّنَّة، وهو الادعاء الذي كان يتجنبه في كل الأوقات. وبدلًا من ذلك، فضل مراجعة القضيَّة على ضوء نظريته في التخصيص. ففي سياق فرض نصف عقوبة الحرة على الإماء، استثنت الآية 25 من سورة النساء العبيد من كامل عقوبة الآية الثانية من سورة النور ـ التي أمرت بجلد الزناة مائة جلدة ـ ومن عقوبة الرجم؛ لأن الموت ليس له نصفٌ مُحدد. وبالتالي، فإن فئاتٍ مُعيَّنةً من المسلمين الأحرار قد تكون معفاةً أيضًا من بعض العقوبات. وتُشير مُمارسة النَّبِيّ إلى أن الزناة المتزوجين لم يكونوا مشمولين بالآية الثانية من سورة النور، أو إذا كانوا مشمولين في الأصل بهذا الحكم؛ فقد استُثنوا فيما بعد، وكانت عقوبتهم هي الرجم. وقد حلتْ سُّنَّة الرجم محل سُّنَّة الجلد والرجم السابقة. وفي مناقشته، يُؤكد الشافعيّ أن قول النَّبِيّ: "قد جعل الله لهن سبيلًا"؛ يدل على أن الحُكم القُرآنيّ )فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا( [سورة النساء: 15] قد نُسِخَ (جون بيرتون، المصادر، J. Burton, Sources, 143-156). وأكد أن النَّبِيّ استغنى عن جلد من كان من المُقرر رجمهم؛ لكنه كان قد طبق العقوبتيْن في وقتٍ سابق. ولأن الجلد كان حكمًا قُرآنيًا لا يُمكن إنكاره؛ فقد افترض بعضهم خطأً أن الشافعيّ يعتقد أن الرجم كان حُكمًا قُرآنيًا.
وقد أقر الشافعيّ بالنوع الثالث من النسخ في مناقشته لمسألةٍ مُختلفةٍ، وهو نسخ آيةٍ قُرآنيَّةٍ مع بقاء الحكم الذي تحتويه. وفي سورة النساء: 23، تُسردُ النساءُ اللواتي يحرم على المسلم الزواج بهن، بما في ذلك مرضعته وأي أنثى أرضعته. وقد اختلف العلماء في عدد الرضاعات التي تُحرِّم. فبالنسبة لمالك، كانت الرضعة الواحدة في الطفولة كافيةً لإرساء حاجزٍ أمام الزواج (مالك، الموطأ، الرضاع، رضاعة الصغير). وبالنسبة لآخرين، كانت المصة الواحدة تُحرِّم. وتمسك الشافعيّ برواية قيل فيها إن عَائشة زوج النَّبِيّ ذهبت إلى أن آيةً نزلت على النَّبِيّ وجعلت المُحرم عشر رضعات، ثم استُبدلتْ بآيةٍ أخرى قللت عدد الرضعات إلى خمس، والتي نُسخت أيضًا فيما بعد. وقد رفض مالك هذا الخبر بشكلٍ قاطع (الموطأ، الرضاع، رضاعة الكبير)، لكن الشافعيّ جعله مركزيًا لاستنتاجاته. لقد قَبل ذلك بوصفه المثال الوحيد الذي لا شك فيه لنسخ آيةٍ قُرآنيَّةٍ بينما ظل الحكم الذي عبّرت عنه ساريًا (اختلاف الأحاديث، 7/208 (هامش كتاب الأم)؛ وانظر: جون بيرتون، المصادر، J. Burton, Sources, 156-158).
الخلاصة
من الواضح أن نظريَّة النسخ طوّرت ديناميكيتها الداخليَّة. ولم يقبل جميع مُعاصري الشافعيّ النظريَّة القائلة إن الآيات القُرآنيَّة المنسوخة كانت موجودةً ذات يوم، لكنها اكتسبتْ لاحقًا دعمًا واسع النطاق. ولم يكن المالكيَّة والحنفيَّة في حاجةٍ عامةٍ إلى هذه النظريَّة، في حين لم يكن الشافعيَّة في حاجة على الإطلاق إلى القول بأن السُّنَّة تنسخ القُرآن أو العكس. بيد أننا نجد علماء المالكيَّة والحنفيَّة يزعمون أن هناك ثلاثة أنواعٍ من النسخ (السرخسيّ، الأصول، 2/81؛ والقُرطبيّ، الجامع، 2/66)، كما يجد المرء أن الشافعيَّة يستدلون بوقوع نسخ السُّنَّة للقُرآن والعكس، وهو ما زعموا أن الشافعيّ نفسه قد أغفله (الغزّاليّ، المستصفى، 1/124).
المصادر والمراجع:
الأساسيَّة: الفراء، المعاني؛ والغزّاليّ، أبو حامد مُحَمَّد، المستصفى من عِلم الأصول، مجلدان، القاهرة، 1322هـ/1904م؛ والحازميّ، مُحَمَّد بن موسى، كتاب العدّ، حيدر آباد، 1319هـ/1901م؛ وهبة الله بن سلامة، كتاب الناسخ والمنسوخ، القاهرة، 1379هـ/1960م؛ والجصّاص، الأحكام؛ ومالك، الموطأ، 3 مجلدات، القاهرة، 1303هـ/1885م؛ ومسلم، الصحيح؛ والنحّاس، كتاب الناسخ والمنسوخ في القُرآن الكريم، القاهرة، دون تأريخ للنشر؛ والقيسيّ، مكّي بن {أبي طَالب]، كتاب الإيضاح لناسخ القُرآن ومنسوخه، تحقيق: أحمَد حَسن فرحات، الرياض، 1976م؛ والقُرطبيّ، الجامع؛ والرازيّ، التفسير؛ وسحنون بن سَعيد، المدونة الكبرى، 16 مجلدًا، بغداد، 1970م؛ والسرخسيّ، شمس الأئمة، الأصول، مجلدان، حيدر آباد، 1372هـ/1952م؛ والشافعيّ، كتاب اختلاف الحديث، على هامش كتاب الأم، 7 مجلدات، القاهرة، 1322هـ/1904م-1324هـ/1906م؛ والمؤلف نفسه، الرسالة، تحقيق: أحمَد مُحَمَّد شاكر، القاهرة، 1358هـ/1940م؛ والطبريّ، التفسير؛ والطوسيّ، التبيان؛ والزمخشريّ، الكشاف.
الثانويَّة: جون بيرتون، تفسير الآية 106 من سورة البقرة، :J. Burton, The exegesis of q 2: 106, in BSOAS 48 (1985), 452-469؛ والمؤلف نفسه، جمع القُرآن، id., Collection؛ والمؤلف نفسه، تفسير الآيتين السادسة والسابعة من سورة الأعلى، id., The interpretation of q 87: 6-7, in Der Islam 62 (1985), 5-19؛ والمؤلف نفسه، مصادر التشريع الإسلاميّ، id., The sources of Islamic law, Edinburgh 1990؛ وغولدتسيهر، الدراسات المُحَمَّدية، Goldziher, MS؛ ونولدكه، تأريخ القُرآن، Nöldeke, GQ؛ وجوزيف شاخت، الأصول، J. Schacht, Origins of Muhammadam jurisprudence, Oxford 1950؛ ومُحَمَّد زيد، النسخ في القُرآن الكريم، مجلدان، القاهرة، 1383هـ/1963م.