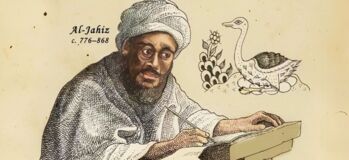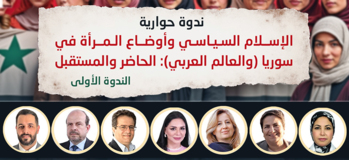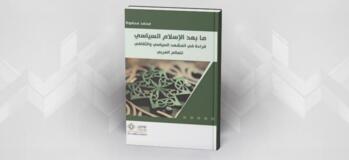تقرير حول الندوة الحوارية السادسة عشرة: الإسلام السياسي وأوضاع المرأة في سوريا (والعالم العربي) الحاضر والمستقبل"
فئة : حوارات

تقرير حول الندوة الحوارية السادسة عشرة: الإسلام السياسي وأوضاع المرأة
في سوريا (والعالم العربي)الحاضر والمستقبل"
في سياق حرصها على خلق فضاء معرفي حرّ ومبدع لنقاش قضايا التجديد والإصلاح الديني في المجتمعات العربية والإسلامية، نظمت مؤسسة مؤمنون بلا حدود لقاء حواريّاً حول موضوع "الإسلام السياسي وأوضاع المرأة في سوريا (والعالم العربي) الحاضر والمستقبل" على منصة زوم بتاريخ 17 يناير 2025، وهو اللقاء الثاني الذي تنظمه المؤسسة هذا العام للحوار حول "الإسلام السياسي".
كان اللقاء تحت إشراف وتسيير د. ميادة كيالي وإدارة د. حسام الدين درويش.
وقد شارك فيه كلّ من:
د. مية الرحبي، طبيبة سورية وكاتبة نسوية؛
د. زهيدة درويش جبور، أستاذة الأدب الفرنسي والفرنكفوني في الجامعة اللبنانية؛
د. نادية محمود، سياسية ونسوية عراقية؛
د. ناجية الوريمي، باحثة تونسية وأستاذة الحضارة العربيّة الإسلاميّة بالجامعة التونسيّة؛
د. أسماء كفتارو، باحثة نسوية سورية وعضو المجلس الاستشاري النسائي السوري؛
د. أنس الطريقي، باحث تونسي وأستاذ مساعد للتعليم العالي اختصاص حضارة حديثة بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في القيروان.
وقد حضر اللقاء نخبة من المهتمين الذين أثروا اللقاء بتساؤلات تفاعل معها ضيوف الندوة.
افتتح د. حسام الدين درويش اللقاء مرحّباً بالحاضرين، ثم قدّم إشارات أضاء بها موضوع اللقاء "الإسلام السياسي" الذي يستمد أهميته من راهنيته، وحضوره المستمر على موائد الحوار، لا سيما مع الوضع الجديد في سوريا اليوم؛ بعد وصول الإسلام السياسي للحكم، وهو وضْع عدّه د. حسام ظرفاً خاصّاً يطرح استفسارات وإشكالات حول الحريات الفردية عموماً، وحرية المرأة خصوصاً. ومن ثم، كان من اللازم مناقشة هذا الموضوع من زاوية أوضاع المرأة في سوريا والعالم العربي.
استهلت د. مية الرحبي الحديث في مداخلتها، بتوضيح موقف الحركة النسوية من الوضع الحالي في سوريا قائلة: "إننا متخوفات من وصول الإسلام السياسي، إلا أن هذا لا يعني أن لنا موقفاً من الإسلام كدين". واختصرت سبب هذا التخوف في نقطتين أساسيتين؛
أولاً: تصور الإسلام السياسي المرأة مواطناً من الدرجة الثانية، وحصره لدورها في رعاية المنزل والزوج والأطفال، وتقييم مشاركتها في المجتمع من خلاله فقط؛ إذ ليس من حقّها المشاركة في المجال العام.
ثانياً: عدم اعتراف الإسلام السياسي بالمواثيق الدولية التي يجب أن تبنى عليها القوانين، وما تصبو إليه الحركة النسوية السورية هو دستور يراعي النوع الاجتماعي ومؤسس على المواطنة المتساوية.
وختمت د. مية كلمتها باستحضار الانتهاكات التي مارسها النظام السابق، رغم ادعائه العلمانية؛ إذ أحصت الحركة حوالي مئة مادة منتهكة لحقوق النساء في عهد الأسد، إضافة إلى تغييب واضح لحقوق الأطفال في مدونة الأحوال الشخصية، متسائلة: إذا كان هذا هو وضع المرأة في ظلّ حكم علماني، فكيف سيكون وضعها في ظلّ نظام يتبنى أفكار الإسلام السياسي؟
بعد ذلك تفضلت د. ميادة كيالي بتقديم مداخلة مختصرة أثارت فيها تساؤلات حول اللغة ومدى ارتباط استخداماتها بالذكورية، وانعكاس ذلك على أدوار المرأة، وضربت مثالاً بخلو اللغة العربية من صيغ أنثوية في كثير من المهن والمناصب، مثل: الرئيس والمدير... فلا وجود لوزن فعيلة للتأنيث؛ فاللغة لا تزال تعكس نظرة تقليدية للمرأة تحصرها في أدوار اجتماعية محدودة، وتتجاهل قدراتها التي تخوّل لها المشاركة في اتخاذ القرار وقيادة المجتمع. لذلك، دعت د. ميادة إلى ضرورة تطوير اللغة لتساير واقع المرأة اليوم، مؤكدة أن التغيير لا يجب أن يمسّ الكلمات المستعملة في الخطاب فقط، بل كذلك الطريقة التي نتعامل بها مع مواضيعها؛ فبدلاً من حصر النقاش حول المرأة كموضوع أو فئة محتاجة إلى الحماية، يجب أن يُوجه الخطاب إلى الاعتراف بدورها كفاعلة وكمشاركة في اتخاذ القرار وتغيير المجتمع. وسوريا بحاجة إلى هذا التغيير الآن، وإلى بناء فهم جديد للمرأة بدلاً من تكريس النظرة القديمة.
تقول د. ميادة: "المرأة ليست مجرد "موضوع" للنقاش أو "فئة" تحتاج إلى حماية، بل هي شريكة في بناء المجتمعات وصناعة القرارات. ومع ذلك، ما زال الخطاب السائد في الكثير من الأحيان يعامل المرأة على أنها استثناء أو إضافة ثانوية".
اختارت د ناجية الوريمي لمداخلتها موضوعا بعنوان "أوضاع المرأة العربية وتعثر التحديث في العالم العربي"، وهو اختيار رأت من خلاله أن الإسلام السياسي وجه من وجوه تعثر التحديث في العالم العربي، ولأنه يوظف تراثاً فقهيّاً ينعت المرأة بكل صفات الدونية دون نقد أو مساءلة، ويروج لمصطلحات تبدو نشازاً في سياق التحديث، ومن هنا ينشأ تقزيم المرأة.
لقد أشارت د. ناجية إلى ضعف نقد التراث وما ينتج عنه من انتكاسات متواصلة، مؤكدة أن ضرورة إعادة قراءة التراث لا تعني إلغاءه؛ فالحداثة ليست إلغاء للماضي، وإنما إلغاء اعتبار الماضي نموذجاً. فمقابل تراث العورة الذي تتفرع عنه معظم الأحكام الفقهية، هناك تراث فلسفي كتراث ابن رشد الذي عدّ المرأة مساوية للرجل في كافة المؤهلات؛ فالنساء في نظره يمكن أن يكنَّ فيلسوفات وحاكمات.
وفي ختام حديثها، نبّهت د. ناجية الوريمي إلى أن المرأة العربية هي أكثر من يتحمل فشل التحديث داخل العالم العربي؛ فقد ظلت خارج النسق لعقود. لذا، فهي معنية الآن بتفكيك العوامل التي تسهم في تجريدها من إنسانيتها، ودورها الفاعل داخل المجتمع.
ودافعت د. أسماء كفتارو في مداخلتها، بصفتها نسوية إسلامية، عن حاجة سوريا اليوم إلى حركة النسوية الإسلامية، مؤكدة أن الظرفية الحالية تفرض علينا استخراج الحجة من الإسلام لمخاطبة الناس ومحاورة الإدارة الجديدة، عوضاً عن محاولة إقناعها بأفكار ذات مرجعية غربية. وشددت على أن النسوية الإسلامية لا يختلف هدفها عن باقي التيارات النسوية في شيء، فهي تشترك معها في كونها حركة أكاديمية اجتماعية فكرية، هدفها تمكين النساء ورفع الظلم عنهن وإنهاء الإقصاء، إلا أن منطلقاتها هي ذات أصول إسلامية (القرآن والسنة) وترتكز على:
- رفض الإطار "تحرير المرأة"؛ نظرا لإيمانها بقدرة المرأة على التحرر من القيود بنفسها، دون حاجة إلى من ينقذها.
- رفض المركزية الذكورية، فالدين مبني على رؤية رجولية، والتمييز الحاصل هو ناتج عن قراءة أحادية.
إن ما سيخلق فرقاً -تؤكد د. كفتارو- في هذه المرحلة، هو فريق نسائي يعيد قراءة النص، ويخلق فقهاً حداثيّاً يؤمن بالمرأة كصانعة وشريكة.
وتناولت د. زهيدة درويش في مداخلتها مركزية الدين في المجتمعات العربية، حيث صار مكوّناً في الهوية الثقافية بوصفها بلداناً ذات أكثرية مسلمة، رغم أنها كانت منذ زمن ولا زالت تعددية. وهنا تساءلت المتدخلة حول حاكمية الدين على المجتمعات، وعن نجاح الحكم الإسلامي لمجتمع تعدّدي التاريخ والبنية؟
وكان جوابها هو نعم ولا في الآن نفسه؛ نعم، إذا ما استلهمت طرائق جديدة لتفسير القرآن. لا، إذا بقي النص أسير تأويلات وتفسيرات تجعل منه موروثاً للإقصاء والتهميش. وعن الاستشهاد بنموذج تركيا الإسلامي المتصالح مع قيم المواطنة، قالت د. زهيدة: "إن علينا ألا ننسى أن هذا النظام قد تأسس على نظام علماني قويّ، كما أن تطلعاته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تحول دونه ودون التراجع نحو التشدد"، كما عبرت عن قلقها حيال وضع المرأة؛ لأن المجتمعات الإسلامية تسودها نظرة تقليدية للمرأة. وعلى الرغم من أن هناك محاولات لباحثات مسلمات استفدن من تطور العلوم الإنسانية، وسعين إلى إنتاج معرفة دينية حديدة، أمثال: نايلة تبارة، وفاطمة المرنيسي... إلا أن أبحاثهن لم تتمكن من الانتشار في نطاق واسع. لذا، فإن السبيل الوحيد بالنسبة إلى المتدخلة في هذه المرحلة، هو اعتماد الحوار والتمسك بالحقوق والإصرار على المشاركة.
أما د. نادية محمود، فقد تحدثت عن الإدارة السياسية في سوريا الجديدة، قائلة: "إنها لم تأت بشيء جديد، فكل الحركات السياسية الإسلامية تشترك في التصور نفسه مع اختلاف في بعض التفاصيل بحسب اختلاف السياقات الاجتماعية." وانطلاقا من اهتمامها وقربها من الحركة النسوية في سوريا، نبّهت إلى أن ما تريده النساء في سوريا ليس حق التعلم أو العمل أو المشاركة السياسية، بل ما تريده هو كسر علاقة القوة التي تنظم العلاقة بين الجنسين ويتجسد ذلك في مشكل الأحوال الشخصية. وهذا ما لن يوفره الإسلام السياسي ما دام يرى في المرأة مجرد مكمّل لما يحتاجه الرجل، غير مساوية، بل تابعة له. وعلى الرغم من أن الدستور الجديد لم يصغ بعد في سوريا، إلا أن د. نادية لا تظن أنه سيكون بعيداً عن الدساتير الأخرى في الدول الإسلامية التي تستند إلى الشريعة. لذلك، فهي دساتير مكرسة للهيمنة من خلال تعزيزها للقوامة وتضييق أنشطة المرأة الاجتماعية، وهو ما يعكس علاقة الدولة بمواطنيها، ويظهرها متحيزة في علاقتها لمواطنيها ضد مواطناتها.
أما عن المستقبل، فقد أكدت د. نادية على ضرورة إصرار الشعب السوري على مطالبه إلى أن تتحقق؛ وذلك لأن الحركات السياسية خاضعة للتغيير الحتمي، وما دامت تريد البقاء في الحكم، فإنها ستضطر حتما لتقديم تنازلات من أجل ذلك.
وتحدث د. أنس الطريقي في مداخلته عن تجذر الإسلام السياسي في سوريا منذ الثلاثينيات وعلاقته الصدامية مع النظام السابق الذي انتهج سياسة القمع ضدهم، كما تحدث عن التقاطعات بين القيادة الحالية والإسلام السياسي التقليدي، ضارباً مثالا على ذلك بالشيخ الألباني السوري الذي تتلمذ على يديه الكثير من زعماء الجهاد مثل "أيمن الظواهري". أما عن نظرة الإسلام السياسي للمرأة، فقد أكد د. أنس أن الحركة رغم حرصها الشديد على فكرة تحرير الإسلام للمرأة، إلا أن أتباعها حافظوا على موقفهم الطبيعي من المرأة، واستعرض بعض المواقف من بينها موقفا مصطفى السباعي في سوريا، وراشد الغنوشي في تونس، حيث أكدا معاً أن المرأة يجب أن تحتفظ بدورها الطبيعي (تلبية رغبة الزوج، الإنجاب وما يترتب عنه من رعاية... إلخ).
وبالنسبة إلى د. أنس، فالقبول بتيار يتبنّى هذه النظرة إلى المرأة يعود إلى الثقافة التي تحتضن هذه النظرة وتدافع عنها. ومن أسباب هذا النكوص والرضا بهذا التيار بديلا لسلطة أخرى مستبدة سابقة، هو التصدي للعقلانية وحجبها عن عامة الناس من البسطاء، الذي اختاره النظام السابق كما تفعل العديد من الأنظمة المستبدة لمنع أي تحديث داخلي للمجتمع.
وفي ختام مداخلته، أكد د. أنس أنه على المرأة السورية في الوضع الحالي، أن تراهن على فكرة الحضور والظهور، فهو كفيل بخلق امرأة منافسة لا صراعية.
بعد انتهاء جميع المداخلات، أثنى د. حسام الدين درويش على جهود المشاركات والمشاركين في مداخلاتهم المتنوعة التي أثرت اللقاء، وأظهرت اختلافاً حقيقيّاً ملهماً، ثم بدأ بطرح عدد من الأسئلة عليهم، تمحورت في مجملها حول خيار الإسلام السياسي في العالم العربي وعما إذا كان هو قدر شعوبه الوحيد؟ وهل يمكن اعتباره خياراً سيّئاً لا محالة أم إنه قابل للتناغم؟
ردّت د. زهيدة بقولها إنه ليس غريباً أن يتقدم العنصر الديني في الهوية السياسية على باقي العناصر الأخرى في مجتمعات إسلامية محافظة، لا سيما بعد فشل مشروع القومية. وعن اعتباره خياراً سيئاً، أجابت د. زهيدة إنه كذلك، ما دام لا يستطيع الانفتاح على الديمقراطية وتقبل الآخر؛ لأن التحديث في العالم العربي يجري من فوق، ويجب أن يظل كذلك ما دامت القاعدة ليست جاهزة بعد، من وجهة نظرها. وهو ما أكدته د. نادية من جهتها مضيفة نفيها لأن يكون هذا النموذج قدر الشعوب العربية؛ فكل حركة سياسية تأتي لتقديم حلول وإجابات، وإذا لم تنجح في ذلك، فإنها تقابل بالاحتجاجات. وعزّز د. أنس ذلك بقوله، إن للشعوب العربية عموماً وسوريا خصوصاً، إمكانياتها التحررية من هذا النموذج رغم تجذّره، وإن التركيز على الحضور والظهور في الشارع من خلال المظاهرات والندوات من أهم سبل مقاومة الاستبداد.
إضافة إلى ما تقدم، تم طرح تساؤل آخر حول علاقة النضال النسوي بالديمقراطية: "هل من الممكن أن يتقدم النضال النسوي بمعزل عن النضال الديمقراطي؟" باستحضار نموذج التحديث البورقيبي لحقوق المرأة في تونس؟ فكان توجه عموم المشاركات والمشاركين يصب في التأكيد على ضرورة التلازم بين المسارين الديمقراطي والنسوي؛ لأنهما يتكاملان مع المطالبة بحقوق المواطن، وأن النضال النسوي يظل مستمرّاً حتى في غياب النضال الديمقراطي، فهو ديمقراطي في عمقه، وأضاف د. أنس أن تجربة بورقيبة كانت خاصة ومن الصعب أن تتكرر؛ لأن تلك الفترة كانت قبل سؤال الديمقراطية في المجتمعات العربية، فقد كان في مرحلة حكم الحزب الواحد التي تلت الاستعمار.
وقد شاركت نخبة من الحاضرين والحاضرات، بآرائها حول المواضيع المطروحة خلال الندوة، وأخذت مسألة التجديد النسوي للدين التي أثارتها د. كفتارو حيزاً كبيراً من النقاش؛ إذ اعترض بعض الحضور على طرح د. كفتارو النسوي الإسلامي. والتي ردت مدافعة عن ضرورة العودة إلى التراث قائلة: إن هدف فصل الدين عن الدولة الذي نحلم به هو في حد ذاته لن نصل إليه، ما لم ننطلق من الموروث ونجدد فهمنا له، ونستجب لضرورة المرحلة.
رابط اللقاء على يوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=x5JvHAAHcfs
رابط البرومو:
https://www.facebook.com/100003163825459/videos/pcb.9112669102181793/1229515411481106