جان جاك روسو وحدود السلطة في العقد الاجتماعي
فئة : قراءات في كتب
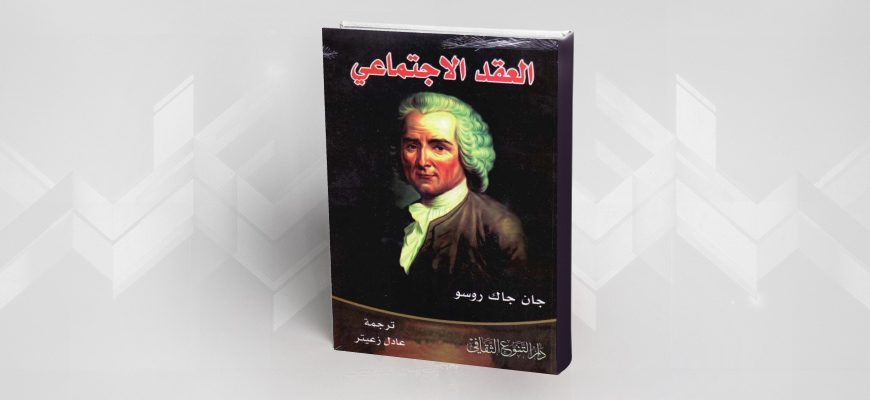
جان جاك روسو وحدود السلطة في العقد الاجتماعي
على الرغم من أن مصطلح "العقد الاجتماعي" له امتدادات تاريخية في الفكر الإنساني منذ ظهوره في أفكار أفلاطون وأرسطو، مروراً ببعض الفلاسفة اللاحقين في العصر الوسيط، إلا أن معالجة المفكر السويسري جان جاك روسو (1712-1778) لهذا المبحث الاجتماعي كانت الأهم في كتابه الأشهر "العقد الاجتماعي"؛ إذ كان لطروحاته التي بشرت بالثورة الفرنسية أكبر الأثر فى نشوء وتطور العلوم والمفاهيم السياسية والاجتماعية تدريجياً وتطبيقها في أوروبا منذ عصر التنوير، وهو يؤكد فيها أن صاحب الولاية الحقيقىة في الدولة هو الشعب نفسه بكافة طبقاته لا فرق بين فرد وآخر. وحتى يسير المجتمع على أسس صحيحة، لا بد من وجود قوانين تسري على الجميع في سبيل ضبط سلوكهم من أجل المنفعة العامة التي يجب أن تحكم المجتمع.
في الفصل الرابع من الكتاب "حدود السلطة ذات السيادة" يشدد روسو على أن الطبيعة كما "تمنح كلَّ إنسانٍ سلطةً مطلقةً على جميع أعضائه، يمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطانًا مطلقًا على جميع أعضائها أيضًا، وهذه السلطة نفسها، وهي التي توجهها الإرادة العامة، تحمل اسم السيادة".
إلا أنه يستدرك أن التعهدات التي تربطنا بالهيئة الاجتماعية ليست إلزامية، إلا لأنها متقابلة، ومن طبيعتها أنها إذا ما أنُجزت، لا يمكن أن يعمل الإنسان في سبيل الآخرين من غير أن يعمل في سبيل نفسه.
ويؤكد أن "الميثاق الاجتماعي يجعل بين المواطنين من المساواة ما يُلزمون أنفسهم معه بذات الشروط، وما يجب أن يتمتعوا معه بذات الحقوق، وهكذا فإن كلَّ عقدِ سيادةٍ، أي كل عقد صحيح للإرادة العامة، يُلْزِمُ أو يساعد، على السواء، وعن طبيعة الميثاق، جميع المواطنين، فلا يعرف السيد بذلك غير هيئة الأمة، ولا يفرق بين من تتألف منهم".
الفصل الرابع
حدود السلطة ذات السيادة
إذا كانت الدولة أو المدينة لا تعد غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد أعضائه، وإذا كانت سلامتها الخاصة أهم ما تُعْنَى به، وجب أن تكون لها قوة عامة قاهرة لتحريك وإعداد كل قسم على أكثر الوجوه ملاءمة للجميع، وكما أن الطبيعة تمنح كلَّ إنسانٍ سلطةً مطلقةً على جميع أعضائه، يمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطانًا مطلقًا على جميع أعضائها أيضًا، وهذه السلطة نفسها، وهي التي توجهها الإرادة العامة، تحمل اسم السيادة كما قلت.
ولكننا إذا عدونا الشخص العام، وجب علينا أن ننظر إلى الأشخاص الخاصين الذين يتألف منهم، والذين يستقلون عنه حياة وحرية بحكم الطبيعة، وعلينا، إذن، أن نَمِيزَ جيدًا حقوق المواطنين والسيد المتقابلة، وأن نَمِيزَ الواجبات التي يجب على المواطنين أن يقوموا بها كرعايا، من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتعوا بها كأناس.
ويُسَلَّم بأن كل واحد يتنزل بالميثاق الاجتماعي عن قسم من سلطانه وأمواله وحريته، وذلك بالمقدار الذي يهم الجماعة استعماله، ولكنه يجب أن يسلم أيضًا، بأن السيد وحده هو الحاكم في هذه الأهمية.
وكل خدمة يقدمها المواطن إلى الدولة يجب أن يقدمها فور مطالبة السيد إياه بها، غير أن السيد، من ناحيته، لا يمكن أن يثقل الرعايا بأي قيد غير نافع للجماعة، حتى أرجو من القراء النبهاء ألا يستعجلوا في اتهامي هنا بأني أناقض نفسي، فلا أستطيع تجنب هذا في الاصطلاحات عن فقر في اللغة، ولكن انتظروا.
إنه لا يستطيع أن يريد ذلك؛ وذلك لأن من مقتضيات ناموس العقل، وناموس الطبيعة أيضًا، ألا يحدث شيء بلا سبب.
وليست التعهدات التي تربطنا بالهيئة الاجتماعية إلزامية، إلا لأنها متقابلة، ومن طبيعتها أنها إذا ما أنُجزت لم يمكن أن يعمل الإنسان في سبيل الآخرين من غير أن يعمل في سبيل نفسه، ولِمَ تكون الإرادة العامة صائبة دائمًا؟ ولِمَ يريد الجميع سعادة كل ولا يفكر في نفسه عند «كل واحد» واحد منهم دائمًا، إذا لم يَعْنِ الشخصُ نفسَه بكلمة التصويت من أجل الجميع؟ هذا يثبت كون المساواة في الحقوق، وكون فكرة العدل التي تنشأ عن هذه المساواة، يشتق من إيثار كل واحد نفسه، ومن طبيعة الإنسان نتيجة، وهذا يثبت وجوب كون الإرادة العامة عامة في أغراضها وجوهرها؛ لتكون هكذا في الحقيقة، ووجوب صدورها عن الجميع لتُطَبَّق على الجميع، وكونها تفقد سدادها الطبيعي عندما تهدف إلى غرض شخصي معين؛ وذلك لأننا إذ نحكم فيما هو غريب عنا هنالك لم يكن لدينا أيُّ مبدأ صحيح في الإنصاف يُرْشِدُنا.
والواقع أن الأمر يصبح موضع جدل، عندما تثار مسألة خاصة أو حق خاص حول نقطة لم تنظم بعهد عام سابق. أجل، إن هذه قضية يكون الأشخاص ذوو العلاقة طرفًا فيها، ويكون الجمهور الطرف الآخر فيها، غير أنني لا أرى أن القانون هو الذي يجب أن يُتَّبَعَ فيها، ولا القاضي هو الذي يجب أن يحكم فيها، ومن المضحك أن يراد الاستناد هنالك إلى قرار صريح للإرادة العامة قد لا يكون غير استنتاج أحد الطرفين، فلا يعده الطرف الآخر غير إرادة غريبة خاصة مالت في هذه الحال إلى الجور وكانت عُرضة للخطأ، وهكذا، كما أن الإرادة الخاصة لا تستطيع أن تُمثِّل الإرادة العامة تغير الإرادة العامة طبيعتها بدورها عندما يكون موضوعها خاصٍّا ولا تستطيع، كإرادة عامة، أن تقضي في أمر رجل ولا واقعة، ولما كان شعب أثينة، مثلًا، ينصب رؤساءه أو يعزلهم، وكان يكرم أحدهم ويعاقب آخر منهم، وكان يمارس جميع أعمال الحكومة على السواء ووفق كثير من المراسيم الخاصة، عاد هذا الشعب هنالك لا يكون ذا إرادة عامة بحصر المعنى، وعاد لا يسير مثل سيد، بل مثل حاكم، ويلوح هذا مخالفًا للآراء العامة، ولكن يجب أن يترك لي من الوقت ما أعرض فيه آرائي.
يجب أن يرى مما تقدم، أن الذي يجعل الإرادة عامة هو المصلحة المشتركة التي تؤلف بين المصوتين أكثر من أن يكونَه عددُهم؛ وذلك لأن كل واحد في هذا النظام يخضع، بحكم الضرورة، للأحوال التي يفرضها على الآخرين، وهذا الاتفاق العجيب بين المصلحة والعدالة هو الذي يمنح المشورات المشتركة صبغة إنصاف يُبْصَرُ زوالُها في المناقشة حول كل أمر خاص، وذلك عند عدم وجود مصلحة مشتركة توحد، وتوفق، بين قاعدة القاضي وقاعدة الخصم.
ومهما تكن الجهة التي يقترب منها إلى المبدأ، فإنه يوصل إلى ذات النتيجة دائمًا، وذلك أن الميثاق الاجتماعي يجعل بين المواطنين من المساواة ما يُلزمون أنفسهم معه بذات الشروط وما يجب أن يتمتعوا معه بذات الحقوق، وهكذا فإن كلَّ عقدِ سيادةٍ، أي كل عقد صحيح للإرادة العامة، يُلْزِمُ أو يساعد، على السواء، وعن طبيعة الميثاق، جميع المواطنين، فلا يعرف السيد بذلك غير هيئة الأمة، ولا يفرق بين من تتألف منهم، وما يكون عقد السيادة بحصر المعنى إذن؟ ليس هذا عهدًا بين الأعلى والأدنى، بل عهدُ هيئةٍ بين كل واحد من أعضائها، وهو عهد شرعي؛ لأنه قائم على العقد الاجتماعي، وهو عادل؛ لأنه مشترك بين الجميع، وهو نافع؛ لأنه لا غرض له غير الخير العام، وهو مكين؛ لأن له ضمانًا بالقوة العامة والسلطة العليا، ولا يخضع الرعايا لغير إرادتهم الخاصة ما داموا غير خاضعين لسوى تلك العهود، والسؤال عن مدى حقوق السيد والمواطنين المتبادلة هو سؤال عن المدى الذي يُمْكِنُ المواطنين ضمنه أن يلزم بعضهم بعضًا، وعن المدى الذي يُمْكِنُ كل واحد أن يلزم نفسه نحو الجميع، وعن المدى الذي يمكن الجميع أن يلزموا أنفسهم نحوه.
ومن ثم يُرى أن السلطة السيدة، المطلقة، المقدسة، المبرمة كما هي، لا تجاوز ولا يمكن أن تجاوز، حدود العهود العامة، وأن كل إنسان يستطيع أن يتصرف تصرفًا تامٍّا فيما تُرِكَ له من أمواله وحريته بهذه العهود، فلا يحق للسيد، مطلقًا، أن يُحَمِّلَ أحد الرعايا أكثر مما يحمل الآخر؛ وذلك لأن الأمر يصير خاصٍّا هنالك فيعود سلطانه غير ذي اختصاص.
وعندما سُلِّمَ بتلك الفوارق مرة رئي من غير الصواب كثيرًا وجودُ أي تنزل حقيقي من قبل الأفراد في العقد الاجتماعي، وذلك عن كون الوضع الذي صاروا إليه نتيجة العقد أفضل، في الحقيقة، من الذي قبل ذلك، وذلك أنهم قاموا بمبادلة رابحة بدلًا من المبايعة، وأنهم نالوا طراز حياة أكثر صلاحًا وأعظم قرارًا بدلًا من طراز حياة متقلب غير ثابت، وأنهم فازوا بحرية بدلًا من استقلال طبيعي، وأنهم ظفروا بحق يجعله الاتحاد الاجتماعي منيعًا بدلًا من قوتهم التي يمكن الآخرين أن يتغلبوا عليها، وتحمي الدولة، باستمرار حياتهم التي وقفوها عليها. فإذا ما خاطروا بها دفاعًا عن الدولة، فما يصنعون أكثر من ردهم إليها ما كانوا قد أخذوه منها؟ وما يفعلون أكثر ما يفعلون، غالبًا، مع مجازفة أعظم شدة، في الحال الطبيعية، التي يخوضون فيها معارك لا مفر منها معرضين حياتهم للهلاك دفاعًا عن وسائل حفظها؟ إن على الجميع أن يحاربَ في سبيل الوطن عند الضرورة لا ريب، ولكن ليس لأحد أن يقاتل في سبيل نفسه إذ ذاك، أو لا نكسب شيئًا باقتحامنا، في سبيل ما يمنحنا سلامتنا، بعض المخاطر التي يجب أن نسعى إليها في سبيل أنفسنا عند فَقْدِ هذه السلامة؟
جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012، ص57-60 (صدر الكتاب الأصلي أول مرة عام 1762).






