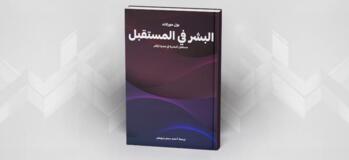كتاب "إمام في فرنسا" من تأليف طارق أوبرو، ترجمة سعيد بنسعيد العلوي
فئة : قراءات في كتب
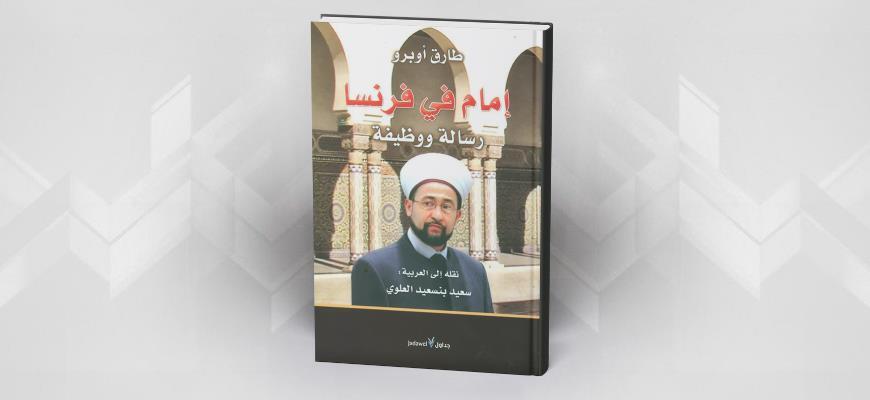
كتاب "إمام في فرنسا" من تأليف طارق أوبرو، ترجمة سعيد بنسعيد العلوي
"إمام في فرنسا" من تأليف طارق أوبرو، ترجمة سعيد بنسعيد العلوي، من إصدارات دار جداول للنشر، بيروت.
أهمية الكتاب
الكتاب في غاية الأهمية بما كان؛ لأنه يعالج قضية محورية في الثقافة الإسلامية، وبالأخص موضوع الإسلام في السياق الأوروبي؛ أي في مجال الدولة الأوروبية التي تقول بالعلمانية وظهرت الحداثة وتشكلت في حضنها، الكتاب يتضمن إجابة منهجية على كثير من الأسئلة المفكر فيها وغير المفكر فيها أحيانا من قبيل، كيف يعيش المواطنون المسلمون كأقلية تحت سقف الدولة العلمانية في الغرب؟ وهل العلمانية نقيض للمسألة الدينية؟ وما هي آفاق حضور الإسلام في الغرب؟ وما هي الأدوار المنوطة بالمثقف وإمام المسجد في أوروبا؟
الإمام والمسجد في أوروبا
الكتاب في أصله مجموعة حوارات مكتوبة باللغة الفرنسية، أجراها باحثان فرنسيان قريبان من الشأن الإسلامي الأوروبي: الدكتور سيديريك بايلوك ساسوبر (الفلسفة والتصوف الإسلامي)، وميشال بريفو (الأنثروبولوجيا) على مدى سنتين تقريباً. أما صاحب الكتاب، فهو من أصل مغربي أمازيغي يقوم بوظيفة الإمامة بمسجد بوردو. يتكون الكتاب من عشرة فصول نذكر من بينها: الإيمان الإسلامي والعقل النقدي، الإمام والمراجعة الدينية، الإمام والتطرف والأجيال الجديدة من المسلمين، الإمام في مواجهة النموذجين الجمهوري والثقافي المتعدد.
يظن أغلب الناس، أن المثقفين في مختلف التخصصات العلمية إلى جانب رجال الإعلام وغيرهم، لهم دور كبير في بناء الوعي الجمعي لدى عموم فئات المجتمعات الإسلامية، هذا صحيح، ولكن إن دققنا في الصورة أكثر، نجد الفقيه وخطيب المسجد هو من يحظى بالحظ الكبير في التأثير على مختلف الفئات العمرية في العالم الإسلامي، وحتى الذين لم يحضروا المساجد في خطب صلاة الجمعة والأعياد، لسبب من الأسباب، فهم يسلمون له الأمر، ويكونون تحت سلطته في لحظة دفن موتاهم وما شابه ذلك، وهذا يعني أن موضوع التجديد الديني والتغيير الثقافي في العالم الإسلامي، سيكون ناجحا، إن انطلق من تجديد عقلية إمام المسجد؛ فالإمام وخطيب المسجد اليوم بالضرورة أن توفر له السبل والظروف، ليكون قريبا من مختلف العلوم الإنسانية إلى جانب العلوم المختصة في أمر الدين ومقاصده وغاياته.
وقد تطرق طارق أبرو من خلال الفصل الأول لوضع الإمام في مختلف المساجد في فرنسا كنموذج من بين الدول الأوروبية، وهو يتحدث عن ظروفه الخاصة ومعاناته من جهة عدم العناية اللازمة بالوضع المادي والاجتماعي من جهة السكن والإقامة التي تخصص للإمام، وقد تحمل عبء السكن في بيوت تفتقد التدفئة أو شروط النظافة.. فنظرة المسلمين إلى الإمام نظرة فيها نوع من التنقيص والدونية، بالرغم من أنهم يصلون خلفه، وبالرغم من أنهم يقصدونه في مختلف أمورهم الدينية وحتى الدنيوية أحيانا، الإمام دائما في موضع شبهة، حتى إن اشترى بدلة جديدة، فهي موضع سؤال وشك وريبة؛ فالمسلمون لا يقومون بهذا عن قصد، وإنما ذلك يصدر منهم بشكل غير واع نتيجة، غياب الوعي لديهم بأهمية الدور الذي بالإمكان أن يقوم به إمام المسجد في التطلع لواقع أفضل، ما يجري على وضع الإمام في فرنسا هو نفس الوضع الذي يعانيه الكثير من مختلف الأئمة في العالم الإسلامي، القليل من الناس من يتمنون وظيفة القيام بإمامة المسجد، فالكل يتهرب منها، وأحيانا تسقط في يد من لا يستحقها ولا علاقة له بها، وبهذا يضيع الدين والاجتهاد في أمر فهمه. طارق أبرو كان واعيا بالأدوار التي كان يقوم بها في توجيه ومشاركة أبناء الجالية المسلمة في مختلف تحدياتهم ومشاكلهم الاجتماعية والسياسية...وهو يتنقل من إمامة مسجد إلى آخر ويتلقى أجور زهيدة، حتى وجد نفسه إماما للمسجد الكبير بمدينة بوردو، مع العلم أنه تابع دراسته في كلية الطب، ثم تحول لدراسة البيولوجيا، فنال ديبلوم في الصيدلة الصناعية، وهو ما مكنه ليكون له تكوين علمي مميز يجمع بين مختلف العلوم الدينية والعقلية والإنسانية. وقد فضل إمامة المسجد على العمل في مجال الصناعة الصيدلة.
شريعة الأقلية
يحضر في أذهان مختلف المسلمين عبر العالم صورة واحدة عن الإسلام، يحملها المسلم معه أينما حل وارتحل، وأينما تيسرت له سبل العيش، دون الوعي بأن الإسلام في شريعته يتشكل ويتجدد في استجابة لمختلف الظروف والبيئات الاجتماعية؛ فالإسلام له القدرة ليستوعب الثقافة الأوروبية ويقدم لنا نسخة عن الإسلام الأوروبي، وليس بالضرورة أن تكون هي نفس النسخة التي تشكلت في المغرب أو في المشرق أو في تركيا أو بلاد فارس...الخوض في هذه الإشكالية يقتضي من صاحبه استيعاب الشريعة الإسلامية في بعدها التاريخي والاجتماعي واستيعاب الفلسفة والفكر الغربي في أبعاده الإنسانية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والوعي بتقديم منظومة القيم العليا في القرآن، على ما هو نسبي وعرضي وتاريخي بطبعه. فصاحب الكتاب يجمع بين مختلف هذه الأبعاد المنهجية والمعرفية. فعندما تلتقي بطارق أبرو وتستمع له، فأنت تفتح عينيك عن تأويل معاصر للإسلام يعي بشكل واقعي ما يمكن العمل من أجله وفق نظرية ما أطلق عليه بشريعة الأقلية؛ لأن المسلمين في الغرب يشكلون أقلية، فهم في حاجة إلى فهم حضاري للإسلام يستحضر فقه الأقلية في فهمهم للإسلام. إنه "إسلام بسيط جداً فيما يتعلق بمظاهره الشعائرية والأخلاقية وذلك من خلال (شريعة الأقلية)، فهي محاولة أصولية تأصيلية تسهم في تمكين المسلمين من الارتقاء إلى مستوى اجتماعي/ اقتصادي يسمح لهم بالمقابل، متى تم استقرارهم نهائياً في نوع من الرفاهية الفكرية، بإدراك دقائق عمق دينهم. فعوضاً عن أن يكونوا مستهلكين للحداثة، فإنهم سيصبحون مساهمين فيها، كما أنهم سيعملون على إثراء الحضارة بالمعنى الأوسع والكوني. وباختصار، فإنّ المقاربة التي أقترح على طبقتين: خطاب يدعو إلى العودة إلى الديني البسيط، غير أنه يمر عبر عملية فكرية لفك التعقيد، والتي هي بدورها مركبة معقدة لاستنباط البسيط السهل الفطري الممتنع، فإذن ليس من البسيط والسهل الوصول إلى الديني المحض أو البسيط أبداً، وأمّا الطبقة الثانية من مقاربتنا، فهي خطاب كوني عالمي، وهو أكثر زمنية ودنيانية، وعندي أنّ وقت بسط هذا الخطاب لم يحن بعد".[1]
تطبيق الشريعة من أجل الشريعة في نظر طارق أبرو "هي شرك خفي، نوع عبادة ناموس. أما فهم الشريعة...فإنه لا يجعل من الممارسات الدينية عوائق تقف في مجرى الحياة الدنيوية للمسلم..، فهذه الأخيرة تضيق وتتسع بحسب الأحوال التي يوجد فيها الناس، وبحسب السياق الذي يوجدون فيه، وحسب الظروف التي يعيشون فيها."[2]
قد يحتج البعض على وجهة نظر طارق أبرو بالقول إن الشريعة مكتملة، فهي تضم مذاهب دينية وعقدية...فمن الأولى الاجتهاد في تنزيل ما هو معروف وموجود ومتداول بين الناس، ففيه الكفاية، وهذا صحيح من جهة استثمار التراث وفهمه واستيعابه وتجاوزه، ولكن من جهة أخرى ينبغي ألا نغفل "أن الأنساق الفقهية والكلامية التي تم بناؤها عبر التاريخ كانت على عبقرية لا تنكر. لكنها تصلبت وأصبحت في قالبها الحالي غير مناسبة للتعامل مع الحداثة وما بعد الحداثة، ومع ما يميزهما بشكل بارز يعني الدنيانية"[3] أي العلمانية. ولنذكِّر بأن القرآن لا يحمل مذهبا فقهيا تمت صياغته وتصوره بصفة قبلية، ولكنه يشتمل على براديغم لا يعلن عن ذاته يفهم حدسيا، ولربما هذا هو مفهوم كلمة فقه في القرآن.[4] "فكونية النص الديني (القرآن) ليست دائما في محتواه وصورته المرتبطة بالسياق التاريخي للوحي، ولكن تكمن في الصورة التي يمكن أن يتخذها تأويل النص نفسه في سياق جديد مختلف عن وضعه الزمني القرآني الأصلي".[5]
العلمانية
القارئ للكتاب سيجد طارق أبرو، خارج عن منهج التفكير الذي تحكمه الثنائيات، من قبيل: الإسلام والعلمانية، المسلم وغير المسلم، الشرق والغرب، علوم دينية وعلوم طبيعية... وهو أمر جعله يجترح الكثير من المفاهيم التي تجمع بين مختلف الثنائيات التي تبدو متعارضة أحيانا، وبأنه لا يمكن الجمع فيما بينها، فوفق التصور الثنائي في التفكير هناك من يرى في العلمانية نقيض الإسلام؛ إذ لا يمكن الجمع بينهما، والمكتبة العربية الإسلامية مليئة بالكثير من هذه الكتب، فطارق أبرو يرى أن العلمانية "ليست ظاهرة عصرية حديثة العهد (بالحدوث) بل إن أصولها ترجع الى فجر الإنسانية. إنها تترجم تلك العلاقة الجدلية أو التمفصل المستمر بين البشري والإلهي، بين الديني والدنيوي، بين الزمني المادي والروحي، بين الساسي والديني؛ فهي لا تفتأ تتخذ أشكالا مختلفة فلكل مجتمع دنيانيته (العلمانية) الخاصة به."[6] فالعلمانية، تعود أصولها الى التاريخ الإسلامي "فمتكلمة الإسلام في العصور الوسطى هم أول من طرحوا هذه الإشكالية للمرة الأولى في تاريخ الديانة السماوية". وهذا يعني أن العلمانية في جذورها الأولى جزء من تاريخ الثقافة الإسلامية، مما يعني أنه ليس بالضرورة أن نميل الى التعارض بين كل من العلمانية والإسلام، فالتحدي يعود الى مطلب التفكير في أمر الدين والشريعة والنظر إليها بكونها مستوعبة للعلمانية.
ولا ينكر طارق أبرو، طبيعة الحدة التي تتميز بها العلمانية في الوقت الحاضر، في الفصل والتمييز بين السياسي والديني، وخاصة في فرنسا. فالعلمانية على الطريقة الفرنسية.[7] تعد تفرُّد في العالم وحتى في أوروبا، ويمكن القول إن فرنسا دولة علمانية ولائكية بامتياز (فلا دين للدولة، فالدين مسألة شخصية)، وهي علمانية قامت في أساسها على معادات الدين، وهذه الحدة جعلت اللائكيين والكاثوليكيين في فرنسا في قلق من الإسلام، وهو وضع يجعل "الإسلام وفاعليه في وضع حساس للغاية، ذلك أن علاقة المسلمين أنفسهم بدينهم تتم عبر نظرة الآخر إليهم، في شعور بالإحباط ورد الفعل."[8] وهو أمر يجد تفسيره، في تاريخ طويل ومزدهر، عندما استطاع المسلمون التوفيق بين الإلهي والبشري، بين الوحي والعقل، بين التصوف والعقلانية، وتمكنوا من خلق مراكز للتسامح الإنساني.[9] فرد فعل المسلمين في التعاطي مع واقعهم، يرتبط باستحضار ماضيهم وتاريخهم، بينما الأمر يقتضي الإقبال والعمل على بلورة نموذج جديد في فهم الإسلام، يتوافق مع محيطنا الحضاري المعاصر في التوفيق مجددا بين الإلهي والبشري، وبين الوحي والعقل.
قلق فئة كبيرة من اللائكيين والعلمانيين والكاثوليكيين من الإسلام، وقلق فئة كبيرة من المسلمين من العلمانية، فكلا القلقين يأتي نتيجة عدم معرفة كل طرف للطرف الآخر، فبالنسبة إلى الذين "ينصبون أنفسهم حراسا لمعبد اللائكية، فإن هذا المفهوم قد يبدوا كما لو كان فيه تحدّ للجمهورية واستفزاز لها. وأما بالنسبة إلى أولئك الذين يجعلون من أنفسهم حراسا لمعبد الإسلام، فإنهم يرون في هذه النظرية بدعة وانحرافا عن الدين مع أنه لا شيء من ذلك".[10]
[1] طارق أوبرو، إمام في فرنسا، نقله إلى اللغة العربية سعيد بنسعيد العلوي، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، ط. 1، سنة 2014م. ص. 211
[2] نفسه، ص. 109
[3] نفسه، ص. 36
[4] نفسه، ص.44
[5] نفسه، ص.132
[6] نفسه، ص.34
[7]بمعنى الفصل القانوني بين المؤسسة الدينية والدولة كما أقره قانون سنة 1905م، والفصل هنا لا يعني إلغاء الدين بل عدم تدخل الدولة في المجال الديني. العلمانية هي "الفصل بين الدين والدولة" أي أنها تعترف بالدين ولكنها لا تعتمد عليه في تشريعاتها وقوانينها. أما اللائكية، فهي "اعتبار الدين اختيار شخصي" و"لا دين للدولة" مثلا الاعياد الدينية غير معترف بها من لدن الدولة..
[8] نفسه، ص.233
[9] نفسه، ص.233
[10] نفسه، ص.43