مركزية الوحي
فئة : مقالات
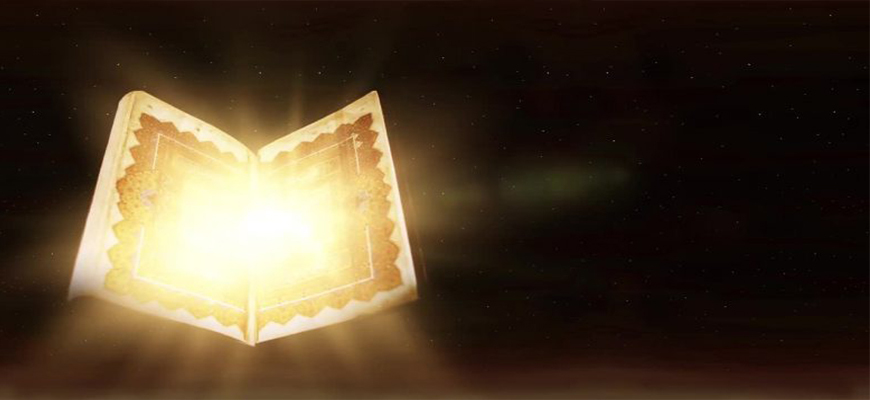
لم ينشأ الفكر الإسلامي بمنأى عن السياقات الثقافيّة الدينية الحاضنة لها، إنما انبثق من خضمّها، وتفاعل معها، فبظهور الإسلام أصبح القرآن الكريم المركز الفاعل في الثقافة العربيّة- الإسلامية؛ فهو المصدر الذي انبثقت عنه الرؤية الدينيّة للوجود، وهو الخطاب المتعالي بنسيجه الدلاليّ والأسلوبيّ، وتركيبه اللغويّ المخصوص، ويليه الحديث النبويّ الذي اكتسب أهميته من حيث كونه مفصّلاً لذلك المُجمل، فعلاقة الحديث بالقرآن علاقة حاشية بمتن، وهما يصدران عن الرؤية ذاتها، ويهدفان إلى تأسيس نظام فكريّ واحد، وبما أنّ القرآن اقترح رؤية للعالم، قالت باستكشاف الأحداث الماضية، وتنبأت بالآتية، فإن الحديث، بحكم علاقته التبعية بالقرآن، انطوى على الرؤية نفسها. حُبس النص الديني وراء حصن منيع لا يسمح لأحد بإجراء عمليات تحليل حرّة لمستوياته الأسلوبيّة، والتركيبيّة، والدلاليّة، ولا يسمح، في الوقت نفسه، لأحد الكشف عن تحيّزات التفكير المرتبط بالنصوص الدينيّة؛ فالمركزيّة الدينيّة، وجوهرها مركزية الوحي، وفّرت لنفسها حماية كاملة ضدّ التاريخ، وحالت دون انخراط مكوّناتها ضمن الوعي التاريخيّ للمجتمعات التي تعتقد بها، وآلت، بمرور الزمن، إلى منطقة خارج مجال البحث والفكر، وبذلك وقعت الجماعة المؤمنة أسيرة تخيلات ثابتة عن عقيدتها، فهي العقيدة المطلقة الصواب في كل ما تقول به.
أصبحت مركزية الوحي تغذّي العالم بمعانٍ جديدة لها علاقة بها، فتُقصي ما لا يتوافق مع ورؤيتها
استندت "مركزيّة الوحي" إلى مفهوم الرؤية الحتميّة لمسار الكون منذ بدء الخليقة إلى النهاية، وضمن مسيرة العالم هذه رتّبت الرؤية الدينيّة شؤون الخلق الفكرية والاجتماعيّة والتاريخيّة، فجعلت العالم ينتظم في سياق يطابق منظورها، فوقعت أحداث التاريخ تحت طائلة المعنى المتفرّد الذي جاءت به تلك الرؤية، وأقصي ما يتعارض معها، فأُعيد ترتيب شؤون العالم على وفق المعايير الدينيّة، وبذلك ترسّخت تلك المركزيّة حيث أمسى العالم بموجب منطوقها، منذ الأزل وإلى الأبد، كتابا مفتوحا لا ينطوي على مجهول، وينبغي قراءته على وفق قراءة تستمدّ شرعيتها من الرؤية الدينيّة، ولعل من بين أهم ما أُعيد فيه النظر هو صياغة الموروث الثقافيّ الذي يكوّن نسيج الذاكرة العربيّة قبل الإسلام صوغا جديدا. وصحّح القرآن التصوّر المتوارث عن الماضي، وأورد أخبار الأمم السالفة، وأدرجها في سياق رؤيته الاعتباريّة للعالم، فأحلّ منظومة قيم مختلفة محل المنظومات القيمية القديمة، والحال هذه، فإنه، عبر التركيب والمزج، صاغ إطارا وفّر إمكانيّة انخراط الأحداث، والأفكار، والمرويّات، في سياق جديد.
اقترح القرآن تاريخا دوريّا للدنيا يبدأ من لحظة الخلق وينتهي بلحظة الفناء، وجعل صيرورته مقترنة برؤيته الخاصّة للعالم، فكلّ شيء فيه لا يكتسب أهميته من خصائصه الذاتيّة، بل من علاقته بالمركزيّة الدينيّة، وأهميته مرتبطة بتلك المركزيّة، ويفقدها إذا انفصل عنها. وفي ضوء ذلك، أصبحت مركزية الوحي تغذّي العالم بمعانٍ جديدة لها علاقة بها، فتُقصي ما لا يتوافق مع ورؤيتها. وبمضي الزمن، وتعاقب العصور، وشيوع التفسيرات الضيقة للظاهرة الدينية، وهي التفسيرات التي استقامت إليها المؤسّسة الدينيّة التي بسطت نفوذها في دار الإسلام، انحسر تأثير الفكر الدنيوي، واعتبر المقترح الديني للحياة هو الأمثل لتدبير أمور الحياة في مناحيها كافة. خضع العالم لزمن دوري تتأكد أحداثه في إطار دائرة معلومة الحوادث، فلا جديد فيه بالنسبة إلى الرؤية الدينية التي حلّت مسالة البداية والنهاية وأخضعتها لإرادة الله الذي يغيب عن بصره شيء؛ ولكي يتحقّق صواب الجهد البشري، والفكري منه بخاصة، فينبغي أن يعبّر عن تلك الرؤية في تفاصيلها وفي مجملها، ويستظلّ بها، ويؤكّد مضمونها، وإلا شذّ عن الطريق القويم، وكانت ثمرته فاسدة، وخاتمته بائسة.
ظهر القرآن بوصفه خطابا دينيّا متعاليا على العالم الذي ظهر فيه، وبسبب من مركزيته المستندة إلى تفسير خاصّ لأحكامه ومضامينه، ظهر تراتب في درجة اللفظ والمعنى بينه والخطابات الأخرى، ولمّا كان لفظه ومعناه متعاليين، فقد أضحى خطابا من الدرجة الأولى أسلوبا، وتركيبا، ودلالة، ولأنّ الحديث النبويّ حاشية على ذلك المتن فما لبث أن أمسى خطابًا من الدرجة الثانية؛ فمعناه يتحدّر عن مصدر القرآن، وهو الوحي، وإن اختلف بالصوغ عنه، وبذلك اتصل الحديث بالقرآن اتصالا وثيقا، فلا انفكاك بينهما، وإن كان الحديث النبوي دون منزلة القرآن الكريم. وقد أفضى التلازم بين الكلام الإلهيّ والنبويّ إلى إبعاد الخطابات الدنيويّة أو دمجها في سياقات تخدم تلك المركزية، فاحتلّت -طبقا لهذا النظام التراتبي-موقع الدرجة الثالثة، شرط مراعاة قواعد الفصاحة، وسلامة المعنى، والامتثال للرؤية القرآنيّة للعالم، أمّا إذا حادت عن ذلك بأية ذريعة، ونزعت نحو الاستقلال بذاتها بمعزل عن مركزيّة الوحي، وأن تُشغَل بجمالياتها الأسلوبيّة، والدلاليّة، ووظائفها التمثيلية، ومضامينها الدنيوية، فلا موقع لها في عالم بسطت عليه المركزيّة الدينيّة نفوذها.
ولأن المركزية الدينية أفرزت كتلة صلبة من اللاهوت ممثلا بعلم الكلام، وهو لاهوت غزير حجب الظاهرة الدينية خلف سجالات افتراضية تستجيب لمقولات مجرّدة لكنها لا تتوافق مع معايير الواقع، ولا تتفاعل مع شروط الحياة الدنيوية، فقد انتهى الأمر بعزل الظاهرة الدينية عن سياقها الدنيوي، فأُنكرت الموارد التاريخية، والجذور الثقافية، والأصول الفكرية، فلا يليق أن تكون الظاهرة الدينية تابعة للظواهر الدنيوية؛ فهي الأصل الأول، والأساس المتين، والمنبت الخصب، وكل ما سواها عيال عليها، وليس ذلك بغريب على الديانات الكبرى، فقد استأثرت بالعناصر الفاعلة في الثقافات السائدة في عصرها، وأعادت إنتاجها طبقا لتصوّراتها الدينيّة. حصل ذلك مع اليهودية في استثمارها المرويّات الأسطوريّة في بلاد الرافدين، ومصر، وبلاد الشام، ووقع ما يناظره في المسيحية، التي مزجّت المأثور اليهوديّ، بالوثنيات اليونانية، بخلاصة الأفكار الشرقية، وأقرّ الإسلام بأنه تمّم تلك الديانات، وجرى على جريها في الاستحواذ على ثقافات عصره من غير اعتراف بها.
وقع تجاهل العلاقات المتفاعلة بين النص الديني المركزي الممثّل بالقرآن، وبين النصوص الثقافية والدينية السابقة عليه أو المعاصرة له، وبإعادة صوغ وعي المؤمنين صوغا دينيا يقوم على مبادئ: العزل، والابتكار، والخلق، والإيحاء، انتقل أمر الخلفيّات والمرجعيّات إلى مستوى غير مفكّر فيه داخل المجال الخاصّ بالوعي الإسلاميّ، وكلّ حفر في ذلك فُهم على أنه يتهدّد الدين، بدل أن يقوّيه، ويضفي عليه التنوّع الخلاق. وعلى هذه القاعدة من الرغبة اللاهوتية في إبعاد الموارد الثقافية للتفكير الدنيوي الحرّ، وُضعت الفرضيات المنهجية الأساسية للتفكير الإسلامي، فكلّ ما ينبغي التفكير فيه يجب أن يدور في فُلك المركزية الدينية. وغالبا ما تستحوذ المركزية الدينية على المأثورات الثقافية المعاصرة لها، وتنتزع لنفسها حقّ تأويل مقصود للنصوص الدينية، على أن النصوص نفسها لا تبرأ من إيحاءات فيها درجة عالية من التمركز حول الذات؛ فالنصوص الدينية تشع بالإيحاءات، ويمكن العثور على النظائر والأضداد فيها بغير عناء، ولطالما جرى تحميلها بغير ما تحمله، وليس من الفائدة الذود الأعمى عن نصوص تركّبت في ظروف غامضة، ولا فائدة من الارتياب بمضامينها الأخلاقية العامة؛ لأنها شكّلت البطانة الداخلية لمعتقدات الناس، ورسمت هوياتهم بما تنطوي عليه من قيم روحية سامية، غير أنه من الضروري القول إن أثر تأويلها كان أشدّ من تأثير الأحكام التي طوتها تلك النصوص، إذ غُلّفت بممارسات تأويلية جرى اعتبارها بطانة للنصوص، وحاضنة لها، ومفسّرة لمقاصدها، وقد تراكمت الظاهرة التأويلية، وغمرت النصوص، فتراجع التأثير الفعلي للنصوص، وقد استقامت المركزية الدينية على تأويل لاهوتي مخصوص للنصّ الديني وليس على فحواه.
اقترح القرآن تاريخا دوريّا للدنيا يبدأ من لحظة الخلق وينتهي بلحظة الفناء، وجعل صيرورته مقترنة برؤيته الخاصّة للعالم
على أنه ينبغي التصريح بأن الحفريّات الأسلوبيّة، والدلاليّة، والبنيويّة في النص الديني، والبحث في المرجعيات الثقافية له، وبيان فائدته العملية في إدارة شؤون الأفراد والأمم، لا يتهدّد النص الديني بأيّ شكل من الأشكال، ولا ينتقص من هيبته، إنما يتهدّد شكلا من التفسيرات المغلقة لتلك النصوص، فتلك الحفريات تسهم في تفكيك ركائز التعاليم العقائدية المغلقة التي طوّقت الظاهرة الدينية، وقطعت صلتها بالحواضن الاجتماعية التي احتضنتها، والإبقاء على تلك التعاليم بذريعة قدسية النص الديني هو الذي غذّى التخيلات الدينيّة المتصلّبة، وهي في مجملها أيديولوجيات رُهابية معتصمة بذاتها، وتثير الذعر في نفس كلّ من يسعى لاستكناه هوية الخطاب الدينيّ بالدراسة التاريخيّة- التحليلية المقارنة، فلا يمكن الاقتراب إليه، وكلّ تحليل أو استنطاق أو تأويل ينبغي أن يقع تحت ذلك المستوى غير المفكّر فيه؛ فسادَ فهم ضيق وضع نفسه في تعارض مع مستجدات التفكير البشريّ، وفي تعارض مع أيّة فكرة لتحديث البحث في الخطاب الدينيّ بصورة عامّة. الإفراط في استدراج كافة الحقائق الدنيوية من النصوص الدينية، سيؤدي، لامحالة، إلى أفول الدين نفسه، فالمؤّولون المفرطون في تأويلاتهم يتقصّدون إخضاع مظاهر الحياة كافة للشرائع الدينية، وذلك يقود، بالتدريج، إلى صدام بين المنظومة الدينية الثابتة والمنظومة الاجتماعية المتغيرة.
وأجد من الضروري التوغّل في قلب الظاهرة الدينية وكشف تحيزاتها، فلا يجوز أن تتحصّن النصوص وراء قداسة تحول دون تحليلها، ذلك أن قيمة النصوص الدينية تكمن في قدرتها على قبول الاستنطاق وليس في منع الباحثين من الاقتراب عليها. النصوص الدينية ليست زجاجا هشّا قابلا للكسر ما أن نضع أيدينا عليه، ولا هي بغشاء رقيق يتفتّت بأوّل لمسة، إنما هي مستودع رمزي للأفكار، قامت بتمثيل شامل لشؤون عصرها، لكنّها جهزت النموذج اللاهوتي بتأويلات خطيرة، وهي تأويلات لها علاقة بالظروف السياسية والتاريخية والثقافية، والآن صار من اللازم مراجعة تلك التأويلات، ونقدها، وكبح تأثيرها، بإحلال تأويلات بديلة تنزع عن الظاهرة الدينية تلك الهيبة المخيفة وتقترح هيبة تقوم على الألفة، والمودّة، والشراكة، وليس هيبة تقوم على الخوف، والعبودية، والترهيب. وظنّي أنّ النقد سوف يسحب الشرعية الزائفة عن معظم الظواهر الاجتماعية والدينية والسياسية التي تغمر مجتمعاتنا، وسوف تنزع الغطاء الثخين عن الظاهرة الدينية، وتجعلها تظهر بعيون لم تعتد على تلك الظلمة التي اختبأت فيها طوال أكثر من ألف سنة. النقد المسؤول، في تقديري، يمكّن المؤمنين من إعادة الاعتبار للظاهرة الدينية والنظر إليها على أنها خيار فردي حرّ، وليس تركة سياسية واجتماعية مُذّلة يساق الناس لتطبيقها بالعصي والسياط، وتقطع رؤوس غير الآخذين بتفسير مخصوص لها.







