معالم المنهج الوسطي في المجال السياسي ودوره في استيعاب فكر الغلوّ والتطرّف
فئة : مقالات
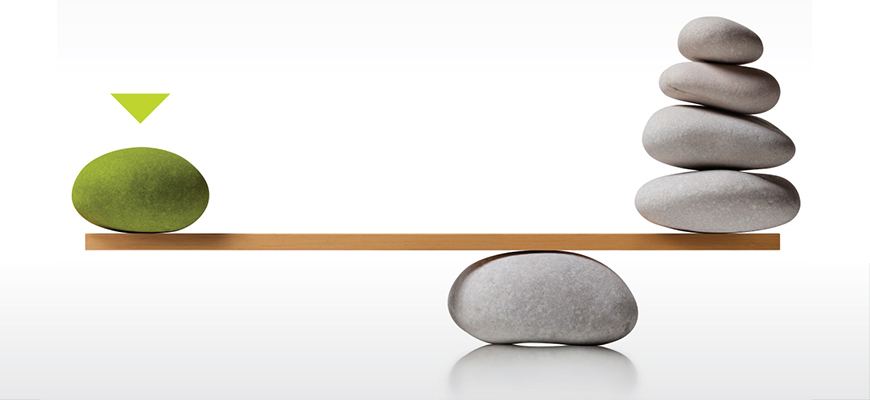
إنّ الحديث عن موضوع الوسطية السياسية، يأتي في سياق يعرف فيه العالم العربي الإسلامي، تحوّلات سياسية واجتماعية، تمثّلت في حراك اجتماعي شمل عددا من أقطار الدول العربية الإسلامية. كما شهد صعود الإسلاميين إلى مواقع السلطة، لكن هذا الحراك الاجتماعي، ظل مفتقدا للفاعلية والتأثير، بدليل حالة التخبّط وانعدام الحوار، وسيادة العنف بين مختلف مكوّنات ذلك الحراك وتيّاراته.
والسبب في ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى أنّ هذا الحراك لم يوازه، ولم يواكبه، حراك على المستوى الفكري والثقافي، حيث يعيد رسم خارطة التفكير الإسلامي، ويعيد بدوره القوة والفاعلية للعقل السياسي الإسلامي، عوض الارتهان لحالة الجمود والتقليد السائدة في أوساط الكثير من ممارسات ومواقف الفاعلين السياسيين الإسلاميين.
المقصد الأسمى للدولة في المجتمع الإسلامي، هو تحقيق مصالح المحكومين وتمكينهم من القيام بواجب الاستخلاف في الأرض
فالخلاصة التي نخرج بها إذن من هذا الحراك، هي أنّ انتفاء الواقع لا يعني بالضرورة انتفاء منظومة التفكير التي تفرزه، وبالتالي فإنّنا نكاد نجزم بأنّ تغيير المعطيات الاجتماعية والسياسية أسهل بكثير من تغيير مناهج التفكير والتعقّل، ومن هنا ضرورة العودة إلى السؤال الجوهري والأساسي الذي من المفروض البدء به أوّلا وهو: هل يمكن إحداث أيّ تغيير نوعي في مجتمعاتنا بنفس آليات التفكير السياسية التقليدية التي لا تفكّر إلاّ ضمن مفردات التراث وخارج سياق الواقع المعاصر؟
انطلاقا من هذا السؤال، سنحاول تناول موضوع الوسطية السياسية في تمفصلاته العامة مع إبراز دوره، وأهمّيته في توجيه وترشيد الممارسة السياسية، وبالتالي الحدّ من فكر الغلوّ والتطرّف؛ ذلك أنّه لا يخفى على كل متتبّع لإنتاجات الفكر السياسي الإسلامي الحديث والمعاصر، أنّه لا يزال لم يستطع بعد أن يقدّم رؤى وتصوّرات سياسية حديثة، تتوافق مع متطلّبات الواقع، ومقتضيات مطلب التجديد والاجتهاد. فما يجري اليوم في العالم الإسلامي من صراعات، وتوترات، وهزّات سياسية عنيفة، تعصف بالأخضر واليابس، وتشلّ حركة الأمة، وتزجّ بها في أفق مظلم، وتعطلّ فيها حركة الإبداع، والنهوض الحضاريين، يؤكّد بأنّ المجتمعات الإسلامية تسير بخطى حثيثة نحو مزيد من الانحدار والتدهور.
إنّ هذا الواقع السياسي المتأزّم، يدفعنا للتساؤل حول الحلول الممكنة، والآليات المقترحة التي يمكن أن تسعف في إيجاد مخرج لهذه الأزمة. وإنّه إذا كنّا نقرّ بأنّ هذه الأزمة مركّبة يتداخل فيها العامل الداخلي بالعامل الخارجي، والثقافي بالسياسي، والماضي بالحاضر، فإنّ هذا لا ينسينا التأكيد على أهمية العامل الفكري في عملية الإصلاح والتغيير؛ فالمشكلة اليوم هي في جوهرها، أزمة منهجية فكرية، وأنّ الطريق لعلاجها هو إصلاح مناهج الفكر الإسلامي، بإعادة تشكيل العقل المسلم، بما ينسجم مع تطلعات الأمّة، ويجيب عن تحدّياتها الراهنة، حتّى تتمكّن من استئناف مسيرتها الحضارية.
وليس يعني هذا إغفال جوانب الإصلاح الأخرى، أو إهمالها، ولكن بداية الطريق يجب أن تكون بالجبهة الفكرية؛ فانحراف المفاهيم خطر على استقامة الفكر، وتصلّبها يؤدي بالضرورة إلى تصلّب الفكر وجموده، وليس ثمّة شيء أخطر على فكر الأمّة من تحول المفاهيم إلى قوالب جامدة، لأجل ذلك فإنّ ترشيد وتصحيح المفاهيم يبقى أحد أهمّ المشاريع الإصلاحية، وأكثرها فاعليّة في ترشيد الفكر الإسلامي وتحقيق الشهود الحضاري؛ فالمدخل الفكري إذن، وإن كانت نتائجه تستلزم زمنا طويلا، فإنّها تكون أكثر رسوخا وأبعد أثرا على المدى البعيد.
وفي هذا الإطار، سنعمل على مقاربة المنهج الفكري الوسطي، في المجال السياسي، على اعتبار أنّ ما نعيشه اليوم من تخبّط سياسي ناتج عن قصور وضبابية في تصور هذا المفهوم، وبالتالي عدم القدرة على تنزيله وتمثله في الممارسة السياسية العملية، وليس أدلّ على ذلك من حالة التمزّق والتفرّق والصراع، التي تسود بين الفرقاء السياسيّين في معظم الدول الإسلامية، إذ غالبا ما يتمّ اللجوء لاستخدام العنف لحسم الصراعات السياسية، وهو النهج الذي يتعارض مع مقاصد الدين الحنيف، ومع التجربة السياسية النبوية التي تمثّل أنموذجا عمليّا وتطبيقيا مهمّا، إذا ما تمّ الاسترشاد به والالتزام بمبادئه وتوجّهاته.
وإنه لمّا كانت العلاقة المعيارية التي بين الدين والسياسة كما هي في عرف المنهج الوسطي، علاقة تمايز، وتوازن، فقد كانت بذلك تقع بين فريقين يقفان على طرفي نقيض، فريق ينادي بعزل الدين عن السياسة محتذيا في ذلك بالتجربة الغربية المسيحية، التي أقصت الكنيسة من التدخّل في شؤون الدنيا، وفريق ينادي بإخضاع شؤون الحياة الدنيا للدين منطلقا من فهم معين للإسلام، لأجل ذلك سنحاول أن نستجلي مفهوم هذه الوسطية، ونكتشف معالمها وأبعادها في المجال السياسي، مع التعرّف-كما قلنا- على أهمّيتها على مستوى استيعاب فكر الغلوّ والتطرّف.
الوسطية السياسية، تجمع بين ثوابت الدين المرتبطة بالمجال السياسي وعطاءات التجربة الإنسانية
أوّلا: معالم منهج الوسطية في المجال السياسي
يمكن القول إنّ هنالك ثلاثة اتجاهات في تصور العلاقة بين الدين والسياسة، التصور اللائكي المتطرف "الذي يرفض أيّ شكل من أشكال العلاقة بين الدين والدولة، وبين الدين والممارسة السياسية، وهو تصور يرى بأنّ الدين هو مجال المطلق، وأنّ السياسة هي مجال المتغير والنسبي، وأنّ الدين هو مجال اعتقادي فردي، وأنّ السياسة ترتبط بالشأن العام الذي هو مجال الصراع بين المصالح، وأنّ الدولة في أقل الأحوال ينبغي أن تكون محايدة، وأن لا يكون لها دين. أمّا التصور الثاني، فهو ما يمكن تسميته بالتصور الثيوقراطي للدولة، الذي يجعل من الدولة دولة دينية؛ أي دولة تحكم باسم الحق الإلهي، وتتماهى فيه اجتهادات الحاكم مع الدين، حيث تصبح أيّة معارضة لسياسات الحاكم أو لتدبيره معارضة للدين، أو دولة يتسلط فيها رجال الدين بالمعنى الشائع؛ أي الفقهاء المنقطعون عن علوم العصر وعلوم الدنيا وعن علوم الواقع التي تمكن من تدبير الشؤون اليومية للمجتمع".(1)
وفي مقابل هذين الموقفين المتطرفين في الاتجاهين، يقف فكر الوسطية السياسية الذي يرى أنّ الدولة في المجتمع الإسلامي هي: "دولة مدنية، لكن مرجعيتها مرجعية إسلامية، وذلك يعني أنها تستند في أسس شرعيّتها على الانطلاق من قاعدة دستورية، ترى أنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأسمى للتشريع بالمعنى الواسع للشريعة؛ أي أحكاما ومقاصد ونصوصا واجتهادا فيها"(2)
ويمكن رصد معالم هذه الوسطية السياسية، كالآتي(3):
تمايز علاقة الدين بالدولة
إنّ المعلم الأول من معالم الوسطية في الفكر السياسي الإسلامي، هو النظر إلى مسألة العلاقة بين الدين والدولة على أنّها علاقة تمايز، فهذا الاتجاه الوسطي يقوم على التمييز بين الدين والسياسة، ويرى بأنّ الرسول، مع جمعه بين الرسالة والسياسة، قد تمايز في إنجاز ما هو رسالة عما هو سياسة، ما هو دين عما هو دولة. إنّه الاتجاه الوسطي المتميز بوسطية الإسلام، تلك الوسطية التي ترى بأنّ هناك تمايزا بين الدين والدولة والرسالة والسياسة، وفي نفس الوقت هناك صلات تربط بين الرسالة والسياسة، وبين الدين والدولة، بروابط المقاصد الشرعية والكلّيات الدينية.
إنّ المراد من كون الإسلام (دين ودولة) هو قبول المرجعية الإسلامية العامة التي تسمح بتعدّد الآراء وتنوعها في الشأن السياسي، كما تسمح بتعدّدها وتنوّعها في كل شأن إسلامي آخر، وبهذا الفهم يتجنّب المسلم المعاصر الوقوع في القول بالفصل التام بين الدين والسياسة، وهو فصل غير صحيح نظريا، وغير واقع عمليا مع فهم أنّ من معاني (الدين) أنّه الشريعة الحاكمة لمعاملات الناس الدنيوية، كما يتجنب الوقوع في وهم أنّ النظام السياسي المقبول إسلاميا هو نظام بعينه، لا يصح الاختلاف حوله ولا الاجتهاد في تفاصيله.
فالمقصد الأسمى للدولة في المجتمع الإسلامي، هو تحقيق مصالح المحكومين وتمكينهم من القيام بواجب الاستخلاف في الأرض، فكل طريق تحقق هذا المقصد يجب سلوكها وكل اجتهاد قديم أو حديث يُقعِد عن تحقيقه، -أي ذلك المقصد- في وقت من الأوقات، ولو كان قد حققه في زمن سابق، يجب العدول عنه ولا يصحّ التمسّك به.
اجتهادية المسألة السياسيّة
إنّ المسألة السياسية كلّها، -أو جلّها- مسألة اجتهادية ظنية، وهي بذلك تقتضي اجتهادا متجدّدا في كل عصر تتحقّق به مصالح أهله، وهو ما يفتح الباب لجواز اختلاف النظم السياسية من قطر إلى قطر، وفي ذلك كلّه رفع لإصر الجمود عن الناس، وتيسير لإعمال أحكام الإسلام الكلّيّة والتفصيلية، غير أنّ الاجتهاد السياسي يبقى منضبطا بالقيم السياسية الإسلامية، والمقاصد الدينية الكلّية، وهذه القيم والمقاصد تعتبر أحكاما ملزمة للحكّام والمحكومين، والفقهاء، والمجتهدين، على السواء، ذلك أنّها كلها محلّ نصوص صريحة في القرآن الكريم والسُنّة النبوية، والالتزام به موضع إجماع على امتداد العصور.
فالوسطية السياسية، تجمع بين ثوابت الدين المرتبطة بالمجال السياسي وعطاءات التجربة الإنسانية؛ أي بين القيم الأساسية للكتاب والسُنّة، وتبقى الوسائل لتنزيل تلك القيم في الواقع مجالا رحبا لاجتهادات الأمة وإبداعاتها، التي تختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى أخرى؛ أي تحقيق "الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر، مع ضرورة مراعاة الثبات في الأهداف والغايات وفي الأصول والكليات، والمرونة والتطور في الوسائل والآليات وفي الفروع والجزئيات"(4) وهذا يقتضي تجاوز كثير من الاجتهادات البشرية في فهم الدين وتنزيله، والتي كانت مرتبطة بظروفها وأعراف زمانها، ومستواها الحضاري، ومن تلك الاجتهادات مسألة حكم التغلب، وتقسيم العالم إلى دار إسلام ودار وحرب، واعتبار غير المسلمين في الدولة أهل ذمة، وإقصاء المرأة من دورها في المشاركة في العمل السياسي، واعتبار تولية المسؤولية أبدية بالنسبة إلى رئيس الدولة، فكلّ هذه المعطيات وغيرها كثير لا يستجيب لمتطلبات وحاجات المجتمع الإسلامي المعاصر. ومن هنا أهمّية الإفادة من منجزات التجارب البشرية، حتى نستطيع تحقيق التفاعل الإيجابي مع مسيرة الفكر الإنساني ونساير تطوّراته.
التعدّدية السياسية واعتماد مبدأ التدرّج في الإصلاح
التعددية السياسية أصل من الأصول التي تسلّم بها المدرسة الوسطية السياسية في الفكر الإسلامي المعاصر، والتعددية تعني في جوهرها التسليم بالاختلاف: التسليم به واقعا لا يسع عاقلا إنكاره، والتسليم به حقا للمختلفين لا يملك أحد أو سلطة حرمانهم منه وقد تكون هذه التعددية سياسية أو اقتصادية أو دينية أو عرقية أو لغوية أو ثقافية أو غير ذلك. وإنّ التسليم بالتعددية البشرية تبعا للتسليم بحق الاختلاف يقود بغير جهد كبير، إلى التسليم بحق التعددية في المذهب السياسي.
من معالم الوسطية السياسية أيضا اعتماد مبدأ التدرج في عملية الإصلاح والتغيير السياسيين، مع ضرورة الانطلاق من قاعدة المجتمع، بالرفق واللين واليسر، وذلك لأنّ الأصل في هذه الدعوة "أنها تتّجه للإنسان لتخلق منه بالعقيدة إنسانا جديدا، فتحرّر طاقاته وتدفعها نحو عمارة الأرض وإصلاحها، فتندفع هذه الطاقات لبناء قيم الإسلام وأنظمته في الأرض، إنّها تتوجه إلى النفس الإنسانية، فتغيّرها من أعماقها وتطلقها من عقالاتها، فتنشأ بذلك عندها فسحة في القيم والموازين، ورحابة في المدارك والتصوّرات، وهنا نفهم أصالة ذلك التغيير الذي يحدثه الإسلام في مجرى التاريخ، تلك الأصالة التي تتجلى في استمرار إشعاع العطاء الإسلامي: فهو عطاء مستمر، (...) إنّ هذا الإشعاع المستمر بمثل هذا العمق والاتساع ما كان ليحدث لو أنّ طبيعة التغيير الذي أحدثه الرسول بالإسلام في حياة الأمة كان ناتجا، عن مجرّد انقلاب سياسي."(5)
كانت هذه بعض المعالم التي تتسم بها الوسطية السياسية الإسلامية، على أنّه لا تزال هناك معالم أخرى كثيرة، تحتاج أن يعمل الفكر السياسي الإسلامي المعاصر على اكتشافها واستجلاء عناصرها، خصوصا تلك المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، والحريات الفردية، ودور المرأة السياسي، والعلاقة بالآخر، وتنظيم العلاقات الدولية، وتدبير التعددية السياسية... إلخ.
بيد أنّ منهج الوسطية لا يقف عند حدود التأسيس الفكري والنظري، بل إنّ له دورا كبيرا على صعيد محاربة فكر التطرّف، ومحاصرة التشدّد السياسي، وهو الأمر الذي سنعمل على رصده من خلال الحديث عن دور الوسطية وأهميتها في استيعاب فكر الغلوّ والتطرّف.
ثانيا: دور منهج الوسطية في استيعاب فكر الغلوّ والتطرّف
إذا كان الغلوّ هو الإفراط ومجاوزة الحدّ، والتشدد في الدين، فإن له مظاهر وتجليات ومجالات متعددة، غير أنّ ما يهمنا هنا هو الوجه السياسي لهذا الغلوّ، ويتمثل في إلزام الناس باختيارات سياسية معينة، أو بنموذج للحكم يُتّخَذ منه شريعة وفريضة دينية، فتتعطل دونه كل المقاصد والمصالح، وتتحول الوسائل إلى أهداف، وتتحول الفروع إلى أصول، وهكذا يقع الناس في الحرج والعنت، اللذيْن ما جاءت هذه الشريعة إلى لترفعهما عن هذه الأمّة.
بناء على ذلك، فإنّ البديل الأمثل الذي بإمكانه أن يجنّب العقل المسلم الوقوع في نزعات الغلوّ والتطرّف، هو الفكر الوسطي والمنهجية الوسطية، لأنّ بإمكانهما توفير الحل المنهجي والمعرفي الكفيل بإعادة التوازن إلى شخصية الإنسان المسلم.
إشكالية سحب المفاهيم الدينية على الحقل السياسي
إنّ الإشكالية الأساسية هنا هي أنّ المفاهيم الدينية، يتم سحبها على المجال السياسي، مما يفقد الفعل السياسي استقلاليته، ويحوّله من مجال للتدافع السياسي، القائم على رعاية المصلحة والحكمة والتدبير، والعدل وقابل لتعددية الاجتهادات والآراء، إلى مجال للحلال والحرام، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، مما يتعذّر معه إمكان قيام فعل سياسي حقيقي، له قواعده وضوابطه المتميزة والخاصة به. خصوصا حينما تتخذ تلك المفاهيم الدينية والعقدية في جوهرها طابعا سياسيا، حيث تكون لهذا الأمر انعكاساته الخطيرة والمباشرة على مجالي الحقوق والواجبات. وكذلك على مستوى المفاهيم، حيث يصبح كل اختلاف سياسي فتنة، وكل معارضة للحكّام معصية، وكل انقياد لهم طاعة مأجورة.
بمعنى أنّ استدعاء النص الديني وتوظيفه في الصراعات التي- هي في جوهرها- صراعات سياسية دنيوية، يفضي بالضرورة إلى حالة الانغلاق والتشدد والغلوّ، ولقد كان لتجربة الصراع بين الفرق الإسلامية حول مسألة الحكم والخلافة، وما أدت إليه من حروب وصراعات وانقسامات، لا تزال ترخي بظلالها على واقع الأمة المسلمة حتى اللحظة الراهنة، كانت أكبر شاهد على هذا التوظيف، حيث فشلت تلك الفرق في تدبير الصراع السياسي بالطرق السلمية، واستمر هذا الفشل مخيّما على واقع الأمة حتى اللحظة الراهنة.
فالمتأمل في تاريخ المسلمين، على المستوى السياسي يلحظ بما لا يدع مجالا للشك، أنّ أشكال تدبير الصراعات السياسية، كانت في معظمها تنزع نحو استخدام العنف كحل وحيد لحل أي خلاف واقع أو متوقع بين مختلف الفرقاء السياسيين، وليس مرد ذلك - بحسب ما نعتقد- إلى النص الديني المؤسس، وإنما إلى واقع الصراعات السياسية. التي كانت تقوم في معظمها على حساب مصلحة الأمة لصالح أهداف وحسابات شخصية وفئوية ضيقة؛ أي أنّ الأمر يرتدّ بالنهاية إلى كيفية فهم تلك النصوص والتعامل معها تعاملا علميا معرفيا، بعيدا عن مطبات الغطاء الأيديولوجي القائم على التعصب والتحيز.
فالأيديولوجيا بطبيعتها متحيزة، وتمثل نظرة ضيقة، وتخدم فئة معينة، على حساب فئات أخرى، كما أنها تنطلق من أحكام مسبقة، وتصورات جاهزة، وتبنى على مواقف من السلطة، سواء معها أو ضدها، وذلك بحسب موقع أصحابها من السلطة وموقفهم منها، وعندما يلجأ أصحابها إلى الدين فهم يتخذونه كأداة لخدمة تلك الأيديولوجيا من أجل تحقيق أهدافهم.
التعددية السياسية أصل من الأصول التي تسلّم بها المدرسة الوسطية السياسية في الفكر الإسلامي المعاصر، والتعددية تعني في جوهرها التسليم بالاختلاف
في الموقف من الديمقراطية
يمكن أن نضرب مثالا على ما قلناه، مسألة الموقف من الديمقراطية، فقد وجدنا عددا من التيارات السياسية الإسلامية، تعتبر الديمقراطية نظام كفر وأنّها ضد الدين، كما تحرّم المشاركة السياسية، والدخول في البرلمان، وهكذا تم وضع الديمقراطية في مقابل الإسلام، بدل أن تكون في مقابل الاستبداد، مما ترتّب عليه قبول الاستبداد والتبرير لمنطقه القائم على الحكم الفردي المطلق.
والحقيقة أنّ الديمقراطية، كانت طرحا سياسيا لا علاقة له بالدين، طرحا يكفل مشاركة الأفراد في حكم بلادهم، وتدبير مصالحهم، فهل يكون التخلص من ظلم الحكّام وتحكمهم بالناس ضد الدين !؟ وهل يجب رفض الدخول في تمثيلية البرلمان، فقط لأنه لم يأت بها الإسلام !؟ أليست الهيئات التشريعية والتمثيلية التي يختارها الناس وكلاء عنهم، أشبه بأهل الحلّ والعقد !؟
وعليه، فإنّ الزعم بأنّ الديمقراطية نظام كفر أو أنها تشكل تهديدا لهوية الأمة، وخصوصيتها، ليس له ما يبرره، لأنّ الديمقراطية حينما تطبق على مواطنين مسلمين حقا، وعلى شعوب مسلمة حقا، لا يمكن أن تنتج إلا مزيدا من تطبيق الإسلام وتعزيز قيمه وأحكامه، وهذا طبعا إذا طبقت الديمقراطية الحقيقة وأعطيت الحرية الحقيقية، وبالتالي فإنّ الخوف من الديمقراطية مجرّد وهم، لأنّ الديمقراطية ليس لها دين، وليست ضدّ أي دين، وحينما تطبّق في وسط إسلامي تصبح أفضل تعبير عن إسلاميته ومن أقوى السبل لتعزيز إسلاميته.
جدلية النص والعقل والواقع
لقد عجز العقل المسلم عن إيجاد صيغة إسلامية واقعية وسلمية، تكون قاعدة أساسية لتدبير الاختلاف بين مكونات الأمة الواحدة، بشكل سلمي وحضاري، إذ "لم تتحوّل عندنا قيمة الاختلاف التكويني: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾(6) إلى قيمة كونية إنسانية عامة، وعجزنا حتى عن تطويرها إلى قيمة إسلامية خاصة، لم تعبر فضاء القيمة لتكون مبدأ حياة، ولم نوجِد آلية حماية لنظام الاختلاف، ورعايته باعتباره أداة تطور المجتمعات ونموّها، لا آلية تدميرها وتفتيت وحدتها"(7).
وقد يقول قائل: إنّ الإسلام قد وضع المبادئ والقواعد والآليات، التي تضمن السلم الداخلي، وتؤسس لتدبير عقلاني وسلمي لأيّ خلاف أو نزاع، وذلك مثل الشورى، والعدل، والحرية، والتسامح والمساواة (...) وأنّ المشكل إنما يكمن في التطبيق، وفي درجة الالتزام بتلك المبادئ والقواعد، والآليات.
إنّ هذا الطرح، يبدو وجيها ومنطقيا، للوهلة الأولى لكننا نرى الأمر أعمق من ذلك، فالشورى مثلا قبل أن تكون آلية، فهي قيمة، وثقافة، وبالتالي فإنّ المشكل مشكل بنيوي يوجد في الفكر والثقافة وأنظمة المعرفة، وفي البنية الاجتماعية وكذلك في الممارسة، إذ أنّه "ما لم تكن البنية المجتمعية الشاملة، والبيئة الاجتماعية الحضارية العامة، تسمح بالتسامح، وتشجع عليه، وتعتبره، وظيفة من وظائفها الأساسية، وتقليدا متعارفا عليه من تقاليدها الراسخة في التعامل وإدارة العلاقات بين الأفراد والجماعات، فإنّه لا يمكن أن يتحول إلى واقع وإلى تطبيق بالممارسة، فإنه ما لم تتلاءم حقائق الواقع المجتمعي، والعلاقات الأساسية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية مع هذه القيم، فإنّ النتيجة لن تكون غير تعميق الازدواج، والتناقض في الشخصية الفردية والجماعية بين المثل المعلنة من ناحية، والسلوك العملي الظاهر، والخفي من ناحية أخرى"(8)
فالمسألة إذن ليست بتلك البساطة التي يظنها البعض، لأنّ عملية التمثّل للقيم والمبادئ على مستوى الواقع والممارسة، لا تتم بشكل ميكانيكي أو آلي، بل لابدّ من شروط قبلية وبعدية، لابدّ من قنوات وسياقات ومناخات، تعزز تلك القيم وتسمح بعبورها من مجال المثل إلى مجال الواقع.
وإنّ نظرتنا للأفكار، لا ينبغي أن تكون نظرة ثابتة، أو جامدة، بل ينبغي النظر إليها في حركيّتها، وسيرورتها، وتفاعلها، وجدليتها مع النص والعقل والواقع، مع تحديد سياقاتها الاجتماعية التاريخية التي نتجت في إطارها؛ فالأفكار حينما تتلبس بالواقع تصبح مفتوحة على كل الاحتمالات؛ ذلك أنّ التعامل مع الواقع، هو غير التعامل مع الأفكار، لأنّ عالم الأفكار عالم النظريات، ما إن يتحرّك في الواقع، ويدخل في عملية التطبيق، حتّى يصطدم بالكثير من المصالح، وبالكثير من التحديات، التي قد تنحرف به عن مساره الطبيعي الأوّل.
ومن هنا تنبع ضرورة المنهج الوسطي، على اعتبار أنّه منهج عملي متكامل، ينطلق من رؤية فكرية مؤسّسة على جدلية العلاقة القائمة بين النص والعقل والواقع، التي تشكّل مدخلا منهجيا مهما، لإعادة تشكيل العقل المسلم، بما يخدم مقتضيات التجدّد الحضاري، وبما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تفرض على الأمّة، ذلك أنّ أيّ سوء في ترتيب هذه العلاقة يؤدي بالضرورة إلى خلل على مستوى الوعي المنهجي، حيث تكون له نتائج سلبية على صعيد الفكر والتطبيق معا.
فتغليب النصّ يؤدّي إلى نزعة ظاهرية ونصية، وتغليب العقل يؤدّي على نزعة عقلية علموية، وتغليب الواقع إلى نزعة واقعية مادية، لذلك فإنّ إعادة النظر في مكوّنات هذه العلاقة وترتيبها ترتيبا صحيحا، ينسجم مع مقتضيات العقل الراشد، والتفكير الصائب، هو وحده الكفيل بإعادة الفاعلية للعقل المسلم.
فهذه الرؤية الجدلية هي رؤية تتّجه إلى تأسيس المجتمع الكوني (الأمّة الإسلامية) المتناقض جذريا مع الاستقطاب السياسي والحضاري المبني على الانغلاق على الذات ونفي الآخر. إنّها رؤية مبنيّة على التكامل المعرفي، حيث تلغي الثنائية الحضارية (شرق / غرب) وتركز على التفاعل بين الحضارات والأعراق لتأسيس مجتمع الوحدة الحضارية الكونية (الأمّة). إنّها رؤية إسلامية رسالية تعيد الاعتبار لدور الإنسان وقيمة الأخلاق خصوصا في ظل طغيان الفلسفة المادية، وتزايد الهوة بين تطور العلم وتأخر الضمير، وهي كذلك رؤية مرتبطة بمشروع حضاري إنساني خالد، لأنّها تستمد عطائها من قيم الوحي.
كانت هذه بعض المعالم التي ارتأينا أنّها تؤسس لمنهج الوسطية السياسية، بوصفه منهجا معتدلا، متوازنا، له من الخصائص والمقوّمات، ما يؤهّله لحل إشكالية الغلوّ والتطرّف التي تهمين داخل المجتمعات المسلمة.
بناء على ما تقدم، فإنّ أهمّ خلاصة يمكن الخروج بها هي أنّ المشكلة ليست في الاختلاف بقدر ما هي في تدبير هذا الاختلاف، بشكل حضاري وسلمي. ولا يمكن حصول هذا الفهم إلاّ بالاسترشاد بمنهج الوسطية السياسية، الذي يبقى منهجا منفتحا ومستوعبا لا يعتبر الديمقراطية نظام كفر، ولا يلغي التعددية السياسية، ولا يحرّم المشاركة السياسية، ولا يجعل من التدافع السياسي وسيلة للفرقة والتشرذم، وبالتالي فهو منهج ذو طبيعة تقبل التعدد والاختلاف في الآراء والمواقف والاختيارات، والاجتهادات، مادام الأمر يتعلّق بدائرة الفروع الفقهية السياسية، التي تظل خاضعة للتطور والتغير، بحسب متطلّبات الأمّة في التطوير والتحديث، وبحسب ما يفرض الواقع من رهانات وتحدّيات.
(1) يتيم، محمد: الوسطية والاعتدال، منشورات حركة التوحيد والإصلاح الرباط- المغرب. ص 68
(2) المرجع نفسه: ص 69
(3) ينظر: العوا، محمد سليم: الوسطية السياسية، سلسلة الأمة الوسط (11) منشورات المركز العالمي للوسطية، الكويت، الطبعة الأولى 1428ھ-2007م.
(4) القرضاوي يوسف: كلمات في الوسطية ومعالمها، دار الشروق القاهرة، الطبعة الثالثة 2011م. ص 58
(5) يتيم، محمد: العمل الإسلامي والاختيار الحضاري، منشورات حركة الإصلاح والتجديد، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 1417ھ-1996م. ص ص 36-37
(6) سورة هود: الآية 118
(7) جاسم، سلطان: أزمة التنظيمات الإسلامية، الإخوان نموذجا، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 2015م. ص 54
(8) الأنصاري، محمد جابر: العرب والسياسة أين الخلل؟ جذر العطل العميق، دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1998، ص 157






