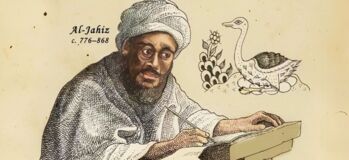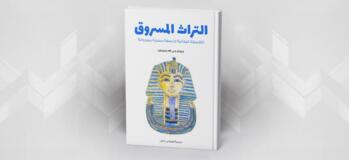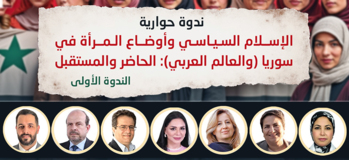مفهوم "إعادة تأهيل التراث والسلطة" عند هانز جورج غادامير مدخلاً للحوار مع مشروع المستشار عبد الجواد ياسين
فئة : مقالات

مفهوم "إعادة تأهيل التراث والسلطة" عند هانز جورج غادامير
مدخلاً للحوار مع مشروع المستشار عبد الجواد ياسين[1]
كانت الأدوات النقدية لقراءة التراث تدخل ضمن اهتمامات خالي جودت سعيد، المفكر السوري، (رحمه الله)، والذي من أحد مؤلفاته كتاب مذهب ابن آدم الأول: مشكلة العنف في العمل الإسلامي، حيث كان يقول إن الشباب إذا دخلوا إلى التراث بدون أن يكونوا مزودين بأدوات نقدية، فإنها أرض ملغومة وقد تنفجر بهم، وهي قد انفجرت بهم في سياقات عديدة كما رأينا وما زلنا نرى. كان خالي يقول هذا بسبب اهتمامه بإشكالية المسارعة لحمل السلاح لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة المعاصرة، ولاختلاط مواضيع متعددة على الكثير من الشباب المتدين بدافع من الإخلاص فيهم كما كان المفكر الجزائري مالك بن نبي يقول ولكن أيضا بطرائق تجنبهم الصواب في العمل؛ لأن مالك بن نبي كان يرى أن أي عمل ناجح يحتاج إلى شرطيْ الإخلاص والصواب، وكان يرى أن الإخلاص متوفر بكميات هائلة في قلوب الشبيبة الشغوفة، ولكن كان يحث على رفع درجات الصواب في تضاريسنا الفكرية.
لقد عاد إلى ذهني اهتمام خالي بالأدوات المناسبة لقراءة التراث ولأفكار مالك بن نبي، لما بدأت بالدخول لقراءة مشروع المستشار عبد الجواد ياسين؛ فهو يقوم بتزويدنا بأدوات نقدية مهمة للتنقل في تضاريس التراث الإسلامي، ويساعدنا في فهم الكثير من الجذور التاريخية لأزماتنا المعاصرة. ومن هذا، فإن مشروعه مهمٌّ جدا للمهتمين في الأبحاث الإسلامية والدراسات الدينية؛ (لأنه يمكن تطبيق العديد من المداخل التي يطرحها في مشروعه ليس فقط على التراث الإسلامي، بل على العديد من الأديان الأخرى كما يفعل هو أيضا في بعض السياقات في كتبه. وخاصة عندما ينظر إلى تطور مفاهيم الدين والتدين في الأديان التوحيدية ومحطاتها التاريخية)، وهو يستفيد ويستعير من العديد من الباحثين الغربيين في إعادة قراءة التراث الإسلامي، ولهذا مشروعه جدير بأن يدخل ضمن القراءات التي تساعد القراء والقارئات العرب في توسيع آفاقهم في الدراسات الدينية المعاصرة من زاوية نظرية، ولكنها تقدم أيضا من ناحية عملية بعضا من الأدوات التي قد تسهم في إنقاذ الشباب من المتاهات المتطرفة والتورطات العسكرية بسبب قراءتهم للتراث من زوايا أيديولوجية محدودة. ولذا، فإنها قد تنقذ حيوات كثيرة.
تكمن أهمية مشروع المستشار عبد الجواد ياسين في كونه يطرح نقدا مفصليا مهمًّا في هذه اللحظة التاريخية الحرجة في المجتمعات المسلمة؛ فهو يعيد فتح باب الحوار مع ذواتنا ومع وتاريخنا. بعد الاطلاع على بعض الجوانب من مشروعه الذي أسسه عبر سنوات طويلة في عمل مضن وتقصيات تاريخية دقيقة شعرت أن من المفاهيم التي يمكن أن تساهم في تقييم هذا المشروع الكبير والمهم، وأيضا من زاوية نقدية قد تكون مساعدة في تطوير المشروع ودفعه نحو حوارات جديدة، هو المفهوم الذي طرحه الفيلسوف الألماني هانز جورج غادامير، عندما تقدم بعبارة "إعادة تأهيل التراث والسلطة"؛ لأن ما يقدمه المستشار ياسين هو ليس قطيعة مع التراث ولا تقديسا له، كما نلاحظ في بعض من عباراته القليلة هنا وهناك، بل هي حالة حوارية، تتضمن أبعاداً نقديه وأيضا أبعاداً شفائية. ولهذا، يمكن القول إن ياسين يقدم زوايا نقدية جديدة، ولكن فيها زوايا تفتح المجال أيضا لإعادة تأهيل تراثنا وإعادة تقييم تاُثير السلطة وعلاقات القوة في تشكل التراكم المعرفي في المجتمعات المسلمة، حتى نتمكن من خوض لحظتنا التاريخية بشكل أفضل، ونكون أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات اللحظة الراهنة. ويقوم ياسين بدور حيوي وفعال في تقديم قراءة نقدية لتشكًل التراث الإسلامي، وبالأخص تفاصيل بعض تراكمات المنظومة الفقهية التشريعية، بسبب تخصصه القانوني وخلفيته وخبرته العملية في هذا المجال.
هناك عدد من العناصر التي تعطي مشروع ياسين زخما لإعادة فتح الحوار مع تراثنا وتاريخ تشكل هويتنا المتدينة. أولا، ينظر إلى الطرائق التي تمت بها إحاطة المصادر المعرفية الإسلامية بهالة من القدسية. وثانيا يعود لسبر تضاريس هذه التواريخ وتفحص الجهود والتقنيات التي تم استخدامها لإسباغ هذه القدسية من خلال تقصي الزوايا التي تدخلت منها المصالح السياسية والسلطة في إسباغ التثبيت والقدسية على هذه المعارف البشرية.
ولكن رغم عمق الطرح التاريخي الذي يقدمه لنا ياسين، وبنسبة ما صعوبة لغته على غير الأكاديميين، فإنه من المهم إدخال مشروعه وأدواته النقدية إلى الحوار الثقافي الأكبر وتقريبه وتبسيطه إلى شريحة أوسع من القراء والقارئات؛ لأن ياسين قادر أن يحرر العديد من السياقات التي تم اختطافها وأسرها داخل سرديات مجردة، وكأنها أحداث خارج حركة التاريخ؛ فهو يوضح ضمن ما يقدمه ليس فقط جمع الحديث، بل أيضا كيف تم اختطاف النص القرآني داخل خطاب أغلق أبعادًا عديدة في النص. ويشرح ياسين هذا من خلال تحليل الكيفية التي حول الخطاب الديني ظروفا تاريخية محلية إلى أحكام قطعية مطلقة عبر الزمان والمكان، بينما أغلق أحكاما قطعية إنسانية واعتبرها في حكم المنسوخ.
يمكن القول إذن، إن عبارة "الإسلام صالح لكل زمان ومكان" من وجهة نظر ياسين، قد تم الانقلاب عليها لصالح عبارة أن عادات العرب وظروفهم صالحة لكل زمان ومكان؛ لأن الإسلام لم يكن صالحا لهم.
من الإشكاليات المفصلية التي يطرحها مشروع ياسين في هذا الانقلاب من الأخلاقي الإنساني العام في الإسلام إلى الظرفي الفقهي المحلي هو ثلاث غيبات (أو غيبوبات):
أولا، غياب مفهوم الواقع كأحد المداخل التي تشكل العملية التشريعية والتفاعل معه كما كان يحدث في زمن الرسول والصحابة.
ثانيا، غياب أو تغييب الفهم الأخلاقي الأوسع، والذي يحض على قيم إنسانية عليا مجردة ومطلقة لتكون سارية في الزمان والمكان مثل العدل والرحمة وقيمة التراضي الجمعي.
ثالثا، غياب الوعي التاريخي المدرك للتطور الاجتماعي والتحولات والتغيرات التي تحدث في المجتمع أو الحركة التاريخية التي يعيش في مضمارها الوعي البشري.
على الرغم من أن المشروع بشكل عام قد يبدو عودة لفهم الماضي، ولكن ينطوي في مضامينه الفكرية على وعي أخلاقي لاستعادة المفاهيم الإنسانية التي تضيء الأفق الأخلاقي عند المسلمين أو كما يضعها هو في البعد الديني المطلق والمجرد (أي الدين لذاته).
لا يقدم مشروع ياسين مفهوما مناقضا أو نافيا للدين، كما يقول هو في أكثر من موضع في كتاباته، بل بالعكس يحاول جاهدا إحياء ما هو فعلا ضمن المقدس الذي هو سار لكل زمان ومكان، وأيضا المرونة في عدم الالتزام بما هو آني وظرفي. ولهذا يقوم ولو بشكل غير مباشر بإعادة تسليط الضوء على القيم المطلقة العابرة للزمان والمكان لإعادة إدخالها في الوعي الجمعي بشكل يسهم في استعادة موقف أخلاقي تجاه الذات الآخر، وليخلق قدرة على التعامل مع الحاضر والتحرك نحو المستقبل.
ولهذا، فإن مشروع المستشار ياسين لا يقدم فقط قراءة نقدية للتراث وإظهار علاقة المصالح البشرية والسياسية والعسكرية في صياغة الفقه الإسلامي، ولكن أيضا يُظهر لنا مفصلية خطيرة، ألا وهي كيف تم تضييق المعاني القرآنية المطلقة والمفتوحة بأشياء آنية ومصالح عابرة. ويظهر هذا تماما في تعاطيه مع عدة قضايا فقهية، عندما يقوم بسبرها بشكل دقيق بتقصي عدد من "التقنيات الفقهية" كما يسميها في عملية التضييق على البعد الأخلاقي والإيماني الأوسع في القرآن، وأيضا في تشكل الحديث والمعارف الإسلامية الأخرى.
وبشكل مختلف عن توجهات ما يمكن أن تُسمى بـ"الحركة القرآنية"، فإن ما يقوم به ياسين هو ليس عودة للنص القرآني الصرف لتقديم البديل، أو نقد الحديث أو محاولة إلغائه لتقديم النص القرآني، كما يحدث في بعض التوجهات الحالية في أوساط ما يعرف بالقرآنيين. وإنما يقوم ياسين بقراءة نقدية للتراكم المعرفي الإسلامي وآليات تداخل الديني بالاجتماعي في تكون كل المصادر المعرفية في التاريخ الإسلامي. ولهذا يصر أيضا أن كلامه لا يعني "إن الحديث كان اختراعا محضا أو أنه "شكل" ديني لمادة دنيوية خالصة،" كما يقول في نهاية كتابه الدين والتدين، "بل يعني أن الحديث كان عملية "تدين" تداخل فيها الاجتماعي بالديني... ومؤدى ذلك أن ثمة من الأحاديث واضح نسبته إلى الرسول، وأن مضمون هذه الأحاديث كان معروفا ومستخدما قبل تدوين الروايات من خلال كونه جزءا من النظام العرفي الذي جرى عليه العمل." (الدين والتدين: 461)
لماذا يفيدنا مفهوم غادامير "إعادة تأهيل التراث والسلطة" للدخول لمشروع ياسين؟
بعد الاطلاع على مشروع المستشار عبد الجواد ياسين، وجدت نفسي أفكر بمشروع غادامير، وخاصة أنه دعا إلى موقف متميز في إعادة الحوار مع التراث والسلطة. فقد اتخذ غادامير موقعا خاصا ما بين الحداثة التي عملت قطيعة مع التراث كما يقول غادامير بنفسه، وبين موقف ما بعد الحداثة الذي رفض أي ثبات لقيم غير زمانية أو لفكر يحاول مقاربة الحق والحقيقة؛ أي يمكن القول إن غادامير تموضع ما بين منزلتين؛ عندما اتخذ طريقا ثالثا بين قطبي الحداثة وما بعد الحداثة، فهو أعاد نقد منهجية الحداثة في الدراسات الدينية وتأويل النص كما تمثل في نظرة المفكر واللاهوتي الألماني فريدرك شلايرماخر، وأيضا ما تلاها مما يٌعرف بمنهجية "نقد المصادر الدينية." وتتلخص هذه المنهجية حسب غادامير في البحث عن الأصول التاريخية للنصوص المقدسة بدل التمعن في المحتوى الذي تقدمه، مرورا بمناهج الدراسات الدينية الاجتماعية التي تضع المادة الدينية كشيء يتم فحصه كأثر تاريخي بدل التفاعل معه. وطبعا وصولا إلى ما بعد الحداثة كما في موقف دريدا وزعزعة المعنى كليا ومدرسته في التفكيك، والذي ظهر اختلافه جليا مع غادامير في مناظرتهما التاريخية الشهيرة في جامعة السوربون في عام 1981.
فكما فعل المستشار ياسين بتقديم موقف أخلاقي يساعد على استعادة وإحياء مفاهيم تم تصغيرها أو إهمالها بدون نبذ الظاهرة الدينية، يتساءل غادامير أيضا عن أهمية قيم تكمن في التراث قادرة على إلهامنا بمفاهيم جديدة، أو مفاهيم لم يتسنّ لها الإثمار. ويسأل غادامير في مقدمته في كتابه، "الحقيقة والمنهج: الخطوط الأولية لتأويلية فلسفية،" هل من المحتم أن يضع المفكر المعاصر نفسه (أو نفسها) في موقع أخلاقي فوقي تجاه الصوت القادم من الماضي؟ وهل يمكن الادعاء بأنه لا يمكن أن نتعلم شيئا ذا قيمة عليا من الماضي بشكل يعلو فوق ما عندنا حاليا؟ يقدم غادامير هذه التساؤلات في بدء كتابه؛ لأنه يريد أيضا تجاوز ما سماه بـ"غطرسة الحاضر"؛ أي الموقف المتعالي تجاه الماضي. فالحوار في نظر غادامير هو دائما موقف أخلاقي يتطلب حالة ما يمكن أن نسميه بـ"أفقية الحوار"؛ أي تفاعل بدون تعال، وأيضا بدون انبطاح أمام صوت الماضي. ولذلك، يرى غادامير أن الانفتاح الحقيقي يحدث بتوسيع الآفاق مع الآخر المختلف والمفارق زمانيا وثقافيا، وأن أي مضمون مختلف مكانيا أو زمانيا يقدم بالضرورة مطالب أخلاقية تتطلب الدخول في حوار صادق. أراد غادامير بهذا تجاوز الهوس في نقد المصادر التاريخية التي علقت عندها اللحظة الحداثية والدخول في إعادة أهمية المضمون عند تلقي صوت الآخر أو ما سماه بالألمانية "زي زاخه" the subject matter أي المضمون الذي يقدمه الصوت القادم من الماضي أو من الحاضر ولكن من ثقافة مغايرة؛ لأنه بالنسبة إلى غادامير، الماضي هو نوع من "المفارقة الغيرية" a form of otherness. ولهذا أراد أن يكون حذرا تجاه إبعاد صوت الماضي كما نفعل بالآخر المختلف ثقافيا؛ فهو أراد أن يعيد إدخال عناصر جديدة في الحوار مع التراث بإعادة القيمة للمضمون بشكل يمكننا من الاستفادة من النقد التاريخي، ولكن بدون أن نفقد إمكانية إيجاد كنوز في التراث كما وصفتها المفكرة هانا آرنت، عندما تحدثت عن أهمية المعرفة التاريخية.
لقد بنى غادامير فكرته على مدرستي هسلر وهايدغر، ولكن فعليا تجاوزهما أيضا ليحدث انقلابا في فهمنا للفهم، وفي فهمنا للتأويل والحوار. فالنسبة إليه، نحن مخلوقات تأويلية تعيش في حالة متواصلة من تأويل ما يجري حولنا، ولهذا أصر غادامير أننا لا ندخل حوارا، وإنما نحن أنفسنا مخلوقات حوارية كما نجد حالنا في بعدنا الإنساني الوجودي؛ أي إننا متأثرون ومؤثرون. ولهذا لم يكن من السهل ترجمه مفهومه عن "الوعي المتأثر تاريخيا"؛ لأنه مفهوم يحمل ليس فقط الوعي الذي يتأثر بفعل التاريخ، وإنما كما يصبو عبد الجواد ياسين أيضا هو وعي مدرك لتموضعه التاريخي، وبالتالي وعي يعي لدرجة ما بقدرته على التأثير، وليس فقط التأثر التاريخي. وهذا الوعي الذي يدرك التأثر والتأثير التاريخي يدخلنا في هامش أكبر من النقد الذاتي، وليس فقط نقد المصادر التاريخية، حسب غادامير؛ لأنه وعي يدرك محدودية ذواتنا الواعية. وهذا عكس موقف الحداثة الذي ينتقده غادامير، عندما ينتقد التراث بدون النظر للذات الناقدة. ولهذا، فإن دعوة غادامير لإدراك محدوديتنا نجد تجلّيا له في الإبستمولوجيا الإسلامية، كما مهد لها العلماء المسلمون في الحالة القاصرة أمام علم الله بإصرارهم التاريخي على قول "والله أعلم" في نهايات نصوصهم. هذا الإدراك بأننا مخلوقات تاريخية، وبأننا مخلوقات بفهم محدود، يقول غادامير يساعدنا على شيء من اليقظة، ولو نسبيا. فبقدر ما نعي محدوديتنا المعرفية والزمانية بقدر ما نتمكن من رؤية هوامش نقدية تجاه الذات والآخر بشكل لا نعلو فيه على الآخر وأيضا بشكل لا تنحسر ذواتنا فيه أمام الآخر؛ أي إننا دائما داخل افق زماني وفي سياق فكري متحرك مع المختلف زمانيا أو جغرافيا. ولهذا لا يمكن ادعاء الحقيقة الكلية، وإنما التوجه نحوها. وبالتالي لم يستبعد غادامير مفهوم الحقيقة، ولكن لم يدّع الوصول إليها أيضا.
ولذلك يرى غادامير أن القراءة هي أيضا حدث متحرك، حدث أنطولوجي يتم فيه ما يسميه آلية "انصهار للآفاق"؛ أي يندمج أفق القارئ أو القارئة مع أفق النص، وهذا حدث متحرك حتى مع الشخص نفسه أو نفسها؛ لأن الفهم والتأويل يظل في حالة تغير حتى مع ثبات النص. ومع انصهار واندماج الآفاق يتصاعد المعنى ويحدث لنا الفهم، والذي بحد ذاته حدث أنطولوجي؛ أي حدث له عواقبه، وبالتالي حدث فيه إمكانية خلق توجهات جديدة. ولذلك، فإن كل قراءة هي بالنسبة إلى غادامير حدث جديد يتصاعد داخل سياق تفاعلي بين أفق المتلقي وأفق النص أو الواقع الذي يتفاعل معه، (ولهذا يقول غادامير إننا نستعمل مجازات مثل قراءة الواقع؛ لأنه أيضا تفاعل بين أفقين). فعند غادامير الفهم ليس شيئا نود "القيام" به، بل شيء "يحدث" لنا في حالة التفاعل.
ولهذا يمثل موقف غادامير نقلة نوعية في تاريخ التأويل، حيث تجاوز الوقوف عند محاولة فهم الظروف التاريخية للمصادر الدينية كما تمثلت عند شلايرماخر وآخرين أو النقد التاريخي، والذي ظل مسيطرا إلى وقت قريب على مفهوم دراسة الدين كظاهرة تاريخية اجتماعية يمكن دراستها من موقع علمي منهجي. وهذا موقف يفقدنا الكثير من مضامين الدين كما يوضحها ياسين أيضا في مشروعه، ولا يمكننا من فهم الدين إلا بتجلياته الاجتماعية الضيقة، ويفقدنا الكثير من الفهم للدين من حيث ذاته؛ لأن الدين بالنسبة إلى غادامير وياسين فيه أبعاد تقدم معاني مطلقة قادرة على توليد فهم جديد ومتواصل، وكلاهما استعملا أمثلة واضحة. فكما أن ياسين يركز على إعادة إحياء مفهوم "لا إكراه في الدين" أو مفهوم "الرحمة" في القرآن، نجد في حالة غادامير أنه يريد إعادة إحياء المفهوم السقراطي للحوار، وأيضا إعادة احياء المفهوم اليوناني فرونيسيس (الحكمة العملية) التي تتطلب معرفة مسبقة، ولكن أيضا هي حكمة واستقلال أخلاقي يمكننا من اتخاد قرارات قد لا تكون بالضرورة مشابهة لما تعلمناه وتلقيناه سابقا؛ أي القدرة على الاجتهاد والتصرف الأخلاقي في سياقات جديدة.
ولهذا رأى غادامير أنه في أي قراءة لنص قديم (أو الصوت القادم من الماضي كما يسميه) أو حوار مع شخص حي، مختلف آخر، فإننا محكومون بموقف أخلاقي لا يمكن التنصل منه؛ لأن التفاعل الإنساني مع الآخر أو حتى في تفاعلنا مع البيئة أو أي من مظاهر الطبيعة في بالضرورة هناك دائما التقاء بالآخر. وكما أنه سيكون موقفنا لا أخلاقيا، إن أشحنا بوجهنا عن شخص يتحدث إلينا كذلك يرى غادامير عدم التفاعل مع محتوى النص الذي نقرأه (وفقط النظر لظروف تشكله التاريخية) نوعا من الفوقية أو نوعا من المنهجية الوصائية التي تتوهم الحياد والموضوعية من طرفنا فقط، لكوننا نتعامل مع شيء نصفه بالقديم أو التاريخي. فمثلا يقول غادامير لو أننا نظرنا فقط إلى الظروف السياسية والاقتصادية في زمن سقراط وأفلاطون، فإننا نحد فهمنا وقدرتنا على التفاعل مع النص إن لم نقبل تلقي الصوت القادم من نص المحاورات نفسها أيضا. وفي هذه الحالة، يرى غادامير أن التمسك فقط بالنقدية التاريخية تنتهك الآخر من خلال هذه الوصائية الزمانية، وأن أي نوع من الاستعلاء ينتهك شروط الحوار الصادق. وهذا الذي قام غادامير بتوضيحه ليورغين هابرماز في حوارهما الشهير، حين أظهر غادامير إشكالية مفهوم المثقف كطبيب يعالج المجتمع المريض حسب نظرة هابرماز؛ لأنه بالنسبة إلى غادامير كما شرح لهابرماز أن أي حوار قادر على حل المشكلات يجب أن يدخل في هذه الحالة الواعية لمحدودية الذات، وليست فقط محدودية الآخر، وألا يدخل إلى الحوار في حالة وصائية مسبقة. والجميل أن هابرماز اعترف بإشكالية هذه النقطة، وتراجع عنها بعد إدراكه لما تحمله من فوقية تجاه الآخر، حيث أدرك أن إصرار غادامير على أفقية الحوار تسهم في توسيع أفق التحليل المتجه نحو حل المشكلات بالدرجة التي يزداد الاعتراف فيها بالأفق الذي يعرضه الآخر أيضا. ولهذا، فإن عملية "إعادة التأهيل" من الأدوات الرئيسة عند غادامير في رغبته في إعادة تأهيل السلطة وعلاقات القوة، وهو اختار هذه الكلمة Rehabilitation لأنها لا تعني إلغاء الآخر، وبالمقابل لا تعني أيضا القبول الكلي به؛ أي هناك درجة من النقد ودرجة من الإنصات، وبالتالي تعنى أننا لا ننبذ الصوت القادم من الطرف الآخر، ولا نبخس أنفسنا أمامه. وهذا الموقف الأخلاقي هو الذي دفع غادامير ليقدم موقفا جديدا من التراث، حيث نكون قادرين على الدخول في حوار نقدي مع التراث بدون أن نفقد التراث، وأيضا بدون أن نفقد أنفسنا أمام التراث؛ أي إننا لا نضعه فوقنا وألا نضعه تحتنا، بل أن ندخل في حوار أفقي قادر على توليد معان جديدة، وبالتالي نقدا للذات والآخر.
أحببت أن أقدم هذه الفكرة بشيء من التفصيل؛ لأنها تعبر عن الثورة التي قام بها غادامير على مدرسة النقد التاريخي الحداثية؛ ولأنها تعبر بشكل جميل عن بعض من العناصر التي فيها عناد وتمسك، عند ياسين، بقدرة الدين على إدخال العناصر الخلاقة والأخلاقية في كل لحظة حين نتفاعل مع سياقنا التاريخي.
المشروع الذي يقدمه المستشار ياسين يمكن أن يسهم في خلق هذا الحوار الأخلاقي الأفقي مع التراث الإسلامي، عندما نضعه في الإطار الثالث الذي يدعو له غادامير. وعندما يمكن أن نخلق ثقافة حية لا ترفض التراث جملة ولا تجعله مقدسا. وتساعدنا الأدوات التي يقدمها ياسين في خلق حالة حوار أخلاقية مع التراث بنوع من الثقة، وأيضا بنوع من التواضع، حيث يمكننا من استعادة المفاهيم الأخلاقية الكبرى التي ضيقت المؤسسة الدينية التقليدية مساحاتها في الفكر الإسلامي، وعلى وجه الخصوص الجانب التشريعي فيه، والتي قننت أيضا الكثير من الفكر الإسلامي، وإمكانات الإبداع الهائلة تحت ضغوط سياسية ومصالح عسكرية ومذهبية.
يركز ياسين في معظم كتاباته على إشكاليتي السلاح والمرأة كفضاءات لدراسة ما حدث في عصر التدوين. ولهذا من الأمثلة التي يقدمها ياسين عن التضييقيات الفقهية لحساب مصالح توسعية هي "آية السيف" (كما يتم الإشارة إليها في المنظومة التقليدية) في سورة التوبة، والتي تأتي آياتها في ظرف محلي محدد بعد فتح مكة في سياق سياسي وعسكري، ومن الممكن اعتبارها إذا قمنا بإسقاطات تاريخية معاصرة أنها تدخل ضمن ما نسميه حاليا بـ"أحكام الطوارئ" (أو فيما يعرف في الدراسات الانتقالية بتدابير ما بعد النزاعات في الـ100 يوم الأولى بعد سقوط أو انهيار نظام سياسي).
وهنا تكمن دقة تحريات ياسين، عندما يشرح تأثير مصالح السلطة على تشكل المعارف الدينية. فمثلا بسبب مشروع الفتوحات العسكرية قامت المؤسسة الفقهية بعكس حالة الطوارئ لتحولها إلى حالة الدستور الثابت، فحولت بذلك آيات التوبة لتكليف مفتوح نافذ، حيث قامت بفتح باب الجهاد على مصراعيه على غير المسلم بشكل مطلق، كما يشرح ياسين، وبالتالي خلق قطيعة مع الذات والآخر تحت مسميات دار الحرب ودار الإيمان، وكأن الحرب هي الحالة الأساسية في الإسلام، بينما السلام هو الحالة الاستثنائية. ويناقش ياسين بشكل رائع كيف يقلب هذا مفاهيم القرآن التي تدفع نحو أفق أخلاقي لا يقبل المساومة في إكراه الدين، والتي كرست فيه الآيات في سنوات الوحي الأولى عدم أذية الناس في معتقداتهم. وعندما نفهم ملابسات هذه القضية، كما يشرحها ياسين، يتضح لنا أكثر كيف تخلص المشرعون الأوائل بسرعة بالغة من القسم الأكبر من القرآن عندما قام الفقه التقليدي (أو المنظومة السلفية كما يسميها) بنسخ معظم آيات القرآن الأخلاقية، وخاصة في التعامل مع الآخر. وهذا أيضا يجعلنا نفهم أيضا حرص بعض التوجهات القرآنية في اللحظة الراهنة على رفض فكرة النسخ في القرآن؛ لأن النسخ كما يظهره مشروع ياسين كان أداة سياسية خطيرة للتخلص من معظم الأحكام المفتوحة زمانيا ومكانيا والقواعد الأخلاقية الإنسانية التضمينية في القرآن لحساب أحكام سياسية محلية ظرفية.
ما يجعلني أقدر مشروع المستشار ياسين، وأعتبره دفعة معرفية مهمة لكل المهتمين بالتراث الإسلامي وبالأخص المهتمين بالدراسات الشرعية هو أنه يساعد على تحفيز قراءات نقدية جديدة لأركيولوجيا المعرفة الإسلامية بالمعنى الفوكوي وظروف تراكماتها السياسية وأهمية تقصى المصالح والامتيازات التي ساهمت في تشكلها. ولأن ياسين لا يتنازل عن النظر إلى المضمون الأخلاقي للنص، فهو بذلك يخلق أيضا تمكينا أخلاقيا لإيجاد حلول واجتهادات جديدة للاستجابة لمشكلات وقتنا الراهن. ليس لاستنباط فقه جديد بالضرورة رغم أن هذه المساحة أيضا تصبح ممكنة في مشروعه ولكن أيضا؛ لأنها تفكك الكثير من الأغلال التي ربطت الفكر الإسلامي داخل سياقات ضيقة جعلت وعينا الجمعي ينفصل ثقافيا ونفسيا عن الكثير من القيم القرآنية العليا، بل ويساعدنا لنفهم كيف فقدنا الصلة الأخلاقية العميقة لسلوكيات وأخلاقيات الرسول (ص) ونجاحاته الاجتماعية والسياسية، عندما حبسنا أنفسنا في صيغ لغوية مثبتة زمانيا ومكانيا كما فعل البعض باستخدام الحديث. فرغم أن ياسين يشيد بمحاولة علم الحديث تقنين وغربلة حجم من الأحاديث يكاد يصل لنصف مليون إلى خمسة ألاف حديث متفق عليه إلا أنه ينبهنا أيضا لإشكالية كبيرة حدثت في علم الحديث. فهو يشرح لنا أيضا أن الخطورة تكمن، حتى في هذه الحالة النقدية تجاه كتلة الحديث، في إيقاف آليات الاختيار والتمحيص. والتي أفقدت علم الحديث حيوته وآلياته النقدية الداخلية، عندما تم اعتماد الخيارات والغربلة في فترة معينة كإنتاجات "نهائية ومقدسة في حد ذاتها." (468)، وليس هذا فقط، بل عندما استفحل الأمر وتوغلت الممارسات الفقهية "حتى انتهت إلى الإقرار صراحة بنسخ السنة للقرآن،" كما يشرح ياسين. (447).
وبسبب هذه التقصيات النقدية نحو آليات تشكل المعارف الإسلامية، فإن فهم مشروع غادامير يعطي أيضا زخما لمشروع ياسين؛ لأنه يساعدنا على استعادة ذواتنا الفاعلة أمام التراكم المعرفي الإسلامي الهائل، ويمكننا أيضا من إعادة قراءة النص القرآني بتذوق وتقدير. وحتى إنه من الممكن إعادة قراءة بعض من الآيات التي قال عنها ياسين إنها ممعنة في المحلية مثل آية الظهار بطريقة جديدة، عندما نسمح لأنفسنا بالتفاعل مع محتوى النص نفسه كما يوصي غادامير. فمثلا يقدم ياسين فكرة سورة المجادلة على أنها تقوم بمعالجة عادة عربية آنية، أو كما قال "ممعنة في المحلية"، حيث كان الرجال العرب يمارسون من خلالها هجر زوجاتهم، لكن كقارئة أعيش في هذا العصر ومع تأثير التراكم المعرفي النسوي عندي، يصير نوع جديد من "انصهار للآفاق." فعندما أقرأ بداية سورة المجادلة أجد اندماجا وانصهارا بين أفقي الذاتي وأفق النص بشكل يجعلني أرى تناسبا وتلاؤما لمشكلة غياب المرأة عن النقد والإنتاج الثقافي. فرغم أن الآية قد تبدو ممعنة في محليتها فيما يخص عادة "الظهار"، لكن لما أسمع بداية السورة: "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ" فأجدني أسمع آيات تركز على أهمية نقد المرأة للممارسات الذكورية في مجتمعها، بل إن شكواها وجدالها يتلقاهما الله كحوار "والله يسمع تحاوركما." وحتى عادة الظهار نفسها، عندما ندخل في تأويل مدلولاتها، فإننا نجد أنها محملة بمعان كثيرة في عرض مشكلة استدارة المجتمع الذكوري عن صوت المرأة وحضورها الفيزيائي في المجال العام.
ولذلك، فإن قراءة هذه الآية من أفقنا وبمنظور نسوي، رغم أنها قد تبدو وكأن لها خصوصية تاريخية ومنغلقة داخل إطار ثقافي معين في الظروف المحلية العربية، تجعلنا قادرات مع أدواتنا التأويلية النسوية في إعادة سماع معانيها الغنية والقابلة لاحتمالات مستقبلية جديدة لاستعادة المرأة مكانتها في انتاج الشكوى والنقد الثقافي ضد زخم ذكوري كاسر. ولهذا كما ينقل المستشار ياسين عن علي بن أبي طالب إن القرآن حمال أوجه، فإننا نرى أن هذه الأوجه تظهر بتعدد قراء القرآن وبتعدد آفاقهم التأويلية، حيث تسهم هذه الرؤى المتعددة في خلق فضاء معرفي أوسع، وبالتالي رفع السقف الأخلاقي للنص وإنقاذه من قراءات ضيقة تخدم مصالح فئات معينة. ولهذا، فإن الهم الذي يحمله المستشار ياسين في محاولاته لفهم الاستعصاء الفكري المعاصر يُظهر إلى السطح بشكل أكثر وضوحا التساؤلات العميقة التي عبرت عن نفسها بأشكال مختلفة في آخر مئتي سنة في العالم الإسلامي، والتي ظهرت بعضها كمحاولات فردية وجماعية لفهم تموضعنا التاريخي في عالم فقد فيه المسلمون دورا قياديا في الإنتاج المعرفي وزمام القرار المحلي والسيادة السياسية. فبعد الصدمة الحضارية مع دخول القوى الاستعمارية إلى كثير من مناطق العالم الإسلامي تشكلت أيضا ارتكاسات فكرية متأثرة بهذه الظروف. ومع تفوق الغرب بتسارع متزايد ما زلنا نرى إيقاع مصالح السلطة والصراعات في تشكل وتكون ذاكرتنا الإسلامية والتورط في أعمال العنف أو إنتاج خطابات دفاعية لتخفف مشاعر النقص الحضارية أو فقدان "الشعور بالأناقة" كما كان بن نبي يسميها.
وأشعر أن موقف غادامير بسبب تركيزه على الآلية الأفقية ورفض الاستعلاء أو الانخفاض في الحوار، فإنه يمكننا من استعادة القراءة كحدث جديد، وخاصة لفئات تم تغييبها، وفي حالتي أركز على تغييب النساء الممنهج الذي أقصى صوتها عن قراءة النص وإنتاج المعرفة، بما فيها المعرفة الدينية، وتقديم مجادلاتها وتشكيها إلى الله (رغم أننا نعرف أنه في العصر العباسي لوحده تم توثيق أكثر من 8 آلاف لأسماء عالمات وفقيهات ومحدثات).
كل ما يحدث حولنا يحفزنا على التأمل والتأويل، وبالتالي على الاعتراف بحالتنا الوجودية التحاورية. فنحن أيضا نعيش في عصر ضيقت فيه معاني حقوق الإنسان التي تم انتاجها فلسفيا وفكريا لصالح قوى عسكرية واقتصادية تسيطر على تضاريس العالم وموارده وبأدوات نووية قادرة على إنهاء الحياة على كوكبنا الأزرق. وهذا يجعلنا أيضا نعي أننا مخلوقات تاريخية، ونعيش ضمن زمن ما تزال قوة السلاح والإكراه تهيمن فيه لحساب مصالح اقتصادية واستراتيجية عالمية، ويتم فيه إنتاج المعرفة في ظروف القوة والسلطة. ولهذا من المهم أيضا أن ندرك أن كثيرا من قراءتنا النقدية المعاصرة للتراث، تقع أحيانا في خانة "التابع" كما سمتها المفكرة الأمريكية-الهندية، غياتري سبيفاك؛ أي التابع والمقلد للغرب. وبالتالي، فإن كثيرا من رغبتنا في نقد التراث خاضع أيضا لضغوط خارجية ورغبة بتقليد الغالب المنتصر عالميا الآن، كما في مصطلحات ابن خلدون.
ولهذا، فإن الحوارات الأفقية التي تقدر على رؤية تموضعها التاريخي وليس فقط تموضع التراث التاريخي تمكننا من فتح زوايا نقدية أكثر تجاه علاقات القوة والهيمنة التي نشهدها في عصرنا؛ لأنها تساعدنا في توسيع أفقنا الأخلاقي المحلي لإعادة قراءات متعددة للذات والآخر بطرائق تبث روح التفاؤل والعناد والإصرار على إنسانيتنا المشتركة وتحدياتنا المشتركة. فنحن الآن نعيش في كوكب ضاقت فيه الحدود الجغرافية، بينما اتسعت فيه إمكانيات الضمير الإنساني وإمكانات الحوار الحقيقي.
[1]- الورقة مقتطفة من ندوة: المشروع الفكري للمستشار عبد الجواد ياسين، التي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلاحدود في 06-شتنبر 2024