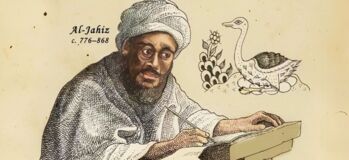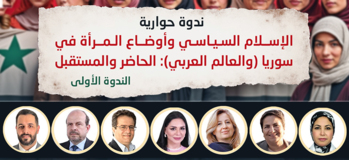مكانة المرأة في حضارة وادي الرافدين من خلال النصوص
فئة : مقالات

مكانة المرأة في حضارة وادي الرافدين من خلال النصوص
*- نصوص التشريع
شكلت الشرائع في حضارة وادي الرافدين أولى الشرائع المكتوبة في تاريخ البشرية، والتي نظمت وضبطت العلاقات على أساس من العدل والمساواة.
وكانت شريعة حمورابي، كما مرّ ذكره، أولَّ مجموعة شاملة من النصوص القانونية، بيْد أن ما سبقها من شرائع في الحقب السابقة لحمورابي كان لا يقل عنها أهمية. ومن اللافت في تلك القوانين هو التكرار للتكليف الإلهي للملك بالحكم وإقامة العدل والتشريع، كما يتجلى من خلال القوانين والتشريعات التالية:
1- «إصلاحات أوركاجينا، وتعود للقرن الرابع والعشرين ق.م؛ إذ استشرى ابتزاز الأموال من قبل موظفي الحاكم، وانتشار المفاسد الاجتماعية، واعتداء القوي على الضعيف، وتسخيره للعمل دون أي مقابل، فقام أوركاجينا بالتصدي لها وخفض الضرائب المفروضة على الناس.
2- قوانين أور-نمّو وهي أول لائحة قوانين دقيقة، وظهرت مع شريعة أورنمّو مؤسس سلالة أور الثالثة الذي حكم ما بين (2113-2095) ق.م، وكانت شريعته تضم في هيئتها أكثر من ثلاثين مادة، عالجت في مجموعتها الأولى مسألة الأحوال الشخصية، وتضمنت معالجات لأحوال العبيد وحالة هروبهم وعتقهم، ومسائل تخص الأراضي الزراعية ومتعلقاتها من مشاكل كالسرقة أو الاعتداء، وتنظيم شؤون الضرائب والحقوق.
3- قوانين لبت-عشتار، وهو خامس ملوك سلالة أيسن الذي حكم ما بين (1939-1924) ق.م، ويعتقد أن الشريعة تضم أكثر من مائة مادة، وأن الإله الراعي لهذه الشريعة هو (أوتو) إله الشمس السومري، وتحتوي، كذلك، على خاتمة ومقدمة وتبحث في الأراضي الزراعية والسرقة والاعتداء على الآخرين والضرائب والأحوال الشخصية والأضرار.
4- قوانين مملكة اشنونا، وهو من أقدم القوانين المكتوبة باللغة الأكدية، والمقدمة كتبت بالسومرية، وقسّمت قوانينه في مجموعات كتسعير المواد، وتثبيت الأجور والسرقة والعقود التجارية، والأحوال الشخصية، ومخالفة أحكام الوديعة، وعقود البيع والرقيق، بحيث يلاحظ توسعها بشكل أكبر لتشمل تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
5- قوانين حمورابي الذي اكتشفت مسلته عام (1902م) في مدينة (سوسا) عاصمة عيلام، على يد العالم الفرنسي (شيل) ووجدت منقوشة على حجر الديوريت، وفي أعلى الحجر نقش بصورة الملك حمورابي وهو يتلقى هذا القانون من آلهة الشمس، ومازال هذا الحجر موجوداً بمتحف اللوفر في باريس، ويحتوي على مقدمة وخاتمة ومئتين واثنتين وثمانين مادة تشريعية شملت كل القوانين الجنائية والمدنية والتجارية.
6- أما الآشوريون، فقد وضعوا شرائع وقوانين جديدة ساد فيها مبدأ القصاص والتعويض ومنها الألواح التي تعود لفترة ما بين (1250-1450) ق.م في العصر الآشوري الوسيط، وتناولت مواضيع السرقة والأذى والقتل العمد والزنا والضرب المؤدي على الإجهاض والسمسرة والأحوال الشخصية، ومن الملاحظ أن القوانين الآشورية سادها قسوة العقاب والتفصيل الأكبر» (الماجدي 2011: 371-375).
إن تطور صيغ القوانين والتشريعات هذه، فضلاً عن كونها أرست العدالة والمساواة، وأنصفت الضعيف، وكانت أولى تشريعات في حقوق الإنسان، يعكس علاقة الدنيوي بالقدسي، وعلاقة الملك بالسلطة الإلهية، فقد كان كل ملك يشير في مقدمة قوانينه إلى أن الآلهة كلفته وغالباً يسمي الإله، والذي هو إله المدينة، وبأنه يتعهد أمام هذا الإله بأنه لن يجعل الضعيف والأرملة بيد القوي، ويمجّد الإله ويحدد تشريعاته، ثم يمجد نفسه، وهكذا.
«وثمة من يعتقد بأنه إذا كانت إرادة الآلهة هي تحقيق العدالة، فلابد للملك أن يكون مؤمناً بهذا التوجـه، وبأن يتباهى أمام شعبه وأمام الآلهة التي اختارته بأنه أقام العدل والقانون والنظام في البلاد، وعمّت الرحمة وشملت الضعيف، وتمّ الوقوف أمام القوي المتجبر، وحماية الفقير من طغيان الأغنياء، وإبعاد الشر والعنف. وكان الملك (سنحاريب) قد أعلن عن نفسه، بصفته (حارس العدالة) (وآشور بانيبل الثاني)، وأعلن في أحد النصوص أن الإلهة (عشتار) زودته (بصولجان العدالة)، ولقـد اختص الإله (شمش) بتقديمها إلى الملوك؛ لأنه ارتبط وجوده بها، وقد وُصِفَ بأنـه أنجب ولدين (كيتو) و(ميشارو) أي العدالة والحق، وهو العـدو اللدود للظالمين، وهذا الملك (نبوخذ نصّر) يتوسل إلى الإله (شمش) يطلب منه (صولجان العدالة) إلى الأبد، وهناك كلمات إلى هذا الإله تقول: (أوه...يا أنت الذي يعـطي المـلك صولجان العدالة)» (الطعان 1985: 129).
«فالحاكم أوركاجينا أقام العدل بأمر الإله (ننجرسو)، وأور نمو يأمره الإله (آنو) أن يوطد العدالة في البلاد، وأن يزيل البغضاء والظلم والعداوة. ولبت -عشتار وفي تطور لافت يظهر في مقدمة قانونه بأنه مُنادى عليه من الآلهة (نو- نام- نر) لإمارة البـلاد وتحقيق العدالـة فيهـا ولمعاقبة الظالم ولـرد العداوة وكـل عصيان مسلح. ويضيف لقد وطدت العدالة في سومر واكد، وفقاً لأمر الإله (إنليل)» (رشيد 1976: 58). ويأتي حمورابي وقد استهلت مسلته الشهيرة بكلام إله الشمس الذي أملى عليه مدونته، حيث يقول: (أنا حمورابي ملك القانون، وإياي وهبني إله الشمس القوانين).
وفي بحث عقراوي كان هناك تركيز على المكانة المرموقة التي احتلتها المرأة في المجتمع على صعيد الأسرة والاقتصاد والسياسة والدين، وقد تمّت الاستفادة من بحثها المرموق الذي وثقته بالمراجع المهمة والترجمات، في تسليط الضوء على مكانة المرأة، ورصد السيرورة التي تحول بها دور المرأة بالتوازي مع تحول دور الإلهة.
إن ما حدث من تحول من النظام الأمومي إلى النظام الذكوري أخذ تشريعه من القوانين التي مثلت إرادة الملك الذي يمثل الإله، وبمقدار ما تغيرت شخصية الإله، فإن التغيّر طاول معه شخصية الملك ومكانته، وتدهورت مكانة المرأة، فقد كانت التشريعات حافظة بشكل أساسي للذكورة وللنسل الذكوري، وفي حين حصرت الزواج للمرأة بواحد، وشددت عليها في قوانين الزنى بعقوبات تصل لإعدامها، سمحت للرجل بالزواج الثاني وبالمحظية، وسمحت له بالرق وقوْننة الزواج، ليكون توزيع السلطة على المرأة من والدها إلى زوجها وأبنائها، حيث إن الميزات التي حصلت عليها المرأة في القوانين كلها كان المتميز فيها هو ما يخص المرأة الأم، سواء في حال الطلاق أو في حال الترمل.
وتسلط الباحثة ليرنر الضوء على الكيفية التي تأسس عليها النظام الذكوري، وكيف انبثقت القوانين والتشريعات لتعزيز السلطة الأبوية، هو ما يبرز في بعض النصوص من شريعة حمورابي التي ألقت من خلالها ليرنر الضوء على هذه النقطة بالذات، وهي توسعت في النصوص والتعليق عليها والاستنتاج منها؛ فالبند 129 من شريعة حمورابي ينص على أنه «إذا قبض على امرأة متزوجة تجامع رجلاً آخر يجب أن يقيدا ويرميا في المياه إذا رغب زوجها بإبقائها حيّة، عندئذٍ يجب أن يجعل الملك خادمته تعيش». وفي التشريعات خلال الفترة الآشورية «إن عرض أمرهما أمام الملك أو أمام القضاة وأثبتت الدعوى، وحَكَم زوج المرأة بموتها يجب أن يُخصى الرجل ويشوه وجهه كله، أو إذا عفا عنها زوجها يجب أن يعفى الرجل أيضاً» (ليرنر 2013: 226).
ويلاحظ أن العفو عن المرأة المتزوجة الزانية وارد، لكنه أنيط برحمة الزوج الذي تحول إلى القاضي الأول الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة في الموت والحياة.
وفضلاً عن ذلك، قوننت شريعة حمورابي السلوك الجنسي، لكي توضح الفرق بين الاستيلاء على النساء بالاستعباد، والحصول عليهن عن طريق الزواج، وكانت معظم عمليات الزواج أحادية إلا في حال كانت الزوجة عاقراً أو كانت كاهنة، فعندها يمكن أن تقدم له الزوجة فتاة عبدة لكي تنجب له أولاداً كبديل لها؛ فالبند 145 من شريعة حمورابي يقول: «إذا تزوج رجل من كاهنة ولم تنجب له أبناء ومن ثم تزوج امرأة عادية يمكن لهذا الرجل أن يتزوج امرأة عادية ويأخذها إلى منزله، إلا أنَّ تلك المرأة العادية يجب أن لا تجعل نفسها مساوية للكاهنة» (ليرنر 2013: 223).
وينص البند 141 من شريعة حمورابي على أنه «إذا خرجت امرأة متزوجة تعيش مع رجل في منزل وواصلت التصرف بحماقة وقللت من أهمية زوجها، يجب أن تدان وإذا قرر زوجها عندئذ أن يطلقها يمكن أن يطلقها، لا شيء يجب أن يُمنح لها كنفقة طلاق بعد رحيلها. إذا قرر زوجها أنه لن يطلقها، يمكن زوجها أن يتزوج من امرأة أخرى، وتلك المرأة يجب أن تسكن كعبدة في منزل زوجها» (ليرنر 2013: 225).
وبالنظر لكون المجتمع الآشوري مجتمع حروب عنيفة؛ فقد أدى هذا إلى التشديد أكثر على المرأة والتشديد أكثر بالعقوبات.
«إن ما حصل في حضارات وادي الرافدين من مأسسة للنظام الأبوي وضع حدوداً فاصلة بصرامة بين نساء الطبقات المختلفة؛ فالدولة أثناء سيرورة تأسيس الشرائع زادت من حقوق ملكية نساء الطبقات العليا، بينما قيدت حقوقهن الجنسية، وفي النهاية تآكلت كلها، وصارت اتكالية النساء مدى الحياة على الآباء والأزواج متأصلة بقوة القانون والعرف، حيث اعتبرت 'طبيعية' وموهوبة من الله. أما نساء الطبقات الأدنى، فقد سُلِعت مقدراتهن الجنسية والتناسلية، وتوجر بها وأجِّرت أو بيعت لفائدة أعضاء الأسرة الذكور، وأقصيت النساء من الطبقات جميعها ومن السلطة العسكرية. ومع بداية الألفية الثانية ق.م، أقصين من التعليم الرسمي. ومع ذلك، فقد ظل هناك نساء قويات لعبن أدواراً قوية في الخدمة الدينية وفي التمثيل الديني، وفي الرموز. فقد كان الرجال والنساء يتوسلون أثناء محنهم أو مرضهم، وينحنون أمام تمثال الإلهة وخادمتها الكاهنة. وكانوا يمدحونها بكلمات تعكس موقف العبد من السيد: 'سيدة ساحة الوغى، التي تهدم الجبال، أيتها السيدة المهيبة، اللبوة بين الآلهة، التي تقهر الآلهة الغاضبين، الأقوى بين الحكام، التي تقود الملوك، أنت التي تفتحين أرحام النساء... عشتار الجبارة'» (ليرنر 2013: 278).
*- النصوص الأدبية
تمتعت المرأة في بلاد الرافدين من الأسر المالكة بقسط واسع من التعليم، ولاسيما أنهن كن يوهبن للكهانة؛ إذ تتعلم المرأة الكتابة وتدرس في مدارس المعابد الكبيرة.
قرب مكان إقامة الكاهنة الكبرى في معبد إله القمر نانا، عثر المنقِّبون على قرص مُدوَّر من مرمر يُصوِّر كاهنة تترأس طقسَ إراقة، كان مكسوراً ومشوَّهاً بصورة متعمَّدة. وعندما تمَّ ترميمه، وجُمعت قطعه، ظهر نقشٌ على ظهره يقول: «إنهيدوانا[1] زوجة نانا/ ابنة سركون، ملك الجميع، في معبد/ إنانا في أور منصّة أنتِ بنيتِ، ومنصّة/ مائدة السماء (آن) أنتِ سمِّيتِ» (ميدر 2008 العدد 1).
لقد تقدمت إنخيدوأنَّا على كل رجالات الأدب ونسائه في التاريخ البشري، بل كانت الأولى التي خاطبت قرّاءها بضمير المخاطب، وأعلنت عن اسمها وهويتها دون لبس، في الوقت الذي نعلم بأن معظم الأدب السومري مجهول الهوية، ومنه ملحمة جلجامش. وهذا الأمر يدحض كل النظريات التي تشكك بشخصية إنخيدوأنَّا التي نسخت أعمالها الشعرية وتراتيلها لمئات السنين من بعدها (mchale-moore 2000: 69-74).
ومن المفيد هنا التوقف عند نصوص إنخيدوأنَّا، التي تصلح كمثال يختزل ثلاثة أدوار للمرأة في التاريخ؛ فقد كانت ابنة الملك التي حازت على تعليم عال ومتميز، وكانت الكاهنة العظمى التي لعبت الدور السياسي المطلوب بزواجها المقدس مع الملك نانا، وكانت الشاعرة التي لها السبق في التاريخ بتوقيع اسمها على أشعارها، والتي شكلت أشعارها مرجعاً مهماً عكس اللغة الأدبية المتميزة والمفاهيم والمعتقدات الدينية التي عكست تقديس إنانا والصلوات والتراتيل المهداة إليها، إن المقتطفات المأخوذة من شعر إنخيدوأنَّا وتاريخها تعود للباحثة بتي دو شونك ميدر[2] وقد ترجمها للعربية كامل جابر ونشرت في مجلة الغاوون العدد 1 من عام 2008.
«يذهب تراثها إلى أبعد من كونها المؤلّفة الأولى في تاريخ الآداب: النابغة والأديبة العبقريّة التي لم تؤثّر على وظيفة الكاهنة الكبرى في أور فحسب، لكن أيضاً على الثيولوجيا واللاهوت السومريّ. وبتعبير حديث، يمكن القول إنها أثّرت على سيكولوجيا عصرها، والأجيال التي أتت من بعدها. لذلك يدعوها هول بأنها أبرز شخصيّة في تلك الحقبة، وربّما الأبرز في أيّ حقبة من تاريخ ديانة إله القمر في أور. وصلت إلينا معظم أعمالها في نُسخ مصنوعة في الحقبة البابليّة القديمة (حوالي خمسمئة سنة بعد وفاتها). شهرتها الفائقة يشهد لها عدد النسخ الموجودة الآن لتسابيح إنانا؛ إذ يوجد لدينا حوالي الخمسين نسخة منها. ويرى هالو وفان دجك أن نتاجاتها الشعريّة، ولا بدّ، قد استُخدمت كنموذج لكَتَبَة التسابيح في الأزمنة اللاحقة» (ميدر 2008: العدد 1).
وكُتب الكثير عن هذه الشخصية النسوية المتألقة في التاريخ، وتناولتها كتب وأبحاث كثيرة وسميت معاهد باسمها، حتى إنها تماهت بشعرها ما بينها وبين الإلهة إنانا في قصائدها التي أفردتها للمديح، كما أن الألقاب التي أطلقتها على إنانا نجد لها مماثلاً فيما أطلقته المسيحية على مريم العذراء.
في قصيدة السيدة ذات القلب الأعظم تعدد إنخيدوأنَّا صفات إنانا كإلهة عظمى المتحكمة بكل النواميس (المي) والمتفوقة على آن العظيم. إنه من المفيد استحضار هذه النصوص وقراءتها لأنها تعكس أمرين؛ الأول هو الإيمان العميق بالإلهة العليا والعظمى للكون، وهي إلهة أنثى بلا منازع، والأمر الآخر هو هذا التناغم ما بين مكانة إنخيدوأنَّا ومكانة الإلهة الأنثى، وهو ما يعكس هذا الترابط في مكانة المرأة على الأرض ومكانة الإلهة في السماء، خاصة وأن هذا يترجم واقعياً عبر مكانة الكاهنة العظمى، ومن ثم فإن السلطة التي تمنحها المؤسسة الدينية تتطابق مع شكل هذه المؤسسة ومصالحها، فحين كانت المؤسسة الدينية تحت سيطرة المرأة كان الرجل الكاهن ذا دور استثنائي، وتواجده بالمعبد كان يحتّم عليه أن يكون مخصياً، ودوره في الحكم دور مرتبط بمباركة المرأة الكاهنة العليا.
يتضح من هذه الصورة إذن حتمية ارتباط الانقلاب على الإلهة في السماء بانقلاب عليه على الأرض، تبعاً لتوسع المجتمعات وتراكم الثروات والمصالح، فالإلهة الأنثى تتجلى بوصفها:
السيّدة ذات القلب الأعظم
متّشحة بالضوء الساطع
ملكة متحمّسة للمعركة
بهجة الأنونا
ابنة القمر الكبرى
عالية في الأرضَين (ميدر 2008: العدد 1).
ثم يأتي وصف مقدرتها وموقعها من الآلهة؛ فهي الأعلى حتى من الإله آن، والنواميس بيدها، ولها القوة وأحكام جميع الآلهة تضمحل أمام كلمتها:
تشمخ بين الحكّام العظام
ملكة المآثر الفريدة
تقطف المي
من الأرض والسماء
تفوّقت على آن العظيم
من بين الآلهة كلّها لها القوّة
أحكامهم تضمحلّ
أمام كلمتها التي لا مثيل لها (ميدر 2008: العدد 1).
ويتابع النص تعداد صفاتها ومقدرتها كمتحكمة بآن العظيم وبكل مظاهر الطبيعة، ويُلاحظ هنا أن الإله ولو كان موجوداً إلا أن الإلهة هي التي تتحكم فيه، فالأقدار بيدها:
من دون إنانا
آن يتردّد
أنليل لا يمكنه تعيين الأقدار
من يجرؤ على تحدّيها
ملكة شامخة الرأس
أعظم من الجبل
هي المبجّلة في المجلس
تجلس على العرش
تنتشر يميناً وشمالاً
بحركة بسيطة من يدها المشوِّهة
تُحوّل الجبل إلى كومة نفايات
تنثر الرماد من الفجر حتّى الغروب
بصخور عظيمة تَرجم
والجبل
مثل جرّة فخار
يتحطّم
بقوّتها العظيمة تصهر الجبل
تُصيّره راقوداً لوَدَكِ الغنم (ميدر 2008: العدد 1).
وتُظْهر إنخيدوأنَّا عظمة هذه الإلهة وتصور قدراتها في الفتك، ومن ثم في الإحياء، وبأنها تتلاعب بموازين الحياة والموت وتتحكم بالمصائر. إنها إنانا:
حاملة السعادة
أمركِ الرهيب
خنجر في اليد
ينشر الضياء على الأرض.
تحمل الحياة في السماء
بيد واحدة
تجرّين الرجال إلى صراع لا نهاية له
أو تتوّجين بالشهرة حياة إنسان مصطفى (ميدر 2008: العدد 1).
إن التركيز على صفات الألوهة من الخلق والقوة والجبروت والمعرفة والذكاء، وكل الصفات الاستثنائية سوف تتحول، فيما بعد، لتكون صفات الإله الذكر بامتياز:
من لا شيء تخلق
ما لم يكن أبداً
وتكشف
ما يعيش في الداخل
ما يخفى في الصدور (ميدر 2008: العدد 1).
ويظهر أن التغيير الذي عاشته إنخيدوأنَّا، وهي الشاعرة المتقدة الحواس، كان كبيراً وترك آثاره في قصائدها، إضافة إلى مكانتها ودورها السياسي الذي برعت بالقيام به لدرجة أنه يُشار إليها من قبل بعض الباحثين على أنها أسهمت في توحيد السومريين والأكاديين في دولة واحدة. لقد عاش شعر إنخيدوأنَّا وابتهالاتها إلى الإلهة إنانا بعدها بوقت طويل:
«إلى الكاهنة العظيمة ذات الأوامر المبجلة، المجد (لها) لمخربة البلدان الأجنبية، التي منحها آنو النواميس الإلهية، إلى سيدتي التي تتشح بالجمال، إنانا!» (عقراوي 1978: 283).
[1]- جاء الاسم في المقال أنهيدوانا وهي إنخيدوأنا
[2]- meador, betty de shong (2009). princess, priestess, poet: the sumerian temple hymns of enheduanna. austin: university of texas press.