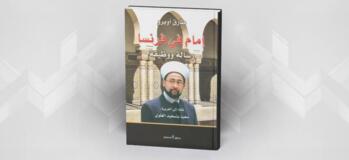من الثورة الجنسية إلى الإصلاح الجنسي (حوار فكري مع عالم الاجتماع المغربي د. عبد الصمد الديالمي)
فئة : حوارات

من الثورة الجنسية إلى الإصلاح الجنسي
(حوار فكري مع عالم الاجتماع المغربي د. عبد الصمد الديالمي)
يُعدّ عبدالصمد الديالمي من أبرز علماء الاجتماع في المغرب، ومن القلائل الذين لهم مشروع فكري واضح المعالم، حيث اهتم في البداية برصد وتشخيص المسألة الجنسانية في المغرب. ومع مرور الزمن وتراكم الخبرة، أصبح مشروعه طموحا يتسع إلى العالم العربي والإسلامي عامة، نظرا للمحددات الحضارية والثقافية والدينية واللغوية التي تتقاسمها دوله.
وهو المشروع الذي اكتمل في نظرية "الانتقال الجنسي" التي بناها د. الديالمي سنة 2007، والتي تتكون من ثلاث مراحل هي كالتالي:
أولاها، مرحلة التطابق الديني بين المعيار الجنسي والسلوك الجنسي؛ فهما معا دينيان بامتياز. أما ثانيتها فهي مرحلة الانفجار الجنسي الحاصل اليوم بين المعايير الجنسية وبين السلوكيات الجنسية، فبينما تظل المعايير الجنسية دينية تنحو السلوكيات الجنسية نحو تعلمن عملي. معالم المرحلة الثالثة تتميز بالولوج التدريجي للحقوق الجنسية كحقوق إنسان إلى العقلية المغاربية (والعربية)؛ ذلك الولوج الذي سيؤدي إلى تطابق علماني بين سلوكيات جنسية معلمَنَة ومعايير جنسية معلمنة أيضًا. من ثم ستصبح المعايير الجنسية الدينية اختيارا فرديا باسم "الحريات الفردية"، فيصبح المواطن المغربي/العربي حرا في اختيار جنسانية دينية أو غير دينية دون تدخل من طرف الدولة والشرع والقانون.
من هنا يتبين أن الديالمي لم يكتف بجعل المسألة الجنسانية مجرد مسألة سوسيولوجية، وإنما تبناها كقضية اجتماعية ساخنة؛ لأن انتظامها في العالم العربي الإسلامي يتأرجح تأرجحا ساخنا بين التشريع الإسلامي وبين حقوق الإنسان. في هذا الإطار، حاول التوفيق بين هاتين المرجعيتين الدستوريتين من خلال مفهوم "الاجتهاد بلا حدود" الذي وضعه منذ 1999 مستندا على تاريخانية ونسبية العلات في تحريم الجنسانية قبل الزوجية والجنسانية المثلية.
يدافع الديالمي عن الجنسانيتين قبل الزوجية والمثلية، انطلاقا من تحليل سوسيو- تاريخي علمي يفضي إلى تبني قيم حداثية علمانية. وبالتالي، فقناعاته نتيجة لدراساته السوسيولوجية النظرية والميدانية التي تفند طروحات المقاربات النكوصية التي تقارب الجنسانية بالاستناد إلى مرجعية إسلاموية تقوم على قراءة حرفية للنصوص الدينية وعلى قراءات مذهبية بالخصوص.
بناء على ما سبق، نشدد أن المشروع الفكري لعبد الصمد الديالمي عرف تطورا كبيرا خلال سيرورة زمنية تقارب خمسة عقود. في هذا الحوار الفكري معه، سنحاول رصد تطور هذا المشروع الفكري والإصلاحي والكشف عن أهم منعطفاته الفكرية والاجتماعية؛ وذلك من خلال إجاباته عن الأسئلة التالية:
دكتور، هل يمكن اعتبار إصدار كتابكم "نحو إصلاح جنسي في المجتمعات الإسلامية"، بمثابة اكتمال البناء المعماري لمشروعكم الفكري؟
عبد الصمد الديالمي: أتحفظ على عبارة "اكتمال"... ما دمت حيّا سأستمر في البحث وفي العطاء العلمي والفكري. بفضل القراءات والتجارب والأبحاث، لا زلت آمُل أن أعطي أكثر، وأن أتعمق أكثر وأكتشف أشياء جديدة في المستقبل. لم أتقاعد علميا... تقاعدي المهني كأستاذ جامعة لا يعني تقاعدي كعالم اجتماع. فعالم اجتماع صفة دائمة تُصاحبني مدى الحياة. عالم الاجتماع حرفة، والحرفة ملازمة دوما للشخص الذي يكتسبها. مثلا، الطبيب يبقى دائما طبيبا، والمؤرخ يبقى دائماً مؤرخا، ولكل شخص حرفة أو صنعة تبقى ملازمة له دوما، سواء بقي يمارسها أو لا يمارسها كمهنة، وهو الشيء الذي يصدق على عالم الاجتماع أيضا. الحرفة شيء نكتسبه ولا نفقده أبدًا. فأنا كعالم اجتماع أستمر في ممارسة هذه الحرفة، وأنا هنا والآن أتكلم معك كعالم اجتماع وليس كأستاذ بالنظر لما أنجزته من أعمال منذ تقاعدي المهني كأستاذ.
بعد هذه التوضيحات أعود للإجابة عن سؤالك، الكتاب المقصود، هو بمثابة دراسة تركيبية لكل أعمالي السابقة في حقول الجنسانية والجندر والنَّسَوية والإسلام. فالدراسات التي يتضمنها الكتاب تتعلق بالمساواة الجندرية بين المرأة والرجل وبين الغيري والمثلي وفيه أعمال متعلقة بالجنسانية في حد ذاتها، والكل محدد بالإسلام وبحقوق الإنسان كمحددين مرجعيين لكل هذه المواضيع.
دكتور، هل يمكن أن تقدم لقرّائكم إضاءات حول مسيرتكم الفكرية التي وضعتم لها العنوان التالي: "من الثورة الجنسية إلى الاصلاح الجنسي"؟
عبد الصمد الديالمي: اهتمامي بالجنس انطلق من تجربة شخصية، وسبق لي أن حكيت عنها مرارًا في الصحف. عندما كنت طالبا بالرباط أدرس بشعبة الفلسفة التقيت بفتاة وبنينا علاقة عاطفية، ثم تزوجنا وسنّي لا يفوق 21 سنة. كان زواجا بسيطا، حيث لم ننظم حفل زفاف، وإنما اكتفينا بتوثيق عقد الزواج بسرعة كبيرة. فأخوها رآها ذات يوم معي في الشارع فلامها على ذلك. وحفاظا على سمعتها "كبنت دارهم"، طلبت مني أن أتقدم لخطبتها، فوافقت على ذلك على الفور، وكان يوم الخطوبة هو يوم توثيق الزواج بإيعاز من أسرتينا معا. بعد تخرجنا من الجامعة تعينت بمدينة آسفي أستاذ فلسفة بثانوية ابن خلدون، وتعينت هي بثانوية أخرى كأستاذة فرنسية. وكنا نعيش حينها حياة "رفاهية": اكترينا ڤيلا، وكانت لدي سيارة حمراء رياضية وكان لنا كلب... هكذا كانت حياتي، حياة بورجوزاي صغير. لا أذكر كيف وقع في يدي كتاب "الثورة الجنسية" لفليام رايش. قرأت الكتاب فانبهرت بأفكار رايش التي أقنعتني بأن الزواج والأسرة مؤسستان تكبحان وتمنعان الرضا الجنسي، وأنهما "مؤسستان برجوازيتان تنتجان الأكباش السياسية". من هنا أتت يساريتي دون أن أكون ملتزمًا سياسيا مع حزب يساري، لكن كنت أشعر أنني ثوري... متمرد بالأصح. كان ذلك الشعور يكفيني لأرضى عن نفسي كأستاذ فلسفة ملتزم. لكن رايش، وهو بالمناسبة محلل نفسي ومناضل شيوعي في العشرينيات من القرن الماضي، "أيقظني" من سباتي العميق، حيث اقتنعت بفضله أنه لا يمكن أن تكون شخصا ثوريا ومتزوجا في الوقت ذاته. كانت تلك هي القناعة التي استخرجتها من قراءتي لكتاب الثورة الجنسية.
هكذا وبكل عفوية وسذاجة اقتنعت بأفكار رايش، بل اقتنعت بضرورة تطبيقها فورا في حياتي الشخصية. فذهبت إلى زوجتي وأخبرتها أني سأطلقها واقترحت عليها أن نعيش سويا بعد الطلاق في إطار علاقة حرة؛ لأن رآيش يقول بالحب الحر، وبالمعاشرة الحُرة، وبالمساكنة الحرة. خاصة وأن الثورة الشيوعية سنة 1917 في الاتحاد السوفياتي كانت ترى أن الزواج هو سجن للمرأة، سجن يجب أن تتحرر منه المرأة حتى تكون لها فرصة للدراسة والعمل والمساهمة في بناء المجتمع الشيوعي.
تأثرت بكل هذه الأفكار من خلال ما فهمته من قراءة رايش، وقلت لزوجتي سأطلقك، وبالفعل نفذت قراري، وتحديت الجميع، ولم يفهم أي أحد من العائلة سبب الطلاق ما عدا أنا. لذلك سميته بـ "الطلاق الميتافيزيقي"، وقصدت بذلك أنه طلاق دون أسباب مادية. في الواقع، كان علي أن أسميه طلاقا إيديولوجيا، وهو الأصح. بعد هذه القطيعة في حياتي الشخصية، وعلى الصعيد المهني، أرسلتني وزارة التعليم سنة 1971 إلى فرنسا من أجل تكوين خاص في علوم التربية بالمدرسة العليا للأساتذة (ENS de Saint-Cloud)، وهناك وفي الحي الجامعي "نانطير" (Nanterre Paris X) عشت ثورة جنسية فعلية. كان الحي الجامعي يتميز باختلاط جنسي دون حدود ودون قيود، فلا رقابة ولا موانع. هناك عشت ثورة جنسية بمعناها الشيوعي أي جنسانية شرعية غير زوجية وغير أسرية، عشت حياة جنسية حرة بكل ما في الكلمة من معنى ومن سعادة. كان ذلك في السنة الجامعية 1973- 1974. كانت سنة رايشية بامتياز. بعدها رجعت إلى المغرب وعينت أستاذا للبيداغوجيا في الدار البيضاء. في "المركز التربوي الجهوي". واستمرّيت في خوض المعركة الجنسية كمعركة شخصية حميمية يومية من خلال كل لقاءاتي بمختلف أنواعها. وفي الوقت ذاته نشرت سنة 1975 في جريدة Maghreb Informations التابعة للاتحاد المغربي للشغل أولى مقالاتيJeunesse marocaine et sexualité.
وفي نفس السنة؛ أي (1975)، سجلت موضوعا لنيل "دبلوم الدراسات العليا" (DES) أو ما يعادل دكتوراه السلك الثالث تحت عنوان "الجنس والمجتمع: دراسة نظرية وميدانية" تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد جسوس. وحصلت على الشهادة سنة 1980، وهو ما أهلني إلى الانتقال من درجة "مساعد" إلى درجة "أستاذ مساعد" في شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. وأثناء تحضير تلك الأطروحة الأولى، نشرت الكثير من المقالات في مجلات مغربية مشهورة، كمجلة "لاماليف" و"الأساس"... هكذا أصبحت المعركة الجنسية موضوعا علميا أكاديميا للمرة الأولى في المغرب. ثم في سنة 1981، سجلت أطروحة دكتوراه الدولة بفرنسا في موضوع "المرأة والخطاب في المغرب"، والتي نلتها سنة 1987، وبفضلها أصبحت "أستاذا محاضرا" سنة 1987 ثم "أستاذ التعليم العالي" سنة 1991.
من 1981 إلى 1987، نشرت مقالات أخرى حول الجنسانية المغربية وعن المرأة، كما نشرت سنة 1985 أطروحتي الأولى في كتابي الأول "المرأة والجنس في المغرب"، ثم نشرت كتبا أخرى من سنة 1987 إلى سنة 2023 عن الجنس والمرأة والنَّسوية والإسلام والإسلاموية، ومقالات أكاديمية في مجلات دولية باللغات المختلفة (العربية والفرنسية والإنجليزية). هكذا وقع التحول، أي الانتقال من الجنسانية كقضية- معركة إلى الجنسانية كموضوع بحث علمي سوسيولوجي وأنثربولوجي، وإلى موضوع تأليف ونشر ومحاضرات وخبرات.
لكن لازال هناك منعطف آخر؛ أي كيف حولت الجنسانية من تجربة ذاتية ومسألة سوسيولوجية إلى قضية اجتماعية. إن الدراسات الميدانية التي أنجزتها عن الجنس جعلتني أنادي بالثورة الجنسية في سياق المجتمع المغربي، خاصة وأني اكتشفت أن هناك الكثير من العلاقات الجنسية "الحرة" في المجتمع المغربي. هذا الأمر هو الذي جعلني أنادي بالحرية الجنسية بصفتي مثقفا ملتزما. فالتحليلات التي قمت بها كانت تبين لي بأن ما هو قائم جنسيا في المغرب لا يأبه بتحريم وتجريم العلاقات الجنسية قبل الزوجية وخارج الزوجية والمثلية. فالجنسانية اللاقانونية في المغرب أصبحت واقعا ينبغي التعامل الإيجابي معه من طرف السلطات التشريعية والتنفيذية والتربوية والإعلامية حتى لا يظل ذلك الواقع بئيسا ومصدر ظواهر اجتماعية مرَضِية.
تدريجيا، ومنذ زواجي الثاني سنة1981، اكتشفت أن مطلب القضاء على الزواج والأسرة بشكل نهائي نوع من الطوباوية. ففي الاتحاد السوفياتي نفسه، استمر ذلك المطلب فقط من بداية التجربة الشيوعية سنة 1917 إلى سنة 1924؛ أي إلى حين وفاة لينين واستيلاء ستالين على الحكم. مع ستالين، لا مجال للتراجع عن العلاقات الجنسية الحرة طبعا، لكن مع الاحتفاظ بمؤسستي الزواج والأسرة، بل بتدعيمهما من طرف الستالينية، وهو ما جعل ستالين يمنع الإجهاض سنة 1936 بعد أن كان قد أبيح منذ سنة 1920. سنتان بعد وفاة ستالين أعاد الاتحاد السوفياتي إباحة الإجهاض سنة 1955.
بالنسبة لي كانت مرحلة الشباب مرحلة حلم وخيال وتمرد ومطالبة بالقضاء الكلي على الزواج وتحرير الجنس منه بشكل كلي ونهائي. وتبين لي منذ زواجي الثاني أنه يجب الانتقال من مطلب الثورة الجنسية إلى مطلب الإصلاح الجنسي، وهو مطلب واقعي قابل للتحقيق.
وما معنى الإصلاح الجنسي، دكتور؟
عبد الصمد الديالمي: يعني الإصلاح الجنسي مناداة بحرية جنسية كحق أساسي مبني على التراضي بين الراشدين من كلا الجنسين ومن كلا الاتجاهين الغيري والمثلي. من ثم، يصبح التراضي مبدأ وأساس الشرعية الجنسية. طبعا، وفي الوقت ذاته، من أراد أن يُزَوْجِنَ جنسانيته فمن حقه ذلك، ومن أراد ألا يزوجنها فمن حقه ذلك أيضا. المهم ألا تظل الأسرة بنية تحتكر لوحدها النشاط الجنسي. نعم للأسرة، لكن لأسرة متساوية في الحقوق بين الزوجين. في كلمة واحدة، جوهر الإصلاح هو الاعتراف القانوني والاجتماعي بجنسانيتين، جنسانية زوجية وجنسانية غير زوجية، كلاهما قائمة على التراضي والمساواة، والاعتراف بالمساواة بين الجنسانيتين.
دكتور، هل يمكن أن ينطبق عليكم التقسيم الكلاسيكي للمفكرين، حيث تؤرخ فترة الثورة الجنسية لمرحلة شبابكم، بينما تؤرخ فترة الإصلاح الجنسي لفترة نضجكم؟
عبد الصمد الديالمي: لِمَ لا، فأنت من حقك أن تقوم بهذا التصنيف، فقط أريد أن أؤكد بأن فترة الشباب فعلا عشتها كمرحلة حالمة طوباوية، حاولت فيها القضاء على الأسرة والزواج كتجربة شخصية، كما عشت وناديت وفقا لقناعاتي آنذاك بالحرية الجنسية. والواقع أني دخلت مرحلة النضج والإصلاح الجنسي عند انخراطي في المعركة النَّسَوية. فالثورة الجنسية في عمقها تعني تمكين المرأة من جنس حر، وهذه كانت معركتي دائما؛ لأن المرأة هي ضحية القمع الجنسي بالأساس. أما الرجل، فكان له الحق في أشكال أخرى من المُمارسات الجنسية غير الزوجية دون أن تكون مُجرمة أو مُحرمة أو أن ينظر إليها المجتمع بشكل سلبي. الجنسانية النسائية غير الزوجية هي التي كان ينظر إليها بشكل سلبي، وكان رهاني هو تحرير الجنسانية النسوية من هذا المنظور السلبي، أي تحرير الجنس وتحرير جنسانية المرأة بالأساس. طبعا، كل هذه السمات تؤكد المنظور الشبابي للجنسانية كمنظور ثوري طوباوي حالم.
بدأ دخولي في منظور الإصلاح الجنسي حينما اكتشفت سنة 1983 كتاب ابن عرضون في خزانة القرويين بفاس وعنوانه "مقنع المحتاج في آداب الأزواج ورياضة الولدان" (طبعة حجرية). انبهرت بما كتبه ابن عرضون عن حق الزوجة الشرعي في المتعة الجنسية، وانتبهت إلى أن الإسلام وضع هنا لبنة للحداثة الجنسية. هذا ما جعلني أضع عنوانا فرعيا لكتابي الثاني "المعرفة والجنس". والعنوان الفرعي هو: "من الحداثة إلى التراث"، وقصدت به من "رايش إلى ابن عرضون". كان ذلك بداية القطيعة مع رايش ومع ثورته الجنسية. بفضل ابن عرضون، تبنيت القضية النسائية كقضية قانونية من خلال المساهمة في إصلاح "مدونة الأحوال الشخصية" سنة 1998. دافعت مرات عديدة عن مشروع الإصلاح وتلقيت تهديدات بالقتل من أجل ذلك في صنعاء، على الأقل لجملة لي نشرتها جريدة "الأحداث المغربية"، وهي: "لا اجتهاد مع وجود النص ليس آية وليس حديثا". وبالتالي يمكن بل يجب الاجتهاد، رغم وجود النص. وقبل ذلك، سنة 1984، كنت وبكل تواضع أول من "اكتشف" فتوى ابن عرضون القائلة بإعطاء الزوجة نصف مال الزوج عند وفاته أو عند الطلاق. وسمي هذا الحق بـ "حق الشقا"/ "حق الكد والسعاية". هذه الفتوى نشرتها في كتابي "المعرفة والجنس". كان ذلك مساهمة من طرفي كجامعي وكرجل نَسَوي ملتزم يطالب بالمساواة في الإرث (رغم وجود النص). وأكدت أن الشريعة الإسلامية من خلال الفقه ليست كلها "ظلامية"، بل تتضمن "نوى عقلانية" كما كتبت، نوى تنتصر لحق الزوجة في المتعة الجنسية وفي النصف من مال زوجها مثلا. إن وجود هذه النوى العقلانية في الفقه دفعني إلى محاولة التوفيق بين الإسلام والحداثة الجنسية والجندرية، بين الإسلام وبين الحرية والمساواة... هكذا بدأت الابتعاد عن رايش ودخلت في مرحلة النضج والإصلاح. وأصبحت من حيث لا أشعر نسويا إسلاميا (féministe islamique)؛ أي مساواتياً جندرياً انطلاقا من الإسلام وباسمه. وفي سنة 2010 وفي إطار ندوة في مدريد عن "النسوية الإسلامية"، كانت مداخلتي تحت عنوان "Le féminisme islamique n’a pas de sexe". وقصدت بذلك أن النسوية الإسلامية ليست حكرا على النساء النسويات، بل بدأت مع رجال نسويين إسلاميين مثل ابن رشد وابن عربي وقاسم أمين والطاهر الحداد، ومن ممثليها المغربيين عبد ربه. وفي سنة 2022، نشرت كتابا في باريس تحت العنوان نفسه جمعت فيه كل نصوصي من 1983 إلى 2022 التي تعبر عن تموقعي داخل النسوية الإسلامية.
مشروعكم الفكري والإصلاحي يقوم على ضرورة الانتقال من النصوص التمييزية إلى النصوص المساواتية. في نظركم دكتور، ما هي البنيات التي قد تعيق أو تيسر هذا الانتقال؟
عبد الصمد الديالمي: هي أولًا البنيات العالمة إن صح التعبير؛ أي البنيات الدينية والسياسية التي تعلم. بكل بساطة، لدينا نصان، القرآن والسنة، فيهما نصوص تمييزية وفيهما نصوص مساواتية. فنحن مضطرون إلى الاختيار. لا مجال في نظري للقول إن هناك وحدة نسقية بين كل تلك النصوص. علينا أن نختار، فكيف سنختار؟ طبعا علينا أن نختار النصوص التي تؤكد على المساواة، إما نصًّا وإما تأويلًا وإما اجتهادا. أما النصوص التمييزية، فيجب تعليق العمل بها وتعليق استلهام قوانين منها؛ لأن أسباب نزولها و/أو صدورها قد تجاوزها العصر ولم تبق ملائمة اليوم. وضع الجنسانية ووضع المرأة اليوم تطورا بشكل كبير وعلينا أن نقطع مع التردد. عبرت عن هذا المطلب منذ 2014. وأؤكد مرة أخرى أن القرار ليس بيد الفقيه، وإنما بيد صانع القرار؛ أي بيد السياسي. فهذا الأخير هو المطالَب بقرار الحسم لصالح المساواة الجندرية والحرية الجنسية، وعليه أن يطلب السند العلمي من عند علماء الشريعة والقانون والاجتماع والاقتصاد. إن النص في حد ذاته لا يتكلم، وإنما نجعله يتكلم وينطق بما نقرر نحن.
بتعبير آخر، هناك نزال بين بنيات محافظة حرفية وبنيات غير محافظة اجتهادية، وفي كلتا البنيتين علماء وسياسيين. هنا تكمن بؤرة الصراع والتوتر، لكن السياسي قادر على حسم الصراع انطلاقا من درجة ديمقراطيته. فكلما ارتفعت تلك الدرجة كلما ارتفع ضغطه على العلماء بمختلف تخصصاتهم لتبني الاتجاه المساواتي والتحرري في العلاقات الجنسية والجندرية.
دكتور، مشروعكم الإصلاحي يقوم على ثلاثة أسس هي: الإصلاح الديني أو إصلاح الإسلام، الإصلاح القانوني والإصلاح الاجتماعي. ما هو الخيط الناظم بين هذه الإصلاحات الثلاثة؟
عبد الصمد الديالمي: الإصلاح لا يمكن أن يكون أحاديا خاصة في موضوعي الحرية الجنسية والمساواة الجندرية. إن تحقيق الإصلاح في هذين الموضوعين الحساسين يقتضي إصلاحا ذا أبعاد ثلاثة، ديني، قانوني واجتماعي.
يقوم إصلاح الإسلام كشريعة على قاعدة "الاجتهاد بلا حدود"، على إعطاء الأولوية في عملية الاجتهاد إلى السياق التاريخي والاجتماعي، وعلى الوقوف على خصوصية أسباب نزول كل آية وصدور كل حديث. فإذا تبين لنا أن السياق التاريخي أصبح متجاوزًا، يجب علينا مباشرة أن نتجاوز ذلك النص، رغم "قدسيته"؛ فبزوال العلة يزول الحكم كما قال الشاطبي تأكيدا على أولوية المقاصد وتجاوزا لحرفية المقاربة. فما القصد من تحريم الجنسانية قبل الزواج؟ بكل تواضع كانت لدي جرأة طرح هذا السؤال والإجابة عليه. إن تحريم الجنسانية قبل الزوجية كان بهدف تجنب اختلاط الأنساب والأموال جراء ولادات قبل الزواج أو خارجه. فوسائل منع الحمل كانت شبه منعدمة باستثناء تقنية العزل التي كانت غير فعالة. فالحفاظ على العرض، وهو أحد مقاصد الشريعة يتوقف على نقاء النسب. لذا تم تحريم زنى المحصن/ المتزوجون وزنى غير المحصن/ العزاب. هذا الأمر تغير بشكل جذري في العصر الحديث، حيث أصبحت موانع حمل متوفرة وفعالة جدا، كما توجد آليات طبية للكشف عن نسب المولود وتعيين والده البيولوجي وإمكانية تحويل ذلك الوالد إلى أب شرعي وقانوني. بفضل كل ذلك، يمكن ضمان "الأمن السلالي". ويمكن اللجوء إلى الاجهاض الآمن للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه كحل جذري. لهذا، أنا لا أرى أي أساس للاستمرار في تحريم وتجريم الجنس قبل الزواج والخارج عن إطاره. كما لا أرى أي أساس منطقي أو علمي للاستمرار في تحريم وتجريم الإجهاض الآمن.
باختصار، تم تجاوز العلة التاريخية والاجتماعية التي كانت تبرر تحريم الجنسانية غير الزوجية. من هنا الدعوة إلى اجتهاد لا محدود لإصلاح قراءة الإسلام ـ الشريعة، ذلك النص الحاضر بكل ثقله في القانون الجنائي وفي مدونة الأسرة... كل ذلك في انتظار علمنة مساواتية ومحررة...
أما بخصوص الإصلاح القانوني، أشير في البداية بأن هناك قطيعة بين النص الديني والنص القانوني في بعض المجالات المرتبطة بالجنسانية. مثلًا القانون الجنائي لا يستعمل أبدًا مفهوم الزنا، وإنما يستعمل مفهوم الفساد الذي يعوض مفهوم زنى غير المحصن من جهة، ويستعمل مفهوم الخيانة الزوجية الذي يعوض مفهوم زنى المحصن من جهة أخرى، كما لا يستعمل مفهومي اللواط والسحاق، وإنما يعوضهما بعبارات "أفعال مخلة بالحياء أو مضادة للطبيعة". القطيعة الثانية بين النص الديني والنص القانوني نرصدها بصدد طبيعة العقوبة. فالزنا من الكبائر التي تقود إلى حد الجلد والرجم، أما الفساد والخيانة الزوجية، فمجرد جنح في القانون الجنائي عقوبتهما الحبس والغرامة. أما القطيعة الثالثة، فتتعلق بإثبات الكبيرة/الفعل الجرمي، حيث تقول الشريعة بالشهود الرجال العينيين الأربعة لولوج حشفة الذكر داخل الفرج، أو بالإقرار الطوعي للزاني أو للزانية. أما في القانون، فالإثبات يقوم فقط على قرائن مثل الخلوة ووجود عازل طبي وعري، وهي قرائن يشير إليها محضر الشرطة.
على الرغم من كل هذه القطائع الواضحة بين النص الديني والنص القانوني، هناك ما أسميه "قرأنة القانون الجنائي" من طرف "المواطن" المغربي العادي الذي لا ينتبه إلى القطائع، والذي يخلط بين التحريم والتجريم فيرى في القانون الجنائي احتراماً وتطبيقاً للإسلام. هذا موقف ساذج يرى أن القانون الجنائي يمثل الإسلام. ولهذا أقول إن النص القانوني مُقرأن مقدس يحل محل القرآن. بتعبير آخر، يشكل إسقاط تجريم العلاقات الجنسية غير القانونية في نظر الكثيرين إسقاطا لحكم الله كما جاء في القرآن والسنة. لذلك، أطالب أن نبين للناس أن القانون لا يمثل الإسلام، وأنه في حد ذاته خيانة للشريعة. وبالتالي، على المشرع آن يحذف من القانون الجنائي كل المواد المجرمة للجنسانيات غير الزوجية، وأن يترك المغربي حرّا في اختيار تحريم تلك الجنسانيات على نفسه وبشكل فردي. أما القول إن الإسلام دين دولة في الدستور المغربي، فهذا أمر لا يحتم على الدولة أن تجعل من الشريعة مصدرا أو أحد مصادر القانون الجنائي في تنظيم جنسانية المغاربة.
في كلمة واحدة، الإصلاحان الديني والقانوني يهدفان إلى إسقاط تحريم وتجريم الجنسانيات غير الزوجية وهذا أمر يحتاج أيضا إلى تربية جنسية شاملة.
دكتور، ترون التربية الجنسية مدخلا أساسيا للإصلاح الاجتماعي، لماذا تعطون كل هذه الأهمية لهذه التربية؟
عبد الصمد الديالمي: أركز على التربية الجنسية كأساس للإصلاح الاجتماعي؛ لأنها تشكل أخلاقا جديدة. فهي تسعى إلى تصحيح التمثل السلبي عن الجنس فتعوضه بتمثل أخلاقي غير بطريركي يثمن الجنس ويرى فيه شيئًا جميلًا وأساسًا لسعادة وتبلور الفرد. الأخلاق الجديدة لا ترى في الجنس إثمًا أو خطيئة أو جنابة أو دنسا. قد يزعم البعض بأن التربية الجنسية موجودة في الإسلام. وهذا خطأ. فالتربية الجنسية الموجودة في الإسلام تربية مضادة للجنس في الواقع، فهي تسجن الجنس في الزوجية (أو في ملكية الجواري بالنسبة للرجل). آداب المعاشرة الجنسية كما جاء عند الفقهاء أمثال ابن عرضون مقيد بعقد النكاح/الزواج. لا تشجيع للإسلام على الجنس في حد ذاته ومن أجل ذاته إلا في إطار تعاقد. الزواج و/أو ملكية اليمين هما رخصتان لممارسة الجنس مع الزوجة ومع الجارية (والجنس مع الجارية موضوع "علم" الباه). دون إحدى تلك الرخصتين، وقوع في الزنا. أما التربية الجنسية الشاملة كما تقول بها العلوم الطبية والنفسية، فتقول بمبدأ الرضا والمتعة المتبادلة، وتجنب العنف، والوقاية من الحمل غير المرغوب فيه ومن الأمراض المنقولة جنسيا. هذه التربية الجنسية الشاملة الإيجابية لا تميز بين المتزوج وغير المتزوج؛ لأن الجنس حق إنساني لكل إنسان شريطة عدم الإضرار بالآخر.
في إطار التربية الجنسية الشاملة، يجب إدراج تربية جنسية مضادة للجندرة التمييزية ضد النساء وضد الأقليات الجنسية من مثليين ومزدوجي الاتجاه الجنسي ومتحولين جنسيين. مفاد هذه التربية مساءلة الرجولة المهيمنة التي تستفيد من امتيازات وسلط لكونها مجرد تحويل بطريركي لذكورة مختلفة (عن الأنوثة) إلى ذكورة متفوقة على الأنوثة. من السلط التي منحها النسق البطريركي إلى الرجولة المهيمنة استعمال عنف متعدد الأشكال ضد النساء وضد الأقليات الجنسية. الرهان هو إعادة النظر في المعايير الجندرية التمييزية من أجل بناء رجولة جديدة مساواتية تتخلى عن العنف كأداة للهيمنة والاحتفاظ بالامتيازات؛ ذلك هو رهان كتابي الأخير الذي صدر سنة 2023 تحت عنوان Pour une masculinité non violente à l’égard des femmes.
دكتور، ما يميز الأعمال السوسيولوجية المغربية هو الترحال الموضوعاتي، لكن أعمالكم تتميز بالاستقرار الموضوعاتي، ما هي الهواجس المتحكمة في ذلك؟
عبد الصمد الديالمي: سأعطيك مثالا بسيطا. حينما تحصل على دكتوراه في الطب العام، فأنت طبيب عام. الطبيب العام يبقى طبيبا عاما كما بإمكانه أن يكمل دراسته في تخصص ما. نفس الشيء بالنسبة إلى عالم الاجتماع. لا يمكن أن تكون عالم الاجتماع إلا بحصولك على شهادة دكتوراه في تخصص معين، والدكتوراه هي أول خطوة في التخصص. ولكي تتحكم في التخصص وتعطي فيه أكثر، يجب أن تستمر فيه بنفس طويل. إذن لماذا يؤاخذني البعض على الاستمرار في نفس الموضوع؟ أعتقد أن ذلك البعض لا يهمه استمراري في نفس الموضوع بقدر ما يهمه استمراري في الاشتغال عن الجنس. في الواقع، يعكس التحفظ اتجاه أعمالي تحفظا من نقذي للإسلام الحرْفي ومن تهجمي الذي يزعمونه على المقدس. من جهة أخرى، يرى البعض أن موضوع الجنس موضوع حقير لا يرقى إلى مرتبة الموضوع العلمي ومن هنا يعبرون لاشعوريا عن موقفهم السلبي من الجنس. هؤلاء "المنتقدون" لا يدركون أن موضوع الجنس ليس قابلا للاحتكار من طرف الطب وعلم النفس، بل هو اليوم موضوعا سوسيولوجيا أكاديميا بامتياز؛ لأن الجنسانية نسق من العلاقات ما بين - الفردية الموسومة بالهيمنة والاستغلال، فهي مرآة للعلاقات الاجتماعية التفاعلية التي تعبر عن وظائف والتي تؤطر في بنيات ومؤسسات. أكثر من ذلك، موضوع الجنس لا يمكن الإحاطة به من طرف ما يسمي "سكسولوجيا/علم الجنس" (sexologie)، فالسيكسولوجيا مقاربة متعددة وما - بينية التخصصات تقتضي بالضرورة إشراك الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع/الأنثروبولوجيا وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ والجغرافيا والفلسفة... باختصار، أنا أشتغل على الجنس كعالم اجتماع متخصص وأنا وفيُّ لتخصصي قصد إغناء التخصص وتنوير الرأي العام ومساعدة صناع القرار على سن سياسات جنسية عمومية تخدم الصالح العام.
دكتور، كيف تتوزع أعمالكم بين ما يمكن تسميته سوسيولوجيا المعرفة وسوسيولوجيا الخبرة؟
عبد الصمد الديالمي: ذلك التوزع أمر طبيعي في مسيرة كل عالم اجتماع؛ حرفة عالم الاجتماع تقتضي منك أولا أن تنزل إلى الميدان قصد تشخيص الواقع بشكل موضوعي. في هذا الصدد، قمت بالعديد من الأبحاث الميدانية. كان أولها ذلك البحث الذي أنجزته في الدار البيضاء لإعداد دبلوم الدارسات العليا سنة 1975، وبكل تواضع كان ذلك أول بحث ميداني عن الجنس في المغرب. من أهم أبحاثي الميدانية الأخرى البحث الذي أظهر دور العامل الجنسي في تشكل الشخصية الإسلاموية المتطرفة العنيفة سنة 1993، ثم البحث حول المواقف والسلوكيات الدينية سنة، 1995 والبحث في السلوكيات الجنسية لدى الشباب المغربي وعلاقاتها بخطر السيدا سنة 1997، والبحث الذي سائل لأول مرة الرجولة المهيمنة في المغرب سنة 2000 وكان سببا في تلقي تهديدات بالقتل في مدينتي خنيفرة ووجدة. وكمتخصص في الجنس والجندر والنَّسوية، طلبت مني بعض المؤسسات والجمعيات إنجاز خبرات في مواضيع الأمراض الجنسية المنقولة وموت الأمهات وإشراك الرجال في مناهضة العنف ضد النساء والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية للعنف القائم على الجندر ومأسسة مقاربة الجندر في بعض القطاعات الوزارية... من خلال أبحاث ميدانية عدة. في كل هذه الأبحاث، سواء الشخصية أو الاستشارية، حرصت على أن أكون أكاديمياً على مستوى المنهج وعلى مستوى التحليل وعلى مستوى التحرير، دون أدنى تنازل، دوما.
بفضل الانغماس السوسيولوجي التشخيصي في الميدان، تمكنت من ممارسة نقد السياسات العمومية في حقلي الجنس والجندر والنَّسوية من جهة ومن بلورة توصيات قصد إصلاح تلك السياسات العمومية من جهة أخرى. تنتهي مهمة عالم الاجتماع الخبير عند صياغة النتائج وكتابة التقرير. أما توظيف البحث من طرف الجهة الطالبة للبحث شيء لا يهم عالم الاجتماع وليس من مسؤوليته. إن شاءت تلك الجهة أن تنفذ التوصيات أو لا فذلك لا يهم الخبير، كما لا يهمه أن تتدخل تلك الجهة في تغيير نتائج البحث. المهم أن يقوم عالم الاجتماع الأكاديمي بالخبرة مع احترام كل شروط وقواعد العمل الأكاديمي، وبهذا يكون وفياً لضميره المهني والأخلاقي.
لكن حرفة عالم الاجتماع لا تقف عند التأرجح بين النقد والبناء، بين التشخيص والتدبير، خصوصا عندما تمارسها كأستاذ جامعة، داخل الجامعة وخارج الجامعة. من ثم تصبح حرفة تفرض عليك صياغة مفاهيم ونظريات تمكن من تفسير وفهم الواقع. إن علم الاجتماع دون ميدان يكون معرفة جوفاء، وهو دون مفاهيم ونظريات يظل معرفة عمياء. لا تناقض بين المعرفة والخبرة ولا تنافر بينهما في مسيرتي كعالم اجتماع. لذا، ما فتئت طيلة مسيرتي "السوسيولوجية" أنتج مفاهيم نظرية و/أو نقدية وأحاول التنظير قدر المستطاع. وهذه لائحة مختصرة لتلك المفاهيم النقدية والتنظيرية: التمييز بين الكتابات السوسولوجية السعيدة، القلقة والفرحة (1984)، موضوعا المرأة والأسرة مدخلان مؤسساتيان/حجابان لدراسة الجنس في المغرب قبل ظهور السيدا، النَّسوية محرك للإصلاح الديني (2000)، اجتهاد بلا حدود، أسس جديدة لاجتهاد جديد (2001)، التمييز بين المعارضة النِسائية (féminine) الأبيسية في التراث والمعارضة النسوية (féministe) في الحداثة (1984)، النَّسوية الكولونيالية المعادية للإسلام (1986). المرأة الوسيلة لإضفاء شرعية دينية على مؤسس الدولة المرينية (1998)، أربع أنماط للعلاقة بين الجنس والمجال (الرمزي، اللسني، الترابي والوظيفي) سنة 1989، الحركة الإسلاموية المغربية من الثورية (حركة اجتماعية ساخنة) إلى الاندماج 1997، مفهوم "الحريك نحو الجنة" سنة 2003، البناء الثقافي للأمراض المنقولة جنسيا (1997)، الترميق الجنسي – المكاني (1997)، البورنوغرافيا أو المعلم الجنسي السيئ للمغاربة (1997)، المفهوم الاجتماعي للعذرية (1997)، استعمال العازل الطبي مع غياب الأخلاق المدنية (1997)، التربية الجنسية ضرورة عمومية (1998)، العمل الجنسي كحل لا مهيكل للبطالة (1998)، الزمن الديني كسبب في وفيات الأمهات (1999)، تواطؤ جزء من اليسار المغربي في إعادة إنتاج الإيديولوجيا الجنسية البطريركية (2006)، مفهوم الانفجار الجنسي ونظرية الانتقال الجنسي (2007)، الإخفاء المالكي المغربي لحلية الإجهاض في المذاهب الفقهية السنية الأخرى (2010)، مفهوم الأمن السلالي أو البكارة كمانع أبيسي ضد الحمل (2012)، العنف الجندري، تكلفة مالية هائلة على عاتق الأفراد والأسر (2013)، عمل المرأة في البيت نفقة على البيت (2016)، نحو ميلاد مثلية هوياتية (2014)، النسوية الرجولية (2018)، قرآنة القانون الجنائي (2021)...
شكرا د. عبدالصمد الديالمي على ما منحتني من وقتك وجهدك في هذا الحوار الفكري. ولكن، ماذا أنت قائل، لو طلبت منك كلمة مركزة نختتم بها حوارنا هذا؟
عبد الصمد الديالمي: صراحة أنا سعيد جدّاً لكوني، انطلاقًا من حياتي الشخصية، عثرت على مشروع فكري تحول إلى هدف استراتيجي في حياتي الشخصية والمهنية والعلمية. لذلك أصبح عملي ممتعا. في الجامعة، كنت أمارس عملي بكل قناعة وبكل متعة. والآن خارج الجامعة أمارس حرفتي كعالم اجتماع بقناعة ومتعة أيضا. لذلك أشعر بنوع من الفخر؛ لأني لم أخن أبدًا مبادئي... ولا ارتشيت ولا طأطأت الرأس من أجل مصلحة ما... هنا تحضرني قولة جميلة لألبير كامو مفادها "القناعات التي نعيش من أجلها هي نفسها القناعات التي نموت من أجلها".