أحداث دمشق: مذبحة وتدمير العالم العثماني القديم
فئة : قراءات في كتب
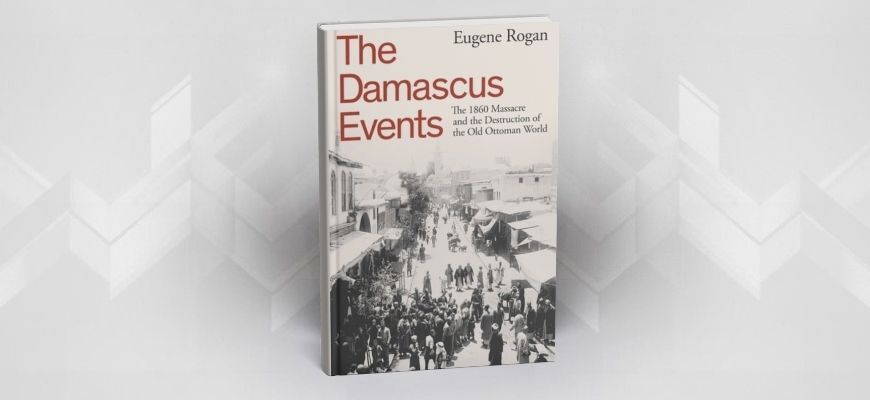
أحداث دمشق: مذبحة وتدمير العالم العثماني القديم
أولًا: مقدمة
في صيف عام 1860، دخل مجموعة من الفتيان المسلمين إلى حي باب توما ذي الغالبية المسيحية، وقاموا باستفزاز أهالي الحي بالصراخ ورسم الصليب بالدهان الأحمر على الأرض وعلى أبواب البيوت. فتقدم أهالي الحي بالشكوى إلى الوالي العثماني، الذي أمر باعتقال الشباب وإجبارهم على تنظيف الطرقات. على الرغم من ذلك، فإن المشهد تكرر في اليومين التاليين ورافقته عبارات الصراخ الطائفي من أهالي الفتيان مثل: "يا يا أمة محمد، المسلمون يكنسون حارة النصارى! لم يبقَ إسلام في الشام...لم يبقَ إسلام"، و"يا غيرة الدين"... ثم انفجر الوضع بشكل مفاجئ، وهجم أهالي الأحياء المجاورة بالمسدسات الحربية والسيوف والفؤوس على الحي المسيحي. انسحبت وحدات الحماية العثمانية من الحي، وجرت مذبحة راح ضحيتها ربع المجتمع المسيحي في دمشق، كما رافقتها أعمال اغتصاب ونهب وحرق للبيوت والأرزاق والمصانع والكنائس، وكذلك القنصليتان الروسية والأمريكية، كما يذكر المؤرخ السوري سامي مروان المبيض[1].
وفي كتابه الصادر باللغة الإنكليزية سنة 2024 بعنوان أحداث دمشق مذبحة 1860 وتدمير العالم العثماني القديم[2] يتناول المستشرق والمؤرخ البريطاني يوجين روغان الخلفية التاريخية، الاقتصادية، السياسية والاستعمارية وراء وقوع هذه الأحداث المروعة. فتش روغان في مصادر عديدة من تلك الحقبة، كالمراسلات الدبلوماسية والأوراق القنصلية، وشهادات الشهود. وركز روغان بشكل رئيس على المذكرات الشخصية التي كتبها ميخائيل مشاقة عن المجزرة، بالإضافة إلى المراسلات التي كتبها مشاقة في معرض عمله، حينما كان يعمل نائب قنصل للولايات المتحدة الأمريكية وكتب هذه المراسلات لرئيسه ج. أوغسطس جونسون المقيم في بيروت آنذاك.
ثانيًا: أهمية الكتاب
إن أحداث 1860 دمشق شغلت العديد الباحثين خصوصًا في الآونة الأخيرة؛ فقد تناول العديد من المؤرخين والباحثين هذه الأحداث من منظورات وسياقات مختلفة؛ وذلك اعتمادًا على روايات شهود عيان عاصروا المجزرة، أو ممن نجوا منها. ويكمن الفرق الذي يميز بحث كل واحد منهم عن الآخر بالحافز الشخصي الذي يقف وراء دافع كل واحدٍ منهم للكتابة عن هذه الأحداث المؤلمة. فبالنسبة إلى الباحث السوري سامي مروان المبيض، والذي ينتمي إلى المدينة نفسها، يبدو أن حافزه وطنيًا؛ إذ يقر في مقدمة كتابه أن الرغبة في الاعتراف بالجزء السلبي من ماضي المدينة بغية التعلم منه[3] هو ما دفعه لكتابة كتابه الذي صدر عام 2021 بعنوان نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860. أما الباحثة رنا أبو مؤنس التي صدر لها عن مطابع بريل اللندنية عام 2022 كتابًا باللغة الإنكليزية بعنوان العلاقات الإسلامية المسيحية في دمشق في ظل أعمال الشغب عام 1860 فيبدو أن الحافز لديها تحليليًا بحتًا. وتستبعد أبو مؤنس البعد الديني كسبب مباشر للمذبحة، على الرغم من أن معظم مرتكبي المذبحة من المسلمين وكل ضحاياها من المسيحيين؛ فالدين بحسب أبو مؤنس كان عاملًا مؤثرًا وليس سببًا مباشرًا. أما السبب المباشر وراء تلك الأحداث فهو الاقتصاد[4].
وعلى الرغم من وفرة الكتابات عن المذبحة، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية كتاب يوجين روغان، موضوع هذه المراجعة. ويمكن اعتبار كتاب روغان تجميعًا للأجزاء المختلفة للصورة التاريخية للحدث. فالكتاب يتميز عن الكتب والدراسات التي صدرت قبله وتناولت الأحداث نفسها، بشغف الكاتب للإلمام بكافة جوانب الأسباب التي أدت إلى وقوعها، والوقوف على سياقاتها المتعددة، دينيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا، سياسيًا واستعماريًا. فاعتمد يوجين على مذكرات مشاقة كمصدر أساسي لبحثه، وذهب إلى البحث والتنقيب في معظم الأوراق التي عاصرته؛ وذلك لتحقيق مذكرات مشاقة ووضعا في سياقها التاريخي الصحيح. جمع الكاتب أوراق ومراسلات مشاقة القنصلية من الأرشيف الوطني الأمريكي، ثم سافر إلى دمشق فكان يقضي وقته بين مكتبتها الوطنية ومكتبة المعهد الفرنسي في دمشق بحثًا في أرشيفهما عن أوراق لتلك الحقبة، سواء أكانت شهادات عيان أو مراسلات قنصلية ودبلوماسية فرنسية عن تلك الحقبة. كما زار أرشيف الجامعة الأمريكية في بيروت لجمع الأطروحات التي تتناول الموضوع نفسه، ثم اتجه يوجين إلى إسطنبول للبحث في الأرشيف العثماني عن أحوال السلطة العثمانية قبل وبعد المجزرة وردة فعلها تجاه تلك الأحداث. وبالإضافة إلى مذكرات مشاقة، وقف يوجين على شهادات شخصيات بارزة في المدينة عاصرت المذبحة، وكان لها دور في حماية المسيحيين في المدينة، في مقدمتهم الأمير عبدالقادر الجزائري (ص ص12-13).
ثالثًا: تعيين ميخائيل مشاقة نائب قنصل للولايات المتحدة في دمشق
لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر بتلك القوة التي تنافس القوى الأوروبية في أراضي الدولة العثمانية، ولم يكن لها سوى نصيب هامشي من التجارة في دمشق أمام توغل البريطانيين والفرنسيين فيها. ولذلك، فقد أراد السفير الأمريكي في لبنان ج. أوغسطس جونسون افتتاح بعثة دبلوماسية في دمشق من أجل تسهيل التجارة الأمريكية فيها. وقد كان من المعتاد أن توظف البعثات الأجنبية في أراضي الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر دبلوماسيين محليين من المسيحيين أو اليهود كممثلين لها لدى السلطات العثمانية. وكان ميخائيل مشاقة (1800-1888)، المولود في لبنان لأسرة يونانية كاثوليكية، ويعيش منذ عام 1834 في دمشق، وهو من أفضل الأشخاص تعليمًا في المدينة وأكثرهم كفاءة لتولي المهام القنصلية للولايات المتحدة الأمريكية هناك (ص ص18-19). يصف يوجين مشاقة في مقدمة كتابه بأنه: "كان رجل نهضة حقيقي، عمل في قصور أمراء لبنان وتدرب كطبيب. نشر العديد من الكتب والرسائل في اللاهوت والفلسفة وحتى في نظرية الموسيقى العربية. ومن أشهر أعماله هو تاريخ سوريا ولبنان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" (ص2).
بدأ مشاقة حياته المهنية، عندما كان في السابعة عشر من عمره، عندما رافق أخواله في سفرهم للتجارة إلى دمياط، وتعلم منهم أساليب التجارة. ودخل العمل السياسي في سن مبكرة حينما عمل في قصر آل الشهابي، العائلة التي تحكم جبل لبنان منذ العام 1697. ومن خلال عمله هذا، بنى خبرة سياسية جيدة بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة مع شخصيات عامة في المنطقة من مختلف المجتمعات الدينية، الدروز، المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك، الشيعة والسنة. وعندما دخل الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا إلى سوريا ولبنان عام 1831 ووقف الشهابيون بقيادة الأمير بشير الثاني الشهابي مع إبراهيم باشا، ورافق مشاقة الشهابيون في الحملة العسكرية إلى دمشق. ومع وقوع عدد كبير من الجرحى في معركة حمص في الجيش المصري عاد مشاقة إلى ممارسة مهنته الثالثة، وهي الطب، حيث درس مشاقة مبادئ الطب من الكتب المترجمة إلى العربية عام 1828 حينما عانى لأشهر من مرض الملاريا، كما أنه كان أثناء خدمته لدى الأمير بشير الثاني الشهابي يرافق الطبيب الإيطالي الخاص بالأمير بشير وتعلم منه بعض الخبرة الطبية. وبسبب قلة الأطباء والأعداد الكبيرة من الجرحى في معركة حمص 1832 فحتى مجرد رجل عادي مع معلومات طبية أساسية ينفع أن يكون طبيبًا (ص25).
وفي عام 1834 قرر مشاقة الإقامة نهائيًأ في دمشق، فعمل فيها كطبيب وتزوج ابنة ميخائيل فارس، أحد وجهاء الطائفة الكاثوليكية اليونانية في دمشق. بنى مشاقة شبكة علاقات واسعة مع وجهاء المدينة، وأصبح محط احترام الجميع. حينما قرر السفير الأمريكي في لبنان جونسون افتتاح قنصلية في دمشق عام 1859، لم يكن ليجد أفضل من ميخائيل مشاقة للعمل كنائب للقنصل؛ فالرجل معروف بحنكته السياسية، خبرته التجارية التفاوضية، وشخصيته الكاريزمية الاجتماعية في المدينة. علاوةً على أنه محط دعم البعثات التبشيرية البروتستانتية لهذا المنصب، فالرجل كان متمرّدًا على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية الشرقية بعد ما تأثر بكتابات رواد التنوير الأوروبي التي ترجمتها البعثات التبشيرية نفسها للغة العربية. وقد أوصت البعثة التبشيرية الأمريكية به فجاء في تقريرها، تعليقًا على نقاش ديني حاد جرى بين مشاقة وبين البطريرك الكاثوليكي المحلي: "صديقنا السيد مشاقة، ربما يكون أكثر علمانيي البلد ذكاءً، والبطريرك هو أكثر رجال الدين علمًا. كان النقاش بينهما بمثابة معركة بين العمالقة حيث جذب الانتباه من جميع الجهات وباهتمام كبير لما يجري بينهما" (ص28).
رابعًا: السياق التاريخي للمذبحة
التزمت دمشق في العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقليات غير المسلمة في دمشق بشكل صارم بقواعد الشريعة الإسلامية خلال فترة الحكم العثماني. وقد احترم المسلمون بشكل كامل حياة وممتلكات السكان المسيحيين واليهود، وكان المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون في نفس الأحياء، ويمارسون نفس الأعمال، وكانت متاجرهم مختلطة في الأسواق. ومع ذلك، فإن المساواة في الأعمال والعلاقات المالية لم تكن لتشمل العلاقات الاجتماعية، فقد كانت الأغلبية المسلمة في المدينة تفرض قواعد صارمة للسلوك واللباس على المسيحيين واليهود، وتؤكد تفوق المسلمين على غير المسلمين. ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر حينما خضعت دمشق لسيطرة إبراهيم باشا، بدأت المدينة تشهد تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة من شأنها أن تحول النظام الاجتماعي التقليدي، وتخلق جوًّا من التوترات بين المسلمين وغير المسلمين.
1- القنصليات الغربية في دمشق منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر:
كان لكل القوى الغربية قنصليات في مصر تحت حكم محمد علي، وبعد أن أصبحت سوريا تحت سيطرته أصبحت الفرصة سانحة لهذه القوى لافتتاح قنصليات لها في دمشق. وفي الواقع كانت بريطانيا قد عينت ويليام فارين قنصلًا لها في دمشق منذ 1830، لكنه لم يجرؤ على دخول المدينة حتى عام 1834 تحت حماية قوات محمد علي؛ وذلك لأن النخب الدمشقية كانوا يشعرون بالريبة تجاه القنصليات الأوروبية ويكنّون لها البغضاء. وقد اعتبرت جريدة التايمز البريطانية دخول فارين إلى دمشق وقتها انتصارًا؛ إذ وصفت مشهد دخوله المدينة في تقريرها الإخباري: "اصطف المتفرجون على جانبي شوارع المدينة، وكانت نوافذ وأسقف المنازل مزدحمة وكان الناس يقفون حتى اثنين وثلاثة على حواف المحلات التجارية. لم يسبق أن شاهد أحد مثل هذا المشهد في دمشق، والتي ظلت منزهة عن اللباس والعادات الأوروبية، واعتبارها مدينة مقدسة حتى دخول السيد فارين. ولم يكن يُسمح لأي شخص قبل الآن بدخولها على ظهر حصان" (ص58). وكانت مسألة دخول غير المسلم إلى دمشق مسألة حساسة بالنسبة إلى المسلمين؛ إذ إنه من بين القيود الاجتماعية على غير المسلمين بأنه لم يكن مسموحًا لغير المسلمين بركوب الخيل حتى لا ينظر إلى المسلم من مكانة أعلى.
وتبع افتتاح القنصلية البريطانية في دمشق افتتاح قنصليات أجنبية أخرى، فافتتح الفرنسيون قنصلية عام 1839، وتبعتها النمسا عام 1840، والروسية عام 1846، وافتتحت الإمبراطورية البروسية (الألمانية) قنصلية لها عام 1849، وفي الخمسينيات من القرن نفسه افتتحت هولندا واليونان قنصليات لها في المدينة. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت آخر الواصلين تقريبًأ حينما افتتحت قنصليتها عام 1859 في دمشق وعينت ميخائيل مشاقة نائبًا قنصليًا لها هناك.
2- التجارة الغربية في دمشق:
كانت الدول الأوروبية ترغب في افتتاح قنصليات لها في دمشق لأغراض تجارية أكثر منها لأغراض دبلوماسية. فكانت دمشق وحلب أهم المراكز التجارية في الشرق في تلك الفترة، وكانت أسواق المدينتين الأكثر ربحية. وفي غضون سنوات قليلة، تمكن القناصل الأوروبيون كل منهم بتعزيز تجارة بلده في سوريا، وتحصيل امتيازات تجارية وإعفاءات ضريبية لمواطنيه التجار من الدولة العثمانية، على حساب تجار المحليين في دمشق. فقد تدفقت الأقمشة القطنية والصوفية الأوروبية إلى دمشق، وقد كانت أرخص بكثير من تلك المصنعة محليًا، وهذا ما ترك أثر سلبي كبير على الصناعة المحلية للأقمشة. بالإضافة إلى ذلك، فقد واجه النساجون المحليون مشكلة ثانية في صعوبة تأمين المواد الخام، حيث كان التجار الأوروبيون يشترون القطن الخام والصوف والحرير لملء سفنهم كي لا تعود فارغة إلى الديار؛ وذلك تسبب بإزاحة الكثير من النساجين المحليين من السوق، وساهم في إفقار الكثير من التجار خصوصًا المسلمين. (ص61).
3- تحول قوافل الحج عن الطرق البرية إلى الطرق البحرية بفعل السفن البخارية الأوروبية:
ليست البضائع وحدها ما كان يغري البريطانيين والفرنسيين في الشرق، وإنما قطاع النقل البحري أيضًا. في عام 1835 أسس البريطانيون أول مركز للشحن بالبخار إلى الشرق عبر المتوسط، تبعهم الفرنسيون عام 1837، والنمساويون عام 1839، وبحلول عام 1841 كان هناك أكثر من خمس وسبعين سفينة بخارية أوروبية تبحر في المتوسط. وكانت الرحلات عبر السفن البخارية أكثر أمانًا ويقينًا من السفن الشراعية من جهة، ومن جهة ثانية خفضت أوقات الرحلات بشكل كبير. ونمت السفن البخارية على مدار أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر بشكل كبير، ما ساهم في خفض تكاليف السفر والشحن. كان من شأن ذلك أن يتحول الكثير من المسلمين لأداء فريضة الحج عبر البحر عن الطرق البرية التقليدية التي تمر من دمشق. فانخفض عدد الحجاج الذين يدخلون دمشق كل عام من حوالي عشرين ألف سنويًا إلى حوالي ستة آلاف بحلول عام 1845، وفي مطلع الخمسينيات أفاد القنصل الفرنسي في دمشق بأن عدد القوافل المغادرة من دمشق لم تتجاوز الألفين وخمسمائة حاج. كان لذلك تداعيات سلبية على التجارة المحلية، حيث كانت القوافل التجارية ترافق قوافل الحجاج القادمة من الشرق، فكانت الأسواق الدمشقية تزدهر ذهابًا وإيابًا من قوافل الحج. بالإضافة إلى ذلك، كان لانخفاض قوافل الحج التي تمر من دمشق آثار ثقافية وروحية مرتبطة بالمدينة، حيث كانت تُقام احتفالات ثقافية ودينية كبيرة ابتهاجًا بقوافل الحجاج التي تمر من المدينة، فكانت هذه الاحتفالات تتقلص سنويًا (ص63).
4- تنامي قوة الأقليات في دمشق:
ربما يكمن التغيير الأهم في المدينة هو تنامي قوة الأقليات الدينية، والذي يمكن النظر إليه كنتيجة للتغييرات السابقة. حينما سيطر إبراهيم باشا على دمشق عام 1832، أدخل مفاهيم المساواة القانونية بين المسلمين وغير المسلمين. وشكلت هذه المفاهيم، التي تم العمل بها بشكل فعلي في مصر، بمثابة صدمة للمسلمين في دمشق، وأثارت استياءهم بشكل كبير. ويصف المستشرق الفرنسي ألفونس دو لامارتين تلك الفترة: "المسلمون في دمشق كانوا مستائين من المساواة التي شرعها إبراهيم باشا بينهم وبين المسيحيين. كما أن بعض المسيحيين استغلوا التسامح الذي تمتعوا به لإهانة أعدائهم بانتهاك عاداتهم وأعرافهم بشكل مباشر، ما أذكى مرارة التعصب بين المسلمين" (ص65). لم تكن إصلاحات إبراهيم باشا وحدها من عزز من قوة الأقليات، إنما توسع التجارة الأوروبية في دمشق. فقد اعتمد التجار الأوروبيون على عملاء محليين لإدارة تجارتهم، وقد كان الأوروبيون المسيحيون ومثلهم اليهود يوظفون أبناء دينهم للعمل لديهم في إدارة شؤونهم التجارية.
وإن أحداث دمشق الدموية 1860 لم تكن حدثًا منفصلًا، إنما جزء من أحداث عنف طائفية أوسع في أماكن عدة من أرجاء الدولة العثمانية خصوصًا بين المسيحيين والمسلمين منذ القرن التاسع عشر. فمنذ أربعينيات القرن التاسع عشر، شهد جبل لبنان صراعا طائفيا بين سكانه الدروز والموارنة. فقد سكن الدروز والموارنة لبنان عبر التاريخ جنبًا إلى جنب، وقد خضع لبنان تاريخيًا لسيطرة العوائل الدرزية. وفي القرن السابع عشر اكتسب الموارنة الحماية الفرنسية بوصفهم مجتمعا كاثوليكيا، لكن فرنسا عززت علاقتها بالموارنة منذ القرن التاسع عشر لحماية مصالحها الإمبراطورية في شرق المتوسط. وبعد خروج قوات إبراهيم باشا من سوريا ولبنان سعى الموارنة عام 1841 بقيادة البطركرية في لبنان إلى تأسيس نظام جديد يهيمن عليه المسيحيون تحت قيادة أمير ماروني وطرد الدروز من جبل لبنان بالكامل، ما أدى إلى موجة أولى من الأحداث الطائفية راح ضحيتها أكثر من 250 قتيل من الطرفين (ص103-106).
5- معارضة التنظيمات العثمانية:
مع بدايات القرن التاسع عشر، أصبحت الدولة العثمانية في حالة ضعف اقتصادي وعسكري أمام جيرانها الأوروبيين، كما لم تعد قادرة على ضبط المتمردين في الداخل. وانخفضت كفاءة الجيش بشكل كبير نتيجة عجز موارد الدولة الحالية على إمداد الجيش بالتمويل الكافي. أدرك العثمانيون حينها أن الدولة في حاجة إلى إصلاحات ضرورية، خصوصًا في المؤسسة العسكرية لرفع كفاءة الجيش، وإصلاح الجهاز الإداري ليستوعب قوانين ضريبية حديثة ترفد خزينة الدولة بالموارد المالية اللازمة. كما كان هناك حاجة ماسة لتحديث التعليم لتزويد الدولة بموظفين أكثر كفاءة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. في عام 1839 أطلقت الدولة مرسوم التنظيمات، والتي كانت بداية عصر جديد من الإصلاح لتحويل الإمبراطورية العثمانية من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية. وركز المرسوم على ثلاث نقاط رئيسة؛ الإصلاح الاجتماعي والمساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية، الإصلاح المالي وإنشاء نظام ضريبي جديد، وإصلاح شروط الخدمة العسكرية (ص79-80).
ولاقت التنظيمات العثمانية معارضة شديدة من رعايا الدولة، حينما بدأت هذه التنظيمات تمسّ حياتهم اليومية. فقد قاوم الرعايا العثمانيون جهود الدولة لتسجيل أسماءهم في سجلات الدولة بسبب خوفهم من الضرائب والتجنيد الإجباري. وتهرب المزارعون من تسجيل أراضيهم في سجلات الدولة لأطول فترة ممكنة. كما ندد المسلمون المحافظون بالتنظيمات؛ لأنها تدخل أفكارًا غير إسلامية إلى الدولة والمجتمع. وكانت القضية الأكثر حساسية هي التغييرات التي طرأت على الأوضاع القانونية للمسيحيين واليهود بموجب مرسوم الإصلاح لعام 1856، خصوصُا وأن القوى الأوروبية كانت تستخدم حقوق الأقليات على مدار القرن التاسع عشر كذريعة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية. أرادت الدولة العثمانية من مرسوم المساواة بين المسلمين وغير المسلمين أن تكف يد الدول الأوروبية عن التدخل في شؤونها الداخلية بحجة حماية الأقليات. لكن من جهة أخرى، كان هذا المرسوم هو المرسوم الأول من مراسيم الإصلاح الذي يتعارض مع حرفية النص القرآني الذي ينص على التمييز بين المسلمين وغير المسلمين (ص87).
خامسًا: رؤية نقدية في الكتاب
يمثل الكتاب إضافة مهمة إلى البحث التاريخي ليس في أحداث المذبحة فحسب، وإنما في تاريخ سوريا ولبنان خلال الحكم العثماني؛ إذ رجع الكتاب للتمحيص في تاريخ المنطقة منذ القرن الثامن عشر؛ وذلك من أجل فهم أحداث مذبحة من خلال سياقاتها التاريخية بشكل دقيق ومدروس. ومذبحة دمشق 1860 بالنسبة إلى الكتاب هي جزء من صورة أكبر في تاريخ الدولة العثمانية، ونتيجة من نتائج عدة لما كان يجري في تلك الحقبة من تحولات كبيرة في الشرق العثماني وعلاقته مع الغرب الأوروبي على حد سواء. ومذبحة دمشق ليست حدثا منفصلا بذاته، وإنما جزء من أحداث عنف طائفية، خصوصًا بين المسلمين والمسيحيين، ضربت عدة أجزاء في الدولة العثمانية منذ القرن التاسع عشر. ولا يمكن البحث في الأسباب الخاصة وراء هذا الحدث فحسب دون البحث في الأسباب الكامنة وراء هذه الأحداث بشكل أعم وأوسع. وهذا ما فعله يوجين روغان في هذا الكتاب؛ إذ إنه حقق أولًا في شهادة مشاقة عن المذبحة، ثم وضع هذا الحدث في سياقاته التاريخية الدينية، السياسية، الاجتماعية والاستعمارية.
يؤخذ على الكتاب بأنه يفسر حرب لبنان الأهلية (1975-1990) على أنها امتداد بشكل أو بآخر للأحداث الطائفية الدموية في لبنان وسوريا خلال الحكم العثماني في الربع الثاني من القرن التاسع عشر. يرى يوجين أن السلطات العثمانية كانت تترك إدارة شؤون المناطق للسلطات المحلية العشائرية والزعامات القبلية. ولم يكن لدى هؤلاء سياسة أيدلوجية في إدارة نزاعاتهم مع بعضهم البعض، ولا في إدارة نزاعاتهم مع السلطة العثمانية، واتبع هؤلاء الزعماء السياسة الواقعية في إدارة علاقاتهم مع الدولة العثمانية من جهة وفي إدارة شؤون مناطقهم من جهة أخرى. وقد جرت حرب لبنان الأهلية عام 1975 بشكل مشابه لما جرى في لبنان وسوريا من أحداث عنف طائفي في القرن التاسع عشر (ص9). ويبدو أن يوجين يبني تفسيره هذا اعتمادًا على مبدأ الحتمية التاريخية الذي يقول إن التاريخ البشري لا يمكن أن يسير إلا بالمسار الذي سار به في ظل الظروف والسياقات التي حدثت به. وهذا، برأيي، خطأ يقع فيه العديد من المستشرقين والمحللين الغربيين في معرض تفسيرهم للأحداث المعاصرة في الشرق وربطها في سياقات تاريخية غير كافية بمفردها لتقديم إجابات وافية عن الأحداث المعاصرة. فالزعامات اللبنانية المشاركة في الحرب الأهلية (1975-1990)، كانت تدير شؤونها بسياسات أيدلوجية إلى حد كبير. وهذا يخالف مبدأ الحتمية التاريخية الذي يعتمده يوجين لتفسير الحرب الأهلية اللبنانية نهايات القرن العشرين بناءً على أحداث القرن السابق.
المراجع:
*- بلغة أجنبية:
Rogan. Eugene, The Damascus Events: The 1860 Massacare and the Destruction of the Old Ottoman World, (UK: Penguin Books, 2024).
Abu-Mounis. Rana, Muslim-Christian Relations in Damascus amid the 1860 Riot, (London: Brill, 2022).
*- بلغة عربية:
المبيض. سامي مروان، نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860، ط1، (بيروت: دار الريس، 2021).
[1] سامي مروان المبيض، نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860، ط1، (بيروت: دار الريس)، ص17-20
[2] Eugene Rogan, The Damascus Events: The 1860 Massacare and the Destruction of the Old Ottoman World, (UK: Penguin Books, 2024).
[3] سامي مروان المبيض، نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860، ط1، (بيروت: دار الريس)، ص12
[4] Rana Abu-Mounis, Muslim-Christian Relations in Damascus amid the 1860 Riot, (London: Brill), 2022

