أفول الدين أم مأزق العلمانية
فئة : قراءات في كتب
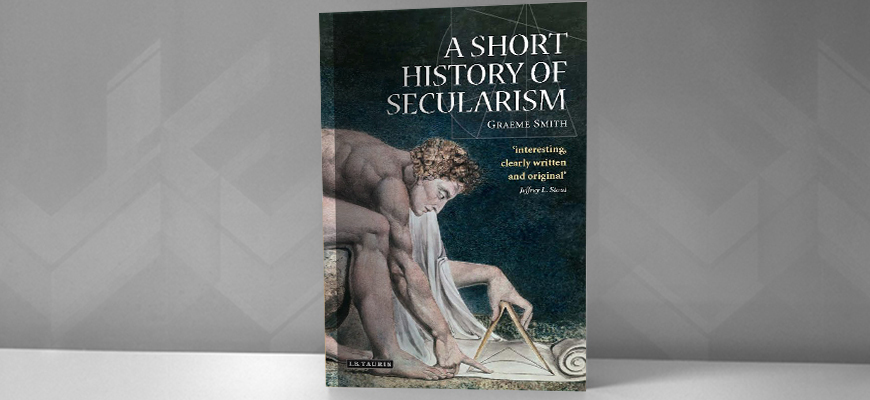
أفول الدين أم مأزق العلمانية
قراءة في كتاب "تاريخ موجز للعلمانية"*
إحدى مشكلات الفكر البشري، بما في ذلك النقدي منه، أنّه يسارع إلى قبول مزاعم معينة رغبة في مسايرة التوجه العام وانتقاصًا لعكسها بدعوى خروجه عن المألوف، ويشرع في ترديدها حد الإفراط، وإذ يكثر المرددون يتناسى الجميع في غمرة الحماسة أنّ الحاسة النقدية تتآكل بالتدريج إلى أن نصل حالة تغدو معها تلك المزاعم حقائق لا مناص من قبولها من دون أي تشكيك. وعلى الرغم من أنّ مسايرة المألوف تصبح مستحبة ومناوأته مستهجنة، فإنّ الفحص النقدي لما يصير بداهات وحقائق يغدو مطلبًا ملحًّا حتى لا تتكلس الأفكار وتستحيل عقائد جامدة.
لا يخلو الحقل الفكري المنشغل بالعلمانية من هذه النقيصة، فقد درج الكثيرون ــ دارسين ومؤرخين وسوسيولوجيين وإعلاميين وأناسًا عاديين ــ على وصف الغرب بأنّه علماني «secular»، وصفًا يحيط به سوء فهم ولغط كبيران، ربما حتى لدى صفوة الدارسين المختصين في الموضوع أنفسهم. ثمة فريقان يختصمان بلا هوادة، ولكل منهما بديهياته الرواسخ. يعادي أحدهما العلمانية بدعوى أنّها مصدر كل الشرور، فهي المسؤولة عن الانحلال الذي تسرب إلى المجتمعات الغربية إضافة إلى الإباحية والبورنوغرافيا وغيرها من الآثام والخطايا، بينما يناصرها الفريق الآخر باعتبارها منارة التقدم وأمارة الحرية في المجتمعات المتقدمة. وسط هذا الفريق الأخير، يحتدم الجدال بين المؤرخين الاجتماعيين والسوسيولوجيين بخصوص بديهية تزعم أنّ الدين في الغرب في حالة أفول، ويتحاجون حول أسباب هذا الأفول وموعد نهايته، ومتى سيصير الغرب علمانيًّا بالكامل. لكن لا أحد يناقش وجود هذا الأفول من عدمه، طالما أنّه وصل وضعًا بات معه خارج نطاق التساؤل والتشكيك.
نأى صاحب كتاب "تاريخ موجز للعلمانية" غريم سميث عن مجاراة أي من الفريقين رافضًا أن يجعل كتابه تبجيلاً للأسلاف العلمانيين الذين صمدوا بنبل في معركة الحرية الفكرية ضد ظلمات الدين وجهالاته، أو عونًا للكنيسة في صمودها في وجه الفجور والانحلال. بدلاً من هذا وذاك، سلك طريقًا نقديًّا عمد فيه إلى فحص الأسس التي يرتكز عليها اليوم أيّ تاريخ للعلمانية أو دراسة لها، من قبيل أن المسيحية تتداعى منهارة، والكنيسة في طريقها إلى الزوال، ونحن على مقربة من نهايتهما، والمجتمع الغربي بات غير متدين، بل إنّ الإلحاد كسب المعركة ضد الدين، إلخ.. لا يندرج عمل غريم سميث تحت نمط الأبحاث التاريخية التي تبدأ من نقطة زمنية وتتتبع المسار الكرونولوجي للأحداث وصولاً إلى نهاية معينة، بل هو تاريخ ضد تاريخ آخر انبنى وترسخ وبات حقيقة، إنّه تاريخ نقدي يفحص المسلمات واليقينيات ويسائلها، مستعملا آليات منهجية مزج فيها بين التحليل السوسيولوجي والبحث التاريخي والنظرية الثقافية والدراسة الثيولوجية[1].
يجيب غريم سميث عن تساؤلات جريئة وغير مألوفة، تساؤلات تنحو في اتجاه التشكيك في التاريخ الذي بات الجميع يرويه، عبر التشكيك في أسس هذا التاريخ وفي المقدمات والفرضيات التي انطلق منها وفي النتائج التي توصل إليها. تهم هذه التساؤلات مسار الأفول الذي رسمه المؤرخون والسوسيولوجيون: هل يدعم الدليل التاريخي الحكاية التي تروى عن انهيار المسيحية من ذروة نشاطها في العصور الوسطى إلى الحضيض اليوم؟ هل يختلف السلوك والمعتقد الدينيان لدى الغربيين الآن عنهما لدى باقي سكان العالم ولدى أجدادهم في الماضي؟ هل هجر الناس الدين في الغرب اليوم لدرجة أنّ نهايته باتت وشيكة؟ وهل نحن مقبلون على ميلاد نوع بشري جديد هو الإنسان غير المتدين (homo non-religio)؟ ماذا تخبرنا الأدلة السوسيولوجية والإحصائية عن المجتمعات الغربية الآن؟ أهي مجتمعات مسيحية مؤمنة أم مجتمعات ملحدة؟ وهل الدين مجرد نمط تفكير طفولي سينتفي مع تطور الإنسان ونضجه؟ أم هو لصيق بالإنسان وجزء لا يتجزأ من كيانه؟ هل يؤدي تطور العلم بالضرورة إلى اتساع رقعة الإلحاد وانحسار رقعة الدين؟
إذا صح التاريخ السائد عن العلمانية، صحت معه كل التحليلات التي تزعم أنّ الدين مرحلة من صبا الإنسانية في طريقها إلى الزوال،[2] لتحل محله العلمانية بعقلها وعلمها وإلحادها، أما إذا لم يصح فإنّنا سنكون ملزمين بأن نعيد النظر في الادعاءات المتداولة عن العلمانية والدين، عبر إعادة كتابة تاريخهما من جديد، بل وأيضًا تحديد ما إذا كان اصطلاح العلمانية ملائمًا لوصف الهوية الدينية للغرب المعاصر.
العلمانية: حكايتان ونتيجة واحدة
حين يوصف الغرب بالعلماني يكون المقصود أنّ المجتمع الغربي يعيش انهيارًا للكنيسة والمسيحية من جميع النواحي، إذ قل المترددون على الخدمات الكنسية (القداس والجنائز والتعميدات وغيرها من الطقوس)، وخسرت الكنيسة وضعها الاجتماعي، وبات صوت قادتها خافتًا لا يسمع إلا فيما ندر كما هو الحال في القضايا المتعلقة بالأخلاق الفردية والإجهاض والمثلية الجنسية، إلخ. علاوة على ذلك، أبعد الدين خارج المجال العمومي بعد أن خسر مصداقيته الفكرية لصالح العلم والعقل، وأضحى مسألة رأي خاص وليس حقيقة عمومية، فأن تعتقد أنّ الله خلق العالم بكل كائناته في ستة أيام هو مجرد رأي شخصي، أما في النقاشات العمومية فتقبل نظرية الانفجار العظيم ونظرية التطور باعتبارهما حقيقتين عموميتين ذواتي مصداقية. بعبارة وجيزة، المسيحية والكنيسة تنهاران وتسيران نحو نهايتهما.
إنّ الوضع السائد اليوم في الغرب، والذي تشكل العلمانية سمته البارزة، ليس سوى المآل الذي آلت إليه الأمور نتيجة لتحول تاريخي بدأ منذ العصور الوسطى. يتعلق الأمر بتحول شامل مس كل شيء (الذهنيات والبنيات الاجتماعية والثقافية والعقيدة الدينية)، فيه كانت المسيحية تخلي مكانها بالتدريج، بينما كانت العلمانية، خاصة العلم، تحل محلها. فكيف أتينا من عالم تسيدته العقيدة الدينية إلى عالم يتسيده العقل ويتداعى فيه الدين؟
1- العلمانية ومعركة الأفكار[3]
يوجد تاريخ لتطور العلمانية وأفول الدين بدأ من حقبة الذروة بالنسبة إلى النشاط الديني المسيحي في العصور الوسطى وينتهي بانتصار العلمانية الآن. في تلك الأزمنة الوسطوية آمن الجميع وترددوا على الكنيسة وهيمن الدين على كل مناحي الحياة، ومن هذه اللحظة شرع مسلسل أفوله. أطلقت النزعة الإنسانية الشرارة الأولى بزعمها أنّ بمقدور المعرفة البشرية أن تنجح وتنمو من دون الحاجة إلى النظر صوب السماء (الدين)، بل فقط بالنظر إلى الأرض والبشر بواسطة العقل. رافق هذه النزعة التي أدارت ظهرها للدين، نزوع عام نحا بعيدًا عن الدين، مثل الاهتمام المتزايد للطبقة المتوسطة بالأعمال التجارية والاقتصادية بدل الدين، إضافة إلى تنامي النزعات القومية التي وجهت ميول الناس نحو بؤرة جديدة غير البؤرة الدينية. أدى الإصلاح الديني لاحقًا إلى تفكيك وحدة الكنيسة، ثم تلا ذلك حروب دينية فظيعة بين الكنائس والطوائف الدينية دفعت الكثيرين إلى هجر المسيحية والسعي وراء معرفة غير دموية ينجزها الإنسان وغايتها الإنسان. من هذه النقطة كان التفوق الذي لا جدال فيه للثيولوجيا المسيحية، باعتبارها ملكة العلوم، قد ولى بلا عودة. في القرن السابع عشر، أنجز العلم ثورة هائلة تلاها عصر العقل (التنوير) في القرن الموالي، وخلال هذين القرنين، سطا العلم والعقل على موضوعات كثيرة كانت حكرًا على الدين مثل الرعاية الصحية وفهم سبل عمل العالم، وظهرت نزعات جديدة تعادي المسيحية كالربوبية (deism) والشك (scepticism) والإلحاد (atheism). أصبحت العلوم الجديدة تفسر العالم بكفاءة عالية ولم تعد هناك حاجة إلى الله لتفسير أي شيء ولا حتى باعتباره خالقًا.
ثمة حدثان يجسدان قدرة العلم على تقويض المسيحية جرى كلاهما في القرن التاسع عشر. الأول كان نشر كتاب "أصل الأنواع" لداروين. انطلاقًا من هذا الكتاب بات ممكنًا تفسير أصل الإنسان على نحو يضاد قصص الكتاب المقدس، وحتى لو اقتضى الأمر وجود محرك أو خالق أول فإنّه لن يكون إله الكنيسة، أي ذلك الشخص المجسد صانع الخوارق والمعجزات، بل سيكون إلهًا من نوع آخر. هكذا ظهر دليل علمي على أنّ التاريخ المدون في سفر التكوين غير صحيح. الحدث الثاني هو ظهور أبحاث تفحص نقديًّا الكتب المقدسة. بينت هذه الأبحاث أنّ معظم كتب العهد القديم مجرد خليط من مصادر قديمة، إنّها قصص وخرافات وأساطير وحكم جمعت لصياغة الكتاب المقدس، ولم يكن العهد الجديد بمنأى عن هذه الشبهة. لقد تبين أنّ هناك إسهامًا بشريًّا فيما كان يعد وحيًا إلهيًّا. عد الكتاب المقدس مصدرًا للحقائق التاريخية لزمن طويل، لكن الشكوك باتت تلقي بظلالها عليه، وبات بمقدور العقل أن يعرف عن العالم وعن الوحي أكثر مما تعرفه الكنيسة نفسها.
كشف العلم ذلك الخدر الذي بثته الكنيسة في العقول وأزاحه، ولم يعد بمقدور أي شيء مقاومة السلطة الجديدة للبراهين وأدلة المختبر. خلاصة هذا المسار التاريخي أنّ العلمانية كسبت معركتها ضد المسيحية فكريًّا. العلمانية شاهد على اكتساب الإنسانية صحة ذهنية ونضجًا أخرجاها من طور طفولتها الحضارية، وحل زمن التخلي عن سخافات الطفولة. تهتم العلوم الجديدة بمواضيع مثل الصحة والعدالة الجنائية والبيئة والأمن الاقتصادي، ولا تبالي بالمواضيع الثيولوجية كفكرة الثالوث والآخرة. لم يعد للدين مكان يشغله، لذلك يحتضر. لا غرابة إذن أن نسمع من نيتشه إعلانه موت الإله.
2- العلمانية من منظور التاريخ الاجتماعي (دعوى العلمنة)[4]
يعزو هذا الضرب من تاريخ العلمانية أفول المسيحية إلى سبب مغاير. لم يهجر الناس المسيحية بسبب قراءتهم للكتابات الألمانية الناقدة للكتاب المقدس، ولا بسبب فهمهم لأبحاث نيوتن وداروين، بل بسبب عجز المسيحية عن الصمود في وجه التغير الاجتماعي. لقد سببت الثورة الصناعية، إضافة إلى التحديث (modernization) والتمدن (urbanization) عملية علمنة (secularization) شاملة طالت المجتمع الغربي وجعلت المسيحية تتوارى بالتدريج فيه وتسير نحو نهايتها. يتوقع بعض الدارسين مثلاً أنّ بريطانيا ستصبح بلدًا علمانيًّا بالكامل عام 2030، أي بلدًا لا أثر فيه للدين.[5]
يعد الدليل الإحصائي حاسمًا في إثبات انهيار المسيحية والكنيسة، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال تثبت الإحصائيات أنّ قرابة نصف السكان أو أكثر ترددوا على الكنيسة عند منتصف القرن التاسع عشر، لكنّ هذه النسبة انهارت إلى ما دون 8 في المائة عام 1999. وبالمثل انهار عدد الزيجات المنعقدة في الكنيسة، وكذلك عدد التعميدات والجنائز وقل عدد رجال الدين، فبم نفسر كل هذا الانهيار؟
قامت السلطة الشمولية للكنيسة على بناء اجتماعي متين جسده المجتمع الفيودالي، الذي تشكل من جماعات مغلقة ومتماسكة بشدة في القرى. في هذا المجتمع التراتبي الحديدي تغلغلت الكنيسة إلى كل مناحي الحياة وإلى كل الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلخ، وتحملت مسؤولية التربية والرعاية الصحية والاجتماعية والرقابة الأخلاقية، وكانت آراؤها حاسمة في كل الشؤون، بدءًا من أبسطها كالولادات وصولاً إلى أعقدها كالقرارات السياسية. بصيغة أخرى، وجد النظام الكنسي التراتبي في المجتمع الفيودالي التراتبي كل الأسس التي يحتاجها ليمسك بزمام الأمور.
حدث انقلاب شمولي قوض هذا البناء برمته مع الثورة الصناعية التي أطلقت موجات هجرات كانت كافية لانهيار المجتمع التقليدي بطبقتيه، طبقة النبلاء وطبقة الأقنان، وعلى أنقاضه ظهر مجتمع آخر بطبقات جديدة ومدن كبيرة وبنيات مختلفة. ازدهرت في المجتمع الجديد النزعة الفردية والميل إلى المساواة والديمقراطية، وخسرت الكنيسة عددًا كبيرًا من اختصاصاتها لصالح الخبراء والمختصين (الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم). لم يعد بمستطاع الكنيسة الدفاع عن الفكرة الفيودالية المتعلقة بالتراتبية الأسقفية، خاصة بعد أن استقطبت الكنيسة البروتستانتية ذات البنية الديمقراطية أعدادًا كبيرة من المؤمنين. تفكك المجتمع التقليدي الصلب الذي تغلغل الدين إلى كل مفاصله، وانهار النظام الشمولي للأخلاق الواحدة والديانة الواحدة والرقابة الحديدية، وحل محله مجتمع الحرية الدينية والاختيار. تداعى الأساس الاجتماعي للكنيسة فانهارت، بينما تعلمن المجتمع.
في مسار العلمنة، لعبت العقلنة (rationalization) دورًا حاسمًا في أفول المسيحية وانهيار الكنيسة. في المجتمع الفيودالي كانت الإجراءات والمعايير والنظم التي يتخذ المجتمع قراراته انطلاقًا منها ووفقًا لها تترتب تبعًا للغايات الدينية الكبرى، وقيست ملاءمة تلك القرارات بمقياس الوحي الإلهي، أما في المجتمع الحديث فقد أضحت تلك الإجراءات والمعايير عقلانية بيروقراطية، وهي تجري بما يتوافق مع معايير مستقلة عن تحيز الفرد، وما يهم فيها ليس الغايات الكبرى والمعاني السامية، بل الكفاءة والإجرائية لا غير. لم تجد المسيحية موطئ قدم لها في المؤسسات الاجتماعية الجديدة التي هيمنت عليها العلمانية، ولم تفرض رأيها في النقاش العمومي الذي بات حكرًا على الخبراء والمتخصصين، وآل حالها إلى العزلة والغربة، فطردت إلى عالم الرأي الخاص.
أفول الدين: حجج وتفنيدات
تؤرخ القصتان السابقتان في الآن ذاته لتنامي العلمانية وتداعي المسيحية، وعلى الرغم من أنهما تسلكان طريقين مختلفين، فإنّهما تنتهيان إلى النتيجة نفسها، أي طرد الدين في الغرب من المجال العمومي ومن مؤسسات المجتمع الحديث، فالكنائس مهجورة، وصوت المسيحية خافت لا يسمع، والدين يحتضر، ونحن على مشارف النهاية. ترتكز القصتان على أسس وفرضيات وحجج ترسم مجتمعة مسار الانهيار. نحن هنا أمام خيارين، إما أنّ هذا المسار يصف فعلاً ما جرى في تاريخ الغرب ويرسم صورة حقيقية عن واقعه اليوم، وحينها يفرض السؤال التالي نفسه، هل نحن مقبلون على عصر ما بعد الدين؟[6] وإما أنّه مسار مغلوط، وفي هذه الحالة نتساءل، ما المعنى الحقيقي للعلمانية؟ وهل تمثل العلمانية، من حيث أنّها نقيض الدين، الوصف الأصوب للواقع الديني في الغرب؟
1- الدليل الإحصائي: خطأ في القراءة
تثبت كل المؤشرات الإحصائية وجود انهيار شامل في الاعتقاد والممارسة الدينيين في أوروبا الغربية، ذلك ما تكشفه المقارنة بين القرن التاسع عشر والفترة الحالية. يبرز مثال المملكة المتحدة هذا الأمر بجلاء. انهار عدد المترددين على الكنيسة من حوالي نصف السكان عام 1851 إلى 12 في المائة عام 1979، وإلى 10 في المائة عام 1989، ثم إلى ما دون 8 في المائة عام 1999. وبالمثل انهار عدد الأطفال الذين حضروا مدرسة الأحد من حوالي 50 في المائة عام 1900 إلى ما دون 4 في المائة عام 1998.[7]
يصطدم الدليل الإحصائي بصعوبتين واضحتين، تثبت الأولى وجود تقهقر في الممارسة الدينية وليس في الاعتقاد، لأنّ 77 في المائة من الأوروبيين أكدوا أنّهم يؤمنون بالله، بل إنّ هذه النسبة وصلت إلى قرابة 90 في المائة في كثير من الدول[8]، ومعدل الذين زعموا أنّهم مسيحيون قريب من هذا، في بريطانيا مثلاً، وهي تعد أحد أكثر البلدان علمانية في أوروبا الغربية، وصل عدد الذين أكدوا أنّهم مسيحيون 72 في المائة، بل 80 في المائة في بعض المناطق، وعبر القارة الأوربية سجلت النسب نفسها تقريبًا[9]. الثانية أنّ القرن التاسع عشر حقبة لا يقاس عليها نظرًا لأنّها عرفت نشاطًا دينيًّا استثنائيًّا. لفهم الفترة الحالية يجب مقارنتها بحقب أخرى كالعصور الوسطى، وهذا ما سنراه لاحقًا. على مناصري دعوى العلمنة أن يفسروا شذوذ هذه الحقبة، لا أن يعتمدوا عليها لتفسير الفترة الحالية، وعليهم أيضا أن يفسروا هذه المستويات المرتفعة للاعتقاد الديني في الغرب.
2- فرضية المسار الخطي لأفول المسيحية
توحي دعوى العلمنة بوجود مسار خطي تقهقري للاعتقاد والممارسة الدينيين على الرغم من أنّها لا تصرح بذلك، فكلما ازدهرت العلمانية بازدهار العقل والعلم، انتكست المسيحية والكنيسة. يسير التاريخ الغربي بلا توقف نحو مزيد من العلمانية. لكن هذه الفرضية مجرد زعم لا يثبته دليل، فالنشاط الديني يسلك مسارًا متذبذبًا بين فترات هبوط وصعود، ومرد هذا التذبذب هو تتالي أوقات الرخاء وأوقات الشدة. تبين الأبحاث التاريخية أنّ النشاط الديني يعرف فترات صعود استثنائي أحيانًا، مثل فترة القرن التاسع عشر وفترة الإصلاح الديني وفترة الانتشار المبكر للمسيحية، لكنّه يعود إلى مستوياته العادية في فترات أخرى كما حدث في أواخر العصور الوسطى ويحدث اليوم. لا تمثل هذه الفترات تراجعًا بل هي بالأحرى عودة إلى المألوف. يكمن الخطأ الكبير في اعتبارها شيئًا جديدًا من قبيل العلمانية[10]، أي أنّ ما يستدعي التفسير والانتباه هو فترات النشاط الديني المفرط لا الفترات العادية.
3- هل التنوير انتصار للإلحاد وهزيمة للمسيحية؟[11]
يؤكد تاريخ العلمانية أنّ حقبة الأنوار سجلت اندحار المسيحية وانتصار العقل والعلم والنزعات الإلحادية والشكية، فخلال القرن الثامن عشر قام العقل الخارج لتوه من جهل العصور الوسطى بتقويض الخرافات والمغالطات الدينية (شكوك هيوم وسخرية فولتير)، فأخلى الدين المكان وحلت العلمانية والإلحاد محله.
تصطدم هذه المقاربة بصعوبات متعددة نكتفي باثنتين منها: الأولى أنّ الأنوار لم تمثل نجاحًا للإلحاد، ولا حتى بداية نجاحه، فالإلحاد منتظمًا في حركات أو تنظيمات، كان وما يزال حتى اليوم فاشلاً بكل المقاييس. لم يكسب تقريبًا أيّ دعم أو مساندة، لأنّ عدد المنتمين إلى الجمعيات الإلحادية ضعيف جدًّا، لم يتجاوز عدد الذين يعدون أنفسهم ملاحدة في أوروبا 5 في المائة أو أقل في معظم البلدان. سجلت النسبة الأعلى في فرنسا (15 في المائة)، وهي البلد الوحيد الذي فاقت فيه النسبة 10 في المائة. أما الثانية فتهم بقاء المسيحية بعد النصر المزعوم للإلحاد. ما حدث أنّ المسيحية لم ترحل بعيدًا، بل كفت فقط عن أن تكون موضوع الاهتمام الرئيسي في النقاش العمومي، لكنها ما تزال حاضرة فيه بقوة من خلال الأخلاق (الأخلاق المسيحية). انفصلت تلك الأخلاق عن أسسها الدينية المسيحية، حتى بات ممكنًا مناقشتها من دون الحاجة إلى مناقشة تضميناتها ولا جذورها الدينية، وكانت الأنوار نقطة الطلاق. على الرغم من أنّ الذهنية العلمية بعد نيوتن هيمنت على الكثير من الاختصاصات التي احتكرتها المسيحية سابقًا، فإنّ هذه الأخيرة عبرت حاجز الأنوار وما تزال حاضرة في أفكار وقيم أنوارية كالليبرالية والفردانية والتسامح[12].
4- العصور الوسطى واليوم: الاختلافات والتشابهات[13]
يؤكد تاريخ العلمانية أنّ العصور الوسطى تختلف عن الفترة الحالية اختلافًا جذريًّا، الأولى فترة تدين شامل وإيمان بما يتعالى على الحس (supernatural)، والثانية فترة عقلانية فقد فيها كل فكر يقوم على ما يتجاوز الحس مصداقيته. كانت المسيحية في العصور الوسطى، اعتقادًا وممارسة، عامة وشاملة، وكان تصورها الخوارقي للعالم الفكرة الوحيدة ذات المصداقية، كانت الهرطقة نمط التفكير الوحيد البديل للمسيحية، لكنّها جوبهت بقسوة وفظاظة، إذ تصدت لها الكنيسة عبر آلية الحرم (excommunication) التي تعني الإقصاء الشامل والعقاب وحتى القتل. لم يعد لهذا أي أثر اليوم، فالمصداقية حازتها العلوم، وزمن الإيمان بالخوارق ولى، ومن ثم فالفترتان الحالية والوسطوية تقعان على طرفي نقيض.
تحوم حول هذه المقارنة شكوك قوية، لأنّ المعطيات التاريخية والسوسيولوجية لا تدعمها بل تدحضها. تبين الأبحاث التاريخية أنّ الذهاب إلى الكنيسة في العصور الوسطى كان متقلبًا وضعيفًا في كثير من الأحيان، وهو يشبه تقريبًا نظيره اليوم. عندما كانت الأزمات والكوارث كالطاعون والحروب تضرب، كان التدين يزدهر بهدف رفع العقاب الإلهي، وفي فترات الرخاء كان يخبو ويذوي، كما كان يعلو في الأعياد والاحتفالات ويهبط في الأوقات العادية. علاوة على ذلك، ما يزال الناس في الغرب يؤمنون بما يتعالى على الحس حتى اليوم، فالإيمان بالله يسجل معدلات مرتفعة تقارب 80 في المائة في أوروبا، وتفوقها في الولايات المتحدة الأمريكية، ويصبح هذا الإيمان أقوى في الحالات التي يفشل فيها العلم، خاصة الطب، وفي حالات اليأس.
تتشابه الحقبتان الوسطوية والحالية من نواح عديدة:
يوجد في كلتيهما أغلبية تؤمن بالله وقلة قليلة لا تؤمن به وتعادي الكنيسة، وضمن الأغلبية هناك فئة صغرى جادة في تدينها وترددها على الكنيسة، بينما الفئة الكبرى خاملة وتدعم الكنيسة من بعيد[14]، بعبارة أخرى، غالبية الناس تؤمن، لكنّها بدلاً من المشاركة في النشاط الديني تفوض القيام بذلك للقلة الجادة في تدينها.
يوجد فيهما أيضًا ازدهار للدين الشعبى ممثلاً في أنشطة وطقوس يتوقع منها نفع وفائدة كالمحاصيل الجيدة والسعادة والتعافي من المرض. يختلف هذا الضرب من الدين عن الدين الرسمي الكنسي في أنّه لا يحتاج إلى معرفة أكاديمية بالدين والكتاب المقدس والرب، وغاياته تختلف عن غايات الكنيسة. يميل الناس إلى المشاركة في الاحتفالات الدينية المرحة، لكنّهم يتفادون الالتزام بالطقوس الكنسيّة الرتيبة.
فيهما أيضًا اهتمام متشابه بالفقراء والضعفاء والمضطهدين تدعمه المسيحية. كان هذا البعد الأخلاقي عنصرًا أساسيًّا في المسيحية الوسطوية، وما يزال يواصل حضوره القوي في المجتمع الغربي على الرغم من تراجع الممارسة الشعبية للدين. وفي الحقبتين معا يتكئ هذا الجانب الأخلاقي على أساس ديني هو الإيمان بالله.
5- المسيحية المثالية والمسيحية التاريخية[15]
ترسم دعوى العلمنة صورة لمسيحية محددة يمكن تعريفها بدقة نظرًا لأنّها تمتلك نواة جوهرية أو هوية ثابتة، تحددت هذه المسيحية في نقطة معينة من الماضي، وبلغت حالتها المثالية في حقبة معينة هي القرون الوسطى، حينما انخرط الجميع في الدين اعتقادًا وممارسة. وهذه المسيحية المثالية تنهار. لا تأخذ دعوى العلمنة دلالتها الأعمق إلا في ضوء فكرة كهذه، ولا مصداقية لهذه الدعوى ما لم تثبت وجود شيء مميز وكامل يتلاشى. يتفق معظم المسيحيين على وجود نواة جوهرية لديانتهم من دون أن يتفقوا حول الشيء الذي يشكل تلك النواة، وهذه هي المشكلة الأولى.
تقدم الأبحاث التاريخية صورة مغايرة عن مسيحية مرنة متغيرة لا تبقي على شيء ثابت فيها إلى درجة أنّ تحولها أحيانًا يضارع ميلاد ديانة جديدة. تستطيع هذه الديانة التبشيرية تقريبًا تبني أيّ مجموعة من الأفكار والمعتقدات وتحويلها واستيعابها، وهي أيضًا تتحول، بينما ترتحل عابرة المجتمعات والثقافات المختلفة، والأدلة على هذا كثيرة، مثل مزج شخصية يسوع بشخصية الإله الفارسي ميثراس (Mithras) والشخصية الميثولوجية اليونانية أورفيوس (Orpheus). يتحدث الدارسون عن مسيحيات متعددة ومختلفة في التاريخ، في هذه الحالة، أيّ مسيحية تنهار؟ وهل يتعلق الأمر بانهيار ــ إن وجد ــ أم بتحول جديد؟ أضف إلى ما سلف أنّ التدين في العصور الوسطى لم يكن مثاليًّا ولا استثنائيًّا، إذ بالكاد يختلف قليلاً عن نظيره في الغرب اليوم.
6- الثيولوجيا والعقلانية، تنافٍ أم تعايش
تتحدث دعوى العلمنة عن وجود ذهنيتين متعارضتين جذريًّا إلى حد أنّ وجود أيّ منهما ينفي وجود الأخرى، ذهنية سابقة على العصر الحديث، وهي ثيولوجية أساسها الإيمان بالمتعالي على الحس وذهنية عقلانية أساسها العقل والعلم والتقنية، وكلما برزت الذهنية العقلانية توارت نظيرتها الثيولوجية، لا مكان في زمن العقل والعلمانية لذهنية تؤمن بالخوارق والمعجزات والغيبيات. يبدو من هذا الزعم كأنّ الدين على شفا الانقراض في الغرب وأنّ باقي الأمم تنتظر ريثما تزدهر فيها العلمانية ليحل بها ما حل بالغرب.
لا شيء في واقع المجتمعات الغربية اليوم يرجح هذا الزعم، خصوصًا إذا علمنا أنّ الأمة الأكثر تقدمًا في الذهنية العلمية والتقنية (الولايات المتحدة الأمريكية) تسجل مستوى نشاط ديني مرتفع جدًّا (90 في المائة أكدوا أنّهم يؤمنون بالله وحوالي 40 في المائة زعموا أنّهم يذهبون إلى الكنيسة مرة كل أسبوع) كما أنّ المسيحية ما تزال قوة فاعلة سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا بقوة[16]. معنى ذلك أنّه لو صحت دعوى العلمنة لوجب أن تكون الولايات المتحدة أكثر البلدان بعدًا عن الله والدين، لكن العكس هو الصحيح.
بدلاً من تصوير الذهنيتين العقلانية والثيولوجية على نحو يجعلهما متصلبتين ومتنافرتين، يخبرنا الواقع عن ذهنيتين ناعمتين ومرنتين ولا تقصي إحداهما الأخرى، بل توجدان معًا وتتعايشان. تستطيع العوامل الاجتماعية والثقافية أن تحمل إحدى الذهنيتين إلى الواجهة وتحجب الأخرى قليلاً. هذا ما يجري اليوم في الولايات المتحدة حيث الذهنية الثيولوجية فعالة بقوة، في حين تنشط في فرنسا ذهنية معادية للإكليروسية.
لا عداء بين المسيحية والعلم، لأنّ التاريخ يبين أنّ المسيحية قبل العصر الحديث قامت بوظائف تقنية كالرعاية الصحية والاجتماعية، وقدمت فهمًا للعالمين الطبيعي والإنساني بني على أسس ثيولوجية. سلب العلم الحديث المسيحية وظيفتها التقنية هذه، لكنّه لم يسلبها وظيفتها الأخلاقية، ولا هو يستطيع ذلك. هنا ما تزال المسيحية ممسكة بزمام الأمور، وما تزال الذهنيتان حاضرتين اليوم معًا، خصوصًا وأنّ علماء وفلاسفة محترمين يؤكدون أنّهم مسيحيون، مثل ديكارت ولوك وكانط ونيوتن وآخرين كثر.
خاتمة
هل الدين طور من صبا الإنسانية مآله الأفول عند بلوغ النضج؟ وهل العلمانية علامة على مغيب شمس الدين؟ هل يقود تطور العلم إلى تقهقر الدين؟ إذا كان الأمر كذلك، لم يواصل الدين حضوره في البلدان التي تقود مسيرة التقدم العلمي؟ بين الفحص السابق للفرضيات والحجج التي يروج لها المجتمع العلمي المنشغل بالعلمانية وما يحيط بها من مسائل وإشكالات وجود نقائص عديدة في تلك الافتراضات والحجج والمقدمات. بات سوسيولوجيو الدين ومعهم دارسو العلمانية اليوم مفتونين بحكاية انهيار المسيحية ونهايتها، روجوا للحكاية وأفرطوا في ذلك حتى باتت عصية على الشك والمساءلة.
حسب وجهة نظر غريم سميث لن تقرع أجراس النهاية الآن ولا قريبًا. لسنا على موعد مع الهزيمة الأخيرة للمسيحية وانتصار الإلحاد، ومن ثم لن نرى قريبًا عصر ما بعد الدين بدليل:
* أنّ المسيحية نجحت حتى اليوم في كل السياقات التي دخلتها، وأثبتت بذلك قدرتها الكبيرة على التكيف ومرونتها الهائلة، ذلك ما يجعلها حاضرة في المجتمعات الغربية، بل فاعلة بقوة في أكثرها علمية وتقنية، على الرغم من الرجات القوية التي تعرضت لها.
* أنّ ما يجري اليوم في الغرب ليس احتضارًا للدين، بل هو تحول للمسيحية من ديانة أرثوذوكسية مثقلة بالطقوس ومحروسة من قبل كنيسة متسلطة وجبارة، إلى ديانة أخلاق. تواصل المسيحية حضورها في الأخلاق والقيم الليبرالية التي يمارسها المجتمع الغربي انطلاقًا من أسس مسيحية خاصة الإيمان بالله. المجتمع الغربي علمي وتقني، لكنّه مسيحي من الناحية الأخلاقية.
* أنّ الجذور التاريخية لأوروبا تمتد عميقًا في تربة المسيحية، وأنّ هذه الديانة تسللت خلال قرون طويلة إلى كل مفاصل الثقافة الأوروبية والغربية عمومًا بشكل يجعلنا لا نستطيع تصور الهوية الثقافية للغرب مفصولة عن الديانة المسيحية. يشاع أنّ قطيعة مع هذا الإرث المسيحي حدثت في أوروبا مع ظهور المنهج العلمي التجريبي والفلسفة الليبرالية، غير أنّ واقع المجتمعات الأوروبية اليوم يثبت أنّها مسيحية القيم والعقائد والثقافة.
* أنّ التدين المعاصر الذي قيل إنّه يكاد ينعدم والتدين الوسطوي الذي وصف بأنّه مثالي يتشابهان أكثر مما يختلفان، وسمات التشابه بارزة في وجود غالبية مؤمنة بعضها جاد في تدينه والبقية خاملة، لكنّها تدعم الكنيسة من بعيد. أما القلة القليلة فتؤكد أنّها ملحدة، وتعادي الكنيسة. الاختلافات لافتة للنظر، فعدد الذين يترددون على الكنيسة اليوم أقل من نظيره في العصور الوسطى، ومرد هذا إلى أنّ الكنيسة كانت آنذاك مركزًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، بالإضافة إلى أنّ الناس يمارسون الكثير من طقوسهم الدينية الشعبية خارج الكنيسة كالاحتفال بأعياد الميلاد مثلاً. يبدو أنّ البشر من جهة الدين متشابهون بشكل عام، يتصرفون ويعتقدون بالطرق ذاتها مع بعض الاختلافات الاجتماعية والثقافية التي تغير توزيع الألوان قليلاً في الصورة.
* أنّ النشاط الديني في القرن التاسع عشر كان حالة استثنائية يجب تفسير شذوذها بدل استدعائها لفهم الدين في الغرب الحالي، فالفترة الحالية لا تشهد أفولاً للدين، بل رجوعًا إلى حالته العادية بعد فترة استثنائية.
إذا لم تكن العلمانية أمارة على انهيار الدين ولا علامة على انتصار الإلحاد، فماذا قد تكون؟ لا بد من تعريفها من جديد بما يتفق وواقع المجتمع الغربي. إنّها التعبير الأخير عن المسيحية، وبتعبير أدق، إنّها الأخلاق المسيحية بعد أن انفصلت عن جذورها الثيولوجية، إنّها تجل جديد للمسيحية أو أحد تحولاتها. لا دليل على أنّ المجتمع الغربي يمثل، من جهة الدين، حالة الاستثناء مقارنة بباقي المجتمعات، فهو مجتمع متدين على نحو غير متوقع، وميزته الأساسية أنّ نقاشاته العمومية لفظت القضايا الثيولوجية كمعتقد الكفارة وطبيعة الرب وعقيدة التثليث، مستعيضة عنها بقضايا تمس ما هو دنيوي كالصحة والتعليم والعدالة الجنائية، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأخلاق المسيحية التي انفصلت عن جذورها الدينية ما تزال حاضرة في النقاش العمومي بقوة.
وأخيرًا يبدو أن المجتمع الغربي وصل إلى حالة تحدد فيها بوضوح مجال العلم ومجال الدين، من الواضح أنّ تفسير أحداث العالم، سواء أكانت طبيعية أم إنسانية، لا يحتاج إلى أي مبدأ ديني، والدين أعجز من أن يقوم بهذه الوظيفة، ومن البين أنّ القضايا والتساؤلات الأخلاقية تقع بعيدًا عن متناول العلم، والعلم أعجز من أن يبني نسقًا للأخلاق. تقدم العلم إذن لا يتناسب عكسيًّا مع أفول الدين. لا عداء بين الإثنين، بل إنّهما بالأحرى يشكلان معا هوية الغرب المعاصر.
*- «A Short History of Secularism» Graeme Smith. 2008 by I.B.Tauris & Co Ltd.
أشير إلى أنّني بصدد ترجمة هذا الكتاب.
[1] المصدر نفسه ص 7
[2] تحليلات أوغست كونت وفرويد وآخرون.
[3] شرح المؤلف هذا الضرب من التاريخ وبين نقائصه في الفصل الثاني من كتابه.
[4] شرح المؤلف هذا الضرب من التاريخ وبين نقائصه في الفصل الثالث من كتابه.
[5] المصدر نفسه ص 42
[6] على الأقل في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وستلحق باقي الأمم بالركب وإن تأخرت.
[7] يظهر النموذج ذاته للانهيار في عدد الزواجات والجنائز والتعميدات التي تجري في الكنيسة وفي عدد رجال الدين، المصدر نفسه، ص 44
[8] المصدر نفسه، ص 51
[9] المصدر نفسه، ص ص 1- 2
[10] المصدر نفسه، ص 90
[11] شرح المؤلف تأثير الأنوار في المسيحية رافضًا قاموس الأفول والنهاية الفول والنهاية عين في الفصل السابع.
[12] المصدر نفسه، ص ص 153- 159
[13] ناقش المؤلف هذه المسألة بتفصيل في الفصل الخامس.
[14] المصدر نفسه، ص 13 و107 - 108
[15] المصدر نفسه، الفصل الرابع
[16] المصدر نفسه، ص ص 57 - 61






