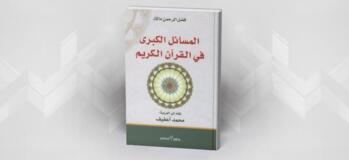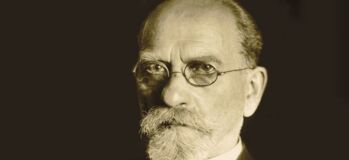أهمية الأنثروبولوجيا الفلسفية في تأسيس حقوق الإنسان
فئة : ترجمات

أهمية الأنثروبولوجيا الفلسفية في تأسيس حقوق الإنسان[1]
أحمد الكايش
ترجمة: أحمد محمد بكر موسى
ملخص:
يحتل الإنسان مكانة عظيمة بين الكائنات الحية الأخرى. وتأتي هذه القيمة للإنسان من خصائصه النفسية والحيوية؛ فالإنسان يصنع الحضارات باستخدام ذكائه ومهاراته اليدوية. ومهمة كل من الفلسفة والأنثروبولوجيا هي توضيح الخصائص الأساسية التي تميز البشر عن الكائنات الحية الأخرى. فمهمة الأنثروبولوجيا الفلسفية هي الكشف عن هذه الاختلافات الوجودية وتفسيرها. وإلى جانب صفات البنية الوجودية للإنسان، من المهم جدًّا التحرك من أوضاع وجوده. ولهذا السبب، تبحث هذه الدراسة في الأسس النظرية للأنثروبولوجيا الفلسفية وحقوق الإنسان. ومن المشاكل المهمة أنه مهما كانت حدود الفلسفة والأنثروبولوجيا قريبة، فنادرًا ما تُستخدم المفاهيم الفلسفية لتفسير الأحداث والتغيرات الأنثروبولوجية، ثم أعرض الإطار المفاهيمي للأنثروبولوجيا الفلسفية، وأدرس المسار التاريخي لحقوق الإنسان ودورها الحالي. وفي الوقت نفسه، أُركز على أسس حقوق الإنسان والمشكلات المتعلقة بالوعي بحماية حقوق الإنسان. وفي نهاية الدراسة أعرض أهمية حقوق الإنسان في سياق الأنثروبولوجيا الفلسفية، وأقدم بعض المقترحات لتحسين هذه الحقوق.
مقدمة
إن فضول الإنسان لمعرفة المزيد عن نفسه ناتج عن سعيه نحو البقاء، ويحتاج الناس في السيرورة التاريخية إلى التعلم من خلال التساؤل عما لديهم، وأصول رموزهم الثقافية وتصرفاتهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم. ونتيجة لهذه الحاجة إلى التعلم، يكتسب الناس فرصة المراقبة والخبرة المنهجيتين. وبالتالي، يمكنهم الوصول إلى معلومات صحيحة وموثوقة حول الظواهر الاجتماعية والثقافية. لقد بدأ الأشخاص الذين حاولوا فهم الطبيعة وشرحها في إجراء دراساتهم في تخصصات مختلفة مع مرور الوقت. والأنثروبولوجيا هي التخصص الذي ظهر نتيجة للدراسات العلمية التي أجراها البشر على العالم وعلى أنفسهم. ومهدت الأنثروبولوجيا الطريق للبشر للتفكير في وجودهم. وقد سعت للحصول على إجابات لأسئلة مختلفة حول التنوع الجسدي والثقافي البشري. وفي هذا السياق، تُعرف الأنثروبولوجيا بأنها علم قائم على المقارنة والملاحظة يبحث عن إجابات للأسئلة المطروحة نتيجة البحث العلمي. وهكذا، فإن الأنثروبولوجيا هي دراسة كل ما هو موجود فيما يتعلق بالإنسان (Şahin, 2020, p. 2). وبالطبع، فإن العلوم الأخرى التي تتناول البشر تعود إلى العصور القديمة. وقد ركزت معظم هذه العلوم على بعض خصائص البشر بدلاً من تناولها من جميع جوانبها، لكن هذه الأساليب ليست كافية لشرح البنية الأنطولوجية للبشر. فيتمتع الإنسان بالتكامل الأنطولوجي كمجال للإمكانية. وهذه التفسيرات التي تؤكد فقط على خاصية معينة للبشر، لا تكفي لمعرفة الإنسان ككل. لذلك من المهم تقييم الإنسان، ككائن أنطولوجي، بما يتماشى مع جميع صفاته. في الواقع، وُلدت الأنثروبولوجيا كتخصص يحاول تفسير البشر بكل صفاتهم. ودُرِّست الأنثروبولوجيا كتخصص حديث في جامعات مختلفة حول العالم منذ بداية هذا القرن. ومن بين مؤسسات التعليم العالي جامعة روتشستر في أمريكا. فقد بدأت جامعة روتشستر تدريس الأنثروبولوجيا في عام 1879. وفي وقت لاحق، في عام 1906، تأسست ككرسي مستقل في جامعة أكسفورد في إنجلترا. وبعد إنشائها ككرسي مستقل، انقسمت الأنثروبولوجيا إلى تخصصات مختلفة (Şahin, 2020, Section 1, p. 3). وكما هو معروف فإن أحد هذه التخصصات هو الأنثروبولوجيا الفلسفية.
تنظر الأنثروبولوجيا الفلسفية إلى الظواهر الإنسانية الأساسية ككل متماسك، كما تأخذ في الاعتبار جميع أعمال الإنسان وما ينتج عنها من إنجازات. ولذلك، فالنهج الأساسي للأنثروبولوجيا الفلسفية هنا هو أن كل هذه الظواهر مترابطة. فلهذه الظواهر بنية تكاملية. فعندما ندرس الظواهر الإنسانية، نجدها لا تتأثر بظروف العصر وتطوراته فحسب، بل تؤثر أيضا على هذا العصر. وقد أوجدت الأهمية المتزايدة للفلسفة والأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان الحاجة إلى الأنثروبولوجيا الفلسفية في حل المشكلات المتعلقة بالبشر (Çotuksöken 2012). لقد تحمل البشر، الذين لا يرضون بما هو موجود ولديهم فضول دائم تجاه الأشياء، مسؤولية الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين. ولأنه ليس لدى السياسة الدولية خطة ملائمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الدولي (Yeşilçayır, 2018)، فقد ركزت الدراسة على أهمية الأنثروبولوجيا الفلسفية وحقوق الإنسان في عصرنا هذا. وفي سياق الأنثروبولوجيا الفلسفية، يفتح هذا البحث الباب لدراسة؛ أي الأساليب أكثر فعالية في إرساء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
العلاقة بين الفلسفة والأنثروبولوجيا
لقد أُجريت عبر التفاعل بين الفلسفة والأنثروبولوجيا دراسات مشتركة على أسس فكرية وأكاديمية لفترة طويلة جدًا. ففي الفلسفة الأوروبية القارية، أدت التحولات الضرورية بين التخصصين إلى إبقاء التعاون متعدد التخصصات على قيد الحياة. وفي هذا الاتجاه، بُنيت الأنثروبولوجيا الفلسفية كنظام جديد يبحث في أفعال الإنسان ومكانته في الطبيعة؛ لأن الأنثروبولوجيا الفلسفية تبحث في الغالب في البشر من حيث كونهم بشرًا، وتحاول العثور عن إجابة للسؤال: ما الإنسان؟ (Gürdal, 2020)، إلى جانب كل ذلك، تُظهر الأنثروبولوجيا الفلسفية ما يجعل الإنسان إنسانًا، إلى جانب مميزاته الفريدة.
وفي واقع الأمر، هناك دراسات مهمة حول الأنثروبولوجيا الفلسفية اليوم، كما كانت في العصور السابقة. وقد قدم لودفيج فيتجنشتاين (1889-1951) أعمال بول كاسيرر (1871-1926) ومارتن هايدجر (1889-1976) إلى الفلسفة التحليلية البريطانية. وعلى الرغم من أن علماء الأنثروبولوجيا نادرًا ما يفكرون في افتراضاتهم الفلسفية، إلا أنهم يعتمدون على عدد من المناهج الفلسفية والأنطولوجية لمعالجة القضايا المعاصرة. على سبيل المثال، استفاد علماء الأنثروبولوجيا أتباع إميل دوركهايم (1858-1917) من فلسفات إيمانويل كانط (1724-1804) في سياق أخلاقيات الواجب. وفي الوقت نفسه، ارتبطت أفكار إيفانز بريتشارد (1902-1973) ور.ج. كولينجوود (1889-1943) بفلسفة هيغل (1770-1831). وتأثر ماكس غلوكمان (1911-1975) بفلسفة الصيرورة لألفريد نورث وايتهيد (1861-1947) وتأثر أيضًا ببيير بورديو (1930-2002) وفيتغنشتاين وباسكال. ويمكن ملاحظة أن العديد من علماء الأنثروبولوجيا ومدارسها، لم يمتنعوا عن التحقيق في المفاهيم الفلسفية للإنسان البدائي (Radin, 1957).
ومن المشاكل المهمة أنه مهما كانت حدود الفلسفة والأنثروبولوجيا قريبة، فإن المفاهيم الفلسفية نادرًا ما تُستخدم لتفسير الأحداث والتغيرات الأنثروبولوجية. وهناك حاجة إلى النقد والتساؤل لدراسة التأثيرات الفلسفية واستكشاف الافتراضات الفلسفية بعمق من منظور ثقافي مقارن، وخاصة على مستوى المقاربات الأنثروبولوجية. في الواقع، للأنثروبولوجيا، بوصفها دراسة مقارنة للوضع البشري، منظور نادرًا ما يستكشفه الفلاسفة أنفسهم. وبظهور المثقفين، خاصة في المجتمعات الغربية، يكتسبون الشرعية كمشاريع فكرية، على الرغم من أنهم غالبًا ما يكونون مهمشين. ويُنظر من الناحيتين الأنثروبولوجية والاجتماعية إلى كل شيء اجتماعي على أنه يتعلق بالسلطة.
ويمكن إرجاع الاتجاه المهيمن الحالي بشكل أساسي إلى فريدريك نيتشه (1844-1900) مروراً بميشيل فوكو (1926-1984). ويعني هذا الفهم أن الأخلاق تعدّ مجرد شكل من أشكال المراوغة (الواعية أو غير المقصودة)، في حين أن الجانب الأخلاقي للوجود الإنساني لا يكاد يعدّ بعدًا للوجود في حد ذاته. ومع ذلك، هناك بعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة التي تشكك جديًا في هذه الافتراضات الأنثروبولوجية (Clammer, 2005). وفي هذا السياق، فإن المشاركة المتبادلة للأنثروبولوجيا من خلال الفلسفات، والفلسفات من خلال الأنثروبولوجيا تفتح الباب للتشكيك في التفكير الحالي الذي يعمل فيه كلا التخصصين في حيز يعدّ انتقادًا ذاتيًا. ومن المهم استكشاف أوجه التشابه بين هذين التخصصين العاملين في الطبيعة البشرية بطريقة تاريخية وتحليلية وإبداعية من خلال تحليل المناطق الحدودية للأنثروبولوجيا والفلسفة جيّدًا.
ويذكر ميسر (1993) أن علماء الأنثروبولوجيا ابتعدوا عن الحساسية تجاه انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان العالمية منذ عام 1947. ويمكن القول إن علماء الأنثروبولوجيا يعانون من انفصال فيما بينهم من حيث دراساتهم النظرية على المستوى الفردي، بينما يختلف الفلاسفة فقط على أساس مجالات اهتمامهم (الأخلاق، وعلم الجمال، ونظرية المعرفة، وفلسفة العلوم) ولا يواجهون انفصالًا عميقًا حول قضايا مثل حقوق الإنسان. ولذلك، فإن إحدى القضايا المهمة بالنسبة إلى علماء الأنثروبولوجيا الفلسفية هي أنه لا ينبغي لهم التفاعل مع التخصصات الفلسفية المختلفة في القضايا العامة، وخاصة في بحث الظواهر الظاهرية، ويجب ألا يتجاهلوا الدراسات الفلسفية التحليلية والموجهة لغويًّا.
هناك أسئلة حول الفلسفة العلمية ونظيرتها الأنثروبولوجية التي لم يُكشف عنها إلى حد بعيد. وتنشأ مشكلات مثل مكانة الإنسان في العالم، وكيفية تشكيل أنظمة المعنى وقبولها، وطبيعة الحقوق والعقلانية والمعايير الأخلاقية والجمالية. وتكشف عملية التحقيق في هذه القضايا كيف يمكن مراجعة هذين التخصصين وإثرائهما؛ وذلك لأن هناك فهمًا شاملاً لكل من الأوضاع الاجتماعية والثقافية والبيئية للجنس البشري. وبالتالي، يجعل البشر لوجودهم معنى ويقترحون كيفية العودة إلى جذورهم الأصلية سعيًا وراء الحكمة بأسلوب مرضٍ. وهناك وجهات نظر عديدة ومختلفة حول هذه القضايا. ويعتمد كل هذا على افتراض أساسي هو أن كلا التخصصين ينفذان مشاريع تكمل بعضها البعض، على الرغم من أنها ليست متشابهة في الواقع.
إن ما ذكره كارل ماركس (1818-1883) قبل مائة وخمسين عاما، فيما يتعلق بمعنى كون الإنسان إنساناً، ناقشه ديفيد هارفي مرة أخرى، في إطار نقده للعدالة الاجتماعية والعولمة (Harvey, 2002). وتمتد هذه المناقشات من الفلسفات الوجودية، التي ترجع جذورها إلى عصر التنوير وما قبله، إلى المناقشات حول العقلانية وحقوق الإنسان. ومن المعروف أيضاً أنها تقع في إطار تراث الأنثروبولوجيا الفلسفية، مثل فلسفة القانون والمفاهيم الواسعة مثل "الطبيعة البشرية" و"الذات" و"الثقافة".
وهذه المواضيع لست ذات اهتمام أكاديمي فحسب، بل إنها تتجاوز الحدود التقليدية بين الأنثروبولوجيا والفلسفة؛ فهي تمتد مباشرة إلى علم الاجتماع (وخاصة مجالات علم الاجتماع التي تتسم بطبيعة مقارنة، مثل علم اجتماع الفن أو الأخلاق)، وعلم النفس والطب النفسي والدراسات الدينية والمناظرات حول العالمية. وبعيدًا عن هذه المناقشات، فإن القضايا التي ظهرت في الفلسفة الغربية في سياق الفلسفة البيئية تبرز كقضية أساسية في الفكرين البوذي والطاوي (Fox, 1990). ومن هذا الموقف، وبينما نتساءل بعمق عن الافتراضات المعرفية والوجودية للفلسفة الغربية السائدة، لا يمكن تجاهل أنها أيضًا قضايا تفسيرية مهمة لعلماء الأنثروبولوجيا العاملين في مجتمعات توجد بها أنظمة معتقدات ذات ممارسات وطقوس (Hall & Ames, 1998).
باختصار، يحاول الفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجيا على حد سواء لفت الانتباه إلى الثراء الرائع الذي تتمتع به الفلسفات الآسيوية والأفريقية وعلاقتها بكلا التخصصين، فهي أنظمة تتجاوز حدودها الخاصة. والعلاقة بين الإيمان والبحث التحليلي، وبين الدين والفلسفة، وبين الأنظمة المعرفية والأنظمة الأخلاقية العملية، بما في ذلك في علاقاتها بالبيئة، مهمة من نواح عديدة وثيقة الصلة بالأزمات العالمية الحالية.
تأسيس حقوق الإنسان في سياق الأنثروبولوجيا الفلسفية
تعد حقوق الإنسان أحد أهم مفاهيم القرن الحادي والعشرين. ومع اعتماد الميثاق الأعظم (Magna Carta) في إنجلترا عام 1215، أصبحت حقوق الإنسان واحدة من أهم الديناميكيات التي تشكل المجتمعات. وحقوق الإنسان، التي تُمكِّن جميع الناس من العيش حياة كريمة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الإيديولوجية، والتي تعدّ حقوقًا وحريات أساسية نتمتع بها لمجرد أننا بشر، هي واحدة من أكثر الموضوعات التي نوقشت أكاديميًّا في الفترة التي نعيشها (Akyüz, 2021a). ومع ذلك، فإن فهم حقوق الإنسان، التي تُستخدم كثيرًا سواء أكاديميًّا أو على المستوى الاجتماعي، بشكل صحيح هو أحد الموضوعات المهمة التي تستحق المناقشة.
ومن أجل تحديد مفهوم حقوق الإنسان بشكل صحيح، من الضروري أولاً فحص معنى مصطلح الحق. فوفقًا لجمعية اللغة التركية، فإن الحق يعني الدقة والصدق والحقيقة والعدالة. وتُعرف حقوق الإنسان بأنها الحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع الأشخاص الذين يعيشون على الأرض، بغض النظر عن أي مجتمع أو دين أو معتقد أو عرق أو جنس. وفي حين نجد الحقوق هي الحريات التي نتمتع بها؛ لأننا مواطنون في بلد ما، فإن حقوق الإنسان هي الحريات التي نتمتع بها لمجرد أننا بشر (Ward & Birgden). وكما ذكر كوتشورادي، فإن حقوق الإنسان هي حقوق فردية أساسية (Kuçuradi, 2007). وتشمل حقوق الإنسان الحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع الأشخاص الذين يعيشون على الأرض على قدم المساواة؛ أي إنها ذات قيمة عالمية (Donnelly, 2013).
وتُعرَّف حقوق الإنسان أيضًا بأنها حقوق تهدف إلى حماية الأفراد من أطراف ثالثة. في الواقع، يصنف عالم السياسة الشهير مايكل فريدن حقوق الإنسان على أنها درع لحماية الأفراد من أطراف ثالثة (Freeden, 1991). فتستند حقوق الإنسان إلى القيود والحريات المتعلقة بكيفية معاملة الأطراف الثالثة والكيانات القانونية للأفراد. على سبيل المثال، تعترف جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية بالحق في الحياة. ويعني هذا الحق أن للأفراد الحرية في عيش حياة صحية جسديًّا وروحيًّا. ولهذا السبب، لا يمكن لأطراف ثالثة اتخاذ أي إجراء يضر بالصحة البدنية والعقلية للأفراد.
واستمرت النضالات من أجل الحقوق والحريات الأساسية للإنسان على مدار التاريخ. وقد اتُّخذت أول خطوة جادة في مجال حقوق الإنسان مع الميثاق الأعظم، الذي اعتُمد في إنجلترا عام 1215 (Kamruzzaman & Das, 2016). وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر، واصلت إنجلترا إجراء إصلاحات مهمة في مجال حقوق الإنسان. واتخذت خطوات مهمة في تطوير الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية من خلال اعتماد "عريضة الحقوق" في عام 1628، و"قانون المثول أمام القضاء" في عام 1679، وقانون الحقوق الإنجليزي في عام 1689. وكان لجون لوك (1632-1704) تأثير كبير على إعلان الحقوق والحريات الأساسية بعد الأحداث الاجتماعية التي وقعت في إنجلترا في القرن السابع عشر (Yurttaşer, 2017). وبحسب لوك، فإن التأكيد أن جميع الناس يتمتعون بحقوق وحريات متساوية يؤدي إلى استنتاج أن هذا حق مكتسب (Tunç, Kurtağzı & Ekici, 2021).
وفي القرن الثامن عشر احتلت أعمال مفكرين مثل كانط وجون ستيوارت ميل (1806-1873) وتوماس باين (1737-1809) مكانة مهمة في تاريخ الفلسفة. وقد أثرت هذه الأعمال الفلسفية على حقوق الإنسان في القرنين التاسع عشر والعشرين. وانعكست كل هذه الجهود في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 (Griffin, 2008). ومع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اكتسبت هذه الجهود بنية عالمية ومؤسسية.
أسس حقوق الإنسان
تُعرف حقوق الإنسان بأنها الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الشخص، بغض النظر عن أي وضع متأصل. هذه الحقوق هي الحريات التي تمكن الناس من الحصول على الاوضاع الصحية والتعليم والعمل والمأوى والتغذية اللازمة للبقاء والعيش حياة كريمة (Akyüz, 2015). وحقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية لكل إنسان بحكم كونه إنسانًا (Kuçuradi, 2007). ولأن البشر هم أكثر الأنواع الحية تطوراً، فإن تفسير القدرات الطبيعية البشرية بيولوجيًّا ونفسيًّا هو موضوع الأنثروبولوجيا الفلسفية. فتهدف الأنثروبولوجيا الفلسفية إلى توفير ظروف معيشية إنسانية للبشر، وتقدير الأشخاص والمجتمعات الأخرى ومعاملتهم بتسامح (Uysal, 2004). وفي هذا السياق، على الرغم من أن حقوق الإنسان مضمونة باللوائح الغربية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس من الصحيح إسناد هذه الحقوق إلى ثقافات أو مجتمعات معينة (Akyüz, 2023).
تؤكد العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية على حقيقة أن حقوق الإنسان مبنية على قيمة عالمية (Akyüz, 2021a). على سبيل المثال، تؤكد المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل لأي دولة أو جماعة أو أي فرد في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه". إنه لنهج خاطئ أن نسند حقوق الإنسان إلى أي مجتمع أو ثقافة. بدلاً من ذلك، فإن النهج الأكثر دقة هو أن نؤسسها على المستوى الأنثروبولوجي؛ أي بناءً على الإمكانات البيولوجية النفسية للكائن البشري (Kuçuradi, 2007). الحجة الرئيسة هنا هي أنه يجب تطبيق الحقوق على قدم المساواة على جميع البشر، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم أو الخصائص الثقافية التي يتمتعون بها. فأينما ذهبنا في العالم، فإن حقنا في الحياة لا يتغير؛ لأننا نحصل على هذا الحق ليس من بلد، بل من حقيقة أننا بشر.
فما هو الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان التي تنطبق على البشر على قدم المساواة؟ الجواب عن هذا السؤال، يتلخص في مبدأ الحقوق الطبيعية. فمبدأ الحقوق الطبيعية هو الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان (Torun, 2007). والواقع أننا عندما ننظر إلى مفهوم حقوق الإنسان، نجده يقوم على مبدأ الحقوق الطبيعية عند لوك ومن دافعوا عن أفكار هذا الفيلسوف في فترات لاحقة؛ ذلك أن هذه الحقوق الفريدة للإنسان موجودة في الطبيعة البشرية، وبالتالي فهي طبيعية (Donnelly, 1982, p. 391).
إن الحقوق الطبيعية تنشأ مع وجود الإنسان، ومن ثم فالحقوق الطبيعية هي حقوق لا يمكن للناس التنازل عنها أو التصرف فيها (Turner, 1993). وبعبارة أخرى، فإن حقوق الإنسان لا تنشأ عن أي وضع اجتماعي أو رأي سياسي أو أصل عرقي أو قوة اقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، بما أن للحقوق الطبيعية سمة عالمية، فليس من الصواب حصرها في مكان وزمان معينين. حقوق الإنسان صالحة حيثما كنا في العالم (Giritli & Güngör, 2002). ولهذا السبب، عندما ننظر إلى الدراسات الدولية، لا نجد رأيًا أو فكرة مقبولة ومنتشرة مثل حقوق الإنسان. على سبيل المثال، وقعت 192 دولة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المصدر الأساسي لحقوق الإنسان الحديثة. ومن المعروف أنه، خاصة منذ ثمانينيات القرن العشرين، أجرى علماء الأنثروبولوجيا دراسات أكثر شمولاً وفعالية حول حقوق الإنسان على أساس كل دولة على حدة (Goodale, 2006, p. 506). وهذه الدراسات هي مصدر مهم للأمل للأجيال القادمة. لأنه بصرف النظر عن الأنثروبولوجيا الفلسفية، فإن دراسة البشر ككائنات فردية واجتماعية هي أيضًا مجال دراسة العلوم الاجتماعية الأخرى.
وتحتل حقوق الإنسان مكانة مهمة في العلاقات الفردية والاجتماعية للبشر. ويظهر مفهوم الحقوق، الذي له مكانة مهمة في العلاقات الإنسانية، مصاحبًا للحياة الاجتماعية (Çeçen, 2020, p. 21). كما تستمر حقوق الإنسان في الوجود مع البشر وتكتسب أهمية مع الحياة الاجتماعية. ونظرًا لأن الناس يعيشون معًا كمجتمع، فقد كان مصدر هذه الحقوق موجودًا دائمًا (Arslan, 2021). ومع ذلك، فقد نوقشت حقوق الإنسان في إطار مفاهيمي في القرون الأخيرة. وعندما ننظر إلى مجالات دراسة الأنثروبولوجيا، نجد حقوق الإنسان من بين الموضوعات التي تتطور وتتوسع بسرعة (Klein & Riles, 2005).
حماية حقوق الإنسان
إن الناس هم الذين يضفون معنى على العالم الذي يعيشون فيه. كما أن عملية صنع المعنى هذه تبرز الوعي بحقوق الإنسان. فالبشر هم أولئك الذين يعرفون الثقافة ويبتكرون في العلم والتكنولوجيا، ويتساءلون عن حريتهم ويدافعون عنها. إن وجود المواهب والحرية الإنسانية والحقوق الأساسية والقانون وحقوق الإنسان من بين أهم القضايا؛ وذلك لأن الجانب الإبداعي للإنسان يعتمد بمعنى ما على حريته وليس على حالته الجسدية (Bodenheimer, 1971, p. 660).
ولا ينبغي أن ننسى أن الوضع القانوني لحقوق الإنسان وحرياته ليس مبدأ مجردًا مستقلًا عن القاعدة القانونية، بل هو قاعدة قانونية إيجابية لها سلطة الجزاء ويمكن تطبيقها (Engin, 2014, p. 214). فتلعب حماية حقوق الإنسان دورًا مهمًّا يومًا بعد يوم في سياق ظروف العصر. والواقع أن حماية حقوق الإنسان كانت من بين القضايا التي نوقشت منذ وجود البشر، إلا أن فكرة حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي نوقشت في أوائل القرن العشرين (Birinci, 2017). ومن المعروف أن الفلسفة اليوم، كما في العصور القديمة، تركز على مشاكل البشر وتدرسها. ولهذا السبب، تعمل الفلسفة بفعالية على تطوير إمكانيات حل المشاكل الموجودة في حياة الإنسان. وتقدم الفلسفة الحلول الممكنة لانتهاك بعض حقوق الإنسان في عالم اليوم. وفي مواجهة هذا الوضع، تجعل الأنثروبولوجيا الفلسفية الدراسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ضرورية. فعندما لا يكون الناس متساوين، تُتجاهل حقوق الإنسان، ويُقضى على الحريات والحياة البشرية. ويمكن إعطاء أمثلة بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب في كوسوفو وتدخل روسيا في أوسيتيا الجنوبية (Griffin, 2008).
ويتزايد اليوم عدد الأمثلة المشابهة لهذه الانتهاكات يومًا بعد يوم. والأمثلة الأكثر واقعية هي الحروب الدائرة في العراق (Davis, 2005)، وأفغانستان (Sadat, 2004, p. 14)، وسوريا (Dixon, 2019)، وبين فلسطين وإسرائيل. وتتجاهل هذه الحروب حقوق الإنسان، والحياة البشرية والحريات وسلامة أراضي البلاد. وكما يتبين من الأمثلة المذكورة، لا تزال هناك حروب مستمرة في أجزاء مختلفة من العالم.
من هنا يمكننا القول إن على العلماء والفلاسفة واجبات مهمة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. فيقول كانط (2010) إن العقل في كل الأحوال يعارض بشدة النهج الذي يستخدم الحرب (Kant, 2010)، وهو يرى أن السلام المطلق واجب ويفتح كل أبواب السلام للبشرية. في الواقع، من المعروف أنه قبل فكرة كانط عن السلام الأبدي، كان القديس أوغسطين (354-430)، أحد أهم فلاسفة الفكر الغربي، قد أسس السلام على النهج الإنساني في سياق الإنسان والإنسان، والإنسان والطبيعة، والإنسان وذاته (Ökten, 2001, p. 235).
ونتيجة لذلك، ينبغي للمدافعين عن حقوق الإنسان والفلاسفة حماية هذه الحقوق من خلال إيجاد حلول عاجلة لهذه القضايا. وما يجب القيام به هنا هو اتباع طريقة تعطي الأولوية لحق كل شخص في الحياة (Dworkin, 2007). ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه في عالم اليوم، تضمن المؤسسات الإقليمية والدولية حماية حقوق الإنسان (Akyüz, 2021b). ويمكن إعطاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كمثال على المستوى الإقليمي. فتخضع انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان التي قبلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (Helfer, 2008; Gearty, 1993). وعلى المستوى الدولي، تعد الأمم المتحدة السلطة المختصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي تلعب دورًا نشطًا بشكل خاص في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان (Forsythe, 1985; McDoug & Bebr, 1964).
ثانياً، لدى الأنظمة القانونية المحلية للدول أيضاً آليات تحمي حقوق الإنسان وترصد انتهاكاتها. وتأتي الدساتير في المقام الأول من بين هذه الآليات (Beck, Drori & Meyer, 2012; Brewer-Carías, 2009). فلكل دولة دستور يحدد شكل حكومتها ويضمن الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها. على سبيل المثال، يحمي دستور عام 1982 الساري في تركيا الحقوق الأساسية للأفراد (Hekimoğlu, 2002). وتحمي قوات إنفاذ القانون الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وفي حالة انتهاكها تُفحص هذه الانتهاكات من قبل السلطات القضائية. ومن هذا المنظور، تهدف الأنظمة القانونية للدول أيضاً إلى حماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن مدى فعالية هذه الآليات في منع انتهاكات حقوق الإنسان أمر مثير للجدل.
لذلك، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان إلى المستوى المطلوب، لا بد من إدراج هذه المبادئ في المنزل والشارع والمؤسسات التعليمية وبيئات العمل وجميع العلاقات الاجتماعية (Yeşil, 2004). ومن الأهمية بمكان ألا تقتصر حماية الحقوق على القوانين والقواعد فحسب، بل لا بد ان تنعكس أيضًا في السلوك.
المناقشة والاستنتاج
إن من أقدم مساعي البشر تاريخيًّا الحفاظ على حياة الإنسان بإنصاف ومساواة. والسبب وراء هذا البحث هو ظروف العصر الذي نعيش فيه. وعلى الرغم من أن ظروف العصر تتغير بالنسبة للناس، فإن حياة الإنسان وأمنه وحريته وحقوقه تستمر ولا تتغير. ويواصل الناس حياتهم بفرص مختلفة بما يتماشى مع تطورات العصر. ومن المستحيل ألا يتأثر الناس الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم بهذه التطورات. فلدى البشر خصائص مختلفة عن الكائنات الحية الأخرى بسبب مكوناتهم البيولوجية والنفسية. وأوضاع الوجود التي تنسبها الأنثروبولوجيا الفلسفية إلى الطبيعة البشرية لها مكانة مهمة في هذا السياق. وفي نهاية المطاف، من المهم تطوير القدرات البشرية وتوجيهها بشكل صحيح. ومن أجل توجيه المواهب بشكل صحيح، من الضروري معرفة الشخص وجانبيه البيولوجي والنفسي. فالإنسان كائن يحمل سلامته البيولوجية النفسية في داخله. إن القدرة على امتلاك وجود نفسي بيولوجي ليست إنجازاً فرديًّا للإنسان، بل الطبيعة هي التي تمنح هذه القدرة للإنسان، وهي وضع وجودي طبيعي غير قابل للتغيير، إلا أن الإنسان يدرك أوضاع الوجود من خلال تطوير كل الأفعال والاهتمامات والقدرات التي يجدها في بنيته البيولوجية والنفسية.
وفي واقع الأمر، إن ما يكشفه الإنسان طيلة حياته يدل على أنه كيان متكامل بيولوجي ونفسي. وكما يؤكد منغوش أوغلو أيضاً، فإن تعريف الإنسان على أساس بعض ظواهره فقط يؤدي إلى نواقص. ومع ذلك، يجبر الإنسان هذا النقص من خلال تبرير سلوكه وإضفاء طابع أخلاقي عليه. وهذه الظواهر الأساسية التي يجبرها الإنسان تشكل أيضاً مجال إنجازاته. وهذه الإنجازات ليست سوى فئات أنثروبولوجية تحدد مجال الوجود الإنساني.
وفي هذا السياق، توفر دراسة الأنثروبولوجيا الفلسفية للظواهر الإنسانية الأساسية معلومات عن العالم البشري؛ لأن الأنثروبولوجيا الفلسفية هي نهج يتعامل مع الظواهر والإنجازات التي تجد أساسها في الأفعال البشرية. وتركز المعلومات التي تقدمها الأنثروبولوجيا الفلسفية على المشاكل الموجودة في العالم البشري وتقدم الحلول لها. ومن ثم، أصبح نهج الأنثروبولوجيا الفلسفية مهمًا دائمًا في تاريخ الفلسفة من حيث فهم البشر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البشرية. وتعد حرية الإنسان وأمنه وممتلكاته وحقوقه من بين القضايا التي تعتبر مهمة في تاريخ الفلسفة، والتي تستمر دراساتها طالما استمر الوجود البشري. لذلك، فالفلسفة والأنثروبولوجيا الفلسفية تؤديان وظيفة مهمة في حياة الإنسان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. إحدى هذه الوظائف هي التأكيد أن جميع الناس يولدون متساوين ولهم الحقوق نفسها. ومع ذلك، لا ينبغي إغفال أن الدول المتقدمة تستثمر بشكل متزايد في تكنولوجيا الحرب التي من شأنها أن تقضي على حياة الإنسان؛ وذلك لأغراض الدفاع ومواجهة التهديد الخارجي. ومن بين هذه التهديدات الاستثمار في الأسلحة النووية كمثال. فالكثير من الأرواح البشرية معرضة للخطر في الحروب التي تندلع مع زيادة الاستثمارات في الأسلحة النووية، كما يتزايد عدد النازحين من ديارهم نتيجة للحروب يوما بعد يوم.
إن هذه الأوضاع التي تتزايد يوماً بعد يوم في العالم، تُظهر تجاهل مبدأ سريان حقوق الإنسان على جميع الأمم. ولأن هذا الوضع يزيد من قلق الناس، فإن حقوق الإنسان تصبح موضوعاً للنقاش المستمر. وتسعى الأنثروبولوجيا الفلسفية إلى خلق أساس متين لحقوق الإنسان من خلال تقديم مناهج جديدة من أجل الناس جميعًا على المستويين الوطني والدولي. فلكل الناس الحق في التعليم إلى جانب الحق في الحياة والمأوى. وللفلسفة والأنثروبولوجيا دور مهم في حماية هذه الحقوق وتطويرها.
ومع التطورات الجديدة في حياة الإنسان، لا يزال النظام الأكثر تقدمًا ومثالية لحقوق الإنسان قائمًا. ومن المهم النظر إلى البعد الفكري لحقوق الإنسان في هذا الإطار ونشره على جميع الأمم. إن حقوق الإنسان ليست خاصة بأي مجتمع أو بلد. هذه الحقوق هي حقوق عالمية لجميع الناس. ومن المهم التعامل بنفس الحساسية فيما يتعلق بتحقيق هذه الحقوق العامة والعالمية للناس وتنفيذها. والجهود النظرية والعملية للفلاسفة مهمة بشكل خاص في هذا التنفيذ والإعمال. ومع الدراسات في هذا المجال، يجب بذل المزيد من الجهود لتسليط الضوء على حقوق الإنسان ونشرها وزيادة الوعي بها؛ لأن المجتمعات الحالية والمستقبلية تتشكل من خلال الاحترام والحساسية تجاه حقوق الإنسان. لذلك، يجب إيجاد حلول لمشاكل حقوق الإنسان بجهود أكبر من تلك التي تُبذل اليوم.
إن الطريق إلى الأنظمة التي تجعل الناس سعداء يمر عبر المزيد من الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن غير المعقول أن ننعم بالسلام في مجتمعات لا يوجد فيها عدالة ومساواة ورخاء وحرية. وفي ضوء هذه الحجج، تغلق الأنثروبولوجيا الفلسفية الباب أمام المناقشات الديماغوجية حول حقوق الإنسان. فهي تستعرض ما علينا فعله لإعمال الحقوق وتقدم حلولاً فلسفية. وإلى جانب هذه الحلول، من الضروري توسيع نطاق التربية الديمقراطية في الأماكن التي يوجد فيها تربية على حقوق الإنسان. وحيثما توجد برامج تعليمية تتعلق بحقوق الإنسان، فلابد من زيادة ساعات الدورات الدراسية على مستوى التعليم الاساسي تدريجيًّا. وعلى نحو مماثل، لابد من خلق الوعي من خلال إعطاء الأولوية لنشر التعليم الفلسفي في التعليم الثانوي والعالي. ولابد من توسيع التفاعلات المؤسسية والتدريب على المستويين الوطني والدولي من أجل إعطاء أهمية لاحترام حقوق الإنسان. ومن الحقائق التي لا مفر منها أنه في مجتمع حساس لحقوق الإنسان، تحاول الفلسفة والأنثروبولوجيا الفلسفية تحقيق أهدافهما الأساسية في حياة الإنسان. وعندما ننظر إلى الإنسان بصفته كائناً ذا قيمة وكرامة، فإنه لا يتطور إلا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لحقوق الإنسان. ومن أجل فهم حقوق الإنسان بشكل صحيح وتطبيقها في المجتمع، فإن من الأولويات الحيوية فهمها من خلال إعطاء أهمية للحياة البشرية وكرامتها. ويمكِّن مثل هذا النهج من حماية حقوق الإنسان، وإضفاء معنى حقيقي عليها، واكسابها طابعًا عالميًا.
REFERENCES
Akyüz, E. (2023). An environmental human rights approach to environmental tobacco smoking. Muslim World Journal of Human Rights, 20(1), 97-120
Akyüz, E. (2015). Çevre sorunları ve insan hakları ilişkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 427-436
Akyüz, E. (2021b). The development of environmental human rights.
International Journal of Environment and Geoinformatics, 8(2), 218-225
Akyüz, E. (2021a). Nuclear Power and Human Rights İn Japan: The Fallout of Fukushima. Lexington Books.
Arslan, A. (2021). Felsefeye Giriş. Serbest Akademi Yayınları.
Beck, C. J., Drori, G. S. & Meyer, J. W. (2012). World influences on human rights language in constitutions: A cross-national study. International Sociology, 27(4), 483-501
Birinci, G. (2017). İnsan hakları evrensel bildirgesi’nin kısa tarihi ı: milletler cemiyeti’nden birleşmiş milletler’e. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7(2), 50-81
Bodenheimer, E. (1971). Philosophical anthropology and the law. Calif. L. Rev, (59), 653-682
Brewer-Carías, A. R. (2009). Constitutional Protection of Human Rights in Latin America: A Comparative Study of Amparo Proceedings. Cambridge University Press.
Bryan S. T. (1993). Outline of a theory of human rights. Sociology, 27(3), 489-512.
Çeçen, A. (2020). İnsan Hakları. Astana Yayınları.
Clammer, J. (2005). Beyond power: alternative conceptions of being and the (asian) reconstitution of social theory. Asian Journal of Social Science, (33), 162-76
Çotuksöken, B. (2012). İnsan Hakları ve Felsefe. Papatya Yayınları.
David L, H. & Ames, R. T. (1998). Thinking From The Han: Self, Truth And Transcendence İn Chinese And Western Culture. State University of New York Press.
Davis, M. C. (2005). Human rights and the war in iraq. Journal of Human Rights, 4(1), 37-44
Dixon, P. (2019). Endless wars of altruism? human rights, humanitarianism and the syrian war. The International Journal of Human Rights, 23(5), 819-842
Donnelly, J. (1982). Human rights as natural rights. Human Rights Quarterly, 4(3), 391
Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory And Practice. Cornell University Press.
Dworkin, R. (2007). Hakları Ciddiye Almak (A. U. Türkbağ, Çev.). Dost Kitabevi.
Engin, Z. Ü. (2014). Birey kavramının gelişimi ve insan hakları. Journal of Istanbul University Law Faculty, 72(1), 201-217
Forsythe, D. P. (1985). The United Nations and human rights, 1945-1985. Political Science Quarterly, 100 (2), 249-269
Fox, W. (1990). Towards A Transpersonal Ecology: Developing New Foundations for Environmentalism. Shambhala.
Freeden, M. (1991). Rights. University of Minnesota Press.
Gearty, C. A. (1993). The European court of human rights and the protection of civil liberties: an overview. The Cambridge Law Journal, 52(1), 89-127
Giritli, İ. & Güngör, H. A. (2002). Günümüzde İnsan Hakları. Der Yayınları.
Goodale, M. (2006). Toward a critical anthropology of human rights. Current Anthropology, 47(3), 485-511
Griffin, J. (2008). On human rights. Oxford University Press.
Gürdal, G. (2020). Felsefi antropoloji’nin gerekliliği ve max scheler’in felsefi antropoloji’sinin değerlendirilmesi. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (29), 135-144
Harvey, D. (2002). Spaces of Hope. Edinburgh University Press.
Hekimoğlu, M. M. (2002). 1982 Anayasasına göre insan hakları kavramı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(7), 53-70
Helfer, L. R. (2008). Redesigning the european court of human rights:
embeddedness as a deep structural principle of the european human rights regime. European Journal of International Law, 19(1), 125-159
Ishay, M. (2008). The History of Human Rights: From Ancient Times to The Globalization Era. University of California Press.
Jean-Klein, I. & Riles, A. (2005). Introducing discipline: anthropology and human rights administrations. Cornell Law Faculty Publications, 28(2), 173-202
Kamruzzaman, Md. & Das, S. K. (2016). The evaluation of human rights: an overview in historical perspective. American Journal of Service Science and Management, 3(2), 5-12
Kant, I. (2007). Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme. Kant (N. Bozkurt,Çev.). Say Yayınları.
Kuçuradi, İ. (2007). İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları. Türkiye Felsefe Kurumu.
McDougal, M. S. & Bebr, G. (1964). Human rights in the United Nations. American Journal of International Law, 58(3), 603-641
Radin, P. (1957). Primitive Man as Philosophy. Dover.
Sadat, M. H. (2004). The implementation of constitutional human rights in afghanistan. Human Rights Brief, 11(3), 48-51
Şahin, C. (2020). Antropolojinin konusu, temel kavramları, yöntemi ve tarihçesi.
M. Güçlü (Ed.), Eğitim Antropolojisi içinde (s.2-21). Pegem Akademi Yayınları.
Torun, Y. (2007). İnsan hakları. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 415-424
Uysal, E. (2004). Eğitime felsefi antropoloji çerçevesinde kavramsal bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 81-
100.Ward, T. & Birgden, A. (2007). Human rights and correctional clinical practice. Aggression and Violent Behavior, 12(6), 628-643
Yeşil, R. (2004). İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde yöntem. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 35-41
Yeşilçayır, C. (2018). İnsan haklarının aydınlatılmasında felsefi bilginin önemi. Kaygı, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (31), 239-261
Yurttaşer, M. A. (2017). Geçmişten günümüze kıta avrupası ve ingiltere politikalarının karşılaştırılması. Euro Politika, (2017 Özel Sayı), 219-236
[1]- مجلة مدرسة التاريخ، جامعة أوشاك، تركيا، عدد 69، 2024