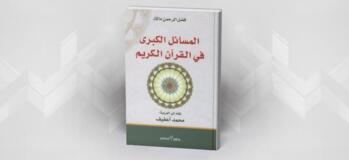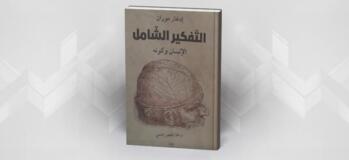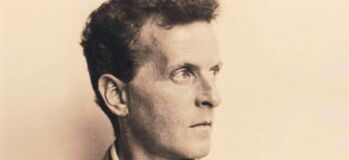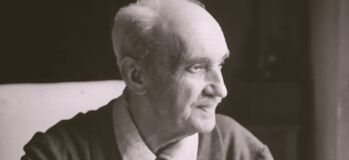الأدب وليد المجتمع (دراسة تأصيلية في مفهوم سوسيولوجيا الأدب)
فئة : مقالات

الأدب وليد المجتمع
(دراسة تأصيلية في مفهوم سوسيولوجيا الأدب)
"تطرح سوسيولوجيا الأدب على بساط البحث العلاقات التي تُقيمها الحياة الأدبية مع الحياة الاجتماعية"([1]).
"إن سوسيولوجيا الأدب تلوح في بعض الأحيان كمعرفة مشغولة فقط بإنتاج الأدب ونشره واستهلاكه وفي مرات أخرى تتقدم كنموذج علمي للنقد الأدبي، خصوصاً مع موجة النقد السوسيولوجي التي استحوذت على النقاش السياسي خلال منتصف القرن الماضي وما بعده، ولكنها في الواقع تجمع في مطبخها الداخلي عدداً من المقاربات التي تحلل مختلف المظاهر الأدبية داخل النص وخارجه، بين الكاتب والمتلقي، الأدب عموماً والمجتمع، وهذا التقابل الموضوعاتي هو الذي يكشف عن الحدود المعرفية لسوسيولوجيا الأدب"([2]).
تمهيد:
نعتقد أن الكلمات ليست حروفاً جامدة على الورق، بل هي نبض حي ينبثق من صميم الواقع ليصوغه من جديد؛ فالأدب والمجتمع كتوأمين ملتصقين، أحدهما يروي حكاية الآخر، والآخر يلهمه حبكات جديدة. فالأدب ليس مجرد مرآة تعكس واقعاً اجتماعياً جامداً، بل هو نحات ينحت الوعي الجمعي([3])، وثائر يهز اليقينيات، وحالم يخطط لمستقبلٍ لم يُولد بعد.
فمن رحم المعاناة تولد الروايات، ومن أحلام الثوار تُنسج القصائد، ومن صخب المدن تبرز الشخصيات التي تحمل في طياتها تناقضات العصر. فهل يمكنك تخيل العالم دون "ألف ليلة وليلة"([4]) التي حفظت أسرار الشرق، أو "دون كيخوتي أو دون كيشوت" لميغيل دي ثيربانتس عام 1605 التي سخرت من أوهام الفروسية؟ إن الأدب تاريخ غير مكتوب للمهمشين، وصوت للذين التهمهم صمت التاريخ. لكن العلاقة ليست باتجاه واحد، فكما يصوغ الأدب المجتمع، تغذيه تحولات المجتمع بدورها. فالثورات تلد قصائد ملتهبة كشعر الكبير محمود درويش (1941- 208)، وهو شاعر فلسطين الذي سجل تراجيديا الأرض والإنسان، والحروب تحفر جراحها في روايات الكاتب الروائي والمسرحي إلياس خوري (1948-2024)، والتكنولوجيا (الأدب خارج الورق) تفرض أسئلة وجودية على أدباء العصر الرقمي، فإن سؤال مستقبل هذا الأدب الذي بدأ شفهياً، وانتقل كتابياً ورقياً، وها هو الآن يتحول لمرحلة جديدة عبر الوسيط التقني إلى ما يسمى "بالكتابة الرقمية"، و"الإبداع الرقمي" والثقافة الرقمية([5]).
بالمقابل، نجد أن كلمات الأديب قد تشعل ثورة كما حدث مع رواية "كوخ العم توم" في الحرب الأهلية الأمريكية لهارييت ستو([6]) عام 1852، أو تعيد تعريف الهوية كما فعلت رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح([7]) عام 1966. فإذا كان المجتمع جسداً، فإن الأدب روحه التي تنبئ بالأسقام قبل أن تظهر، وتشخص الأحلام قبل أن تتحقق. هذه العلاقة الجدلية الغامضة هي ما يجعل من سؤال "الأدب والمجتمع" لغزاً يستحق الاستكشاف والتعجب... أيعقل أن تكون الكلمات بهذه القوة!!!
وهكذا يكوّن الأدب والمجتمع نسيجاً واحداً متشابكاً؛ فكل منهما يؤثر في الآخر ويستمد منه قوته. فالأدب ليس مجرد مجموعة من الحروف والكلمات، بل هو مرآة تعكس المجتمع بكل جوانبه وأبعاده الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وهو أيضاً أداة للتأثير في المجتمع وإعادة رسم معالمه، حيث يعكس الأدب ويشكّل قيم ومعتقدات المجتمع الذي يوجد فيه.
باختصار شديد، يعدّ الأدب والمجتمع وجهان لعملة واحدة. فالأدب هو نتاج المجتمع، يؤثر فيه ويتأثر به. بناءً على ما سبق، سنناقش بشيء من التفصيل والتبسيط العلاقة ما بين الأدب والمجتمع من خلال العناصر التالية:
أولاً- الأدب وليد المجتمع: لم يعد ثمة إلحاح على إثبات اجتماعية الأدب وارتباطه بالواقع الاجتماعي، فقد أصبح ذلك من البديهيات المسلم بها، ولكن التساؤلات تطرح دائماً حول طبيعة تلك العلاقة القائمة بينهما أو الكيفية التي يرتبطان بها، وما مدى التجانس بينهما بالنظر إلى التنافر الظاهر بوصف الأدب فردياً خيالياً، وعلم الاجتماع موضوعياً واقعياً([8]).
في حقيقة الأمر، إن علاقة الأدب بالمجتمع علاقة جدلية تفرضها مقومات النشأة والتطور في سياق معين، وقد فرضت الظروف والمتغيرات والتحولات المجتمعية ظهور نوع جديد من الالتزام المحدد بالأوضاع الاجتماعية والسياسية، الثقافية التي تتحول وتتغير بوصفها صيرورة وجودية لا بد من التعبير عنها أدبياً، والمقصود هنا بالالتزام انصهار الأديب في مجتمعه وانشغاله بقضاياه التي تعد جزءاً من يومياته الاجتماعية. بمعنى أبسط، هي علاقة وثيقة ومتبادلة، حيث يؤثر كل منهما في الآخر بشكل عميق. وتتجسد العلاقة بينهما عندما يعكس الأدب قيم المجتمع وتقاليده وأفكاره وهمومه بوصفه مرآة تعكس صورة الحياة اليومية للناس وتساعدهم على فهم أنفسهم وعالمهم بشكل أفضل. ولا يقتصر دور الأدب على عكس الواقع فقط، بل يتعداه إلى تشكيل المجتمع وتوجيه الأفكار والسلوكيات، فالكتب والشعر والقصة القصيرة والروايات وغيرها من أشكال الأدب يمكن أن تغير نظرتنا إلى العالم وتلهمنا للتغيير. كما يعدّ الأدب وسيلة للتعبير يوفر منصة للتعبير عن الأفكار والمشاعر التي قد يصعب التعبير عنها بطرائق أخرى. يمكن للأدب أن يكون صوتاً للمهمشين والمضطهدين، وأن يفتح حواراً حول القضايا الاجتماعية والسياسية. وأخيراً يحفز الأدب عملية التغيير الاجتماعي، حيث يمكن للأدب أن يكون قوة دافعة للتغيير الاجتماعي، فالعديد من الحركات الاجتماعية والثورات استلهمت أفكارها من الأدب. ومن الأمثلة على ذلك (المذاهب الأدبية)([9]): الأدب القديم (أو ما يعرف بالأدب الكلاسيكي) الذي يتناول القضايا الاجتماعية والسياسية في المجتمعات القديمة، مثل: (الظلم، والعدالة، والحب، والحروب). باختصار شديد هو الأدب الذي كان يُدرّس في أوروبا، والذي ينظر إليه على أنه الأدب الحقيقي الذي بقي على مر العصور الأوروبية، محافظاً على عراقته الأدبية، وصامداً في وجه التحولات والتغيرات الأدبية، وينظر إليه على أنه الوسيلة الأفضل للتربية والتثقيف، وأطلق عليه الأدب القديم أو الكلاسيكي، لتميزه عن اللهجات المحلية المطورة التي تجاهلها النقاد. والأدب الرومانسي الذي يعبّر عن المشاعر الإنسانية العميقة وأثرها على حياة الأفراد. والرومانسية هي وليدة الثورة على القيم الكلاسيكية في أوروبا في مجالات السياسة والاجتماع والفكر؛ وذلك في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. وهي ترجع إلى أفكار فيلسوف العقد الاجتماعي (جان جاك روسو) في فرنسا التي مهدت للثورة الفرنسية عام 1789، وجسدت القيم الليبرالية أو النزعة التحررية في مجالات الحياة كافة. فقد سيطرت الملكية والإقطاع والكنيسة على أوروبا لفترة طويلة، وأخضعت الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية إلى قيود وضوابط كان الإنسان مجبرا على حملها، ولكنه لم يعد قادراً على تحملها في القرن الثامن عشر بما عج فيه من أفكار واكتشافات وتوجيهات وطنية وقومية. ويعدّ فيكتور هوغو (1802-1885) واحداً من أهم الشعراء والروائيين والمسرحيين الرومانسيين في أوروبا، كتب العديد من الأعمال العظيمة، والتي تعد من الأعمال الخالدة في الأدب العالمي؛ وذلك من خلال تنقله بين العديد من المدن مثل باريس وبروكسل وجزر القنال، ومن أهم مؤلفاته رواية: (أحدب نوتردام، البؤساء)، وقد اشتهر في فرنسا كونه شاعراً أكثر من كونه روائياً. ومن أهم رواد الأدب الرومانسي عربياً "جبران خليل جبران"، وهو فيلسوف وشاعر وكاتب ورسام لبناني أمريكي، ولد في عام 1883 ببلدة بشري شمال لبنان، هاجر وهو صغير مع أمه وإخوته إلى أمريكا عام 1895، حيث درس الفن وبدأ مشواره الأدبي، أسس الرابطة القلمية هناك، واشتهر عند العالم الغربي بكتابه الذي تم نشره سنة 1923، وهو كتاب "النبي"، وكانت إبداعاته الأكثر مبيعاً، بعد شكسبير ولاوزي، توفي في نيويورك عام 1931 بداء السل. بالإضافة إلى الأدباء "عباس العقاد، وميخائيل نعمة".
أما الأدب الواقعي، فقد سعى إلى تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع مثل: (الجريمة، العنف، الاستبعاد الاجتماعي، حقوق الإنسان). الواقعية الأدبية (الأدب الواقعي) محاولة تصوير الحياة تصويراً واقعياً دون إغراق في المثاليات، أو جنوح صوب الخيال. ظهرت الواقعية الأدبية في أربعينيات القرن التاسع عشر في فرنسا، وأثرت في أوروبا كمحاولة لإعلاء شأن تصوير الحياة الواقعية، وهي حركة أدبية واعية عارضت الرومانسية التي كانت سائدة في بداية القرن التاسع عشر. ففي أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كانت الرومانسية سائدة ومهيمنة على الإبداع الأدبي، والتي كانت ثورة ضد المعايير الاجتماعية والسياسية الأرستقراطية التي تنتمي إلى عصر التنوير السابق، لكن في منتصف القرن التاسع عشر جاءت الواقعية كردة فعل على الرومانسية التي أفرطت في الخيال والأحلام والانطواء على الذات. من أهم مبادئ الأدب الواقعي المجتمع (الواقع الاجتماعي)، حيث تسلط المدرسة الواقعية الضوء على كل ما يهم المجتمع والحياة البشرية، مهما كانت هذه القضايا بسيطة أو صغيرة، فهي تعالجها، وتبتعد عن كل الأمور التي لا تهم المجتمع مثل السريالية والخيال والخرافات التي تختلف كلّياً عن الواقع المحيط.
والواقعية الأدبية هي باختصار شديد "تمثيل الواقع في الأدب"؛ أي تمثيل الموضوع بصدق دون اصطناع، مع تجنب العناصر صعبة التصديق وتجنب الإغراب وما وراء الطبيعة. فهي حركة تصور الواقع والحياة بدقة دون تحسين أو تجميل، وتجنح بعيداً عن المثاليات والخيال وكل ما هو بعيد عن الواقع([10]).
وفي السياق الثقافي العربي، بُني الأدب العربي على مدارس عدة، ولكل مدرسة فكر خاص، وتوجهات معينة تسير وفقها، ويلتزم أدباء هذه المدرسة بمبادئها وتوجهاتها، ومن المدارس الأدبية التي انتشرت في العصر الحديث، ولا سيما في الأعمال الأدب العالمي كانت المدرسة الواقعية في الأدب. مع أن الواقعية تتجلى كمدرسة لها مبادئها وأسسها، إلا أن الوقوف عند تحديد مفهومها بدقة لم يُضبط ضبطاً دقيقاً إلى الآن؛ إذ تكثر الآراء ووجهات النظر حول تعريف المدرسة الواقعية في الأدب، ولا سيما في الأدب العربي.
ومن رواد المدرسة الواقعية في الأدب العربي الأديب "حنا مينا" اقتبس مينا ففي أعماله الكثير من أسلوب الواقعية الماركسية، حتى كادت أعماله كلها تتشابه في الفكرة الرئيسة، فجل أعماله عن طبقة العمال والفلاحين والكادحين الذين يُستغلّون من قبل الإقطاعيين والتجار. كما نلمح الواقعية الاشتراكية في رواية (الأرض) للأديب "عبد الرحمن الشرقاوي"، وقد دارت أحداثها في عقد الثلاثينيات في إحدى القرى المصرية مظهرة حاجة أهل القرية إلى الإصلاح الزراعي من خلال توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين، ومواجهتهم للفساد وتقلبات الطبيعة. ومن الروايات التي مثلت الواقعية النقدية التي ركزت في أدبها على مشكلات الطبقة البرجوازية الصغيرة: رواية (زقاق المدق) "للأديب نجيب محفوظ" وفيها يصور حياة الناس في حي زقاق المدق في القاهرة إبان الحرب العالمية الثانية، ويظهر انصياع الشخصيات الروائية التي تعيش في هذا الحي للمؤثرات الاقتصادية والاستعمارية لتنتهي بها الأحداث نهايات مأساوية.
وفيما يتعلق بالأدب النسوي، نجد أنه يتمحور حول قضايا المرأة وحقوقها وكفاحها من أجل المساواة مع الرجل. ويطلق عليه أيضاً أدب الأنثى أو أدب المرأة، وهو يشير بالمعنى الدقيق إلى الأدب الذي يكون النص الإبداعي فيه مرتبطاً بطرح قضية المرأة والدفاع عن حقوقها دون أن يكون الكاتب امرأة بالضرورة. ويعرفه البعض على أنه الأدب المرتبط بحركة نصرة المرأة وحرية المرأة وبصراع المرأة الطويل التاريخي للمساواة بالرجل، بينما يراه البعض الآخر مصطلحا يستشف منه افتراض جوهر محدد لتلك الكتابة بتمايز بينها وبين كتابة الرجل في الوقت الذي يرفض الكثيرون فيه احتمال وجود كتابة مغايرة تنجزها المرأة العربية استيحاء لذاتها وشروطها ووضعها المقهور([11]). والحقيقة تكمن في أن المرأة الكاتبة والأديبة تستخدم اللغة أداةً للإبداع؛ أي لغايات تعبيرية وفنية، لتتمكن بالدرجة الأولى من تجاوز منطقة الصمت التي استقرت فيها عدة قرون، لا بل فضّل المجتمع والسلطة أن يبقيها عالقةً فيها، وبالتالي، من الإفصاح عن رؤيتها للعالم والآخر والذات وعدم الاكتفاء بدور الناقلة للقيم الثقافية من خلال الأدوار المتوقعة منها كأم أو مربية، فتضطلع عبر اللغة والإبداع بدورها كفاعلة ومبدعة ومتملكة لناصية اللغة؛ أي أداة النقل والتعبير، ما قد يفسر لنا جزءاً من الأسباب التي جعلت الأدب واللغة من ورائه (والمسرح بدرجة أقل تداولاً) يختصان بهذه التسمية دون السينما والفن التشكيلي والنحت وغيرها من الفنون. فالصورة، وإن كانت مُحملة بالرموز القوية، تنقل حدثاً أو مشهداً، ويبقى أثرها على النفس وتشكلها وامتدادها ذات آثار محدودة بالمقارنة مع اللغة التي تمتلك قدرة هائلة على نقل القيم والمعاني داخل ثقافة ما وإحداث قطيعة مع سياسة الصمت المفروضة على شرائح معينة من المجتمع([12]). ومن أهم رائدات الأدب النسوي في الأدب العربي "مي زيادة" (1886-1941)، فقد لعبت دوراً بارزاً في الدفاع عن حقوق المرأة، والمطالبة بالمساواة. لذا استحقت أن تكون رائدة من رائدات النهضة النسائية العربية الحديثة، حيث استطاعت عبر مسيرتها أن تقدم للمرأة صورة جديدة تتقاطع مع عنوان أحد أشهر كتبها، وهو (بين الجزر والمد) الصادر عام 1924، وكذلك كانت حياتها الأديبة. وأيضاً الكاتبة والروائية الجزائرية "أحلام مستغانمي" (1953-)، التي تعد واحدة من أشهر الكاتبات العرب وأكثرهن جماهيرية بين مختلف الفئات العمرية، حيث صنفت روايتها (ذاكرة الجسد) الصادرة عام 1993، ضمن أفضل مائة رواية عربية، كما فازت بجائزة "نجيب محفوظ للأدب" عام 1998، وميدالية الرواد اللبنانيين تكريماً لها على مجمل أعمالها، بالإضافة إلى ذلك، منحها مركز دراسات المرأة العربية في باريس ودبى لقب أكثر النساء العرب تميزاً لعام 2006.
وعن أهمية دراسة علاقة الأدب بالمجتمع، نجد أنها تنبع من خلال الدور الذي يلعبه الأدب في الحياة الاجتماعية، حيث يساعد الأدب على تحقيق فهم أعمق للتاريخ والثقافة والقيم التي شكّلت مجتمعاتنا. كما يعتبر الأدب أداة قوية للتعبير والتغيير في السياقات الاجتماعية المختلفة. بالإضافة إلى أن الأدب يمكننا من المشاركة في النقاشات والحوارات البنّاءة حول القضايا والمشاكل المجتمعية المصيرية من خلال فهم وتحليل وتفسير النصوص الأدبية.
خلاصة القول، إن العلاقة بين الأدب والمجتمع قائمة بالفعل، وبالقوة؛ فالأدب لا يكون أدباً إلا في ظل شروط اجتماعية محددة، فالأديب المنتج للعمل الأدبي، هو في البدء والختام فاعل اجتماعي قادم من مجتمع معين والمتلقي المفترض لهذا المنتوج الأدبي - الاجتماعي هو فاعل اجتماعي آخر، والنسق العام الذي يحتضن هذه العملية يظل هو المجتمع بفعالياته وأنساقه الفرعية الأخرى، فعلى مستوى حقل الاشتغال، يتأكد واقعياً أن حقل علم الاجتماع الأدبي يتعلق بالأديب والأدب والمتلقي على صعيد المجتمع، فالأدب مشروط من حيث إنتاجه وتداوله بوجود المجتمع، وإلا ما أمكن عده أدباً. أما على مستوى آليات الاشتغال ومولداته، فإن الاجتماعي يؤدي دوراً بالغاً في إنتاج الأدب، وبلورة الرؤى والمسارات المؤطرة له، فإذا كان أنصار التحليل النفسي يذهبون إلى الربط الصارم بين العملية الإبداعية الأدبية وبين العناصر السيكولوجية([13])، فإن الدرس السوسيولوجي يلح على التداخل والتشابك بين عدد من العناصر النفسية والاجتماعية والسياسية والثقافية في صناعة الأدب، وهي عناصر يمكن إجمالها في سؤال (المجتمع)، فعملية الإنتاج الأدبي والإيديولوجي لا تنفصل بالمرة عن العملية الاجتماعية العامة.
خلاصة القول، لا يمكن أن ينفصل الأدب عن سياقه المجتمعي، فكل نص أدبي ليس سوى تجربة اجتماعية، عبر واقع ومتخيل... فعلى الرغم من كل المسافات الموضوعية التي يشترطها بعض الأدباء لممارسة الأدب، فإن المجتمع يلقي بظلاله على سيرورة العملية الإبداعية، بل يوجه مساراتها الممكنة في كثير من الأحيان، فلا أدب من دون مجتمع، ولا مجتمع من دون أدب، فلكل مجتمع أدبه، ولكل أدب مجتمعه الذي ينكشف من خلال نصوصه ورواياته الشفاهية([14]).
ثانياً- تعريف علم الاجتماع الأدبي (مناهجه وموضوعه وأهميته): يشير إسكاربيه إلى أن تسمية علم اجتماع الأدب ظهرت لأول مرة في أربعينيات القرن العشرين على يد الفرنسي "غي ميشو" في كتابه (مدخل علم الأدب) الذي نشر في إسطنبول عام 1950. وهو لا يقصد عندما أشار إلى ظهور فكرة (سوسيولوجيا أدبية) آنذاك أن نشأة علم اجتماع الأدب كانت مكتملة، وإنما بداية الشيوع لهذا المفهوم المعاصر، الذي لم يكن موجوداً من قبل في الأدبيات السوسيولوجية، بالرغم من التناول السابق للأدب من منظور سوسيولوجي، فهناك قبل هذا التاريخ وبعده محاولات سوسيولوجية متفاوتة المستوى من حيث مقاربتها للظاهرة الأدبية من خلال الربط بين بعض المتغيرات الاجتماعية والأشكال الأدبية التي تعكس الواقع الاجتماعي بصورة ما أو تحيل إليه بتعبير أدق. وإن كان الدارس لعلم الاجتماع يلحظ إحجاماً من رواد علم الاجتماع عن تناول الظاهرة الأدبية بالبحث السوسيولوجي. وتأكيداً لنقطة التحول هذه، يشير "آرون وفيالا" إلى عام 1957 بوصفه منعطفاً في مسيرة علم الاجتماع في دراسة المسألة الثقافية والأدب على نحو خاص، حينما أصدر "روبير إسكاربيت" كتابه (سوسيولوجيا الأدب) عام 1958([15]).
وفي حقيقة الأمر دراسة علم الاجتماع للأدب ليست ترفاً، وليست مضيعة للوقت، فالأدب ظاهرة إنسانية ارتبط وجودها بوجود الإنسان وانبثاق الثقافة وتطورها. فالأدب يعبر ويعكس علاقة الجماعة بالكون وخالقه، وعلاقات الإنسان بالآخرين وبنفسه، كما يكشف عن قدرة الإنسان على استخدام اللغة للتعبير عن خبراته وآلامه وآماله، وقدرته على تصوير الواقع الذي يحيط به.
ومثلما يهتم علم الاجتماع بفهم مكانة الإنسان في المجتمع وعلاقة الإنسان بالآخرين، كما يدرس سلوك الناس في المجتمع، ويكشف عن التزامهم بالمعايير الاجتماعية أو انحرافهم عن هذه المعايير، يحاول علم اجتماع الأدب أن يكشف عن مدى الالتحام والاتصال بين علم الاجتماع والأدب، ويجيب عن السؤال الآتي: أين تكمن العلاقة بين الأدب وعلم الاجتماع؟ ويرى سوينجوود أننا إذا نظرنا إلى مستوى المضمون، فسوف نرى أن علم الاجتماع والأدب يشتركان في عامل واحد هو النظرة العامة الشاملة. فعلم الاجتماع أو علم المجتمع هو الدراسة العلمية الموضوعية للإنسان في المجتمع، وهو يحاول أن يدرس النظم والعلاقات والعمليات الاجتماعية، كما يحاول الإجابة عن السؤال الذي طرحه الفيلسوف الإنجليزي هوبز: كيف يكون المجتمع ممكناً؟ وكيف يعمل مثل هذا المجتمع وكيف يستمر؟
هذه الرؤية لموضوع علم الاجتماع ترتبط بمفهوم الاستقرار والاستمرار والبقاء، وتسعى إلى فهم الأساليب التي يتم بها قبول الأشخاص للنظم الاجتماعية باعتبارها نظماً ضرورية وعامة. أما الأدب، فيهتم بالعالم الاجتماعي للإنسان، ومدى تكيف الإنسان مع هذا العالم، ورغبة الإنسان وتطلعاته للتغيير إلى الأحسن. ويؤكد سوينجوود أن علم الاجتماع والأدب يكمل كل منهما الآخر، ويساعدان الإنسان على فهم المجتمع والحياة الاجتماعية، إلا أنهما ظلا – تاريخياً – بعيدين عن بعضهما البعض، مثل تباعد علم الاجتماع عن علم النفس. وقد فرض موضوع التخصص والرؤية النرجسية لهذا الموضوع بقاء أسوار عالية تحيط بكل تخصص، وهي أسوار مفتعلة تحجب الرؤية عما يدور في الخارج([16]).
يُعرف علم الاجتماع الأدبي بوصفه فرعا من فروع علم الاجتماع العام يهتم بدراسة الأدب كظاهرة اجتماعية (في محتواها الاجتماعي) من خلال دراسة أثر المجتمع على الأدب وأثر الأدب على المجتمع. بمعنى آخر، هو يحاول فهم العلاقة بين النص الأدبي والمجتمع (السياق) الذي أنتج هذا النص. أو تخصص يدرس العلاقة الجدلية بين الأدب والمجتمع، ليس كمجرد انعكاس للواقع الاجتماعي، بل كنتاج معقد يتفاعل مع السياقات التاريخية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية. هذا الحقل المعرفي يبحث في كيفية تشكل النصوص الأدبية بواسطة المجتمع، وكيف تساهم بدورها في تشكيل الوعي الاجتماعي. إن الهدف الرئيس من هذا التخصص تحليل الأدب بوصفه ظاهرة اجتماعية، وفهم كيفية تأثير البنى الاجتماعية (كالطبقة، الجنس، العرق، الدين، السلطة) على إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها.
بناءً على ما سبق، يمكن لنا وصف علم الاجتماع الأدبي بأنه: فرع من علم الاجتماع يدرس الأدب لا بوصفه بناء فنياً متكوناً من بنى وعلائق لغوية وأشكال جمالية بهدف نقده أدبياً، وإنما بوصفه موضوعات اجتماعية غير منفصلة عن موقع منتجها وما يحيط به، بقصد التعرف على المجتمع أو بعض أجزائه، أو إبراز الجانب الاجتماعي للمنتج الأدبي، كما يدرس ما يحيط بأطراف الأثر الأدبي من مظاهر اجتماعية. وعندما نقول إنه فرع من علم الاجتماع فالمقصود أنه يطبق ويستفيد من بعض نظريات ومناهج علم الاجتماع ويسترشد بها في تحليله للأدب. كما أن موضوعه يتمحور باختصار حول الجوانب الاجتماعية والأوضاع المتعددة لثلاثة عناصر أو محاور رئيسة مكونة له، وهي: الكتاب (النص) والكتاب والجمهور أو المتلقون، ليس من منظور فني ولكن من منظور سوسيولوجي ينظر للجوانب الخارجية من تلك العناصر ومدى ارتباطها بالواقع الاجتماعي([17]).
تنحصر منهجيات البحث في علم الاجتماع الأدبي في تحليل المضمون من خلال دراسة الموضوعات المتكررة في النصوص وربطها بالسياق الاجتماعي. وتحليل الخطاب من خلال السعي إلى فحص اللغة والأساليب الأدبية كتعبير عن علاقات القوة. ودراسة الحالة عبر تحليل أعمال كتّاب معينين (مثل تأثير الحرب الأهلية اللبنانية على أدب إلياس خوري). والمقارنة بين الثقافات مثل مقارنة تمثيل المرأة في الرواية العربية والرواية الغربية. والإثنوغرافيا الأدبية من خلال البحث عن خصوصيات المجتمع الثقافية ومميزات حياته ونمط معيشته القائمة على عادات وتقاليد تعود إلى زمن بعيد يقودنا إلى اكتشاف عالم غريب عجيب من القيم والمنظومات المتنوعة التي تحتاج إلى الوقوف عندها بالدرس؛ وذلك من أجل الإفادة منها معرفةً واكتشافاً، ولعل النص الرحلي استطاع أن يخوض هذه التجربة بكل نجاح حين كان الرحالة باحثاً عن كل شيء، ومتلقّفاً لكل شيء في مختلف المجتمعات التي مرّت بها رحلاته، وما تعلق بوصف طبائع البلدان وخصال أهلها وأسلوب حياتها، ولو أن حديثه عن ذلك لم يكن مؤسساً على علم ثابت بأصوله وقواعده، لكنه في ذات الوقت أسس المنهج بحثي يعتمد على تقديم أساليب الحياة ونمط المعيشة التي تحكمها مجموعة من العادات والتقاليد، هذا المنهج هو ذاته ما عرف حديثاً بالإثنوغرافيا كعلم تطور، وأخذ خصوصياته من علم الانثروبولوجيا ولعل الوقوف عند المنهج الإثنوغرافي راجع في الأساس إلى أن كثيراً من رحلات العرب تزخر بشكل كبير بالمحتوى الإثنوغرافي الذي يمثل متطلباً رئيساً للدراسة والبحث في هذا المجال([18]).
بذلك نجد أن الإثنوغرافيا لا تخرج عن كونها وصفاً للأديب الرحالة الذي يلعب دور الإثنوغرافي حين يقوم بتفقد البلدان والأماكن، ويصف مختلف المشاهد والعادات التي استرعت انتباهه ما يميزه عن الإثنوغرافيا كعلم أنه يرتكز على بنية اللغة والأساليب الفنية التعبيرية في تقديم عرضه الرحلي، ويفتقر في ذات الوقت لبعض الخصائص العلمية التي تتوافر لدى باحث الإثنوغرافيا، ولو أن الجامع المشترك بينهما هو مختلف الخطوات التي يقومان بها، والتي تبدأ من الملاحظة القائمة على التعرف على صفات وخصائص ما يتم دراسته أو التقديم له، ثم العملية القائمة على فهم الظواهر المتكررة لتحديد أوجه الاختلاف والاتفاق في الصفات، ثم الوصف الدقيق الموضوعي لما يراه وتدقيق مختلف البيانات التي ستكون مطابقة للواقع الذي سيشمله الوصف، وصولاً إلى آخر مرحلة، وهي جمع المعلومات وربطها بعضها بعض وتحقيق الانسجام والتألف بينها خاصةً أمام كم كبير من المعرفة التي حصل عليها الباحث الرحالة أو الإثنوغرافي في رحلة اكتشافه([19]). وفي النهاية المنهج الوضعي الذي يعدّ العمل الأدبي وثيقة ومصدراً للمعرفة الاجتماعية والتاريخية. لذا، فهو يولي أهمية لجوانبه المضمونية والغاية التي يريد الكاتب التعبير عنها دون اعتبار لخصوصياته الجمالية، فهو يهتم بالأديب والظروف الخاصة والعامة التي عاش فيها وكل هذا يشكل هويته الاجتماعية؛ فالناقد هنا يسعى للوصول إلى الحياة الاجتماعية للأديب لربطها بالحياة الشخصية وبالمجتمع([20]). أما عن موضوعه، فيدرس علم اجتماع الأدبي كيف يؤثر المجتمع على الكاتب، وما هي القيم والمعتقدات السائدة التي تنعكس في أعماله. كما أنه يحلل كيف يعكس النص الأدبي الواقع الاجتماعي، وما هي القضايا الاجتماعية التي يتناولها بالدراسة والتحليل والنقد. ويبحث في كيفية تأثير الأدب على أفكار وسلوكيات الأفراد والمجتمع ككل. وأخيراً يسعى إلى توضيح ودراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تلعب دوراً أساسياً في تشكل النتاج الأدبي([21]).
تنبثق أهمية علم الاجتماع الأدبي من خلال مساعدة الباحث في هذا المجال على قراءة النص الأدبي بشكل أعمق، وفهم الدلالات الخفية فيه؛ أي من خلال قراءة ما بين السطور. بالإضافة إلى فهم المجتمع (السياق الاجتماعي وتفاعلاته) الذي أنتج هذا النص، وتطوره عبر الزمن. وأخيراً يظهر لنا كيف أن الأدب ليس مجرد عمل فني، بل يعكس مشاعرنا وهمومنا وتطلعاتنا كبشر في سياقات الحياة اليومية. ومن أهم الأسئلة يطرحها التي يطرحها علم الاجتماع الأدبي على سبيل المثال، كيف أثرت الثورة الفرنسية على الأدب الرومانسي؟ ما هي القضايا الاجتماعية التي تناولتها روايات الأديب نجيب محفوظ؟ كيف يعكس شعر محمود درويش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ باختصار شديد، علم الاجتماع الأدبي هو أداة قوية لفهم العلاقة المتبادلة بين الأدب والمجتمع، وهو يفتح لنا آفاقاً جديدة لقراءة وتحليل النصوص الأدبية.
ثالثاً- تأثير المجتمع في الأدب (مرآة تعكس الواقع): إن علاقة الأدب بالمجتمع علاقة تكاملية متبادلة. فكما يؤثر المجتمع في الأدب، يؤثر الأدب بدوره في المجتمع. ويمكن تشبيه هذه العلاقة بمرآة تعكس الواقع، حيث ينعكس المجتمع في الأدب، والأدب يعكس المجتمع.
يعكس الأدب الواقع الاجتماعي بكل تفاصيله، سواءً عبر الرواية، الشعر، المسرحية أو القصة القصيرة، فمثلاً روايات نجيب محفوظ تصور التحولات الطبقية والسياسية في مصر خلال القرن العشرين. كما يبرز الأدب القضايا الإنسانية مثل الفقر، الظلم، الحب، والصراع بين التقاليد والحداثة، كما في أعمال "غسان كنفاني" التي تتناول حقوق ومظلومية الشعب الفلسطيني.
تلعب الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية دوراً حاسماً في تشكيل مضمون الأدب واتجاهاته مثل: الأزمات، الحروب، الثورات، التغيرات الاجتماعية، بوصفها أحداثا تترك بصماتها على الأعمال الأدبية التي تكتب في تلك الفترات. كما تؤثر القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع على اختيار الأديب لموضوعاته، وأسلوبه في التعبير، وشخصياته. بالإضافة إلى ذلك يتأثر الأديب بتجاربه الشخصية في المجتمع، بما يراه ويسمعه ويعيشه، وهذا الانعكاس يظهر جلياً في أعماله الأدبية. "فالكاتب مهما بعد خياله وشط، لا بد من أن ينطلق في عمله من واقع إنساني ما، يستمد مواده منه، ويشكلها بطريقته الخاصة به التي تحمل معها دلالة ما إلى القارئ وهو في عملية الإنتاج الأدبي، لا بد من أن يصدر عن تجاربه المباشرة التي تيسر له، بتراكمها عبر السنين، مادة تصلح لبناء عالم مقنع يحمل مصداقية لقارئه أو متلقيه، تحفزه على تغيير عالمه هو نحو الأفضل"([22]).
وأخيراً تؤثر التيارات الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع، مثل: الرومانسية، الواقعية، الرمزية، على طبيعة الأدب المنتج. ومن الأمثلة على تأثير المجتمع في الأدب نجد أن الأدب الرومانسي الذي نشأ في ظل الثورة الصناعية في المجتمعات الغربية الصناعية، كنوع من الهروب من الواقع الإنساني الصعب والبائس الذي خلفته الآثار السلبية للثورة الصناعية من أجل البحث عن الجمال والحب والإنسانية. كما أننا نجد الأدب الواقعي الذي ظهر كرد فعل على الرومانسية، وركز على تصوير الواقع الاجتماعي بكل تفاصيله، مثل: روايات "تشارلز ديكنز" 1812-1870 التي صورت حياة الفقراء في إنجلترا، وحمل على المسؤولين عن المياتم، والمدارس، والسجون حملةً شعواء، من أهم رواياته أوليفر تويست (Oliver Twist) (1839)، وقصة مدينتين (A Tale of Two Cities) (1859)، وأوقات عصيبة، ونقلهما إل العربية منير البعلبكي، ودايفيد كوبرفيلد (1850). وأخيراً الأدب الملتزم الذي يركز على قضايا المجتمع الملحة والمصيرية، مثل: (الظلم الاجتماعي، الحروب، الفقر، غياب العدالة الاجتماعية)، ويحاول إحداث تغيير اجتماعي من خلال الثورة عليه، لذا يعرف الأدب الملتزم بأنه نهج للمؤلف أو الشاعر أو الروائي أو الكاتب المسرحي أو الملحن الذي يلتزم بعمله للدفاع عن وجهة نظر أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية أو إيديولوجية أو دينية أو تأكيدها، غالباً من طريق أعمالهم.
ومن أهم أدبائه في العالم العربي الأديب غسان كنفاني (1936-1972)، حيث إن الالتزام عنده مشتق من طبيعة حياته والتصاقه بالدفاع عن القضية الفلسطينية والهم الوطني التصاقاً مبنياً على صدق التجربة وعلى الوعي بتوجيهه وإغنائه بالإبداع والممارسة، بمعنى آخر، لم يكن الأدب ولم تكن الفنون الإبداعية بوقاً للسياسة أو للشعارات أو التوجهات الحزبية، ومن يمارس الأدب يعرف صعوبة شروطه ويعرف اختلاف التعبير الأدبي عن أي تعبير آخر مهما يكن محترماً أو نبيلاً، ومن أهم مؤلفاته رواية رجال في الشمس عام 1963، التي تصف تأثيرات نكبة عام 1948 لتمثل الصراخ الشرعي المفقود، إنها الصوت الفلسطيني الذي ضاع طويلاً في خيام التشرد، إنها الإطار الرمزي لعلاقات متعددة تتمحور حول الموت الفلسطيني وانتهاك حقوقه من خلال التشرد والموت والحيرة.
خلاصة القول، إن المجتمع هو الوعاء الذي يتشكل فيه الأدب، وهو المادة الخام التي يتغذى عليها الإبداع الأدبي. فالأدب هو لسان حال المجتمع، يعبر عن آماله وأحلامه، ومخاوفه وآلامه. ووظيفة الأدب محصلة لوعي الأديب في سياقه الاجتماعي وإيمانه بدور الكلمة في التغيير وإعادة بناء الواقع المجتمعي. كما يؤكد الأدباء والشعراء والنقاد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الأدب والفن في ترسيخ قيم الحرية والعدالة والإنسانية في المجتمع ضد الظلم والتسلط والاستبداد السياسي، بوصفه المصباح الذي ينير درب الشعوب في مواجهة الطغيان والظلم والقهر والاستبعاد الاجتماعي.
وفي النهاية، نعتقد أن الأدب والمجتمع يتغذيان من بعضهما، فكل عمل أدبي هو ابن بيئته، لكنه أيضاً قادر على تجاوز حدود الزمان والمكان ليصيح صوتاً إنسانياً عالمياً هذه الديناميكية تجعل العلاقة بينهما حية ومستمرة. وعلم الاجتماع الأدبي لا يقتصر على تحليل النص، بل يربطه بشبكة معقدة من العلاقات: المؤلف، القارئ، المؤسسات، والسلطة. بهذا المعنى، يصبح الأدب فضاءً للصراع والتغيير، حيث تُعاد كتابة المجتمع عبر الكلمات، وتُعاد كتابة الكلمات عبر المجتمع.
- المراجع المعتمدة:
1- أنور عبد الحميد الموسى: علم الاجتماع الأدبي (منهج سوسيولوجي في القراءة والنقد)، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 2011
2- عبد الله العرفج: علم اجتماع الأدب، كتاب المجلة العربية (283)، الرياض (السعودية)، ط1، 1441هـ.
3- مدحت الجيار: النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط2، 2005.
4- بول آرون وألان فيالا: سوسيولوجيا الأدب، ترجمة: محمد علي مقلد، مراجعة: حسن الطالب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط1، 2013
5- محمد سعيد فرح: علم اجتماع الأدب، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط1، 2012
6- أحمد الحاج أنيسة: علم اجتماع الأدب فروعه ومناهجه، مجلة فصل الخطاب، المجلد: 04، العدد: 16، الجزائر، ديسمبر 2016
7- محمد مندور: في الأدب والنقد، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط2، 2022
8- صالح مفقودة: إشكاليـة الأدب والتكنولوجيـا، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد: 03، العدد: 05، الجزائر، 2003
9- هارييت بيتشر ستو: كوخ العم توم، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط2، 2020
10- حسام الدين فياض: الأدب عرّاب فهم أغوار النفس البشرية (قراءة في علاقة علم النفس بالأدب)، مجلة فكر الثقافية، العدد: 43، الرياض، 2025
11- مارتن لينداور: الدراسة النفسية للأدب، ترجمة: شاكر عبد الحميد، آفاق الترجمة (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، القاهرة، 1996
12- أحمد صانع: الرحلة بين الأدبية الإثنوغرافية، مقاربة في نصوص رحلية، مجلة دراسات معاصرة، المجلد: 05، العدد: 02، الجزائر، 2021
13- حسين غريب، فطوم حوه: الوعي الجمعي لدى "دوركايم" واللاوعي الجمعي لدى "كارل يونغ"... علاقة تكامل أم تضاد؟، مجلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية، المجلد: 02، العدد: 06، الجزائر، 2017.
14- علاوي الخامسة: سوسيولوجيا الأدب بين النظرية والتطبيق، مجلة كلية الآداب واللغات، المجلد: 01، العدد: 02، الجزائر، ديسمبر 2015
15- بخوته محمد نوح الشيخ الصوفي: المرأة في أدب الشنقيطي حضور وإسهامات، مجلة متون، جامعة سعيدة د. مولاي الطاهر، المجلد: 14، العدد: 04، الجزائر، ديسمبر 2021
16- كاهنة عباس: "الأدب النسائي"... ماذا تعني هذه التسمية؟، موقع الشبكة المتوسطية للإعلام النسوي (مساهمة مع ميد فيمينسويّة)، 04 ديسمبر 2022. https://zt.ms/p4D
17- ساير الشمري: الرواية الواقعية وأهميتها في الأدب، صحيفة الجزيرة، الرياض، الجمعة / السبت 20 سبتمبر 2024. https://www.al-jazirah.com/2024/20240920/cm12.htm
([1]) بول آرون وألان فيالا: سوسيولوجيا الأدب، ترجمة: محمد علي مقلد، مراجعة: حسن الطالب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط1، 2013، ص(9).
([2]) علاوي الخامسة: سوسيولوجيا الأدب بين النظرية والتطبيق، مجلة كلية الآداب واللغات، المجلد: 01، العدد: 02، الجزائر، ديسمبر 2015، ص(155).
([3]) مجموعة من المعتقدات والعواطف المشتركة لدى متوسط أعضاء المجتمع الواحد والتي تشكل نظاماً اجتماعياً محدداً له حياته الخاصة به، وهو أيضاً اسم ظاهرة تتعلق بآليات اتخاذ القرارات وتبنيها لأيّ عدد من الأفراد المجتمعين. ويعتمد الوعي الجمعي في وجوده على والعواطف والمعتقدات الموجودة في الوعي الفردي. انظر حسين غريب، فطوم حوه: الوعي الجمعي لدى "دوركايم" واللاوعي الجمعي لدى "كارل يونغ" .. علاقة تكامل أم تضاد؟، مجلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية، المجلد: 02، العدد: 06، الجزائر، 2017، ص(257-258-259).
([4]) ألف ليلة وليلة هو كتاب يتضمّن مجموعة من القصص التي وردت في غرب وجنوب آسيا، بالإضافة إلى الحكايات الشعبية التي جُمِعت وتُرجمت إلى العربية خلال العصر الذهبي للإسلام ترجمها إلى اللغة العربية عبد الله بن المقفع في القرن الثامن، وهو كاتب شهير من العصر العباسي فارسي الأصل، يعد ابن المقفع أول من أدخل إلى اللغة العربية الحكمة الفارسية الهندية، والمنطق اليوناني، وعلم الأخلاق، وسياسة الاجتماع، وهو أول من عرّب وألّف، كما يرجع الفضل إلى كتبه في تطور النثر العربي ورفع مستواه الفني إلى أعلى المستويات. كما يُعرف الكتاب أيضاً باسم الليالي العربية في اللغة الإنجليزية، منذ أن صدرت النسخة الإنجليزية الأولى منه سنة 1706، واسمه العربي القديم "أسمار الليالي للعرب مما يتضمن الفكاهة ويورث الطرب" وفقاً لناشره وليم ماكنجتن.
([5]) انظر صالح مفقودة: إشكاليـة الأدب والتكنولوجيـا، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد: 03، العدد: 05، الجزائر، 2003
- انظر هارييت بيتشر ستو: كوخ العم توم، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط2، 2020
([6]) هارييت بيتشر ستو (1811 - 1896) كاتبة أمريكية ومُناهضة للعبودية، وهي شخصية مؤثرة في كتاباتها وكذلك في وقفاتها العلنية في القضايا التي كانت تهم المجتمع آنذاك. كانت روايتها "كوخ العم توم" (1852) صورة لحياة الأفارقة - الأمريكيين تحت ذل العبودية والاضطهاد.
- انظر هارييت بيتشر ستو: كوخ العم توم، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط2، 2020
([7]) الطيب صالح 1929-2009 أديب وكاتب سوداني، بدأ رحلته مع الكتابة في خمسينيات القرن العشرين، وساهم في نشر الأدب والثقافة السودانية في مختلف أنحاء العالم من خلال رواياته ومؤلفاته وكتاباته التي ترجم العديد منها إلى لغات عالمية، ولُقب بـ: "عبقري الرواية العربية". في واقع الأمر مثّلت رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) وقت ظهورها، حدثاً استثنائياً في تاريخ الرواية العربية، وانطلاقاً إلى آفاق جديدة في الثقافة العربية، فبعد أكثر من خمسين عاماً من ظهور الرواية، لا تزال رواية موسم الهجرة إلى الشمال طازجة، كيوم ولادتها. وفي السياق الذي نشهده من موجات اللاجئين والمهاجرين العرب في أوروبا، وموقف الدول الأوروبية من ذلك مع صعود تيار اليمين فيها، فإن الرواية تكتسب معاني جديدة، وتمنح القارئ فرصة لرؤية الأحداث بطريقة مدهشة. انظر الطيب صالح: موسم الهجرة إلى الشمال، دار العودة، بيروت، ط14، 1987
([8]) عبد الله العرفج: علم اجتماع الأدب، كتاب المجلة العربية (283)، الرياض (السعودية)، ط1، 1441ه، ص(39).
([9]) انظر محمد مندور: في الأدب والنقد، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط2، 2022، ص(70 وما بعدها).
([10]) ساير الشمري: الرواية الواقعية وأهميتها في الأدب، صحيفة الجزيرة، الرياض، الجمعة / السبت 20 سبتمبر 2024. https://www.al-jazirah.com/2024/20240920/cm12.htm
([11]) بخوته محمد نوح الشيخ الصوفي: المرأة في أدب الشنقيطي حضور وإسهامات، مجلة متون، جامعة سعيدة د. مولاي الطاهر، المجلد: 14، العدد: 04، الجزائر، ديسمبر 2021، ص(280).
([12]) كاهنة عباس: "الأدب النسائي"... ماذا تعني هذه التسمية؟، موقع الشبكة المتوسطية للإعلام النسوي (مساهمة مع ميد فيمينسويّة)، 04 ديسمبر 2022. https://zt.ms/p4D
([13]) انظر حسام الدين فياض: الأدب عرّاب فهم أغوار النفس البشرية (قراءة في علاقة علم النفس بالأدب)، مجلة فكر الثقافية، العدد: 43، الرياض، 2025، ص(32). ومارتن لينداور: الدراسة النفسية للأدب، ترجمة: شاكر عبد الحميد، آفاق الترجمة (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، القاهرة، 1996.
([14]) أنور عبد الحميد الموسى: علم الاجتماع الأدبي (منهج سوسيولوجي في القراءة والنقد)، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 2011، ص(19).
([15]) عبد الله العرفج: علم اجتماع الأدب، كتاب المجلة العربية (283)، الرياض (السعودية)، ط1، 1441ه، ص(29).
([16]) انظر محمد سعيد فرح: علم اجتماع الأدب، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط1، 2012
([17]) عبد الله العرفج: علم اجتماع الأدب، مرجع سبق ذكره، ص(26).
([18]) أحمد صانع: الرحلة بين الأدبية الإثنوغرافية، مقاربة في نصوص رحلية، مجلة دراسات معاصرة، المجلد: 05، العدد: 02، الجزائر، 2021، ص(164).
([19]) المرجع السابق نفسه، ص(165).
([20]) أحمد الحاج أنيسة: علم اجتماع الأدب فروعه ومناهجه، مجلة فصل الخطاب، المجلد: 04، العدد: 16، الجزائر، ديسمبر 2016، ص(231).
([21]) انظر عبد الله العرفج: علم اجتماع الأدب، مرجع سبق ذكره، ص(11 وما بعدها).
([22]) أنور عبد الحميد الموسى: علم الاجتماع الأدبي (منهج سوسيولوجي في القراءة والنقد)، مرجع سبق ذكره، ص(73).