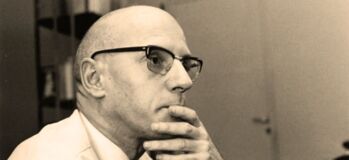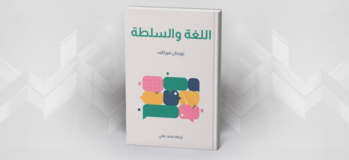الأنساق الرمزية وصناعة المشروعية السياسية
فئة : أبحاث محكمة

الأنساق الرمزية وصناعة المشروعية السياسية
الملخـص:
حظي البحث في الآليات الرمزية لتسويغ الهيمنة السياسية باهتمام المفكرين الغربيين، ذوي التوجه الماركسي على وجه الخصوص، وقد حذا المفكرون العرب حذوهم، فقاموا بدورهم بحفريات معرفية في الطبقات العميقة للبناء الذهني السياسي للمجتمع العربي، بهدف استنباط ميكانيزمات اشتغال عقله السياسي، ومنهم من ذهب بعيدا في اتجاه التحليل النفسي للشخصية العربية في عمقها السياسي، منقبين عن ماهية اللاشعور السياسي والمخيال الاجتماعي الذي تتشكل فيه السلوكيات والمواقف والمعتقدات السياسية اللاواعية، والتي تعكس حقيقة توغل البناء الإيديولوجي السياسي في الشخصية العربية عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومختلف أجهزتها الإيديولوجية.
لقد أسفرت جل هذه الأبحاث عن النتيجة التالية: وجود واستمرار النسق السياسي في البلاد العربية الإسلامية، رهين بدوام تنشيط الرساميل الرمزية، وإعادة شحنها بشكل مستمر بالموروث الديني والتاريخي والثقافي والأسطوري، من منطلق كون السلوكيات والمواقف والقيم والمعارف السياسية في المجتمعات المتخلفة عموما هي سليلة بناء سيكولوجي لا واع موشوم بالرموز التراثية الدينية والتاريخية والثقافية والاجتماعية. إنها تنبعث من مخيال اجتماعي ولاشعور سياسيين، في إطار عملية إعادة إنتاج الهيمنة السياسية، بآليات إيديولوجية ماضوية، والترويج لرأسمال رمزي تراثي. وإذا اقتضى الأمر، يتم صقل هذه الأدوات العتيقة بأصباغ حديثة، وتغليفها في قوالب سياسية جديدة، لضمان ديمومة نسق سياسي عتيق في لبوس معاصر، وهذه مسألة لا يمكنها أن تدفع بالبلاد العربية الإسلامية، والمغرب أنموذجا، إلى إنتاج مجال سياسي ديمقراطي يحكمه العقل والمصلحة العامة والكرامة وقيم الحداثة والمواطنة وحقوق الإنسان.
مقدمـة
لا يمكن الحديث عن نسق / نظام سياسي مستقل ومحدد الهوية وكامل الوجود، إلا إذا كان قادرا على التحكم في مكونات مجاله السياسي، المادية منها والرمزية، وتتمثل الأولى في امتلاك السلطة السياسية لعناصر القوة المادية من مؤسسات الجيش، والشرطة، والسجون ... إلخ، وتمثل هذه العناصر المادية العنف الفيزيائي المنظم والموجه ضد الجسد من خلال مؤسسات تمثل الإكراه البدني. إنها الحقيقة المادية للسلطة ووجهها المكشوف.
تتمثل المكونات الرمزية في كل ما يضمن دوام المشروعية السياسية للسلطة الحاكمة؛ أي امتلاك عناصر القوة الرمزية التي تعمل الأجهزة الإيديولوجية للدولة على ترسيخها في المجتمع، باعتماد مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية والسياسية، من مؤسسات تعليمية ودينية وإعلامية واجتماعية وسياسية وثقافية، وهذا الأمر رهين بقدرة النسق السياسي على تكييف سلوك الناس وذهنياتهم ولا شعورهم وفق منظوماته الرمزية. إن المستوى الرمزي للنسق السياسي لا يقل أهمية من المستوى المادي، فانهيار عناصر القوة الرمزية للسلطة بانهيار مصداقية أجهزتها الإيديولوجية إيذان بنهاية النسق السياسي كله، ولن تجدي آنذاك الأنساق القمعية المادية نفعا، لذلك تهتم الأنظمة دوما بدعم روافدها الرمزية وأجهزتها الإيديولوجية.
يستند هذا التصور الذي يميز بين أجهزة الدولة المادية وبين أجهزتها الإيديولوجية، إلى تحليلات مجموعة من الباحثين الماركسيين مثل: أنطونيو غرامشي ولويس ألتوسير وبيير بورديو ... والتمييز بين الأجهزة المادية القمعية والأجهزة الإيديولوجية يتوقف على طبيعة الدولة والنظام، حيث: "تستطيع أجهزة معينة الانتقال من مجال لآخر، والاستيلاء على وظائف غيرها أو تغييرها. المثال الواضح على حالات كهذه هو الجيش، الذي يصبح في أشكال محددة من الدكتاتورية العسكرية جهازا إيديولوجيا ـ تنظيميا مباشرا، ويبرز أساسا كحزب سياسي للبرجوازية"[1].
تنجذب مختلف محاور هذا البحث إلى ثنائيات: السلطة والرمز، السياسة والإيديولوجيا، الشرعية والمشروعية، وهي ثنائيات تفاعلية متقاربة الدلالة، تشتغل جميعها في خضم نسق سياسي معين، وتهدف إلى الكشف عن الوجه الخفي للسلطة، تلك البنية العميقة التي تتوارى خلف مظاهرها المادية، من خلال بيان الدور المركزي للمشروعية السياسية في إنتاج السلطة، ودور الإيديولوجيا في صناعة الهيمنة السياسية، باستنباط آليات اشتغال المخيال الاجتماعي واللاشعور السياسي في بناء الرمزية السياسية، وسنحاول أن نرصد مختلف إنتاجات الفكر الغربي والعربي حول هذا الموضوع، دون أن نترك العموميات النظرية معلقة في سماء الفكر؛ وذلك من خلال تنزيل التنظير الفكري إلى أرض الواقع السياسي، بالاستدلال بالأنساق السياسية العربية الإسلامية عامة، والنسق السياسي المغربي على وجه التخصيص، مركزين على التراث الديني ودوره في وجود وديمومة النسق السياسي المغربي.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1] ـ نيكولاس بولانتزاس، نظرية الدولة، ترجمة ميشيل كيلو، مؤسسة التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، بيروت، 2010، ص: 31