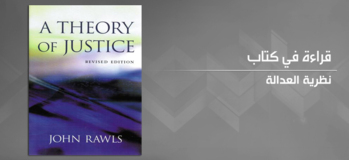الإسلام دين الدولة
فئة : مقالات

تنص دساتير دول عربية وإسلامية على أن "الإسلام دين الدولة"، وهي عبارة غامضة تحتاج إلى توقف، فهل تعني مثلاً "المشروعية الإسلامية العليا"، بمعنى ضرورة انسجام الأحكام والتشريعات والقرارات مع الشريعة الإسلامية أو تبريرها وفق مبدإ عدم التناقض مع الشريعة؟ لا توصف الدول بأنها إسلامية أو مسلمة، فالإسلام وصف أو حكم يقع على الأفراد ضمن شروط محددة، فكيف تشهد الدولة أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله، وكيف تقيم الصلاة وتصوم؟ وكيف تؤمن بالله واليوم الآخر؟ إن متطلبات الإسلام تتحقق باعتقاد وأفعال الأفراد وليس الجماعات أو السلطات، إذن ماذا يمكن أن تضيف أو تحدد عبارة "الإسلام دين الدولة"؟ هل تعني مثلاً أن الاختلاف على انسجام تشريع مع الإسلام هو مخالفة دستورية، ويجب أن يرد الاختلاف في المسألة إلى المحكمة الدستورية، لتقرر أن التشريع أو القرار منسجم أو متناقض مع الدستور؟ أم أن العبارة رمزية تشير إلى انتماء البلد إلى الأمة والحضارة الإسلامية؟
الواقع أن السؤال يتعلق بالجماعات والمؤسسات، وما معنى جماعة إسلامية؟ أو بنك إسلامي؟ أو مستشفى إسلامي؟ فإذا كانت الدولة إسلامية بموجب الدستور فكل مؤسساتها إسلامية حكمًا، وكل مواطنيها إسلاميين حتى غير المسلمين، ويستوي في النسبة إلى الإسلامية جميع المواطنين، لأنهم جميعًا يعملون تحت مظلة الدستور، وهم جميعًا مكلفون بتطبيقه، ولذلك فإنها صفة تتخذها جماعات وأحزاب ومؤسسات ليس على سبيل الاختصاص أو الانفراد أو الاحتكار، أو يفترض أن يكون الأمر كذلك، ولكنها للتأكيد على مبادئ وأفكار وقيم معينة، كما تتسمى أحزاب وجماعات ومؤسسات بالديمقراطية أو الإصلاح أو الحرية.
والواقع أنها تسميات تعبر عن مثل أعلى، وليس عن تيار أو منهج، فليس هناك تيار إسلامي وآخر غير إسلامي، وتيار ديمقراطي وآخر غير ديمقراطي، وتيار دستوري وآخر غير دستوري، ولا يمكن تصنيف الجماعات والتيارات والأحزاب والبرامج على هذا الأساس، ولكن التصنيف مبني على مواقف محددة ومميزة، مثل دور الدولة في الاقتصاد، وحدود تنظيم السوق، ودور القطاع الخاص، ودور المجتمع، والضرائب والرعاية الاجتماعية، والتعليم الأساسي،...وغيرها من القضايا والمواقف التي تتضمن اختلافات ورؤى متعددة، ولا يغير من صفة الإسلامية أو الديمقراطية أو الإصلاحية موقف معين في اليمين أو اليسار أو الوسط من هذه القضايا والتشريعات.
إن التسميات تختلف عن المنهاج والبرامج والتيارات، ويجب أن تقدم الأحزاب والتيارات نفسها بوصف يمكن تحديده، كما نعرف على سبيل المثال أن اليسار يؤيد دورًا اجتماعيًا واقتصاديًا للدولة، وأن الليبرالية تؤيد دورًا متعاظمًا للأسواق والحريات الفردية، ولكن "الإسلامية" يمكن أن تعني ذلك كله، فنحتاج للقول إسلامية ليبرالية أو إسلامية يسارية،. ..إلخ، فما معنى إسلامية إذن؟
هناك تناقض آخر تترتب عليه قضايا وإشكاليات عملية وتطبيقية؛ ففي الأردن على سبيل المثال توجد منظومة "محاكم شرعية" مختصة في تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية؛ الأسرة والميراث والزواج والطلاق،...إلخ، وهي سلطة قضائية تسمى دائرة قاضي القضاة، مختلفة عن السلطة القضائية التي تدير المحاكم القضائية المسماة اصطلاحًا "نظامية" أو "مدنية"، ولكن قانون الأحوال الشخصية صادر عن السلطة التشريعية، وهو أحد قوانين الدولة، فلماذا يسند تطبيقه إلى محاكم خاصة مستقلة مختلفة عن المحاكم القضائية الأخرى. يعني ذلك في واقع الحال أن المسلمين في الأردن هم مجموعة خاصة أو فئة من المواطنين يطبق عليهم قانون خاص بالأحوال الشخصية الخاصة بهم والمختلفة عن قانون مدني عام معتمد للدولة، وفي هذه الحالة، فإنه يسمح للمسلمين بتطبيق بعض القوانين والطقوس والإجراءات المختلفة عن القانون، ولكنها لا تتناقض معه جوهريًا، ولكن لا يوجد في الأردن قانون "مدني" عام يطبق على المسلمين وغير المسلمين، هناك قانون "إسلامي" يطبق على المسلمين، وأما المسيحيون، ولا يعترف رسميًا في الأردن إلا بالإسلام والمسيحية، فيخضعون في أحوالهم الشخصية للمحاكم الكنسية.
لكن وبما أن قانون الأحوال الشخصية "الإسلامي" هو قانون الدولة الصادر عن السلطة التشريعية، فيجب أن يكون ملائمًا لجميع المواطنين من غير قهر أو إكراه، حيث يكونون قادرين على تطبيقه، وإن كان يسمح ببعض الاختلافات لفئات من المواطنين، وهي اختلافات تقتضي التوسع في السماح، وتقليص أو إلغاء الممنوعات، ويقتضي ذلك بالضرورة إلغاء أي تمييز في القوانين والوثائق أو الإشارة إلى دين المواطن في الوثائق الرسمية والشخصية، مما يعني بالضرورة أن دين المواطن لا يؤثر أبدًا في حقوقه وواجباته وفي تطبيق القوانين والحقوق والواجبات، ولا يعني أبدًا أي حرمان أو تمييز إيجابي أو سلبي. ما الحاجة إذن إلى محاكم شرعية خاصة أو مختلفة، فالمحاكم العادية المدنية يفترض أن يناط بها تطبيق قانون الأحوال الشخصية، طالما أنه قانون صادر عن السلطة التشريعية، وأن الإسلام دين الدولة؟
والواقع أن "إسلامية الدولة" المنصوص عليها في الدستور تقتضي "العلمانية" بالضرورة، وأن يكون ثمة قانون مدني عام للأحوال الشخصية يصلح لجميع المواطنين، على أن يسمح في الوقت نفسه باللجوء إلى محاكم ومؤسسات دينية خاصة بأتباعها، شرط ألّا تتناقض مع القانون العام والمواطنة والحريات، وأما الحالة القائمة فهي ليست إسلامية وليست علمانية، وإنما تطبق الجانب الأكثر قسوة منهما؛ الدين والعلمانية، وتتناقض معهما دون وجود سبب منطقي يدعو إلى ذلك.
ليست المسألة سوى صراع على الدين بين السلطة والمعارضة الإسلامية، والضحية في هذا الصراع هو الدين نفسه والعلمانية والحقوق والحريات الشخصية والاجتماعية؛ ففي الصعود الديني اليوم صار الدين موردًا تتصارع عليه السلطات والجماعات والمؤسسات، وبطبيعة الحال تجد المؤسسات والجماعات الدينية لنفسها اليوم حقًا في السلطة والتأثير، وفي احتكار فهم الدين وأحكامه والوصاية على النصوص الدينية. ويبدو أن المسألة اليوم تحتاج إلى جدل ونضال في مرحلة من التحولات السياسية قد تحول الدول والمجتمعات من الدكتاتورية السياسية إلى الدكتاتورية الدينية.
ثمة منظومة واسعة من التطبيقات والأحكام المتعلقة بشؤون الناس الفردية والجماعية، وفي الوقت نفسه، فإن ثمة نصوصًا وأفكاراً دينية متعلقة بها، وقد تشكل حول بعضها تراث راسخ متراكم التبس بأصل الدين، أو بدأ في محاولة لفهم الدين وتفسيره، ثم اتخذ مسارًا آخر مختلفًا عن أصله ومنشئه، وتحول إلى دين "ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله".
وربما يكون ثمة مجال في الجدل الدائر اليوم حول الأفكار والمحاذير والتنبؤات المتصلة بصعود زيادة دور الدين في الحياة والسياسة، لتوضيح ما هو إنساني وما هو ديني، ثم نحدد من الديني ما هو فردي لا علاقة ولا شأن للسلطة أو المجتمع به، وما هو متعلق بالسلطة والمجتمع، وسيكون الجدل بالطبع حول الأحكام والأفكار المتعلقة بالسلطة والمجتمع، إذا استطعنا أن نتفق على الحرية المطلقة في العبادة والاعتقاد والسلوك والفكر.
والسؤال الأساسي في الجدل حول الدور الديني للدولة، هو هل للدولة دور متعلق باعتقادات الناس وشأنهم الديني أو سلوكهم الفردي والشخصي، سواء كان مخالفًا للدين أو متفقًا معه؟
سيردّ على هذه المقولة بالسلامة والمصالح العامة التي يمكن أن تضر بها الحريات الفردية، وهو ردّ صحيح، ولذلك سيكون ثمة جدل وخلاف على حدود الاستثناء في الحريات الفردية، ولكن هذا الانتقال بالجدل مع الاتفاق على الحريات الفردية إلى الجدل حول الاستثناءات، يعد خطوة متقدمة.
والسؤال الثاني هو كيف نوائم بين الاجتهاد والارتقاء الإنساني في الحكم والسياسة وبين الخطاب الديني الموجه للسلطة والمجتمع، والكثير من هذا الخطاب قابل للمواءمة والانسجام، مثل الحريات والحقوق العامة والعدل، وبعضه يحتاج إلى جدل وتوضيح، مثل الفنون والموسيقى والاختلاط والعلاقة بين الرجل والمرأة، ودور المرأة وسلطتها، وضرب الزوجات، والتبني، وتعدد الزوجات، والميراث والحدود والعقوبات.
لقد تحول الدين بفعل نشاط المتدينين ورجال الدين، أو حدث ذلك بفعل تطورات وتفاعلات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، إلى شأن يفوق قدرة رجال الدين وعلمائه على الاستيعاب والإحاطة وادعاء الانفراد بفهمه ومعرفته، وصار شأنًا متصلاً بحياة الناس ومواقفهم وصراعاتهم، وجزءًا من معظم المعارف والتخصصات العلمية، وأصبح رجال الدين وعلماؤه شركاء مع غيرهم، وربما أقل من الكثير من الشركاء الآخرين من العلماء الدنيويين والساسة والنشطاء الاجـتماعـيين، والمستثمرين والاقتصاديين أيضًا.