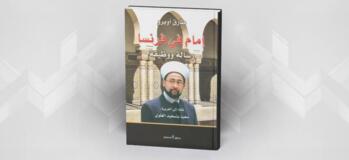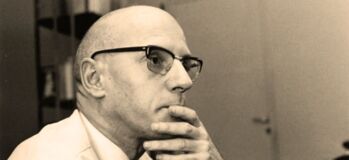الإسلام والتحوُّلات الاجتماعية.. تحوُّلات العالم والسؤال المعرفي
فئة : أبحاث محكمة

الإسلام والتحوُّلات الاجتماعية.. تحوُّلات العالم والسؤال المعرفي
يرافق التحوُّلات الكبرى التي تجري في العالم، وعلى مختلف الأصعدة والمستويات، الكثير من التساؤلات والاستفسارات. وقد أغرت هذه التحوُّلات الجميع بممارسة السؤال والتساؤل، ومواجهة اليقينيات المختلفة بالمزيد من أسئلة الشك والنقد والتقويم.
فالعالم اليوم يمتلئ باليقينيات على مختلف الصعد، كما يمتلئ بأسئلة الشك على مختلف المستويات. لذلك لا يمكن أن تموت الأسئلة في عالم يموج بالمتناقضات والتعقيد، فكل شيء في هذا العالم المعاصر، يؤسس على الدوام للأسئلة، ويستدعي الإثارة والبحث، فلا مناص من السؤال والتساؤل، مهما بدا العالم متقدِّماً ومتطوراً.
فالتساؤل هو تقوى الفكر على حدِّ تعبير (هايدغر)، وهو سبيل الكشف عمَّا تحجبه القوة أو المادة من حقائق ووقائع. والخطاب الغربي المعاصر الذي يُؤسِّس للتواريخ بعد موتها لا يُلغي التساؤلات، ولا ينفي الدهشة، بل يُؤكِّدها ويُحفِّز على تأسيسها في كل المواقع والحالات؛ لأنه لا يمكن أن تُمرَّر عناصر هذا الخطاب من دون نقد ومساءلة وتمحيص. ولا ريب في أن كل تساؤل ينطوي على نقد، كما أن كل نقد يُثير العديد من الأسئلة والتأويلات المتعدِّدة. لهذا، فإن إثارة الأسئلة على مسارات الواقع المختلفة من ضرورات الحياة والوجود؛ لأنه لا حقيقة ناصعة إذا لم تسبقها أسئلة الشك والنقد ورفع الحجب والأوهام. ففي رحاب السؤال والمساءلة تتولَّد عناصر الحقيقة، واستمرار النقد يعني فيما يعني نمو الحقائق والأفكار والقناعات داخل المحيط الاجتماعي.
من هنا قيل: إن العلم عبارة عن خطأ مصحح؛ فلا بد من توسُّل السؤال والنقد حتى ننجو من الزُّور والرياء والمخاتلة. وخطاب المطلق الذي يخفي الكثير، ولا يظهر إلَّا القليل والنادر، وكلّ منظومة فكرية لا تقبل السؤال وتقمع النقد والمساءلة، فإن مآلها السكون والموت.
نحن هنا لا ندعو إلى التشكيك في نوايا السائلين، وإنما نُؤسِّس لمواقع السؤال والنقد في مسار الحقيقة وإثراء الفكر والمعرفة؛ لأن الكائن المتلقي دائماً، بلا أسئلة وشروط ونقد، نساهم معه أو نساعده على انتزاع عقلانيته، ونذوّبه في أوعية متماهية ومتطابقة تقتل كل حس حيوي فيه وإرادته الإنسانية. فالكائن الإنساني لا يمكنه أن يمارس إنسانيته وعقلانيته وشهوده، إذا لم يمارس السؤال والبحث المضني عن الأفكار والحقائق. ولا يوجد على صعيد الأفكار البشرية من يتَّصف بالكمال والشمول؛ لأن الأفكار دائماً بحاجة إلى التطوير والتراكم، والسؤال مدخل من مداخل تطوير نظام المعرفة والتفكير والتأويل.
ونحن لا نعني بهذا أن الناس مفطورون على السؤال والتساؤل، ولكن ما نريد قوله: إن حياة الإنسان الحقيقية مرهونة بقدرته على استعمال عقله، لكي يكتشف الحقائق بنفسه، ويعرف الحدود الفاصلة بين القضايا والأمور، بين الوسائل والغايات، بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
وكلما ارتفعت حقيقة استخدام العقل لدى المجتمعات الإنسانية كانوا هم أقرب إلى النجاح والسعادة. فلا تنمو المجتمعات حضاريّاً إلَّا بالمزيد من استخدام العقل؛ لأنه وسيلة النمو، وهو الذي يمنح المجتمعات ماء الحضارة وعصب التقدُّم.
ولا شك في أن السؤال، ومواجهة بديهيات الحياة الاجتماعية بالنقد والمساءلة، هما جزء من منظومة استخدام العقل. وبهذا المعنى، يكون (السؤال بالمعنى العام الحضاري) هو عصب الحياة والأفكار. فلا حياة بلا تساؤل، كما أنه لا أفكار ناضجة وحيوية بدون نقد وتقويم وتطوير.
ولا يمكننا أن نقارب أيَّ ظاهرة من ظواهر الاجتماع والوجود بلا تساؤل، فهو لازمة لمختلف الظواهر، ومن دونه لا وجود لثقافة تريد أن تشقَّ سبيلها إلى الدينامية والفعالية.
فلا يمكننا أن نمارس فعل الحياة على أكمل وجه من دون السؤال والتساؤل، فهو وسيلة الإنسان لاكتشاف المجهول، وتطوير معارفه، وتهذيب مداركه، وإنضاج علاقته بالطبيعة والكون.
لهذا من الضروري الاهتمام بأسئلة الواقع، والإنصات إلى الأفكار النقدية التي تتَّجه إلى الوقائع والحقائق القائمة، للاستفادة منها، وإزالة ركام عهود طويلة من السكون والهمود الفكري.
وفي هذا الإطار، ينبغي التأكيد على النقاط التالية:
1- لعل من الأخطاء الجسيمة التي قد ترتكبها المجتمعات بحق نفسها ومستقبلها، هي حينما تُوجد حاجزاً نفسيّاً وعقليّاً بينها وبين أسئلة واقعها وتحدِّيات راهنها؛ لأن هذا الحاجز يمنع الكثير من الفوائد التي يجنيها المجتمع لو أنصت بشكل إيجابي وفعَّال إلى أسئلة راهنة.
إن الإنصات إلى أسئلة الراهن، وامتلاك حساسية شديدة لالتقاط المهم والضروري من هذه الأسئلة، ومن ثَمَّ التفاعل المعرفي والمجتمعي معها، تعدُّ من أهم وسائل تطوير المجتمعات وتقدُّمها.
لذلك، من الأهمية بمكان العناية بأسئلة الواقع، وبذل الجهود من أجل اكتشاف ومعرفة جواهر هذه الأسئلة وأهمها، حتى يتسنىَّ لنا كمجتمعات عربية وإسلامية الاستفادة منها، لكي نُواكب الراهن، ونستعد الاستعداد الأمثل لمواجهة التحدِّيات والصعاب.
فما يجري في العالم اليوم من أحداث وتطوُّرات وتحوُّلات مليئة بالدروس والعبر، ولكن المجتمع الذي لا يعتني العناية الفائقة بأسئلة حاضره وراهنه، فإنه حتماً سيمنع عن نفسه الاستفادة من هذه الدروس بما يخدم واقعه ومستقبله. فلا نستطيع مواكبة العصر إلَّا بالتواصل الفعَّال مع أسئلة الواقع، والتفكير الجاد في بلورة إجابات عليها. أما الانزواء من الواقع بهواجسه وتحدياته، والهروب من العصر بآفاقه ومجالاته واحتمالاته، فهو تخلٍّ عن دورنا الطبيعي في الحياة، ونكوص على أعقابنا، وهروب من مصيرنا ومستقبلنا.
إن الأمم التي تهرب من عصرها تفسح المجال واسعاً لخصومها وأعدائها لصياغة راهنها ومستقبلها.
ومن المؤكَّد أن في هذه الصياغة انتقاصاً للاستقلال، وتأكيداً وتعميقاً للتبعية، ونهباً وامتصاصاً لخبراتنا وإمكاناتنا البشرية والطبيعية، لهذا نحن بحاجة إلى التواصل مع الواقع، وقراءة أسئلته بصورة صحيحة وسليمة.
2- لكل حقبة في التاريخ أولوياتها الخاصة وإمكاناتها المحدودة. لهذا ينبغي دائماً أن تتشكَّل لدينا رؤية جديدة ومتكاملة عن مسارات الواقع ودروبه، حتى نتحاشى الأخطاء القاتلة والمميتة.
كما أن لكل حقبة وعصر معايير خاصة للتقويم، نابعة من ظروف ذلك العصر، ومتطلَّبات الأمة وأولويات عملها.
والتخشُّب عند معيار ثابت في تقويم الواقع يخرجنا من دائرة الشهود، ويجعلنا عرضة للأحكام الخاطئة والتصوُّرات المشوَّهة.
وجماع القول: إن التواصل مع الواقع، والإنصات الحيوي إلى أسئلته وتحدِّياته، هو الذي يُوفِّر لنا القدرة على تحديد متطلَّبات كل حقبة وأولوياتها الخاصة والعامة.
الإسلام والتحوُّلات الاجتماعية:
إدراك الأولويات الوطنية في البناء الاجتماعي، ونبذ حالات التقليد الأعمى لتجارب الغير، وغرس روح الإبداع والابتكار، الذي هو الطريق الأمثل لتمثُّل الأفكار الإنسانية الصالحة.
من البداهة القول: إن الواقع الإسلامي اليوم يتشكَّل ويتقوَّم من مكوِّنات وعوامل شتى، إلَّا أنها متشابكة ومتراكبة، وقد بلغت قدراً من التعقيد وبمجملها هي التي يتشكَّل منها واقع الإسلام المعاصر، وأمر التحوُّلات في هذا الواقع كامنة في هذا الواقع ذاته. ومكوِّناته المتعدِّدة؛ إذ إنها ذات طبيعة متحوِّلة ومتطوِّرة ومتغيِّرة باستمرار على حسب تبدُّل الظروف والأحوال. والإسلام باعتباره مكوِّناً أساسيّاً للواقع العربي والإسلامي يُشكِّل بالنسبة لنا المعيار والهدف في آن، حيث إن المجتمعات العربية والإسلامية تجعل من قيم الإسلام الكبرى هي الغاية، وتسعى لإحداث تغييرات وتطوُّرات مرغوبة في الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم.
وبهذا، فإن مصدر التحوُّلات في الكيانات الاجتماعية هو المحيط العام الذي يتطوَّر باستمرار في كل المناحي والجوانب. وإرادة أبناء هذه الكيانات لتطوير واقعهم وإيصاله إلى مستوى أرقى ممَّا هو عليه. وأن غياب هذه الإرادة لا يُوقف التطوُّرات في المحيط العام، وإنما يُعطِّل قدرة الكيانات الاجتماعية المتوقِّفة عن التطوُّر الذاتي، واستيعاب وتوظيف تطوُّرات المحيط العام.
فالكيانات الاجتماعية قادرة على التغيير والتطوُّر حين تريد ذلك، كما أنها تتغيَّر رغماً عنها بفعل تغيُّر أحوال المحيط العام؛ فالتاريخ العربي والإسلامي لا يُحدِّثنا أن مصدر التغيير والتحوُّلات العامة هو فقط المعرفة الذاتية والدوافع العامة التي تخلقها في النسيج الاجتماعي.
وإنما كان دائماً هضم واستيعاب علوم ومعارف المجتمعات الأخرى وما تُحدث هذه العملية من تأثير وتفاعل مصدراً آخر من مصادر التطوير والتغيير. وكان دور أقطاب العلم وأئمة المعرفة ومؤسساتها في التجربة التاريخية هو إحداث عمليات تكييف لهذه العلوم والمعارف بحيث تُشكِّل حالة سويَّة في الجماعة العربية والإسلامية.
من هنا، فإننا نؤُكِّد على الأمور التالية:
1- معرفة الحوامل المعرفية والاجتماعية: إذ لا يمكن أن نتعرَّف على حركة التحوُّلات الاجتماعية إذا لم نُدرك ونستوعب الحوامل المعرفية والاجتماعية الحقيقية للتحوُّلات العامة. وبهذا يتم الابتعاد عن تلك الأفكار الخرافية والقدرية التي لا تُؤدِّي إلَّا إلى تعطيل الإنسان عن أداء دوره الحقيقي في الوجود.
وينبغي أن نُدرك أن معرفة حوامل التحوُّلات الجوهرية تعتبر تجاوزاً نوعيّاً إلى تلك العقدة الكامنة في الكثير من العقول، والتي تحول دون إحداث التحوُّل المطلوب في الواقع القائم.
2- استيعاب الجانب الموضوعي للتحوُّلات: من الطبيعي أن لهذه التحوُّلات بُعداً موضوعيّاً، يتكامل مع البُعد الذاتي المباشر لعملية التحوُّلات الاجتماعية. ولا يمكن أن يتمَّ فقه التحوُّلات الاجتماعية ومعرفة آلياتها واتجاهها إذا لم نُدرك البعد أو الأبعاد الموضوعية لهذه التحوُّلات؛ بمعنى أن حركة الناس اليومية، وفي كل الاتجاهات وتواصلهم مع المجتمعات والحضارات الأخرى، تُشكِّل هذه الأمور بمجموعها ظروفاً موضوعية، تُشجِّع على عملية التحوُّل، وتُهيِّئ النفوس والعقول له، ومن دون إدراك هذه الظروف لا يمكننا بأيِّ شكل من الأشكال التقاط إشارة التحوُّل ومعرفة اتِّجاهه.
لذا، من الخطأ تضخيم العوامل الذاتية للتحوُّلات الاجتماعية والتغافل عن العوامل الموضوعية لهذه العملية.
واستيعاب الأبعاد الموضوعية لعملية التحوُّلات الاجتماعية يعني:
أ- توظيف تطوُّرات العصر وتحوُّلاته السريعة في اتِّجاه تطوير قابلية النهوض الاجتماعي؛ إذ إن المجتمعات العربية والإسلامية تمتلك التطوُّرات المتلاحقة ثقافيّاً واجتماعيّاً لتطوير قابلية النهوض الاجتماعي. ومن الأهمية أن نذكر أن هذه القابلية بتعبيراتها المتعدِّدة هي التي وقفت أمام الكثير من مشاريع التحريف في الأمة.
ب- إدراك المعادلات الاجتماعية القائمة التي تُشكِّل ذاكرة المجتمع ووعاء فعله ومصدر تجاربه، حتى يتم الابتعاد الكلي عن عمليات الإسقاط الأيديولوجية أو السياسية، واستطراداً نقول: إن أحد الأسباب الرئيسة لعملية الإخفاق للكثير من المشاريع الفكرية أو السياسية في العالم العربي والإسلامي هو عدم إدراك تام للمعادلات الاجتماعية القائمة، وبالتالي سعت هذه المشاريع إلى إسقاط معادلات الآخرين على الواقع العربي والإسلامي. فالموضوعية تقتضي إدراك المعادلات الاجتماعية وصياغة الأفكار والاستراتيجيات على ضوء هذا الإدراك.
3- تنظيم العلاقة بين المعرفة والواقع: إذ إن شروط الوعي التاريخي في كل حقبة تاريخية تختلف، ولسنا ملزمين بإسقاط شروط الوعي التاريخي لحقبة تاريخية على كل الحقب والفترات التاريخية.
وفي هذا التنظيم نتجاوز حالة «النقاش خارج الواقع»، والتي تعني -كما عبَّر عنها د. برهان غليون[1]- انغلاق العقل داخل دائرة أطروحات وقضايا تبلورت في وضع حقبة معيَّنة، فأصبحت هي التي تتحكم في رؤية العقل للواقع، وتمنعه من تحديد أدواته وطرائقه بالاحتكاك مع التجربة المتغيِّرة والملاحظة المباشرة، وتجعله لا يعيش الواقع إلَّا على مستوى القضايا والأفكار المصاغة مسبقاً، وخطأ السكولاستيكية «النقاش خارج الواقع» هو أنها تُخضع تحليل الواقع إلى تحليل الأنظمة الشكلية والصورية للفكر، وتنتهي إلى قياس الواقع العملي على الواقع النظري، بينما استيعاب الأبعاد الموضوعية للتحوُّلات يعني قدرة الفكر على الإمساك بالواقع أو التحكم به؛ وذلك عبر معاينة الواقع وفهمها وتحليل عناصرها، وعبر هذه الأمور يتمكَّن الإنسان من الاستفادة القصوى من التحوُّلات الاجتماعية، دون أن تُؤدِّي هذه التحوُّلات والاستفادة من إحداث غربة نفسية أو اجتماعية للإنسان.
فالتحوُّلات الاجتماعية واقعة قائمة، ولا يمكن نكرانها أو التغاضي عنها، وإنما المطلوب دائماً استنطاق ثوابت الإسلام لبلورة الرؤية والموقف الصائب تجاه هذه التحوُّلات، وإننا نخسر كثيراً حينما نجمد ونتقاعس دون أن نستجيب استجابة حضارية وواعية على تطوُّرات العصر.
وإن المطلوب هو أن نفتح أبواب الحضارة على أنفسنا. وفي منظورنا، إن أيَّ حضارة لا تبدأ إلَّا بتكامل عاملين: العقل والروح، الفكر والإرادة، العلم والإيمان؛ لذلك من الأهمية بمكان أن ننفتح على عناصر ومفردات الفكر والإرادة حتى يتسنىَّ لنا استيعاب تطوُّر العصر، والاستجابة الواعية إلى التحوُّلات الاجتماعية العميقة والسريعة في آن.
لذا، فإننا بحاجة أن نبلور المنهج والكيفية العلمية، التي تُوفِّر لنا التقنية اللازمة لاستيعاب تحوُّلات الراهن. ولا بد من الإدراك، أن مجرَّد الاحتفاظ بالمبادئ العامة لا يعني توفُّر المنهج الذي ينقل هذه المبادئ من عالم المثل إلى عالم الواقع، وإنما بحاجة إلى بذل جهود نوعية ومكثَّفة لصناعة ذلك المنهج الذي يأخذ بيد الناس للوصول بهم إلى ما يجب أن يكون ليتمَّ تحقيق ما تقتضيه جملة المبادئ والقيم العامة؛ لهذا وفي إطار ضرورة استيعاب تحوُّلات المجتمع والعصر من الضروري التأكيد على النقاط التالية:
1- ضرورة الانفصال النفسي والاجتماعي عن رواسب وثقافة التخلف والتأخَّر، والاتِّصال الفعَّال بأسباب الحياة الكريمة.
2- إعادة النظر في مناهج التثقيف، وأهداف اكتساب الثقافة والعلم في ضوء هدف مركزي، هو صناعة الإنسان الجديد وفق ثوابت الشريعة وتطوُّرات العصر.
3- إدراك الأولويات الوطنية في البناء الاجتماعي، ونبذ حالات التقليد الأعمى لتجارب الغير، وغرس روح الإبداع والابتكار، الذي هو الطريق الأمثل لتمثُّل الأفكار الإنسانية الصالحة.
بهذه العناصر تستطيع المجتمعات العربية والإسلامية، التي فقدت فاعليتها وتوقَّفت عوامل الدفع الحضاري عن العمل، أن تُعيد لها الفاعلية، وتوقظ عوامل الدفع الحضاري، وتدفعها إلى قلب الفعل الحضاري.
الدينامية الاجتماعية:
ومن هنا، فإن المقصود بالدينامية الاجتماعية -أيضاً- هو توفُّر الحركة الاجتماعية في كل الاتجاهات على معنى سامٍ وأهداف مرسومة، ودون ذلك تبقى الحركة الاجتماعية عشوائية-فوضوية.
تتعدد العوامل والأسباب المفضية إلى ضمور وغياب الدينامية الاجتماعية؛ إذ إن هذه الظاهرة مركَّبة ومعقَّدة، ولا يمكن بأيِّ شكل من الأشكال أن تكون وليدة عامل أو سبب واحد فقط، فهي ظاهرة صنعتها العديد من العوامل والأسباب، وامتزجت مع بعضها، حيث أضحت ظاهرة غياب الدينامية والفعالية الاجتماعية منعكسة في كل أبعاد الحياة الاجتماعية، فغياب الدينامية الاجتماعية له أسبابه المتعدِّدة، فمنها ما يرجع في حقيقته إلى تحلُّل الفكرة الوطنية وانفجارها من الداخل، من جرَّاء التوتُّرات الاجتماعية والثقافية، التي تُعومل معها في الكثير من بلدان العالم الثالث بأدوات عنيفة وقهرية، ممَّا أدَّى إلى إقصاء العديد من القوى الاجتماعية، وتحوَّل المجتمع إلى مراكز قوى مناقضة، كل قوة تسعى نحو تقويض القوة الأخرى، حتى لو كان هذا التقويض يكون على حساب أسس المجتمع وبنيته التحتية.
ومنها ما جاء من جرَّاء تفاقم الهيمنة الغربية المادية والفكرية، وتحكُّمها بمصير الشعوب والمجتمعات مع ما تحمله هذه الهيمنة من مظاهر الاستلاب والمسخ واهتزاز الشخصية الوطنية والعقدية، ومن شعور متعاظم بخطر الانقسام والاقتتال الموصل إلى أزمة الهوية، وغياب البوصلة النظرية الواضحة الموجِّهة إلى المجتمع في حركته الداخلية وعلاقاته الخارجية.
ومنها ما يعكس أزمة اجتماعية-اقتصادية عميقة، وهي عبارة عن التدهور المتواصل في مستويات المعيشة وتفاقم التفاوت الطبقي، ومن نشوء جماعة بشرية قليلة العدد تحتكر كل الإمكانات والثروات، وإلى جانبها جماعات شعبية مهمَّشة في أحياء الصفيح وأحزمة البؤس من دون أمل ومن دون مستقبل. هذا المزيج من العوامل والأسباب أدَّى ويُؤدِّي باستمرار إلى تدهور الحياة الاجتماعية والمدنية، وشيوع حالات من القلق الخطير التي تُؤدِّي إلى العبثية والعدمية والتحلُّل من المسؤولية مهما كان نوعها أو شكلها.
وفي الاتجاه الثاني تفاقم مظاهر النقمة-العنيفة من هذا الوضع، وبالتالي الانخراط في تشكيلات وممارسات تخريبية-عنفية، إما لدواعٍ اقتصادية بحتة، أو لانسداد الآفاق الطبيعية للعمل لدى هؤلاء الأفراد أو التشكيلات، ممَّا دفعهم إلى فقدان المعايير والقيم الروحية والفكرية الناظمة لتصرُّفات الإنسان والمحدِّدة لقيام كيان اجتماعي واحد.
وإن ما تعيشه مجتمعات العالم الثالث اليوم من مشكلات وأزمات هي من جرَّاء هذه الحالة.
وبالنتيجة، إن الصيغ المستخدمة لعملية التحريك الاجتماعي أصبحت تقليدية وذات جدوى محدودة، لذلك ينبغي البحث عن صيغة اجتماعية جديدة تُحقِّق دينامية مجتمعية جديدة.
المقصود بالدينامية الاجتماعية:
وقبل أن نستطرد في بيان عناصر الصيغة الاجتماعية الجديدة من الضروري توضيح مقصودنا من مصطلح الدينامية الاجتماعية عبر النقاط التالية:
1- الحركة الذاتية: إن معيار الدينامية الاجتماعية الأساس هو وجود الديناميكية الذاتية، إذ إن المجتمع الذي يفقد حوافز الحركة الذاتية لا يمكن أن نطلق عليه أنه مجتمع دينامي. فالحركة الذاتية هي مقياس الدينامية، ودونها تبقى النشاطات والفعاليات الاجتماعية رهينة بظروفها ودوافعها الخارجية.
كما أنها المحركة الحقيقية للعملية الاجتماعية والتاريخية؛ لأنها تنطلق من إمكاناتها وتتحرَّك بحوافزها وفق أهداف محدَّدة وتاريخية.
2- العلاقة العقلانية مع التكنولوجيا الحديثة: ممَّا يلفت النظر حقّاً أن المجتمعات الإنسانية بفعل التكنولوجيا والتقنية الحديثة أصبحت تتمتَّع بطاقات هائلة، إلَّا أنها في «الغالب» في الوقت ذاته تعاني من كل أشكال غياب الدينامية والفعالية الاجتماعية.
وهذا يدفعنا إلى القول: إن طبيعة العلاقة التي تحكم المجتمع مع الطاقة الحديثة هي طبيعة لا عقلانية؛ لهذا فإن بداية الدينامية الاجتماعية هي تأسيس علاقة عقلانية مع الطاقة الهائلة المتوفِّرة في المجتمع من جرَّاء التكنولوجيا والصناعات الحديثة.
والعلاقة العقلانية هي قبل كل شيء قدرة المجتمع على استيعاب أسرارها، وعلى تحقيق التطوُّر الدائم وفق حوافز ومتطلَّبات ذاتية. وينبغي أن نُدرك أن وصول المجتمع إلى مصافٍّ متقدِّمة على المستوى الصناعي والاقتصادي، لا يعني بالضرورة أن علاقته مع المعدات والمنتجات الحديثة علاقة عقلانية. وهذا ما حاول أن يثبته (هربرت ماركوز في كتابه (الإنسان ذو البعد الواحد)[2]، إذ يؤُكِّد أن المجتمع الصناعي المتقدِّم هو برمَّته مجتمع لا عقلاني؛ لأن تطور إنتاجيته لا يُؤدِّي إلى تطوُّر الحاجات والمواهب الإنسانية تطوُّراً حرّاً، بل على العكس من ذلك تماماً، فإنتاجيته لا يمكن أن تستمر في التطوُّر على الوتيرة الراهنة إلَّا إذا قمعت تطوُّر الحاجات والمواهب الإنسانية وتفتُّحها الحر، شأنها في ذلك شأن السِّلْم الذي ينعم به المجتمع المعاصر؛ إذ إن هذا السِّلْم غير متحقِّق إلَّا بفضل شبه الحرب الشاملة المنذرة دوماً بالاندلاع.
فالعقلانية في علاقات المجتمع مع مُعدَّات التقنية الحديثة هي التي تجعله يستفيد منها أقصى استفادة دون أن تأسره أو تُزيِّف من حاجاته ومتطلَّباته الملحَّة.
وثمَّة صلة عميقة بين الدينامية الاجتماعية والتقدُّم؛ إذ إن التقدُّم في محصلته النهائية هو ثمرة الدينامية الاجتماعية، فلا تقدُّم إنساني من دون دينامية اجتماعية وحيوية إنسانية، تتحرَّك وتعمل وتكافح في سبيل تحقيق قفزات نوعية في مسيرة المجتمع.
وإن التوتُّر بين الراهن والممكن يتفاقم ويستفحل مادام المجتمع بعيداً عن الدينامية الاجتماعية، فهي الجسر الذي ينقل المجتمع إلى ممكنه وأهدافه وتطلُّعاته.
3- وضوح الغايات والأهداف: ثمَّة تمايز جوهري بين المجتمع الذي تتوفَّر في حركته حالة الدينامية والفعالية، والمجتمع الذي يفتقد هذه الحالة. وهذا التمايز يتجسَّد في أن المجتمع الحي يتحرَّك وفق خريطة واضحة من الأهداف والوسائل الموصلة إليها، ويسير وفق معنى عام، حيث يستوعب هذا المعنى كل نشاطات وطاقات المجتمع في كل الاتجاهات والآفاق. ومن هنا، فإن المقصود بالدينامية الاجتماعية - أيضاً- هو توفر الحركة الاجتماعية في كل الاتجاهات على معنى سامٍ وأهداف مرسومة، ودون ذلك تبقى الحركة الاجتماعية عشوائية-فوضوية، تبذل الكثير من الجهود المبعثرة، دون أن تصل إلى تطلُّعاتها أو أهدافها؛ إذ إن السير على غير هدى لا يزيد المجتمع إلَّا ابتعاداً عن غاياته وأهدافه. ولغياب الدينامية الاجتماعية، مؤشرات عدة منها: سيادة الفكر السلبي، وغياب المبادرات الجمعية المتَّجهة إلى التطوير والبناء، وسيادة روح ومنهجية التثبيط، وفقدان الثقة بالذات والاستقالة من المسؤوليات، والتهرُّب منها، وسيادة روح الارتجال والانفعال، وضمور فضيلة التخطيط وتحديد الأهداف والمقاصد.
وجماع القول: إن غياب الدينامية الاجتماعية يعني وجود مجتمع بلا روح، مجتمع متقاربة أجسادهم ومتباعدة قلوبهم ونفوسهم، مجتمع يتغافل عن أعدائه الخارجين وينشغل صبح مساء بمنافسيه الداخليين، مجتمع يصرف الأموال الطائلة على استهلاكه المحموم دون أن يُفكِّر بتطوُّر اقتصاده الإنتاجي، مجتمع فاقد للهدف والمعنى السامي للحياة. من هنا، فإن قوة المجتمع لا تُقاس بالعوامل المادية، بل بمدى توفُّر الروح الخلاقة والفاعلية الذاتية في المجتمع. والمجتمع الذي يفقد هذه الأمور تتحوَّل إمكاناته المادية من نعمة إلى نقمة من جرَّاء تخبُّطه، وعدم قدرته على امتصاص آثار هذه الإمكانات.
فالدينامية الاجتماعية هي المطلب الملحُّ، التي ينبغي توفير عناصرها وثقافتها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حتى يتسنىَّ لنا الانخراط في العالم ونحن نعيش الحيوية والنهضة في كل المجالات والحقول.
نقد الجمود:
إن تبديد غيوم الجمود في المحيط الاجتماعي بحاجة إلى حركة ذاتية ــــ دينامية.. لا تنتظر المحفزات من الخارج، بل ينبغي أن تكون المجتمعات مولدة للإصلاح والتغيير وصانعة له.
ثمة حقائق ووقائع تاريخية، ينبغي استحضارها باستمرار في حركة الوعي المعاصر، حتى يتم الاستفادة منها وتمثلها وتجسيدها في واقعنا المعاصر. ولعلنا نرتكب جريمة كبرى في حق تاريخنا وتراثنا، إذا لم نعمل على استيعاب القيم والدوافع الإنسانية النبيلة التي وقفت خلف تلك الحقائق التاريخية المجيدة.
ولعل من المسائل الشائكة التي تعترض راهننا وتبحث عن إجابات واقعية لها، هو كيف ينبغي أن تكون علاقتنا مع حضارة عصرنا.
وبعيداً عن المضاربات الفكرية والأيديولوجية، نحن بحاجة أن نستحضر تجاربنا التاريخية في هذا الصدد، لكي نستهدي بها، ونستفيد منها وصولاً لتأسيس رؤية عميقة. تحدد لنا طبيعة العلاقة التي ينبغي أن ننسجها مع حضارة عصرنا.
لهذا، فإن السؤال هو: كيف تعامل المسلمون الأوائل مع حضارات عصرهم. وتحديات راهنهم؟.
من المؤكد أن الأمم لا تتمكن من تحديد إجابات وافية على هذا التساؤل الحضاري، إذا لم ترفع ما يحول بينها وبين قوانين الحياة الاجتماعية والتاريخية.
فالأمة التي تزيح عن كاهلها كل معوقات التعاطي الإيجابي مع قوانين الوجود الاجتماعي ستحتل مكان الصدارة، على الصعيدين الاجتماعي والحضاري؛ لأن كل فضاء معرفي-اجتماعي، يملي جملة من التصورات العامة، كما يملي جملة من أدوات التحليل الخاصة.
وإن تحقيق الانتصارات والمكاسب الحضارية في الماضي، لا يجعلنا إذا لم نتشبث بنفس الأسباب والعوامل التي أهلت وأوصلت آباءنا وأجدادنا إلى تلك الانتصارات والمكاسب، نحقق انتصارات راهنة في واقعنا المعيش.
فالإغراق في الماضي يعمي عن تحديات الراهن، ويشكل بشكل أو بآخر وسيلة للهروب من مواجهة العصر وقضاياه. فالمطلوب إذن من أجل حيوية وفعالية، علاقاتنا بماضينا وحضارات عصرنا وتحديات راهننا، هو نقد الجمود، جذوره والانعتاق من آساره وحبائله؛ لأن سيادة عقلية التقليد الأعمى والجمود والحرفية في المنهج والتفكير، لا يؤديان إلا إلى الذوبان في الماضي وقضاياه والهروب من الحاضر وتحدياته.
وبطبيعة الحال، لا يمكن لأمة أن تعيش بلا ماض ولا تاريخ. ولكن الأمم الحية هي التي تستطيع أن تحدد منهجية واضحة وفعالة في علاقاتها بماضيها، حيث يكون ماضيها وتاريخها وسيلة للنهوض المعاصر، لا وسيلة للهروب والانزواء عن الواقع.
فإن المهمة الكبرى الملقاة على عاتق الجميع، هي نقد الجمود بقوالبه الفكرية وآليات تأثيره المجتمعي؛ لأنه بوابة العبور إلى علاقة حسنة وإيجابية مع الماضي وحضارات العصر. والجمود الذي نرى أن مهمة الجميع محاربته ومقاومته والخروج من آساره يعني:
1- التوقف عن العطاء الحضاري والإنساني والعيش على أمجاد الماضي ومكتسبات الأجيال الغابرة.
2- الانغلاق المميت على الذات. ورفض الآخر وإيثار التقليد على الاجتهاد والاتباع على الإبداع.
3- سيادة روح الإحجام والبعد عن الإقدام والانجذاب إلى الماضي لا إلى المستقبل ولا يقف الجمود عند حد معين، بل يتعدى ويصل إلى نقص في القدرة على التفكير السليم، ونقص في الشجاعة، وإلى تركيب مجتمعي غير متجانس مع وحدة الشكل الخارجي.
4- محاربة وعرقلة المحاولات التجديدية. تحت مبررات ومسوغات واهية. لا ترقى إلى أهمية إحداث تحوُّلات نوعية في مسيرة مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فليس كل المحاولات التجديدية تعد تجديفاً في الدين، أو خروجاً عن أصول الممارسة الفكرية السليمة، ولكن الجمود بمتوالياته النفسية والعقلية والسلوكية هو الذي يقف دون تبني مواقف إيجابية من محاولات التجديد في مسيرة الأمة.
والجمود لا يعبر عن مرحلة تاريخية فحسب، ساد في الأمة وطبع وقائعها كلها بصفاته وآليات تعبيره، وإنما أيضا يعبر عن طبيعة المرحلة الراهنة، حيث إن الكثير من الظواهر السلبية والسيئة في جسم الأمة على مختلف المستويات هو وليد شرعي إلى مرحلة الجهود السائدة.
فانعدام الثقة بالذات أو ضعفها، والغرور والتميز الأجوف، والذي يصل إلى حد العنصرية في بعض الأحيان والفصل بين الأقوال والأفعال، بين الظاهر والباطن كلها مظاهر وآثار مترتبة على سيادة حالة الجمود في المحيط المجتمعي.
فالجمود بمثابة البؤرة التي تضخ مختلف أشكال التعويق وانعدام الوزن، وتعطل كل علامات وإرادات النهوض المجتمعي.
لذلك، وبسبب ما تضخه عقلية الجمود من تبريرات وما تزرعه في الوسط الاجتماعي من معوقات ذاتية تبقى كل مشاريع التقدُّم والنهوض ذات طابع فوقي ولا تلامس بشكل جاد جذور الأزمة ومنابع الخلل.
فعلى المستوى الفكري والثقافي تحولت غالبية مشاريع النهضة إلى مشروعات ثقافية انتقائية، تلفيقية متجاورة في ذلك مع كل أفكار التبرير ومشروعات ليس بالإمكان والمقدور.
وعلى المستوى الاجتماعي، لم تستطع هذه المشروعات في غالبيتها إلا ممالاة الواقع والتساكن مع عناصره ورموزه.
ولعل الذي أوصل الحالة إلى هذا المستوى هو توفر حالة الجمود في المحيط الاجتماعي. وبقاء أفكار التقدُّم والنهضة من جراء ذلك ذات طابع نخبوي خاص.
فالجمود بما يشكله من عقلية واستقالة من المسؤولية العامة. وانكفاء على الذات بشكل لا يطاق. يعد هو العقبة الكأداء أمام مشروعات النهوض في العالم العربي والإسلامي.
وعلى ضوء هذا، فإن مهمة العالم العربي والإسلامي نقد الجمود بأيديولوجيته وآليات عمله، حتى يتحرر الواقع العربي من آساره.
ونقد الجمود ومحاربة جذوره النفسية والعقلية والاجتماعية، ليست مهمة بسيطة أو وظيفة سهلة، وإنما هي من الوظائف المعقدة، والتي تتطلب الكثير من الجهود والإمكانات والطاقات. وتوظيفها الأمثل في إطار محاربة كل عناصر الجمود والكسل العملي والاجتماعي؛ بمعنى أن إنهاء الجمود من الفضاء الاجتماعي، يتطلب القيام بعملية تغييرية شاملة، حيث إن النظام القيمي الذي يعطي الأولوية للعمل والسعي والبناء والعمران هو الذي يسود الفضاء الاجتماعي بكل أبعاده وآفاقه.
ومن أجل تحقيق هذه المهمة نؤكد على النقاط التالية:
تعميق الوعي التاريخي:
إن التاريخ الإنساني يشكل سلسلة مترابطة الحلقات، وسياقاً متواصلاً منذ فجر التاريخ وإلى الآن. لذلك، فإن التعاطي مع التجربة الإنسانية والتاريخية، باعتبارها مجموعة من القصص المتفرقة أو الأحداث المنفصلة والغريبة عن بعضها. لا تؤدي إلى الفهم السليم لهذا التاريخ ولا تحرر المحيط الاجتماعي من الجمود وسلطته، بينما التعامل مع التاريخ كوحدة إنسانية مترابطة ومتواصلة عبر الزمن. يعمق في نفوسنا وعقولنا الوعي التاريخي، والذي يزيل الالتباسات ويعرّي جذور الخلل الكامن في الجسد الاجتماعي. ويقضي على ما يمكن تسميته بالوعي الطفولي للتاريخ.
فتعميق الوعي التاريخي شرط ضروري للنمو والتقدُّم وتجاوز معوقات الجمود واليأس.
الحركة الذاتية:
إن تبديد غيوم الجمود في المحيط الاجتماعي. بحاجة إلى حركة ذاتية-دينامية.. لا تنتظر المحفزات من الخارج، بل ينبغي أن تكون المجتمعات مولدة للإصلاح والتغيير وصانعة له.
وإن الحركة الذاتية هي التي تفتح أبواباً جديدة لرؤية الراهن وبلورة آفاقه. فإن الإمكانات والقدرات التي يتضمنها أي مجتمع لا يمكن توظيفها في مقاومة الجمود. إذا لم تكن هناك حركة ذاتية في المجتمع. يتحرك بحوافزها ويسعى نحو الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتوفرة في الإنسان والطبيعة.
القوة النفسية والإرادة الفاعلة:
إن المجتمعات المهزومة نفسياً لا تستطيع توظيف إمكاناتها وقدراتها في مشروع نقد الجمود وإقصاء عوالمه من التأثير؛ لأن النفسية المهزومة لا تعكس إلا إرادة خائبة لا تستطيع القيام بأي عمل. لهذا، فإن مقاومة الجمود تتطلب القوة النفسية والصلابة المعنوية التي تبث إرادة فاعلة وعزيمة راسخة وتصميماً فولاذياً على تطوير الواقع وتبادل الصعاب ومجابهة العوامل المضادة التي تحول دون التقدُّم والتطوُّر.
واستطراداً نقول: إن الخطر الحقيقي الذي يواجه الشعوب والأمم ليس في الهزيمة المادية والخارجية، بل في الهزيمة النفسية والجمود الذي يسقط كل خطوط الدفاع الداخلية، ويمنع من وجود القدرة الطبيعية من إدارة الذات فضلاً عن تطورها.
لذلك، فإن نواة التقدُّم والتنمية هي وجود القوة الاجتماعية المتحررة من قيود الجمود، والتي تعيد للإنسان عافيته وتجعله يقاوم تحدياته بإمكاناته المتوفرة.
كيف نخرج من الدوامة؟
وبفعل عملية التغذية العكسية بين التقليد والتبعية أضحت إشكالية التطوُّر التاريخي لمجتمعاتنا تحت التأثير المقرر لكلتا الظاهرتين.
التقليد والتبعية من المفاهيم المترابطة، والذي يعكس ترابطها مدى التأثير المتبادل بين هذين المفهومين؛ فالمسافة جِدُّ قصيرة بين التقليد بوصفه حالة معرفية ونفسية سائدة في محيطنا العام، والتبعية بوصفها علامة من علامات العجز الذاتي والتوقُّف عن النمو العام.
ولا نعدو الصواب حين نقول: إن التقليد هو الوجه الآخر للتبعية في عملة واحدة، لا ينفصل عنوانها الثقافي عن وجهها السياسي.
وفي اللغة العربية (حسب القاموس المحيط)، نجد أن المفهومين يدلَّان على الانقياد والاقتداء واللحاق والمضي مع، والمرافقة والملازمة والمداينة والمطالبة، وهي من المفردات التي تُحدِّد أو تُعيِّن علاقة متبادلة بين طرفين أو أكثر.
فالمسافة بين التقليد والتبعية هي المسافة بين السبب ونتيجته؛ وذلك بالمعنى الذي يصل التقليد والعجز الذاتي عن النمو والتطوُّر والإبداع بحالة التبعية والخضوع. وإذا كانت التبعية هي الاستجابة الطبيعية لكل من توقَّف عن النمو، ودخل في نفق التقليد الأعمى، فإن التقهقر الحضاري والاستلاب الثقافي والاجتماعي هو الناتج الطبيعي لكلا الأمرين، سواء على المستوى الفردي أو الجمعي.
فالتبعية إلى الآخرين بجميع أشكالها وصورها هي حصيلة للتقليد والجمود والوقوف عن النمو في الداخل؛ فالاعتماد المطلق على الآخرين يتغذَّى باستمرار من الأمصال التي تمدُّها إليه حالات الجمود في العقل والتقليد في التفكير التي يعانيها أيُّ مجتمع. ولم يُسجِّل لنا التاريخ أن أمة من الأمم أو شعباً من الشعوب خضع لمشروع التبعية والاستتباع الحضاري إلَّا على قاعدة تخلُّف عميق وجمود شامل تعانيه تلك الأمة أو ذلك الشعب في ذاته وكيانه الداخلي.
فمنطقا الواقع والتاريخ يدفعاننا إلى القول: إن الأمة الجامدة والمتوقِّفة عن التقدُّم، لا يمكن لها الاستمرار في الحياة إلَّا بالخضوع والتبعية إلى طرف أو أطراف أخرى، وهذا الخضوع لا يستمر إلَّا مع قاعدة الجمود والتقليد الأبله للآخرين.
لهذا، فإن إنهاء التخلُّف والجمود والتحرُّر من عقلية التقليد الأعمى هو البداية الحقيقية للتخلُّص من مشروع الاستتباع الخارجي؛ لأن الجمود والتقليد في إطارهما العام يعنيان تأخُّر مستوى الوعي، وتراجع درجة النضج العقلي والنفسي، حيث ينتقل الإنسان من آفاق الإبداع إلى جبر الاتِّباع، ومن مناخ المساءلة إلى مناخ التسليم على حدِّ تعبير الناقد (جابر عصفور). والتبعية كحالة وسلوك في حياة الإنسان الفرد والجماعة، حينما لا تتمكَّن الأنا من الفعل الإيجابي في الحياة، على مختلف المستويات والصعد، من هنا نرى أن مسلسل الهزيمة الذي أصاب العالم العربي والإسلامي في عصوره السالفة كان جرَّاء التخلُّف والجمود والتقليد الذي استفحل في جسد الأمة وأصابه بالعطب والعقم. وهذا بدوره أدَّى إلى شيوع ظاهرة التبعية في علاقات العالم العربي والإسلامي مع العوالم الحضارية الأخرى.
فالعلاقة بين التقليد والتبعية علاقة معقَّدة ومتشابكة، حيث إن شيوع ظاهرة الجمود والتقليد في الحياة الاجتماعية لأيّ أمة يُؤدِّي إلى استتباع هذه الأمة للخارج، وعملية الاستتباع هذه بما تصنع من آليات وتداعيات ومراكز قوى، تسعى من أجل ضمان مصالحها واستمرار هيمنتها إلى تعميق كل حالات الجمود والتقليد؛ لأنها مهاد التبعية الحقيقي.
فالجمود والتقليد في الداخل يُؤدِّي إلى ذيلية وتبعية للخارج، وحتى يستمر الخارج في هيمنته على الداخل يستخدم كل إمكاناته وقدراته لإدامة حالة الجمود والتقليد في الداخل. ولعلَّنا لا نعدو الصواب حين القول: إن هناك علاقة وطيدة بين التبعية والاستبداد؛ إذ إن الأولى تقود إلى الثانية، ولكي يستمر الاستبداد يلجأ إلى الخضوع للأجنبي والتبعية له في كل شيء.
فالعلاقة بين التقليد والتبعية علاقة معقَّدة ومتشابكة، حيث إن كل طرف يُغذِّي الآخر، ويمدُّه بأسباب الحياة. فالتقليد هو عبارة عن حالة نفسية ومعرفية متوقِّفة عن النمو، وتعتقد أن ما وصلت إليه من معارف وعلوم هي المستوى الأقصى للمعرفة والعلوم، فتتوقَّف عن النمو، وبهذا تتكرَّس حالة من الجمود واليباس الفكري، ويجبر النقص الذي يتوفَّر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جرَّاء الجمود واليباس والتوقُّف بالاستيراد الشَّرِه إلى كل ما تنتجه المجتمعات الأخرى من بضائع وسلع.
وتتأسَّس من جرَّاء هذه العلاقة اللامتكافئة خيوط مسيرة التبعية، بفعل غياب الرغبة الحقيقية في تطوير الذات، وتوسيع آفاقها المعرفية، والاستفادة الواعية من معارف الآخرين وإنجازاتهم.
فالبنية الاجتماعية المتخلِّفة والجامدة تُغذِّي مشروع التبعية للخارج، هما أن العامل الخارجي «التبعية» لا يستديم في هيمنته وسيطرته وامتصاصه لخيرات الداخل إلَّا بتغذية ودعم العناصر المكوِّنة «للوضع الداخلي» المتَّسم بالجمود والتخلُّف والتقليد.
وبفعل عملية التغذية العكسية بين التقليد والتبعية، أضحت إشكالية التطوُّر التاريخي لمجتمعاتنا، تحت التأثير المقرَّر لكلتا الظاهرتين.
وعلينا في هذا الإطار، أن نتساءل عن الطريق الذي يُخرجنا من هذه الدوامة والإشكالية التاريخية.
ومن دون مضاربات فكرية وسجالات أيديولوجية، نتمكَّن من القول: إن ثمَّة طريقاً للخروج يتجسَّد في ضرورة توفُّر الفعل الحضاري في الداخل العربي والإسلامي، والذي يعني وجود مقوِّمات البناء الذاتي، والدينامية الطامحة إلى التطوير والخروج من إسار التقليد والتبعية في آن، والروح المعنوية اللازمة لكل عملية تطوير وتقدُّم اجتماعي، ومجموع هذه العناصر تُشكِّل في مجملها مشروعاً نهضويّاً. يطمح إلى تبديد الجمود وإزاحة التقليد الأعمى من العقول والنفوس، ومقاومة كل شروط التبعية الاجتماعية والاقتصادية.
والمناخ الذي يُشيعه مشروع النهضة يتَّجه إلى تطوير لا يطال السطح فقط، وإنما تطوُّرات شاملة وعميقة في البنى المعرفية والثقافية والحضارية.
وهذا المناخ دون شك يعتبر مفتاح الحلِّ في القضية الحضارية للعالم العربي والإسلامي.
وفي هذا الإطار، ثمَّة مفارقة بين «الحداثة والنهضة» ينبغي التأمُّل في أبعادها المعرفية والحضارية؛ إذ اتَّجهت الحداثة في الفترة الأخيرة في العالم العربي والإسلامي إلى تحصين الجاهز وتدعيمه منعاً من اختراقه، بدلاً من أن تطلق حركة الاجتهاد طاقاتها الإبداعية، وصياغة الرؤى العامة لتتنزل على الوقائع بروح وفهم جديدين.
وإن الإبداع الحضاري والتجديد الاجتماعي يستلزمان إطلاق حركة الاجتهاد والإبداع، حتى يمدَّ المسيرة الاجتماعية بالأفكار والرؤى التجديدية، التي تُخرج المجتمع من حبائل التقليد والجمود والتبعية وآلياتها الجهنمية.
وإن أخطر أثر يصنعه الجمود في الأمة هو أنه يُزيل القدرة الذاتية التي تدافع عن قيم الأمة ومصالحها الحيوية، وبالتالي تُصبح الأمة لغياب القدرة الذاتية عرضة لكل عوامل النكوص والتأخُّر الحضاري.
ويتطلَّب الخروج من الدوامة الآتي:
1- تنمية الذات، والعمل على الإمساك بأسباب الحياة الكريمة؛ إذ لا يمكن الخروج من هذه الدوامة والدائرة الجهنمية، التي تُديم التخلُّف والانسحاق والتبعية للآخرين، إلَّا بالعمل الجاد على تنمية الذات في كل الحقول والمجالات، حتى يتمَّ الخروج من هذه الشرنقة التي تُبدِّد طاقاتنا، وتقتل مواهبنا، وتُميت اندفاعاتنا صوب الاستقلال والاعتماد الواعي على الذات؛ فالخطوة الأولى المطلوبة للخروج من هذه الدوامة هي أن ننطلق من مشروع تنمية الذات في كل الحقول والمجالات، حتى يتوفَّر الظرف الذاتي المؤاتي للتحرُّر من ربقة التقليد الأبله والتبعية المُذلَّة.
2- تطوير المجتمع: لا شك في أن التقليد الأبله ومعادله الموضوعي التبعية المُذلَّة يجدان في تأخُّر وتخلُّف البنية الاجتماعية الأرض الخصبة لاستمرار وبقاء تأثيراتهما المتعدِّدة في المجال الاجتماعي بأسره. لذلك لا يمكن التحرُّر من ربقة التقليد والتبعية إلَّا بتحديث المجتمع وتطوير قدراته وإمكاناته البشرية والمادية، حتى يتسنىَّ له مجابهة كل العوامل والأسباب الموجبة لاستمرار التقليد والتبعية في الفضاء الاجتماعي؛ فالخروج من الدوامة يتطلَّب صوغ مشروع اجتماعي جديد يزيل أسباب التأخُّر، ويستوعب الطاقات والقدرات ويُوجِّهها صوب البناء والتقدُّم، ويُنظِّم العلاقة بين أجيال المجتمع وقواه الحيَّة، ويغرس في نفوس أبناء المجتمع الهمَّة العالية والملموح الواعد، والإرادة الصلبة والعزم الذي لا يلين. كل هذا من أجل تنفيذ برنامج المشروع الاجتماعي الجديد الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة المجتمع على مختلف المستويات.
3- صوغ علاقة متكافئة من الخارج، بما يشمل من قوى إقليمية ودولية وسياسية واقتصادية، تقوم هذه العلاقة على قاعدة مراعاة واحترام المصالح الذاتية والوطنية، حيث تغيب كل أشكال العلاقة التي تنتهك حرمة الاستقلال والمصالح الوطنية العليا؛ وذلك لأن للتبعية مفاعيل وتأثيرات إقليمية ودولية عديدة لا يمكن تجاوزها إلَّا عبر تنظيم شبكة العلاقات الخارجية للمؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث يكون قوام هذه العلاقات صيانة الذات وتطوير مصالحها واحترام مقتضياتها ومتطلَّباتها.
وإن الخروج من دوامة التقليد والتبعية بحاجة إلى حياة ثقافية ــــ اجتماعية، تحارب مكوِّنات الجمود وبؤر التقليد ومسبِّبات التبعية، في سياق اجتماعي واحد، يستمد أسباب قوته من طاقات الأمة وتطلُّعها التاريخي إلى إعادة مجدها الغابر، وطموحها الراهن إلى تحقيق مفهوم الشهود الحضاري.
من هنا نبدأ:
إن أخطر ما يُصيب المجتمعات الإنسانية من آفات هو حينما يفقد أبناء هذه المجتمعات فاعليتهم، وتتوقَّف عوامل الدفع الحضاري لديهم، فتنتشر أفكار الكسل والخمول والتبرير، وتسيطر على مجريات حياتهم، فتموت في مهدها كل جذوة فكرة تتطلَّع للخروج من هذه القدرية الفكرية والاجتماعية المقيتة، وتسود في الوسط العام كل الكوابح والعقبات، التي تحول دون الانطلاق وتحقيق مفهوم الشهود الحضاري، ويستولي عليهم التقليد الأبله لواقع تاريخي أو في تجربة مجتمعية محدَّدة. وفي هذا الظرف يفقد المجتمع القدرة على استثارة الطاقات الداخلية وكوامن الحياة فيها، وحينذاك يتحوَّل المجتمع إلى كيان هامشي في كل شيء، فغذاؤه واقتصاده يستورد من الخارج، ومعايير قيمه الاجتماعية والعامة مقتبسة من النماذج الفكرية الأخرى، وكيانه الاجتماعي ليست محدَّدة هويته، بل تصطرع في داخله شتَّى الهويات والنظريات.
ولعل جذر غياب الفاعلية في المحيط الاجتماعي، وتوقُّف عوامل الدفع والحفز الحضارية، هو عدم انتظام العلاقة بين (عالم الأفكار)، ونقصد بذلك منظومة القيم العليا والأفكار التي تُساهم بشكل فعَّال في صياغة السلوك الخاص والعام و(عالم الأشخاص)، من حيث مدى التزام هذا العالم بمتطلَّبات المنظومة القيمية. وهذا الاضطراب أو عدم الانتظام لا يقف عند حدود معيَّنة، وإنما ينعكس بشكل طبيعي على منهج التعامل مع (عالم الأشياء). وبنظرة واحدة إلى الأزمات الكبرى التي يعانيها العالم العربي والإسلامي نكتشف مدى الخلل المتوفِّر في علاقة هذه العوامل بعضها مع بعض، وكيفية تأثير كل عالم أو حقل على العوالم أو الحقول الأخرى.
فحينما يبتعد عالم الأشخاص عن منظومة القيم ولا يُحكِّمونها في واقعهم، فإن هذا العالم (الأشخاص) يتحوَّل إلى أشبه شيء بغابة مليئة بالصراعات غير المنضبطة، والتي تشتعل لنوازع شريرة وغرائز وأهواء شيطانية.
وهذا بطبيعة الحال، يُؤدِّي إلى انهيار تام في المنظومة الاجتماعية، وتضمحل إمكانات خروج هذا الجمع من مآزقه وأزماته. والأنكى من ذلك أن حالة الانهيار لا تصيب الأشخاص فقط، وإنما تتعدَّى ذلك وتصل إلى الطريقة المستخدمة للتعامل مع عالم الأشياء، فتتحوَّل التنمية إلى المزيد من الاستيراد الشَّرِه لمنتجات الحضارة الحديثة، ويُصبح معيار التفاضل الاجتماعي ليس الكسب الحسن والصالح، بل هو التفاخر بالأموال والممتلكات، فتبدأ المادة تطغى عل كل شيء، وتُصبح هي معيار كل مسألة في الكيان الاجتماعي؛ فالإنسان بأمواله حتى ولو كان سيِّئ الأخلاق وعديم الضمير، فالمآزق الاجتماعية العامة، التي تعانيها غالبية شعوبنا، هي من جرَّاء اضطراب العلاقة بين العوالم الثلاثة (الأفكار والأشخاص والأشياء)، وإن تجاوز هذه المآزق لا يتم إلَّا بتنظيم هذه العلاقة بين هذه العوالم.
فلحظة الانهيار الحضاري الذي أصاب الواقع العربي والإسلامي بدأ من تلك اللحظة التاريخية التي اضطربت فيها العلاقة بين الأمة ومنظومتها العقدية والفكرية، كما أن فترات الازدهار والشهود الحضاري لهذه الأمة تحققت حينما اتَّسقت العلاقة بين عالم الأشخاص وعالم الأفكار والقيم.
فنقطة البداية هي تنظيم العلاقة بين (عالم الأشخاص) والمنظومة القيمية أو (عالم الأفكار)، حيث تكون تصرُّفات الأشخاص ومواقفهم نابعة من تلك المنظومة، ومُؤدِّية إلى تثبيتها في المحيط العام. وهذا يتطلَّب الأمور التالية:
1- ضرورة وجود المنهج السليم الذي يربط عالم الأشخاص بعالم الأفكار؛ لأن في الكثير من الأحيان، فإن ما ينقص الشعوب والمجتمعات، ليس الإمكانات المادية، للخروج من حالات التخلُّف التاريخية، بقدر ما هو غياب ذلك المنهج الواضح الذي يُوفِّر الفهم الصحيح لهذه المجتمعات. فالمنهج الواضح عبارة عن تلك السبيل المعروفة بداياته ونهاياته، والتي يسير المجتمع على هداها لبلوغ غاياته وأهدافه. ولعل ما ينقص تجربتنا العربية الحديثة في عملية النهوض هو غياب هذا المنهج، الذي يجمع كل الطاقات في سبيل أهداف محدَّدة وغايات معيَّنة، وكما يبدو أن هذا هو السبب في تراجع التجربة العربية وعدم وصولها إلى أهدافها وتطلُّعاتها. والمنهج الواضح يعني -أيضاً- إنهاء حالة الوهم، التي ترى في جملة المبادئ العامة أنها هي البرامج والخطط والوسائل الموصلة إلى الأهداف والغايات. إن مجرَّد الاحتفاظ بالمبادئ العامة لا يعني توفُّر المنهج، الذي ينقل هذه المبادئ من عالم المثُل إلى عالم الواقع، وإنما ذلك بحاجة إلى بذل جهود نوعية مكثَّفة لصناعة ذلك المنهج الذي يأخذ بيد الناس للوصول بهم إلى ما يجب أن يكون ليتمَّ تحقيق ما تقتضيه جملة المبادئ والقيم العامة.
2- ملاحظة ظروف الزمان والمكان في فهم عالم الأفكار؛ لأن الكثير من الجهود الثقافية والفكرية المتوفِّرة في الساحة، والتي تتطلَّع لإخراج الراهن من مآزقه؛ هو وفي أغلبها إما منتج دون مراعاة لظروف الزمان وفقه المرحلة، أو دون مراعاة لظــــروف المكان وفق الواقع، لذلك أصبحت هذه الجهود تتجاذب الكثير من الشعوب دون أن تتجاوز مآزقها الذاتية؛ لذلك نحن بحاجة إلى تلك الجهود الثقافية والفكرية التي تلحظ ظروف المكان، كما تأخذ بعين الاعتبار ظروف الزمان، وبهذا يتم تجاوز حالة التكديس والأسر التي أصابت الكثير من الجهود الثقافية العربية، بفعل الفصام النكد بين الزمان والمكان في الإنتاج الثقافي والفكري.
3- إعادة بناء عالم الأفكار؛ إذ من البداهة القول: إن عصور التخلُّف والانحطاط أوجدت جملة من الأفكار والقناعات الثقافية التي تُبرِّر واقع التخلُّف؛ لذا فإن إعادة بناء عالم الأفكار، وتنقية الواقع الفكري والثقافي من تلك الأفكار التي يعتبرها المفكر (مالك بن نبي) أفكاراً ميتة أو قاتلة، أي لا تستطيع أن تُعيد الفاعلية والحيوية إلى الجسم الاجتماعي، أو تزيد الوضع الاجتماعي تشتُّتاً وضعفاً من جرَّاء الوافد الفكري. من هنا فإن إعادة بناء عالم الأفكار يعني:
1- إعادة النظر في مناهج التثقيف وأهداف اكتساب الثقافة والعلم، في ضوء هدف مركزي، هو صناعة الإنسان الجديد وفق ثوابت الشريعة وتطورات العصر.
2- إدراك الأولويات الوطنية في البناء الاجتماعي، ونبذ حالات التقليد الأعمى لتجارب الغير، وغرس روح الإبداع والابتكار الذي هو الطريق الأمثل لتمثُّل الأفكار الإنسانية الصالحة.
3- الانفصال النفسي والاجتماعي عن رواسب ثقافة التخلُّف والتأخُّر والاتِّصال الفعَّال بأسباب الحياة الكريمة.
وبهذه العناصر، تستطيع المجتمعات العربية والإسلامية التي فقدت فاعليتها، وتوقَّفت عوامل الدفع الحضاري عن العمل، أن تُعيد لها الفاعلية، وتُوقظ عوامل الدفع الحضاري، وتدفعها إلى قلب الفعل الحضاري.
مؤسسات العصر والعمق التاريخي:
كل التكوينات الاجتماعية والثقافية والسياسية والروحية بحاجة إلى السند التاريخي الذي يدعمها، ويُوفِّر لها أسباب الفعالية، ويمنع تكلُّسها وجمودها ويباسها.
وأيُّ خلل جوهري يُصيب علاقة التكوينات المجتمعية بسندها أو عمقها التاريخي يُؤدِّي إلى بداية الانحلال والتآكل على مستوى الثقة ومقدار فعالية الأنماط على قاعدة تلك التكوينات. وبهذا يرتبط العمق التاريخي بمؤسسات العصر وتشكيلاته المجتمعية. وأيُّ تخفيض لمستوى العمق التاريخي في علاقته مع هذه التشكيلات والتكوينات يُؤدِّي بشكل أو بآخر إلى بروز ظواهر تزيد من تصحُّر هذه التكوينات وانفصالها البنيوي عن واقعها المجتمعي.
ومن خلال هذا المنظور، ينبغي أن ننظر إلى التشكيلات المجتمعية الحديثة في الفضاء المعرفي والاجتماعي العربي الإسلامي؛ إذ إن الكثير من المؤسسات والتكوينات الحديثة؛ أي المؤسسات التي برزت في العالمين العربي والإسلامي من جرَّاء احتكاك وتفاعل العرب والمسلمين أفراداً أو جماعات مع الحضارة الحديثة؛ قد لا تجد في الواقع العربي والإسلامي بيئة صالحة لنموِّها وتطوُّرها، وذلك من جرَّاء الإسقاط العفوي، أو التقليد الأبله للمجتمعات المتقدِّمة، بينما من الأهمية النظر إلى مؤسسات العصر باعتبارها نتاجاً مجتمعيّاً وتاريخيّاً لبيئة وحضارة معيَّنة. وإغفال العوامل التاريخية والمجتمعية لبروزها وتطوُّرها لا يُؤدِّي إلى تبيئتها وغرسها الطبيعي في الواقع العربي والإسلامي، بقدر ما يُؤدِّي إلى غربتها وشكلانيتها في الفعل والتأثير.
لذلك، نجد أن العالمين العربي والإسلامي، يمتلئان بتلك المؤسسات والتشكيلات التي تنتمي إلى العصر وتطوُّراته المذهلة، إلَّا أن عمل وتأثير هذه المؤسسات في فضائنا العربي والإسلامي لا يزال محدوداً، ولا ينسجم والجهود التي بُذلت في جميع الاتجاهات في سبيل نقل هذه المؤسسات إلى الواقع العربي والإسلامي.
ومحدودية العمل والتأثير ليست ناتجة من طبيعة هذه المؤسسات، بقدر ما هي ناتجة من جرَّاء آليات استخدامنا لها، والظروف الموضوعية لعملية النقل والاستيراد؛ إذ إن المؤسسة الحديثة التي لا تُحتضن مجتمعيّاً، بمعنى لا تجد لها عمقاً في التكوين المجتمعي، فإنها ستُصبح مؤسسة شكلية وبعيدة عن دورها الطبيعي إن لم تمارس دوراً معكوساً في هذا الاتجاه؛ وذلك لأن استراتيجيات التهميش المتواصلة للمؤسسات الأصلية في الواقع العربي، وتغييب تاريخيتها، وتشكيك أبنائها في دورها وفعاليتها، لا يُؤدِّي إلى زراعة الرغبة الحقيقية عند هؤلاء الناس للتشبث باستراتيجيات استيراد المؤسسات الحديثة، وإنما يُؤدِّي على العكس من ذلك تماماً؛ إذ تزيد من الاغتراب النفسي والاجتماعي، وتحول دون غرس الوعي الضروري لاستيعاب مؤسسات العصر في الفضاء العربي والإسلامي؛ بمعنى أن تهميش مدنية المجتمع الذاتية، وإقصاء مؤسساته الأهلية، يُؤدِّي إلى الانكفاء والهروب النفسي والعملي، وتوفّر الحواجز المجتمعية التي تحول دون الاستمرار التاريخي.
فتقويض الوقائع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية القائمة، وذات السند والعمق التاريخي، يُؤدِّي لا محالة إلى تراجع مستوى الفعل والمبادرة الاستراتيجية عند المجتمع، ممَّا يجعله غير قادر على امتصاص الخبرات الحديثة، واستيعاب مؤسسات العصر، وبالتالي يكون المجتمع بمثابة ساحة مفتوحة للتأثيرات المختلفة والمتناقضة القادمة من الخارج.
وهذا ما حصل بالفعل في نهايات الدولة العثمانية، وبداية تأسيس الدول العربية والإسلامية المستقلة، إذ قامت النخب السياسية بتقويض الوقائع والحقائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية القائمة، بدعوى تخلُّفها وعدم مواءمتها للعصر، وقد استخدمت في سبيل التقويض وسائل قسرية وتعسفية، ممَّا أدَّى إلى غياب المبادرة الاستراتيجية عند المجتمع، وعدم قدرته الفعلية على التحكُّم بمصيره، فأصبح عرضة لتأثيرات الخارج المتناقضة.
والقارئ والباحث في تلك الحقبة التاريخية يكتشف أن العالمين العربي والإسلامي أصبحا ساحة مكشوفة لكل التيارات والاجتهادات والسياسات والاستراتيجيات، دون أن تكون لديهما القدرة على التمييز والاختيار المناسب.
فتبيئة المؤسسات الحديثة في الواقع العربي والإسلامي لا يتأتَّى بتقويض المدنيات والمؤسسات الأهلية القائمة؛ لأن هذا التقويض ومتوالياته المتعدِّدة يُؤسِّس في المجتمع حالة من الانكفاء وعدم التفاعل الخلَّاق مع هذه المؤسسات.
كما أن فعل التقويض يعني تواصل واستمرار التهميش التاريخي والمجتمعي، ولا يمكن بأيِّ شكل من الأشكال أن يستوعب مؤسسات العصر مجتمعٌ يعاني من التهميش المتواصل.
وإن ما يحصل بفعل التقويض والتهميش هو تراجع قوى الإبداع والفعالية الخلَّاقة في المجتمع، وبذلك يفقد المجتمع القدرة على حماية نفسه. وأيُّ مجتمع يصل إلى هذا المستوى فهو يتهالك ويسير بخطى حثيثة نحو الانحدار الشامل.
فتغييب المدنيات الأهلية هو الخطيئة الكبرى في أغلب استراتيجيات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومؤسسات العصر؛ لأن هذا التغييب القسري قضى على البنية التحتية للمجتمع، وبالتالي فقد الأهلية التامَّة لحماية نفسه، واستيعاب التقنية الحديثة. من هنا تنبع أهمية رعاية وتفعيل العمق والسند التاريخي لمؤسسات المجتمع، حتى تباشر دورها في عملية تبيئة مؤسسات العصر، وأيُّ فصل بين عملية التبيئة والعمق التاريخي لا يُؤدِّي إلَّا إلى نتائج عكسية.
ونقصد بالعمق والسند التاريخي الآتي:
1- ضرورة إعادة الحياة إلى المدنيات والمؤسسات الأهلية. ويُخطئ من يعتقد أن طريق تبيئة المؤسسات الحديثة هو القضاء على المؤسسات التقليدية؛ لأن في هذا الفضاء إنهاء لفعالية المجتمع وحيويته. ومن خلال إعادة الحياة والحيوية لهذه المؤسسات تتوفَّر كل الأسباب الضرورية لامتلاك القدرة على تبيئة واستيعاب مؤسسات العصر. ولا يخفى على أحد أن البلدان التي مارست أعمالاً تعسفية في حق المدنيات والمؤسسات الأهلية كمدخل لتوطين مؤسسات العصر، لم تجنِ من هذه العملية إلَّا المزيد من التدهور، وضياع الإمكانية الحقيقية للتطوُّر والتقدُّم.
2- إن العمق التاريخي لا مضمون حضاريّاً له إلَّا في المجتمع الحي الذي يمارس عملية الانعتاق والتحرُّر من كل معوِّقات التأخُّر والتخلُّف، لذلك لا يمكننا أن نفصل بين مفهوم العمق التاريخي والمجتمع الحي؛ إذ إن حيوية المجتمع وفعاليته ونشاطه المتواصل، في سبيل الارتقاء والتقدُّم، هي التي تُعطي لمفهوم العمق التاريخي المضمون الحضاري.
ومن دون حيوية المجتمع وفعاليته يبقى العمق التاريخي كجزء من الفلكلور الشعبي، الذي يتغنىَّ به الناس، دون أن يكون له دور في عملية التعبئة والحركة.
فالمجتمع الجامد والميِّت لا يمكنه -مهما كانت إمكاناته المادية- تبيئة واستيعاب مؤسسات العصر. وحده المجتمع الحي هو القادر على استيعاب مؤسسات العصر.
العرب وسؤال التحوُّل الجديد:
في الحقب التاريخية السابقة تعطَّل مشروع الديمقراطية في العديد من الدول العربية والإسلامية، بدعوى وتبرير أن الديمقراطية لازالت مشروعاً طوباوياًّ، وأن بلداننا تعيش أولويات أخرى؛ لذلك تأجَّل هذا المشروع تارة باسم الاستقلال وضرورة استكماله، وتارة أخرى بدعوى أولوية التنمية والعدالة الاجتماعية، وتارة ثالثة بفعل أن التحدِّيات والتهديدات الخارجية التي يُواجهها العالمان العربي والإسلامي تحول دون اتِّخاذ الخطوات العملية في هذا السياق. فتعدَّدت في العقود الماضية مبرِّرات ومسوِّغات تأجيل الديمقراطية.
ولكننا لم نستطع بفعل هذا التأجيل والمماطلة والتغييب إنجاز تنميتنا الشاملة، ولم نستطع أن نُنهي التحدِّيات والتهديدات الخارجية.
وعند التأمُّل والتحليل العميقين نكتشف أن الإخفاق في كل هذه المجالات كان بفعل التغييب المقصود للديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي وثقافي، وأن الأوضاع المعاصرة التي نعيشها على مختلف الصعد لا تتحمَّل الدخول في نفق التأجيل والتعطيل والتغييب، وإنما هناك حاجة ماسَّة للديمقراطية بكل عناوينها ومجالاتها؛ وذلك لأنه لا يمكن أن نخرج من العديد من الإخفاقات والانتكاسات إلَّا بتبنيِّ الخيار الديمقراطي.
وأن الديمقراطية بالنسبة لنا لم تعد مشروعاً مثاليّاً، وإنما أصبحت ضرورة سياسية ومجتمعية وحضارية. وإن أيَّ تسويف أو تأخير أو تعطيل فإن محصلته النهائية هو الدخول في أتون الانفجارات الاجتماعية والسياسية المفتوحة على كل الاحتمالات والمخاطر.
وإنه آن الأوان بالنسبة لنا أن نخرج من الخديعة التاريخية التي وقعنا فيها. فلا مقايضة بين التنمية والديمقراطية، أو بين الاستقرار والحرية، فلا تنمية من دون ديمقراطية، بل نستطيع القول: إن شرط التنمية المستدامة هو الديمقراطية السياسية الحقيقية، كما أن الاستقرار سياسي واقتصادي وأمني من دون نظام ديمقراطي يكفل للجميع حقوقهم ومكتسباتهم.
كما أننا لا يمكن أن نواجه المشروع الصهيوني مواجهة حقيقية من دون الانخراط في مشروع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في بلداننا العربية والإسلامية؛ بمعنى أن الاستبداد السياسي يُعطِّل الكثير من قدرات أمتنا وطاقاتها، ويُخرجها من المعركة الحضارية مع العدو الصهيوني. فالديمقراطية هي بوابة انتصارنا الحضاري على الغُدَّة السرطانية المغروسة في جسدنا العربي والإسلامي.
إننا أحوج ما نكون اليوم إلى الديمقراطية، ليس باعتبارها فقط خيارنا للخروج من مآزقنا العديدة، وإنما لكونها -أيضاً- طوق نجاتنا، وبوابة دخولنا في التاريخ من جديد.
وإن الديمقراطية أصبحت اليوم مشروعاً ممكناً وقابلاً للتحقُّق في مجالنا العربي والإسلامي؛ بمعنى أن هناك العديد من العوامل والظروف المؤاتية لإنجاز هذا التطلُّع التاريخي.
ومهمتنا هي العمل على توظيف هذه العوامل والظروف، بما يخدم تمتين القاعدة الاجتماعية والسياسية، وتفعيل دور النخبة باتِّجاه توسيع المشاركة العامة، وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، والحد من تغوّل السلطة واستبدادها، والسعي المتواصل من أجل تعزيز الخطوات والمبادرات والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية والحقوقية، التي تصبُّ في مجرى الديمقراطية، وتُوسِّع من قاعدة الخيار الديمقراطي، وتُقلِّص من مساحة الاستفراد بالرأي واحتكار القوة والسلطة.
ووفق التجربة التاريخية والثقافية لمجالنا الإسلامي، نستطيع القول: إنه لا يمكن التقدُّم وتحقيق قفزات نوعية في حياتنا على مختلف المستويات، حينما يتمُّ استبعاد الإسلام من الحياة العامة للمسلمين؛ بمعنى أن التجارب السياسية والقانونية والاجتماعية التي استبعدت الإسلام من التوجيه والقيادة، لم تحصد إلَّا المزيد من التوترات والصدامات بين مشروع الدولة ومشروع المجتمع والأمة.
كما أن الإسلام الذي نقصده كقاعدة ثابتة لمشاريع التقدُّم والتطوُّر في الأمة، ليس جملة الطقوس الفردية والارتباط السطحي والشكلي بالإسلام، بل المقصود أن تكون خياراتنا الكبرى منسجمة وقيم الإسلام، ومستوحاة من المبادئ العليا للدين؛ لذلك فإن طريق التقدُّم في المجال الإسلامي لا يمرُّ عبر إلغاء الإسلام أو تجاوز قيمه العليا، بل عبر استنطاق الإسلام وحضوره في الحياة السياسية والعامة للمسلمين. وهنا لا نجعل الإسلام في مواجهة الديمقراطية؛ لذلك فإننا ضد منطق المقايضة بين الإسلام والديمقراطية؛ إذ إن الأخيرة من المكتسبات الإنسانية التي ينبغي أن نتفاعل معها، ونستفيد منها أقصى فائدة.
وعليه، فإن طريق تقدُّم المسلمين في الحقبة المعاصرة، يمرُّ عبر:
1- حضور الإسلام وقيمه العليا في حياة المسلمين الخاصة والعامة.
2- وتبنيِّ الديمقراطية كمنهج سياسي وإداري وقانوني، لإدارة أمورنا، وتنظيم اختلافاتنا، وضبط صراعاتنا وتنافساتنا، وتطوير واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولا تناقض بين ضرورة الحضور النوعي للإسلام في حياتنا العامة، وتبنيِّ الديمقراطية كمنهج وآلية وطريقة ومتطلَّبات. ونحن هنا لا ندعو إلى توفيقية متعسِّفة بين الطرفين، بل ندعو إلى قراءة الإسلام قراءة حضارية وإنسانية، بعيداً عن تجارب الاستبداد التاريخية، ومحاولات التهميش والتشويه المعاصرة. إن هذه القراءة الواعية والمدركة لجوهر التجارب الإنسانية على هذا الصعيد ستوصلنا إلى حقيقة عميقة مفادها:
إننا لا يمكن أن نتقدَّم ونتطوَّر كعرب ومسلمين إلَّا بجناحي الإسلام والديمقراطية.
صحيح أن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية تكتنفها الكثير من التساؤلات والالتباسات والاستفهامات، وأن طبيعة العلاقة بحاجة إلى توشيج وبيان معالمها وأسسها ومعاييرها، ولكن مع كل ذلك نجزم القول: إننا كمجتمعات لا يمكن أن نُحقِّق قفزات كبرى في مضمار التقدُّم والتطوُّر من دون الإسلام والديمقراطية.
وهنا الديمقراطية ليست هي الوجه الثاني من المعادلة، بل إن ثراء الإسلام، وكمال قيمه، وحيوية مبادئه، وحركة الاجتهاد، وتطوُّر مسيرة الانبعاث الإسلامي، كل ذلك سيساهم بشكل أو بآخر في إعادة تحديد أولويات المجتمعات العربية والإسلامية، وسيُوفِّر القدرة التامَّة لقراءة جادَّة وجديدة لقيم الإسلام السياسية والحضارية.
فالدينامية والفعالية المعاصرة لمجتمع العرب والمسلمين مرهونة إلى حدٍّ بعيد بهذه القراءة، وصياغة الواقع الإسلامي المعاصر على ضوء وهدى حضارية الإسلام وإمكاناته المذهلة على استيعاب منجزات الإنسان ومكتسبات الحضارة.
وأمامنا اليوم فرصة تاريخية كبرى لإعادة بناء واقعنا ومجتمعاتنا على هدى الإسلام ومنجزات العصر.
وبهذه العملية نُحقِّق في واقعنا ديمقراطية أصيلة، لها عمقها الثقافي والاجتماعي، ولها الامتداد المطلوب على الصعيدين الفكري والفلسفي. وتنطوي هذه العملية التاريخية على إمكانية التقدُّم والتطوُّر على قاعدة التكامل بين الغايات المادية والمتطلَّبات الروحية والمعنوية.
والتحديث القسري على المستويين الاجتماعي والاقتصادي لا يصنع ديمقراطية، بل يُفضي إلى أشكال من الديمقراطية مع مضامين استبدادية وأمنية صرفة.
ولهذا نجد على مستوى التجربة في المجالين العربي والإسلامي أن محاولات التحديث القسري رافقها باستمرار ضمور وتحديد وتقليص للمشاركة السياسية العامة، وتعاظم العلاقة غير المتكافئة مع القوى الخارجية، وخطوات متواصلة لطمس الهوية الذاتية وتعبيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتبنيِّ خيارات قمعية وإقصائية تجاه المكوِّنات والتعبيرات السياسية المغايرة. وكأن النخبة التي تقود عملية التحديث القسري تجبر النقص في قاعدتها الاجتماعية بالارتماء في أحضان الأجنبي، وبعدم سلامة وصلاحية مشروعاتها التحديثية باستخدام القهر والقمع في تنفيذها.
وغفلت هذه النخبة عن حقيقة أساسية، وهي: أنه لا يمكن إنجاز التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المجالين العربي والإسلامي، من دون إصلاح سياسي حقيقي، يُوسِّع من دائرة المشاركة السياسية، ويُعطي الشعب بكل مكوِّناته وتعبيراته الحق القانوني والعملي بإدارة شؤونه، وتسيير أموره، وتحديد خياراته، وبلورة مصائره الراهنة والمستقبلية.
فلا تحديث حقيقيّاً في ظل الاستبداد والديكتاتورية، وإقصاء القوى السياسية والاجتماعية. وكل محاولة تحديثية لا تلتفت إلى هذه الحقيقة، فإن مآلها الفشل الذريع والدخول في متاهات جديدة وإحباطات متراكمة.
فالديمقراطية بكل عناوينها السياسية والثقافية والاقتصادية هي بوابة التحديث الحقيقي في بلداننا العربية والإسلامية؛ وذلك لأن الديمقراطية هي التي تقوم بتطوير البنى الاجتماعية والسياسية؛ وذلك لرعاية واحتضان كل تجلِّيات التحديث وخطواته المتنوِّعة.
وبهذا يتم تحرير فكرة التقدُّم والتحديث من شبكة العنكبوت التي نسجتها الأفكار الغربية وحالات الاستنساخ الحرفي للتجارب والتصوُّرات. والتجارب الإنسانية ليست مجالاً للاستنساخ والتبنيِّ المطلق، وإنما هي للتعلُّم منها، واستنباط الدروس والعبر والخبرة من أحوالها ومحطاتها.
وبهذا تمتزج في واقعنا إرادة التعلُّم من التجارب الإنسانية والسياسية مع الرؤية النقدية التحليلية التي تتَّجه إلى تمحيص هذه التجارب، وغربلة هذه الخبرات؛ وذلك من أجل اجتراح رؤية وتجربة جديدة، مفتوحة على التجارب والخبرات الإنسانية، كما أنها تتواصل بشكل عميق مع خصوصياتها ووقائعها الذاتية. وبهذا تستجيب مجتمعاتنا إلى قواعد الإيمان، وتنسجم وضرورة الشهود والمشاركة في العمران الحضاري.
التحول الذاتي.. وإرادة الإنسان:
إن حياة الجمود والركود والسقوط التي تعيشها المجتمعات والأمم في بعض مراحلها وحقبها، فإن الخروج من هذه الوهدة منوط ومرهون بعزائم البشر وإرادة الإنسان، ومشروط بالتزام هذه المجتمعات بشروط الخروج من المأزق وعوامل الانعتاق من أساس الجمود والخمود.
ففعل التغيير والتطوير دائماً وفي أيِّ اتجاه وحقل كان، منوط بإرادة الإنسان، فهو الذي يُقرِّر بقدراته وإرادته إمكانية التطوير والتغيير من عدمها.
ويشير إلى هذه الحقيقة القرآن الكريم، إذ يقول تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ} [الرّعد: 11].
فلا يمكن أن يتمَّ التغيير الاجتماعي إلَّا بتغيير الذوات وتهيئتها لقبول متطلَّبات التطوير، ومن دون تغيير النفس تبقى شعارات التغيير ويافطات التطوير أشبه شيء بمشروعات أحلام اليقظة والآمال البعيدة.
كما أن إرادة البشر وعزائمهم هي التي تُحدِّد واقعية المسار التطويري والتحديثي، فلا تطوير اجتماعيّاً إلَّا بتغيير للذات. وكلما توسَّعت دائرة الملتزمين بمشروع التغيير الذاتي؛ أي تغيير ما بالنفس، كان المجتمع أقرب إلى التطوير الشامل.
والدين الإسلامي لا يعالج مشاكل البشر بحلول سحرية أو طرائق إعجازية، وإنما منظور الإسلام في معالجة مشكلات البشر المختلفة هو العناية بتهذيب النفس وتطهيرها من الرواسب والشوائب، حتى تكون مهيَّأة بشكل تامٍّ لعمليات التغيير والخروج من آثار المشكلات التي تُؤرِّق الإنسان والمجتمع المسلم. لذلك نجد أن القرآن الحكيم يُؤكِّد على اتِّباع العلم ومفارقة الجهل والظن وكل المفردات التي لا تُؤدِّي إلى المعرفة والخبرة، قال تعالى: {وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسرَاء: 36]، وقال تعالى: {وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} [النّجْم: 28]؛ وذلك لأن اتِّباع الظن لا يُؤدِّي إلَّا إلى مراكمة الأخطاء والمشاكل. ولهذا قال علماء المنطق: «إن الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره»[3]، ولا شك في أن الظنون والاحتمالات لا تُؤسِّس لدى الإنسان تصوُّراً دقيقاً عن طبيعة المشكلات وطرق معالجتها.
فالإنسان يصاب بالعطالة إذا كانت إرادته خائرة وعزيمته واهنة؛ لذلك فإن حجر الزاوية في عملية التغيير وتذليل المشكلات التي تعترض طريق الإنسان والمجتمع، هو أن تكون لدى الإنسان إرادة وعزيمة راسخة للخروج من شرنقة المشاكل وبؤر الأزمات والمآزق التي يعيشها. فالإرادة والعزيمة من الشروط الأساسية التي يعتبرها الدين الإسلامي أساسية في معالجة مشكلات البشر.
«فالتوجيهات الإسلامية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب - في البدء- تعزيز الذات وتغييرها المتواصل إيمانيّاً، ثم تمضي باتجاه الأسرة الأقرب إلى الإنسان الفرد، في علاقاته الخارجية، ومن هناك تنداح الدائرة باتجاه الجار، والقربى، والحي والمدينة، فالمجتمع المسلم، فالأمة الإسلامية على امتدادها، فالشعوب والأمم المجاورة، فالإنسانية جمعاء.
إن بؤرة الحركة، هي الذات: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغِيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ} [الأنفَال: 53]، وحدها الآخر، هو البشرية {وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ} [الأنبيَاء: 107]. وما بين الذات والبشرية تتحرَّك المعطيات الإسلامية، تشريعاً وتوجيهاً، لكي ترسم لكل حالة طريقها، وتضع كل ممارسة في مكانها الموزون، ولكي ما يلبث هذا الجهد الديناميكي، الذي لا يقف عند حدّ أن يساهم في صياغة الحياة الإسلامية المتوازنة المستقيمة، الآمنة، السعيدة، القادرة على العطاء وبقطبيها الفرد المسلم والمجتمع المسلم»[4].
فالخطوة الأولى التي ينبغي أن نقوم بها إزاء كل ظاهرة ومشكلة هي البحث والفحص الجاد عن الأسباب الذاتية التي أدَّت إلى هذه الظاهرة أو المشكلة، فلا بد أن نُوجِّه الاتِّهام أولاً إلى أنفسنا، قبل أن نُوجِّهه إلى غيرنا.
وهذه المنهجية تُلخِّصها الآية القرآنية {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عِمرَان: 165]، فإزاء كل هزيمة، إزاء كل مرض وظاهرة سيئة، كل مصيبة على رؤوسنا، ينبغي أن نلتفت قبل كل شيء إلى نصيبنا، إلى دورنا، إلى ما كسبته أيدينا.
إن واقع العرب والمسلمين الراهن هو أسوأ واقع، والانهيار في حياتهم يُهدِّد وجودهم نفسه، ولكن أين يمكن أن يقف هذا الانهيار، ويبدأ التحوُّل؟ جوابنا الحاسم: في أنفسنا، يجب أن يقف في أنفسنا الانهيار، ويبدأ في أنفسنا التحوُّل، فإذا تحوَّلنا إلى مسلمين حقيقيين كما يريد الإسلام تحوَّل بنا مجتمعنا، وتحوَّل بنا المسلمون في كل مكان، وتحوَّل بنا العالم. فالنواة الأولى للتطوُّر النوعي في المجال العربي والإسلامي اليوم، هي في تغيير الذات وإزالة رواسب التخلُّف والانحطاط منها. إن تغيير ما بالنفس هو النواة الأولى لعمليات التطوُّر النوعي، وإحداث نقلة عميقة في نمط تعاملنا مع واقعنا ومحيطنا.
فالتحوُّلات الاجتماعية والحضارية في أيِّ مجتمع وأمة لا تُنجز إلَّا على قاعدة تغيير ذاتي عميق، يُزيل ركام الانحطاط، ويُهيِّئ النفوس والعقول لاحتضان وممارسة متطلَّبات التحوُّلات الاجتماعية والحضارية المطلوبة.
وعلى قاعدة التغيير الذاتي المستديم تأتي أهمية الإرادة الإنسانية التي هي وسيلة الانتقال من الوعد إلى الإنجاز، ومن القول إلى الفعل.
والإرادة هنا تعني وبكل بساطة: أن تطوُّر الشعوب والأمم لا يقوم به الغير، وإنما كسب الأمة ذاتها هو الذي يُحقق التطوُّر، فعمل الأمة وسعيها المتواصل، وجهدها المستديم، وتصميمها القوي، وإيمانها العميق بمسارها الحضاري، وتضحياتها في هذا السبيل، كل هذا هو الذي يصنع التطوُّر والتقدُّم.
فإرادة الإنسان هي الفيصل، وهي محل المراهنة الحقيقية على مشروعات التقدُّم والتطوُّر.
فلنغُيِّر ذواتنا، ونُغذِّي هذا التغيير بإرادة إنسانية تأخذ على عاتقها إنجاز التطلُّعات وتحقيق الطموحات.
وسنبقى بعيداً عن كل إنجاز اجتماعي وحضاري مادامت قيم التخلُّف وتصوُّرات الانحطاط تتحكَّم في عقولنا ومسارنا العام.
فلكي نتقدَّم نحن بحاجة إلى تغيير نفوسنا وتنقية عقولنا من ركام التخلُّف والانحطاط، وإلى إرادة إنسانية تأخذ على عاتقها -بالنفس الجديدة والعقل الجديد- صنع وقائع الحياة المعاصرة.
ودائماً التقدُّم الإنساني والتطوُّر الحضاري بحاجة إلى إرادة إنسانية صلبة، تأخذ على عاتقها ترجمة الآمال، وإنجاز الوعود، وخلق الوقائع والحقائق المفضية إلى التقدُّم بكل صوره وأشكاله.
وينبغي أن نُدرك في هذا المجال، أن استعارة سلع التقدُّم والتطوُّر لا يفضي إلى المفهوم الحقيقي للتقدم الحضاري، وإنما يُؤدِّي إلى حالة من التجاور العجائبي والتعايش المتغاير بين سلع التقدُّم ومنجزات التطوُّر وممارسة إنسانية لا ترقى إلى المستوى المطلوب في التعامل مع منجزات العصر الحديث.
إن بوابة التقدُّم الحقيقي هي تغيير الذات المصحوب بإرادة إنسانية تُحيل الطموحات إلى حقائق، والآمال إلى وقائع، والأرض اليابسة إلى أرض خصبة خضراء، تُثمر كل الخير والإنجاز إلى الإنسان حاضراً ومستقبلاً.
[1] - برهان غليون، اغتيال العقل، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2012م، ص ص 43-44
[2] - هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، الإنسان ذو البعد الواحد، دار الآداب، بيروت، الطبعة الثالثة، 1988م.
[3] - عبد الهادي الفضلي، خلاصة المنطق، مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ص 14
[4] - راجع: عماد الدين خليل، رؤية إسلامية في قضايا معاصرة، دار أخبار اليوم، الطبعة الثانية، 2017م، ص55