الإيمان اللانهائي الترنيمة الكونية العظيمة
فئة : مقالات
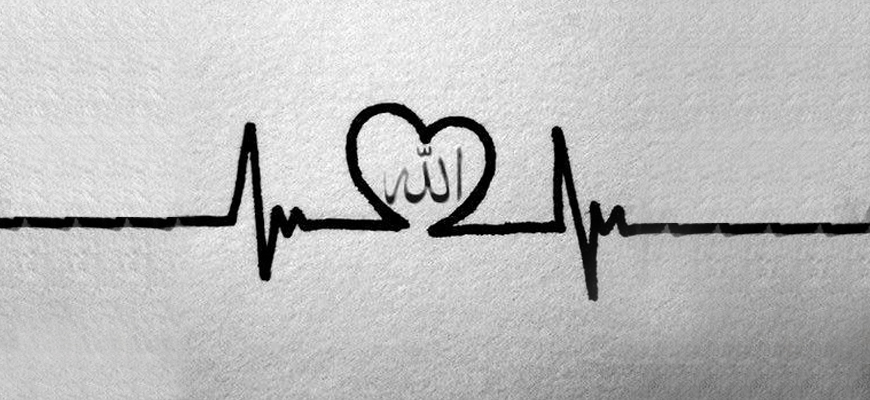
خارج نطاق الذات لا وجودَ لـِ (الإله)؛ أعني أنَّ الله –تحديداً من وجهة نظر الذات الواحدة، لأنَّ أي مقاربة أخرى سَتُفْضِي إلى وجوده خارج هذه السياقية- هو وجود استيلادي لهذه الذات، ولو حدثَ أنْ أزلنا رأس هذه الذات عن كيانها الجسماني لحالَ الله – بالنسبة إلى هذه الذات- إلى سَلْبٍ وجودي، بلغةٍ فلسفية!.
هُنا – بإزاءِ هذا الطرح- سينشأ إشكال معرفي فيما يتعلّق بالذوات الأخرى، ومدى معرفتها بالله؛ فالذات المُؤطّرة لهذه المعرفة من حيث هي تستولد هذا الإله، ومن ثمَّ تُحيله إلى سَلْبٍ –كما أسلفت- في حال انعدامها، ستقعُ ضحية سؤال كبير يُمكنني اختزاله على النحو التالي: هل ثمة قطعٌ نهائي من قبل الذات – أي ذات- بالصورة الكمالية والاكتمالية لـِ (الإله)، التي تخلّقت في منظومتها العقلية، ومن ثم تراكمت تِباعاً حتى غدت أكثر قناعة بمعارفها على حساب معارف الذوات الأخرى فيما يتعلق بالإله، والتعقيب سَلْبَاً على وجوده بالنسبة للذوات الأخرى؟.
هل الله الموجود في عقل الذات الواحدة هو وجود نهائي، وقاطع بالنسبة لهذه الذات، وإلزامي في ذات الوقت للذوات الأخرى؟. وهل يعني إلحاق الله بالذات – أي إخضاع اللانهائي للنهائي- ضرر أنطولوجي من الناحية الإبستمولوجية؟. هل يحقّ للنهائي أن يبتّ في مصير اللانهائي، لا سيما إذا ما وضعنا في الاعتبار مسألة معارف الذات ضمن شرطي الزمان والمكان على محكّ التساؤل؛ فالذات مشروطة بشرط إنساني تراكمي، وحجم المعارف التي يمكن أن تحصلّها الذات، وتتراكم بالتالي مهما قضت من عمر زماني في هذا الوجود، هي معارف محدودة، وغير نهائية؟!. هل يحقّ لأحد ما أن يدعّي امتلاكاً أخيراً ونهائياً، لناحية معرفته بـِ الله، واعتبارها معرفة قارّة تستوجب إيماناً – من قبل الغير- وتصديقاً، بما يقطع الطريق على الذوات الأخرى في استلهام هذا الحضور الإلهي العظيم بين جنبيها؟ أليسَ في ذلك خنق وجودي من نوع ما؛ فالذات إذ تُبرّر لذاتها قبولاً نهائياً بمعارفها، وتُمارس إلغاء بحقِّ الذوات الأخرى؛ فإنها تضع نفسها في نفس الخانة مع ذاتٍ أخرى تمارس نفس الإلغائية؟ ففي نهاية المطاف من هي الذات التي يُمكنها أن تقطع قطعاً حاسماً فيما يتعلق بمعارفها تجاه الله، وتتعدّى ذلك إلى قبول حاسم من قبل الذوات الأخرى بأحقية هذه المعارف وأنْ لا لبس فيها إطلاقاً؟.
زحزحة المنظومة
إذن، والحالُ هكذا، أرى أنَّ أيّة إجازة للذات بتجاوز الحدود فيما يتعلّق بعلاقة الذات بالله إبستمولوجياً، هي خرق أنطولوجي لا تُحْمَد عقباه، إذ لا يتوقف عند حد الإلغائية والإقصائية، إنما يتعدى هذا الشعور إلى استئصال الذوات الأخرى، ووضعها في وضعٍ سياقي غير مُتطامِنٍ لناموس الله، هذا إضافة إلى ما يُمكنني تسميته بالاعتداء على الله ذاته؛ فالذات –أياً كانت- إذ تعتقد أن رؤاها هي التطبيق الأخير للوجود الإلهي بما يستلزم إيماناً به من الآخرين، يعني في واحدةٍ من تدافعاته العنيفة الإعابة – حتى ولو على مستوى اللاشعور- على الذات الإلهية بإيجاد ذواتٍ أخرى غيرها!.
لكن أليسَ في سؤال: لماذا تجشمّت الذوات الإنسانية وجوداً لا زالَ مُتنامياً، رغم التعاقب التاريخي الطويل؟ فضٌّ لإشكال القطع المعرفي من قبل الذات الإنسانية – الذات الواحدة- بمعرفة الله معرفة نهائية وقطعية، لصالح الاندماج ضمن منظومة إنسانية شاملة شاركت – في مجموعها الكلي- في بلورة هذا الشغف الوجودي، ونقله من حالة الكمون والفطرة إلى حالة الظهور والتجلّي العياني الخارجي، عبر سياقات معرفية مُتنامية في العقل البشري على إطلاقه؛ فالمساهمة في هذه المعرفة مساهمة مُتجاوزة للذات الواحدة ضمن شرطها الزمكاني ومُتخارجة عن مرجعياتها، وبذات الوقت مُفضية إلى سياقات انفتاحية تتجاوز المُؤطّر والمُضلَّع والمبتوت به.
هذا السؤال وما يمكن أن يفضي إليه من استحقاق إبستمولوجي على المستوى الأنطولوجي، يصطدم بعقبة ما يُمكنني تسميته بـِ (الأنانية الوجودية) من حيث هي عائق كبير أمام تقدّم الذات الإنسانية الواحدة في مسار ملحمي يُطلُّ على المُطْلَق والخيارات الكبرى ليس من خلال انغلاقات بل عبر انفتاحات. ويبدو أن خيار الأنانية طبع الوجود الإنسي بطابعه – على الأغلب - لذا ثمة تغليب في معظم الأحيان لهذا الخيار الأُحادي على حساب الخيار الانفتاحي، ولقد قاد هذا الخيار على الدوام إلى مذابح مُروّعة، إذ أُدّعيَ في لحظةِ غرورٍ كبيرة بأحقية الذات في البتّ النهائي بالمعرفة الذاتية بأنها الخلاصة معرفةً بالله؛ لذا لا سبيل إلى زحزحتها لا لاهوتياً ولاناسوتياً؛ فالإمكان استحالي هَهُنا، وعلى الذوات الأخرى الخضوع لهذا التبرير طوعاً وكرهاً. وهكذا وصلت البشرية إلى حائط مسدود، إذ عمدت الذات ليس فقط إلى التبرير الأنطولوجي لإبستمولوجيتها فيما يتعلق بالله، بل عمدت إلى استغلال اسم الله، وقتال الذوات الأخرى باسمه العظيم، وصار التدافع على خشبة الخلاص الأخيرة يُفتعَلُ باسم الله، لناحية أن المعارف المتوافرة لدى هذه الذات تستبطن علم الله، وتبتّ في المصائر ليس في هذا العالم فحسب، وإنما في العالم الآخر كذلك؛ فالله –حسب معرف هذه الذات- هو حبيبٌ حَصْرَاً لها، وما عداها من الذوات محض وجود هامشي، يجب أن يقتدي برؤى هذه الذات لكي ينتقل من مرحلة الهامشية والإقصاء إلى مرحلة المتن والاعتراف.
المحنة: الذات الفردية والاستحقاق الإبستمولوجي
لكن، لنلقي نظرةً على التاريخ الإنساني (نظرة شخصية وليس نظرة عرض وسرد لأحداثٍ تاريخية نحن في غنى عنها هَهُنا) ولنُعايِن مدى أحقية الطرح السابق من بطلانه!. إنَّ نظرةً عجلى إلى المدونة الإنسانية المكتوبة ستظهر مدى عدم الخلاص فيما يتعلّق بالمعرفة الذاتوية لـِ (الإله)، بل إن ما حدث يُشكّل في إطاره العام إرهاصاً ملحمياً للوجود الإنساني على هذه الأرض، والتدافع –عند عتبة ما تحت الوعي، على اعتبار أن الوعي الإنساني بإزاء الوجود هنا، والآن أفضى في تجلّيه الأعنف إلى مذبحة مروّعة لا تزال ممارسة طقسها الذبحي ديدناً يطبع الطابع الإنساني في العموم- ناحية إنجاز مشروع المعرفة الإنسانية تجاه أقانيم الوجود الكبرى: الله، العالَم والذات هو تدافع تراكمي انبنائي؛ فالوجود الإنساني إذ يتناسل ويتنامى، فهذا مؤشّر على أنّ المعرفة لم تكتمل بعد، وأن فكرة التدافع قائمة، ولكن ثمة وضع إشكالي آخر قد يتخلّق هَهُنا متمثّلا بالذات الواحدة وانواجدها في الزمن والمكان، ومن ثم صيرورتها إلى فساد وموت و تفسّخ؛ أليسَ في انبثاقها وجوديا –ميلاداً وموتاً، مروراً بتجسّد عياني- وانبنائها في هذا العالَم تنامياً إبستمولوجياً من نوعٍ ما، وإفضاء إلى البتّ في كثير من الأمور الإشكالية؟.
بلى، ولكن لم يثبت للآن أن أفضت ذاتٌ ما – أيّ ذات- إلى نوعٍ من اليقين المعرفي الخلاصي. و خارج إطار الهلوسات السيكولوجية، وما يمكن أن ينتاب المرء المُهلْوِس بإزائها من إدعّاء بامتلاك الخوارق المُستعصية، لم يحدث للآن أن تحوّل السيستم المعرفي إلى ناظم داخلي لذاتٍ ما؛ حيث غدا الوجود، ومسألة إحداث تغيير جوهري عليه، حدثاً خارج نطاق الإحداث الزمني للذات. ولو قُدّرَ لشخصٍ ما انْوَجدَ على هذه الأرض قبل عشرة آلاف سنة أن يستمر في رحلة وجوده إلى الآن، فإنّ معارفه لن تتوقف أبداً، بل ستأخذ طابعاً تراكمياً يتنامى تباعاً إلى ما لا نهاية.
ولكن مِنْ أين لذاتٍ أن تدّعي معرفة نهائية بموضوعةٍ كـَ (الله)، ومُتجاوزة في ذات الوقت إطار المعرفة إلى إطار الإكراه – إكراه الذوات الأخرى- على قبول هذه المعرفة والرضوخ لها، مع العلم أنّ التجربة التاريخية للإنسان في هذا الوجود أثبتت أنْ لا ذات قادرة على الاعتماد على نفسها اعتماداً كلياً، بل هي بحاجةٍ ماسةٍ إلى معارف الآخرين لتسيير أمور دنياها وتعميق إحساسها بالحياة، ومن بابٍ أولى –بإزاء هذه الفجائعية المعرفية الدنيوية- أن تتورّع الذات عن إطلاق أحكام قيمة بإزاء معارفها تجاه (الله)؛ فالفجائعية هَهُنا مضاعفة، فإذا كانت الذات عاجزة عن القيام – لسببٍ أو لآخر- على قدميها إلا بمساعدةٍ من الآخرين، فمن باب أولى أن تُقرّ بعجزها كذاتٍ فردية عن البتّ في موضوعة هائلة كموضوعة الله، ومن ثمّ عدم إكراه الآخرين برؤاها وخلاصاتها حول هذه الموضوعة الشائكة.
الذات الفردية والذات الكلية
لنفترض أن ثمة ذات تمكنت – بمقتضى وجودها هُنا والآن، ابتداء من ولادتها وانتهاء بموتها- من قراءة 20 ألف كتاب، وطافت معظم دول العالم، والتقت بشخصيات من مختلف الحضارات...الخ.
السؤال: هل هذا مُفضٍ كنتيجةٍ ضرورية إلى حالةٍ من الإلمام الكُلّي والنهائي بكلّ شيء في هذا الوجود، أم إنَّ الأمر يحتمل ضرورةً أخرى كنوعٍ من الاستحقاق المنطقي لهذه المعادلة ضمن سياقاتها الوجودية؟ هل هذه الخبرات كفيلة بوضعِ حدّ، والقول: نعم، لقد انتهت المعرفة الإنسانية عند هذا الحد تحديداً، الحدّ الذي وصلت إليه هذه الذات المذكورة أعلاه، أم إنّ ثمة ذوات أخرى – لربما لا تعرف عنها هذه الذات شيئاً- لديها ما لدى هذه الذات من معارف ولربما أكثر؟
ماذا عن: "لاو تسو" و"كونفوشيوس" و"غوتاما البوذا" و"ديموقريطس" و"صن تسو" و"قس بن ساعدة" و"النعمان بن المنذر" و"سقراط" و"المسيح" و"النبي محمد صلى الله عليه وسلّم " و"أفلاطون" و"امرؤ القيس" و"القديس أوغسطين" و"ابن عربي" و"ابن رشد" و"نيوتن" و"ثربانتس" و"ابن المقفّع" و"جيوفاني بوكاشيو" و"ابن جبيرول" و"أسبينوزا" و"فيكتور هوغو" و"غوته" و"نيرودا" و"بوشكين" و"دوستويفكسي" و"هيغل" و"رفاعة الطهطاوي" و"جمال الدين الأفغاني" و"هنري برغسون" و"محمد عابد الجابري" و"محمد أبو القاسم حاج حمد" و"محمد ديب" و"مالك بن نبي" و"علي عزت بيغوبيتش" و"إسماعيل كادريه" و"خالد حسيني"...الخ؟.
ماذا عن كُتبٍ مثل: (ملحمة جلجامش) و(الإلياذة لهوميروس)، (ألف ليلة و ليلة)، (الطب في القانون لابن سينا)، (المبادئ لنيوتن)، (كتاب الموتى الفرعوني)، (المعلّقات الشعرية العربية)، (الجريمة والعقاب لدوستويفسكي)، (محاورات أفلاطون)، (المنطق لأرسطو)، (الرامايانا لفالميكي)، (فن الحرب لصن تسو)، (الطاو: إنجيل الحكمة الطاوية في الصين لـ لاو تسو)، (القرآن الكريم)، (الكتاب المقدس بعهديه القديم و الجديد) (تعاليم الفيدا)، (روائع طاغور)، (اعترافات جان جاك روسو)، (المسيح يصلب من جديد لنيكوس كازانتزاكيس)، (مئة عام من العزلة لغابرييل غارسيا ماركيز)، (الفتوحات المكية لابن عربي)، (قصة الحضارة لـ ول ديورانت)، (جنة الورد للشيرازي)، (رباعيات الخيّام)، (كليلة ودمنة لابن المقفع)، (طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي)، (آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي)، (البؤساء لفكتور هوغو)، (فاوست لغوته)، (العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة لمحمد أبو القاسم حاج حمد)، (الكون في قشرة جوز لستيفين هوكنغ)...الخ؟.
لماذا تعدّدت كل هذه الذوات وهذه الحيوات؟ هل كان من الضروري وجودها أم لا؟ وهل حدث أن بَتّ أحدٌ ما وقال: نعم، إنّ الحقيقة لديّ كاملة غير منقوصة؟ هل كانَ الله بحاجةٍ إلى وجود كل هذه الذوات وهذه الحيوات، لكي يتجلّى في الوجود، إذا كان ثمة ذوات تدّعي أنها صاحبة الحق الكامل والنهائي في تعميم رؤاها ومعارفها – فيما يتعلق بالله- على الذوات الأخرى؟.
هل تصل الذات الباتّة بالمصير الإنساني لناحية معرفتها بالله من عدمه (طبعاً وفقاً لرؤاها) إلى نوع من القطيعة الوجودية مع الله، من حيث هي تُمارِس دوراً ليس ضمن سياقاتها الانوجادية؟ هل يتم التعدّي على حقِّ الله في تجلية نفسه من خلال ذواتٍ عديدة، في حال ادّعت ذات بعينها أنها صاحبة الرؤية الصحيحة والحقيقية لما يتعلق بالمعرفة بالله؟.
إنَّ الظرفية الزمكانية – كما أسلفت- التي انوجدت فيها الذات الإنسانية، إضافة إلى تعدّد الذوات منذ بداية الخلق، لمما يحدّ من غلواء الذات، ويضع معارفها فيما يتعلق بالله على محكّ التساؤل الأنطولوجي والأشْكلَة الإبستمولوجية؛ فمن ناحية مِنْ أينَ لذاتٍ أنْ تبتّ في قضية كانت موضع تساؤل إنساني دائم؟ وللآن، لم يُتوصَل إلى نتيجة قاطعة في هذا الشأن؛ ففي نهاية المطاف هذه ليست معادلة رياضية يمكن البتّ في نسقيتها بمجرد توافر العناصر الأولية، بل هي قضية إشكالية تتخذ طابعاً امتدادياً، تناسلياً في الذهن الإنساني؛ فالله إذ يتموضع في ذهنِ ذاتٍ من الذوات الإنسانية، فإنّه يصير رهناً لمرجعيات هذه الذات؛ أي مرجعياتها المعرفية وخبراتها الحياتية، لذا – من ناحية ثانية- نتجت الأَشْكَلَة الإبستمولوجية على مدار التاريخ بين ذوات تنتمي إلى مرجعيات مختلفة: دينية، فلسفية، غنوصية...الخ؛ فلقد كان ثمة إله للفلاسفة، وإله للمسلمين، وإله لليهود، وإله للمسيحيين، وإله للبوذيين، وإله للملحدين، وإله للعلماء، إضافة إلى انوجاد الله كحالةٍ خاصة بالذات المُستحضرة له؛ فداخل البنية الفكرية الواحدة، ثمة تعدّدية كبيرة وهائلة لتموضعات الله في أذهان الذوات الفردية. نعم، الله هو الله داخل البنية ذاتها كتصوّر عام، ولكنه ذو طابع خاص بالنسبة للذات الواحدة، حتى وإن تقاطعت ذهنياً مع ذوات أخرى في الأسس الفكرية. حتى داخل البنية الذهنية الواحدة لذاتٍ بعينها الله هو تعدّدي ولا نهائي؛ فالذات الطفلة لديها تصورات عن الله تختلف عن تصوّرات نفس الذات لـِ الله، وهي في ميعة الصبا؛ كذا الأمر في مرحلةِ الشباب والشيخوخة؛ فالتنامي الذهني لممَّا يُسهِم في بلورة تطوّرية داخلية في النظر إلى الله.
إذن؛ الله لا نهائي حتى، وهو يتموضع في الأذهان هُنا والآن، وأعتقد أن سبراً للرؤى والتصورات الذهنية الإنسانية – منذ بداية تشكّل الوعي البشري- سَيُودِي إلى ما يمكنني تسميته بـِ (الموضعة اللانهائية)، وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ، فإنما يدلّ على عبقرية الانوجاد الإلهي في الذهن الإنساني، بما يقطع الطريق على أية حدودية يمكن وضعه فيها، وبالتالي عدم إكراه الآخرين على اتبّاع رؤية بعينها، فـَ (الله) أكبر من أن يتم تأطيره ضمن جمجمة واحدة أو جمجمة جمعية محدودة، والانوجاد الإنساني والجماجم الكثيرة –التي تعاقبت وجوداً في هذا العالم- تُسهم في بلورةِ نسق تفاعلي فيما يتعلق بعلاقة الذات الإنسانية بالذات الإلهية، ومدى تعميم هذا الفاعلية على النسق الكُلّي؛ حيث يتحول الوجود الإلهي في الذهن الإنساني وجوداً لا نهائياً ابتداءً؛ فهو إذ يستعصي ذاتوياً ضمن سياق فردي، فإنه يتموضع كصيرورةٍ لا نهائية، تتفاعل داخل منظومتها التفاعلية الذات الإنسانية بما يُؤكّد مدلوليتها – من خلال المساهمة في بلورة نسقية فردية تلتقي في مصبّ البشرية العظيم- في التأكيد على هذا الوجود الإلهي داخل بنائيتها، بما يتجاوز الانطوائية الذاتية إلى الفعالية الحضارية، والتعقيب بما يؤكّد لا نهائية الله من خلال احترام رؤى الآخر وتطلعاته اللاهوتية كما تطالبهم – أي الذات الفردية أو الذات الواحدة- باحترام تطلعاتها.
ورغم أن التجربة التاريخية والروحية للوجود الإنساني في هذا العالم، لا سيما في جانبها اللامرئي قد قامت على الفعالية، فطوعاً أو كرهاً، انْبَنَت الرؤى الإنسانية لله على التعدّدية اللانهائية، وتعدّد الذوات، وتعدّد حيواتها دليل على ذلك؛ إلا أنّ خلافاً حاداً حول الله، لناحية مَنْ هو الأحقّ بالبتّ في معرفته وإكراه الآخرين على اتّباع هذه المعرفة، سيبقى قائماً كما هو الآن، وكما كان سابقاً. ستبقى الحِرابُ على الخواصِر، وستبقى الأيدي على المُسدّسات بانتظار إطلاق الرصاصات من جِرابها الأوتوماتيكي!.
لكن أليسَ لنا أن نتّعظ، ونستفيد بالتالي من هذه التراكمات التي تركها لنا أسلافنا (وأنا أعني هنا كل الكائنات الإنسانية التي تعاقبت وجوداً في هذا العالم)، لناحية فهم هذه التعدّدية، وبالنتيجة سحب فتيل الأزمة الإنسانية فيما يتعلق بالذات الإلهية؟!.
إنّه سؤال برسم الذات، الذات الفردية قبل الذات الكلّية؛ فما ينتج عن ذاتٍ واحدةٍ، سينبني حتماً ضمن تكتّل كُلّي، والمساهمة التي تضطلع بها الذات الواحدة ضمن شرطها الزمكاني هي مساهمة جد مهمة، لناحية أُحاديتها وأنانيتها وقطعيتها مع العناصر الكونية المختلفة في هذا الوجود، أو لناحية اندماجيتها وتفاعليتها وانفتاحيتها على المنظومة الكونية ككل؛ حيث تغدو فاعلة مع العناصر الوجودية من مبتداها إلى منتهاها، لا منفعلة برؤاها بعيداً عن أية سياقات فاعلية.
* معاذ بني عامر باحث أردني






