التأثير المسيحي في تفسير القرآن لمصطفى بوهندي
فئة : قراءات في كتب
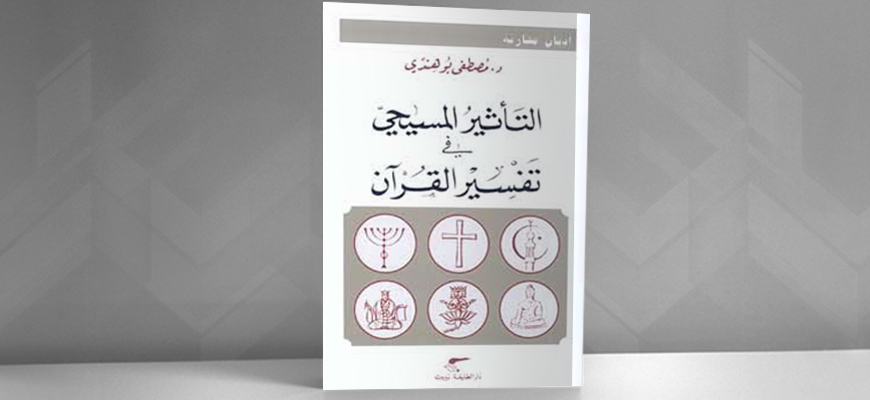
مثَل القرآن الكريم أحد الرّوافد الأساسية التي ساهمت في تأطير بنية عقل المسلم وتشكيلها منذ اللحظة الأولى للنُّزول، وصولاً إلى أزمنة ما بعد عصر الرّسالة، إذ سينفتح النصّ على عوالم جديدة، كانت إيذانًا بانتهاء مرحلة التّفاعل، وبدءِ مرحلة التّوظيف، حيث احتدم الصّراع السّياسي، وتعمّق الجُرح الطّائفي في ذهنية المسلم، وتفرّق النّاس إيديولوجياً إلى الحدّ الذي صار فيه النص القرآني شاهداً على كلّ رغبة، أو طموح، أو نزوع سياسي، أو سعيٍ لسلطة. ومن خلال هذا الدّور الذي اضطلع به النصّ القرآني في وظيفيّته، تشكّلت معالم مدارس فكرية تعددت بتعدّد أبعاد المعرفة الموجودة حينذاك.
هكذا سمح هذا الغنى بظهور مقاربات في تفسير القرآن الكريم، ونقلِ معانيه وبلاغته، وتيسير مفرداته، وشرح أحكامه، وبيان لطائفه وإشاراته، فكان بذلك التفسير الأثري، والفقهي، والإشاري، والنّحوي، والبلاغي، ليتمّ بعد ذلك عملية التّقنين والتّأصيل لعلم التفسير بما يشدِّد الخناق على كلّ الإيديولوجيات غير السّنّية السّائدة حينذاك. لقد كانت القيمة الرّمزية للقرآن الكريم، ومكانته المعرفية والوظيفية كما يسمّيها أركون، مجالاً يتبيّن من خلاله قيمة هذا النصّ بالنسبة إلى العقل الإسلامي قديماً وحديثاً، إلى أنْ استحكمت كما أكّدنا سابقًا الإيديولوجية السّنّية في ما عُرف بأهل الأثر، حيث سيصبح القرآن الكريم مرتهناً بيد الرّوايات المنسوبة إلى النّبيّ محمد، وأقوال الصّحابة والتّابعين. ومن ثمّ يصير النّص التّأسيسي المتجلّي في القرآن هامشيًّا. ويحلّ مكانه المنتوج الثّقافي بوصفه تعبيراً وتجلِّياً من تجليات التفاعل الإنساني مع الظاهرة الدينية.
كان لفشل المقاربة الأثرية تحديداً دورٌ مركزيٌ في ظهور قراءة معاصرة، رفعتْ شعار القرآن، لتعيد قراءته وفق بنيته الأصلية، محاوِلة التخلّص من رواسب الثقافة التفسيرية التي طبعتْ التعامل مع هذا النصّ، متجاوزة لحدود الرواية في تصوّرها، عبْر عملية نقدية تستهدف عرض هذه الرّوايات الثقافية على مضامين القرآن وموازينه ليحدُث التعارض، ومن ثمّة الانتصار لمنطق القرآن في شموليته ووحدته. ظهرتْ كتابات مجموعة من الرّواد في هذا المجال، كجمال البنّا، وأبي القاسم الحاج حمد، ومحمد شحرور، وسامر إسلامبولي، وأحمد صبحي منصور، وكمال مصطفى مهدوي، وسمير إبراهيم خليل حسن، وغيرهم كثير[1]. والغاية الأساسية هنا هي الشّعور بحاجة هذا التراث الفكري الإسلامي في شقّه الرّوائي إلى تنقية وتمحيص، ودراسة تميّز فيه بين الصّواب والخطأ، وبذلك يتحرّر النصّ المحوري من قيْد الحمولات الثّقافية التي أنتجتْها الرّواية بمختلف مستوياتها.
في هذا السياق يأتي مشروع الدكتور مصطفى بوهندي، مستفيدًا من هذا التّراكم الذي بدأ مع هؤلاء الرّواد، محاولاً أنْ يضع القرآن الكريم ميزاناً للحُكم على ثقافة إسلامية لم تسلَم من مؤثّرات يهودية ومسيحية، تسلّلت إلى الثقافة الإسلامية عبْر أدوات التفسير ومناهجه وقواعده وتأصيلاته، واستحكمتْ في العقل المسلم لتغيّب النصّ الأصلي من خلال هذه الآلة التّفسيرية، ليصير مجرّد شاهد على عقائد ومنطلقات وتصوّرات جاء بالأساس لينقضها، فتحوّلتْ إلى أصول عقدية وفكرية سمحتْ بتمريرها الروايات التي كانت أصلاً في عملية التفسير.
إنّ الناظر في مشروع بوهندي الفكري يجده متمركزًا حول ثلاثة محاور أساسية تجلّتْ من خلال مختلف كتاباته: فالأول هو إعادة الاعتبار للعملية التفسيرية، من خلال نزع القداسة عنها، وعدم تحويلها إلى مادة مطلقة، يمكن أنْ تصير قرآنًا موازيًا أو نصّاً أصليًّا، يبعدنا عن تدبر هذا الكتاب، أو احتكار الحقّ في فهمه وتأويله. وهنا كان كتاب "نحن والقرآن" دعوة صريحة للعودة إلى أصول التدبر بدَل التفسير.
الثاني فهو كتاب بعنوان "أكثر أبو هريرة"، وقد كان جرأة فعلية في واقع مغربي محافظ، أراد أنْ يمرّر من خلاله بوهندي فكرة محورية، وهي أنْ لا قداسة للأشخاص، كما القواعد والأصول. فلا يمكن أنْ تحُول بيننا وبين القرآن أيّ شخصية تاريخية، مهْما كانت مكانتها في ذهنية المسلم. فالقرآن أكبر من الأشخاص، والثقافة، والتاريخ، والمفاهيم، والقواعد. وجميعُها صُنع ليخدم أغراضًا أخرى كشف عنها البحث في مضامين النصوص التي نُقلت عن أبي هريرة.
الثالث: وهو علاقة القرآن الكريم بباقي الكتب السماوية الأخرى، ففي هذه العلاقة حسب بوهندي ما يوحي بفكرة الهيمنة التي هي عبارة عن استرجاع نقدي لمضامين هذه الكتب السابقة. وقد تماهى بوهندي مع فكرة المرحوم الحاج حمد بخصوص هذا الاسترجاع، وكشف عنه من خلال بعض القصص القرآني كقصة آدم وموسى وعيسى وإبراهيم، معتمدًا في ذلك على ما يسمّيه بالاقتراح القرآني، أو الإضافة النوعية للقرآن في مثل هذه القضايا، وهي أفكار مستوحاة إلى حد كبير من محمد باقر الصدر وتفسيره الموضوعي.
يعدّ كتاب "التأثير المسيحي في تفسير القرآن: دراسة تحليلية ومقارنة" أحد تجليّات مشروع بوهندي، وقد صدر عن دار الطّليعة سنة 2004، في 321 صفحة. وجاء مقسّماً إلى أبواب، تضمّ بدورها فصولاً ومباحث مختلفة. فالباب الأول كان عبارة عن مجموعة من المقدّمات التي اعتبرها الكاتب خللاً منهجيًّا في علم التفسير. أمّا الباب الثاني فقد ناقش فيه بوهندي مسألة النّبوة والألوهية، كما ناقش في الباب الثّالث قضية أشراط الساعة، ومدى تأثّر المسلمين بالعقائد المسيحية في هذا الشأن.
التفسير الإسلامي ومكامن الخلل:
يبتدئ بوهندي كتابه بالحديث عن مفهومين مركزيين في الثقافة الإسلامية ألا وهما التّفسير والتأويل. إنّ تتبع لفظة التّفسير في القرآن الكريم، يصل إلى نتيجة مفادها، قلّة اللفظ وندرته. إذ لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى "وَلَا يَأْتُونَك بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاك بِالْحَقِّ وَأَحْسَن تَفْسِيرًا" (الفرقان/33). فالتّفسير هنا لا يعني ما ذهب إليه علماء التفسير بكونه بحثًا عن كيفية النّطق بألفاظ القرآن الكريم، ومدلولاتها وأحكامها الانفرادية والتّركيبية. فحسب سياق الآية، إنّ القائم بالتّفسير هنا هو الله تعالى، وليس شخصاً آخر. وهنا يحيلنا بوهندي إلى مسألة أعمق، وهو أنّ التفسير أمرٌ خاص بالله، وإضافته إلى عِلم، أو شخص يثير مجموعة من الإشكالات المعرفية، منها مسألة البيان وكشْف المغطَّى. "فالقرآن الكريم مبينٌ في قمّة البيان غير محتاج إلى بيان خارجي من الناس، وهو مفهومٌ وغير مُغطًّى وغير مشكَلٍ، وميسّر للذِّكر لمن أراد أنْ يذكَّر، وقد نزل إلى عموم النّاس لا خصوصهم" (ص12).
لقد حاول بوهندي من خلال هذا الاستقصاء أنْ يضع القارئ أمام إشكالية المفاهيم، وصناعتها في الثّقافة الإسلامية، وتحويرها إلى وجهات لم تكن مقصودة في بنية النص الأصلي. وهنا يمكن أنْ ندلي بملاحظة في هذا السّياق، وهو أنّ بوهندي كان متأثراً إلى حد كبير بنظرية المشترك اللفظي، حيث تفهم دلالات الألفاظ وفق الدلالة القرآنية، باستقراء ما في القرآن الكريم من صيغ اللّفظ، وتدبّر سياقاتها الخاصّة في الآية والسّورة، وفي القرآن كلّه. هذه الإشكالية المنهجية في مدارسة النصّ القرآني. هي ما سمّاه أبو القاسم الحاج حمد بـ "التمييز بين التوظيف الإلهي للغة والتوظيف العربي"[2]. ففهم مصطلحات القرآن يجب أنْ يكون فهْماً موضوعيًّا يتجاوز النظرة التجزيئية التي طبعَت التفسير بالمأثور، وذلك لا يتأتّى إلا بالاحتكام إلى أسلوب القرآن نفسه، على هديِ التتبع الدّقيق بمعهود استعماله للألفاظ والأساليب داخل سياقاتها القرآنية. ولكنّ صعوبة هذا المنهج هو في وجود ألفاظ لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، فمن أين سنستقي دلالاتها؟ هل من داخل بنية القرآن أم من خارجه؟ وهنا يلجأ الباحث إلى المعاجم لتحديد الدلالة، وبالتالي يلجأ إلى القواعد والبنى نفسها التي ينتقدها بالأساس.
يعرض علينا بوهندي مقدّمات أساسية في التّعامل مع القرآن، سبَقَ وأنْ طرَحها في كتاب "نحن والقرآن":
أوّلاً: القرآن الكريم كتاب مبين لا يحتاج إلى بيان.
ثانيًا: العلاقة مع القرآن هي علاقة تفاعل، أساسها التدبر حسب السياقات والسقوف المعرفية.
ثالثًا: التدبر تجربة إنسانية. وحينما نتحدّث عن تجربة إنسانية، فالمقصود هنا هو قابليتها للخطأ والصواب. وهو ما سمّاه أيضًا بالنسبية في التفسير.
رابعًا: التدبر منهج نبوي.
خامسًا: بين التدبّر والتفسير. فإذا كان ما يطلق عليه الآن تفسيرًا هو بالأساس عملية تدبرية إنسانية، فذلك هو المطلوب، وليس شيئًا آخر.
سادسًا: التّفسير الذي نحتاجه، هو التّفسير الجماعي، الذي يساهم فيه الجميع من منظورات مختلفة، تفتح النصّ القرآني على عوالم جديدة، لا أنْ تمنع البحث في القرآن باسم التفسير.
إنّ المصطلح الثاني الذي يستحقّ من الباحثين التّأكيد عليه حسب بوهندي، هو مصطلح "التأويل". فالتّأويل مثَّل موضوعاً إشكالياً منذ نشأة النصّ الدّيني. وعلى ذلك تأسَّستْ الهرمينوطيقا بوصفها فنّاً لمقاربة النصّ الدّيني. ولو أنّ لفظ التّأويل كان مثار خلاف بين الدّارسين في الحقل الدّيني، بين من يرى بأنّ التّأويل يحمل دلالات التّفسير، كما عنوَن بذلك ابن جرير الطّبري تفسيره، أو هو صرفُ الدّلالة الظّاهرة إلى المجاز لوجود قرينة تفيد ذلك.
لم يكن سؤال التأويل والهرمونيطيقا خاصًّا بالغرب المسيحي، أو القراءة المسيحية للنصّ الديني. فالثّقافة الإسلامية أيضاً قاربت الموضوع من زوايا نظر مختلفة، كان التأويل فيها شيئًا مدنّسًا، وتحريفاً لمضامين النّصوص الحقيقية. بل تجاوز الأمر ذلك إلى تأسيس مدرسة الأثر في مقابل مدرسة العقل والتأويل. وتخاض معارك ضدّ الثانية لاختلافها مع منهج السّلف والصحابة والتابعين. ولقد أشار نصر حامد أبو زيد إلى بعض من هذه الأشياء في مقاربته لموضوع التّأويل[3]. فبالرغم من أنّ لفظ التأويل هو لفظٌ قرآنيٌّ إلا أنّ دلالته عرفتْ اختلافاً كبيرًا بين مختلف الطّوائف[4]. وحينما انتقد أبو زيد بعض القراءات التي شبّهها بالانطباعية، حيث تفتح النصّ على دلالات متعدّدة، اقترح في المقابل طريقة للتّعامل مع النصوص التراثية من خلال زاويتين، الأولى: زاوية التاريخ بالمعنى السّوسيولوجي. والزاوية الثانية: زاوية السّياق الاجتماعي والثّقافي الرّاهن.[5]
ركّز بوهندي في مقاربته مصطلحَ التّأويل على آيات سورة آل عمران: "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ". كما اعتبر الكاتب بأنّ هذا النصّ المحوري، هو أساس الاختلاف بين الدّارسين والباحثين، وعلى أساسه كان الاختلاف في مجموعة من التأصيلات، خاصّة ما تعلّق بالمحكم والمتشابه، والتّأويل، وغيرها من المفاهيم المنتمية إلى حقل التفسير.
إنّ القراءة التّجزيئية لهذا النصّ أفرزتْ لنا أفهاماً مختلفة، لم تراع النّظرة الموضوعية لبعض الألفاظ الواردة فيها. فلفظ الآيات القرآنية لا علاقة له بالمقطع، أو الجزء من القرآن إلا على سبيل الاصطلاح ولا مشاحة فيه. لكنّ الآيات هي المظاهر الكونية المختلفة، والأحداث التاريخية المتنوِّعة، والسّنن الاجتماعية والنفسية المتعدّدة، والأخبار الغيبية الكثيرة، والأحكام التشريعية، والأمثال المضروبة، والمواعظ المذكورة التي تتلى على النّاس بالحقّ في الكتاب (ص30).
أمّا المحكم فينطبق عليه ما يسري على الآية. فإذا كانت الآية تتجاوز ما هو لغوي، فإنّ لفظ الإحكام يتجاوزه أيضًا، حيث يصير الإحكام هو البرهنة التي لا تترك مجالاً للشكِّ أو الرِّيبة أو الوساوس الشّيطانية. هذا الإحكام في آيات الله التي هي دلائله وبراهينه، هو ضدّ المتشابه الذي يتبعه أهل الزيغ والهوى. فمشكلة المشركين ليست في عدم فهم معنى أو دلالة لغوية، بل هي في هذه الآيات المحكمة التي لا تترك مجالاً للشكِّ فيها أو الرّيب. ومن يقرأ سياق البلاغات القرآنية السّالفة الذِّكر، يتبيّن له بوضوح تجليّات هذه المعاني، فالتأويل ليس إلا الوقوع الفعلي لهذه الآيات التي لا يعلم وقوعها إلا الله، والرّاسخون في العلم الذين يؤمنون بما جاءهم من ربِّهم، وهو كلّ ما أنزل عليهم من الكتب السّماوية السّابقة إذا حكَّمنا السياق.
ينتقل بنا بوهندي في الفصل الثاني من كتابه إلى موضوع "النّسخ"، وهي قاعدة من قواعد التفسير المعروفة، والتي تعني "رفع الحكم الشّرعي بدليل شرعي"، وغالبًا ما تستخدم هذه القاعدة عند من يعتمدونها أصلاً من أصول التفسير، لرفْع التعارض بين ما يمكن أنْ يشكِّل للقارئ لبْساً على مستوى الفهم. ولقد عرفت هذه القضية، والالتزام بها وجهات نظر متعددة، تباينت باختلاف منطلقات كلّ باحث أو دارس. فهناك من غالى في وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهناك من توسّط، وهناك من أنكر بالجملة وجود النسخ، واعتبره تشريعًا للتّناقض في القرآن الكريم، وهو ما ذهب إليه بوهندي في كتابه، وقد سبقته أيضًا إلى ذلك مجموعة من الباحثين لعلّ أهمّهم أحمد صبحي منصور في كتابه عن النّسخ، وكذلك سامر إسلامبولي.
لم يكن هذا الغلوّ في نظرية النّسخ ناشئًا من عدم، بل كانت القراءة التجزيئية دوماً هي المنطلق في التأسيس لهذه الأفهام والتوجيهات. كما أنّ الثّقافة الكتابية أثَّرت بشكلٍ من الأشكال في هذه الرؤية، حيث أنّ المسيحيين واليهود قد ناقشوا هذا الأمر، بل كان من المشاكل الأساسية بينهم، حيث أنكر اليهود أنْ يبعث الله بعد شريعتهم والأحكام التي فيها، شريعة وأحكاماً تنسخ أحكامها (ص47).
في الفصل الثّالث ينتقل بنا بوهندي إلى ما سمّاه التّفسير النّبوي، وهو أحد المقدّمات الأساسية في علم التّفسير، بحيث ما من تفسير إلا وأشار في مقدمته إلى أهمية تفسير القرآن بالحديث النبوي، كما أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري وابن كثير وابن تيمية وغيرهم. فالسّنّة حسب هذا الطَّرح هي مبيِّنة لمشكل القرآن، وغامضه. لذلك حاول بوهندي أنْ يقرأ بعض الآيات التي شرحها البعض بآلية التّفسير النّبوي، قراءة يعيد فيها الاعتبار للنصِّ القرآني، وقد اختار لذلك أصحّ كتابٍ حديثي، وهو الجامع الصّحيح للإمام البخاري، للمكانة التي يمثِّلها هذا الكتاب في ذهنية المسلم، وتحديداً الذِّهنية السّنِّية الأثرية. ولنأخذ مثالاً على ذلك ما رواه أبو هريرة عن الرسول حيث قال: "من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثِّل له شجاعاً أقرع ثمّ تلا هذه الآية: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله". فهو استشهاد على قول النبي بالآية وليس تفسيرًا لها، إذ ليس فيها الشّجاع الأقرع ولا غيره (ص90).
ومثل ذلك نجده في تفسير قوله تعالى: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" بحديث أبي سفيان الطويل ورسالة الرسول إلى هرقل والتي ضمّنها الآية، ولم يعن ذلك أنّ الآية كانت غامضة حتى بيّنتها الرّواية، بل إنّ الرّواية قد وردتْ ضمن كلامٍ مختلف عنها إنْ لم نقُل مخالفٍ لها (ص90).
إنّ ما يريد أنْ يصل إليه بوهندي من خلال هذا التّقابل بين الرّوايات ونصوص القرآن، هو التفريق بين التفسير النبوي، والتّفسير بالحديث النبوي. فالأوّل هو عملية تدبّرية تفاعلية قام بها النبي في علاقته بالقرآن، أمّا الثاني فالأمر لا يعدو أنْ يكون توظيفًا واجتهادًا بشرياً معرّضًا للخطأ والصّواب. ومنشأ اللُّبس هنا هو عدم التفريق بين القرآن وما سمّي بالسنة، فالذين يركِّزون على أنّ السّنّة مثل القرآن اعتمادًا على رواية "ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله معه"، يجرّدون النّبي من بشريته حين يجعلون كلّ أقواله وأفعاله وتقريراته حسب تقسيمهم وحيًا من الله، وهو فهمٌ يسلُب الرسول أبسط الحقوق الإنسانية. وهي العقيدة المسيحية في عيسى ابن مريم الذي حسب اعتقادهم حلّ في ناسوته اللاهوت، فصار كلامه وفعله وتقريره كلامًا وفعلاً وتقريرًا إلهيًّا. ولذلك جعلوه ابنًا لله بالروح (ص113).
وفي الفصل الرابع يطرق بوهندي موضوع تفسير الصّحابي، وامتداداته في علم التفسير. فالصّحبة والصّحابة من المواضيع التي أثارت حساسية كبرى لدى مختلف الطوائف الإسلامية، منذ اللحظة الأولى التي توفي فيها النّبي محمد. وعلى إثر ذلك تمزّقت الأمّة الإسلامية فِرقاً وطوائف ومذاهب متناحرة ومتقاتلة، ما زالت تلقي بإشكالاتها على الواقع المعاصر في تجليّاته المختلفة. ومن هذا المنظور اختلف الباحثون في تقويم أقوال الصحابة، وقبولها أصلاً في التفسير. إلاّ أنّ روّاد التفسير الأثري جعلوا من أقوالهم أصلاً ثالثًا بعد تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنّة كما نقل ذلك ابن تيمية في كتابه مقدمّة في أصول التفسير.
والحقيقة أنّ أصحاب هذا الرأي غالَوا في تصويرهم لطبيعة الصّحابة، ومعرفتهم، وأخلاقهم، وحِفظهم، وعدالتهم. فبما أنّهم بشرٌ، فإنّهم تحكمهم كلّ القوانين الاجتماعية والنفسية التي تسري على باقي الخلق. وبالتّالي يصير كلّ حديث عن العدالة والضبط والحفظ، خاضعًا للطبيعة المحدودة للجنس البشري، وهذا ما نبّه إليه بوهندي في مناقشته لهذا الموضوع الحسّاس، الذي استفاض فيه في كتابه الآخر "أكثر أبو هريرة"، خاصّة حين ترفع الأحاديث الموقوفة على الصّحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه. وهذا ما فسح المجال لتمرير مجموعة من الرّوايات التي تحمل عقائد وتصوّرات مباينة للمفاهيم التي جاء القرآن الكريم لتصحيحها، تحت غطاءٍ من قواعد وتأصيلات ساهمت في تكريس هذا المشروع الثقافي.
ملامح التأثير المسيحي في التفسير الإسلامي:
في الباب الثاني يناقش بوهندي موضوع الألوهية في فصله الأوّل من زاوية مسيحية، فيرى بأنّ المسيحيين قالوا بوحدة الأقانيم الثّلاثة والتي هي الأب والابن والروح القدس، وهي جميعها إله واحد. وهي من العقائد التي تمّ تثبيتها من خلال المجامع والكنائس، وليس على مقرّرات الكتاب المقدّس. وقد وقع المسلمون أنفسهم في الخلط بين مجموعة من المفاهيم التي تداولتْها الديانة المسيحية، كمفهوم الروح والكلمة. مع أنّ كلمة الرّوح في القرآن الكريم ومن خلال سياقات ورودها تعني الملَك جبريل، وكذلك الكلمة التي تعني الخلق.
إنّ أخطر فكرة في العقيدة المسيحية، هي فكرة الحلول والتجسّد. وهي فكرة ضاربة في القدم، عرفتْها مجموعة من الدّيانات والمذاهب، وتأثّر بها المسلمون في حركاتهم الصوفية من خلال فكرة التطهّر والفناء، وهو الواقع الذّي أدّى إلى ظهور ما سمّي بطقوس الرهبنة، والإيمان بقدرة الإنسان على الإتيان بالخوارق والمعجزات والكرامات. وهو الأمر نفسه الذي كان يسمّيه محمد عابد الجابري بالعقل العرفاني. فالجابري يميّز بين الأرسطية، وطريقة هرمس (الهرمسية)، ويؤكِّد وجود هذا التّمايز. فالعرفان انطلاقاً من هذا التّمييز الأخير هو النّظام المعرفي الذي ساد العصر الهلنستي بمراحله الثّلاث. ذلك أنّ هذا العصر شهِد رِدّة واسعة ضدّ العقلانية اليونانية فانتشر "العقل المستقيل"، وأصبح طلب العِرفان هاجس العصر كلّه[6].
إنّ ما يميّز العرفان هو الموقف من العالم، والوجود، والإنسان. فالطابع السّائد في هذه المدارس الفكرية هو الهروب، والغربة، والشّكوى، والانزواء، والبُعد عن محاور الصّراع والتّدافع. وبالتّالي الجنوح على حدّ قول الجابري إلى تضخيم العارف لأناه[7]. فما يأخذه الكاتب على هذا النّمط في التّفكير هو رؤيته السّحرية للعالم، حيث يضفي العارف على نفسِه كلّ الصّفات الإلهية المطلقة، وبالتّالي يتجاوز عالم الإنسان، إلى عالم لا يعترف بقيود الزّمان والمكان والطبيعة.
أمّا في الفصل الثّاني فينتقل بنا بوهندي إلى موضوع ولادة المسيح بين القرآن والأناجيل. ويسجّل بأنّ هذه الولادة لم ينقلها إلاّ إنجيلا متّى ولوقا، مع أنّهما لم يذكرا شيئاً عن الوسط العائلي للسيّدة مريم من قريب أو بعيد. وهو تساؤل مشروع، حين نستحضر البعد القدسي لشخصيتي عيسى وأمّه. أما القرآن فقد أشار إلى كلّ ما يتعلق بمريم ووسطها العائلي والاجتماعي، وصولاً إلى مراحل الوضع والنّشأة، والرسالة. والمتتبّع لهذا الغياب يمكنه أنْ يستشفّ عبْر مدارسة هذا الموضوع بأنّ هذا التغييب المقصود من باقي الأناجيل، كانت غايته هو إقحام شخصية يوسف في نسب المسيح، ونسبة المسيح إلى داود، مع الإقرار بأنّه مولود دون أب. وهذه التناقضات وغيرها كشف عنها البحث في نصوص الكتاب المقدّس.
وبالرّجوع إلى التّفسير الإسلامي، خاصّة تفسير ابن جرير الطبري نرى بأنّ الرؤية المسيحية هي التي استحكمتْ في توجيه الآيات، من خلال مجموعة من المواضيع التي شكّلتْ البناء الأساسي لقصّة المسيح في الأناجيل، كهروب مريم بابنها من قومها إلى مصر، والطّلوع به إلى الشّام، والرّسالة في سنّ الثلاثين، والرّفع. وبالرّغم من غياب هذه المواضيع في القرآن الكريم، إلا أنّ هذه التفاسير الأثرية مملوءة بهذه الأخبار والروايات مع أنّها تحمل نفَساً يهوديًّا ومسيحيًّا يخالف التصورات التي جاء على أساسها النصّ القرآني. وهو الأمر الذي امتدّ إلى فكرة وفاة المسيح نفسها. فالكثير من المفسّرين الذين نقل عنهم بوهندي يؤكّدون بأنّ الوفاة هنا ليستْ على حقيقتها. وهو أمر يخالف نصّ القرآن، فهو يؤكّد وفاة المسيح، وانتهاء حياته، وأنْ لا مكان للرّجوع أو العودة، إلاّ إذا استحضرنا المنظور المسيحي اليهودي للموضوع، وهي الرؤية نفسها التي ينهل منها التفسير الإسلامي.
خصّص بوهندي الباب الثالث لقضية مهمّة في العقيدة الإسلامية، وهي ما يسمّى بأشراط السّاعة، وناقشها نقاشاً مستفيضًا يبيّن فيه تناقضات هذه المرويات من خلال المقارنة والتّحليل لمضامينها من جهة، ومن خلال عرضها على آيات القرآن الكريم من جهة أخرى. فبالرغم من تأكيد القرآن من خلال نصوصه المختلفة فجائية السّاعة، فإنّ الكثير من المرويات تجعل لها علامات دالة على قربها، وهو موضوع يفتح الباب على مجموعة من التناقضات كشف عنها البحث والدراسة.
إنّ موضوع عيسى باعتباره شرطاً من أشراط السّاعة كان فيه كثير من التجاوز من المفسرين، متأثرين بذلك بمجموعة من المرويات التي تحكُمها النظرة المسيحية. ولو حكّموا السياقات القرآنية، والتزموا عدم إخراج النّصوص عن دلالتها المقصودة، لأدركوا بأنّ كل ما اعتبره المفسرون شواهد على تلك العقائد، هو بالأساس عملية تحكّم وُظِّف فيها النصّ القرآني لتمرير عقائد لا يعترف بها بالأساس كعودة المسيح أو فكرة المسيح المنتظر. والفكرة نفسها هي ما أشارت إليه بعض المرويات من وجود مسيح دجّال سيظهر آخر الزمان بمواصفات خارقة، تصل إلى حدود الألوهية مع بعض الفوارق. مع عدم إشارة القرآن الكريم إلى فكرة الدجّال، وحضورها بشكل قويّ في كتابات المفسرين، والمحدّثين، ومن اشتغل بعلم العقائد.
عودٌ على بدء:
إنّ ما قام به بوهندي من خلال هذا الكتاب هو جهْدٌ في سياقٍ كبير، بدأه غيره من الكُتّاب والباحثين والدّارسين للقرآن الكريم. وكان هذا الجهد مرتكزًا على قاعدة تفعيل قواعد نقد المتن، وإعادة الاعتبار للنصّ القرآني من حيث هو نصٍّ مولٍّد للمعرفة، يمكن أنْ يساهم في البناء الحضاري لهذه الأمّة الممزّقة ثقافيًّا. إنّه الهمّ والشّعور بأنّنا أمام ثقافة مزوّرة بتعبير النيهوم، وثِقلٍ كبير خلّفته ثقافة روائية امتدّت قرونًا طويلة، واستقرّت في البناء النّظري للعقل الإسلامي. وهذا الجهد أيضًا هو انخراط في السّؤال الفلسفي المثير، والذي طرقته مجموعة من الفلاسفة والمفكّرين والباحثين: كيف نتعامل مع التراث؟
إنّ المدخل للإجابة على هذا التساؤل هو مدخل فلسفيّ إشكاليّ يصعب معه الرّكون إلى توجّه وحيد، أو رؤية، أو تصوّر. وعلى الرغم من أنّ بوهندي حدّد معالم مشروعه، وتفاعل مع هذا التراث تفاعلاً انتقائيًّا. فإنّه ينظر إليه من خلال معيارية النصّ القرآني، ومعيارية الفهم القرآني. وهذا يخلُق في حدّ ذاته إشكالاً معرفيًّا عنوانه التحيّز. فحينما نقرّ بأنّ القرآن هو الأصل، وكلّ ما سواه هو جهدٌ بشري، فإنّنا نقرّ بأنّ فهْمنا أيضًا ينسحب عليه ما ينسحب على الآخرين، مهما كان ملتصقًا به، وبعيدًا عن إشكالات التاريخ.
[1] انظر في هذا الصدد:
الكردي، إسماعيل، (2002)، نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث: دراسة تطبيقية على أحاديث الصحيحين، (ط1)، دار الأوائل، دمشق.
إسلامبولي، سامر، تحرير العقل من النقل.
مهدوي، مصطفى كمال، البيان بالقرآن، على الرابط التالي:
http://www.libya-watanona.com/adab/mmehdawi/mm10046a.htm
الحاج حمد، أبو القاسم، (2004)، جدل الغيب والطبيعة والإنسان العالمية الإسلامية الثانية، (ط1)، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشر.
منصور، أحمد صبحي، القرآن وكفى، ملف pdf، على الرابط التالي:
https://www.goodreads.com/ebooks/download/9374095
البنا، جمال، تجديد الإسلام وإعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية، كتب عربية. دون تاريخ نشر. ملف pdf، ص 435
شحرور، محمد، (2012)، السنة الرسولية والسنة النبوية، (ط1)، دار الساقي، لبنان.
شحرور، محمد، (2000)، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، (ط1)، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ص 60 وما بعدها.
[2] الحاج حمد، أبو القاسم، (2004)، جدل الغيب والطبيعة والإنسان العالمية الإسلامية الثانية، (ط1)، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشر، ص 53
وانظر كذلك: عائشة، عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم، (ط7)، دار المعارف، ص 10
[3] أبو زيد، نصر، حامد، (1994)، نقد الخطاب الديني، (ط2)، مصر، ص 140
[4] انظر ما كتبه بوهندي، مصطفى، التأثير المسيحي في تفسير القرآن، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2004، ص 28
[5] نقد الخطاب الديني، ص 142
[6] المرجع نفسه، ص ص 252-253
[7] المرجع نفسه، ص 255






