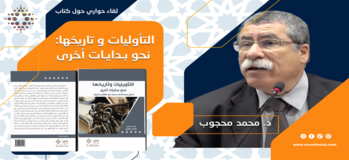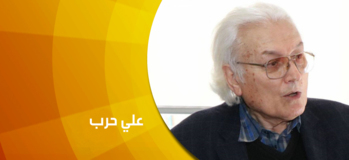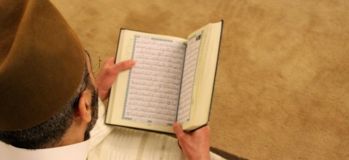التأويليات وتاريخها
فئة : حوارات

التأويليات وتاريخها[1]
"والفكرة التي حركته هي فكرةٌ غايتها الأولى والأخيرة إثارة الانتباه إلى راهنية المسألة التأويلية، والإسهام كلٌّ على قدر استطاعته في تكريم الأستاذ محمد محجوب"
شكرًا دكتور درويش وتحية إلى الحاضرين في بيت الحكمة؛ ومنهم د. محمد محجوب في المقام الأول، كونه معني بهذا اللقاء، وكذلك دة. ميادة كيالي مديرة مؤسسة مؤمنون بلا حدود، وسائر الزملاء من تونس؛ منهم الصديق عماد عماري، وكذلك الصديق والزميل العزيز عبد الله السيد ولد أباه من موريتانيا الحبيبة.
حديثنا عن هذا الكتاب الذي ظهر منذ فترة قريبة في السنة الماضية، والذي دعينا من أجله لهذا اللقاء ينبغي أن يكون مسبوقاً بواجب الشكر، وهذا واجب ضروري؛ أولا لمن يستحقه ممن بادر إلى الفكرة التي بمقتضاها تحقق هذا الكتاب بفضل حرص مؤسسة مؤمنون بلا حدود والقائمين عليها لإنجازه، ثم للتعريف بما تنتج من كتب وإصدارات للجمهور العريض؛ فقد صار عندها الآن طبقة محترمة من القراء، ينتظرون هذه الإنتاجات، ويقبلون عليها إقبالاً جميلا، وكذلك صمود هذه المؤسسة، رغم العراقيل والصعوبات واستمرارها في السنّة التي وضعتها من الاشتغال في مختلف حقول الفكر، لا سيما الفلسفة، وتخصيص جزء من مجهود الدار للمجال التأويلي من خلال السلسلة التي ابتدأت باسم "تأويليات"، ونشرت فيها بعض العناوين التي صارت معروفة ترجمة وتأليفاً، ونتمنى أن تستمر، وكذلك الحفاظ على المجلة الوحيدة التي بقيت تصدر في المؤسسة ورقيًّا على الأقل، وهي مجلة "تأويليات" التي بلغت العدد السابع هذه السنة، ويصدر إن شاء الله في أقرب الأوقات، وهو جاهز تقريباً. وواجب الشكر أيضا لبيت الحكمة، هذا الصرح العريق، الذي استقبل هذه المناسبة الطيبة، التي تساهم بقسط مهمّ في التعريف بالإنتاج الفلسفي والكتاب الفلسفي، التونسي والعربي، ومنه ما هو من إنتاج المؤسسة المحترمة التي هي صاحبة الفضل في إخراجه وصناعته وتوزيعه، ولكن الكتاب أيضا إنتاج تونسي إلى حدّ ما؛ يعني أنه يعبر عن اجتماع كفاءات وباحثين معروفين؛ أكثرهم من تونس، وبعضهم من أوروبا ومن باقي الدول العربية شاركوا بمساهماتهم للاحتفاء بالعمل الفلسفي للدكتور محمد محجوب.
أما فكرة الكتاب ونشأته وبلوغه طور التحقق، فقد عانت في البدء من معوقات كثيرة؛ منها طبعا ما تعرضنا له من انقطاع فجائي في الأثناء لأنشطة البحث والنشر، مع ظهور الجائحة التي ذكرتها الدكتورة الكيالي، وأدت إلى تأجيل المشروع الذي هو في الأصل مؤتمر علمي من المؤتمرات الدورية التي تعقدها المؤسسة بشكل سنوي تقريبا، لاستحالة عقده في الظروف الصحية الصعبة التي مر بها الجميع طيلة سنتي 2020-2021 وقضت في نهاية المطاف بتعليق كلّ نشاط. فكان أن اقترحنا تحويل فكرة المؤتمر نفسها والحفاظ عليها على شاكلة كتاب جماعي يشارك في تأليفه جملة من الباحثين والمفكرين، ممن أرسلوا موافقتهم للمشاركة في المؤتمر. قد يكون هذا الكتاب جزءًا من الظرف الشديد الذي مررنا به جميعا، ولكنه أيضا ذكرى جميلة؛ لأنه اتخذ في الثناء صفة جديدة غير مجرد الجمع والنشر هي صفة التكريم والاحتفاء، الأمر الذي يندر تقريباً في السياق الفلسفي العربي أن يحدث بالشكل الكافي، الذي يحقق مطلب الوفاء لمن علمنا وتقدم علينا بما بذل من الجهد والعطاء؛ هذا الكتاب ربما يكون شهادة على منجاتنا من صراط عبرناه في وقت عسير.
يضاف إلى ذلك أمر آخر مفاده أن الاحتفاء بالتكريم في هذا الكتاب، لا يعني أن عمل محمد محجوب هو مخصص كله للتأويليات، حتى لا يقع في ظن القارئ غير المتخصص أو القارئ الذي يعرف جزئيًّا المنشورات الرائجة في الفلسفة، أن التخصص الذي ينسب إلى محمد محجوب أو أحيانا إلى بعض الباحثين الآخرين من الأساتذة هو أمر نسبي؛ ذلك أن التفكير يمكن أن يتركز، وأن يأخذ وجهة بعينها، كأن يتبع أسلوباً تأويليًّا، ولكن التأويلية في نهاية المطاف ليست بالضبط جزءاً كلاسيكيًّا من أجزاء الفلسفة، هي أوسع من ذلك؛ بمعنى أنها تتصل بمعارف وعلوم أخرى، وفي الفلسفة تحاول أن تفتك لها موقعاً بمحاذاة التخصصات الأخرى؛ فإذن الذي هو غير معروف عند الجمهور، أن محمد محجوب اشتغاله الأساسي هو في تاريخ الفلسفة أولا، ونحن ممن درس هذا الأمر على يديه، ابتداءً بتاريخ الفلسفة القديمة، والحديثة أيضا، وبشكل خاص تاريخ الفلسفة المعاصرة، إضافة إلى اهتمام مواز بتاريخ الفلسفة الإسلامية في نوع من السفر والتنقل بين هذه المجالات بارتياح؛ ذلك ما كنا قد تلقيناه في الدروس والمحاضرات، وتشكلت به نظرة وأسلوب عمل، ربما ليس له نظير بالمعنى الحرفي في المؤسسات الجامعية الأخرى، إلى حد الآن، وعندما ألتقي أصدقاء من الدول العربية المختلفة، دائما ما يشيرون إلى هذا الأمر؛ أعني أن هناك في الإنتاجات الفلسفية التونسية ما يدلّ على روح خاصة في التعامل مع التراث الفلسفي، وهذا يؤثر في القراء وفي الباحثين، ويعطي انطباعات جيدة وثابتة، نلمسها فعلا عند متابعي الإنتاج الفلسفي.
إذن هذه عناصر مدرسة تشكلت منذ فترة طويلة، ولكنها انطبعت بفكرة التأويلية في مرحلة معينة، وصارت هذه الفكرة هي المنظمة لمختلف الاهتمامات الفلسفية، سواء لمحمد محجوب أو للعاملين معه من الذين يشتغلون في الدراسات العليا على رسائل الماجستير وعلى أبحاث الدكتوراه، ثم الباحثين المتقدمين الذين استطاعوا أن يعملوا في ترجمة النصوص أو في التأليف؛ فصارت تقريبا منذ بداية الألفينيات منتظمة في تعليم تخصصي كريس مجال التأويلية في الجامعة التونسية كمجال قائم بنفسه، والذي لم يكن موجودًا في الحقيقة، ولعله غير موجود في معظم الجامعات العربية، سواء في الدراسات العليا أو في التمهيد للإنتاج الفلسفي في هذا المجال القديم-الجديد. صارت هناك هوية شخصية خاصة بهذا النوع من العمل. ولا يخفى طبعاً، أن الأساس في الانشغال بالتأويلية هو دائما مادة فكرية أو تاريخية أخرى تسبقها؛ أعني مثلا فلسفة هايدغر أو الفلسفة الحديثة أو فلسفة أفلاطون أو أرسطو. التأويلية في حد ذاتها ليست لها أهمية إلا بالمادة الفلسفية التي تشتغل عليها؛ فلذلك هي تحمل معها هذه المادة، ولكنها لا تُرى، بل ما يُرى للقراء وللمتابعين هو الصيغة النهائية التي تخرج بها، والتي تنتزعها من مادتها الأولى. أما هذه المادة التي تحملها من خلال ما يسميه محمد محجوب الاشتباك مع النصوص، فلا تظهر إلا قليلا، حيث إن المضمون الأساسي للعمل التأويلي هو مضمون فلسفي (أو غير فلسفي) سابق يقتضي معرفة ثابتة بتاريخ الفلسفة وبتاريخ الفكر، وبالتراث الفلسفي القديم، والتراث العربي الإسلامي، والفكر الحديث والمعاصر.
إنما هي مهمة ثقيلة الحقيقة، وليست مجرد عنوان شكلي يوضع على البحوث كيفما اتفق، وهي مهمة صعبة وثقيلة اضطلع بها محمد محجوب في الجامعة التونسية، وكانت لها سوابق هنا وهناك. وحينما سنحت المناسبة لتكريمه في ذلك الوقت الذي تحدثنا عنه، كانت فكرة التأويلية، في أفق استقبال القراء، هي الفكرة الأنسب والأكثر راهنية؛ لأنها سياق تأليفي أولا، ولأنها جامعة لمختلف البحوث، ومختلف الأنشطة التي اضطلع بها طيلة مسيرته الجامعية. إن الأولية التي تتمتع بها التأويلية يمكن تفسيرها بثلاثة أصناف من الأسباب:
الصنف الأول؛ أن التأويلية لها القدرة على توفير لغة مشتركة بين الباحثين والمفكرين. اللغة المشتركة هي نمط من koine، بالعبارة اليونانية، هي سياق جامع نشأ بالتدريج، ثم صار الآن عنواناً لمجامع فلسفية، وأنشطة كثيرة، ومنشورات أيضا. هذا العنوان ليس تخصصاً دقيقاً جامعيًّا فقط، ولكنه أيضا هو نوع من الإطار الموجه للبحوث ولتكوين الباحثين أيضا، وللإنتاج الفلسفي بالمعنى الحصري؛ وذلك أنه يصعب أن تجد في العناوين الفلسفية المتوفرة في السياق التداولي العربي، ما يمكن أن يجمع مثل الفلسفة التأويلية ونظيراتها؛ أقصد مثلا الرافد الفينومينولوجي الأساسي لهذه الفلسفة، وكذلك المصادر الأساسية من تراث تاريخ الفلسفة الحديثة، وأيضا المدارس المعاصرة القريبة منها: الكانطية المحدثة، الفلسفة التحليلية، النظرية النقدية، النظرية الأدبية، اللاهوت وفلسفة الدين وغير ذلك. هنالك مجال كبير جدًّا واسع يستطيع استقطاب الباحثين وتكوينهم على مستوى رفيع.
السبب الثاني الداعي الثاني؛ أن التأويلية هي عابرة للتخصصات، وعابرة أيضا للفلسفات، وللمذاهب والنظريات، وهي فكر كما ذكر الدكتور درويش في البداية، يحتمل الآخر، ويعطي الحق للآخر. وحين كنت أفكر في الصيغة الأنسب لتقديم هذا الكتاب، وجدت أن القدرة على احتمال الآخر في نوع من التنافس الفلسفي الحر، غير متيسرة دوما للأسف الشديد، من ذلك مثلا ما نراه في كثير من الأوساط الجامعية، من نزوع بعض التيارات الفلسفية إلى إقصاء غيرها. وكأنها توجد من حيث لا تتحمل أن تدخل في نوع من الاشتراك ونوع من التفاعل مع التخصصات النظيرة لها، عكس ما حدث تماما في المجال التأويلي الذي لم يعلن عن نفسه أبدا أنه عدو لأيّ تخصص آخر، ولم يعلن عن نفسه أنه ينوي استبعاد أو إقصاء أي فكر، ولكن هل رأيتم ندوة أو مؤتمرًا فلسفيًّا يكون فيه الجمع بين متخصصين في الفلسفة التأويلية أو الفلسفة الفينومينولوجية أو غيرها، وبين نظراء لهم من التخصصات الأخرى؟ قد لا يوجد من ذلك إلا القليل النادر؛ ربما لأنه ليس هناك تقبل متبادل بين الباحثين في المستوى الأكاديمي بعدُ. فإذن الفكر التأويلي فكر متسامح يرى نفسه جزءًا من الآخر، جزءًا من الآخرين، يتفاعل معهم، ويستمد مادته الأساسية من المناظرة، والجدل، والحوار الذي يقيمه مع المحاورين أو المخاطبين له دوما. أنوه بهذا الشرط الأخلاقي؛ فكأنّ التأويلية أخلاقية أيضا Hermeneutica moralis؛ بالمعنى الذي راج في عصر الأنوار، حيث تنطوي على شروط أخلاقية في التفكير من درجة عليا.
السبب الثالث، هو أن التأويلية فرصة ونوع من العمل يدرب الباحثين والمفكرين على العمل المثابر والصبور، لكونها تتعلق بنوعية صعبة من النصوص، لا فقط النصوص الفلسفية النظرية، وإنما كذلك النصوص الدينية والعلمية والأدبية، وتلك الآتية من التقاليد الفيلولوجية وكذلك مختلف أصناف النصوص المتداولة، فهي تتشابك معها باستمرار. ولذلك، يصعب أن نقف في التأويلية على نوع من التخصص الفلسفي الخالص، وإنما هو تخصص مختلط بغيره بالضرورة، يأخذ المادة من نظرائه أيضا، وهذا يحتاج إلى استعداد وإلى نوع من الحساسية الفلسفية الخاصة.
هذه ملاحظات حاولت من خلالها أن أبين أهمية الانتساب الذي يعلن عنه هذا الكتاب إلى التقليد التأويلي وعلاقته بأعمال محمد محجوب، وهو يفسَّر بهذا السبب لكونه يفكر دائما في توسيع الأفق وفتحه إلى أقصى الحدود؛ كذلك أجد أن الدافع إلى اختيار هذا العنوان الذي طرحناه ليس دافعاً تقنيًّا صناعيًّا، يعني ليس المقصود هو أن يقع تقديم جملة من البحوث في تاريخ التأويلية من طرف متخصصين بالمعنى الدقيق لسبب بسيط ربما؛ لأنه لم تتشكل بعدُ في المجال البحثي العربي، هذه النوعية من التخصصات الدقيقة التي تستأثر بمجموعة من المناهج والتطبيقات على نصوص بعينها؛ فقد يكون هذا الاهتمام موجودًا عند البعض، ولكنه محدود فلسفيًّا. إن المقصود بالعنوان - "التأويليات وتاريخها" - هو إثارة الانتباه إلى راهنية المسألة التأويلية بشكل عام وعلاقتها بتاريخها وكيفية كتابة هذا التاريخ. وقد كنت انتبهت إلى هذا الأمر حينما كُلّفتُ بالاضطلاع بالتدريس في نطاق ماجستير "التأويلية وتاريخ الأنساق" (جامعة تونس المنار - المعهد العالي للعلوم الإنسانية، أسسه وأشرف عليه محمد محجوب) منذ قرابة العقدين من الزمان، ثم الابتداء بكتابة بعض الأبحاث في الغرض، انتبهت إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تأويلية بالمعنى المجرد؛ بمعنى يقرب من الهواية الفلسفية التي تكتفي بالتعامل مع النصوص والأفكار دونما ثقافة متينة من المعارف والعلوم المختلفة. التأويلية دون معرفة لتاريخها لا معنى لها. ولذلك، ذهبت مباشرة في ما أذكر إلى المصادر المادية لهذه الفلسفة: شلايرماخر، المؤسس، ودلتاي، وإلى تقليد المدرسة التاريخية والتقليد الألماني عامة؛ لأنه هو التقليد الأساسي الذي تستمد منه التأويلية أفكارها وفرضياتها ومناهجها؛ فعلاقة التأويلية بتاريخها عنوان عام نموذجي وأساسي. والمداخلات التي نُشرت في الكتاب بعضها نوع من العناية بهذا المحور بشكل مباشر؛ منها المقال الافتتاحي الذي شرفنا به الأستاذ جان غرايش J.Greisch من باريس، الأستاذ السابق بالمعهد الكاثوليكي في باريس، أمد الله في أنفاسه، ولا يزال الآن أحد من الورثة الكبار للتقليد التأويلي الأحياء من تلامذة ريكور؛ وقد شرّفنا بالمقال الذي أسهم به في هذا التكريم، وعلاقته بالدكتور محجوب معروفة، حيث تشكلت بين جان غرايش وبيننا في تونس، علاقة مودة مع هذا الرجل وهذا الفيلسوف المحترم، فكان المقال الافتتاحي في هذا المعنى، في إعادة تفكير حية؛ لأنه كُتب خصيصاً لهذا التكريم؛ ولا أزال أحتفظ بالنص الفرنسي، لا أدري هل نشره أم لا في الأثناء، ولكنه كان في السنتين أو الثلاث الماضية هي خلاصة فكره في نهاية المطاف، وخلاصة تجربته، ورؤيته لمعنى التأويلية ووظيفتها اليوم، ولتاريخها أيضا، حيث نجد هذه المراوحة بين المحاولات التاريخية من أفلاطون صعودًا إلى اليوم، وصولًا إلى ما يقترحه من أنموذج سماه "الوظيفة ميتا"، وهو الأفق التجاوزي للقول التأويلي كجنس أو كتنويع أخير من تنويعات القول الميتافيزيقي. نجد كذلك من المحاولات والاجتهادات الفكرية التي تضاف إلى محاولة غرايش، محاولة فتحي التريكي في الحقيقة وما بعد الحقيقة كإضافة لا من داخل التقليد التأويلي، ولكن من داخل الجدل الراهن حول مفهوم الحقيقة الذي هو مهم في التأويليات، لا سيما علاقته بالخطاب والمعنى، ولكن من خلال ما يعرف اليوم بما بعد الحقيقة على نحو مختلف المابعديات التي صارت من عناوين الجدل الفلسفي اليوم المنبئة بالنهايات. أما محمد محجوب، فقد انتخب لتقديم تصوره لكتابة تاريخ التأويليات معالجة المنظور الإغريقي، حيث تكون التأويلية حسب عبارة ريمي براغ R.Brague "بابا للإقبال على العالم الإغريقي" من خلال نظر هيدغر في مفهوم الحقيقة (آليثيا) كما نطقت في الإغريقية وتقلبت بين مواضع شكلت محور تطورات مفكر الغابة السوداء وممكناً من ممكنات التأويلية الأنطولوجية وتصاريفها من خلال مناقشة المشكل الذي رافقه طيلة حياته حتى في ما بعد المنعطف وما بعد كتاباته الأولى.
إن التفكير مع الفلاسفة المعاصرين انطلاقا من قراءة ومن علاقة حيّة بالفكر اليوناني، أمر يكاد أن يكون مفقوداً تماماً في أيامنا، فإذن الفضل لمحمد محجوب أنه يحافظ على شيء صار نادرًا جدًّا اليوم، وهو المحاورة المباشرة مع التراث الإغريقي، لا على أساس أنه من تراث الماضي المنقضي، بل على أساس أنه جزء من يومنا الفلسفي. أقول هذا الكلام، وأنا أرى الباحثين اليوم في الدراسات الفلسفية من الجيل الشاب خاصة وقد فقد إمكان التعامل، مجرد التعامل، مع التراث الفلسفي، لا القديم فحسب، بل الوسيط، وحتى التراث الحديث صار حضوره باهتاً على حساب الغلبة المتزايدة للدراسات المعاصرة ذات النبرة الهجينة شبه الفلسفية شبه الحضارية والثقافية. وفي السياق نفسه، ساهم عماد عماري في الجدل حول تأويليات الحدثية، هذا الجدل الذي ساهم في إرسائه أيضا محمد محوب بنشر ترجمة كتاب هايدغر الذي هو عبارة عن دروس الفصل الصيفي 1923 بعنوان: أنتولوجيا (تأويليات الحدثية)، والذي صدر أيضا في مؤسسة مؤمنون بلا حدود منذ سنوات قليلة، وشكل حدثا فلسفيا في الحقيقة، لم يُنتبه إليه طبعا إلا قليلا؛ لأن الاهتمام عند المفكرين والمثقفين هو دائما بأشياء أخرى، من الراهن والمباشر والعابر، لا بالأحداث الفكرية؛ أي بالنصوص التي تصنع هذه الأحداث، وأيضا ضاعت منا الفرصة مرة أخرى أن نحتفل بمئوية هذا الكتاب في السنة الماضية، لا أدري إن خطرت هذه الذكرى على بال أحد؛ ففي سنة 2023 تكون قد مرت مائة سنة بعد "تأويليات الحدثية"، هذه الفكرة وهذا الحدس الفلسفي الفذ الذي هو الحدس الرئيس لفلسفة هايدغر الشاب التي أرى فيها شخصيا فلسفته الحقيقية دون ما تلاها.
أما المحوران، الثاني والثالث، في هذا الكتاب، فيتعلقان تباعاً بأمرين لا يتصلان مباشرة بتاريخ التأويلية، وإنما يتصلان بها بطريقة مُداورة، أو بطريقة غير مباشرة؛ الأول هو المحور الذي يتعلق بالنماذج التأويلية بالمعنى الأعم، مثلما نرى في تصور سعيد توفيق، الذي تخير نموذج السيرة الذاتية، وهو نموذج حيّ، وطريقة خاصة في الكتابة وفي تقديم الفكرة الفلسفية، وعرض التجربة الشخصية على شكل فلسفي؛ والأنموذج الثاني هو فكرة "الإبدال" Parasdigm من المنظور الفيلولوجي كما اقترحها محمد الحيرش، في سياق إحياء لتقليد عريق يحتاج إليه الجهد التأويلي بالأخص كعمل على النصوص وعلى اللغة بشكل مباشر، ثم أنموذج "الغيرية" عند عبد العزيز بومسهولي كتجربة فكرية أساسية هي محك حقيقي لمختلف التجارب التأويلية، ومنها الترجمة بوجه خاص. كلها خبرات فينومينولوجية ولكن بعضها تطبيقي مباشر، وبعضها مستأنف من نصوص، وتقاليد ثقافية ومهرفية راسخة.
وأما المجموعة الأخيرة من المقالات، فهي التي سميتها "تنويعات" variations، على النواة التأويلية الثابتة لهذا الكتاب، ولكن هذه التنويعات أتت، إما من باب الحداثة وممكناتها مثل مقالة محمد البوبكري من خلال الجدل بين هابرماس وغادامر مثلا، أو من باب الدين، وهو المقال الذي تقدمتُ به كقراءة في نمطين من "الحديث" عند شلايرماخر: حديث النفس وما يمكن أن يستفاد منه لتأسيس تجربة فكرية جديدة للذات على قاعدة غير ميتافيزيقية وغير مثالية، والحديث في الدين الذي يخاطب به الفيلسوف الشاب معاصريه من منكري العقيدة والإيمان. لا ننسى أن شلايرماخر ليس فقط مفكر التأويلية، ولكنه أيضا مفكر الدين ومصلح اللاهوت في العصر الحديث. أما التنويع الأخير، فهو الذي يرتبط بالمقالات الأربعة الأخيرة، المجموعة في نهاية الكتاب، والمتعلقة كلها بالنص القرآني، إما بتأويلية هذا النص عموما كنص تأسيسي، أو بالتركيز على محور بعينه وقراءته قراءة مباشرة، أو بتطبيق قراءة تاريخية للفرق الإسلامية عليه، وأقصد هنا في المقام الأول مداخلة المرحوم الذي أهدينا هذا الكتاب إلى روحه، رسول محمد رسول، الباحث العراقي الذي فقدناه في الأثناء، وتحدث عن بناء التجربة التأويلية في الإسلام المبكر، أو كذلك من خلال قراءة في القصص القرآني عند فيصل الشطي، ورؤية معاني التأويل وتجلياتها في المتن القرآني كما يفعل عادة صابر مولاي أحمد بطريقته المعروفة، وأخيرًا من خلال معالجة العلاقة بين القراءات والفرق كما قدم ذلك المنجي الأسود في فحص دقيق للحيثيات التاريخية للمسألة التأويلية في الإسلام؛ فقد اشتغل هؤلاء على النص القرآني كبنية أساسية وأصلية للتجربة التأويلية تنظيرًا وتطبيقًا في نفس الوقت.
بذلك، أكون قد أتيت على مختلف مفاصل هذا العمل التكريمي من خلال تعقب الحركة العامة للكتاب، ومضمونه ومختلف محاوره. والفكرة التي حركته هي فكرةٌ غايتها الأولى والأخيرة إثارة الانتباه إلى راهنية المسألة التأويلية، والإسهام كلٌّ على قدر استطاعته في تكريم الأستاذ محمد محجوب، على ما بذله طبعاً من الجهد الذي صار مكسباً للجميع، وما له من الفضل في تأسيس هذا السياق، أو تجديده، وفي دفع العقول والكفاءات الشابة بوجه خاص، للاشتغال عليه.
[1]- الكلمة مقتطفة من الندوة الحوارية العاشرة حول التأويليات وتاريخها، والتي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلاحدود في بيت الحكمة- تونس بتاريخ 24 أكتوبر 2024. الندوة كانت حوارًا علميًّا مع نخبة من المفكرين حول كتاب مهدى لمحمد أبو هاشم محجوب. أدار الحوار د. حسام الدين درويش، وقدمت له الدكتورة ميادة كيالي.