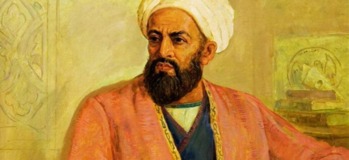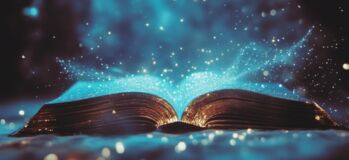التاريخ الطبيعي للدين
فئة : مقالات

التاريخ الطبيعي للدين
لعل أفضل من كتب في التاريخ الطبيعي للدين الفيلسوف الاقتصادي المؤرخ الأسكتلندي ديفيد هيوم David Hume في كتابه التاريخ الطبيعي للدين، وكان بحق أول فيلسوف طرح بشكل شمولي فلسفة طبيعية تناولت جزئيات الفكر اللاهوتي عبر التاريخ من خلال إيمانه أن العقل البشري نسخة مصغرة عن العقل الإلهي السائد في المعتقدات الدينية، حتى وجد نفسه منكراً للفلسفة الإغريقية بوجود الإله المحرك الأول للكون، حتى شرع بدراسة معتقدات العقل البشري وقد أثر في فكره الشمولي في الفلسفة المادية، جون لوك، جورج بيركلي وآدم سميث. أنتقد ديفيد هيوم تعدد الآلهة التي اكتسبت طابع الوثنية، فلو راجع الإنسان تاريخ المعتقدات للفترة التي عاشها المسيح أو قبله، سنجد أن البشرية جميعا اتخذت من الحياة الوثنية طابعا لخيالها العقلي للمعتقدات، فلم يكن التوحيد والربوبية مصدرا إلهامياً. لقد أثبتت شهادة التاريخ على مر العصور السابقة للأديان الإبراهيمية هذه الحقيقة التي سادت في حياة الشعوب، فلم تكن مبادئ الإيمان بإله واحد قد ولدت، لقد كان الجهل ومن خلاله صاغت عقولهم الشكل التعبدي بما تناسب مع حجم التخلف الاجتماعي؛ فالقبائل كانت كلها بربرية، قاسية. لهذا كانت القبائل التي توحدت فيما بينها، وأسست لها لغاتها الخاصة ومعتقداتها الخاصة؛ فالجهل وانعدام القيم المدنية للمجتمعات قد أنتجت شعوباً وثنية، وأنتج الجهل أفكاراً متدينة لها انسجام روحاني مع قوى غيبية شخصت نماذجها في التعبد الوثني، فلقد سكنوا الكهوف والمغارات؛ إذ لم تكن هناك ألوهية صافية تمثلت بكلي المعرفة وكلي القدرة، وكلي الوجود قبل أن يدرك الإنسان وجوده؛ ذلك أن العقل ينمو تدريجياً ويضع التجريد محل المنطق في رسم عقيدة الإيمان، حتى إن العقل كان في تصوره وبعده الإيماني بطيئاً فمن خلال تشكيل فكرة الكمال خضع العقل إلى خصوصيات التعبد الوثني، ولم يكن ربط الكمال فيها قد قدم للعقل البشري ما أنجزه الفلاسفة والعلماء والمفكرون كما قدمه عصر التنوير في أوروبا.
لا شك أن نظام الكون بدقته وقوة صنعه قد دفع بالعقل البشري إلى متاهات المعتقدات الوثنية؛ لأنها رسخت في داخله الإيمان بكمال الكون والطبيعة، فهذا الكمال في سمو الكون ورقيه عبر النظام الراقي كان له التأثير الواضح عندما شكل الفكر الإنساني البدائي بداية معتقداته الراسخة عن الدين.
لقد أعلن العقل الإنساني محنة آدم في مساره الخيالي والفوضوي من خلال جداله مع خالق أو شخصية روحانية فصار العقل البدائي مصدرًا للجدل، هذا الرجل المغامر آدم، وقع بين شخصيتين إحداها للخير وأخرى للشر، إحداها تختبر طاعته، وأخرى تختبر حريته لذاته، كان تفوقاً رائعا للعقل الإنساني أن أنجز على النوع من الخيال الديني الرابط بين الخيال والواقع، بين العقيدة الخرافية والوجود الاجتماعي، كان لابد أن يوجد اتحاد عقلي بين الخيال والواقع أو كما يقال بين العدل والتمرد على القيم، فلا تؤسس معتقدات بلا بديل لمعادلة تنسجها الطبيعة البشرية بين الوجود والعدم في إطار محاكمة العقل لما يمكن أن يجعل القوى الغيبية قادرة على صياغة معتقد يأخذ بها من الإطار التعبدي الوثني إلى الواقع بميزانه المثالي بين الخير والشر.
لا يجيب الدين من أين جاء الإله الكامل في صفاته، ومن أين جاء نقيضه في العالم الروحاني؟ ذلك أن نتاج العقل البشري قادر على صنع شخصيات روحانية تعيش في العقل، لكن لا جذور لها في التاريخ الواقعي للبشرية، هي محاولة استلهام العقل تنظير المعتقد الوثني إلى شخصيات روحانية صنعها العقل كي تؤسس من خلاله النظام الوضعي في الأرض.
بقدر ما مارس العقل من خلال المعتقد الوثني أعطى للوثنية حقها في السلطة لخوارق الطبيعة فهي تسيّر الكون، وآلهة للحرب، للجمال، للشر، للنجوم، للجحيم، وغيرها من تقسيمات قام العقل بجعلها الواجبات الدينية للآلهة المتعددة في أن وضع نظاماً عقلانيًّا للكون. نعود إلى عقيدة الإيمان آدم، لقد كان محوراً وثنيًّا بلا شك، ليس فقط من خلال نتاجه الفريد في المعتقدات السومرية، بل جسّد المعتقد الوثني الرابط بين الأديان الإبراهيمية، أديان التوحيد التي بدأت في بداية عهد التوراة إلى الميول الاعتقادية، ودفعها بسحب السلطات الروحانية للوثنية، من خلال الشخصية المركزية بين الوثنية وعقيدة التوحيد. لا يجيب الفكر الوثني عن أسئلة العقل التي استفاقت فجأة في عصر التنوير. تماما كالروايات الدينية التي انتعشت في عصور التخلف، ثم تحولت إلى أساطير لا قيمة لها في عصر التنوير. آدم المخلوق بأمر إلهي قد أعد له الخالق مكاناً في الجنة، شكل تجريدي يمثل هدف الطاعة والاختبار، لكن هذا الاختبار يسيئ كثيرًا إلى الإيمان بكلي المعرفة؛ أي إلى إحصائيات الغيب الإلهي في المنهاج العقلي إلى مكانة الدافع الإلهي الوثني الذي رسم كمال القدرة ووضعها بمعتقد عقلي في إله يختبر غير قادر على معرفة النتائج. هنا تبرز شخصية تعبدية للإله، تفردت في العبادة المخلصة للإله لكنها شخصية متمردة أظهر الجدل أنها انتقصت من حكمة اختيار الإله لمخلوقه الجديد آدم. لقد تعثر اختيار الإله لمخلوقه الجديد بين قدره المحتوم وتناقضه في علم الغيب، مما جعل الصلوات والأضاحي بهدف شفاعة الأقدار لا قيمة لها؛ لأن الأقدار لا علاقة لها بحب الإله أو بعداوته لمخلوقاته، فالأقدار تقف خارج القدرة الإلهية؛ لأنها تناقض الأفعال الإلهية، فالأفكار الدينية نشأت ليست من تأمل أعمال الطبيعة، بل بما تعلق فينا من آمال ومخاوف وصراعات نفسية وعقلية بداخلنا، حتى استوطنت في العقول القوى الغيبية التي اقترن وجودها في العبادة الوثنية، هكذا استمرت عقولنا معلقة في ترقب شديد بين الحياة والموت، الصحة والمرض، فدوافع الموت كانت تبدو مجهولة ورجاء الإنسان في بقائه حيًّا، وأن حياته البشرية ستعود كما كانت، حيث الرجاء في الأمل وحيث الفكر الإنساني في صراعه مع الوجود والعدم، ماهي إلا صلاة روحانية قد استلقت مفرداتها على المعبودات الحجرية. ابتلى المعتقد هذه العقول البشرية بالتشبث في البقاء كي ترث من الطبيعة البقاء بعد الفناء، وهي عقول لم تخلق لعوالم روحانية، إنما صاغت لنا عقولا لا تدرك عوالم الغيب؛ لأنها نتاج مادي دنيوي تماما كبقية الكائنات الحية عدا هذا الوعي الذي يميز الإنسان بوجوده، عقول تطورت من نتاج بيولوجي صارم لا تستجيب لأي حقيقة غيبية، لكنها رغم هذه الحتمية في محدودية عقولنا، إلا أننا تركنا مساحة لعمل العقل في خيالات الأوهام وزجها عنوة كما فعل المتصوفة والرهبان، الذين عصفوا بعالم الفكر، كي يستجيب مع المعتقد الخرافي، لهذا عجز العقل البشري قاصراً متأملا معاناة القدر، الخوف من الموت وعبث الطبيعة أن خضع إلى قوى غير مرئية حتى صاغت تلك العقول أشكال الآلهة الحجرية على الشكل البشري، هكذا قادتنا العواطف البشرية إلى فكرة القوة الخفية، صياغة أمل البقاء، الخوف كما فعل الإيمان، أعمال الخير كما تلقينا الكوارث والمأساة، تلك العواطف بشرية الصنع، لكنها في العقول روافد خيال ومعتقدات؛ فالإله الوثني كحاله مثل الإله الغيبي لا مجد لا رجاء مضمون عنده، يدفع الحياة للمأساة، دفعنا أنفسنا للمزيد من العبادة والتبجيل، لكن أقدار المتدين والكافر كلاهما سواء، أمام المحن والفقر والنهاية المحتومة، يبقى العقل تابعاً يغوص في الخوف من المجهول متوسلاً كي يرضي قوى الغيب؛ ذلك أن قدرنا يعتمد عليها، رغم أن الكثير من الرجال يخضعون للعواطف الغريزية والميول للنساء؛ فهي دوافع تبين ارتباط العقول بالحاجة للميول الجنسية هي ذاته بحاجة للطواف بالعقول في خيال المعتقد الديني.
لقد ارتبط عالم اللاهوت في الانسجام الكامل بين البشر؛ إذ هيمن على عقولهم بقواه الخفية لكن في بداية التاريخ الاعتقادي لم تتمثل بكائن خرافي واحد، بل بعدة كائنات حجرية حملت صفات بشرية، وأخرى خصائص تسلطية أضفاها العقل البشري للمعتقدات الغيبية، هكذا تدرج العقل البشري بوجود إله أسمى خلق الطبيعة، رغم استحالة التحكم فيها والسيطرة عليها من عواصف وفيضانات وتقلبات بيئية قاهرة، لكن جعل اللاهوت من حال الطبيعة غير المنتظم إلى قوى أخرى خفية، كالأشباح والملائكة، والأرواح الشريرة، لكنها أدنى مرتبة من تلك الكائنات ذات الطبيعة الإلهية. فهؤلاء المتدينون هم نوع من ملحدين يؤمنون بالخرافات ويبعدون الوحدانية في التعبد عن عقولهم، وعندما انتقلوا للإيمان لوحدانية التعبد، تحولوا إلى نوع جديد من الإلحاد؛ ذلك المزيج بين العقول التي صنعت وحدانية العبادة البعيدة عن الأوثان، إلى العبادة التي تحاكم النفس في معتقدات الغيب، فهو نوع من محاكاة أو حوار الذات للذات، من شأنه أن يجعل الرجاء في المعتقد قائماً لا يتغير عند الملحد غير المؤمن والملحد المؤمن الذي تدرج من الوثنية إلى الوحدانية، لكنه لم يغير خصائص الوثنية عن المعتقد اللاهوتي. كان أريستوفانيس Aristophanes من أعظم كتاب الكوميديا الإغريقية في القرن الثالث قبل الميلاد، ومن أهم أعمدة المسرح الإغريقي، نقد تخبط الحكام في عصره متطلعاً إلى أمجاد أثينا العسكرية وانتصاراتها على إسبرطة، لقد هاجم الطقوس والعقائد الوثنية، فامتلك وعياً راقياً وفهماً موضوعياً لمحاربة الخرافات بأسلوب ساخر، ساعيا لمحاربة الوثنية، لقد حارب شعباً معتقدا بالخرافات، لم يتخيل أي وثني يرى أن أصل الكون لا علاقة له بكائنات غيبية خارقة، ومن أجل أن نبحث في أصل المعتقدات عليها أن نفكر أن علماء اللاهوت القدماء اختاروا فكرة التوليد بدلا من الخلق؛ فالوثنية بحسب معتقداتهم امتدت في السلالة الخرافية بين الأب والابن، الأم، والأحفاد، فلقد تطور فيها الحس الخرافي على عبادة أنصاف الإلهة بين الأرض والسماء؛ إذ ذكر الإله حورس Horus إله الشمس في أساطير مصر القديمة رمز الخير والعدل وكان أبوه أوزيريس إله البعث والحساب في العالم الآخر، وكانت أمه إيزيس، انتقل منها الموروث الوثني في العلاقة بين الأم التي أنجبت إلهاً والأب الذي أنجب إلهاً إلى استنباط فكرة التدرج الخرافي في موروث اللاهوت لأنصاف الآلهة؛ أي انتقل الموروث الوثني إلى العلاقة بين الكهنوتي، السماوي والموروث البشري، في علاقة أبعدت عنها التراث الوثني وتحول لموروث بشري؛ إذ انتقد المعتقد الخرافي خلال فلسفة أفلاطون التي مهدت الطريق لقيام العقيدة المسيحية، بين الابن البشري والإله في الموروث السابق للوثنية أن تحول إلى علاقة بين الجوهر والمادة، بين المرئي وغير المرئي. إن فكرة إيجاد منظومة لاهوتية تركن إلى عقل واع يخاطب العقل الإنساني بذكاء متميز اخترعها الفلاسفة، كي تزيل النقص التراثي في العقيدة الوثنية قد وصلتنا بوقت متأخر، إلى عصر هيرقليطس الذي اعتنق نظام نشأة الكون معتبراً النار هي الجوهر الأول، ومنها نشأ الكون فهو المؤسس الأول لعلم الوجود. اعتنق هذا الفكر المادي البعيد عن الموروث الخرافي، فلم يتم اتهامه بالإلحاد. لقد ساد سلطان القدر أو المصير المحتوم، في جميع المراحل الزمنية للمعتقدات الوثنية، حتى انتقلت إلى الأديان التي بدأت التعامل مع الغيب للإله الواعي المجهول، وأبقت إليه عقيدة القدر.
كل من آمن بوجود قوة ذكية فعالة وغير مرئية، لابد أنه قد استنتج إيمانه من خلال التصميم المثير للإعجاب في جمال واكتمال الطبيعة؛ فنماذج الطبيعة أثارت فيه الخيال والإعجاب في ذلك الكائن الروحاني الخيالي، لكن الوثني يؤله كل جزئية في الكون، ويجد لها إلهاً مختصًّا بها، كالشمس، القمر، النجوم، الريح، الماء، الأمطار، النار، حتى صار الإيمان بالطبيعة تركيز انتباه المؤمن الوثني بالمرئيات الحسية، صار عقله يدفع إلى توحيد القوى الخفية مع شيء مرئي. صار إله الحرب عنيفاً قاسياً دموياً، وإله الجمال رقيقاً شاعرا خيالياً يحب الطبيعة، حتى إن صياغات الرسامين والنحاتين في أعمالهم كانت تتجلى قدسية المعتقدات، منتقلة من العبادة الوثنية إلى العبادة في أديان التوحيد. لقد تطور اللاهوت من معتقدات الوثنية في نشوء الحكايات الرمزية في تأليه المخلوقات البشرية بتولد عبادة القائد البطل، حتى بات الذكاء الروحي غير المرئي ليصل إلى مرحلة القداسة، على أن القيادة الروحانية للشخصية المتميزة قد استبدلت الكثير من معتقدات الوهم والخرافة في الربط المثيولوجي بين شخصوها والعالم العلوي.
إن التركيبة اللاهوتية لنشوء الإله الواحد من نتاج عقيدة الآلهة المتعددة انتمت إلى تاريخ قديم؛ فالإله غير المرئي يعود بجذوره إلى القوى السائدة لأسباب غير مرئية، وقد تصادف ظواهر طبيعية غير متوقعة يتم إيعازها إلى قوى خارقة، تماما كوجود الطبيعة في نظامها الكوني قبل وجود الإنسان، لقد نسبت تلك الظواهر إلى الذكاء المتفوق الناجم بفعل العناية الإلهية، فهذا الإله امتلك العقل المطلق تحكّم في الطبيعة والكون، فتأمل العقل في دقة إتقان الكون، دفع العقول في العالم القديم إلى تطوير المعتقد التعددي للآلهة إلى دمجها بإله واحد خبير كلي القدرة، أن الذي ركن إلى أسباب الطبيعة في إيمانه الغيبي للإله الواحد بمجرد أن يكتشف أن الطبيعة نظام لا علاقة له بما تعلمه من إرث خرافي في ربطه بالإله يتداعى إيمانه لكن بمجرد أن يتحول هذا الإيمان إلى برهان على التخطيط والذكاء الخارق، فإنه يعود إلى الإيمان لكن أصحاب التوحيد اعتمد إيمانهم أصلا على مبادئ غير عقلانية؛ لأن نقصها الدليل الاستدلالي ولف ظنونها الخيال والعاطفة التصورية. فهذا الإله لغز لا يمكن حله؛ لأنه تركيبة معتقدات ترسخت في العقول وانعدمت فيها السببية ولا مجال لمؤمن في الاستدلال، بل غلق على عقله باب المنطق والتفسير العلمي للطبيعة. المهم صيانة المعتقد مهما تلظى في خرافيته على أن تبقى طبيعة الإله الواحد ولا تنكسر.
إن تقييد العقل بعقيدة الإله الكامل، القوي المثالي القادر على كل شيء قد أغلق ابواب العقل الاستدلالي، لكن هذا الإيمان يعترض دائما بمحنة العقل في الصياغة والدفاع عن الإله الواحد، فبما أنه المسبب للخير والشر، في الميزان اللاهوتي كان ينبغي عليه أن يكون مغيراً للكون بما يلائم رفاهية العابد، أمنه وسلامة أقداره. لكن هذا الكمال في الفكر الإلهي افتقده الله في عدم حماية المؤمن به من الكافر بوجوده؛ فكلاهما خضع لقانون الطبيعة الصارم، فصار الفاسد ينال من نعيم الحياة، وكثيراً ما يكون مصير المؤمن الفقر والمرض وقساوة الاقدار. فلا حماية ولا اتصال بين العابد والمعبود. إذا افترضنا أن الإله غير المرئي كامل بسرّه بوجوده الظني، واختفائه عن العقول، فإن عبادته لا يفترض أن تحط من شأنه ككائن مقدس، لكن كون الطبيعة البشرية تجسد إلهاً تابعاً، فهو يتخطى التأليه كما هو الحال في مريم العذراء ارتقت من كونها امرأة يهودية إلى انتزاع الصفات الإلهية للإله الكلي القدرة. فهي أم الله في المعتقدات المسيحية حين وضعت الطبيعة الإلهية والبشرية في امتزاج عقائدي واحد تمثل في يسوع المسيح؛ إي إن الإله غير المرئي أعاد هيكلة وجوده اللاهوتي إلى الطبيعة البشرية، فسار بين الناس ومات على صليبهم ودفن إلههم في مقابرهم ثلاثة أيام؛ إذ فقد حكم العالم، مع ذلك بقي الكون يدور في نظامه الكوني، رغم موت الله. رغم أن طبيعة المسيح البشرية للتأليه لم تكن مناسبة، إلا أنها ليومنا معتقد راسخ الجذور في العالم المسيحي، هكذا استحدث الوهم من خلال خلود الروح وخروجها من الجسد، وانبعاثها من جديد، حالة ميتافيزيقية هي التي تمنح الجسد الحياة، عنصر الخير عكس الجسد عنصر الشر، وتنتقل من الأموات للأحياء كما عبر عنها سقراط. إن مصير الروح تنتقل من الموت للحياة في جسد آخر عند الولادة، وأن روح الفيلسوف ستعيش بسعادة مع الآلهة، هكذا تحكمت التفسيرات الظنية وطورت منهاجها العقلي في التراث الاعتقادي للغيب، فصارت الأرواح مسكن العقائد الوثنية وعقائد التوحيد في اليهودية، المسيحية والإسلام، كان الإله بعل إله العواصف، حكم الأرض والسماء في الشرق عبدته شعوب الأرض عند الكنعانيين، والفينيقيين، كان يعني الحياة لهذه الشعوب فلقد تحكم في أرزاق الناس، تحكم في المطر، والحصاد، ظهر كإله محارب؛ إذ حارب إله البحر وإله الموت، فلقد تم بناء هذا الإله على مذابح مخصصة له للحصول على بركاته، لقد كان من أهم الآلهة الوثنية في أساطير العالم القديم؛ إذ كان الإله السيادي للكون، لكن العقل البشري الذي أسس الفكر الوثني كان له ميل طبيعي للارتقاء من الوثنية للتوحيد، فالكثير من أصحاب العقول الذين طوروا المنهج الاعتقادي الوثني إلى التوحيد لم يطوروا تأملاتهم العقلية إلى ترتيب جسم النبات والحيوان والإنسان إلى التطور البيولوجي في الطبيعة، فلقد وجدوا سعادتهم بالاعتماد على قوة سرية استغرقت في عقولهم عشرات العقود، فكان الإيمان بغير المرئي وبكل أسف، سبيل العقول لأشياء تراها العيون، فصار المجهول في عقولهم السبيل الأكثر إقناعاً فيما وقعت عليه حواسهم، فهذا هو أصل الدين بين الوثنية والتوحيد. سعادة الإحساس بإله غير مرئي مثير في الوقت ذاته للقلق من قسوته، من ناره ومن جبروته، فهو إله ذكي يقبع في الغيب المجهول في عالم لا تدركه العقول، فهي التي أنتجت للغيب الروحانية حتى في أجسادنا، أنه استنباط ذكي بين وكلاء تابعين للإله غير المرئي هؤلاء أنصاف آلهة أو كائنات وسيطة؛ فهذه الأديان بكل انفعالاتها العاطفية في النهاية تنهي نفسها ومازال العقل البشري يجره الإيمان من إله روحاني كلي القدرة إلى إله جسدي محدود، يتكلم، وقد أعد أدواته في عالم الغيب، يدفعهم إلى ملكوته العالي، من الصور العقلية غير المرئية إلى إله كامل لا محدود خالق للكون، وباسط سلطانه في قدرية اختارها العقل لهذا الإله؛ إذ شاء بعلمه المطلق أن يحيط مصائر عباده قبل خلقهم، لتكون إرادته مطلقة اليقين فيما اختاره من مصير حتمي للبشرية، فعليها أن تؤمن كما أراد الله، وقد رصدت سورة الأعراف القرآنية حالة مصيرية كهذه، في أنها عبادة لمصير محتوم، فأخرج من صلب آدم كل ذرية نثرها بين يديه فكلمهم، استخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق، وهم مازالوا في العدم. أن تكون مسيّراً بإرادته ومخيراُ بعلمه، وما عليك إلا قبول محنة العقل كما أرادها لنا أصحاب العقول الأولى في التاريخ أن نصنع إلهاً نريده على قياس مصيرنا؛ لأننا لم نجد لوجودنا معنى إلا بالتناقض الذي سلب حقائق الوجود وأعطانا الغيب، فكل ما فيه من مزايا سلبية لإله واحد سريع الحساب، أن يستبعد عنا كل شي غير عقلاني.
إن الأديان كلها تلك التي دافعت عن وحدانية الله لم تتسامح مع الخطأة، فهي إما أن تزيل وجودهم بالموت او تحرقهم بالنار، أو تدافع عن وجود الله لقتل الآخرين لإثبات وجوده، هكذا فعلت الزرادشتية أن غلقت أبواب السماء في وجه غير الفرس، فهذا الإيمان بإله عالمي للكون، نزعة اجتماعية إلى حد أننا نجد القسوة والكراهية في أصحاب المذهب الديني المشترك بين الطوائف، وكما غرست الأديان في مزارع الآخرين بذور الحقد كما هو الحال بين الكاثوليك، البروتستانت، الأرثوذكس، تمثلت ذلك في اليهودية، والمذاهب الإسلامية بين سنة وشيعة، بين أقباط ومسلمين؛ إذ مهما كانت قسوة الصراع الديني بين الشعوب همجية ودموية، فهي عادة تكون لصالح الإله البعيد، حيث يبقى خالداً في نظامه المقدس الباقي حتى موتنا غير مرئي.
ماهي فواصل العقل البشري وأهميته بين التوحيد والشرك؟ إذ وهب العقل البشري من الصفات للإله الوثني وإله التوحيد، ما لا يمكن أن يحيطه العقل في الخيال والقدسية، لأي مصدر كوني آخر غيره، رغم ذلك فإن المخاوف البشرية في صناعة الوهم كحقيقة تجعل العقل البشري يتدنى إلى أسفل درجات الخضوع والذل، عندما يتعلق الأمر بقمع الشهوات، لكن عندما يدرك العقل الإنساني أن قدراته أسمى، يتراجع إيمانه بالغيب ويركز في وجوده الذاتي أن عقله يفوق العقل الإلهي في تحديه وطموحه، في فتوحاته العسكرية كما فعل الإسكندر المقدوني في أكبر إمبراطورية وجدت في العالم القديم، وذو القرنين؛ إذ تركزت الألوهية في إحساسهم الذاتي والغلو بقدراتهم. صار تأليه الحاكم في مصر الفرعونية، انتزاع صفة أنصاف البشر، فلم تكن هذه الألوهية مجرد محاولة تأمل، إنما تعبير عن عقيدة تطورت عبر السنين، فصار الجبابرة يفتنون بقدراتهم الحسية، فكانوا يرون أنفسهم الأحق بالعبادة، فنشوء الألوهيات البشرية تاريخ قديم ناجم عن خصب العقل في خياله واستحداث كائنات خرافية وثنية، إله غير مرئي، جبابرة بشرية، وأنصاف آلهة إلى عهدنا الحديث في التوحيد، فهذه الأديان كلها عملت على اختلاس العقول تنوع فيها أشكال الوهم. إن الأديان الإبراهيمية التي ورثت المعتقدات الوثنية وطورت ما فيها من عوالم لاهوتية شواهد «ما ذكره هيرودوت أيضا بأن الفرس في زمانه كانوا يؤلّهون ظواهر الطبيعة ويعبدونها، منها النار فهي إلهتهم ... فالفرس يعتقدون أن النار إله، ولذلك لا يحرقون موتاهم وأن تقديم جثة الميت إلى إله إثم ... هذا يعني أنها ديانة تؤله الشمس، وتدعو إلى عبادتها، سواء سميناها المجوسية، المزدية، أو الزرادشتية»(1) فانتقال الفكر الوثني، وعبادة الكواكب، وأحداث الطبيعة ثم انتقاله لعقيدة التوحيد، إنما يمثل سعي الفكر البشري منذ فجر البشرية إلى الإيمان بالمعتقد الغيبي، وإن تبدلت مظاهر الإيمان به. إن ظهور فكرة التوحيد المطلقة وتشكل المنظومة اللاهوتية بما احتوته الأديان الإبراهيمية ظهرت آفاتها في الخيال الديني منذ عهد المعتقد الزرادشتي، عندما «عمد الله بمشاركة الروح القدس سبينتا ماينو إلى إظهار ستة كائنات قدسية ... يستعين بها على مقاومة الروح الخبيث أنجرا ماينو ... وقد شارك هؤلاء الخالق فيما تلا من أعمال الخلق والتكوين وصاروا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه وبين العالم، ثم إن هؤلاء قد أظهروا إلى الوجود عددا من الكائنات القدسية الطيبة المدعوة بالأهورا ... يعمد الشيطان إلى مهاجمة العالم ... ولكن عدوانه سيؤول إلى خسران في نهاية الزمن، ويحسم الصراع لصالح الخير»(2) إن التركيبة اللاهوتية للعقيدة الزرادشتية تركت بصمات عديدة ومحطات لفكر ديني متقدم لنظام لاهوتي لوحدانية الإله الذي حكم العالم في الأديان الإبراهيمية، فالكائنات المقدسة ومقاومة الروح الخبيث، بما يستدل به عقيدة الشيطان وما تسبب فيه من صراع بين الخير والشر، كلها تفسيرات متشابهة إلى حد تصبح المقارنات بين الوثنية والعقائد الغيبية ووحدانية الإله جسر واحد مشى فوق أطيافه العقل البشري على مدى التاريخ الديني. «التعددية ليست في الحقيقة تعددية، إنما هي توحيد متنكر في شكل تعددية، هناك إله واحد فقط، الرب براهما الخالق، الرب فيشنو الحافظ، والرب شيفا المدمر، والربات ساراسفاتي ولاكسمي وبارافاتي (زوجات براهما وفيشنو وشيفا) والرب غانيش الإله الفيل والمئات الآخرون، كلهم ليسوا سوى تجسيدات أو تقمصات متعددة للإله الواحد»(3) ومن تلك الأرباب في تعددية الإله، نشأ الاعتقاد الغيبي لتوحيد التعدد في شخصية إله واحد، في أن الأصل في التعدد حرب القوى الشريرة التي جسدها الشيطان وحرب القوى الخيرة التي مثلها الله، وهما معاً وقعا في شباك العقل الاستدلالي العلماني في عصر التنوير، ولقد عرض في مفارقات تناقض الثنوية الكونية بين الرحمن والشيطان، ما يجعل العقل يستعيد مكانته الكونية، فهذا الحوار الذاتي بين الخير والشر بين الله والشيطان قد جلب لنا من التناقض المنطقي والعقلي ما يمكن الوقوف عنده، حيث وضع رجال الدين جميعهم في قوالب الزمن الثابت، وفي النصوص التي لا تقر بوجود الزمن الفاعل في تاريخ الشعوب. «كان الناس يحكمون على كل من لا يعتقد بالخرافات الوثنية الأكثر مدعاة للسخرية بأنه ملحد وغير تقي، لأي غرض ... مثل أي لاهوتي في الوقت الحاضر بالميل إلى الشك العام في عصره، لكنه يشجبه بعدئذ بشدة، من يستطيع أن يتخيل، أن المعتقد الخرافي الوطني الذي استطاع أن يضلل رجلا عبقرياً، لن يفرض على عامة الناس؟»(4) فهذا استدلال واقعي ناطق لحركة التاريخ، أن صناعة المنظومات اللاهوتية في أزمة قديمة كانت تفسر كعقائد يقينية، الخارج عنها متهم بالإلهام بالإلحاد، قد تحول المعتقد التعددي، في تاريخه الحالي الميل إلى إنكار الوحدانية؛ فبالرغم من ذكاء النصوص وتناقضاتها التي حكمت العقول في الأديان الإبراهيمية، عشرات العقود قد ران عليها الزمن، وأصبح من زوّرها اللاهوتي مهزوزاً منكسراً أمام تحولات العلم وتقدمه البارع أمام محنه الفكر الديني. تناقض الحوار الإلهي مع الشيطان نسخة تاريخية قديمة امتدت إلى آلاف السنين، ندرج خلاصتها أنصافاً للتاريخ الإنساني؛ إذ فيها من الأخطاء ما لا يمكن للعقل المعاصر التغاضي عنها؛ ذلك أن الوثنية والأديان الإبراهيمية في توحيد الإله يربطهما تاريخ لاهوتي مشترك، رفض الشيطان السجود لآدم بصفته مخلوقا من نار، عكس آدم الذي خلق من تراب الأرض، بسبب خلاف الله مع الشيطان رمى الله الشيطان في نار جهنم. رواية غير منطقية؛ ذلك أن الله يعلم الغيب، فرفض آدم كان ضمن العلم الإلهي فالله الذي قدّر على الشيطان رفض أمره، ليس هناك سبب لسجود إبليس لآدم، فلم تكن هناك منفعة للطرفين، صار رفض السجود وغضب الله عليه غير ذي معنى لإله عالم للغيب، رغم غضب الله لآدم استجاب لطلبه أن يبقيه مع ذرية آدم إلى قيام الساعة، فهذه الاستجابة دللت على تناقض الحكمة الإلهية في ميزان عدله، ثم إن إبليس كيف علم أن البشر سيكون لديهم يوم للقيامة، وأن ذرية آدم تسفك الدم؟ كيف عرف إبليس أن آدم سيكون له أبناء وأحفاد؟ هل كان إبليس مطلعاً على الغيب؟ فتاريخ إبليس يدل ضمن «خيال الإنسان الأسطوري وملكاته الخرافية ... لا أريد أن أتكلم عنه بصفته كائنا موجودا وحقيقيا، إنما أريد دراسة شخصيته بوصفها شخصية مثيولوجية أبدعتها ملكة الإنسان الخرافية وطورها وضخمها خياله الخصب. عند التفكير بموضوع إبليس أجد نفسي واقفاً وجها لوجه أمام تراث بيولوجي ديني عريق في قدمه وتاريخه»(5) فهذه الديباجة اللاهوتية في النصوص تكمن في كون السرد الديني للواقعة رمزاً لا في كونه وصفاً حقيقياً لأحداث وقعت فعلاً في تاريخ هذا الكون الواسع. لقد امتد تاريخ العقائد بين الوثنية والتوحيد إلى المعتقدات التي نقلت البشرية إلى عوالم الكون إلى الأعالي بمعراج أخنوخ «لمعراج محمد صلة كبيرة ومباشرة بمعراج أخنوخ ... فهناك العديد من ادعى صعوده للسماء مثلا ماني مؤسس المانوية، زرادشت ادعى عروجه للسماء كذلك إيليا والمسيح»(6) احتلت معارج العقائد الوثنية والأديان الإبراهيمية في علاقة الإنسان الصلة المباشرة بين الوثنية والتوحيد في تاريخ امتد إلى عشرات القرون في تاريخ البشرية، فلقد اقتبست المسيحية سلطة إبليس الخرافية، وأدخلتها ضمن معتقداتها اللاهوتية «ثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ إلى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ. فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أن تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا». فَأَجَابَ وَقَالَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ.»(7) لقد اقتبس لاهوت المعتقدات الإبراهيمية من جذور الوثنية، وأسس منها خياله في التوحيد، وقد وقعت محنة أيوب هي الأخرى، أن الله طرد إبليس بسبب خلافه بعدم السجود لآدم، لكن الله أعاده للملأ الأعلى، كي يختبر إيمان أيوب طالبا من إبليس أن يفعل ما يشاء بأيوب شرط أن لا يميته، ففي العهد القديم والجديد، موروث مثيولوجي موغل في القدم مثله الشيطان كذلك في الإسلام حتى صار الإله الإسلامي وموروث معتقد الشيطان أنهما باتا يمثلان وجهان لعملة واحدة، حتى إنهما اشتركا في تزيين أعمال السوء ففي النص القرآني: «أن الذينَ لا يُؤمِنُون بالآخِرةِ زَيَّنَّا لَهم أعمَالَهم» ورد النص المقابل للشيطان « – «وَزيّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ مَا كَانوا يَعمَلونَ» استعمال المفردات نفسها استدلال واضح لخيال العقل البشري للنص الديني، أن التاريخ الطبيعي للأديان امتداد مثيولوجي حافل بالمعتقدات، وسيبقى العقل البشري ينوء بحمله الثقيل إلى قيام الفكر المستنير ليؤسس حضارة علمانية تقوم بفصل المعتقدات التراثية للموروث القديم، ليتم تأسيس مجتمع قائم على الواقع وليس على الخرافة. إن التفسير الحاسم لجدلية تعدد الآلهة وعقيدة التوحيد منذ فجر الوعي الديني في «هور الديانات المقارن كشف عن حقيقة مهمة هي أنه بينما تتضمن كل الديانات وجود علاقة واعية بكائن يدعي «الله» إلا أن إدراك هذا الكائن يختلف باختلاف الديانات، فأحيانا هو واحد، وأحيانا هو كثرة من الآلهة، مرة هو جزء من الكون المادي، ومرة أخرى هو كائن روحي، أحياناً له شبيه أو ظاهر في كل شيء في السماوات من فوق أو على الأرض من تحت، في الحيوانات وفي البشر، لا يمكن تشبيهه ... قد يكون إلهاً خاصاً بأسرة معينة من البشر، أو بأمة من الأمم أو بكل الجنس البشري.»(8) إن مسعى اللاهوت طريق طويل موغل في المعتقدات، وقد صاغت شخصية الله الجسر الواصل في متاهات العقول بحثاً عن مسار يصل فيها بين مجاهل الغيب وواقع الطبيعة. لقد أبدع العقل البشري عبر تاريخه الطويل من التعدد في الوثنية، والتعدد في بشرية الألوهية إلى الوحدانية المطلقة أن نصل فيها إلى استنتاج أن كل تلك المعتقدات سارت على طريق الإيمان الظني بحثاً عن الله، حتى دفعت لروحانيته في التوحيد صراع الشعوب وقد أن الأوان أن يجد العقل البشري في المنظور الديني كائنا مفترضا تـأسس من أفكار الديانات البدائية، كما نادت به الديانات السامية، في كل تطور مراحله عبر التاريخ معتقد بقي راسخاً في عقول الملايين، مازال ليومنا هذا موضوعاً للعبادة في بعض تجلياته للعقول البشرية.
المصادر:
1 - خرافة النبوة والوحي والتوحيد في الديانة الزرادشتية، أستاذ خالد كبير علال، دار المحتسب، الجزائر، 2015، ص 136
2 - الرحمن والشيطان، الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ، فراس السواح، مؤسسة هنداوي 2017، المملكة المتحدة. ص 57
3 - وهم الإله، ريتشارد دوكنز، ترجمة بسام البغدادي، تحرير نور الهدى ووفاء البحري، ستوكهولم 2019. مؤسسة ريتشارد دوكنز للعقل والعلم. ص 34
4 - ديفيد هيوم، التاريخ الطبيعي للدين، ترجمة حسام الدين خضر، طبعة أولى 2014، دار الفرقد للطباعة والنشر، دمشق، سورية. ص 97
5- صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، طبعة ثانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1970، ص 83
6 - باسم عبدالله، نقد الفكر الديني، بين النص والواقع، ستوكهولم 2020، basim abdulla www.academia.edu ص 104
7-إنجيل متي، الاصحاح الرابع، الفقرات 1-5
8 - دائرة المعارف الكتابية، حرف الألف تحت اسم «الله» دار الثقافة، مجلس التحرير دكتور القس صموئيل الحبيب، دكتور القس فايز فارس، المحرر وليد وهبة، ص 374