التاريخانية والمقدس: قراءة في كتاب "السنّة والإصلاح" لـ"عبدالله العروي"
فئة : قراءات في كتب
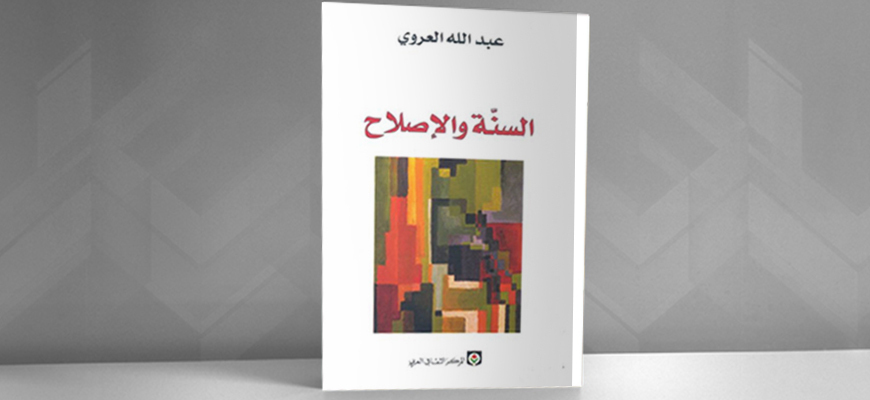
التاريخانية والمقدس:
قراءة في كتاب "السنّة والإصلاح" لـ"عبدالله العروي"*
ليس التأويل السني للقرآن معطى ميتافيزيقيًّا بل وجد وسيظل ضمن زمان ومكان تاريخيين. فقد ظهر هذا التأويل في بيئة صحراوية اقتضت من قاطنيها مزاولة التجارة دون الفلاحة، كما ظهر في سياق مجتمع تتشكل وحداته الأساس من قبائل وعشائر وأسر فاعتبر التأويل السني عمادًا لاستمرار توازن هذه الوحدات، وأخيرًا وجد هذا التأويل في سياق ثقافي يشكل الشعر ركنه الأساس، وخلفية فكرية "هلنستية" لا يمكن التنكر لها. وبهذه المعاني مجتمعة يعتبر التأويل السني للقرآن ظاهرة تاريخية. تلك هي الأطروحة الأساس لكتاب "السنّة والإصلاح"، أطروحة من شأن بحثها توسيع دائرة الوعي التاريخي بالقرآن.
- السنّة، القرآن والتاريخ:
1- السنّة والقرآن:
إذا كان لابد من تحديد مبتغى كتاب "السنة والإصلاح" نقول إنّ مقصده هو وضع التأويل السني للقرآن تحت مجهر التاريخانية لإبراز البعد التاريخي لتأويل يضفي على نفسه طابع القداسة. فالتأويل السني معطى تاريخي، لذلك تكون مهمة التاريخانية هي بحث شروط الإمكان التاريخية التي كانت خلف ظهوره. نحن هنا بصدد الكشف عن الشروط المتناهية لما يقدم نفسه باعتباره لامتناهيًا، مقدسًا. من هنا، لا يخلو الأمر من مجازفة ترافق كل بحث يركب مغامرة اللقاء مع المقدس ومراجعته، لاسيما وأنّ الفهم السني دأب على تقديم نفسه باعتباره رديفًا للمقدس الإسلامي الذي ما يفتأ يكشف عن نفسه بطرق مختلة من خلال حضوره السوسيولوجي والسياسي القوي إلى حد احتوائه لكل ما هو مدني.
يوحي عنوان الكتاب بأنّ أيّ فهم جديد للقرآن يمر حتمًا عبر مساءلة الفهم السني. لذلك انصب اهتمام العروي على النص السني باعتباره نصًّا رديفًا، نصًّا عبره بلغنا التأويل الأساس للقرآن. لقد ساد الكتاب المقدس، اليوم، وعبر التاريخ بوصفه تأويلاً للسنة إلا أنّه كأي تأويل يعبّر عن مضمون اجتماعي محكوم بمصالح، إنّه مفعول للتاريخ حيث السنّة نفسها مفعول للحدث.
علاقة السنة بالقرآن، فيما يرى العروي، تتمثل في أنّ السنّة شكّلت نصًّا على "هامش" النص المقدس إلاّ أنّ هذا النص الموازي ليس نصًّا ثانويًّا، بل إنّه النص الذي يقدّم نفسه بوصفه فهمًا قطعيًّا للقرآن. هنا يظهر وكأنّ المفعول أقوى من فاعله، يظهر النص السنّي نصًّا فاعلاً للنص القرآني، ففهم القرآن يتمّ بدالّة السنة بوصفها سلطة تأويل. تبيّن العروي أنّ "النص الأصلي" خضع لتحويل شامل ضمن "النص الفرعي"، استأثرت السنّة بحق التأويل فكان لا محيد للعروي عن مواجهة السنة وذلك عبر تجذير الوعي التاريخي بظاهرة القرآن.
يبدأ الوعي التاريخي بالقرآن من تناوله بوصفه ظاهرةً تاريخية، أي ظاهرةً برزت في التاريخ وعبره نشأت، نشأت حيث التفت السنّة على فعل نشأتها وتطوها عبر التاريخ. لذلك تكون مقاربة القرآن على خلفية التاريخ بمثابة لقاء مع السنّة، إلا أنّه لقاء تحت رحمة التاريخ ومكره. من هنا يكون التاريخ مطلق المطلقات إنّه شرط القرآن والسنة، به نستعين لفهمهما باعتبارهما يعبران معًا عن ظاهرة المقدس الإسلامي وهو في غمرة التاريخ.
تقدّم السنة القرآن نصًّا فوق التاريخ والحال أنّها صاغت تأويله تحت ضرورات تاريخية. تنفي السنة ضرورات التأويل وتجعل من تأويلها قراءة خالصة مطابقة لروح النص، ترفض أن تكون قراءتها مجرد تأويل وهي بذلك تنفي أن تكون طرفًا في حرب التأويلات المدفوعة بالحدث التاريخي. توجد السنّة تحت نداء التاريخ وتفعل كما لو أنّها سيّد التاريخ، مبتغاها أن تكشف عن نفسها باعتبارها جماعة دون انتماء اجتماعي وأنّ تأويلها محايد بل أنّ مشروعها إلهي.
تدّعي السنة أنّها جماعة ترهن مصيرها بالسماء لذلك تقدّم نفسها على أنّها فرقة ناجية وحدها كفيلة بحفظ مطلق المقدس، القرآن. وسيلة السنّة في حفظ المعنى المقدس الرواية الشفوية، لكن "الرواية الشفوية اختزالية بطبيعتها، كل سنّة ترتكز على تاريخ مبتسر"[1]. الرواية الشفوية قفزة على التاريخ من أجل حقيقة "حول" التاريخ. وهي مبتسرة لأنّها انتقائية تقول ما يناسبها وتقصي ما عداه. تسعى الرواية الشفوية إذن إلى اختلاق تاريخ على هواها متمنّعة بذلك على قبضة التاريخ الفعلي، تمكر به فتنسج إيديولوجيا تتحكم فيها مطامح الذات لا منطق الوقائع.
بعملها ذاك حقّقت السنة تضخيم الأصل ليرتقي إلى ما فوق التاريخ ويتجاوز منطق الحدث، فالقرآن لاتاريخي وبذلك أصبحت السنّة نفسها فوق التاريخ والمجتمع معا. تتبنى، مبدئيًّا، أنّ التاريخ مجال الناقص فتخشى على المقدس من الدنيوي، وعملاً بهذه الحديّة تشكّل التاريخ كما تريد. إنّ السنّة لاتنفلت من قبضة التاريخ تمامًا، فهو ما يكشف عن انتسابها الاجتماعي وإيديولوجيتها الخاصة، لذلك تجد السنّة أن لا مفر من مواجهة التاريخ الفعلي بالتاريخ-الرواية الشفوية. تاريخيًّا نجحت السنة في ذلك حيث فرض أشراف مكة فهمهم للتاريخ. ففهم الأشراف فهم شريف. إنّه ليس تأويلاً بل محايثة لروح النص، روح متجانسة لا ينال منها التاريخ لأنّها وحي أي معطى فوق تاريخي.
تعيش السنة في التاريخ وتنسج آخرَ، تتنكر للأول وتذيع الثاني. تلك صيغتها في مواجهة الخصوم، الخوارج والشيعة الذين واجهوها بالمنطق نفسه، لذلك يقول "العروي" إنّ "الشيعة سنّة معكوسة"[2]، فهما معًا تأويلان في صلب التاريخ ضد التاريخ. هنا الأمر على خلاف ما اعتادت البحوث الأكاديمية والدراسات المتخصصة حيث التقابل الصارم بين الشيعة والسنة.
السنّة سنّة، تقليد وتكرار للّحظة المطلقة، تماه مع لحظة الوحي. هكذا تتجاهل السنّة شروط إمكانها هي لأنّها تتجاهل الزمن، تنفي الزمن بوصفه تقدمًا لشروط الإمكان لتحصره في تكرار عهد الرسول، إنّه تكرار يعاند تقدم الزمن، يكابر حيث التاريخ لا محالة صائر سائر. تجهد السنّة كي تظهر بمظهر المجدّد الشرعي الوفيّ للمقدس وذريعتها في ذلك أنّها جماعة الرسول، جماعة تستلهم الحق من مصدره قبل أن يفعل التاريخ فعله فيه، بل لكي لا يتمّ للتاريخ ذلك يكون التقليد هو جهد السنّة الأساس، فالتقليد توقيف للزمن باعتباره تقدمًا للتاريخ وانفصالاً عن الأصل.
تابعت السنة مسيرتها، عبر التاريخ، في نفي التاريخ وضمن كل تمظهراتها يكشف التشخيص عن أعراض متشابهة. فمن الجماعة إلى المتكلم والفقيه هناك إلحاح على البقاء خارج الحدث، أمر يتأكد في صيغة علاقة السنة بالقرآن. فهي، من جهة، تستحضره نصًّا مقدسًا وتنزع عنه، من جهة أخرى، كل طابع ملغز يرافق ظاهرة المقدس بما هو كذلك. تضفي الجماعة إذن، البداهة على ظاهرة القرآن وبالبداهة نفسها تسيّج وجودها الاجتماعي، فهي تحصر ما حدث فيما تناقلته الرواية الشفوية أي مطلق المعقول الديني إذ ما كان ليحدث إلا ما حدث وعلى نحو ما حدث. هكذا أصبحت الفاهمة معطلة والتقصي نشازًا.
بلغت الأطروحة السنّية ذروتها في القرن الخامس الهجري حيث "في نهاية القرن الخامس الهجري لم يعد يوجد عندنا فكر ليس له تقليد خاص به، يخضع له خضوعًا تامًا...فلم يعد مجال لأية مناظرة صريحة متعمقة مفيدة"[3]. ترسّخ مفهوم التفكير باعتباره عودة مطلقة إلى أصل يلزم تحيينه باستمرار مع ما يرافق ذلك من معاكسة لسيرورة الزمن ومعاندة لقدر التاريخ، ولعل هذا الحدث الذهني الممانع للحدث التاريخي هو تكثيف أساس لمفهوم السنّة، فالسنّة هي رجعة الفكر دون رجعة والنتيجة هي تفاوت إيقاع الحياة الذهنية مع إيقاع الحياة الفعلية وهو ما يعكسه اليوم التفاوت بين الذهنية والسلوك. ظل هذا التفاوت يغطي تاريخ الثقافة العربية فهي في التاريخ فعلاً، لكنّها تعمل على نفيه ذهنيًّا ودليلها على ذلك السيرة النبوية كما تناقلتها الرواية الشفوية. يلاحظ العروي أنّه في كل لحظة من التاريخ يعمل رجال السنّة على تشذيب "كل ما علا وظهر، أو فاق وفاض وتعدّى، وكل ما لا يقف عند حدّ معلوم..."[4] ذلك أنّ الحدّ المعلوم هو مكارم الأخلاق كما صاغتها السيرة النبوية.
تشكل السيرة النبوية نواة الإيديولوجيا الفقهية التي تتكثف ضمنها الأطروحة السنيّة مما يقتضي حفرًا في المذاهب الفقهية، حفرًا يكشف عنها وهي في غمرة التاريخ بوصفه مجالاً لصراع المصالح والأهواء، إذ وحده ذلك كفيل بالكشف عن الخاصية الانتقائية للذهنية السنيّة التي تسعى بنهجها الارتكاسي إلى تخليص المقدس من شوائب الدنيوي "المدنّس". لذلك سارع العروي إلى وضع الحلقات الأساس للإيديولوجيا الفقهية ضمن سياقها المدني الذي هو سياق التاريخ حيث تتبدى دعاوى الفقيه في صميم الشرط التاريخي وإن كانت تكدّ من أجل رفض التاريخ.
لقد تعذر على السنة تبيّن الآفاق المسدودة التي يمكن لذهنية ارتكاسية أن تنفتح عليها بفعل معاندتها للتاريخ، وهذا ما أصبح متكشّفاً منذ "ابن حزم" حيث "تراجع الرأي لصالح الحديث...تراجع العقل لصالح النقل... وتراجع الباطن لصالح الظاهر"[5]. ويضيف العروي مستخلصًا: "هكذا نرى حقولاً معرفية واسعة تهمل تدريجيًّا الواحد بعد الآخر أثناء مسيرة تراجعية دامت سبعة قرون"[6]. إنّ "ابن حزم" إذ عمل على ذلك فهو يبتغي المكر بالتاريخ، إلاّ أنّ مكر التاريخ أشدّ وأقوى ذلك أنّه "عند ابن حزم نرى الثقافة تدعو إلى الأمية، الذكاء يدعو إلى البلادة، الطموح يدعو إلى الخمول، التفنن يدعو إلى البساطة، النباهة تدعو إلى الغفلة، اليقظة تدعو إلى السهو، إلخ"[7] وليس هذا كله غير تلك النتيجة المشينة لمعاكسة حركة التاريخ: التخلف.
حيث تشيع الذهنية السنيّة معاداة التاريخ ويكون التخلف نتيجة طبيعية، فالتقدم وإدراك منطق التاريخ سيّان. تلك هي خلاصة التاريخانية بمعناها عند العروي الذي سبق وأن شدّد على الأمر التالي: "أذكر هنا بأنّني أطلقت اسم التاريخانية على وضع ثقافي معين، وأنّ هذا المفهوم لا علاقة له بما يعرف تحت هذا الاسم في الموسوعات الفلسفية"[8] ثم يضيف: "التاريخانية ليست اختيارًا فلسفيًّا وإنّما هي وصف الواقع"[9]. هكذا تتشكل التاريخانية بوصفها فينومينولوجيا لظاهرة السنّة، فينومينولوجيا يتكشّف من خلالها أنّ تشارط السنّة والتخلف هو بمثابة تحصيل حاصل.
تنسج السنّة تاريخًا إيديولوجيًّا على هامش التاريخ الفعلي، هو تاريخ إيديولوجي بقدر ما يعاند التاريخ الفعلي وينفيه. لذلك لم يفت "العروي" تسجيل الملاحظة التالية: "السنة تكوّن مستمر في كل من أطوارها تتأثر بحادث وتعمل آليا على طمسه" لكن الحدث أشمل وأقوى "الحدث، هو الآخر مزيج من المصادفة والضرورة"[10]، فلا شيء ينفلت من قبضة الحدث، ماهية التاريخ. توجد السنّة، إذن، في التاريخ ولأنّها تصرّ على نفيه فهي تظل على هامشه، لكنّه الهامش الذي تتأكّد من خلاله حيث أنّ "كل سنّة تتقوّى بإخفاقاتها"[11].
يحلّ التاريخ بوصفه حدثًا فتسيّجه السنّة بأحكام قيمة مستوحاة من لحظة خالصة تعلو التاريخ لتصحّحه، إنّها لحظة الرسول كما تناقلتها الرواية الشفوية. الحدث في عرف السنّة مؤامرة الدنيوي على المقدس، والحل هو العودة إلى الأصل والتذكير به. هكذا يكابر أشراف مكة لتأكيد استثنائهم في وجه منطق التاريخ، مكابرة لها ما يبررها كما يستنتج العروي: "بما أنّ أشراف مكة لايزالون يتمتعون بالجاه والنفوذ، لا لسبب غير عراقة النسب، فمن الطبيعي أن يتشبثوا بمفهوم الإرث التقليدي"[12]. لا تنشغل ذهنية السنّة بغير التميّز من خلال العودة والتشبّث بالتقليد، فذلك شرط بقائها واستمرارها.
كل عودة خالصة إلى أصل خالص هي عودة تتضمن فهمًا لاتاريخيًّا للتاريخ. هذه الخلاصة يتعذر بلوغها على السنّة وعلى ما تطاله قوتها، وهي بالفعل طالت كليّة الثقافة العربية. إنّ الذهنية السّنية بفعل نزوعها الشمولي لا تتوقف عن تسييج مسارات الفكر والحياة ومراقبتها، فكل ما يبدو لها زيغًا نفته ولعل ذلك ما نفهمه من قول العروي بشأن "ابن حنبل" سقف السنة: "ننتقل من مئات إلى آلاف الأحاديث، متفاوتة الصحة، لأنّنا بحاجة إلى أن تطال السنة كل حوادث الحياة البشرية العامة والخاصة، إذ المسلم، في رأي ابن حنبل، هو من يعيش باستمرار تحت نظر خالقه وبالتالي من تنعكس في حياته صورة ما من حياة الرسول"[13].
تقابل ردّة الفقيه على التاريخ بردّة مضاعفة من التاريخ، فبعدما كان "أبوحنيفة" رائد مدرسة الرأي يستجيب لمقتضيات الحدث أصبح "ابن حنبل" رائد مدرسة الحديث يحكّم مبدئية الحديث على الحدث. ولأنّ الحديث رواية شفوية لا يخلو توضيبها من أغراض خاصة فهو اختزالي انتقائي يروم الكيد بالحدث، بمنطق الضرورة الذي يشرط مكارم الأخلاق نفسها كما يعرضها الوحي. هذه العلاقة الجدلية بين النفي والإثبات، نفي السنة للحدث من حيث هو في الوقت نفسه شرط فعلها الإقصائي وشرط إثباتها، هذه العلاقة هي مقصد العروي من قوله: "تؤسّس السنة بالرفض والإقصاء وتنتعش وتنمو بالانتقاء والتزكية"[14] ثم يضيف: "تتصف عقيدة السنة بخاصيتين: الجدل والنفي. وبذلك لا تستطيع الانفصال عن ظروف نشأتها. ما يثبتها هو بالضبط ما ينقصها، حالاً ومآلًا"[15]، وهذا وذاك هو التاريخ باعتبار الحدث ماهيته الأساس.
يغيب عن السنة أنّ الانتقاء إغفال للتاريخ سياقًا ضروريًّا لسرد الوقائع الإنسانية، فهو سياق لا سبيل إلى تغييره، إلاّ أن إغفالها له لا يترتب عليه إغفاله لها ففعلها بوصفه إقصاءً للتاريخ يتحدد بالتاريخ نفسه إذ التاريخ باعتباره سياقًا للضرورة هو أصلاً هنا قبل قرار السنة. لذلك فما يشغل العروي هو إعادة الاعتبار للوعي التاريخي من حيث هو وعي بإيجابية التاريخ.
يبحث كتاب "السنة والإصلاح" تاريخ الإثبات والنفي. فقد تراوحت اختيارات الثقافة العربية بين نفي التاريخ والقبول به، وفي كل مرة تخطو فيه الثقافة العربية نحو مصالحة التاريخ يواجه تقدمها ذاك بنزعة نفي التاريخ وتلك كانت الوظيفة الأساس للسّنة، إنّها "رفض عنيد للحدث"[16] ولفكر الحدث. لذلك كانت رفضًا عنيدًا للمعتزلة على مستوى علم الكلام ورفضًا لأبي حنيفة على مستوى الفقه ورفضًا للفلاسفة على مستوى الفكر.
مثّلت المعتزلة موقف مبدئية الحدث وانتهت إلى تأسيس الدين على الأخلاق، كان مبتغاها في ذلك توحيد المجتمع على أرضية أوسع تتجاوز حدود الدين، كانت تريد إمكان الاجتماع وإن لتعدّد ملل وأديان لذلك لاحظ العروي أنّهم "كانوا يرمون إلى أن يوفّروا... إيديولوجيا حسب تعبير العصر توافق ميول المسلم وغير المسلم وإن أدى الأمر إلى إغفال جانب من النص القرآني وذلك باللجوء إلى قدر من التأويل. الهدف الأبعد سياسي بالدرجة الأولى هو تحقيق العدل، المساواة بين الفئات المختلفة والتوحيد، توحيد المجتمع..."[17] فباستجابة المعتزلة لنداء الواقع أعلت لواء التأويل الذي لا يعني غير إخضاع النص للواقعة.
إنّ نجاحات المعتزلة هي الوجه الآخر لإخفاقات السنّة لكن ولأنّ "كل سنّة تتقوى بإخفاقاتها"[18] كانت المعتزلة فرصتها لتأكّدها الذاتي والنتيجة أنّه في "متمّ القرن الثالث الهجري انتصرت السنّة على الاعتزال. لكن هذا الأخير لم يختف كليًّا"[19]. تفسخت وشائج الارتباط بين المعتزلة والتاريخ، أصبح المعتزلة هامشًا فألزموا بالحضور من خلال لغة مجردة وهذا ما يرمي إليه قول العروي: "ساد المعتزلة لمدة قصيرة ثم تاهوا في منعرجات عدة..."[20]. التّيه عند العروي فصل للمفهوم عن شروطه المادية، عن التاريخ باعتباره وقائع مادية، عن الحدث تكثيفًا للتناهي. هكذا، عندما يسأل المعتزلة السؤال التالي: "ما العدل الإلهي؟يتعلق الأمر أصلاً بالعدل البشري عدل الخليفة العباسي..."[21] تدير فرقة المعتزلة معركة سياسة بلغة دينية مخافة مراقبة السّنة وعقابها.
حيث تسود روح الاعتزال تستنفر السنّة قواها فلم تقض السنة على المعتزلة فقط بل على امتداداتهم، على وجودهم بوصفهم ظاهرة ثقافية. وتعكس بعض أقوال "أبي حنيفة" حربًا ضارية في مجال الفقه بين الرأي وأعدائه فقد كان يصف خصومه من أصحاب الحديث على النحو التالي: "أعلم الناس بما لم يكن وأجهل الناس بما كان"[22]. تعبّر شدّة ردود "أبي حنيفة" عن شدّة الانتقادات القوية التي ووجه بها من قبل الجماعة والسّنة، فقد اعتبر ممثلاً لموقف الاعتزال في مجال الفقه، ونعرف أنّ السنّة رموا المعتزلة أحيانًا بالزندقة وأخرى بالكفر، رأوا فيهم جسر الخطر الذي يداهم النص من ملل أخرى دخيلة.
تسارعت ضربات السنّة لأبي حنيفة ولمدرسة الرأي عمومًا فرجحت كفة معاداة الواقعة التاريخية من خلال إخضاع التاريخ للنص باعتباره معطى فوق تاريخي فاكتمل مذهب السنة مذهبًا شاملاً للفقه والكلام، للثقافة العربية وذلك ضمن المذهب الظاهري الذي يقول بشأنه العروي: "المذهب الظاهري هو التنظير الأقوى والأمتن لموقف السنّة وهذا الموقف هو خاص بجماعة معيّنة، نخبة اجتماعية وسياسية"[23].
لم تكن نشأة موقف السنة نشأة تصاعدية. لقد ظهر حينًا وخبا حينًا آخر وهو بذلك يعبّر عن علاقة توتر ظلّت ومازالت تعتمل في صلب الثقافة العربية إذ النصرة منذ قرون هي في صفّ السنّة، فقد "تجدّدت الحنبلية تجدّدت الظاهرية. وإلى غاية عصر النهضة لم يقم أحد بإحياء موقف الخوارج أو المعتزلة كما لو لم يطرح أي من الفريقين أسئلة وجيهة ولم يواجه مشكلات موضوعية كما لو كان المجتمع الإسلامي دائمًا في أوج القوة والازدهار..."[24]. أي كما لو أنّ المجتمع الإسلامي يتعالى على منطق المجتمع بوصفه منطقاً للصراع، وعلى إيقاع التاريخ إيقاعًا للنفي والإثبات.
يعمل موقف السنّة على طمس حقيقة المجتمع باعتبارها ظاهرة أي مجالاً لصراع أغراض، أهواء ورغبات كما طمس حقيقة التاريخ بوصفها سياقات ضرورية. لذلك فهو موقف يعبّر، من جهة، عن أزمة توتر الثقافة العربية مع التاريخ ومن جهة أخرى عن جهد جهيد لتأكيد الأزمة واستمرارها.
إنّ مكر الموقف السنّي بالتاريخ هو تحت سلطة مكر التاريخ، وليس في وسع علم الفقيه إدراك ذلك. يعتقد الفقيه أن مردّ تردي الأحوال هو الابتعاد عن الأقوال، لكن ما يستفيده النظر المشبع بروح التاريخ هو ما انتهى إليه العروي بشأن أوج السنّة الذي هو في الوقت نفسه أوج الأزمة: "يرسم ابن حزم صورة قاتمة عن أحوال زمنه المتميّزة بالتردد والحيرة وهي أحوال تذكرنا بما عرفه العصر الهلستيني في عقوده الأخيرة"[25]. فحيث تسود السنة يسود التخلف لأنّ السنّة إرجاء للتاريخ ومن يرجئ التاريخ يتجاوزه التاريخ ويتخطاه.
2- السنّة والتاريخ:
انحدرت الثقافة العربية على أكثر من محور طال الأمر أولاً المعتزلة بوصفها هيأةً استشارية لقادة سياسيين أفل نجمهم ليشمل بعد ذلك أفرادًا مثقفين، فقهاء وفلاسفة. عندما يتيه المعتزلي في مفاهيم مجردة، فهو بذلك يعتزل التاريخ ومع مرور الوقت يوغل المتكلم في التصورات دون مراعاة منطق التاريخ وتكون النتيجة ولادة الفيلسوف، إنّه يعبّر عن أزمة أكثر مما يشكل حلاًّ لها. تقود أزمة الوعي التاريخي باعتباره وعياً بمنطق الوقائع إلى انتعاش الفيلسوف الذي يتيه في تفاصيل المفهوم خارج الزمان والمكان التاريخيين، من هنا لا سبيل إلى الوعي التاريخي إلا بتذكير الفيلسوف بأصوله الكلامية وبذلك وضعه في صلب الصيرورة التاريخية، ولن يتأتى هذا إلاّ باستعادة المفهوم إلى تربة التاريخ. أليس ذلك هو مشروع العروي؟ أليس مشروعه هو وضع الوعي التاريخي في صميم الفكر العربي وذلك من خلال رهن الفلسفة بالعلم التجريبي، رهن الفلسفة بالاجتماعيات والنفسانيات والتاريخانية؟
يجد العروي نفسه ملزمًا بالتخلص من خصمه العنيد، الفيلسوف، لأنّه يتقاسم معه استشكال ما يعتبره سقفًا للتفكير أي الزمن. الزمن التاريخي زمن المجتمعات، الثورات والتحولات الاقتصادية والسياسية فهو زمن الدولة. إنّ همّ التاريخانية هو الزمن الملموس إذ يراوح الفيلسوف مكانه وهو يدرس الزمن خارج الأحداث، بذلك فهو يوجد في التاريخ ويفعل كما لو أنّه خارجه، ينشغل بدراسة النظرة إلى الأحداث دون دراسة الأحداث والنتيجة أنّه يحيد عن التاريخ مجالاً للحقيقة. موقف الفيلسوف هذا هو ما يفسّر تنكّر العروي للفيلسوف حيث يؤكد للسائلة: "لا أرى نفسي فيلسوفًا - من يستطيع اليوم أن يقول إنّه فيلسوف؟-"[26]. إنّ ما أصبح يبرر عدم الحاجة إلى الفلسفة والفيلسوف هو أنّ "العلم الموضوعي، التكنولوجيا، السياسة، الفن، هذه المسالك كلّها لم تعد بحاجة إلى نظيم"[27] لا حاجة للأبناء بأم العلوم، من هنا عندما يقدم العروي نفسه تاريخانيًّا يضيف أنّ "هذا المفهوم لا علاقة له بما يعرف تحت هذا الاسم في الموسوعات الفلسفية"[28] ذلك أنّ الحدّ الفارق هو الواقع، يعيش الفيلسوف في المفهوم وينسى الواقع. لذلك يضيف العروي: "التاريخانية ليست اختيارًا فلسفيًّا وإنّما هي وصف لواقع"[29].
ينطلق العروي من الواقع الملموس بدافع المنفعة، لا يكتفي بالتمرين العقلي لتحديد المفاهيم وتصنيف المذاهب بل يجعل من التاريخانية ضرورة تظل تحت طلب واقعة التخلف لينتهى بذلك إلى تحديد مبتغى عمله قائلاً: "أظهرت ضرورة تبني النظرة التاريخية على أساس المنفعة فقط، بدون إصدار أيّ حكم فلسفي قيمي"[30]. تلك عقيدة العروي قبل نصف قرن ولا يقول اليوم غير ذلك عندما يخاطب السائلة مؤكدًا أنّه رفع راية التاريخانية بدافع الواقعية.
عندما يتم الاحتكام إلى الواقعية أي منطق المنفعة ينتفي التعامل الانتقائي مع التاريخ. فنجد أنفسنا ملزمين بأن نأخذ بمنطق التاريخ، منطق يقع شأن تقصيه وتبليغه على عاتق التاريخانية. إنّها مدرسة الوعي التاريخي حيث "لا يكتسب المجتمع التقليدي فكرة التاريخ إلا في إطار الدعوة التاريخانية"[31]. التاريخانية وليس التأريخية، لذلك لم ينج المؤرخ العربي نفسه من مطرقة العروي. إنّ المؤرخ يدرس التاريخ خارج منطق التاريخ ليرهنه بلحظة مقدسة خالدة لا يفهم التاريخ إلاّ بدالّتها، لذلك لاحظ العروي حجم القطيعة بين التصور الحديث للتاريخ ومنظور المؤرخ العربي: "الفلاسفة المحدثين يعرّفون التاريخ بأنّه مجال الضرورة ومحكمة العقل. أين هذا التعريف من منظور المؤرخ الذي يرى التاريخ كسلسلة أحداث متماسكة الحلقات بل كإعادة مستمرة لعهد النور والحقيقة؟"[32]. هذا أقصى ما بلغه مفهوم التاريخ عند العرب حتى في أوج عطائهم وهم يشاركون في القضايا الكونية للفكر البشري، لذلك انتهى العروي في "مفهوم العقل" إلى أنّ ابن خلدون يحصر التاريخ حصرًا، فيستبعد إمكانية التجديد بمعاكسة سنن الكون.
استولت تصورات السنّة على مختلف أركان الثقافة العربية من الكلام إلى التاريخ مرورًا بالفقه والفلسفة. الوعي بخطورة الموقف هو خطوة أولى لن يمكّننا منها إلاّ تحكيم الوعي وقد تشبّع بالتاريخ في مدرسة التاريخانية، أي تحكيم الوعي التاريخي الذي ينبئنا بالأمر التالي: "الظرف التاريخي يفرض علينا فرضًا أن نغامر ونتقدم في الحقول الملغومة"[33]. ولا يتحقق هذا التقدم إلاّ أخذًا بالمبدأ العام: "السنّة، أية سنّة تنعقد وتنحل بمغالبة العلم والفن والسياسة"[34]، مبدأ يحدد المعرفة المدنية وصميمها المعرفة التاريخية رافعةً لتخطي حالة التخلف من خلال القطيعة المنهجية مع الخلفيات الثقافية للسنّة.
تهدف التاريخانية إلى فهم الظاهرة التاريخية بوضعها في سياق التاريخ لغرض إدراك حدودها، وإذا كان الأمر كذلك فإنّ العروي عندما يحدد الفهم السني للقرآن ظاهرةً تاريخية فهو لا يسعى إلى التقليل من قيمة الكتاب المقدس بل يرتئي أنّ استعادة الكتاب قيمته تتأتى عبر وضع تأويل السنّة أمام تهافته. وإذا كان من اللازم تصور المستقبل خارج سقف السنّة فإنّ نقطة البداية هي ملاءمة التأويل السنّي مع مقتضيات التاريخ. ويقتضي ذلك الانطلاق من البداهة التالية: "إن كان وضع العرب لايزال غامضًا، فظاهرة القرآن أكثر غموضًا"[35]. كلما تقدّمنا إلى محكمة التاريخ تبدّدت دعاوى السنة وانتقلنا من بداهة إلى أخرى، من بداهة الرواية الشفوية التي تشكّل عماد إيديولوجيا أشراف مكّة والتي تعمد إلى طمس التاريخ، إلى بداهة التاريخ سقفًا للقرآن وليس العكس.
يفيدنا البحث التاريخي بأنّ القرآن كتاب ضمن كتب لذلك أكّد العروي أنّ "القرآن كمصحف يتصفح، كمجموع حروف وكلمات وعبارات وثيقة مادية كباقي الوثائق. لا اعتراض على إخضاعها لجميع أنواع النقد المعاصر"[36]. والنتيجة أنّ الإسلام دين بين أديان هو محصلة لشرط تاريخي وعلاقة اجتماعية. يتمثّل الشرط التاريخي في السياق الثقافي الذي شكّل شرطًا لإمكان الإسلام حيث يؤكد العروي: "عند ظهور الإسلام، إذن، كان الشرق في حلبة المتوسط قد حسم لصالحه المنافسة الروحية بينه وبين الغرب..."[37].
يستجيب الإسلام لنداء الشرق في معركة الريادة التاريخية عبر وسائل مادية وروحية. بهذا يندرج الإسلام ضمن لعبة الإثبات والنفي باعتبارها الماهية الأساس لإيقاع التاريخ، فهناك الإسلام لأنّ هناك التاريخ وهناك القرآن لأنّ هناك سياقًا ثقافيًّا عاماًّ. وعندما يرى العروي أنّ الشعائر التي جاء بها الإسلام تواترها العرب عمّا قبلهم، فإنّه بذلك يعمل على تحرير الكتاب من المقدس ليكشف عن خلفية إيديولوجيا أشراف مكّة حيث "لا يزالون يتمتعون بالجاه والنفوذ، لا لسبب غير عراقة النسب فمن الطبيعي أن يتشبثوا بمفهوم الإرث والتقليد"[38]. يتوافق هوى أسياد مكّة مع دعاوى السنّة، إرادة التميّز ولاشيء غير التميز من خلال العودة إلى الأصل، أصل دون تاريخ.
يحدد العروي القرآن بوصفه ظاهرة تاريخية إلاّ أنّه وككل واقعة تتداخل فيه سياقات من مستويات مختلفة نفسية اجتماعية ولغوية. يبدأ العروي تشخيص السياق بالانطلاق من الخاص إلى العام، من شخصية الرسول التي تتجلى في سلوكه المحدد ببنية اجتماعية لا تأخذه على محمل الجد لا لشيء إلا لأنّه من صغار القوم، ينتمي إلى قبيلة لا شأن لها، رجل فقير وعلاوة على ذلك رجل أمّي. لهذه الأسباب انتهى العروي إلى تقييم وضعية الرسول ضمن سياق يتجاوز أهواء الأفراد وأحلامهم: "ينطلق النبي وهو واع كل الوعي بعائق كبير، هو وضعه الاجتماعي. يدرك جيّدًا أن لا تناسب بين مقاله ومقامه، بين جسامة ما يدعو إليه ودوره المتواضع في المجتمع"[39].
فيم يفيد هنا التذكير بمآسي التاريخ غير تحديد هوية الأطراف المتناحرة، الرسول باعتباره طرفًا يشرح القرآن مشروعه، مشروع تخليص الأرض من الشرّ الذي ظل يلازمها حتى بعد كل الرسالات السابقة. فما يتأكد في كل مرّة هو استجابة الرسالة للتاريخ وتخطي التاريخ للرسالة، إنّه مجال صراع ومغالبة. تسعى كل رسالة إلى تخليص التاريخ من شروره فتقع في حبال التاريخ ثم تظهر الرسالة مجددًا فيخذلها التاريخ مجددًا. لم يكن الرسول إلاّ حاملاً لرسالة تردّ الفعل فيرتد عليها، تريد محاصرة التاريخ فيسارع التاريخ إلى محاصرة حصاره وهكذا دواليك. لذلك لاحظ العروي أنّ "القرآن في منحاه العام...ردة عنيفة على صدمة مروّعة وكشف مذهل"[40]، ردّة فعل لرجل لا شأن له بين بني جلدته يعلي راية إصلاح التاريخ من مآسيه فذلك مبتغى كل رسالة وليس هناك ما يميز الإسلام عمّا عداه من الرسالات، فلا جديد لدى العروبة غير التاريخ بوصفه وحدة سياق، وباعتباره سياق الضرورة يستدرج التاريخ أهواء الأفراد وأمانيهم، لذلك قال العروي: "وقع النبي في التاريخ وفيما يواكبه من عنف ومكر"[41].
القرآن إذن هو ردّة فعل على الفساد المستشري في الأرض، ردّة يسعى من خلالها رسول إلى استكمال ما بدأه أسلافه من الرسل وهم بذلك جميعًا يستجيبون لنداء سياق عام، سياق الثقافة سياق التاريخ القديم حيث "لاحظنا آنفًا أنّ دارس التاريخ القديم لا يسعه إلاّ تسجيل ميل عام، تيار جارف نحو فكرة الوحدة على جميع المستويات"[42]. هنا يحدّد العروي السياق الذي قاد إلى ديانات التوحيد، فالأمر يتعلق بجينيالوجيا فكرة واحدية الله إذ تبدو رسالة رسول مكة انعكاسًا لسياق أكثر منها تقريرًا وتوجيهًا للسياق، فضمن سياق طبع الشرق ظهرت الرسالة المحمّدية ذلك أنّه "في الشرق يسهل الانتقال من التعدد إلى الوحدة...من فوضى الغوغاء أو تناحر الأشراف إلى الانقياد لإرادة الفرد المتسلط. يأتي الإسلام في خاتمة هذا التطور العام..."[43].
فكرة الوحدة إذن، سياق عام حدّد الدين الإسلامي فكان القرآن بمثابة الصياغة المثلى لفكرة الله الواحد، إلاّ أنّ الأخطر من ذلك أنّ فكرة الوحدة لم تقتصر على الإسلام دينًا بل أيضًا الإسلام دولةً، والأجدر بنا القول من وجهة نظر تاريخية أنّ تمحور الدين حول فكرة الواحدية هو ما أوكلته العلاقة السياسية للدين من أجل خدمته لها، ففكرة الواحدية فكرة أرضية أوحت بها السياسة للدين كي يوحي بها مجددًا الدين للسياسة لتكتسي طابع القداسة. هذا سياق عام موغل في التاريخ يقول العروي بشأنه: "إذا أخذنا بالمدى الطويل، فإنّنا نخلص حتمًا إلى أنّ حكم الواحد...هو الذي هيّأ الأذهان في المدار المتوسطي إلى اعتناق عقيدة التوحيد..."[44]. فعلت التربية على الواحد فعلها في أهل مكّة وانسحب البساط من تحت أشرافها المشركين بالواحد، فوجدت دعوة محمد السياق الجديد أرضية خصبة قاومها أولاً أسياد مكة فانبطحوا لها ثانية بعدما فهموا السياق على هواهم، وما هواهم إلاّ المشاركة في تأكيد قداسة الرسالة مدخلاً لإثبات قداسة مملكة الإسلام، دولة الخلافة. نجحوا في ذلك حيث "القفز من السياسة إلى الشرع يقوم به الفقهاء بعدما يستنجد بهم أصحاب السلطة"[45] والحقيقة أنّهم مازالوا يستنجدون بهم ومازال الفقهاء يقفزون إلى يومنا هذا.
يقود الوعي التاريخي بالقرآن إلى حقيقة مبدئية السياق التاريخي على وقائع التاريخ، فلا تستكمل الواقعة التاريخية دلالتها إلاّ ضمن السياق العام الذي يحيط بها ويشرطها، وإذا كان القرآن بوصفه وحيًا أي واقعةً ميتافيزيقية يتعذر وضوحها باعتبارها لغزًا خارقاً فإنّ وضعها ضمن سياقها التاريخي ينتهي بنا إلى أنّ القرآن هو حكاية شعب تحت قدر التاريخ بوصفه مجالاً للنفي والضرورة. لعل هذا ما يذهب إليه العروي عندما يقول: "الإسلام ليس سوى "قراءة" يقوم بها شعب بعينه وذلك قبل أن تدوّن تلك القراءة الخاصة المتميزة في نص مضبوط"[46].
عندما يجهد العروي لردّ القرآن إلى واقع معيش، إلى سياق التاريخ، فإنّ ذلك من باب تحصيل الحاصل مادامت التاريخانية هي منطق التقييم، إذ كيف يستعصي على المرء تبيّن القرآن في استقلال عن المقدس والمقدس في استقلال عن السلطة إذا كان يحدد مقومات معنى التاريخانية في ثبات قوانين التطور التاريخي ثم في وحدة الاتجاه؟ إنّها مقومات هي شرط إمكان فهم مدني للقرآن، فهم ينتهي به إلى الانكشاف ظاهرةً تاريخيةً.
إنّ القرآن كأيّ ظاهرة تاريخية كلما أحاط بها الوعي التاريخي زادت غموضًا واستشكالاً هذا ما لا يغيب على روح كتاب "السنة والإصلاح"، روح فلسفية لا مثيل لها حتى عند من يحسبون تقليديًّا على مجال الفلسفة، هي روح فلسفية يتنكر لها العروي قولاً ويجاهر متّهمًا إياها بالتجريد والتيه، يعادي منطقها إلاّ أنّه ما يفتأ يحققها فعلاً، لقد كانت الروح الفلسفية سنده لمجابهة منهج السنة القائم على تركيز روح البداهة. وإذا كان لابد من تحديد عام لمنهج العروي نقول إنّه المنهج التاريخاني محملاً بروح فلسفية عالية لا تبقي ولا تذر.
3- القرآن والسؤال:
يدور كتاب "السنة والإصلاح" حول هوية القرآن من وجهة قوانين التاريخ الراسخة، الحقيقة أنّ سؤاله هو: ما هذا الشيء الذي اسمه القرآن؟ يتقصى العروي هذا السؤال من خلال تمحيص أهم جواب قدّم بهذا الشأن، أي جواب السنّة. فانتهى إلى أنّه تأويل مختزل، وسبيل تخطيه هو تأويل ظاهرة القرآن من وجهة نظر التاريخ إذ ذلك وحده كفيل بتحرير ما عملت السّنة على طمسه حيث: "قرنان ونصف بعد الهجرة. هذه مدّة نضيفها إلى القرون الثلاثة السابقة عليها، أي على الهجرة، لنكوّن فترة تعوّدنا على أن نقول في شأنها ما يروق لنا أو ما يخدم أغراضنا دون أن نعرف عنها كثيرًا بالدقة المطلوبة"[47].
تتربّص أسئلة الفكر التاريخي ببداهات الثقافة العربية، أسئلة يطرح عنها العروي السؤال التالي: "ما المانع أن يتوصل متخصص في الخط القديم إلى قناعة، وبحجج دامغة، أنّ لهجة مكّة كانت غير ما توهّمنا إلى حدّ الآن"[48]. لم يكن من الممكن طرح سؤال كهذا لو أبقى الباحث على بداهات السنة، وهي بداهات تحمل في ذاتها تصورًا منفّرًا من التاريخ يحول دون استشراف مستقبل مخلخل لأركان المقدس العربي من جنس المستقبل الذي يرسم العروي ملامحه الأساس ضمن قوله: "من الوارد جدّا أن يعثر أحد الباحثين، في إيثيوبيا أو آسيا الوسطى، على صفحات من الذكر سابقة على مصحف عثمان"[49]. هنا نلمس شأنًا للحقيقة بالتاريخ باعتباره بؤرة احتمالات، الأمر الذي تعذر على الفكر العربي حتى في أعتى لحظات تمسكه بالروح التاريخية مع ابن خلدون.
لا تقوم حقيقة القرآن حقًّا إلاّ على أساس تصور تاريخاني للتاريخ، تصور يصالح التاريخ مع نفسه بتحريره من أغاليط السنّة ومخاتلاتها التي تنتقص من التاريخ بطمسه، لذلك "لكي يكون التاريخ ميدان جدّ ومسؤولية، لابدّ من اعتبار الحقيقة المطلقة كحركة وكصيرورة"[50]. ذاك هو أفق قراءة القرآن وفهمه باعتباره ظاهرة تاريخية.
قراءة القرآن في أفق الزمن التاريخي، هذا هو درس كتاب "السنة والإصلاح". لكن هذه القراءة لا تتم إلاّ عبر تحرير الزمن من قبضة التثبيت، تثبيت الزمن الذي هو المقصد الأساس للتأويل السنّي إذ تعرف السنّة أنّ "الزمن هو منبع كل المفارقات التي تواجه المذهب السنّي، بل كل تفكير تقليدي"[51]. إنّه كشّاف البداهات العزيزة على السنة. من هنا مفارقة السنّة كما صاغها العروي، إنّها تريد الإصلاح لكن بمعاكسة الزمن فهي إذ نادت مجددًا في نهاية القرن 19، إثر صدمة الحداثة، نادت وذكّرت بأنّ الإسلام دين ودولة، ارتأت أنّ الإصلاح عودة إلى الأصل، عودة تسخر من الزمن ولا تضعه في الحسبان. تنسى السنّة أو تتناسى أنّ "الزمن مخلاف. يغيّر فينا كل شيء. يغيّر موقفنا من الكون والمجتمع والسياسة والأخلاق. يغيّر علاقتنا بالطبيعة وبالجسد وبالأسرة وبالسلطة"[52]. هذا ماتبيّنه أهل الضفة الأخرى ويظهر في مختلف تجليات حياتهم بدءًا من الملبس والمأكل إلى إدارة الدولة، وهذه الواقعة هي ما يؤكدها هنا قول العروي: "إنّ اليهود والنصارى، بفعل الزمن وحده، لم يعودوا يقرؤون كتابهم المقدس كما كان يفعل أجدادهم"[53]. هذا ما سيظل مسجّلاً على جدول أعمال الثقافة العربية بوصفه أولوية للوعي النقدي.
يحدّد العروي عناصر جدول عمل الفكر التاريخي بقوله: "واجب علينا إنقاذ العلم والسياسة، لا من الدين... بل من التأويل الذي فرضته السنة، والسنّة مؤسسة بشرية"[54]. فإذا كانت السّنة لا تنتعش إلاّ على أساس معاكسة الزمن ولا ترى سبيلاً إلى الإصلاح إلاّ في درء سننه فإنّ "الزمن يواصل سيره ولا يتوقف عند رغبة هذا المتأخر. فيدور عليه كما دار على من سبقه. يرغمه على الانصياع لحكم الجميع وطرق سبل المتقدمين"[55]. هذا الوعي الشقي لكن في الوقت نفسه المتطلع إلى مستقبل أفضل هو نقطة البداية.
إذا ما ترسّخ الوعي التاريخي يصبح السؤال الأساس متعلقًا بتدبير شأن علاقتنا بالحاضر والمستقبل، وبنفس القدر والأهمية تدبّر أمر تموضعنا تجاه الماضي، ولا يستقيم التموضع الصحيح إلاّ بطرح السؤال التالي: "كيف تكوّنت السّنة؟ من قام بذلك العمل ولأي هدف؟"[56]. وهو السؤال الذي يعتبر كتاب "السنّة والإصلاح" محاولة قوية ومتميّزة للإجابة عليه.
* نشرت هذه الدراسة في مجلة "ألباب"، شتاء 2015، العدد 4
[1] العروي(عبدالله)، "السنة والإصلاح"، ص 41، المركز الثقافي العربي، ط1، 2008
[2] نفسه، ص 174
[3] نفسه، ص 154
[4] نفسه، ص 149
[5] نفسه، ص 143
[6] نفسه، ص 144
[7] نفسه، ص 146
[8] مجلة اختلاف، ع 6 /7، ص 8، 1993
[9] نفسه، ص 9
[10] العروي(عبدالله)، "السنة والإصلاح"، ص 191، المركز الثقافي العربي، ط1، 2008
[11] نفسه، ص 193
[12] نفسه، ص 191
[13] نفسه، ص 141
[14] نفسه، ص 168
[15] نفسه، ص 173
[16] نفسه، ص 196
[17] نفسه، ص 138
[18] نفسه، ص 193
[19] نفسه، ص 180
[20] نفسه، ص 180
[21] نفسه، ص 137
[22] نفسه، ص 184
[23] نفسه، ص 160
[24] نفسه، ص 143
[25] نفسه، ص 185
[26] نفسه، ص 6
[27] نفسه، ص 19
[28] مجلة اختلاف، ع 6 /7، ص 8، 1993
[29] نفسه، 9
[30] العروي(عبدالله)، العرب والفكر التاريخي، ص 98، المركز الثقافي العربي، ط 2، بدون تاريخ.
[31] العروي(عبدالله)، مفهوم التاريخ، ص 404، المركز الثقافي العربي، ط1، 1992
[32] العروي(عبدالله)، العرب والفكر التاريخي، ص88، المركز الثقافي العربي، ط2، بدون تاريخ.
[33] العروي(عبدالله)، "السنة والإصلاح"، ص 163، المركز الثقافي العربي، ط1، 2008
[34] نفسه، ص 208
[35] نفسه، ص 91
[36] نفسه، ص 125
[37] نفسه، ص 92
[38] نفسه، ص 191
[39] نفسه، ص 133
[40] نفسه، ص 104
[41] نفسه، ص 118
[42] نفسه، ص 27
[43] نفسه، ص 93
[44] نفسه، ص 167
[45] نفسه، ص 135
[46] نفسه، ص 94
[47] نفسه، ص 158
[48] نفسه، ص 86
[49] نفسه، ص 86
[50] العروي(عبدالله)، العرب والفكر التاريخي، ص 93، المركز الثقافي العربي، ط2، بدون تاريخ.
[51] العروي(عبدالله)، "السنة والإصلاح"، ص 190، المركز الثقافي العربي، ط1، 2008
[52] نفسه، ص 88
[53] نفسه، ص 87
[54] نفسه، ص 210
[55] نفسه، ص 84
[56] نفسه، ص 129






