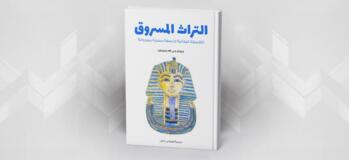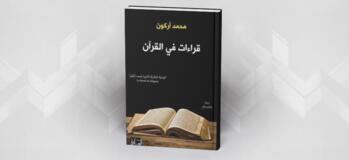التراث والمنهج بين أركون والجابري نايلة أبي نادر
فئة : قراءات في كتب

التراث والمنهج بين أركون والجابري
نايلة أبي نادر
كتاب "التراث والمنهج بين أركون والجابري" للكاتبة نايلة أبي ناذر، وهو من إصدارات الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت لبنان في طبعته الأولى سنة 2008م.
أهمية الكتاب
الكتاب في غاية الأهمية؛ فأهميته لا تفترق عن أهمية مشروع كل من الجابري وأركون، وهما من أبرز المشاريع الفكرية التي تمكن روادها من بسطت رؤى منهجية ومعرفية في التعامل مع التراث؛ ليس من أجل التراث ذاته، بل بهدف فتح الآفاق العلمية والعملية في وجه سؤال النهضة العربية، وهو سؤال واقعي في علاقتنا بالآخر، وكان له حضور بارز وبين منذ أواخر القرن التاسع عشر بصيغ مختلفة من بينها لماذا تقدم الغرب وتأخر الشرق؟ هذا السؤال تفرعت عنه الكثير من الأسئلة التي تعبر عن موقف نخبة المثقفين العرب بشكل خاص والمسلمين بشكل عام، من قضايا الحاضر ومستجداته الحضارية والثقافية والسياسية؛ ومن الماضي وحمولاته الثقافية والمذهبية والاعتقادية، ومن المستقبل وما ينبغي أن يكون عليه. اختار البعض من المثقفين؛ خيار القطيعة مع الماضي (التراث) بشكل نهائي؛ وظنوا بأنه يعيق طريق التقدم والنهضة العربية؛ واختار البعض الآخر تبجيل ذلك الماضي والتفكير بداخله؛ واختار البعض الآخر أن يتعامل معه بنوع من الاستخفاف ويختزل بشكل متعمد بعض من جوانبه في ما هو أيديولوجي بشكل فج، وتعامل معه آخرون بشكل كمي بغياب سؤال الكيف وسؤال المنهج، بينما اتجه كبار المثقفين إلى البحث والحفر في سؤال المنهج في التعامل مع ماضي الثقافة العربية الإسلامية الغني بمختلف التجارب في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية والحضارية بشكل عام، لا شك وفق تصريحات نخبة من المثقفين الكبار من بينهم الجابري، فإن هزيمة 1967م كانت من بين الأسباب التي عجلت في سؤال كيف نتعامل مع التراث؟ فالنصف الأخير من القرن العشرين تميزت فيه المكتبة في العالم العربي بظاهرة مختلف المشاريع الفكرية التي تبحث حول إجابة كافية لسؤال كيف نتعامل مع التراث؟ وهو سؤال يخفي من ورائه سؤال ما هو السبيل الأمثل والمنهج القويم للنهضة العربية؟
سؤال المنهج حاضر بقوة وبشكل بين وواضح في مشروع كل من محمد عابد الجابري، ومحمد أركون، وهما يشتركان في التخصص العلمي (تخصص الفلسفة) ويشتركان في المجال الجغرافي دول شما افريقيا(الجزائر والمغرب) وهو مجال استحوذ عليه المستعمر الفرنسي؛ فالبلدة (فكيك) التي ولد فيها الجابري بالمغرب؛ كانت إلى جانب الحدود التي وضعها المعمر الفرنسي بين المغرب والجزائر، وهناك نوع من التقارب بين طفولة كل منهما؛ فالجابري كانت له علاقة حميمية مع أمه وأخواله ووالده وأعمامه؛ فقد وجد في محيطه العائلي نوعا من العناية من أجل الدراسة، وكان جده لأمه يحرص على تلقينه بعض السور القصيرة من القرآن وبعض الأدعية، وما لبث أن ألحقه بالكتاب، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ ما يقرب من ثلث القرآن.
وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى محمد أركون؛ إذ تلقى في طفولته تربية دينية منفتحة، فحفظ القرآن على ظهر قلب مع خاله وعمره لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة، وفي الوقت ذاته كان من حظه أن يتعرض لتأثير رجال الدين المسيحيين زمن الاستعمار في مدرسة دينية قريبة من قريته، وكان عمره لا يتجاوز الخامس عشرة سنة.[1] كل منهما كان ينظر إلى الأجنبي الفرنسي نظرة يطبعها نوع الرفض والإعجاب، وهما من أبناء نفس الجيل؛ الجيل الذي رأى النور في ثلاثينيات القرن العشرين، زمن ما بين حربين عالميتين الأولى والثانية، {محمد عابد الجابري (1935م/ 2010م). محمد أركون (1928م/ 2010م)} هل من باب الصدفة أن يرحل كل منهما في نفس السنة 2010م؟ وهل من باب الصدفة أن يسمى كل من هؤلاء باسم محمد؟ صحيح أن الجابري لم يستكمل دراسته في المغرب، وقد رحل إلى الشرق العربي (دمشق) وعاد إلى المغرب وحصل على درجة الدكتوراه، بينما نجد محمد أركون قد رحل إلى الغرب، فهو خريج جامعة السوربون، وقد كتب جل كتبه باللغة الفرنسية، بينما كتب الجابري كتبه باللغة العربية. وقد ترجمت مختلف مؤلفات كل منها إلى مختلف لغات العالم، ويحسب لكل من الجابري وأركون، أن كلا منهما قد فكر بشكل جاد في مصير الإنسان المشترك بين الشرق والغرب.
لأهمية كلا المشروعين (الجابري وأركون) اشتبكت على ضوئهما ومعهما مشاريع فكرية وأفكار وطروحات كثيرة جدا، اتفاقا واختلافا ونقدا وتحليلا، على مستوى المنهج والمعرفة والتعاطي الفكري والسياسي معهما، مرة أخرى لا ندرى هل من باب الصدفة أن يرحل كلا الرجلين 2010م لحظة اندلاع الحراك العربي الذي تحولت آماله إلى خيبة أمل، في كثير من أقطار الوطن العربي، نتيجة اتساع الأصولية الدينية بشكل كبير، فلا شيء يحمينا من التشدد والأصولية باسم الدين، دون الفكر والمعرفة، ومن هنا تأتي مجددا أهمية سؤال نقد العقل العربي بتعبير الجابري، ونقد العقل الإسلامي بتعبير أركون، نحن اليوم في أمس الحاجة لاستثمار مختلف المشاريع الفكرية التي جاد بها أصحابها طيلة القرن العشرين.
في هذا السياق، تأتي أهمية كتاب التراث والمنهج بين أركون والجابري نايلة أبي ناذر، صحيح هناك الكثير من الدراسات والأبحاث حول كل من الجابري وأركون، ولكن ينبغي التمييز بين نوعين من الدراسات في هذا المجال: فهناك دراسات وأبحاث غير واعية ومرتبطة بما هو أيديولوجي باسم الدين أو العروبة أو الهوية. وهنالك دراسات واعية وناقدة ولها القدرة على الاستثمار والعرض والتحليل والنقد، وهذه هي المطلوبة ولا شك في أن هذا الكتاب من هذا النوع؛ فهو يسد فراغا كبيرا من نوعه على مستوى النقد والتحليل والمقارنة، ولا شك فإنه سيساعد الدارسين والمهتمين للخروج من حالة الاستقطاب التي كرسها البعض مع الجابري وضد أركون أو مع أركون وضد الجابري، وهي مسألة لا يترتب عنها تفكير ناضج، فالصواب هو نحن مع الجابري وأركون ليس في كل شيء؛ ولكن من أجل تعميق النظر والتفكير بهدف بسط نموذج تكاملي في التفكير والنقد يحضر معه الرأي والرأي الأخر والوعي بنسبية الرأي والتفكير، وهذا سيجعلنا نتحاور ونتواصل بشكل أكبر حول حل قضايا تعنينا جميعا ليس نحن العرب والمسلمين لوحدنا بل نفكر في العالم من خلا أنفسنا.
فصول الكتاب
يضم الكتاب مقدمة: تلقي الضوء حول مشكلة المنهج في قراءة التراث، وثلاثة أقسام: القسم الأول: خصوصية أركون في نقد الفكر العربي الإسلامي. ويضم: {الفصل الأول: مقومات المنهج الأركوني. الفصل الثاني: نقد العقل العربي الإسلامي عند أركون. الفصل الثالث: في إشكالية الخطاب السياسي عند أركون}. القسم الثاني: خصوصية الجابري في نقد العقل العربي. ويضم: {الفصل الرابع: مقومات منهج محمد عابد الجابري. الفصل الخامس: مشروع نقد العقل العربي عند مخمد عابد الجابري. الفصل السادس: في نقد العقل السياسي العربي عند الجابري.} القسم الثالث: التراث والمنهج النقدي بين أركون والجابري دراسة مقارنة. ويضم: {الفصل السابع: في المنهج النقدي. الفصل الثامن: مشروع نقد العقل العربي الإسلامي لدى أركون والجابري. الفصل التاسع: الديني والسياسي في مشروع الجابري وأركون. الفصل العاشر: نظرة في تلقي المشروعين النقديين} خاتمة: وتبقى الحداثة الهدف المنشود.
فكرة الكتاب
تتمحور فكرة الكتاب وموضوعه حول سؤال المنهج في التعامل التراث من خلال تقريب وتحليل ونقد مشروع كل من الجابري وأركون. وهو موضوع حديث يرتبط بالزمن الحاضر، فلا يوجد عند المتقدمين شيء اسمه تراث بالمعنى الفكري والأدبي للكلة كما هي اليوم، فمفهوم التراث عند المتقدمين كان يشير في الغالب إلى المال والحسب، ورد في لسان العرب "التُّراثُ: مَا يَخْلُفُهُ الرَّجُلُ لِوَرَثَتِهِ، والتاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ. وَرُوِيَ"[2] وهذا ما خلص له محمد عابد الجابري في دراسته وتتبعه لكلمة "تراث" و"ميراث" فمفهوم التراث في نظره، كما نتداوله اليوم، يجد إطاره المرجعي داخل الفكر العربي المعاصر ومفاهيمه الخاصة، وليس خارجهما. اصطلاح التراث إذن بالشكل المعرفي الذي نعرفه، يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر بعد لحظة التقاء الشرق بالغرب؛ أي بعد حملة نابليون (الحملة الفرنسية) على مصر (1798م-1801م) التي شكلت نقطة التقاء مباشر بين حضارتين، حضارة الشرق وحضارة الغرب.
يرى رضوان السيد أن الإصلاحيين النهضويين، في سياق مصارعتهم لفتح باب الاجتهاد والتجديد في وجه التقليد اختاروا مصطلح التقليد (وليس التراث)، في تعبيرهم عن الماضي الديني والثقافي للمسلمين الذي يرون تجاوزه، لصالح أمرين مهمين: الأول: وضع الاجتهاد والتجديد في وجه التقليد. والثاني: تأسيس التجديد على مرجعية مزدوجة، تستند إلى الأصول الإسلامية وتستخدم الطرائق والمناهج الأربية الحديثة. أما الانتقال من مفهوم "التقليد" إلى مفهوم "التراث"؛ فقد حدث بعد ذلك وترسخ مع العقود الأولى للقرن العشرين وكان للمستشرقين دور في هذا الأمر؛ ففي الأول كانت كلمة التراث تعني الموروث الثقافي والأدبي المكتوب أي المخطوط، دون أن تعني النص الديني، وعندما اشتد الصراع في الستينيات والسبعينيات بين مختلف الاتجاهات وضع الموروث الديني كله في دائرة التراث. فتطور مفهوم التراث على طول القرن الماضي يعكس في الحقيقة مجريات الصراع على السلطة في المجتمع والثقافة والدين والدولة لدى العرب والمسلمين.[3]
تؤكد مؤلفة الكتاب أن موضوع الكتاب لا ينحصر في مجال المقارنة بين مشروع كل من أركون والجابري، رغم أن هذا المعطى حاضر في الكتاب، فصاحبته تمضي إلى تحديد مفهوم النقد وتسليط الضوء على المنهج النقدي كما عرفه كل من الجابري وأركون وكيف تم توظيفه واستحضاره في مختلف مؤلفاتهم.[4] فغاية كل من مشروع الجابري وأركون هي تيسير سبل الحداثة والتحديث والنهضة في العالم العربي والإسلامي.
[1] التشكيل البشري للإسلام، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، إصدار، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، المركز الثقافي العربي، ط.1، 2013م، ص.80
[2] جمال الدين ابن منظور الأنصاري (المتوفى: 711هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان؛ ط.3، 1414هـ، ج.2، ص 201
[3] رضوان سيد؛ التراث العربي في الحاضر: النشر والقراءة والصراع؛ هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة؛ دار الكتب الوطنية، ط.1؛ 2014م، ص ص. 13-14
[4] نايلة أبي ناذر، "التراث والمنهج بين أركون والجابري" الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت لبنان في طبعته الأولى سنة 2008م، ص.29