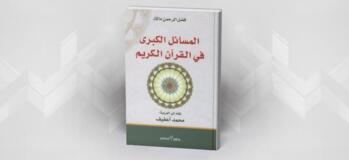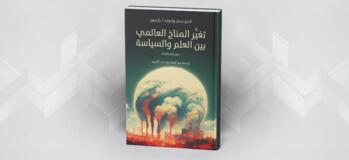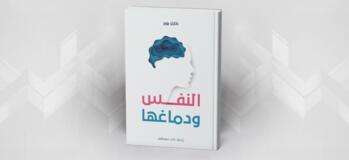التعدُّدية وسبل الاستقرار السياسي والاجتماعي
فئة : أبحاث محكمة

التعدُّدية وسبل الاستقرار السياسي والاجتماعي
الطريق إلى الاستقرار:
عديدة هي الدول والنخب السائدة التي تعتقد أن سبيل استقرارها واستمرار سيطرتها وهيمنتها على مجتمعها هو بالمزيد من الإجراءات والأنظمة التي تُكبِّل المواطنين، وتمنعهم من حرية الحركة، وتحول دون ممارسة الكثير من حقوقهم ومكتسباتهم المدنية.
لذلك، فإن هؤلاء يتعاملون مع مفهوم الاستقرار السياسي والاجتماعي بوصفه صنو الأمن وتوأم تقييد الحريات وملازماً للكثير من الإجراءات المقيدة للحريات والمانعة من ممارسة الحقوق. وعلى ضوء هذا الفهم للاستقرار وطريق الوصول إليه، فإن هذه النخب مع أيّ مشكلة تتعرَّض إليها أو أزمة تُصيبها، لا تُفكِّر في أسبابها الحقيقية وموجباتها العميقة، وإنما تعمل على زيادة الاحتياطات والاحترازات الأمنية، وكأن غياب الاستقرار أو تعرُّضه لبعض الهزَّات، هو من جرَّاء تراخي الأمن.
وهكذا، فإن هذه الرؤية تتعاطى مع مسألة الاستقرار ليس بوصفه محصِّلة نهائية للعديد من الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية، وإنما بوصفه نتاج القوة المادية وممارستها تجاه الفئات أو النخب الاجتماعية الأخرى.
ومن هنا نفهم طبيعة الخوف والحذر الذي تُبديه النخب السائدة في العديد من الدول من الحرية وتوسيع حقائقها وآليات عملها في الفضاء الاجتماعي، فتجعل وفق هذا المنطق قيمة الاستقرار مناقضة لقيمة الحرية وحقوق الإنسان.
وإذا أردنا الاستقرار، فعلينا أن نُضحِّي بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا سبيل إلى الجمع بين هذه القيم في الفضاء الاجتماعي. فيتم شراء الاستقرار بمنع الحرية، وبانتهاك حقوق الإنسان الأساسية. وهكذا توفَّرت في العديد من الدول تقاليد لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، مُؤدَّى هذه التقاليد هو أن طريق الاستقرار هو التضحية بحريات الناس وحقوقهم الأساسية، وبالمزيد من تعظيم دور الإجراءات التنفيذية والعملية كمُقيِّد لحركة الناس وحرياتهم. وفي مقابل هذه الرؤية التي تتعاطى مع مفهوم الاستقرار من زاوية أمنية محضة، هناك رؤية أخرى تحاول أن تُوفِّق بين مطلب الاستقرار السياسي والاجتماعي وضرورات الحرية ومتطلَّبات صيانة حقوق الإنسان، وترى أنه لا تناقض جوهريّاً بين هذه الضرورات والمتطلَّبات والاستقرار السياسي والاجتماعي، بل على العكس من ذلك تماماً، حيث إن طريق الاستقرار الحقيقي لا يمرُّ إلَّا عبر بوابة ممارسة الحرية ونيل الحقوق والمكاسب المدنية. وإن أيَّ محاولة لفكِّ الارتباط بين الاستقرار والحرية، بين الأمن وحقوق الإنسان، سيُفضي إلى المزيد من تدهور الأوضاع وانهدام أسباب الاستقرار الحقيقية.
ويُخطئ من يتصوَّر أن طريق الاستقرار يمرُّ عبر التضحية بحريات الناس أو التعدِّي على حقوقهم؛ وذلك لأن هذه الممارسات بتأثيراتها المتعدِّدة وانعكاساتها المتباينة، ستزيد من فرص عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع.
فالطريق إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي هو ممارسة الحرية وصيانة الحقوق الإنسانية والمدنية.
ولذلك، نجد في المشهد السياسي العالمي أن الدول التي تُنتهك فيها الحقوق وتنعدم فيها فرص ممارسة الحرية والديمقراطية، هي ذاتها الدول التي تعاني الأزمات السياسية والاقتصادية، وتعيش الاضطرابات الاجتماعية، وتُعاني الأمرين من جرَّاء غياب معنى الاستقرار السياسي والاجتماعي الحقيقي.
أما الدول الديمقراطية التي تصون حقوق مواطنيها، وتعمل على تعزيز فرص المشاركة لدى مختلف فئات المجتمع في الحياة العامة، فهي الدول التي تعيش الاستقرار والأمن، وهي البعيدة عن موجبات الاندحار وأسباب تدهور الأوضاع.
فالتجارب السياسية والاجتماعية في العديد من مناطق العالم، تُعلِّمنا أن طريق الاستقرار السياسي والاجتماعي ليس المزيد من تقييد الحريات، وإنما بصيانة الحرية وتعزيز وقائع وحقائق حقوق الإنسان في الفضاء الاجتماعي، فكلما توفَّرت أسباب الحرية وصيانة الحقوق الأساسية في الفضاء الاجتماعي، اضمحلت أسباب الأزمة، وتلاشت عوامل النكوص وتدهور الأوضاع، وخطيئة تاريخية وحضارية كبرى، حينما يتمُّ التعامل مع مفهوم الاستقرار وكأنه مناقض لمفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ لأن هذا الفهم هو الذي يقود إلى الاستبداد بكل صنوفه، بدعوى المحافظة على الاستقرار. ولكن ومن خلال تجارب العديد من الأمم والشعوب، فإن الاستبداد يحمل في بنيته وأحشائه كل عوامل الاضطراب وأسباب الفتن وموجبات التفكُّك السياسي والاجتماعي. فمن دون معادلة متوازنة بين الاستقرار والحرية، بين السلطة وحقوق الإنسان، لن تتمكَّن مجتمعاتنا العربية والإسلامية من صيانة استقرارها والمحافظة على أمنها الوطني والقومي.
وكل محاولة لفكِّ الارتباط بين الاستقرار والحرية أو السلطة وحقوق الإنسان، هي في المحصلة النهائية دِقُّ إسفين في مشروع الاستقرار السياسي والاجتماعي؛ لأنه لا يمكن أن نحصل على الاستقرار الحقيقي بانتهاك الحقوق وتكميم الأفواه؛ لأن هذه تزيد من تدهور الأوضاع، وتُؤسِّس على الصعيدين السياسي والاجتماعي لكل أسباب الاضطراب والفوضى والتمرُّد؛ فالعلاقة جدُّ عميقة بين الاستقرار والحرية، فلا حرية من دون استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي، كما أنه لا استقرار من دون حرية مؤسسية تسمح لجميع المواطنين من المشاركة في إدارة وتسيير شؤون حياتهم المختلفة.
ولعلنا لا نبالغ حين القول: إن العديد من أزماتنا ومشاكلنا في المجالين العربي والإسلامي، هي من جرَّاء الخلل في العلاقة بين الاستقرار والحرية. فالنخب السائدة تسعى من خلال عملها وإجراءاتها إلى تلبية حاجات أحد الأطراف وهو الاستقرار، حتى ولو كانت هذه التلبية على حساب متطلَّبات وقواعد الحرية.
والنخب السياسية والاجتماعية الأخرى تكافح -أيضاً- من أجل الحرية دون الأخذ بعين الاعتبار قواعد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وهكذا ومن خلال هذا الخلل ينتج الكثير من المشاكل والأزمات؛ فالإجراءات التي لا تتحدَّد بسقف الحرية وحقوق الإنسان تكون إجراءات ظالمة ومفزعة ومؤسِّسة للحروب الداخلية الكامنة والصريحة، كما أن المطالبة بالديمقراطية التي لا تُراعي قواعد اللعبة وثوابت المجتمع والوطن تُفضي إلى صراع مفتوح يضيع فيه الاستقرار، كما تتضاءل فيه فرص الحرية والديمقراطية؛ لذلك فإن عالمنا العربي -وهو في سياق تحرره من أزماته الداخلية ومشاكله الذاتية- هو بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الاستقرار وحاجاته، والحرية ومتطلَّباتها؛ لأن العلاقة الإيجابية والدينامية بين الاستقرار والحرية هي البداية الصحيحة للخروج من أزمات الراهن بأقل خسائر ممكنة، وهنا يتطلَّب أن تلتفت النخب العربية والإسلامية السائدة إلى متطلَّبات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يتطلَّب من قوى المجتمع الأخرى أن تأخذ بعين الاعتبار وتحترم حاجات الاستقرار السياسي والاجتماعي، فنحن بحاجة أن نلتفت إلى متطلَّبات الحرية، دون دفع الأمور إلى الفوضى والصراعات المفتوحة، كما نحترم قواعد الاستقرار دون التحجُّر والجمود واليباس.
فالمطلوب علاقة تفاعلية ودينامية بين متطلَّبات الحرية وحاجات الاستقرار؛ وذلك من أجل أن ينطلق مجتمعنا في التغيير والتطوير على قواعد متينة من الاستقرار الاجتماعي. وإن التطوُّرات المتسارعة التي تجري في المنطقة اليوم تجعلنا نُؤكِّد أن طريق الاستقرار السياسي والاجتماعي لا يمرُّ عبر المزيد من الإجراءات والاحترازات الأمنية مع أهميتها وضرورتها، وإنما عبر إعادة تشكيل الحياة السياسية، حيث يتسنىَّ لجميع قوى المجتمع وتعبيراته من المشاركة في بناء الوطن وتعزيز وحدته الداخلية، وتمتين أواصر العلاقات بين مختلف المكوِّنات.
فالاستقرار السياسي والاجتماعي اليوم، في الكثير من البلدان العربية والإسلامية، بحاجة إلى حزمة من الإجراءات والخطوات السياسية، التي تستهدف رفع الاحتقانات الداخلية، وبلورة الأطر والمؤسسات للمشاركة الشعبية وإعادة تأسيس العلاقة بين متطلَّبات الحرية ومشاركة الناس في شؤون حياتهم المختلفة وحاجات الاستقرار والنظام، حيث لا تقود خطوات الإصلاح إلى فوضى، بل إلى بناء متراكم وعمل وطني متواصل، يستهدف تطوير التجربة وتحديثها، وإزالة عناصر الخلل والضعف منها.
وهذه المهام ليست مستحيلة، وإنما هي ممكنة وتتطلَّب من جميع الأطراف الاهتمام بالنقاط التالية:
1- إن القوة الحقيقية اليوم في أيِّ مجتمع لا تُقاس بمستوى الكفاءة العسكرية أو الإجراءات الأمنية المحكمة، وإنما تُقاس القوة اليوم بمستوى الانسجام والرضا بين مؤسسة الدولة والمجتمع بكل مكوِّناته وتعبيراته. فالدولة التي تمتلك أحدث الأسلحة، ولكنها منفصلة أو مفصولة عن شعبها فهي دولة ضعيفة؛ وذلك لأن قوَّتها الحقيقية ليس في الأسلحة والمعدات العسكرية، وإنما في رضا المجتمع عنها، وفي كفاح المجتمع في الدفاع عنها بكل مؤسساتها وهياكلها. والدولة التي لا تمتلك الأسلحة الحديثة ولا الثروات الطبيعية الهائلة، إلَّا أنها تعبير حقيقي عن مجتمعها، فهي دولة قوية؛ لأنها محتضنة من قبل شعبها ومجتمعها. فقوة الدول ليس في ترسانتها العسكرية، بل في انسجامها مع مجتمعها في خياراتها ومشروعاتها. لذلك كله، فإن استقرار الدول اليوم مرهون إلى حدٍّ بعيد على قدرة هذه الدول في التفاعل مع قضايا مجتمعها والتعبير عن تطلعاته وحاجاته.
2- إن بناء العلاقة الإيجابية والمتطورة بين الدولة والمجتمع في المجال العربي، بحاجة إلى جهود مشتركة بين الطرفين؛ فالدولة تتحمَّل مسؤولية مباشرة في خلق الأجواء والوقائع التي تدفع الواقع صوب التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع، كما أن المجتمع بقواه المتعدِّدة يتحمَّل مسؤولية مباشرة في إطار تطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع في التجربة العربية المعاصرة؛ فمؤسسات المجتمع المدني ليست بديلاً عن الدولة، كما أن مؤسسات الدولة ليست بديلاً عن فعاليات المجتمع الأهلية والمدنية. فالاستقرار السياسي والاجتماعي بحاجة إلى جهود مشتركة ونوعية تقوم بها مؤسسات الدولة كما يقوم بها المجتمع عبر مؤسساته الأهلية والمدنية؛ فالاستقرار هو نتاج عمل متواصل ومتراكم يتَّجه صوب تعزيز حرية الإنسان وحقوقه الأساسية، كما أنه لا يغفل أو يتجاهل حاجات المجتمع إلى الأمن والاستقرار.
فالطريق إلى استقرار أوضاع العالم العربي اليوم بحاجة إلى مبادرات وطنية نوعية تتَّجه صوب إصلاح الأوضاع، وتدشين مرحلة سياسية جديدة قوامها ممارسة الحريات وصيانة حقوق الإنسان.
في نقد مفهوم الأقلية في العالم العربي:
برزت في الآونة الأخيرة ظواهر خطيرة في جسم العالم العربي، وهي ظواهر تزيد من محن العالم العربي، وتُدخله في نفق مظلم، إذا لم يتسارع الحكماء في هذا العالم لمعالجة هذه الظواهر، وإنهاء مفاعيلها السلبية في واقع العالم العربي. ولعل من أبرز هذه الظواهر وأخطرها في آن، هي ظاهرة النزوع نحو العصبيات التقليدية في المجتمعات العربية. فكل المجتمعات العربية اليوم تبرز فيها عصبيات دينية ومذهبية وقومية وجهوية، حيث أضحت هذه العصبيات هي العنوان البارز للعديد من المشاكل والأزمات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات العربية. ففي السنوات الماضية كان العربي يعتزُّ بعروبته، ويتعامل مع كل العرب على أساس العروبة الواحدة، دون الاقتراب من دين أو مذهب هذا العربي، حيث كانت العروبة حاضنة لجميع الأديان السماوية، بل إن رُوَّاد القومية العربية المعاصرة هم من العرب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي.
ولكن هذه المسألة لم تُشكِّل لأحد مشكلة يقف عندها أو يستغرب منها، فكانت العروبة الحضارية بمشروعها الثقافي والاجتماعي حاضنة لكل العرب بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم ومناطقهم، فكانت المجموعة القومية الواحدة تضم هذا الخليط الديني والمذهبي، دون أن يُشكِّل أيَّ حساسية لأيِّ طرف.
أما الآن، فإن الواقع العربي بأسره يعيش العصبيات الدينية والمذهبية والمناطقية، فتراجعت العروبة، وبرزت تلك العصبيات التي تُصنفِّ العرب، وتُقسِّمهم إلى فئات ومستويات انطلاقاً من أديانهم ومذاهبهم ومناطقهم، فأضحت هذه العصبيات هي العلامة البارزة في المشهد العربي كله من أقصاه إلى أقصاه.
وفي سياق بروز هذه العصبيات بدأنا نسمع وبشكل دائم مفاهيم الأقلية والطوائف المختلفة، وبدأت المواقف تتَّخذ انطلاقاً من هذه المفاهيم، وبدأ البعض يُراجع أحداث التاريخ البعيد والقريب على قاعدة هذه العناوين العصبوية التي ساهمت بشكل سريع في تهتُّك النسيج الاجتماعي العربي، وبدأت ما أشبه بالحروب الأهلية العربية الكامنة بين جميع عناوين ويافطات تلك العصبويات التي بدأت بالبروز في المشهد العربي.
وحين التأمُّل في الأسباب والعوامل الحقيقية التي ساهمت في إيقاظ هذه الخصوصيات والعصبويات على نحو سلبي في العالم العربي، نجد أن العنف والاستبداد هما اللذان أدَّيا إلى تسعير التوترات، وتفجير الاحتقانات في مناطق عديدة من العالم العربي.
ونحن نعتقد أن استمرار هذه الأوضاع على حالها سيزيد من الاحتقانات الأفقية والعمودية في العالم العربي، وسيُهدِّد استقراره السياسي والاجتماعي. وإننا اليوم بحاجة إلى درء الفتنة في العالم العربي عبر ضبط هذه العصبيات وإعادتها إلى حالتها الإنسانية-الطبيعية.
وإنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلَّا بنقد مفهوم الأقلية في العقل السياسي والاجتماعي العربي؛ فالأقليات والأكثريات في العالم العربي ينبغي أن تكون سياسية وليست دينية أو مذهبية؛ بمعنى أن هناك مشروعات سياسية وطنية متعدِّدة ومختلفة، وكلها متاحة للنشاط فيها من قبل جميع المواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم، وعلى ضوء النتائج الانتخابية أو الاجتماعية يتحدَّد مفهوم الأكثرية والأقلية في العالم العربي.
فهي أكثرية وأقلية خيار سياسي، وليست أكثرية دين أو مذهب أو منطقة معيَّنة؛ لأن هذه الانتماءات التاريخية ينبغي أن تكون محلَّ احترام الجميع، والتنافس والصراع ينبغي أن يكونا في الخيارات السياسية بصرف النظر عن أديان ومذاهب القائمين على هذه الخيارات.
والوصول إلى هذا يتطلَّب بطبيعة الحال، تحوُّلاً نوعيّاً وتطوُّراً استراتيجياً في فكرنا السياسي والاستراتيجي، حتى نتمكَّن من تجاوز عصبيَّاتنا التقليدية والتاريخية إلى رحاب المنافسة والصراع على قاعدة المواطنة الواحدة والمشتركة.
لهذا، فإننا بحاجة لأنْ نُعيد قراءة مسألة الأقليات والخصوصيات الدينية والمذهبية في العالم العربي، وحتى تتَّضح رؤيتنا حول هذه المسألة بشكل جليّ نقول الآتي:
إنه وبعيداً عن المضاربات الأيديولوجية والسياسية بإمكاننا أن نُحدِّد معنى الأقلية بأنها (التكوين البشري، الذي يتمايز مع جماعته الوطنية في أحد العناصر التالية «الدين - المذهب - اللغة - السلالة» وهذا التمايز تعبير عن التنوُّع الطبيعي بين البشر.
ولكن هذا التمايز في هذه العناوين الأربعة، لا يعني أن كل من يخالف الأكثرية في أحد هذه العناوين والعناصر هو مناوئ لمطلب الوحدة أو العروبة؛ لذلك فإن توصيف جماعة معيَّنة كأقلية لا يعني بالضرورة أيَّ حكم مسبق على اتِّجاهاتها صوب قضايا الأمة أو الوطن الكبرى.
وعليه، فإن درجة التميُّز وحِدَّته وعمقه الاجتماعي والسياسي، وأهدافه وتطلُّعاته القريبة والبعيدة، مرهون كل هذا إلى حدٍّ بعيد إلى طبيعة التعامل الذي تمارسه الحكومات العربية والقوى الاجتماعية المختلفة. فإذا كان التعامل جافّاً وبعيداً عن مقتضيات العدالة والحرية فإن الشعور بالتميُّز الذي يُفضي إلى تهميش ونبذ وإقصاء سيُؤدِّي إلى المزيد من التشبُّث بالخصوصية، وسيدفعه هذا الشعور إلى خلق عصبيات دينية أو مذهبية، تكون هي بمثابة السُّور الذي يحميه ويدافع عنه في آن.
لذلك، فإنه كلَّما قلّت وتضاءلت مستويات الاندماج برزت في المجتمع مسألة الأقليات وتداعياتها الثقافية والاجتماعية؛ بمعنى أن وجود الأقليات في أيِّ فضاء اجتماعي يتحوَّل إلى مشكلة، حينما يفشل هذا الفضاء في تكريس قيم التسامح واحترام المختلف وصيانة حقوق الإنسان والمزيد من خطوات ومبادرات للاندماج الوطني.
حينذاك تبدأ المشكلة، وتبرز العصبيات والخصوصيات الذاتية، وتنمو الأطر التقليدية لكي تستوعب جماعتها البشرية بعيداً عن تأثيرات المحيط واستراتيجياته المختلفة.
فالأقلية كمفهوم وواقع مجتمعي لا تكون في قبالة ومواجهة القوميات والوطنيات. ويُسيء إلى جميع هذه المفاهيم من يجعل من مفهوم الأقلية مواجهاً لمفهومَي القومية والوطنية؛ لأنه من المكوِّنات الأساسية لكل قومية ووطنية هويات متعدِّدة إما دينية أو مذهبية أو أثنية أو لغوية. ويبدو أننا من دون فهم واقع الأقليات والإثنيات في العالم العربي، وبلورة المعالجة الحضارية لهذا الواقع، من دون هذا سيبقى الواقع الداخلي والمجتمعي للعرب والمسلمين يعاني الكثير من الأزمات والاختناقات والنكبات؛ لأن العديد من الصراعات والحروب الصريحة والكامنة تجد جذورها ومسبَّباتها العميقة في هذا الواقع الذي يتمُّ التعامل مع الكثير من عناوينه وقضاياه بعيداً عن مقتضيات العدالة والحرية، وحينما نلحّ على ضرورة قراءة هذه المسألة ودراستها، بشكل معمَّق، لا نريد تبرير واقع الانقسام والتشظِّي، أو نُشجِّع أصحاب المصالح والمخطَّطات للاستفادة من هذه الفسيفساء أو التناقضات والتباينات، وإنما نريد بناء مفهوم الوحدة الوطنية في كل بلد عربي على قاعدة أكثر حرية وعدالة ومساواة.
إننا نقف بقوة وحزم ضد كل محاولات التفتيت والانقسام في العالم العربي، كما أننا نقف بالدرجة نفسها ضد محاولات التجاهل والتغييب لمشكلاتنا العربية الحقيقية. ولكي ترتفع الأقليات والإثنيات من دوائرها التقليدية وكياناتها الذاتية إلى مستوى المواطنة الجامعة، فهي بحاجة إلى عوامل موضوعية وسياسية، تُساهم في إشراك هذه الدوائر في بناء مفهوم الأمة والأوطان الحديثة.
ولقد علَّمتنا التجارب أن التعامل القهري مع هذه الكيانات الأقلوية والإثنية لا ينهي الأزمة، ولا يُؤسِّس لمفهوم حديث للأمة والوطن، وإنما يشحن المجتمع بالعديد من نقاط التوتُّر، ويدفع هذه الكيانات إلى الانكفاء والانعزال، وبهذا تبقى أزمة الثقة قائمة دون حلول حقيقية لها.
وإن إدامة العصبيات الدينية والمذهبية والإثنية في العالم العربي ستحول دون القدرة على بناء دولة عربية حديثة، حاضنة لجميع مواطنيها، وهي في الوقت ذاته تعبير حقيقي عن كل مكوِّناتها وتعبيراتها. ولا سبيل لضبط هذه العصبيات، وإبقائها في حدودها الطبيعية من دون مشروع وطني متكامل في كل بلد عربي، يستهدف دمج كل التعبيرات والأطياف في إطار مشروع وطني متكامل. الدمج الذي يتمُّ بوسائل حضارية-سلمية، بعيداً عن سياسات القسر والعسف.
وبهذه الطريقة يتمكَّن العالم العربي من إخراج مفهوم وحقائق الأقليات من عنوان لمشكلة أو أزمة إلى عنوان حضاري لاحترام التعدُّدية بكل أشكالها في الجسم العربي بعيداً عن خيارات النبذ والإقصاء والشعور بالتهميش والمظلومية.
في فقه الاستماع:
في كل المنظومات الأيديولوجية والفكرية ثمَّة أنظمة معرفية ذات طابع معياري، ولا يمكن إدراك جوهر هذه المنظومات الأيديولوجية وآفاقها الإنسانية من دون فهم الأنظمة المعرفية، التي تصوغ نظام الإرسال والاستقبال، وتُحدِّد معايير التقويم وآليات اتِّخاذ المواقف من القناعات والأفكار والنظريات على ضوئها من الأشخاص. وفي الدائرة الإسلامية ثمَّة أنظمة معرفية تُؤكِّد عليها آيات الذكر الحكيم والسُّنةَّ المعصومة، وتُشكِّل هذه الأنظمة المعرفية المرتكز الأساسي لفهم مدارك القيم ومقاصدها العليا.
ومن هذه الأنظمة المعرفية القرآنية نظام الاستماع، بوصفه أحد سُبُل المعرفة، والرابط بين نظام القول ونظام الفعل.
وسنحُاول في هذا السياق، تظهير عناصر هذا النظام المعرفي بوصفه أحد الأجهزة القيمية والأخلاقية والمعيارية، التي تحول دون التأثُّر السلبي من أقوال الآخرين ومؤسساتهم الإعلامية، بوصفها الشكل المؤسسي لنظام القول الديني والسياسي والثقافي والاجتماعي والأخلاقي.
الحاجة إلى نظام الاستماع:
تتأكَّد حاجتنا إلى تظهير مفردات وعناصر نظام الاستماع مع ثورة المعلومات وانتشار سلع التقنية الحديثة التي قرَّبت بين الأمكنة والأزمنة، وألغت المسافات، وأضحى الإنسان قادراً في لحظات بسيطة أن يتواصل مع الإنسان الآخر في أيَّة بقعة من بقاع الأرض.
ولا ريب في أن إحدى متواليات هذه الثورة المعرفية والمعلوماتية هي توفُّر كل أقوال الأمم والمجتمعات عبر وسائل إعلامهم المتعدِّدة. ونظام الاستماع لا يُلغي إمكانية التواصل مع أقوال الأمم والمجتمعات والحضارات، وإنما يُوفِّر نظاماً معرفيّاً لتحديد الصائب من الأقوال والسقيم.
فالنظام المعرفي الذي يُرسي أسسه ومرتكزاته القرآن الحكيم، لا يعرف الحظر وصمَّ الآذان، وإنما يُفسح المجال للاستماع واستيعاب مختلف الأقوال، وعلى ضوء المعايير القيمية مطالب باتِّباع أحسن الأقوال، إذ يقول تبارك وتعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزُّمَر: 18].
إطلالة على المصطلحات:
ثمَّة مقولات ومصطلحات متداولة في آيات الذكر الحكيم لا يُمكننا تظهير نظام الاستماع من دون تحديد معاني هذه المصطلحات.
وقبل تحديد معنى هذه المصطلحات، سنستعرض بعض الآيات القرآنية التي تضمنت هذه المقولات والمصطلحات.
1- قال تعالى: {وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعرَاف: 204].
2- {وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلإِنْسانِ عَدُوّاً مُبِيناً} [الإسرَاء: 53].
3- {وَإِذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هَذا إِنْ هَذا إِلاّ أَساطِيرُ الأَوَّلِينَ} [الأنفَال: 31].
4- {وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ ما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البَقَرَة: 93].
5- {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ} [يُونس: 31].
6- {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُوكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاّ أَساطِيرُ الأَوَّلِينَ} [الأنعَام: 25].
وغيرها من الآيات التي تضمَّنت هذه المفردات والمصطلحات.
أما المصطلحات التي تحتاج إلى تحديد دقيق لمعناها، فهي كالآتي:
1- السمع: يقصد به استقبال الأذن ذبذبات صوتية من دون إعارتها اهتماماً.. فهو (أي السمع) عملية فسيولوجية تعتمد على الأذن وقدرتها على التقاط الذبذبات، وبالتالي فإنها عملية غير إرادية تتمُّ دون بذل جهدا أو مشقَّة، وهي مفردة تكرَّرت في القرآن الكريم (27) مرة، منها قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ} [المؤمنون: 78]، {وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسرَاء: 36].
2- الاستماع: وهو يعني فهم الكلام والانتباه إلى الشيء المسموع، وهو عملية إنسانية مقصورة، تهدف إلى الفهم والتحليل والتفسير ثم البناء الذهني.
3- الإنصات: ويُقصد به السكون والاستماع للحديث مع تركيز الانتباه مع الإصغاء التام، وأصغى إليه رأسه وسمعه أي أماله، والميل حسِّي ومعنوي، كأن تميل إلى مُحدِّثك، وتقترب منه بسمعك ورأسك وجسدك،
وقد يكون داخليّاً بأن تميل إليه بقلبك.. قال تعالى: {إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التّحْريم: 4].
4- القول الحسن: الكلام في حدِّ ذاته حروف مركَّبة تدلُّ على معنى في ذاته، وحسن المعنى وقبحه ينعكسان على تلك الألفاظ التي تحكي تلك المعاني، فيتحوَّل اللفظ إلى حَسَن أو أحسن أو قبيح على حسب الدلالة التي تدلُّ على المعنى.
لذلك، يقول تبارك وتعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ} [إبراهيم: 24].
وجاء في تفسير الآية الكريمة {وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الإسرَاء: 53]:
«كيف تكون الكلمة التي يُطلقها الإنسان في الحوار أو التخاطب الاجتماعي؟ هل هي الكلمة التي يُوحي بها المزاج، في لحظة انفعال، أو نزوة هوى، أو هي الكلمة التي يخطط لها العقل، ويُحرِّكها الإيمان؟ إن للكلمة مدلولها في حسابات الفعل وردِّ الفعل، وأثرها السلبي أو الإيجابي في حركة العلاقات الخاصة والعامَّة، وفي إثارة المشاكل أو في حلِّها.. وهذا ما يريد القرآن أن يُوجِّه الإنسان إليه في دراسة الفكرة التي يريد أن يُحرِّكها في المجتمع، ليختار الفكرة الأفضل التي تفتح القلوب على المحبَّة، والمشاعر على الرحمة، والعقول على الخير والحقيقة، ثم يدرس الكلمة الأحسن التي لا تختزن الحساسيات المعقَّدة، ليقول الكلمة الأحسن في اللفظ والمدلول. ولا بد له -في ذلك- من دراسة المسألة من جميع جوانبها بطريقة مقارنة ليرفض السيِّئ والأسوأ ويختار الحسن والأحسن».
ويبدو من منطوق (عبادي) أن هذا الخطاب الذي يستهدف قول الأحسن في كل المواقع والظروف موجَّه إلى عموم الإنسان. فالمطلوب من الإنسان فرداً وجماعةً وفي أيّ بيئة اجتماعية أو دينية أو قومية أن يقول التي هي أحسن؛ لأن هذه القيمة تُساهم في تعزيز قيم المحبَّة والسلام بين الناس، وفي الدائرة الإيمانية تتعمَّق وتتعزَّز الصلة الروحية والأخلاقية بين المؤمنين، لالتزامهم بقول التي هي أحسن في كل المواقع ومهما كانت المناخات والظروف.
في تفكيك ظاهرة الكراهية:
تفكيك هذه الآفة الخطيرة، وإنهاء موجباتها وأسبابها المباشرة وغير المباشرة، يقتضي العمل على تنقية الراهن وبناء العلاقة بين أهل الوطن الواحد ومنظومة الحقوق والواجبات على قاعدة المواطنة الجامعة، حيث لا يكون كرهي لأحد (لا سمح الله) سبباً لحرمانه من حقوقه الطبيعية والأساسية، كما لا يكون حبي لأحد هو الدافع لمنحه امتيازات تتجاوز حقوقه الطبيعية.
ثمَّة موجات عنفية خطيرة تجتاح بعض الدول العربية، حيث القتل العشوائي اليومي، والذي يذهب ضحيته العشرات من الأبرياء، وتزيد هذه الموجات العنفية من أزمات وصعوبات الحياة، حيث لا تكتفي هذه الموجات بقتل البشر، وإنما -أيضاً- تقوم بتدمير البنى التحتية للمدن، وتُنهي كل أسباب الحياة الطبيعية في المناطق التي تقتل وتفجّر فيها.
والذي يزيد من خطر هذه الموجات العنفية هو أنها تتغذَّى من مقولات دينية تُبرِّر عمليات القتل والتفجير، وتُساهم في خلق موجة من الكراهية بين الناس والمواطنين لأسباب دينية ومذهبية وقومية، ما يزيد من مخاطر عمليات القتل والتفجير، ويُدخل هذه البلدان في أتون العنف والعنف المضاد والكراهية المتبادلة؛ لذلك فإن العمل على تفكيك خطاب الكراهية ومقولاته المتعدِّدة يُعدُّ اليوم من الضرورات القصوى لأمن واستقرار المنطقة. وفي سياق العمل على تفكيك هذا الخطاب من الضروري القول إن ثمَّة أفكاراً وقناعات عديدة حين التفكير في الإجابة عن السؤال المتعلِّق بطبيعة ظاهرة الكراهية في المجتمعات الإنسانية؛ لأن الإجابة السريعة تقول: إن الكراهية بين الناس تتمُّ لأسباب دينية أو مذهبية أو قومية، لذلك فهي ظاهرة دينية-ثقافية، ولا دخل للسياسي في إنتاج ظاهرة الكراهية.
ولكن حين التأمُّل في هذه الظاهرة المعقَّدة والمركَّبة نجد أن جوهرها العميق جوُّه سياسي؛ بمعنى أن ممارسة الكراهية تتمُّ لأغراض سياسية دنيوية، حيث يسعى الطرف الممارس إلى إزاحة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى عن طريقه من أجل غايات سياسية بحتة. ولأن النخب السياسية السائدة تعتمد باستمرار في إدارة شعبها على قوتين أساسيتين وهما: القوة الخشنة-الصلبة عبر وسائلها المباشرة وقدراتها الصلبة، والقوة الناعمة التي تستدعي خطابات دينية وثقافية وإعلامية، تُغطِّي ممارسة صانع الكراهية، وتُبرِّر له نهجه الفئوي والعصبوي. ومن المؤكَّد في هذا السياق، أن الدين كمؤسسة ومقولات أيديولوجية يستخدم في تبرير عملية النبذ والطرد الذي من متوالياته ومقتضياته بثُّ الكراهية بين المواطنين لأسباب دينية أو قومية.
ولكن لو غاب الانحياز الديني أو القومي الذي يمارس لأغراض سياسية دنيوية، لما برزت حالة الكراهية بين المواطنين لعناوين دينية أو قومية.
ولكن الإرادة السياسية والخيار السياسي هما اللذان يُوقظان الخصوصيات على نحو سلبي، فينتج من جرَّاء ذلك التباغض والكراهية بين المواطنين؛ لأن جميع المواطنين بدؤوا يتلمَّسون حقيقة أن انتماءهم الديني أو المذهبي أو القومي له مدخلية أساسية في نيل حقوق المواطنة الكاملة أو منعها عنهم. فلذلك تنمو الحساسيات بين المواطنين، والتي تنتهي بحالة من الجفاء المستحكم؛ لأن الطرف الممارس للكراهية حصل على الخيرات لاعتبارات غير كسبية لا دخل له فيها، لذلك سيستميت هذا الإنسان إلَّا ما ندر لإبقاء هذه الامتيازات القائمة في جوهرها لأسباب سياسية ودنيوية لا دخل للمقولات الدينية الجوهرية فيها.
وفي المقابل، فإن الطرف أو المكوِّن المطرود من نيل حقوقه لاعتبارات لا دخل له فيها في الغالب سيندفع من الناحية السيكولوجية للتشبُّث بخصوصياته، وسيرفع مظلوميته، وسيُطالب بإنصافه وجماعته الدينية أو المذهبية أو القومية.
من هنا، فإن تفكيك هذه الآفة الخطيرة يتطلَّب من جميع الدول العربية والإسلامية العمل من أجل التالي:
1- سيادة القانون ورفض اختراقه أو تجاوزه، حيث يكون التعامل مع جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم ومنابتهم وأصولهم على حدٍّ سواء، فللجميع كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات.
فكل المجتمعات الإنسانية تعيش حقيقة التعدُّدية والتنوُّع بكل إبعاده وآفاقه، وبعضها دخلت بسبب هذه التنوُّعات في حقبة من حقب الزمن في صراعات وصدامات دموية، ولكن الجميع لم يتمكَّن من تفكيك ظاهرة الصدام الدموي بين حقائق التنوُّع إلَّا ببناء منظومة قانونية متكاملة، تكون هي مرجعية الجميع، وتضمن حق الجميع من دون افتئات على أحد لأيِّ سبب من الأسباب، ولا تكتفي هذه المجتمعات ببناء مرجعية قانونية، وإنما تعمل بكل إخلاص لكي يكون لهذه المرجعية سيادة وحاكمية على الجميع؛ لذلك فإن سيادة القانون هي أحد المداخل الأساسية لبناء علاقات سوية وإيجابية بين جميع تعبيرات الوطن والأمة.
2- إعادة بناء رؤية وموقف حضاريين من أحداث التاريخ ورجاله؛ لأن الكثير من الموضوعات التي تُثير الكراهية بين المسلمين تعود إلى التاريخ، ونحن جميعاً لا نتحمَّل مسؤولية ما جرى في التاريخ، فرجال تلك الحقبة هم وحدهم من يتحمَّل مسؤولية ما جرى في راهنهم؛ لذلك آن الأوان بالنسبة لنا جميعاً ومن مختلف مواقعنا أن نتحرَّر من عبء التاريخ، ونبني علاقاتنا وفق معطيات راهننا ومستلزمات استقرارنا الاجتماعي والسياسي.
3- تطوير نظام الشراكة العامة على قاعدة المواطنة الجامعية واحترام الخصوصيات الثقافية والمجتمعية، دون تحويلها إلى مبرِّر للانكفاء والانعزال.
ومن الضروري في هذا السياق، أن نُفرِّق بين مرحلتين في التجربة العربية؛ المرحلة الأولى هي ما قبل الموجة الأصولية التي اجتاحت المنطقة العربية بعد انتصار الثورة في إيران وحقبة الجهاد في أفغانستان، وهي موجة ساهمت بطريقة أو بأخرى في إشعار الجميع وعلى نحو عدائي في حدوده الدنيا بين الذات والآخر بقاعدة الهوية الضيِّقة التي يحملها الإنسان ووجوده الاجتماعي، وفي هذه المرحلة ازداد منسوب الخصومة والكراهية بين المختلفين والمغايرين من جرَّاء الخوف المتبادل والتباين في المواقف والنظرات تجاه أحداث وتطوُّرات المنطقة.
فالموجة الأصولية ساهمت في بناء الحدود بين الناس على قاعدة الهوية الدينية أو المذهبية، لذلك تراجعت حقائق التسامح وازدادت صور الإحن بين الناس على قاعدة دينية أو مذهبية.
أما مرحلة ما قبل الموجة الأصولية، فكانت العلاقة قائمة في أغلبها على الوُدِّ والتسامح والتديُّن الشعبي الذي يسمح بالاختلاف، ويتعامل مع تجلياته بروح المحبَّة والمودَّة، وإن كانت هناك نوازع كراهية كامنة في النفوس والعقول.
لذلك، ثمَّة قناعة عميقة على هذا الصعيد، وهي أن إنهاء موجة الكراهية الدينية والمذهبية والقومية التي تجتاح المنطقة اليوم ولأسباب سياسية تتغذَّى من خطاب ديني متشدِّد أو مقولات مذهبية متعصِّبة، لا يتمُّ إلَّا بالعودة إلى التديُّن الشعبي الذي لا يحمل خوفاً من وعلى المرأة، ولا يدعو إلى المفاصلة الشعورية والعملية بين المختلفين، وتبرز في ثناياه مضامين إنسانية رائعة تتجاوز التباينات التاريخية والفروقات المذهبية لصالح متَّحد اجتماعي قائم على المعايشة والتواصل والصحبة الإنسانية.
التعدُّدية والممارسة العربية الحديثة:
لعل من أهم حقائق المجتمع الإنساني هو أنه مُتعدِّد ومُتنوِّع أفقيّاً وعموديّاً، ولا يمكن إدارته على نحو إيجابي إلَّا بإدارة حقائق تنوُّعه بطريقة حضارية، تسمح لهذه الحقائق أن تُمارس دورها في إذكاء حالة التنافس الإيجابي بين مكوِّنات المجتمع، وتُثري الواقع الاجتماعي على المستويات الإنسانية المختلفة.
ثمَّة فروقات جوهرية بين مفهوم المجتمع الإنساني ومفهوم السديم البشري؛ فالأول يلحظ الخصوصيات اللغوية والثقافية والتاريخية للجماعة البشرية، ويُرتِّب على ضوء هذه المعرفة الخيارات المناسبة والسياسات القادرة على إدارة جماعة بشرية بخصائص ثقافية متنوِّعة ومستويات اجتماعية متفاوتة ومصالح عامة قد تكون متباينة أو متزاحمة. وسديم بشري لا يلحظ كل هذه الحقائق ومقتضياتها النفسية والاجتماعية والثقافية.
وثمة خبرات إنسانية عديدة، تراكمت في سياق إدارة واقع التعدُّدية. ونودُّ في هذه السطور أن نقترب من واقع الخبرة العربية في إدارة واقع التعدُّدية في المجتمعات العربية. ولو درسنا الممارسة والخبرة العربية المعاصرة في التعامل مع حقائق التنوُّع والتعدُّد الأفقي والعمودي الموجودة في البلدان العربية لرأينا أن هذه الممارسة لا تخرج من الخيارات التالية:
1- إن المختلفين معنا هم موضوع للتذويب والدمج القسري؛ لأنهم من الناحية الدينية ليسوا مثالاً صالحاً ومتكاملاً؛ لأن لديهم هرطقات دينية وانحرافات عقدية، كما أنهم من الناحية السياسية يُشكِّلون بطريقة أو بأخرى طابوراً خامساً لقوى أجنبية، تحاول هذه القوة أن تعبث بأمننا واستقرارنا من خلال هذا الطابور الخامس، وبالتالي وحفاظاً على الأمن الوطني أو القومي، ثمَّة ضرورة للتذويب والتفكيك بوسائل عديدة للمجموعات البشرية الأخرى المختلفة مع الأكثرية، سواء في الدين أو المذهب أو القومية أو العرق.
ولا شك أن هذا الخيار بمتوالياته الأمنية والسياسية والاجتماعية، كلَّف المنطقة العربية الكثير، حيث الأزمات وغياب الاستقرار السياسي العميق، وشعور فئات عديدة في المجتمع أنه يتمُّ التعامل معها بتمييز وبعيداً عن مقتضيات المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
2- خيار النبذ والطرد والقمع والتهميش والإبعاد عن كل المسؤوليات الوطنية، سواء الكبرى أم المتوسطة.
ويتمُّ في سياق تغطية خيار النبذ والتهميش تأسيس خطابات دينية متطرِّفة أو قومية شوفينية، تُبرِّر وتسوغ للسلطات السياسية فعل النبذ والطرد والتهميش؛ لذلك نستطيع القول على صعيد الواقع العربي المعاصر: إن أغلب الدول العربية بتفاوت محدود بينها سقطت في امتحان التعدُّدية؛ لأنها في أغلب خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي منحازة ضد الأقليات، ولا يتَّسع صدرها وقلبها وعقلها إلى احترام خصوصية هذه الأقليات، والتعامل مع أهلها بوصفهم مواطنين لهم ما لبقية المواطنين وعليهم ما على بقية المواطنين.
ومن جرَّاء هذا السلوك المشين في التعامل مع الأقليات في العالم العربي، تعمَّقت مشكلات سياسية واجتماعية وأمنية عويصة ومركَّبة، وتشكَّل خاصرة رخوة في كل المشهد العربي المعاصر.
3- ويبقى الخيار الذي ندعو إليه، ونعتبره هو الخيار الذي ينسجم مع قيم الأديان التوحيدية ومواثيق حقوق الإنسان والمنظومات الدستورية الحديثة، ألا وهو خيار المواطنة المتساوية، الذي لا يُفرِّق بين مواطن أو آخر لأيِّ اعتبار من الاعتبارات.
ولا شك في أن تحقيق هذا الخيار وسيادته في العالم العربي يتطلَّب تفكيك نزعات البغض والكراهية، والتي تتغطَّى بمقولات دينية طاردة للمختلف والمغاير الديني أو المذهبي، أو مقولات قومية شوفينية طاردة للمختلف والمغاير القومي؛ لأننا نعتقد أن بنية النزعات القدحية والإكراهية هي تنتج باستمرار خيار تنمية الفوارق والاختلافات بين المواطنين؛ لأنها في جوهرها ليست دولة لجميع المواطنين، وإنما هي دولة لبعض المواطنين. ولا فرق في هذا السياق بين الدولة العربية التقدُّمية، التي تطرد باسم العرب والقومية العربية تعبيرات ومكوِّنات عديدة من الاجتماع العربي المعاصر أو باسم الدين ومشروع الإسلام السياسي؛ لأنها -أيضاً- تمارس التفرقة بين المواطنين، وليست قادرة بنيويّاً على أن تكون -كمؤسسة- التعبير الدقيق والشامل لكل حساسيات مواطنيها.
إننا نعتقد أن الدول الأيديولوجية، سواء كانت قومية أم دينية في التجربة العربية المعاصرة، هي دول غير قادرة على بناء دولة مواطنة، بل هي دولة القوم أو الطائفة وبقية العناوين الأخرى. لذلك هي دول بالضرورة تمارس التمييز بين المواطنين. ولا خيار أمام العرب في اللحظة الراهنة لإدارة حقائق التعدُّد والتنوُّع إلَّا ببناء دولة مدنيَّة حاضنة لجميع المواطنين، وتتعامل مع جميع المواطنين بوصفهم مواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم.
وإننا نعتقد أن مشكلة الكراهية السائدة لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية في المشهد العربي المعاصر، هي في جوهرها مشكلة سياسية، وإن وظّفت الخطابات الدينية المتطرِّفة والمقولات القومية الشوفينية، ولا قدرة فعلية لمعالجة ظاهرة الكراهية في المنطقة العربية إلَّا بتفكيك بنيتها العميقة، وبناء وقائع اجتماعية-تعدُّدية-مدنيَّة.
ونُدرك وفق المعطيات السياسية والاجتماعية والثقافية القائمة في المنطقة العربية اليوم أن الوصول إلى هذا الهدف ما زال بعيد المنال، وما زالت هناك عقبات وصعوبات جوهرية تعترض العرب جميعاً للوصول إلى بناء الدولة المدنية-الديمقراطية، ولكن صعوبة الطريق لا تُلغي صوابية الفكرة والمقصد؛ لأن التجربة الغربية -مع اختلافات على مستوى السياقات التاريخية والشروط الثقافية والتحوُّلات السياسية- لم تتمكَّن من إنهاء وتفكيك ظاهرة الكراهية التي أنتجت مع عوامل أخرى حروب المئة عام إلَّا بتفكيك البنية الشمولية-الإلغائية وبناء دولة مدنيَّة جديدة. وحدها الدولة المدنية التي قدرت في التجربة الغربية على إنهاء التطاحن الأهلي والحروب الدينية-المذهبية.
ونحن نعتقد أن الواقع العربي المعاصر لن يخرج من دوَّامة الاقتتال والعنف العبثي ومقولات التحريض وبثِّ الكراهية إلَّا ببناء دولة المواطنة.
التعدُّدية والاحترام المتبادل:
لا نُفشي سرّاً من الأسرار حين نقول: إن مجتمعنا كبقية المجتمعات الإنسانية يحتوي تعدُّديات وتنوُّعات عديدة، وإن هذه التعدُّديات إذا أُحسن التعامل معها تتحوَّل إلى مصدر إثراء وحيوية لمجتمعنا ووطننا، وإن وجود هذه الحقيقة في أيِّ مجتمع إنساني ليس عيباً يجب إخفاؤه، أو خطأ ينبغي تصحيحه، وإنما هو جزء طبيعي من حياة المجتمعات الإنسانية، بل هو أحد نواميس الوجود الإنساني. فالأصل في المجتمعات الإنسانية أنها مجتمعات متعدِّدة ومتنوِّعة. وإن شقاء المجتمعات لا ينبع من وجود هذه الحقيقة، وإنما من العجز عن صياغة أنظمة اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية قادرة على إدارة هذه الحقيقة من دون افتئات وتعسُّف. وعليه، فإن أيَّ محاولة لطمس هذه الحقيقة، أو التعدِّي عليها، هو إضرار باستقرار المجتمع، وإدخال الجميع في أتون المماحكات والسجالات التي تضرُّ بالأمن الاجتماعي والسياسي.
وقبولنا بحقيقة التعدُّدية لا يعني أن المطلوب هو أن تتطابق وجهات النظر والرؤية في كل شيء؛ فمن حقِّ أيِّ طرف ديني أو مذهبي أو قومي أن يختلف في رؤيته عن الطرف الآخر، ولكنه الاختلاف الذي لا يقود إلى الإساءة أو التعدِّي على الخصوصيات والرموز. من هنا، فإننا ندعو جميع تعبيرات المجتمع وأطيافه المختلفة للعمل على نهج وطني متكامل، قابل بحقيقة التنوُّع والتعدُّدية، ويثبت مبدأ الاحترام المتبادل على مستوى الوجود والرأي. فليس مطلوباً مناَّ جميعاً، من مختلف مواقعنا الدينية أو المذهبية أو الفكرية، أن تتَّحد نظرتنا إلى كل القضايا والأمور، أو تتطابق وجهات نظرنا في كل أحداث التاريخ أو شخوصه. ولكن المطلوب مناَّ جميعاً هو أن نحترم قناعات بعضنا البعض، وأَلَّا نسمح لأنفسنا بأن نُمارس الإساءة لقناعات أو أفكار الأطراف الأخرى.
إننا نرفض نهج السَّبِّ والشتيمة، وإطلاق الأحكام القيمية الجاهزة. وإننا نعترف باختلافنا الفكري أو تعدُّدنا الديني أو المذهبي، ولكن هذا الاعتراف يُلزمنا صيانة حق الإنسان الآخر في الاعتقاد والانتماء. فالتعدُّدية بكل مستوياتها لا يمكن أن تُدار على نحو إيجابي إلَّا بمبدأ الاحترام المتبادل؛ بمعنى أن من حقِّ أيِّ إنسان أن يعتزَّ بقناعاته الذاتية، ولكن ينبغي أَلَّا يقوده هذا الاعتزاز إلى الإساءة إلى الآخرين. فبمقدار اعتزازه بذاته وقناعاتها، بالقدر ذاته ينبغي أن يحترم قناعات المختلف واعتزازاته.
وبهذه الكيفية نُخرج طبيعة العلاقة بين المختلفين من دائرة السجال والاتِّهام وسوء الظن والبحث عن المثالب والقراءات النمطية، إلى دائرة العلاقة الإنسانية والموضوعية، القائمة على الاعتراف بحق الجميع بالاختلاف وضرورات الاحترام المتبادل بكل صوره وأشكاله.
وفي سياق العمل على ضبط حقيقة التعدُّدية بكل مستوياتها بمبدأ الاحترام المتبادل، أودُّ التطرُّق إلى النقاط التالية:
1- إن كل الناس على وجه هذه البسيطة يعيشون انتماءات متعدِّدة، وإن العنصر الحيوي الذي يُؤدِّي إلى تكامل هذه الانتماءات بدل تناقضها أو تضادها هو الاحترام المتبادل.
فكل الناس ينتمون إلى عوائل وعشائر وقوميات وأديان ومذاهب، وبإمكان كل هذه الدوائر في حياة الأفراد والجماعات أن تكون متكاملة ولا تناقض بينها. والبوابة الحقيقية لهذا هو الالتزام بمقتضيات الاحترام المتبادل، حيث يحترم كل واحد منا دين الآخر أو مذهبه، كما يحترم عائلته أو عشيرته أو قبيلته. واعتزاز الناس بدوائر انتمائهم لا يعني الإساءة إلى انتماءات الآخرين بكل دوائرها ومستوياتها. فالتناقض بين هذه الانتماءات ليس تناقضاً ذاتيّاً وإنما عرضي؛ بمعنى حين تغيب قيمة الاحترام المتبادل تنمو الوقائع والمناخات المضادَّة لتكامل دوائر الانتماء، أما إذا ساد الاحترام المتبادل فإن تكامل هذه الدوائر يكون طبيعيّاً ومثمراً.
فالاعتزاز بالدين أو العائلة أو أيَّ دائرة من دوائر الانتماء الطبيعية في حياة الإنسان ليس جريمة، ما دام لا يُؤدِّي إلى رفض المشترك أو تجاوز مقتضيات الاحترام المتبادل.
فالعرب جميعاً اليوم ينتمون إلى أوطان متعدِّدة، وبيئات اجتماعية مختلفة، وتجمُّعات إقليمية متنوِّعة، إلَّا أنهم جميعاً يعتزُّون بعروبتهم وبكل عناصرهم المشتركة.
ولا يرى المواطن العربي -سواء في المشرق أم المغرب- أيَّ تناقض بين اعتزازه بوطنه ومنطقته، واعتزازه بعروبته وقوميته.
وما يصحُّ على المواطن العربي على الصعيد القومي، يصحُّ عليه في مختلف دوائر الانتماء.
2- نعيش جميعاً ولاعتبارات عديدة لحظة تاريخية حسَّاسة، يمكن أن نُطلق عليها لحظة انفجاريات الهويات الفرعية في حياة الناس والمجتمعات.
وهذه اللحظة يجب أن يتمَّ التعامل معها بحكمة وعقلية تسووية.
فليس مطلوباً -على الصعيد الاجتماعي والوطني- أن ينحبس الناس في هوياتهم الفرعية؛ لأن هذه الانحباس والتوتُّر المترتِّب عليه يقود إلى المزيد من الأزمات؛ لذلك فإن المطلوب هو التعامل بوعي وحضارية مع هويات الناس الفرعية، حيث تتوفَّر لجميع المواطنين الأقنية المناسبة والأطر القادرة لاستيعابهم وإزالة الالتباسات والهواجس، حتى لا يتمُّ التعامل مع هذه الهويات بوصفها أطراً نهائية لا يمكن التحرُّر منها.
3- إن مقولة الاحترام المتبادل تتضمَّن الموقف الإيجابي من الآخر المختلف والمغاير، والكلمة الطيبة، وعدم الاكتفاء بأدنى الفهم فيما يتعلَّق والرؤية ومعرفة الآخر، وسن القوانين الناظمة للعلاقة بين مختلف التعدُّديات. فنحن حينما نتحدَّث عن الاحترام المتبادل لا نتحدَّث فقط عن الجوانب الأخلاقية، وإنما نحن نتحدَّث عن كل مقتضيات الاحترام المتبادل، سواء على صعيد السلوك الشخصي أو الرؤية الثقافية والاجتماعية والالتزام السياسي والحماية القانونية. إننا نتحدَّث عن ضرورة حماية حقيقة التعدُّدية بكل مستوياتها في مجتمعنا من خلال بوابة الاحترام المتبادل.
وجماع القول: إننا نعتقد إنه لكيلا تتحوَّل هذه الحقيقة المجتمعية إلى مصدر للتوتُّر والأزمات نحن بحاجة إلى تعزيز خيار الاحترام المتبادل، حتى نتمكَّن من صيانة تنوُّعنا والمحافظة على استقرارنا الاجتماعي والسياسي.
احترام الإنسان:
ثمَّة حقيقة أساسية يُبرزها النص القرآني، وهي أن الإنسان هو صانع حركة الحياة ضمن السُّننَ الكونية والاجتماعية التي تُمثِّل القوانين التي أودعها الله في الكون وفي حركة الإنسان في المجتمع؛ لذلك يقول تبارك وتعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغِيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفَال: 53].
فالإنسان يتحرَّك في الحياة من خلال أفكاره، وحركة الأفكار هي التي تُمثِّل حركة الحياة؛ لأن حركة الحياة هي صورة ما نُفكِّر به. لذلك كله، فإن التغيير الذاتي على مستوى الطبائع والأفكار والقناعات هو قاعدة التغيير الاجتماعي والسياسي. فقضايا الاجتماع الإنساني لا تتغيَّر ولا تتحوَّل إلَّا بشرط التحول الداخلي-الذاتي-النفسي.
فالتعاليم القرآنية واضحة في أن في هذا الكون وحياة الإنسان سُنناً وقوانين، هي التي تتحكَّم في مسيرة الكون، كما أنها هي القوانين المسيِّرة لحياة الإنسان الفرد والجماعة.
والإنسان في المنظور القرآني هو نفحة ربانية استحقَّت التكريم التي تبوَّأها في أعلى مرتبة في الوجود، أعني الاستخلاف في الأرض بصريح الآية القرآنية {وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ} [البَقَرَة: 30].
ومن أجل ذلك استحقَّ الإنسان التكريم بقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً} [الإسرَاء: 70].
وحتى يُحقِّق الإنسان وظيفته على أحسن وجه كان كل ما في الوجود مسخَّراً لفائدته، وكان العالم مسرحاً لكل فعالياته بصريح آيات قرآنية عديدة، منها قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [الحَجّ: 65].
والكائن الإنساني في الرؤية القرآنية له القدرة والاستطاعة على ممارسة الحرية والاختيار؛ بمعنى أن الفعل الإنساني ليس خاضعاً لمقولات القسر والجبر، كما أنه ليس بعيداً عن قوانين الله سبحانه وأنظمته في الكون والمجتمع؛ بمعنى أن الباري عز وجل هو خالق أفعال الإنسان؛ لأنه بجميع أفعاله مخلوق الله، ولكن مع ذلك له استطاعة يحدثها الله فيه مقارنة للفعل. لذلك، فإن الإنسان مكتسب لعمله، والله سبحانه خالق لكسبه. فالفعل الإنساني -في مختلف دوائره ووجوده- هو خاضع لمنظومة من القيم والسُّننَ التي ينطلق الفعل الإنساني من خلال الالتزام بهذه المنظومة. فالإنسان ليس خالقاً لأفعاله، كما أنه ليس مجبوراً في أفعاله، وإنما هو «لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين». لذلك يقول تبارك وتعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَتَعالَى عَمّا يُشْرِكُونَ} [القَصَص: 68]. والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يُكلِّف الناس ما لا يُطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. فإرادة الله هي التي صنعت إرادة الإنسان، والإنسان هو الكائن الوحيد الذي اختار أن يكون قدره أكثر من إمكان واحد، وأوفر من احتمال واحد في الزمان والمكان. لهذا كله فإن احترام الإنسان وصيانة حقوقه من أعظم المهام والوظائف في حياة الإنسان في الوجود. فلا يصح بأيِّ شكل من الأشكال أن الباري عز وجل يُكرِّم الإنسان ويصون حرماته وحقوقه، ويأتي الإنسان ويمتهن حقوق الإنسان وكرامته.
إن التوجيهات الإسلامية تُؤكِّد -وبشكل لا لبس فيه- أنه لا يجوز بأيَّة حال من الأحوال انتهاك كرامة الإنسان أو التعدِّي على حقوقه ومكتسباته الإنسانية والمدنية.
والاختلافات العقدية والفكرية والسياسية بين بني الإنسان، ليست مدعاة ومُبرِّراً لانتهاك حقوقه أو التعدِّي على كرامته، بل هي مدعاة للحوار والتواصل وتنظيم الاختلافات وضبطها تحت سقف كرامة الإنسان وصون حقوقه.
ولقد آن الأوان بالنسبة لنا نحن العرب والمسلمين، إلى إعادة الاعتبار إلى الإنسان ومقاومة كل حالات التعدِّي على حقوقه ومكتسباته؛ فالاختلاف مهما كان شكله أو طبيعته، ليس مُبرِّراً ومُسوِّغاً لانتهاك حقوق الإنسان.
فالخالق سبحانه وتعالى أكرم الإنسان، ودعانا وحثَّنا جميعاً وعبر نصوص قرآنية عديدة على احترام الإنسان بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو فكره، وصيانة كرامته وحقوقه.
والحرية بوصفها مصدر المسؤولية لا تُفضي بالكائن البشري إلى اختيار الحق والعدل والخير بالضرورة، بل تجعل الاختيار مفتوحاً على جميع الاتجاهات والاحتمالات؛ لذلك كان التاريخ البشري حافلاً باختيار الظلم والشر إلى جانب العدل والخير، وكان الإنسان مسؤولاً عن ذلك كله. أما الكائنات الأخرى فليست مسؤولة عمَّا يعرض لها أو بسببها؛ لأنها ليست كائنات مختارة. فالباري عز وجل لم يخلق الإنسان خلقاً جامداً خاضعاً للقوانين الحتمية التي تتحكَّم فيه فتُديره وتصوغه بطريقة مستقرَّة ثابتة، لا يملك فيها لنفسه أيَّة فرصة للتغيير وللتبديل، بل خلقه متحرِّكاً من مواقع الإرادة المتحرِّكة التي تتنوعَّ فيها الأفكار والمواقف والأفعال، ممَّا يجعل حركة مصيره تابعة لحركة إرادته. فهو الذي يصنع تاريخه من خلال طبيعة قراره المنطلق من موقع إرادته الحرَّة، وهو الذي يملك تغيير واقعه من خلال تغييره للأفكار والمفاهيم والمشاعر التي تتحرَّك في واقعه الداخلي لتحرُّك الحياة من حوله.
وهكذا أراد الله للإنسان أن يملك حريته، فيتحمَّل مسؤوليته من موقع الحرية، ويدفعه إلى أن يواجه عملية التغيير في الخارج بواسطة التغيير في الداخل، فهو الذي يستطيع أن يتحكَّم بالظروف المحيطة به، بقدر علاقتها به، وليس من الضروري أن تتحكَّم فيه. فالإنسان هو صانع الظروف، وليست الظروف هي التي تصنعه. وعليه، فإن تطوير واقع الحرية في الحياة الإنسانية يتوقَّف على الإرادة الإنسانية التي ينبغي أن تتبلور باتجاه الوعي بهذه القيمة الكبرى أولاً، ومن ثَمَّ العمل على إزالة كل المعوِّقات والكوابح التي تحول دون الحرية. فالحرية في الواقع الإنساني لا تُوهب، وإنما هي نتاج كفاح إنساني متواصل ضد كل النزعات التي تعمل على إخضاع الإنسان وإرادته، سواء كانت هذه النزعات ذاتية مرتبطة بحياة الإنسان الداخلية، أم خارجية مرتبطة بطبيعة الخيارات السياسية والاقتصادية والثقافية، التي قد تُساهم في إرجاء الحرية أو تعطيلها ووأد بذورها الأولية وموجباتها الأساسية.
وما دام الإنسان يعيش على ظهر هذه البسيطة سيحتاج إلى الحرية التي تمنحه المعنى الحقيقي لوجوده. ولكي يُنجز هذا المعنى هو بحاجة إلى إرادة وكفاح إنساني لتذليل كل العقبات التي تحول دون ممارسة الحرية الإنسانية على قاعدة الفهم العميق لطبيعة عمل سُنن الله سبحانه في الاجتماع الإنساني. ومن هنا ومن خلال هذه المعادلة التي تربط الوجود الإنساني برمَّته بالحرية والإرادة والمسؤولية، فإن الكدح الإنساني سيتواصل، والشوق الإنساني إلى الحرية والسعادة سيستمر، والإحباطات والنزعات المضادَّة ستبقى موجودة وتعمل في حياة الإنسان؛ لذلك فإن الوجود الإنساني هو عبارة عن معركة مفتوحة بين الخير الذي ينشد الحرية والسعادة والطمأنينة القلبية، والشر الذي لا سبيل لاستمراره إلَّا البطر والطغيان والاستئثار.
ولكي ينتصر الإنسان في معركته الوجودية هو بحاجة إلى الإيمان والعلم والتقوى حتى يتمكَّن من هزيمة نوازعه الشريرة وإجهاض وتهذيب نزعات البطر والطغيان.
ولا يخفى أن شعور الإنسان بالأمن والطمأنينة في الحياة هو الشرط الضروري لكي يُقدم على العمل والإنتاج والتعمير في الأرض. ففي مناخ الأمن النفسي تنمو القدرات الذهنية وتتَّجه نحو الإبداع، وتنشط القدرات الإنجازية وتتضاعف فعاليتها ويزكو إنتاجها. فإنسانية الإنسان في جوهرها وعمقها مرهونة بحرية الإنسان؛ إذ إن الحرية هي شرط إنسانية الإنسان. وحينما يفقد هذا الشرط يفقد الإنسان مضمونه وجوهره الحقيقي؛ لذلك فإننا نرى أن احترام آدمية الإنسان، ومجابهة أيَّة محاولة تستهدف انتهاك حقوقه الأساسية، هي الخطوة الأولى في مشروع تحقيق إنسانية الإنسان. فالإنسان بكرامته وحرماته وحقوقه هو حجر الأساس في أيِّ مشروع تنموي أو تقدُّمي؛ لذلك فنحن بحاجة دائماً إلى رفع شعار ومشروع صيانة حقوق الإنسان وكرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو قوميته أو أيديولوجيته.
الاحترام المتبادل:
نشرت الصحف المحلية والعربية قبل أيام خبراً صغيراً مفاده: أنه تم اعتقال عالم الدين الإيراني يعسوب الدين رستكاري جويباري في مدينة قم الإيرانية، لأنه أهان مصادر التشريع، وآثار شكوكاً جِديَّة في أسس المعتقدات لدى إخواننا أهل السنة على حدِّ تعبير نص الخبر.
ولكن وللأسف الشديد، لم يأخذ هذا الخبر بمضمونه وآفاقه، حيِّزاً مهمّاً من التفكير والنقاش والحوار، حيث إن احترام التعدُّديات المذهبية والاجتماعية والفكرية والسياسية هو من أسس الاستقرار الاجتماعي والسياسي. صحيح أنه ليس مطلوباً أن تتطابق وجهات النظر في كل شيء، ولكن من المهم أن يتمَّ الاحترام العميق لأسس العيش المشترك، حيث يمتنع كل طرف من الإساءة إلى الطرف الآخر.
ولا شك في أن ظاهرة التنوُّع الاجتماعي والتعدُّد المذهبي والفكري والسياسي تُثير العديد من الأسئلة والتحدِّيات، ولا بد من بلورة إجابات حقيقية وواقعية لهذه الأسئلة والتحدِّيات. فليس صحيحاً أن نهرب من أسئلة التنوُّع وتحدِّيات التعدُّد برفضهما والركون إلى الفكر الأحادي والرؤية الأحادية.
لذلك، فإننا ينبغي أن نتعامل مع هذه الظاهرة الإنسانية، باعتبارها من الظواهر التي تُثير الكثير من الأسئلة، وتُطلق جملة من التحدِّيات، وواجبنا الفكري والأخلاقي يقتضي احترام هذا التنوُّع والتعدُّد، والبحث عن إجابات عن الأسئلة والتحدِّيات التي تُطلقها هذه الظاهرة الإنسانية الثابتة.
فإقامة الجدار العازل بيننا وبين حقيقة التعدُّد المذهبي والفكري والسياسي يمنعنا من الاستفادة من بركات هذه الحقيقة الإنسانية، ويحول دون بلورة إجابات دقيقة وعميقة لجملة التحدِّيات التي تُطلقها هذه الحقيقة.
لذلك كله، فإننا باستمرار بحاجة إلى مبادرات فكرية وخطوات قانونية وسياسية وجهد ثقافي متواصل، لتأصيل هذه الحقيقة في فكرنا وواقعنا الاجتماعي أولاً، ومن ثَمَّ العمل على بلورة حلول عملية وممكنة لكل التحدِّيات التي تبرز في واقعنا من جرَّاء التزامنا بخيار الاعتراف الكامل بحقوق كل التعدُّديات التقليدية والحديثة في ممارسة دورها ووظيفتها في الحياة الوطنية العامة.
وإننا بحاجة إلى مواطنة مبنيَّة على انتماء متكافئ بين متطلَّبات الخصوصيات وضرورات العيش والانتماء الوطني المشترك. فالتنوُّع بكل مستوياته ينبغي أَلَّا يقود إلى الانقسام والتشظِّي، بل ووفق الرؤية القرآنية ينبغي أن يقود إلى التعارف والوحدة.. إذ يقول تبارك وتعالى: {يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحُجرَات: 13].
والتعارف في الآية القرآنية الكريمة يختزن كل أبعاد وشروط التواصل الحقيقي بين مختلف التنوُّعات الإنسانية، كما أن هذه المقولة (التعارف) تشمل جميع الشرائح والفئات الاجتماعية. فالنظرة القرآنية تُؤكِّد أن الاختلاف ينبغي أن يقود إلى التعارف والاحترام لا إلى الخصومة والتباغض.
فالتنوُّع وسيلة من وسائل التعارف، باعتبار حاجة كل فريق من هذه الدائرة إلى ما يملكه الفريق الآخر في الدائرة الأخرى، من خصوصياته الفكرية والعملية ليتكاملوا في الصيغة الإنسانية المتنوِّعة ليكون التعارف غاية للتنوُّع، بدلاً من التحاقد والتناحر والتنازع.
ويبقى التعارف غاية إنسانية من أجل إغناء التجربة الحيَّة المنفتحة على المعرفة المتنوِّعة، والتجربة المختلفة للوصول إلى النتائج الإيجابية في مستوى التكامل الإنساني.
وإن إلغاء الخصوصية لا يُمثِّل نهجاً واقعيَّاً في التعاطي مع الواقع الاجتماعي والثقافي؛ لأن الإلغاء من قبل أيِّ طرف لا يُغيِّر شيئاً من المسألة في طبيعتها الذاتية، أو من تأثيراتها الموضوعية، باعتبار أنها تُمثِّل بعداً في عمق الذات، لا مجرَّد حالة طارئة على الهامش، ممَّا يجعل من مسألة الإلغاء مشكلة غير قابلة للحلِّ، بل ربما تضيف إلى المشكلة مشكلة أخرى على صعيد الحالة النفسية والعملية.
وعلى ضوء ذلك، فإن الدين الإسلامي يُشجِّع على تحرُّك الخصوصية في دائرتها الداخلية في الجانب الإيجابي الذي يدفع الإنسان للتفاعل عاطفيّاً وعمليّاً مع الذين يشاركونه هذه الخصوصية في القضايا المشتركة، ولكن بشرط ألَّا تتحوَّل إلى عقدة عصبية ذات بُعد عدواني تجاه الآخرين؛ لذلك فإن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن أن يُعين قومه على الظلم. فإلغاء خصوصيات الإنسان الذاتية والدينية والمذهبية لا يُعدُّ نهجاً صحيحاً وواقعيّاً؛ لأنه لا يزيد الإنسان إلَّا تمسُّكاً وتشبُّثاً بهذه الخصوصيات؛ وذلك لأنها ليست حالة طارئة وهامشية، وإنما من صميم الذات الإنسانية.
لذلك، نجد أنه على المستوى التاريخي لم يكن التعدُّد الفقهي والمذهبي في التجربة التاريخية الإسلامية مظهراً من مظاهر الانقسام والتشظِّي في الدائرة الإسلامية، بل دليل حيوية عقلية وفكرية ومناخ اجتماعي حر ومنفتح أدَّى إلى تطوير عملية الاجتهاد ونشوء الاتِّجاهات الفكرية والسياسية في الدائرة الإسلامية.
لذلك، فإن احترام هذا التعدُّد والتنوُّع يعني فيما يعني حماية؛ لأنه نتاج الحوار والبحث المضني والمتواصل عن الحقيقة. وحينما نقول بضرورة حماية التعدُّد في الدائرة الوطنية، فإننا نقصد حماية تلك القيم والمبادئ التي أنتجت ثراءً فقهيّاً وفكريّاً وعلميّاً في التجربة التاريخية الإسلامية. فلا يمكن أن نفصل ظاهرة تعدُّد المدارس الاجتهادية والفقهية في تجربتنا التاريخية عن قيم الحوار والاعتراف بالآخر وجوداً ورأياً، وتوفّر المناخ الاجتماعي المؤاتي للاجتهاد بعيداً عن ضغوطات السياسة أو مسبَّقات التاريخ.
وإن دعوتنا الراهنة إلى حماية هذا المنجز التاريخي يستدعي إحياء هذه القيم والمبادئ وإطلاقها على مستوى حياتنا كلها، حتى نتمكَّن من إنجاز فرادتنا التاريخية والحضارية.
وهذا بطبيعة الحال، يقتضي انفتاح المدارس الإسلامية على بعضها في مختلف المستويات، وإزالة كل الحواجز والعوامل التي تحول دون التواصل الفعَّال بين مختلف المدارس الفقهية والمذهبية.
لهذا كله، نحن بحاجة اليوم إلى إعادة بناء وصوغ العلاقة بين أتباع المدارس والمذاهب الإسلامية على أُسس الاحترام المتبادل؛ وذلك حتى يُصاغ من التعدُّد الفقهي والمذهبي واقع للإثراء وتعزيز الوحدة والاندماج، وليس سبباً للفرقة والتشظِّي. فالتعدُّد الفقهي والتنوُّع الاجتماعي ينبغي ألَّا يقودا إلى بناء كانتونات اجتماعية متحاجزة وبعيدة بعضها عن بعض، وإنما لا بد أن يقودنا هذا التنوُّع إلى بناء وطني جديد على أُسس لا تحارب التعدُّد ومقتضياته، ولا ترذل التنوُّع وحاجاته، بل تتعاطى بوعي وحكمة مع هذا التنوُّع.. الوعي الذي يُؤسِّس لحالة حضارية من التعايش السلمي على أسس الفهم والتفاهم والحوار والتلاقي، وتنمية الجوامع المشتركة وصيانة حقوق الإنسان.
والحكمة التي تمنع اندفاع أيِّ طرف للقيام بأيِّ تصرُّف يضرُّ بمفهوم المواطنة أو يُؤسِّس لخيارات اجتماعية لا تنسجم ومقتضيات الوحدة.
إننا نتطلَّع إلى مواطنة متساوية في الحقوق والواجبات، لا تُبنى على أنقاض خصوصياتنا التاريخية والفكرية، وإنما تُبنى على أساس احترام هذه الخصوصيات والاعتراف بمتطلَّباتها والعمل على حمايتها من كل التهديدات والمخاطر.
لذلك، فإن المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نتَّبعه في التعامل مع حقائق التنوُّع الإنساني والخصوصيات الثقافية للمجتمعات هو تشجيع هذه الخصوصيات للعمل في الفضاء الاجتماعي والوطني في الجوانب الإيجابية التي تدفع الإنسان عاطفيّاً وفكرياًّ، نفسيّاً وعمليّاً إلى المشاركة الإيجابية في شؤون الوطن والمجتمع المختلفة.
وبهذه الطريقة ننزع عن كل الخصوصيات كل العقد، التي تُفضي إلى الانكفاء أو التعصُّب الأعمى للذات؛ فالتعدُّد الفقهي في إطار سياق ثقافي واجتماعي يحترم التعدُّد، ويضمن حق الاختلاف وحقوق الإنسان الجوهرية، هو من الروافد الأساسية لبناء مواطنة غنية في ثقافتها وخياراتها المجتمعية.
لهذا كله، فإننا مع المعاقبة القانونية لكل شخص أو طرف يمارس الإساءة بكل مستوياتها إلى الأطراف الأخرى؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يُبنى السِّلْم الاجتماعي والعيش المشترك على أسس صلبة ومتينة، إلَّا بالاحترام المتبادل والعميق بين مختلف المكوِّنات والتعبيرات. صحيح أنه ليس ممكناً أن تتطابق وجهات النظر في كل شيء، ولكن من الضرورات القصوى لاستقرارنا ووحدتنا أن نصونهما بالاحترام المتبادل.
لذلك، فإننا نقف ضد كل الأقوال والممارسات التي تُسيء إلى رموز ومقدَّسات الآخرين، كما نطالب الآخرين أن يحترموا رموزنا ومقدَّساتنا.
إننا مع الاحترام المتبادل بكل متطلَّباته ومقتضياته؛ وذلك لأن تسفيه مشاعر الآخرين لا يقود إلى التضامن والوحدة، بل إلى الشقاء والمحنة.
ولنا في التجربة النبوية في المدينة المنوَّرة خير مثال ونموذج؛ إذ إن المواطنة التي شكَّلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تلغِ التعدُّديات والتنوُّعات، وإنما صاغ قانوناً يُوضِّح نظام الحقوق والواجبات، ويُحدِّد وظائف كل شريحة وفئة، ويُؤكِّد على نظام التضامن والعيش المشترك، إذ جاء في صحيفة المدينة: «وانه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثاً، ولا يؤويه، وإنه من نصره وآواه فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل».
فسبيل المواطنة الصادقة ليس تسفيه مشاعر الآخرين والحطَّ من رموزهم وتاريخهم، وإنما بالاحترام المتبادل الذي يصون الحقوق والحرمات، ويحول دون التطاول المتبادل.
وإننا وفي هذه اللحظة الزمنية الحسَّاسة والخطيرة أحوج ما نكون إلى سيادة نهج الاحترام العميق والمتبادل بين مختلف مكوِّنات المجتمع؛ وذلك لأنه سبيلنا لتعزيز تلاحمنا الداخلي وصون وحدتنا الوطنية.
الوحدة والاحترام المتبادل:
لعلنا لا نحتاج إلى جهد نظري كبير لتثبيت أن خيار الوحدات الاجتماعية والوطنية، في كل البيئات والظروف، هو الخيار الأنسب والأصلح على مختلف الصعد والمستويات؛ فالمواطن العربي في كل البيئات الاجتماعية مؤمن بشكل عميق بخيار الوحدة، ونبذ كل نزعات التجزئة والتفتُّت، بل إن الجهة السياسية التي تبحث عن تسويق مشروعها وخطابها في العالم العربي تتمسَّك ولو شكليّاً بخطاب وخيار الوحدة.
والجهة السياسية المهدِّدة في شعبيتها وحضورها الاجتماعي والسياسي هي تلك الجهة التي تُسوِّق لخيار التفتُّت والتجزئة، أو لا تدافع كما ينبغي عن خيار الوحدة والتضامن والتعاضد بين مختلف أطراف المجتمع والوطن العربي الواحد؛ لذلك ليس ثمَّة مشكلة حقيقية حول مبدأ الوحدة، سواء على المستويات الوطنية أو المستويات القومية. فالغالبية هي ممَّن تُؤمن بضرورة العمل المتواصل لإنجاز هذا الخيار، كما أن الغالبية شعوريّاً ووجدانيّاً تنبذ أي نزعة للانفصال والتجزئة على مستوى الدول العربية قاطبة، ولكن تتعدُّد الرؤى وتتمايز القناعات حول الطريق المؤدِّي إلى الوحدة، والخطوات العملية المفضية إلى تعزيز خيار التضامن والتعاضد على مستوى البيئات الوطنية العربية.
وعلى كل حال وبعيداً عن السجالات الأيديولوجية المختلفة المتعلِّقة بهذا الموضوع، يمكننا القول: إن الوحدة سواء على المستوى الوطني أو المستوى القومي لا تساوي دحر ومحاربة كل حقائق التنوُّع والتعدُّد الموجودة في العالم العربي. وثمَّة علاقة عميقة بين مطلب الوحدة وحقائق التنوُّع والتعدُّد في الفضاء العربي، سواء أكانت هذه الحقائق دينية أم مذهبية أم جهوية أم عرقية أم قبلية أم ما شابه.
فكل من يبحث عن الوحدة وهو يحارب في خياراته الثقافية والسياسية حقائق التعدُّد والتنوُّع في مجتمعه ووطنه، فإنه لن يحصد إلَّا المزيد من التآكل والتحاجز بين مختلف الأطراف والأطياف، كما أن كل من ينشد واقع الوحدة والاتِّحاد ويطالب بتعزيزهما في بيئته الوطنية، وهو لا ينسج علاقات إيجابية وتواصلية مع مكوِّنات وطنه؛ فهو لا يؤمن إيماناً عميقاً بمبدأ الوحدة وضرورته الوطنية والقومية.
فحقائق التنوُّع والتعدُّد الأفقي والعمودي في بيئاتنا الوطنية والقومية، ليست حقائق مضادَّة للوحدة، بل هي من مرتكزات الوحدة، ولا تُبنى الوحدة الحقيقية من دونهما؛ فمحاربة حقائق التعدُّد لا تُفضي إلى وحدة، بل إلى المزيد من الانقسام والتفتُّت. ومن يتعامل مع مبدأ الوحدة بوصفه مشروعه الفكري والسياسي، فعليه أن يكسر حاجز القطيعة والانفصال عن مكوِّنات مجتمعه وتعبيرات وطنه. فالطريق الموصل إلى الوحدات الاجتماعية والوطنية الصلبة هو الذي لا يُحارب حقائق التعدُّد، بل هو الذي يُؤسِّس لنظام اجتماعي وثقافي لإدارة هذه الحقائق على نحو إيجابي، حتى تتحوَّل هذه الحقائق إلى مصدر لإثراء خيار الوحدة وتعزيزه في الفضاء الاجتماعي والوطني.
ويبدو من مختلف التجارب والوقائع الوطنية في أغلب البلدان العربية أننا بحاجة إلى ثقافة وطنية متكاملة قوامها الأساسي احترام المختلف وصيانة حقائق التنوُّع والتعدُّد، وحماية كل التعبيرات الموجودة في الفضاء الوطني والقومي. فالنتيجة الطبيعية لقيم الاحترام والصيانة والحماية هي تعزيز خيار الوحدة في الاجتماع الوطني، ودون ذلك ستبقى مقولات الوحدة وخطابات التضامن هي مقولات وخطابات مجرَّدة لا تُغيِّر من وقائع الأمور أي شيء. وعلى ضوء العلاقة العميقة التي تربط قيمة الوحدة بضرورة صيانة وحماية التعدُّدية الأفقية والعمودية في مجتمعاتنا الوطنية، نودُّ التأكيد على النقاط التالية:
1- إن احترام وحماية المتعدد الوطني ليس لقلقة لسان أو ادِّعاءً يُدَّعى، بل هو ممارسة وطنية مستديمة، تستهدف تثبيت أن مفهوم المواطنة الجامعة لا يساوي أن تكون قناعاتنا وأفكارنا متطابقة في كل شيء، بل مفهوم المواطنة يتَّسع لجميع المختلفين والمتعدِّدين، ولا يحق لأيِّ طرف أن ينسب لنفسه حقيقة المواطنة ويسلبها من المختلف معه، سواء على الصعيد الديني أم المذهبي أم القومي أم القبلي.
كل هذه التعدُّديات يحتضنها ويحميها مفهوم المواطنة إذا أردنا كأفراد ومؤسسات أن نلتزم بمقتضيات وحقائق المواطنة، كما أن قناعات وأفكار كل طرف ليست موضوعاً للتشنيع والإساءة والإسقاطات الأيديولوجية المبتذلة، فمن يحترم التعدُّدية يحترم أشخاص وأفكار وقناعات المتعدِّدين وصيانة حقوقهم المادية والمعنوية.
والاحترام لا يساوي الاقتناع بقناعات الآخرين، وإنما احترامها من موقع المختلف والمغاير لهذه القناعات. ولا أحد يدَّعي في كل الدنيا أن شروط المواطنة الجامعة أن يقتنع الجميع بأفكار وقناعات بعضهم البعض، ولكن من شروط المواطنة الاحترام المادي والمعنوي لقناعات وأفكار أبناء الوطن الواحد. فالمسلم الهندي ليس مقتنعا على المستوى العقدي أو المعرفي بقناعات وعقائد وأفكار شريكه الوطني من الهندوس والسيخ والعكس، ولكن المطلوب دائماً أن تحترم جميع المكوِّنات عقائد وقناعات الشريك الوطني، وألَّا تتحول قناعات وعقائد الشريك إلى مصدر للتشنيع والتشويه والابتذال.
فوحدة الأوطان تتطلَّب باستمرار تطوير نظام الاحترام المتبادل بين جميع أطرافه وأطيافه، وندعو في هذا الإطار جميع الكتَّاب وصُناَّع المعرفة على المستوى الوطني إلى عدم الوقوع في هوة الإساءات المتبادلة.
2- من حق الجميع أن تختلف وجهات نظرهم السياسية وتتباين قناعاتهم الفكرية، ولكن الاختلاف والتباين الفكري والسياسي شيء، وتشويه عقائد المختلف أو التشنيع ببعض قيم المتباين شيء آخر.
فمن حقّنا جميعاً أن نختلف، ولكن ليس من حقنا أن نُسيء إلى قيم وعقائد بعضنا البعض. ومن مقتضيات صيانة الوحدات الوطنية هو خلق المسافة الضرورية بين الاختلاف والتباين الفكري والسياسي وهو حق مشروع ومتاح، وبين التشنيع بعقائد المختلف معنا.
فمن حقنا وواجبنا القومي أن نختلف ونتصارع صراع وجود مع الحركة الصهيونية في فلسطين المحتلة، ولكن ليس من حقنا التشنيع على الديانة اليهودية؛ لأن اختلافنا وتناقضنا مع الحركة الصهيونية شيء، وتشنيعنا على الدين اليهودي شيء آخر.
فثمَّة ضرورة وطنية وقومية للتفريق بين التباين والاختلاف في الخيارات والقراءات السياسية، والتعرُّض بسوء إلى عقائد من نختلف معهم في خياراتهم وقراءاتهم السياسية.
3- تعالوا جميعاً نخرج من سجن الماضي وإحنه، ونبني أوطاننا على أسس المحبَّة والوئام والتآلف وحقوق وواجبات المواطنة؛ لأن إحن الماضي لو تحكَّمت فينا فإنها ستُدمِّر نسيج مجتمعاتنا وأوطاننا، ونحن جميعاً لا نتحمَّل وزر ومسؤولية ما جرى في حقب الماضي؛ لذلك ثمَّة ضرورة إسلامية وإنسانية وعربية ووطنية، للخروج من صراعات الماضي، والانفتاح على بعضنا البعض على أسس وهدى قيم الإسلام الخالدة، التي تحثُّ على العدالة والمساواة وتنبذ الكراهية والتعدِّي على الحقوق والحرمات.
نحو عقد سياسي جديد:
في ظل الخلافات والنزاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تنتاب العديد من مناطق العالم الإنساني من الضروري أن نتساءل: كيف لنا في هذا الجو المحموم أن نُبدع ثقافة حوارية، تُساهم في تطوُّرنا الروحي والإنساني والحضاري؟ كيف لنا أن نُطوِّر ثقافة البناء والإصلاح في عالم يمور بالخلافات والنزعات والحروب؟
ونحن حينما نتساءل هذه الأسئلة المحورية لا نجنح إلى الخيال والتمنيِّ، ولا نتجاوز المعطيات الواقعية، وإنما نرى أن الخروج من نفق الحروب والنزعات ومتوالياتهما النفسية والاجتماعية والسياسية، لا يتم إلَّا بتوطيد أركان ثقافة الإصلاح والحوار والتوازن.
ولا بد من إدراك أن هذه الثقافة ليست حلّاً سحريّاً للمشكلات والأزمات، وإنما هي الخطوة الأولى لعلاج المشكلات بشكل صحيح وسليم؛ فالعنف المستشري في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية لا يمكن مقابلته بالعنف؛ لأن هذا يدخل الجميع في أتون العنف ومتوالياته الخطيرة، ولكن نقابله بالمزيد من الحوار والإصلاح في أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ بمعنى العمل على تطوير وتحسين الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم بشكل أو بآخر في تغذية قوافل العنف والقتل والتطرُّف بالمزيد من الأفكار والتبريرات والمسوِّغات.
وإن طبيعة التطوُّرات الاستراتيجية والأحداث السياسية التي تمرُّ بها المنطقة، تتَّجه إلى تأكيد حقيقة أساسية في المشهد السياسي للمنطقة، وهي: أن النخبة أو الفئة سواء كانت حاكمة أو محكومة التي تربط مصيرها بخارج حدود الوطن، فإن هذا لا يُفضي إلَّا إلى المزيد من الإرباك والتدهور، حيث إن الارتباط الهيكلي بخارج الحدود سيزيد من فرص استخدام القهر والقوة لفرض الخيارات وجبر النقص في العلاقات الداخلية من جرَّاء الارتهان للأجنبي.
وهذا يقود إلى تنامي مشاعر العداء والخيبة لكل ما يجري في الساحة العربية، وستشهد المنطقة من جرَّاء ذلك حالة من عدم الاستقرار والقلق والخوف، كما سيتفاقم العنف الرمزي والمادي؛ لأن القهر والظلم والإذلال ينبوع دائم للإرهاب والعنف وعدم الاستقرار.
وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد الجازم، أن الاستقرار السياسي الحقيقي والدائم في فضائنا العربي والإسلامي لا يتأتَّى من حالة الارتهان للأجنبي، أو الانسجام المطلق مع استراتيجياته وخياراته الإقليمية والدولية، بل إن هذه الحالة تزيد من فرص انهيار الاستقرار وتفاقم من حالات اختراق الأمن الوطني والقومي.
لذلك، فإنه يُخطئ من يتصوَّر أن بوابة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتنا هي الخضوع لرهانات الأجنبي وخياراته في الغطرسة والهيمنة. فالتجارب السياسية تُثبت أن الارتهان للأجنبي لا يجلب إلَّا المزيد من الصعوبات وسخط المجتمعات وفقدان ثقتها وإيمانها بنخبتها السياسية والاقتصادية.
وفي ظل الأوضاع الراهنة تزداد مخاطر الارتهان للأجنبي على مختلف المستويات.
ويبقى في تقديرنا خيار تنمية مشروع المصالحة الداخلية في الفضاء السياسي والاجتماعي العربي؛ إذ إننا لا يمكن أن نُحقِّق الأمن والاستقرار إلَّا على قاعدة المصالحة الداخلية في المجتمعات العربية بين مختلف المكوِّنات والتعبيرات.
مصالحة بين السلطة والمجتمع، بين النخب السياسية والثقافية والاقتصادية، بين المكوِّنات والتوجُّهات الدينية والقومية، حيث يتوفَّر مناخ جديد يزيد من فرص الوفاق والتوافق، ويُقلِّل من إمكانية الصدام والصراع المفتوح بين الخيارات المتوفرة في الساحة.
إننا جميعاً نخباً ومجتمعات، لا نمتلك القدرة الحقيقية لإنجاز حلول جذرية لأزماتنا ومشكلاتنا، واستمرار أوضاعنا وأحوالنا على حالها سيفاقم من الأزمات، وسيُوصلنا جميعاً إلى شفير الهاوية.
لذلك، وفي ظل أحوالنا المتردية والتحدِّيات والمخاطر الكبرى التي تواجهنا من مختلف المواقع، وغياب القدرة الحقيقية لدينا جميعاً للانعتاق الجذري من هذه الاختناقات، لذلك كله لا يبقى أمامنا كحكومات وشعوب إلَّا أن يلتفت بعضنا لبعض، ونعمل بوعي وإحساس عميق بالمسؤولية لإطلاق مشروع مصالحة سياسية واجتماعية بين مختلف مكوِّنات المجتمع، حتى نتمكَّن من الخروج من هذه الدائرة الجهنمية التي تُراكم المخاطر، وتُكثِّف من التحدِّيات وتزيدنا ضعفاً وتراجعاً وانتكاساً. فالتطوُّرات السياسية الأخيرة في العراق وفلسطين تُؤكِّد أن المجال العربي بأسره عاجز عن حماية ذاته والدفاع عن أمنه الوطني والقومي، وأن المشروع الصهيوني يتغوَّل ويتضخَّم ويصل إلى أهدافه الخطيرة من جرَّاء عجزنا وضعفنا. ولن تستطيع الخُطب الرَّنَّانة أو الشعارات الصارخة أن تُغيِّر من أحوالنا وأوضاعنا، وتُزيل عن كاهلنا حالة العجز المطبق التي كلَّفتنا ولا زالت الكثير من الخسائر والانكسارات، كما أن استمرار الأوضاع الداخلية في البلدان العربية على حالها يعني استمرار الأخطار والخسائر.
وهذا يُنذر بحدوث كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية في العديد من المناطق والبلدان.
لذلك، لا خيار حقيقيّاً أمامنا إلَّا مصالحة أنفسنا وإعادة بناء عقد سياسي واجتماعي جديد على المستويين الوطني والقومي، حتى نتمكَّن من توفير شروط الخروج والانعتاق من هذه الأزمات الخانقة، والتي تُهدِّد وجودنا ومستقبلنا كله. فلا أحد في العالم العربي كله يتحمَّل اليوم الانتقال من خسارة إلى أخرى ومن نكسة إلى نكسة أخرى أشدّ منها وطأةً وخطراً وتأثيراً على الحاضر والمستقبل. ففي ظل الأوضاع الحالية ازدادت الأمة معاناة وتراجعاً، وفي ظل النظام العربي الرسمي القائم توسَّع المشروع الصهيوني، وأصبح يُهدِّد الجميع أمنيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً، وازددنا تفكُّكاً وتفتُّتاً على ضوء الموقف من مشروع السلام والتطبيع.
وفي ظل هذه الظروف والأوضاع حدثت حروب ومصادمات عربية- عربية أرهقت الجميع، وأدَّت إلى أضرار فادحة في جسم الأمة.
وخلاصة الأمر: إن جميع الوقائع والتطوُّرات الداخلية والخارجية تُثبت بشكل لا لبس فيه حاجتنا جميعاً إلى نظام وعقد سياسي جديد يضع الأمة من جديد في الطريق الصحيح من أجل تحقيق أهدافها وتطلُّعاتها التاريخية. إننا أحوج ما نكون اليوم إلى رؤية وعقد جديد يُنظِّم العلاقات الداخلية بين قوى الوطن المتعدِّدة والدول العربية بعضها مع بعض، ويُنمِّي طاقاتنا، ويصقل مواهبنا، ويُعزِّز قدراتنا الذاتية والموضوعية، ويُحرِّر إرادتنا من العجز أو الارتهان والتبعية، ويشحذ كل طاقات وقدرات الأمة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية، ودحر المشروع الصهيوني من فضائنا ومجالنا السياسي والحضاري. فثغرات واقعنا العربي عديدة وعظيمة، والتحدِّيات والمخاطر التي تُهدِّدنا متواصلة، ولا خيار أمامنا غير إعادة ترتيب أوضاعنا وأحوالنا على أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطوُّرات والتطلُّعات الداخلية، دون أن تغفل حاجتنا جميعاً إلى الائتلاف والوحدة.
وهذا يتطلَّب من النخب السياسية في المجال العربي اتِّخاذ إجراءات وخطوات عملية ملموسة لوقف الانهيار والانطلاق في بناء حياة سياسية جديدة، تُؤسِّس لمشروع عربي جديد يُحقِّق نهضتنا، ويُوفِّر لنا القدرة النوعية لمجابهة التحدِّيات الكبرى التي تفرضها قوى الهيمنة والغطرسة في المجال العربي.
وإن الخطوة الأولى في مشروع وقف الانهيار وإعادة التوازن إلى المجال العربي هي إصلاح وتطوير العلاقة بين السلطة والمجتمع في الإطار الوطني والعربي؛ فهي مدخل وقف التراجع والتقهقر، وهي التي تُمكِّننا من التغلُّب على المصاعب الاقتصادية والسياسية التي تواجه دول العالم العربي لأسباب وعوامل مختلفة.
وإن هذه المصالحة بما تتضمَّن من رؤية ونمط جديد للعلاقة والتعامل، هي اليوم أكثر من ضرورة. إنها خيارنا المتاح للدخول في حركة التاريخ من جديد، وتجاوز كل المعضلات والعقبات التي تحول دون تقدُّمنا وانطلاقتنا من جديد.
وما لم تقم دول العالم العربي بمشروع المصالحة مع شعوبها ومجتمعاتها، فسيكون مستقبل المجال العربي بأسره قاتماً وخطيراً على مختلف المستويات.
فلا تقدُّم من دون إصلاح، ومن ينشد التطوُّر والتقدُّم دون القيام بخطوات إصلاحية حقيقية، فإن أغلب الخطوات التي يقوم بها ستراكم من الأزمات، وستُكثِّف من حالات الإحباط والفشل؛ فالارتباط بين الإصلاح والتقدُّم هو ارتباط النتيجة بالسبب.
وهذا العقد الاجتماعي-السياسي هو الذي يراعي مصالح الجميع، وهو المرجعية العليا لكلا الطرفين. فمفتاح الخلاص للعديد من التوتُّرات والأزمات وجود عقد يُنظِّم طبيعة العلاقة بين قوى الأمة ومؤسساتها المتعدِّدة، ويُحدِّد الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي تسعى إليها قوى الأمة، وتبلور حقوق وواجبات كل طرف.
ومن المؤكَّد أن تنظيم العلاقة بين مختلف مكوِّنات الأمة بحاجة إلى العديد من الجهود والإمكانات، وإلى ثقافة سياسية جديدة، تأخذ على عاتقها تعبئة المجال العربي وفق أهداف واضحة وأساليب ممكنة وحضارية، وإلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والثقافية، حيث نصل إلى مستوى حضاري يحكم علاقة السياسي بالثقافي والعكس.
وجماع القول: إن بوَّابة خلق الإجماع الوطني والقومي الجديد هي تجديد الحياة السياسية، وتوسيع مستوى المشاركة فيها، وتنظيم قواعد التنافس والصراع فيها أيضاً.
والعقد السياسي-الاجتماعي الجديد هو الذي يوفر الأرضية المناسبة لتطوير مؤسسة الدولة وتحديث هياكلها الدستورية، وبناء الاقتصاد الوطني ووضع برامج النهوض في مختلف الميادين والمجالات.