الدولة الإسلامية وأزمات الفكر الإسلامي المعاصر
فئة : قراءات في كتب
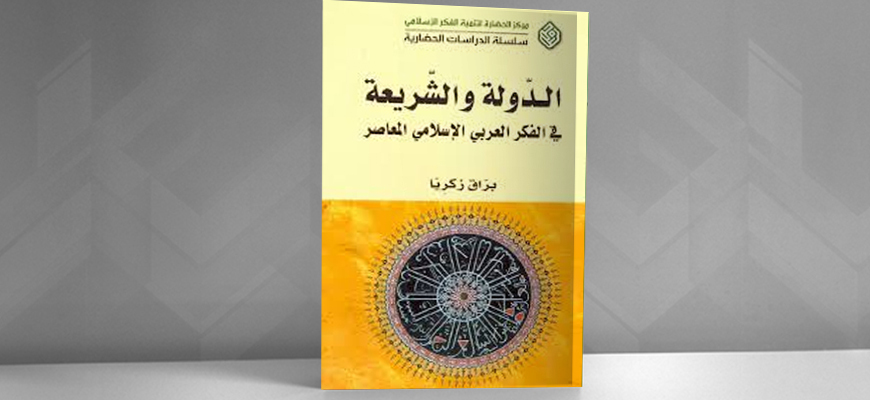
الدولة الإسلامية وأزمات الفكر الإسلامي المعاصر
قراءة في كتاب "الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر" لمؤلّفه برّاق زكريا
تدفعنا تجارب الإسلاميين في الحكم وتداعياتها، كذلك المد الجهادي في الوطن العربي وراية الشريعة التي رَفعتها هذه الجماعات المُتباينة لبنةً لمشروعهم السياسي المستهدف تحقيقه - "الخلافة" - إلى البحث في الأصول الفكرية التي تشكل وعي هذه الجماعات تجاه شكل الدولة ومن ثم تطبيق الشريعة. فعلى الرغم من الكتابات المُتنوعة حول هذه المسألة طوال ما يزيد عن قرن مضى منذ بدايات الاحتكاك بين أوربا والبلدان العربية عن طريق الاحتلال العسكري وما تبعه من غزو فكري أنتجَ جِدالات متعددة المستويات حول العلاقة بين الدين والدولة، لم تَزل هذه الجدالات متداولة بل ومُبهمة في وعي الكثيرين سواء من هم خارج التيار الإسلامي أو داخله. فعند النظر إلى المشهد الإسلامي نجد أنّه على الرغم من تنوع مرجعياته الجماعاتية تظل الدولة الإسلامية مجرد شعارات أكثر منها إشكاليات ومشروعات قابلة للتنفيذ، أما من هم خارج إطار الجماعات الإسلامية فخلفيات هذه الدعوات/القضايا وطبيعة مركزيتها في وعي هذه الجماعات أمرٌ غير واضح.
ومن هنا يأتي كتاب "الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر"[1] حيث يقدم لنا مؤلفه برّاق زكريا خريطة مُبسطة شاملة لأكثر المفكرين الذين لعبت كتاباتهم في هذه المسألة دورًا كبيرًا في الحركة الإسلامية عبر مراحلها، والذين شكلوا وعي هذه الجماعات تجاه مسألة الحكم.
يشتمل الكتاب على ثلاثة أقسام؛ يتحدث في الفصل الأول من القسم الأول عن ظروف نشأة الدين وماهيته وأدواره ووظائفه، وفي الثاني ماهية الدولة وبواعث نشأتها ووظائفها، في حين يناقش الفصل الثالث نظريات العلمانية ونشأتها. وفي القسم الثاني يرصد إشكالية العلاقة بين الدين والدولة في أوربا واشتباك أشهر زعماء النهضة العربية معها، كذلك يستعرض أفكارهم تجاه الدولة والحاكم في الإسلام. أما القسم الثالث فيتعلق بالحديث عن الإحيائية الإسلامية وأفكارها وأبرز روّادها من خلال استعراض أفكار مفكرين ذوي خلفية إخوانية مثل سيد قطب ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي. كذلك أفكار الجهاديين حول العلاقة بين الدولة والشريعة وواقعها وأبرز التحوّلات التي طرأت على أفكارها.
أزمة مفاهيم وتطبيقات
النقطة الأساسية الأولى التي يمكن أن نقرأ فيها الكتاب هو تصوّر الإسلاميين للدولة، وبناءً عليه نَتَفهّم موضع قضيتهم الكبرى "تطبيق الشريعة"، ومن أجل ذلك يخصص الكتاب الجزء الأبرز في قراءة بانورامية تحليلية بالتركيز على أفكار زعماء الإصلاح في العالم العربي إجمالاً مرورًا بالإحيائية الإسلامية وصولاً إلى الأصولية الإسلامية الرفضية أو الاحتجاجية "الجهادية" تجاه إشكاليات العلاقة بين الدين والدولة في الفكر السُنّي تحديدًا - لاختلاف الإشكاليات السنية عن الشيعية والتي يراها الباحث إشكالية قائمة بذاتها لم يتطرق إليها حيث تحتاج لمعالجة مختلفة أكثر توسعًا- وقصر البحث على بعض المفكرين دون غيرهم لأسباب أبرزها أنّهم الأغزر إنتاجًا والأكثر شهرة والأبعد تأثيرًا في أوساط الجمهور الإسلامي حيث يرى الباحث في ملاحظة نراها دقيقة - وغير مُشار إليها كثيرًا - أنّ أفكار الآخرين تلتقي في معظمها مع أفكارهم!.
يُشير الكاتب إلى وجود أزمة مفاهيم تتمثل في وجود التباسات تعتري مفاهيم "الدولة" و"الدين"، و"العلمانية"، و"الشريعة" ويُعيدها إلى أزمات الفكر العربي والإسلامي المعاصر وتصارع تياريه الرئيسين: الإصلاحي والإحيائي منذ الانفتاح على أوروبا. فقد كان للثورة الفرنسية ومبادئها أبلغ الأثر والتأثير في الشرقيين عند أول احتكاك حدث في أعقاب دخول الفرنسيين لمصر سواء في فترة وجود الحملة بعلمائها، أو من خلال البعثات التي بدأ يرسلها محمد علي إليها بعد ذلك. كان الهّم السياسي وإشكالية الدولة الشغل الأكبر لمفكري النهضة العرب والمسلمين في القرن التاسع باعتباره السبب الجوهري ولعلّه الرئيسي لتخلف البلاد العربية والإسلامية بحسب ما بدا لهم. وانصب مجهودهم الفكري والسياسي على التوفيق بين النظرية الإسلامية في الحكم من جهة، والتغييرات الكبرى التي كانت تستجد على واقع الحكم من جهة ثانية بهدف جعل الإسلام أكثر مُواءمة، وتَكيّفًا مع الواقع بمستجداته لإثبات عدم تعارض الإسلام مع العلم أو التقدم العلمي بإطلاق. ويضيف: "عمدت هذه الإصلاحية الإسلامية إلى الدفاع عن دولة العدل مُبشرة بنموذج الدولة الحديثة، لكنها انتقلت من الاكتفاء بالدعوة إلى الإصلاح إلى نقد السلطنة بعدما تبين لها أنّ الإصلاحات قد فشلت، وفشل الاستبداد، حيث بدأت الولايات العثمانية تسقط في أيدي الاحتلال لتكتمل صيغة الدعوة إلى الدولة الوطنية وتحرير المجال السياسي من الاستثمار الديني ثم نقد الاستبداد السياسي والدعوة إلى الشورى الدستورية كما كتب عبد الرحمن الكواكبي في (طبائع الاستبداد)"[2].
نازعت فكرة "الدولة" رؤيتان؛ الأولى حيث ذهب رواد الفكر العربي المعاصر إلى فهم الدولة بأنّها ذات اليد الطولى على كل شيء بالمجتمع، وقدم بعض العرب "العلمانية" كأنّها حتمية تاريخية دون النظر إلى سياقات انبعاثها، ومن الشطط نزوعهم إلى الربط بينها وبين الديمقراطية بحيث لا يمكن تصور وجود إحداهما دون الأخرى. في حين ينظر الإسلاميون إلى "الدولة" باعتبارها حارسة الدين، مُجادلين بأنّ الواجب أن يكون للدين دورٌ في إدارة الدولة، فالدولة هي الأساس والدين هو البناء وبدون أساس لا يكون البناء. كما قدم بعض المفكرين الإسلاميين تَفسيرًا للإسلام ضخَّموا فيه الشق السياسي على بقية مكونات البناء الإسلامي الروحي.
وكما حدث في النظرة إلى "الدولة" كانت الأزمة في طبيعة النظرة إلى "الشريعة" والتي أصبحت مفهومًا مطاطًا من حيث طبيعتها ودورها ومقاصدها. وهذا التحول يُعيده "زكريا" إلى التطور الحادث في مفهوم القانون في الدولة الحديثة ودوره ومكانته ووظيفته في التنظيم الاجتماعي والسياسي. ويوضح أكثر فيقول: أصبح التفاهم حول طبيعة القانون أو الخضوع لقانون واحد هو محور تكوين الأمة بالمعنى القومي، وأصبح القانون هو محور العمل السياسي لذا جَنح مُفكرو الإحيائية الإسلامية إلى تحويل الشريعة لقانون، بل حولوا الإسلام نفسه إلى ما يشبه المُدونة المادية للأحكام والنصوص التي يتركز شأنها على تنظيم حياة مجتمع ما من الناحية السياسية، مما أدى لتقليص عُمقه الروحي والديني، وغايتهم في ذلك تعبئه الجماهير لمآرب سياسية. في حين يرى آخرون أنّ الشريعة ليست قانونًا وإنّما هي أخلاق القانون وقيمه، فهي نظام اجتماعي أخلاقي ناجم عن رُؤية معينة للذات وللآخر وللعالم. لذا لابد التمييز بين الشريعة التي هي كتاب الله وإرادته وهي التي تتوجه إلى الانسان وبين القانون الذي هو تحويل هذه الإرادة إلى وسيلة للحكم على الأرض وأداة للدولة، ومن ثم إلى نظريات ومعارف وأحكام مدنية محددة.
فيما بعد أصبح الفكر العربي والإسلامي الحديث بمعناه الواسع - من ثلاثينات القرن العشرين إلى يومنا هذا - فكرًا قطائعيًّا أو فصاميًّا، سلبًا أكثر منه إيجابًا، بمعنى أنّ كل حِقبة من حقباته تَقطع مع الحقبة التي سبقتها سواء على المستوى الفكري أو المستوى الخطابي كذلك المستوى السلوكي. ونجم عن ذلك أن أصبحت هناك قطيعة بين الفكر "النهضوي" الذي انشغل بإشكالية النهوض والتقدم بمختلف طرائقهما - سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا - وعنوا من أجل ذلك بالفكر المقاصدي، في حين انشغل الفكر الإحيائي الذي انشغل بهاجس الهوية ومقتضياتها، وما أعاروا الفكرة المقاصدية اهتمامًا إلا لمامًا. فضلاً عن تحوّل الدين لدى الإسلاميين إلى أيدلوجية للسُلطة ذات صبغة عقدية، فالكثير منهم يُصوّرون الدين على أنّه قانون صارم ينبغي الاحتكام إليه.
ويشير الكتاب إلى سيادة خطابين إسلاميين في التنظير لفكرة الدولة وهما: الخطاب الإخواني والخطاب الجهادي وبينهما مساحات رمادية. فالخطاب الإحيائي واحد وروّاده ليسوا سواء - وإن كانت ثمة قطيعة على المستوى النظري- الحركي بين كلا الخطابين تتبدى في موقفهما من مفهوم "الدولة الإسلامية". فعلى الرغم من انبثاق الخطاب الجهادي - بحسب الكاتب - من المنظومة الفكرية الإخوانية حيث نشأ على أدبياتها فإنّ خطاب الإخوان ينظر إلى الدولة نظرة شعبوية إسلامية لا تُكفّر المجتمع ولا تراه جاهليًّا. فهو أقرب إلى دار الحرب منه إلى دار الإسلام. والدولة الإسلامية في خطابها تَميل إلى التوفيق والمُواءمة بين مصالح الدين والدنيا من خلال تطبيق الشريعة التي تتسم بالكمال والسمو والدوام، وهي لذلك تَفترض إطلاق الاجتهاد لمُسايرة التطوّر الاجتماعي واستيعابه لا تكفيره، بحيث تتطابق الشريعة مع المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثَمَّ شرع الله. أما "الخطاب الجهادي" والذي بلوره المودودي وقطب فإنّه يتمركز حول نظرية "ثيوقراطية" للدولة، وثمرة الخلاف/القطيعة بين الخطابين أنّ الخليفة أو الإمام في الخطاب الإخواني حاكم مدني من جميع الوجوه، ووكيل عن الجماعة ويستمد سلطته من الجماعة عبر ممثليها من أهل الحل والعقد. في حين أنّ الحاكم في الخطاب الجهادي "ثيوقراطي" سلطته من الله وليس الجماعة بحيث أنّه يقوم مقام نائب الله.
ويورد الكتاب ملاحظة هامة وهي أنّه مع غلبة السمة النكوصية عمومًا على أفكار المفكريين الإحيائيين نجد في المقابل نزعة تقدمية لدى رواد الفكر الإحيائي، فبعض المتقدمين كانوا يرفضون كل ما له علاقة بالثقافة الغربية بما في ذلك الديمقراطية - أبو الأعلى المودودي، حسن البنا، عبد القادر عودة - وفي العقود الأخيرة كانت محاولات "الإسلاميين الجدد" - كالقرضاوي والغزالي - لإعادة النظر في العلاقة مع الغرب باعتباره ليس شيطَانًا إمبراليًا بالكلية، فبالإمكان الإفادة مما لديه بما لا يَتصادم وأصول الشريعة وكلياتها، فلا مُبرر للنزعة الانكماشية التي وسمت الفكر الإسلامي المعاصر لعقود. وتجلى ذلك بعد الثورات العربية حيث سارع كبار مُنظّري هذا الفكر إلى المناداة بالدولة المدنية والديمقراطية - بمختلف مظاهرها وتفرعاتها - بعد أن وصلوا إلى اقتناع مفاده أنّ إرادة الشعب لا تتناقض مع الإرادة الإلهية.
جدليات الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر
أما النقطة الثانية في قراءتنا للكتاب فتتمثل في استعراض الأصول الفكرية التي شكلت وعي قطاعات الإسلاميين - كل بدرجات مختلفة - فضلاً عن مركزيتها عند التطرق إلى إشكالية علاقة "الدين" بـ"الدولة". أول هذه الأصول "محمد رشيد رضا" الذي يرى أنّ "الأمة" صاحبة السلطة وينوب عنها أهل الحل والعقد الذين يجب عليهم مقاومة الظلم، وصلاح الأمة وصلاح حكامها يتوقف على صلاح أهل الحل والعقد، والحكومات المستبدة كانت السبب وراء إضعافهم. فلا يصلح لأمّة من الأمم شرع أمّة أخرى تختلف في مقوماتها إلا إذا أرادت أن تندمج في أمّة أخرى فكوّنا أمة واحدة. ويضيف أنّ اضطرار الحكومتين المدنيتين التركية والمصرية إلى اللجوء لاستبدال الشريعة الإسلامية ببعض القوانين الوضعية ماهو إلا جهل منهم بالشريعة الإسلامية وأُسس الاشتراع فيها، وذُهولٌ منهم عن الفروق بين التشريع في الاصطلاح الفقهي وفي الاصطلاح العصري. فالمراد بالتشريع لدى الفقهاء مايتعلق بأمر الدين سواء ما يتعلق بالعبادات وترك الفواحش والعدل في المعاملات .. إلخ، وما عدا ذلك من أمور السياسة والإدارة والقضاء فهو من شؤون الدنيا. ويشدد رضا على أنّ حكومة الخلافة الإسلامية حكومة مدنية قائمة على العدل والمساواة للمسلم وغير المسلم. ويرى أنّ أول فساد طرأ على الخلافة هو جعلها وراثية في أهل العصبية والغلب، وتقصير المسلمين في عدم وضع نظام لها يضبطها. ويؤكد أنّ الخليفة في الإسلام ليس إلا رئيس الحكومة المُقيدة، لا سيطرة له على أرواح الناس وقلوبهم فما هو إلاّ مُنفذ للشرع، وأنّ الأعاجم هم من أفسدوا أمر الخلافة والإمامة، وبثُّوا في المسلمين التفرقة ليبعدوهم عن أصول الإسلام الثوري (الديمقراطي)، وينشئوا فيه حكومة أُوتوقراطية مُقدّسة. وعلى الرغم من دعوته بإلحاح إلى إعادة الاعتبار للاجتهاد وقوله بمدنية السلطة في الإسلام وإمكانية أن يكون مُتوليها رئيسًا أو مَلكًا، وليس بالضرورة خليفة وباسم الشعب وليس باسم الدين إلا أنّه بقى أسيرَ النَّظرة الفقهية الكلاسيكية فيما يَتعلق بشكل الدولة، وأنّها لابد أن تكون خلافة إسلامية، فالمقصد الأسمى الذي شُرِّعت لأجله هو إقامة الشرع في العبادات والمعاملات - وعلى رأسها إمام هو "خليفة المسلمين" أنَّى وُجدُوا.
- ثاني الأفكار المتعلقة بجدلية العلاقة بين الدين والدولة وشكلت تيارًا بصورة ما، قد أَوردها الشيخ "علي عبد الرازق" حيث يُؤكد أنّه لا دليل ولا شُبهة دليل من كتاب الله على أنّ إقامة "الإمام" فرض، كذلك "السنة" وما يستدل به بعضهم من أحاديث تُومئ إلى الإمامة أو الجماعة .. إلخ - مثل: الأئمة من قريش، ومن مات وليس في عنقه بيعه فقد مات ميتة جاهلية - فليس فيها ما ينهض دليلاً على ما زعموه من أنّ الخلافة واجبة، ولا أنّ الخليفة يقوم مَقام النبي. وفَنَّد دعوى الإجماع على وجوب نصب الإمام ذاهبًا إلى أنّها غير صحيحة، سواء أكان مُرادهم بها؛ إجماع الصحابة، أم التابعين، أم علماء الإسلام، أم المسلمين جميعًا. ويشير إلى أنّ الخلافة لم ترتكز إلا على أساس القوة الرهيبة.
وفيما يخص ذلك يتساءل عبد الرازق ما إذا كان النبي صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة أم صاحب رسالة سماوية؟ وإن كان لا يُنكر أنّه كان في الحكومة النبوية ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية ولعل أولها مسألة الجهاد والشؤون المالية إلخ، وفي حين يرى بعضهم أنّه نظام البساطة الفطرية مُقارنة بالنظم الحالية المتكلفة، يرفض "عبد الرازق" ذلك مُؤكدًا أنّ النبي لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي يُفهم فهو ما كان إلا رسولاً، ويرى أنّ الرسالة في ذاتها تنطوي على نوع من الزعامة للرسول في قومه، وهي لا تُشبه من قريب أو من بعيد زَعامة الملوك وسلطانهم. ويؤكد أنّ ظواهر القرآن تدل على أنّ عمل النبي لم يَتعدّ حدود البلاغ المُجرد من كل معاني السلطان. وفيما بعد وفاته كانت الزعامة لخلفائه سياسية لا دينية. ويرى أنّ لقب أبي بكر "خليفة رسول الله" من أكبر أسباب الخلط الذي تسرب إلى العامة حيث خُيّل إليهم أنّ الخلافة مركز ديني ونيابة عن الرسول. وعلى هذا التوجه نفسه نحا "خالد محمد خالد" في كتابه "من هنا نبدأ" إلا أنّه رجع في كتابه "الدولة في الإسلام" عما سبق وطرحه، مُؤكدا أنّ دوافع الرؤية السابقة هي تأثره بما قرأه عن الحكومة الدينية المسيحية في أوروبا، كذلك ما رآه من سلوك المتدينين في مصر، وتحديدًا التنظيم الخاص المنبثق عن الإخوان، ولجوئه إلى العنف في مواجهة الآخر، "المُفارق أيديولوجيًا" لينتهي إلى أنّ الإسلام دين ودولة.
- أما عبد القادر عودة الرمز الإخواني البارز فقد سعى إلى تَقنين الشريعة، وتقريبها للواقع لتأكيد صلاحيتها لكل زمان ومكان. ويُشير الكتاب إلى أنّ نصوصه أكثر "راديكالية" من سيد قطب خاصة في ما له مساس بمفهوم "الحاكمية". حيث يرى أنّ المسلمين يَسيرون من ضعف إلى ضعف، ومن جهل إلى جهل، والعلة الرئيسة لذلك هي إهمال الشريعة وتطبيقها. فالشريعة بحسبه هي مجموعة المبادئ والنظريات التي شرّعها الإسلام في التوحيد والإيمان والعبادات والأحوال الشخصية والمعاملات.. إلخ. فأحكام الإسلام شُرَّعت للدين والدنيا، وهي أحكام يُراد بها إقامة الدين وتشمل: العقائد والعبادات، وأحكام يقصد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات فيما بينهم، وهذه تشمل: المعاملات والعقوبات والأحكام الشرعية. فالخلافة وهي الرئاسة بمعناها العام - وليست للدلالة على نظام بعينه - نيابةٌ عن الله، مع التأكيد على أنّ الخليفة في الإسلام لا يكون نائبًا عن الله إلا بقدر ما يُعدّ أي فرد آخر من أفراد الجماعة. كما يرى أنّ الإسلام يَمزج بين الدولة والدين بحيث لا يمكن التفريق بينهما، ووظيفة الحكومة الإسلامية أنّ تقييم الإسلام بالقضاء على الشرك والتمكين للإسلام. ويؤكد عبد الرازق أنّ الجهل بالتنظيمات الداخلية لدولة معينة لا يُنهض حجة أنّها لم تكن دولة، فإن كُنا نجهل تفاصيل نظام النبي في تعيين الولاة والقضاة فيكفي أن نعلم أنّه عيّنَ ولاة وقضاة في جهات معينة، لنستظهر من ذلك أنّه كان يفعل ذلك في سائر الجهات. كما يُؤكد أنّ من ينزعون إلى أنّ الإسلام عقيدة وليس نظامًا هم جهال أو أغبياء بل هم أعداء الإسلام!، فالإسلام عقيدة ونظام وحتمًا يكون حكمًا لأنّ العقيدة تَقتضي قِيام نظام يقوم على خِدمتها وحمايتها ونشرها والذبّ عنها، وطبيعي أن يَكون هذا النظام من طبيعة تلك العقيدة.
- في حين يرى أبو الأعلى المودودي أنّ الإسلام برنامج تفصيلي لمختلف نواحي حياة الإنسان، والقائد، والعبادات، ومبادئ الحياة العملية تشكل كلاًّ واحدًا غير قابل للتجزئة. وتتميز الدولة الإسلامية وهي حكومة إلاهية أو ثيوقراطية بأنّ الحاكم الحقيقي هو الله عز وجل، وليس لفرد أو أسرة أو طبقة نصيب من الحاكمية. فالتشريع لله وحده، وبُنيان الدولة مهما تَغيرت الظروف لا يقوم إلا على القانون الُمشرع، والحكومات التي بيدها زمام السلطة في الدولة الإسلامية لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث أنّها تحكم بما أنزل الله. ويشير المودودي أنّ الثيوقراطية الإسلامية ليس بها طبقة من السدنة أو المشايخ التي تستبد بأمرها، بل هي في أيدي المسلمين بعامةً، وهم الذين يتولون القيام بشؤونها وفق ماجاء في كتاب الله وسُنّة رسوله، فهي دولة فكرية أو عقدية قائمة على مبادئ وغايات مُحددة، والحاكم الحقيقي هو الله وحده، وما الذين يُنفّذون القانون الإلهي في الأرض من أُولي الأمر إلا نُواب عن الحاكم الحقيقي. ويُقر بأنّ إقامة نظام الإسلام بالغ الصعوبة في كل بلاد المسلمين؛ فانتخاب الأمير لا يكون إلا على أساس التقوى وعليه مشاورة أهل الحل والعقد، وهو لا ينتخب للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى أو أي منصب من يبادر بترشيح نفسه أو يسعى لذلك فهذا ليس من الإسلام. ولإقامة الدولة لابد أن تسبقها حركة شاملة مُؤسسة على نظرية الحياة الإسلامية وفكرتها الإسلامية، وعلى الرغم من تأكيده على اختلاف أحوال مُسلمي باكستان عن غيرهم من الدول الإسلامية، وخصوصية شبه القارة الهندية إلا أنّ سيد قطب ومن تبعه أَسقطوا نظريته في "الحاكمية الإلهية" على البلاد العربية دون الالتفات إلى الاختلافات التي أشار إليها المودودي!.
- أما الإسلاميّون الجدد - بتعبير الكاتب - فأبرزهم يوسف القرضاوي الذيتنازعه اتجاهان الأول أصولي، والثاني ترشيدي. يرى القرضاوي حتمية المصير إلى الحل الإسلامي، فجميع الحلول المستوردة المسقطة على بلادنا العربية والإسلامية قد فشلت، ومع إقراره بحسنات الليبرالية الديمقراطية خاصة في جانبها السياسي الذي يتمثل في إقامة حياة نيابية يُؤكد أنّ أخطر ما ساد حياة المسلمين بتأثير الاستعمار كان عَزْل الإسلام عن الدولة، وعن توجيه الحياة العامة وقيادة المجتمع. لذا؛ فالعالم اليوم في حاجة إلى رسالة جديدة، تحمل حضارة عالمية إنسانية أخلاقية ربانية جديدة، لا شرقية ولا غربية، تُصالح بين العلم والإيمان، وتجميع بين المادة والروح. ويرى أنّه بالإمكان حصر الحلول القائمة لعلاج أدوائنا المادية والمعنوية في ثلاثة حلول: الحل الإسلامي القرآني، الحل الديمقراطي الليبرالي، الحل الاشتراكي الثوري، وهذه الحلول الثلاثة ترجع إلى حَلّين؛ الحل الطبيعي وهو النابع من ضمير الأمة وهو الإسلامي، أما الحل المصطنع فهو الدخيل المستورد من الغرب.
والشرط الأول لقيام مجتمع إسلامي يتمثل فيه مُقومات المجتمع المسلم وخصائصه، هو أن يقوم في رقعة مُعينة من الأرض حكم إسلامي خالص، يقود المجتمع وفق هداية الله وتعاليم الإسلام وأحكامه وشريعته، فهو يرى أنّه لو لم تَجئ النصوص مُتظاهرة على وجوب إقامة الدولة في الإسلام – وهي دولة مدنية مَرجعها الإسلام عالمية/ شرعية دستورية، شورية.. إلخ - لكانت حاجته إلى دولة أمرًا لازمًا لحماية عقائد الإسلام، فهي عقيدة انقلابية شاملة، لا تَرضى أن تعيش على الهامش، كذلك لإقامة شعائره، وتنفيذ التشريعات والقوانين التي جاء بها الإسلام. فضلاً عن فريضة الجهاد لحماية دعوة الإسلام، ولغرس آداب الإسلام وأخلاقه. ويؤكد أنّ المقصود من نظرية الحاكمية ليس أنّ الله هو الذي يُولي الأمراء ليحكموا باسمه، بل هي حاكمية تشريعية، وسند السلطة الإسلامية مَرجِعُهُ إلى الأمة صاحبة الحق في اختيار حكامها ومحاسبتهم.. إلخ. فالحاكمية التشريعية التي لله وحده هي الحاكمية المُطلقة التي لا يقيدها شيء.
ويُشايع القرضاوي في غالب أفكاره الشيخ محمد الغزالي أحد رموز الفكر الإحيائي المعاصر والذي خرج مثله من صفوف الإخوان المسلمين، وتتلمذ على يد حسن البنا - فلا يجد غضاضة من الاقتباس من الحضارة الغربية في مجالات النظم الإدارية والسياسية والعسكرية وشؤون الدنيا.
أما التيار الرفضي/الاحتجاجي فيشير الكتاب إلى أنّ أصحابه هم أصحاب فكر جديد يجمع من كل جبل عصا، بمعنى أنّهم استفادوا من أفكار الخوارج الأوائل مُوسطين ابن تيمية وابن كثير وفتاواهما. كما نهلوا من كتابات المودودي وسيد قطب. ويشير إلى أنّ المنهج الانقلابي هو الطابع الذي يصبغ حركتهم بالثورة الإسلامية على النظم الجاهيلة. فعبدالسلام فرج ينزع إلى أنّ الأنظمة السائدة تتشابه من حيث حكمها بغير ما أنزل الله، وبُعدها عن الإسلام، وعيشتها في جاهيلة القرن، والمجتمعات الإسلامية القائمة كافرة، ولا ينسحب الكفر على الأفراد مالم يعلنوا ذلك بسلوكهم أو بأفكارهم. وفي "ميثاق العمل الإسلامي" هناك أربع حتميات تُوجب المواجهة؛ أولها خلع الحاكم المُبدل للشريعة لكفره بهذا التبديل، وثانيها قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام، وثالثها وجوب تنصيب خليفة للمسلمين وإقامة الخلافة، أما رابعها فيُوجب تحرير بلاد المسلمين والجهاد لنشر الدين.
خلاصة نقديّة
بعد العرض السابق للكتاب نشير إلى عدة ملاحظات منها ما يتعلق بغياب الجانب المقارن فيما يخص مسألة الخلافة والدولة بين المفكرين الذين استعرض الكتاب أفكارهم من جانب وبين الإسهام الشيعي من جانب آخر. وإن رأى الكاتب أنّ الإشكالية الشيعية قائمة بذاتها وتحتاج إلى معالجة مختلفة أكثر توسعًا فإنّ غياب الجانب المقارن حرم القارئ من عدة أفكار تتعلق بإشكالية الكتاب قد تضيف إليه خاصة وأنّ الكاتب اقتصر على إيراد رؤى بعض المفكرين بسبب غزارة إنتاجهم وبعد تأثيرهم في أوساط الجمهور الإسلامي دون تحليل السياقات التي نشأت فيها هذه الأفكار.
كما غلب التركيز على أفكار الدعاة/المفكرين المصريين - باستثناء أبي الأعلى المودودي - دون التطرق إلى إسهامات الشوامّ فيما يخص الدولة والخلافة، خاصةً أنّ لهم إسهامات "مُنتشرة" مثل سعيد حوي وفتحي يكن، ورضوان السيد لاحقًا، فضلاً عن غياب التطرق إلى أُطروحات مغاربية ككتابات راشد الغنوشي، وإسهامات محمد عابد الجابري. إضافة إلى غياب الإسهامات ذات المرجعيات القانونية على الرغم من أهميتها مثل ما طرحه منذ عقود عبد الرزاق السنهوري في كتابه الشهير "فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية"، كذلك ما قدمه توفيق الشاوي في كتابه: "فقه الشورة والاستشارة"، ومن بعده من المعاصرين المصريين مثل كتابات طارق البشري، كذلك محمد سليم العوا في كتابه: "في النظام السياسي للدولة الإسلامية".
- أيضًا لم يتطرق الكتاب إلى فكرة الدولة من منظور السلفية السياسية التي برزت بدرجات مختلفة في العقود الأخيرة، ومنحتها الثورات العربية حجماً دفع بها إلى مقدمة المشهد السياسي بدرجات متفاوتة.
- ويُثار تساؤل حول أسباب ضمور المساحة التي استعرض فيها الكاتب أدبيات التيارات الجهادية حيث اكتفى بالتأكيد على أنّهم "أصحاب فكر جديد يجمع من كل جبل عصا"، ومن ثم عمد إلى قراءة سريعة لكتابات الجهاديين الكلاسيكيين - صالح سرية وعبد السلام فرج وميثاق العمل الإسلامي للجماعة الإسلامية - دون التطرق لأدبيات القاعدة، وهي إشارة ولو وجدت، ولو بشكل عابر، قد تكون إضافة إلى الفهم الآني للتمدد الجهادي في الوطن العربي خاصة في ظل إعلان إحدى المجموعات الجهادية لما سمته "الخلافة الإسلامية".
- ويثير غياب موضع الحريات في منظور هؤلاء المفكرين ومن ثم موضعها من الدولة الإسلامية /الخلافة المنشودة التساؤل، حيث ينطلق المُعارضون لجماعات الإسلام السياسي من فكرة غياب الحريات وضماناتها في مشروعهم لمهاجمتهم.
- وآخر ملاحظاتنا تتعلق باقتصار عرضه لإسهام الإخوان المسلمين على ما قدّمه المستشار عبد القادر عودة دون التطرق لتحليل أفكار حسن البنا على الرغم من مركزيته، سواء بتحليل أدبياته المنشورة مثل "مجموع رسائل حسن البنا"، أو بالإشارة إليها اعتمادًا على ما قدمه - إبراهيم البيومي غانم في كتابه "الفكر السياسي للإمام حسن البنا" على الرغم من أنّ الطبعة الأولى نشرت عام 1992 والثانية عام 2013!. أو كتاب عبد الإله بلقزيز "الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر" (مركز دراسات الوحدة العربية, ط.2/ 2004) والذي اعتمد عليه كأحد المصادر!.
والكتاب الأخير تحديدًا نراه أكثر ضبطًا في تناول مسألة الدولة سواء من حيث الكم باعتماده على المنهج المقارن فضلاً عن ضبطه لمسألة فكرة الدولة ومراحلها في وعي الإسلاميين. فمما خلص إليه براق زكريا في كتابه - واتفق معه - هو وجود بعض الانحدار في العقل السياسي الإسلامي منذ لحظته الإصلاحية مرورًا بلحظته الإحيائية (الإخوانية) ومن أبرزها الانتقال من إشكالية الدولة الوطنية إلى إشكالية الخلافة ثم الدولة الإسلامية فالدولة الدينية "الثيوقراطية"، مع ما رافق ذلك الانتقال المُتدرج هُبوطًا في معنى الدولة والسُلطة السياسية من تراجع يراه بلقزيز "مُريعًا" في معدل المعرفة والوعي لدى كتّاب الإسلام السياسي المتأخّرين.
وعلى الرغم ممّا سبق من ملاحظات يبقى الكتاب مدخلاً مُيسّرًا وهامًا لفهم الحالة الفكرية الإسلامية فيما يخص مسألة الحكم، ومنها يمكن أن نتفهم حالة الإخفاق التي مُني بها تيار الإسلام السياسي عامةً في الحكم. ففي خاتمة الكتاب يؤكد براق زكريا أنّ الإسلاميين أمام اختبارات وتحديات عظيمة إما أن يثبتوا أنّهم أصحاب مشروع نهضوي قابل للحياة، لا أُولي شعارات جذابة لكن جوفاء لا معنى لها - "الإسلام هو الحل"، تطبيق الشريعة والحفاظ على الهوية -، وإما أن يفشلوا ويسقطوا فيما سقط فيه سابقوهم، وآنئذ ستعود الأمة إلى نقطة الصفر، لكن واقع الحال يشير إلى اختيار الإسلاميين للعودة إلى نقطة الصفر!.
[1]ـ من منشورات مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 2013، عدد الصفحات: 435 صفحة.
[2]ـ المرجع نفسه، ص 138






