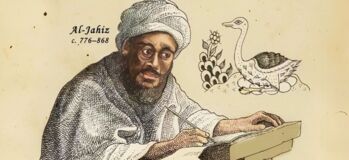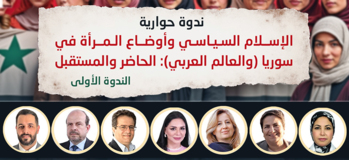الرواية الحديثة: ملحمة إنسانية (تأويل توأم الروح)
فئة : مقالات
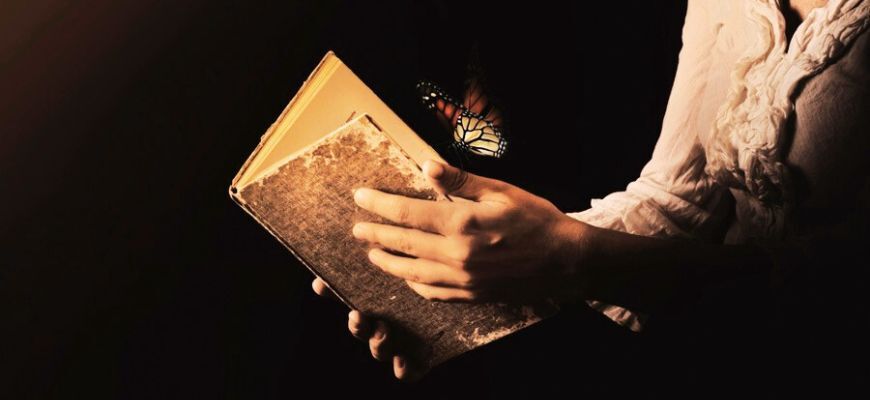
الرواية الحديثة: ملحمة إنسانية
(تأويل توأم الروح)[1]
- ماهية الرواية
ما الرواية؟ ولماذا نقرأها؟ هل نفعل ذلك فقط من أجل المتعة الجمالية؟ إن الرواية عبارة عن حكاية أو قصة طويلة، وفن نثري أدبي، وعمل تخييلي، يستمد مادته من قوة الخيال بخلاف التاريخ الذي يتوخى تحري الواقع الذي مضى؛ إذ تقوم أساسا على سرد وقائع وأحداث وسير شخصيات، حيث حلت الرواية في العصر الحديث في هذا الصدد، لتعوض مهام كانت تقوم بها أشكال أدبية قديمة وخاصة الأشعار الطويلة المسموعة والملحمات؛ [2] لأن الملحمة في القديم كانت هي المهيئة لاستيعاب وتصوير الشخصيات الرئيسة من آلهة وأبطال وعمالقة...إذ يربط هيغل ظهور الرواية بالتحول التاريخي العنيف الذي حصل للوعي الأوربي، فيضع الملحمة كسرد شعري عاش في العصور الخالية للتعبير عن حالة الوعي عند الشعوب القديمة، في مقابل الرواية التي تجسد الوعي الأوروبي الجديد في الأزمنة الحديثة.[3] لكن هل يتعين اعتبار هذا الشكل الأدبي وسيلة للتسلية الجمالية وإرضاء الذوق الاستطيقي فقط، من خلال مخاطبة الأشجار والعصافير، أو حتى قص حكايات شخصية متعالية، ففي هذه الحالة ستصير فائدتها محدودة، ويمكن أن تكون، كما صاغ ذلك جورج لوكاتش، مجرد صيغة أدبية مفضلة عند البورجوازية تصور الحياة المجيدة لأقلية في المجتمع، وإذن ستكون بعيدة عن هواجس التاريخ ومسائل سيرورة الحياة المشتركة.[4]
في هذا السياق، يذهب الفرنسي إدغار موران[5] إلى اعتبار الرواية الجيدة كتقصي ومعرفة حقة عن بنيات الوجود الإنساني، حيث بإمكانها أن تطلعنا على أعمق ما يمكن أن يطلعنا عليه أي علم آخر؛ فالروايات ليست مجرد طرائق للإشباع الاستطيقي فحسب، والأديب الذي اكتفى بهذا الغرض قد فوت على عمله مهام أخرى تخلد الكتابات. فالرواية وسيلة خلاقة لفهم الكائن البشري بكفية أعمق تتجاوز التسطيح؛ إذ يتم تكوين من خلالها رؤية مركبة عن الوضع البشري وعن العالم الذي نعيش فيه، [6] وتعيننا الرواية العظيمة أيضا في إدراك التحولات الكبرى للعصر، وتترصد بحس أدبي حقيقة الواقع ومآسي الإنسانية، فليس هناك من يضاهي الرواية في سبر أغوار النفس البشرية.
إن هذه السمات تعيدنا إلى نقاش الفلسفة والأدب، والعلاقات بينهما المنسوجة بأصالة، وبخاصة الرواية، التي وجد فيها الكثير من فلاسفة طريقا لاستئناف النظر العقلي والتأمل[7]. هكذا يمكن القول إذن إنه بالإضافة إلى مطلب فهم الإنسان والعالم، تلعب الرواية دور المقاومة؛ أي مقاومة الظلم الاجتماعي والسياسي، والتصدي للتخلف الحضاري، والتلكس الديني وهيمنة الثيولوجيا البائدة، والاستبداد السياسي والهيمنة الاقتصادية والحضارية، وكل ما يعرقل العيش المشترك؛ إذ تساهم من جهتها في خلق مناخ فكري جديد وإيجاد حلول للمشكلات الحضارية. إنها شهادة حية لا تفنى على سمات العصر الذي كتبت فيه، حيث يمكنها أن تتضمن تفاصيل الحياة في عصر ما وفي مجتمع ما، بكيفية لا يمكن أن تجدها في أي كتاب تاريخ، وفي مقابل ذلك تلعب الرواية دورًا إنسانيًّا في إشاعة قيم الحب والخير والحق والجمال...ورواية توأم الروح في هذا السياق رواية فكرية؛ إذ تجمع بين الفلسفة والأدب، تتأمل وتتخيل، تبلغ رسائل أخلاقية ونظرية، حيث جعلت من الأديان موضوعها الرئيس، وفق استراتيجية سردية محكمة تزاوج بين الطرح النظري والتخييل الأدبي، فيعتمد المؤلف السرد أداة لتعميق النقاش في أموره الفكرية.
- فرضيات القراءة
فرضيات القراءة هي مجمل التوقعات التي يحملها القارئ قبل فتحه لدفتي المؤلف؛ إذ تشمل الخلفيات الثقافية والاجتماعية التي يتميز بها السياق التاريخي، والتي تفترض منهجا محددا للقراءة. فعندما اطلعنا على حدث توقيع رواية السيد عبد الرزاق الرميشي في ربيع 2024 بمناسبة المعرض الدولي السنوي بالرباط، وبما أن لدينا معرفة عنه مسبقة بصفته شخصية أمنية قضى حياته في هذا الجهاز، وبما يمكن أن يصادف في أداء مهامه من أشخاص وأحداث وجرائم وقضايا عمومية، تترك بصماتها الخاصة في الذاكرة، وتجعل العديد من الأمنين يفكرون لو أتيحت لهم الفرصة لمشاركة تجاربهم، فإن الفرضية التي تتبادر للذهن لأول وهلة هي أن يكون عملا بوليسيا مثل الأعمال العالمية التي تأخذ من الجرائم محور حبكتها، على درب أجاثا كريستي[8] على سبيل الحصر، خاصة وأن هذا المسار قد عرف رواجا حتى في المغرب ليس في الأدب فقط، ولكن أيضا في وسائل الإعلام والسوشل ميديا...
هذا بخصوص المؤلّف، أما ما يتعلق بمجرد العنوان "توأم الروح"، فهو عنوان يفتحنا على عالم ثاني قريب من شغل الفلاسفة؛ لأن توأم الروح عنوان حملته من قبل أسطورة إغريقية شهيرة، نستحضرها باستمرار في لحظات الدرس الفلسفي مع الطلاب، تلك الأسطورة التي أوردها الفيلسوف اليوناني أفلاطون داخل حوارات مأدبته، [9] حيث يحكي الكوميدي الساخر أريسطوفان قصة من الخيال عن البشرية القديمة، التي كان الإنسان فيها مضاعف الأعضاء مورفولوجيا وفيزيولوجيا، حيث كان كل فرد بأعضاء مزدوجة، رأسان وأربعة أقدام وأربعة أيدي بما فيها ازدواجية الأعضاء الجنسية، ولأنهم كانوا أقوياء مزهوين بعظمتهم ومغرورين ينظرون بعين التحدي إلى السماء، فقد أزعج ذلك آلهة الألب القديمة، فقرر زيوس شطرهم إلى نصفين عقابا منها، وسخطا لإضعافهم، هكذا أصبح كل نصف يعيش الاغتراب والضياع، ويقضي كل حياته في البحث عن النصف الذي ضاع منه كي يتحقق اللقاء ثانية، ويعود العيش سعيدا كاملا غير منقوص، وهذا ما تحققه تجربة الحب، ثم الزواج، باعتباره ليس مجرد نزوة، وإنما وعد إلهي بلقاء الأرواح وتحقيق الكمال المفقود. فهل تكون رواية توأم الروح رحلة عاطفية ووعد بالكمال الإنساني؟ أم تعقب لحب ثان لحبيب ليس من بني البشر؟
لذلك، تنطلق وجهة نظري في هذه القراءة إلى اعتبار توأم الروح تقدم منظورًا متميزًا وأخلاقيا للعلاقة بين الأديان الإبراهيمية، ولاسيما باقي الأديان الوضعية التي حضرت بشكل أو بآخر هذا المتن؛ إذ تتوسل خاصة في الأقسام الأخيرة بالسرد العاطفي لسالم وإسرائيلا، فما يمكن أن أبديه من ملاحظات، إنما كانت من زاوية فلسفية وفكرية أكثر منها أدبية.
- موت المؤلف وأهمية التأويل
البحث عن نظرية للقراءة يأتي من انزعاج بعض المؤلفين من المسارات التي أخذها أعمالهم بعد نشرها قراءة وتأويلا، حيث في هذا السياق انشغل رولان بارت[10] Roland Parthe بجودة القراءة، مثلما سينشغل فوكو بعده بمسألة المؤلِّف خاصة في مقالته عام 1969 التي تحمل عنوان من هو المؤلف؟ qu’est-ce que l’auteur، حيث راح بارت يتقصى الطرائق الفعالة لقراءة النص الأدبي وفهمه، خاصة في ظل عدد من القراءات التي لم ترقه أبدا، بل يمكنها أن تكون قراءات تعوق كل فهم سليم، مثل القراءات الأيديولوجية التي سادت لعصور طويلة، والقراءات الاجتماعية والسياسية والدينية وغيرها، التي تعبر عن قراءة منحرفة وانحياز غير مبرر يفسد لذة النص وغاياته.
هكذا سينشر بارت مقاله الشهير الذي يحمل عنوان موت المؤلف La mort de l’auteur ليؤكد أن المؤلَّف بمجرد وصوله إلى دار النشر، يكون بذلك قد قطع رباطه بكاتبه بكيفية حاسمة، [11] حيث تنتهي مهمته وسلطته على النص، يتركه ليعيش حيوات أخرى غير تلك التي خطها بنفسه، وفي مقابل ذلك تولد سلطة جديدة، هي سلطة القارئ، الذي تصبح لديه الشرعية الكاملة في القراءة وتأويل النصوص والدلالات وفق رؤياه وحسب ما يراه ملائما، ومن ثم يمكنه أن يكتشف مسارات ورؤى مبتكرة لم تكن بذهن المؤلف الأصلي لحظة كتابتها، وأحيانا قد تكون بعيدة عن اهتماماته، لذلك عادة ما يقول الكُتاب إنه لم يكن بذهنهم ولا خطر على بالهم ما ينتهي إليه القراء والمؤولون من نتائج خصبة فيما بعد.
علما أن بارت يدافع أن الفكرة كانت سابقة عليه؛ إذ يشير إلى ستيفان مالارميه[12] في الشعر، الذي رافع من أجل اللغة بوصفها فوق مقام الشاعر نفسه؛ لأن اللغة هي التي تتكلم وليس شاعر، هكذا تقوم مجمل شاعرية مالارميه على حذف المؤلف لصالح الكتابة ونزع وصايته على نصه.[13] من هذا المنظور على الشعر أن يقرأ نفسه بنفسه، بكيفية يغيب فيها الشاعر عن قصائده، يخفض من صوته لتحل محله نبرة الأبيات والكلمات وتحتل الصورة، حيث السؤال المهم هنا إلى أي حد سيستطيع القراء والمؤولون تفحص هذا العمل بعيدا عن غايات المؤلف ونواياه؟
- عن المضامين
توأم الروح هي سردية لشاب من أسرة أمازيغية تعود أصولها لقبيلة آيت عتاب إقليم أزيلال، حيث هاجر والده مبكرًا المنطقة إلى سلا وتزوج هنا، أصيب فيما بعد بمرض مزمن، أدى إلى وفاته، وهو في ريعان الشباب. هكذا، فقد سالم والده في وقت مبكر، وما يصاحب ذلك مما يمكن أن يواجه أي يتيم من قهر ومصاعب، ورغم كل ذلك يحرص الشاب سالم على أن يعيش سعيدا، حيث ظل يعيش برفقة والدته الأرملة وأخويه محمد وإدريس في منزل عتيق بباب سبتة سلا.
ولأن سالم كان تلميذًا ناضجاً بأقسام الباكالوريا، فقد شكل لقاؤه بزميله ناصر مناسبة قمينة، بسبب انسجامهما الفكري وتقربهما الوجداني، وناصر تلميذ سلاوي ينتمي لأسرة مقتدرة علميا واجتماعيا؛ إذ يعيش وحيدا في بيته الفاخر مع أمه عايدة أستاذة التاريخ المتقاعدة، بعد أن توفي والده الذي كان طبيبا فرنسي الأصل بثقافة أرستقراطية اعتنق الإسلام وتزوج عايدة، وأقام عيادته بواجهة البيت. سيتخذ الكاتب من شخصيات أستاذة التاريخ المتقاعدة، ثم ناصر ثم العم دانييل الذي يشغل شماسا بكنيسة، حيث عاش الرهبنة منذ شبابه، ولم يتزوج اقتداء ببولس الرسول الذي قال "حسن للرجل ألا يلمس امرأة"، كلها شخصيات شكلت قنوات الكاتب لإبراز أطروحاته، وبسط سردياته المختلفة عن الدين والتسامح الديني والفن والفلسفة والسياسة والجامعة.
- الرواية والقضايا المعاصرة
الرواية توأم الروح رحلة فكرية ونظرية وغوص تخييلي في ثيمات تعد ضمن أعقد المسائل التي تفرض نفسها على الفكر المعاصر منه بصورة خاصة، بدءا من الشأن الديني وقضية التعصب، ثم إشكالية المرأة والمجتمع الذكوري في علاقتها بالمقدس ثم بالفن والاستطيقا، ناهيك بتلك الروابط الفريدة بين الشغل الفني الحديث ومسألة التصوف الإسلامي، وهي علاقات أصبحت تطرح بشدة في الفلسفة المعاصرة؛ إذ نجد على سبيل الحصر من يقارب التصوف بالفينومينولوجيا مثل هنري كوربان وغيره كثير. ناهيك بتعقب أطلال ومعالم مدينة القراصنة سلا والغوص أعماقها الروحية والثقافية والدينية، وبعدها الرباط طبعا. لذلك، فالرواية تحقق هدف موران كما سبقت الإشارة، وتقدم نفسها كتأصيل للمعتقدات والمعارف، وكأننا أمام جينيالوجيا للمعارف والقيم والمعتقدات.
- الفن مرآة الحقيقة
ينطلق هذا العنصر من سؤال ما إذا كان المؤلف قد صور الواقع الديني والفكري بمقدار محترم من الموضوعية أم إنه أعاد صياغته في قالب فكري وفلسفي؟ ذلك أن الرواية تتضمن خطابا مبتكرًا حول الفن وفهما عميقا لأهميته ودلالته، خاصة في اعتبار أهمية الإبداع الفني لا تقوم في ذاته فيما نعطيه له من معنى ودلالة، وهذا ما نبه إليه هيوم من أن الجميل ليس خاصية في الشيء ذاته، وإنما في العقل الذي يتأملها، [14] هكذا يستدعي لوحة الموناليزا[15] Monalisa الكائنة ببيت ناصر، ليطلعنا من خلالها على مكنونات حضارتنا، وما تتضمنه من أسرار، حيث استطاع أن يقحمنا في عمق أحد أعقد المشكلات في الماضي والحاضر، وهي مسألة المرأة في علاقتها بالمقدس والمدنس. فالموناليزا التي تم تصويرها بلا حاجبين ولا رموش، وتجمع في ذاتها بين الذكورة والأنوثة، تكرس في عمقها مجدًا وقداسة للجنس الآخر. من هذا المنظور ترتبط بكيفية وثيقة بصورة المرأة في الوعي الإنساني عموما، سرّها من سرّ الأنثى في ذاتها المقترن بقصص الولادة والخلق. فالإنسان في العصور القديمة كان يتوجه بالتقديس لكل ما هو شاذ وغريب وغير مفهوم ومثير مثل الظواهر الطبيعية والإنسانية المخيفة من مشاهد الرعد الطبيعية وحوادث البرق والموت والحياة، أو كما يصف الـأمر صاحب كتاب سيكولوجية الإنسان أن يصل التقديس إلى درجة تأليه الأنثى، وهكذا امتدّ الأمر إلى تقديس المرأة باعتبارها منبعا للنشأة والإبداع...
وقد كانت الإلهة عشتار في ميثولوجيا العالم القديم أولى المقدسات في بلاد ما بين النهرين، إلهة تختص بالحب والجمال، حيث كانت تمثل رمزية كل شيء، مصدر الحياة والموت، في صلبها تتكون الآلهة وتتكاثر، حيث تفسر الأسطورة السومرية بداية النشأة والخليقة بانشطار عشتار إلى قسمين؛ إذ طار الشطر الأول إلى السماء، بينما استقر الثاني على الأرض، فبدأت الحياة رحلتها المخلدة. وفي مصر سيتم تكريس قداسة الأنثى من خلال أسطورة الإلهة أزيس العذراء الطاهرة، التي لم يمسسها بشر، حيث أنجبت حورس فقط عبر ملامسة جسم أوزيس بدون أن يحصل اتصال مباشر أو إيلاج شرعي، حتى تبقى عذراء مقدسة طاهرة نظيفة. وينبهنا المؤلف في هذا السياق عبر عمل جينيالوجي إلى أصول الأفكار والمعتقدات التي تشكل أطرا حية ومهيمنة على تاريخ الثقافة، ومنها قداسة المرأة، التي ترسخها الأديان السماوية، ومنها المسيحية التي تصور مريم في صورة مقدسة وخالدة تنجب اليسوع بلا أي علاقة مع البشر، حيث يقيم الكاتب أواصر واضحة بين توجهات الأديان السماوية والأساطير السابقة عليها، من أجل فهم خلفيات الثقافة الراهنة، وهو عمل يصب مباشرة في بحوث علماء الأديان.
إن ذلك لا يفسر فقط قداسة الأنثى في الديانات المتأخرة وفي الوعي الجمعي الحديث، وإنما يفسر أيضا بعض الظواهر التي ما زالت تؤرق الشعوب حتى اليوم، من الرهبنة والعزوف عن الأنثى بوصفها شكلا مختلفا من التقديس، حيث يحاكي الرجل قداسة الأنثى في الديانات القديمة، فكان يعمد إلى إخصاء نفسه بنفسه، ويلقي بعضوه الذكري أمام المعبد عربونا للوفاء ودلالة على دخول لحظة مقدسة كاملة، وبالتالي ينقطع الرجل المقدس عن إتيان المرأة فيصير بذلك قديسا عن الأصالة، وهو نفس الفكر الذي ما زال مهيمنا على ثقافتنا اليوم، ويعود إلى حضارات عتيقة جدًّا، حيث ينظر إلى البنت العذراء في صورة إلهية ذات قيمة سامية لا يناظرها شيء في ذلك. أما البنت التي فقدت عذريتها أو المطلقة، فإنها في المنظور الجمعي تفقد قيمتها وما يربطها بنا من إنسانية، كلها عناصر ثقافية قديمة حان الوقت لمواجهتها وفضح ما تقوم عليه من وهم مقدس... والاختتان الذي ورثته الشعوب العربية عن الحضارة العبرانية القديمة، إنما يخدم هذه الغاية، غاية القداسة والطهارة، لذلك نقول نحن المغاربة على أننا نريد أن نطهر الطفل أي سنختنه، وكأن الله خلق الإنسان متسخا حاشا لله، فيتدخل بعض الناس الضعفاء ليطهروا عمل الطبيعة الكامل.
علما بأن اليهودية ستشكل انتكاسة في التاريخ التقديسي للأنثى؛ لأنها أول من حدث البشرية عن خلق المرأة من جسم الرجل، وسيقول المسلمون فيما بعد بانبثاقها عن ضلع الرجل، وهو تصور نكوصي؛ لأنه صعق التصور الأسطوري العظيم المتوارث عن الميثولوجيا القديمة، وكرس دناسة الأنثى ووضاعة موقعها الوجودي، وانحطاطها الأبدي، ومنه ستنهل الشريعة الإسلامية مجمل رؤيتها عن الأنثى... بخلاف المسيحية التي جاءت برؤية مختلفة، وتصور هادم لمخلفات التوراة وشرائع موسى، فاتخذت مريم زمرًا للأنثى المقدسة التي لا يقربها بشر وتنجب في نفس الوقت الآلهة... وهذا يطرح أسئلة عميقة عن علاقة الأديان الإبراهيمية وصراعها عبر التاريخ...
كما يتوسل الكاتب في مناسبة ثانية بتلك اللوحة الفنية التي حصل عليها ناصر كهدية من عايدة مقابل الصداقة الفاضلة بتعبير أرسطو التي جمعته بناصر، حيث تتضمن رسماً للإله خانوم الهيروغليفي المصري القديم، الذي كان يختص بخلق البشر، صور المؤلف هذا المشهد في نظري في إطار عمل جينيالوجي يتعقب أصول المعتقدات الراهنة والآراء الراسخة في الثقافات المختلفة؛ إذ يكشف في هذا الصدد أن خانوم كان في الحضارة المصرية يخلق البشر بغرض خدمة الآلهة، حيث كان يجلس الإله الخالق أمام آلة الفخار ليصنع البشر من صلصال كالفخار؛ ذلك أن أصل الإنسان يعود إلى الطين الذي بشرت به الأديان الإبراهيمية فيما بعد، فالطين ليس فكرة أصيلة للإسلام أو اليهودية، حيث تبدو استفادة الكاتب من بحوث علوم الأديان واضحة، التي تتعقب أصول المعتقدات والقيم والأفكار، وتنتهي بها في الغالب إلى أصولها المثولوجية، فالروايات جميعها الدينية والميثولوجية اجتمعت على الطين بوصفها أساس الخلق والصنعة؛ لأن الإنسان القديم لم يكن أمامه شيئا آخر غير الطين[16]...
في هذا الصدد، إذ نسجل تقدماً نظريًّا بديعاً في مقاربة الكاتب الفن بالتصوف الإسلامي، الخيال بالحدس، فالأعمال الفنية ساهمت بفعالية في تكوين الوعي الإنساني، معالجة القضايا الإنسانية الكبرى. ذلك الإيمان ثم المعرفة بالدين والعقائد في التصوف ما هو إلا خطوة أولى من أجل تحقيق الخير العظيم، وهو الحلول باللاهوت والفناء فيه، والاتحاد مع الذات الإلهية، هكذا يكون الإيمان والمعرفة ليسا معا غاية في ذاتيهما، بل مجرد بداية لمعرفة عالية تلامس الحلول بمعناه الصوفي، والفن من جهته أرقى أنواع المعرفة.
- وحدة الأديان الإبراهيمية ومسألة التسامح
تنحو الرواية في منحى أخلاقي ضارب في أعماق الإنسانية؛ إذ تكشف عن وعي عصري لدى المؤلف وتمرس متين بالفلسفات الأخلاقية والتنويرية، حيث يؤكد في هذا الصدد، أن الشرق هو بداية كل شيء، في نطاقه نزلت الرسائل السماوية على الرسل، فنشأة الأديان جميعها يهودية ومسيحية وإسلام، كلهم ورثة إبراهيم الخليل. ليس هذا فقط، إنما ذهب في اتجاه خلخلة التمركز العقدي والديني الذي تستأثر به الأديان الثلاث وتقوقعت حوله الشعوب؛ إذ لا يوجد في هذا العالم فقط المؤمن التوحيدي يهودي أو مسيحي أو مسلم، وإنما هناك أديان أخرى كثيرة، يوجد ما يزيد عن أربعة ألاف إله في العالم؛ فالبوذيون يحجون كما التوحيديون إلى أماكنهم الخاصة والمقدسة في الهند، كما يفعل الشيء نفسه الهندوس والسيخ والبهائيون والزرادشتيون.
على صعيد ثانٍ، فالمؤلف يؤكد ما أصبحت تتميز به المسيحية المعاصرة من رحابة صدر، وإيمان بقيم الاختلاف والتعدد، الكنيسة المتنورة في مقابل المساجد الغارقة في الخلافات العقدية واللاهوتية، التزمت الفقهي وخطاب الكراهية، مثلها في ذلك مثل العقائد اليهودية المتطرفة، التي ترفض انتساب أي عنصر دخيل للعرق المتميز والشعب المختار، حيث يضمرون نظرة خاصة للآخر (جوييم) أو الأغيار، وهو تعبير توراتي عن كل من ليس يهوديًّا، كتمييز وإقصاء مقيت، وهو ما لم يرق سالم قط، في حين أن الكنائس تتميز بروح المحبة التي تملأ الأجواء والتسامح والتودد، هو ما تصر عليه الأخت سارة بقولها إننا كلنا أبناء الرب، وأحباؤه، نسير على خطى وحدة الروح الإبراهيمية، فأن نتوغل في المحبة هي أسرار الإيمان القويم، غير أنه رغم وحدتها فالرسالات الثلاث دون غيرها من الوثنية عرفت تاريخ من العنف والاضطهاد والاعتداء والتناحر، ما زال ينزل بثقله على العالم حتى اليوم.
هكذا تبنّى الراوي رؤية متنورة جاءت على لسان دانييل ومشروعه؛ إذ تؤكد أن المسيح جاء ليتمم ما ورد في نبوات العهد القديم، المسيحية جاءت لتكمل اليهودية وتبشر بالإسلام؛ فالديانات الثلاث كلها صورة واحدة عن الله المطلق، لا تعارض بينها في الجوهر، وما بدا اختلافاً لا يتجاوز الأعراض والتجليات، هدفها إشراق الذات الإلهية وصفاته وأسراره، التي تنكشف للتقاة الذين يطبقون شريعة السماء الحقة.
- تقويم ونقود: يتضمن هذا العنصر بعض الآراء التي لا تقلل من أهمية العمل، ولكنها ضرورية لتوجيه من يريد أن يكتب ويؤلف، وتلفت انتباه مؤلف توأم الروح في أعماله القادمة.
- حجم الرواية: تضمنت الرواية 393 صفحة، وهو حجم كبير بالنظر إلى ما يمكن أن نسميه موضة الرواية المعاصرة ومطلب القارئ المفقود؛ لأن الكاتب عليه أن يضع في الاعتبار أن المؤلف يتعين أن يجد من يقرأه، والكتاب الذي لا يجد من يقتنيه ويتأمله هو كتاب يولد ميتا. لذلك في رأيي كان من الأفضل أن تكون أقل حجماً، بشكل تتفادى بعض الوصف المطول أو اختصار أحداث أو حوارات قد لا تخدم الحبكة بصورة فعالة، وأحيانا يمكن أن تتسبب في إثقال الإيقاع.
- اللغة والتواصل مع القارئ: لا يمكنني إلا أن أبدي إعجابي بفصاحة الكاتب، وقدرته على السرد بمنتهى العمق، والوصف البديع للمشاهد، إلا أنه من حين لآخر، أشعر بأنه يقوم بما يمكن أن نطلق عليه الاستعراض اللغوي، وخاصة في اعتماد ألفاظ قديمة وأحيانا مهجورة لم تعد متداولة، تدعو القارئ، وأنا واحد منهم إلى الرجوع للمعجم لمعرفة معناها بدقة، مما يجعل الفهم صعباً واللغة بعيدة من نفس القارئ المعاصر الذي صار يريد كتابة سلسة وعصرية، وإلا ستصير الرواية مهددة بالعنوسة، في حين يمكن تبسيط الأسلوب دون فقدان المعنى، وبشكل يجذب القارئ ويحثه على المواصلة والإنصات للراوي، حيث تصير الكلمات وسيلة لتيسير الحكي وليست عبئا عليه.
- تقسيم الرواية: يلاحظ أن الرواية لم تتضمن عناوين فصول أو فهرست واضحة، ربما قد تكون ساعدت المؤلف في الاسترسال والتمتع بحرية أكبر في السرد وطلبا لتدفق الأحداث، ولكنني أنا كقارئ وناقد، قد لا أشارك المؤلف قناعته بهذا الخصوص؛ ذلك أن تعيين الفصول بعناوينها تساند القارئ في التوجيه، وتخلق له عنصر التشويق بوصفها أيقونة مهمة في العمل الأدبي، وتقدم له فكرة واضحة عن الثيمات التي ستخوض فيها الرواية، وغيابها قد يعني ضياع القارئ، وأحيانا افتقاد المحفز والدافعية للقراءة.
وأكثر من هذا، فالعناوين ليست للتشويق والحافزية والتوقع فقط، ولكنها مهمة أيضا في عمليات التحليل والتركيب، من أجل فهم وتفكيك شيفرات الحبكة، إضافة إلى وظيفة التذكر للأحداث والمواقف بسهولة وفق النظام العصبي الذي يتميز به الإنسان...
- مشكلة الفكر والسرد: ولأن النقد لا يعني فقط إبراز مكامن الاختلال، وإنما أيضا تثمين مناطق القوة والإبداع، نسجل القدرة المتميزة التي تجمل بها الكاتب في خلق ذلك التوازن المطلوب بين الفكر والسرد، مع حضور التخييل، ولا سيما عنصر التشويق، حتى إن القارئ أصبح يشعر بشوق خاص لزيارة سالم لبيت ناصر ولقاء عايدة أو لقاء دانييل طلبا لما سيكتشفه من دروس ونفحات فكرية أو تاريخية أو فلسفية، مما يعني أن العمق الفلسفي لم يؤثر على المسار السردي، وإنما ساهم في إثرائه وإغناء حبكته، وفي نفس الوقت يذهب الرتابة والملل عن النفس...
المصادر والمراجع:
- عبد الرزاق الرميشي، توأم الروح، دار أبي رقراق، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 2023
- الطيب بوعزة، ماهية الرواية، عالم الأدب للبرمجيات، بيروث، لبنان، الطبعة الأولى، 2016
- جورج لوكاتش، الرواية كملحمة برجوازية، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروث، لبنان، الطبعة الأولى، 1979
- عبد المنعم الكيواني، الفكر المركب في مواجهة الأزمات الراهنة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، مقال على الموقع، 2025 Le Site: https://shorturl.at/VhSlp
- محمد لطفي جمعة، أفلاطون ومأدبته، كلام في الحب، مؤسسة هنداوي، الأمم المتحدة، 2021
- JSSA_Volume 19_Issue العدد التاسع عشر الجزء الرابع_Pages 1-26.pdf
[1] عبد الرزاق الرميشي، توأم الروح، دار أبي رقراق، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 2023
[2] https://www.hindawi.org/books/69246413/3.2/
[3] الطيب بوعزة، ماهية الرواية، عالم الأدب للبرمجيات، بيروث، لبنان، الطبعة الأولى، 2016، ص. 60
[4] جورج لوكاتش، الرواية كملحمة برجوازية، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروث، لبنان، الطبعة الأولى، 1979، ص. 06
[5] إدغار موران ولد عام 1921، هو فيلسوف وسوسيولوجي معاصر، ومن أكثر الفلاسفة الفرنسيين والعالميين شبابا وتأثيرا، يعرف فكره بفكر التعقيد، ويتميز بشمولية الطرح في فهمه للعصر وقضاياه، من مؤلفاته كتاب منهج المنهج Méthode de la méthode.
[6] عبد المنعم الكيواني، الفكر المركب في مواجهة الأزمات الراهنة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، مقال على الموقع، 2025
Le Site: https://shorturl.at/VhSlp
[7] انظر مثلا رواية حي ابن يقظان للفيلسوف المغربي ابن طفيل الذي ضمن فيها رؤيته للمشكلة التاريخية في العصر الوسيطي وهي مسألة التوفيق بين الدين والفلسفة.
[8] أجاتا كريستي (1890-1976) روائية بريطانية، تحمل لقب ملكة الجريمة، بسبب اشتهارها بالتأليف البوليسي عن الجرائم العالمية.
[9] محمد لطفي جمعة، أفلاطون ومأدبته، كلام في الحب، مؤسسة هنداوي، الأمم المتحدة، 2021، ص، 118.
[10] رولان بارت (1915-1980) هو من أبرز المفكرين الفرنسيين المعاصرين، عاش في القرن العشرين، وبصم حضوره كشخصية ذات أهمية كبيرة خاصة في مجال الدراسات النقدية والأدبية، حيث مارست أعماله تأثيرها القوي على الفكر والفلسفة والأدب والسيمائيات، من أعماله الأسطورة في الثقافة الشعبية (1957).
[11] JSSA_Volume 19_Issue العدد التاسع عشر الجزء الرابع_Pages 1-26.pdf
[12] ستيفان مالارميه (1842-1898) هو شاعر فرنسي مبدع ومشهور، يعد إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في الشعر الأوربي الحديث...
[13] رولان بارت، هسهسة اللغة، ص. 77.
[14] عبد الرزاق الرميشي، توأم الروح، مصدر سابق، ص. 123.
[15] الموناليزا توجد بمتحف اللوفر بباريس، وتشير إلى إحدى اللوحات العالمية الأكثر شهرة وانتشارا في تاريخ الفن، حيث أبدعها الفنان الإيطالي ليوناردو دا فنشي بين 1503 و1519
[16] عبد الرزاق الرميشي، توأم الروح، مصدر سابق، ص. 119