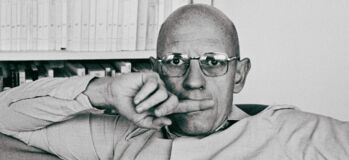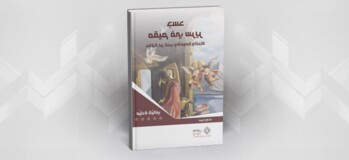السلطة واختلاقها للاختلاف
فئة : مقالات

السلطة واختلاقها للاختلاف
ياسين بوفري[1]
إشراف: محمد مزيان
الملخص:
تهدف هذه الورقة إلى استعراض المقاربة الفلسفية لمشكلة المعرفة والسلطة في فلسفة ميشال فوكو (Michel Foucault)، من خلال دراسة كتابيه الأساسيين "المراقبة والعقاب: ميلاد السجن" و"تاريخ الجنسانية: إرادة العرفان". ليس الهدف من ذلك مجرد انتقاد الرؤية الفلسفية للسلطة، بل الكشف عن الاستراتيجيات والآليات التي تعتمدها السلطة داخل السياق الفلسفي لخلق الاحتلاف. ولفهم هذا الأمر، يتعين أولاً التركيز على تحول مفهوم السلطة في براديغم التفكير من البحث عن طبيعتها/ماهيتها إلى الاهتمام بكيفية عملها، ثم تحليل ومناقشة كيفية إدارة السلطة للجسد والرغبة.
استهلال
"إنه يجب أن ننخدع نحن أنفسنا بهذه الحيلة الداخلية للاعتراف كي نمنح للمراقبة والكلام والتفكير، دورا أساسيا؛ ويجب أن نكون لأنفسنا تمثلا معكوسا عن السلطة لنعتقد بأنها تتحدث لنا عن الحرية في كل هذه الأصوات التي تجتر، منذ زمن طويل في حضارتنا."
تقديم
عنوان هذا المقال هو علامات اخترنا أن تكون موجِهة لهذه الورقة في البحث والتحليل، من خلال الوقوف عند مؤلفين يضربان بعمق في تاريخ الفلسفة المعاصر: تاريخ الجنسانية: إرادة العرفان؛ المراقبة والمعاقبة: ميلاد السجن؛
حديث يروم، لا إلى كتابة تاريخ الماضي - لعلاقة المعرفة بالسلطة - بعبارة الحاضر، بقدر ما يتغيا كتابة تاريخ الحاضر، على ضوء أسئلة تقطع مع التصورات الماهوية؛ - ما السلطة؟ ما الاختلاف؟ أو يقيم ثنائيات حولها توسمُ بالتوتر والتنافر بينهما. كما لا يقدم بديل لممارسة السلطة، بقدر ما يحاول استكناه بؤر السلطة المتعددة في أنحاء المجتمع، وكيفية إختلاقها لبنيات سوسيوثقافية؛ من خلال الاجابة على تساؤلات من قبيل عبر أي قنوات، ومن خلال أي خطابات، تتمكن السلطة من الوصول حقا إلى السلوكيات الاكثر فردانية والأكثر خصوصية؟ وما هي الوسائل التي تسمح لها بالوصول إلى هذه الأشكال؟
نُظر إلى السلطة، على الأقل، مع ماكيافلي مرورا ب: هوبز، وصولا إلى روسو، على أن السلطة ترتبط أساسا بالحق والملكية المختزلة في شخص الحاكم، وأن أساسها يذهب في مرحلته الاولى إلى أن السلطة مطلقة لدى الحاكم، وعلى إثرها يحكم دون الرجوع إلى الشعب، ومتى ما استشعر خطرا يتهدّده يتدخل بكل الوسائل المتاحة له؛ مشروعة كانت أو غير مشروعة تحت ذريعة الحق.
عرفت السلطة في القرن السادس عشر والسابع عشر، نوعا آخر من المساءلة وُسم بـ "نظرية التعاقد"، الذي عالجت مسألة أساس قيام السلطة، ومدى محدودية تدخل الحاكم في حرية الأفراد باسم الحق. ويمكن القول سريعا إن الثابت في هذه النظرية رغم تعاقب فلاسفتها- هوبز، لوك، روسو، - مسألتين: التنازل عن الملكية (جزء من الحرية إلى الحاكم) والحق (الذي يبقى في يد الحاكم مع اختلاف صيغة التعاقد).
في نهاية القرن الثامن عشر، تبين أن صيغة التعاقد هذه، الذي تبنتها الثورة الفرنسية، وفلسفة الأنوار، والتي كان من المفروض أن تتدخل بإسم الحق، للحفاظ على السلم والحريات؛ أصبحت تشرعن لنفسها إمكانية التدخل بالعنف تحت ذريعة الحق، مما أدى إلى مساءلة صيغة هذا الحق الذي يختزل في يد الحاكم. لكن هذه القرون الثلاثة لم تتجرأ يوما للمطالبة برأس الأمير، وظلت تسائل وتتساءل حول طبيعة الحكم و"حدود الحق" الموكل لهذه الملكية؛ الأمر الذي يجعلنا نَسِمُ هذه العقود بلغة فوكو بثنائية: السلطة - القانون.
إن طبيعة السؤال الماهوي، الذي تجدر في هذه العقود الثلاثة حول السلطة، جعلنا نقيم حول السلطة ثنائيات ميتافيزيقة، لا يستقيم أي خطاب عليها وحولها دون الانطلاق منها؛ السلطة - المعرفة، التكتم - التكلم، القمع - الحظر، السلطة - الرغبة، إلخ. إن طبيعة هذا السؤال الماهوي، وتوجُس الميتافيزيقا بنا عبر ثنائياتها (نعم - لا) جعلتنا ننتج خطابا متعاليا حول السلطة؛ والحال أن السلطة "إمبريقية" متجذرة في الواقع، وتشتغل عبره ومن خلاله.
وعليه، إن الحديث عن اختلاق السلطة للاختلاف، يقطع مع هذا المنظور المتعالي للسلطة، ويعبر لا من خلال نظرية سلطة- قانون، بل من خلال نظرة تحليلية لا تأخذ الحق كنموذج، بقدر ما تُعرف الميدان المتميز الذي تكونه علاقات السلطة وتحليل الأدوات التي تمكن من السيطرة عليه.
بكلمات فوكو نقول: "أن الطرائق الجديدة للسلطة تختلف بالمطلق عن طرائق السلطة القانونية؛ إذ تشتغل هذه الطرائق الجديدة لا بالحق ولكن بالتقنية، لا بالقانون ولكن بالتطبيع، لا بالعقاب ولكن بالمراقبة، والتي تمارس على مستويات وفي أشكال تتجاوز الدولة وأجهزتها.".[2]
من هذه الوجهة، وبهذا الفهم، سيذهب التحليل في هذه المحاولة، إلى البحث عن اختلاق السلطة للاختلاف من خلال تحليلية الجسد، متوقفا عند أربع ميكانزمات[3]: (ميدان السلطة؛ تكتيكات السلطة؛ المنهج الموظف؛ الخطاب المنتج) ملتزما في التحليل بأربعة عقود توسلت السلطة فيهم بالكنيسة والعلم والمؤسسات، واشتغلت عبرهم من خلال نظام متعدد في الخطاب، موحد في الغاية؛ إنتاج الحقيقة.
لبسط منهجي، سنحاول تقسيم هذا المقال إلى عنصرين، يتخلل كل واحد منهما محورين:
- تقنيات السلطة في بسطها للعقاب على الجسد؛
- الجنس والسلطة؛
ارتأينا في التحليل الانطلاق من كتاب المراقبة والمعاقبة: ميلاد السجن. وصولا إلى تاريخ الجنسانية: إرادة العرفان. ومرد هذا الترتيب لسببين: الأول: احترام التعاقب الزمني لإصدار المؤلفين. ثانيا: لأن التحليل ينطلق من علاقة الجسد بالسلطة بشكل عام، وصولا إلى علاقة الجنس بالسلطة بشكل خاص.
1- تقنيات السلطة في بسطها للعقاب على الجسد:
أ- الجسد كهدف للعقاب:
يذهب الحديث في هذا العنصر، إلى استشكال علاقة المعرفة بالسلطة، من خلال تتبع آليات ممارسة السلطة وانتشارها داخل حقول معرفية، ومؤسسات إنتاجية، بالوقوف عند ما سمي في الحقل الفوكوي: بجهزوت السلطة، او السلطة جهزوت؛ مقاربا جهزوت السجن وجهزوت الجنس.
إن توجه المقاربة نحو جهوزت السجن لاستشكال قضية السلطة، هو توجه يتغيا البحث عن الاستراتجيات والآليات والاستعدادات التي تحكم بهم السلطة سير العمل، وخلق واقع يكون فيه الجسد في بؤرة الصراع، وينمط وفق التكتيكات المختلفة التي اعتمدت في كل عصر.
يفتتح فوكو كتابه "المراقبة والمعاقبة" ميلاد السجن، بمشهد درامي للمحكوم عليه دامين بطريقة أدبية تظهر اقتباس آليات الحكم الكلاسيكية للأسطورة اليونانية بروميثيوس من خلال حمل دامين لشعلة نارية، وتقييده على خشبة المسرح، لينطلق في تحليل استراتيجيات السلطة في القرون الوسطى التي كانت تستهدف جسد المُدان.
إدراج هذا المشهد منذ مطلع الكتاب، كان لغرض أساسي، يتجلى في تتبع الآليات التي تشتغل بها السلطة والنقاط التي تستهدفها، والغايات التي تحققها. إذ يظهر من خلال التحليل، أن السلطة تشتغل وفق تكتيكات تجعل من العقوبة تستهدف جسد المحكوم عليه - هو عنوان الفصل الأول - بطريقة مأساوية، تحاول عبرها تقديم العبرة وإظهار قوة الحاكم. إنها لحظة تشتغل وفق آليات متعددة تحاول استنزاف طاقة الجسد ما أمكن، وتُطوِّل من تمثيلية المشهد.
إن جسد المجرم يواجه بشكل مباشر - عبر توسط الجلاد - انتقام الحاكم؛ إذ إن الإقدام على إرتكاب جريمة، لا يعد خرقا للقانون فقط، بقدر ما يعبر عن توجيه إهانة للحاكم؛ إهانة تُواجه بعرض عقابي يعترف فيه المجرم بالذنب، ويُعرض لأقصى أنواع التعذيب الذي يفترض فيه أن يكفر من خلاله عن الذنب، الذي يظهر كمشهد احتفالي للجمهور.
إلا أن وضع الجسد موضع مشاهدة، وتنفيذ القصاص أمام الجمهور، سرعان ما انقلب ضد الغرض الذي وضعته السلطة، المتمثل في إظهار قوة العدالة وإعطائها شرعية؛ إذ أدى هذا التمثيل إلى إحلال المجرم محل المظلوم، والعدالة محل القاتل. من جهة أخرى، هذا العيد العقابي، الذي كان يشكل مناسبة لتجديد التحام الشعب مع العدالة، أصبح، على العكس من ذلك، يعكس تعاطف الجمهور مع المجرم. الشيء الذي سرّع من خلق استراتيجيات وأخلاق جديدة للسلطة.
ب- انزياح العقاب من دلالة الانتقام إلى الدفاع عن المجتمع:
أمام هذا المعطى المتجلي في تعاطف الجمهور مع المجرم، في عصر الفضيحة بلغة فوكو، ما كان للسلطة إلا أن تُحيِّن آليتها لخلق أخلاق جديدة لممارسة السلطة؛ أخلاق وضعت الجسد محل مراقبة، والروح موضع معاقبة.
آليات حاولت بسط سيطرتها على جسد المجرم، من خلال وضع مجموعة من القواعد التي تؤطر يومه، وتراقب تحركاته، وتستنزف طاقته في العمل، حيث يمكن اختزال هذه القواعد في: وقت الاستيقاظ، الصمت، فتح باب الزنزانة، الأكل، قراءة كتب أخلاقية ودينية، تحديد أوقات العمل والاستراحة.
لقد عملت السلطة عبر آلياتها إلى قلب المواقع التي تشتغل منها، وقلب التصور العام نحو نظرة الجمهور إلى المجرم. إذ أصبح الطقس يعرف جهر الحكم والمداولات وسرية التنفيذ، كما أن آليات تفعيله لم تعد في يد الجلاد وحده، بل حاولت العدالة للحفاظ على صورتها، خلق مجموعة من المؤسسات التي تسهر على عملية التنفيذ، وهنا تظهر وظيفة العلوم الانسانية المشبوهة؛ إذ "توافد جيش من التقنيين ليحل محل الجلاد الذي كان هو المشرح المباشر للألم: المراقبون والأطباء، والكهنة، والاطباء النفسانيون، والمربون؛ كل هؤلاء بوجودهم وحدهم قرب المحكوم عليه. يؤدون للعدالة المديح الذي تحتاجه: فهم يكفلون لها بأن الجسد والألم لن يكونا الغرضين النهائيين لعملها التأديبي."[4]
إبطال المشهد وإلغاء الألم، زرع أخلاق جديدة للسلطة؛ أخلاق أمحت العرض العقابي، وجعلته يدخل في مجال الوعي المجرد، كما أن هذا النوع الجديد من العقاب لا يستهدف الجسد، بل أصبح الجسد يشكل فقط لحظة "ومضة" تلتقي فيها المقصلة مع رأس المدان. وبالتالي، فإن هذه التحولات اقترنت بانتقال في الغرض الذي ترمي إليه العملية العقابية، حيث "إن التكفير الذي يتكالب على الجسد قد أستبدل بقصاص يعمل بالعمق على القلب، والفكر والإرادة والاستعدادات."[5]
من جهة أخرى، عملت السلطة على إعادة تلطيف نظرة الشعب إلى ممارستها العقابية، خاصة وأن تعاطف الشعب مع الضحية، جعل منظروا وفلاسفة الإصلاح في القرن الثامن عشر، يطرحون تساؤلا حول الحالة القصوى التي يمكن للعقوبة بلوغها دون المساس بإنسانية المجرم؛ الشيء الذي أدى إلى مساءلة السلطة على ضوء سياسة حقوقية تأخذ بمعيار الانسانية.
قراءة هذا المعطى، يجب أن يستند إلى التحول الذي حدث على مستوى الجريمة؛ إذ لم تعد الجريمة تستهدف الانتقام والقتل، بقدر ما أصبحت تتميز بالاحترافية والمكر والحيل، وانصبت بشكل كبير على السرقة، خاصة مع تنامي المجتمعات الاقطاعية، وتوسع الزراعة والمصانع؛ ليرفع شعار النصف الثاني من القرن الثامن عشر على شكل "فلتكن العقوبات معتدلة ومتناسبة مع الجرائم، وألا يحكم بعقوبة الموت إلا على المجرمين القتلة، وأن يلغى التعذيب الذي يتنافى مع الإنسانية."[6]
أمام تضامن الشعب مع المجرم، والتفكير في حتمية التمرد على السلطة العليا، تأكدت الحاجة إلى التخلي عن الاقتصاد القديم للسلطة العقابية - القائم على توزيع ومركزة السلطة - إلى خلق آليات واستراتيجيات جديدة تستهدف الجسد الاجتماعي في كليته، وتحاول ضبط وتصنيف وتثقيف والتنبؤ بالجريمة. أو بشكل أدق: عملت السلطة عبر آلياتها على إعادة اللحمة الاجتماعية حول السلطة العليا؛ وذلك من خلال تقسيم الجريمة وتفيئها، والتخلي على فكرة أن الظنين -متهم- في كل الأحوال، إلى العمل على تتبع البراهين حتى يتأكد الجرم أو الجريمة.
أدى ذلك إلى عزل المجرم عن الجسم الاجتماعي؛ إذ لم يعد يوضع خارق القانون مقابل العاهل، بل أصبح يوضع أمام الجسم الاجتماعي ككل، ويستشعر كل فرد بأن خرق المجرم للقانون، هو خرق يؤذِيه هو بطريقة مباشرة. الأمر الذي أدى إلى التفكير في نمط مغاير من العقوبة، حيث "أصبحت إنسانية العقوبات، هي القاعدة التي تعطى لنظام عقوبات عليه أن يتبث حدود هذه وتلك. فالإنسان الذي يُراد احترامه في العقوبة هو الشكل الحقوقي والأخلاقي الذي يعطى لهذا التحديد المزدوج."[7]
هذا التحديد المزدوج، سمح للسلطة بالاشتغال من خلال وظيفة الاستباق والإنذار؛ أي إنها جعلت العقاب ينظر إلى المستقبل ويعمل من خلال قواعد رئيسة (قاعدة الكمية، قاعدة الفكروية، قاعدة المفاعيل الجانبية، قاعدة اليقين التام، قاعدة الحقيقة المشتركة، قاعدة التخصص الأمثل.)[8]
لقد سعت هذه القواعد إلى تعميم القصاص الجزائي ليشمل الجسم الاجتماعي في كل عنصر من عناصره، لتنبؤ بالجريمة والإحاطة بها، وتجزيئها وتقسيمها وتصنيفها إلى جرائم ترتبط كل واحدة فيها بنوع العقوبة، والمدة الزمنية المتوقعة لها، حتى يتشكل وعي لدى الإنسان يجعل اللا- شرعيات الشعبية موقع تساؤل وظلم يستشعره الكل.
هذا التقسيم والتصنيف، نتج عنه مسألتين: الأولى: تحول تقنية العقاب من الثبات المتمثل في تنفيذ العقوبة الدموية، إلى تقنية الانتشار والتموقع داخل الجسم الاجتماعي ككل. ثانيا: وهي مسألة أساسية: ظهور تقنية السجن، كآلية جديدة لممارسة السلطة، بغرض إصلاح الأفراد وإعادة إدماجهم في مؤسسات الإنتاج؛ متوسلة بالقواعد التي وضعت من طرف منظري الإصلاح؛ إذ "في نظر القانون، يمكن أن يعتبر الاعتقال حرمانا من الحرية؛ وقد تضمن الحبس الذي يؤمنه، دائما مشروعا تقنيا. ولا يُشكِلُ الانتقال من التعذيب، وما فيه من مراسم متألقة، ومن فن مزدوج بالاحتفال الألمي، إلى عقوبات الحبس المتوارية ضمن هندسات بنائية ضخمة محاطة بالسرية الإدارية، انتقالا إلى عقوبة لا متميزة مجردة ومبهمة. إنه انتقال من فن العقاب إلى فن آخر، لا يقل عن الأول إتقانا."[9]
ظهور السجن كتقنية من تقنيات السلطة عرف انتقادات كثيرة، خاصة وأن الجسم الاجتماعي، كان ينتظر إنزال القواعد الحقوقية للإصلاح على أرض الواقع، إلا أنه بدل من ذلك ظهرت تقنية السجن، كآلية سلطوية للعقوبات البديلة. من جهة أخرى، عرفت هذه الآلية تزكية التلاحم الاجتماعي مع السلطة العليا، باستبدال السلاسل التي يتقيد بها المجرم، وهي سلاسل ظلت مستمرة من العيد العقابي، بعربات بانوبتية تحد من المس بإنسانية المجرم. ومع ذلك "فإن الطريقة التي حلت بها محل "السلسلة"، وأسباب هذا الحلول تضم باختصار كل العملية التي حل فيها الاعتقال محل التعذيب خلال ثمانين عاما: كتقنية مدروسة من أجل تغيير الأفراد. فالعربة/ الزنزانة إنما هي جهاز إصلاح. وما محل التعذيب، ليس حبسا كثيفا، بل هو تدبير تأديبي انضباطي، متقن التمفصل بعناية. من حيث المبدأ على الأقل."[10]
لنوجز القول، لقد نظر إلى تقنية السجن في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على أنه لم يحقق ما يرجى منه؛ أي تطبيق ما أتت به "النظرية الإصلاحية"، وأنه على العكس من ذلك لم يتمكن السجن، كتقنية من تقنيات السلطة - تقنية لم يكتب تاريخها حتى نتمكن من آليات اشتغالها- من إصلاح الفرد ودمجه في دورة الإنتاج، بل أدى، على العكس من ذلك، إلى تزايد الجريمة واستفحالها، بل إن تكرارها من طرف المجرم اصبحت بنسبة كبيرة شبه مؤكدة.
الجواب عن هذه الانتقادات، وإلى حدود اليوم، كان دائما واحد: هو أن المؤسسة السجنية تحتاج دائما إلى المبادئ الثابتة للتقنية التكفيرية، كوسيلة لإصلاح وتقويم فشلها الدائم، ما سمح لها بتطوير بعض المبادئ التي تشتغل بها ومن خلالها: "مبدأ التقويم، مبدأ تكييف العقوبات، مبدأ العمل كموجب وكحق، مبدأ التثقيف السجني، مبدأ السيطرة التقنية على الاعتقال، مبدأ المؤسسات الملحقة." (ص: 265-269).
كما أن فشل السجن في مهمته الإصلاحية، راجع بالأساس إلى الاستعمال السيء للسلطة، من قبل الإدارات السجنية، وتفاوت في الذكاء بين المحكومين الأذكياء، الذين طوروا أساليبهم الإجرامية، والتكتُمية (النميمة) داخل المؤسسة السجنية، في مقابل أُمية الموظفين داخل المؤسسة السجنية؛ أضف إلى ذلك سوء المعاملة وتشريد أسرة المجرم، ما يجعل المجرم لا ينظر إلى ذاته نظرة المجرم، بل ينظر إلى العدالة نظرة ظلم واحتقار.
على هذا الأساس، يذهب فوكو إلى أعمق من ذلك، ويقترح قلب هذه الفرضية التي تدعي فشل السجن، والتساؤل حول ما يمكن أن يختبئ وراء هذا الفشل الظاهر للمؤسسة العقابية، لتكون الفرضية قائمة بدلا "من رؤية التناقض، نوعا من النتيجة؟ يتوجب عندئذ أن نفترض أن السجن وبشكل عام، ولا شك العقوبات، ليست مخصصة لإبطال المخالفات، بل الأولى لتمييزها، ولتوزيعها ولاستخدامها؛ وإنها تهدف، لا إلى صد اللذين لديهم استعداد لمخالفة القوانين، بل إنها تتجه إلى ترتيب مخالفة القوانين ضمن تكتيك عام استعبادي."[11]
إن قلب الفرضية القائمة حول فشل السجن كتقنية، يتوجب قراءتها على ضوء معطى تعميم اللاشرعيات الشعبية، وتطورها فيما بعد لتصبح لا شرعيات عالمية، عملت السلطة على توزيعها في أشكال مختلفة وفي مستويات متعددة. وبالتالي، فإذا كان هذا هو الواقع، فإن السجن حين يفشل ظاهريا، لا يفقد هدفه، بل إن هدفه هو "أن يساهم في صنع لاشرعية رؤوية، مرسومة، ثابتة عند مستوى معين ومفيد سرا - متمنعة ومطيعة بآن واحد، فهو يرسم ويلحظ شكلا من اللاشرعية يبدو وكأنه يلخص رمزيا كل الأشكال الأخرى، ولكنه يسمح بأن تبقى في الظل الأشكال التي يراد لها أو التي يجب التسامح بها."[12]
إن هذه التقنية الجديدة للسجن تضرب في عمق الإشكال الذي انطلقنا منه المتمثل في خلق السلطة للاختلاف؛ إذ إن الهدف من التقنية السجنية، لا القمع، بل خلق لا شرعيات مختلفة وتعميم فائدتها، وتسليط الضوء على احدها وتهميش الأخرى. إنها تشتغل وفق آلية تفاضلية تمعير من خلالها اللاشرعيات، وتنتج أشكال أخرى أقل خطورة من الناحية السياسية والاقتصادية، أشكال تبدو هامشية ظاهريا لكنها محكومة من قبل المركز. هذه الاشكال تتمثل في الجنون والجنس.
من هذا المنطلق، يمكننا التقدم في التحليل بالانتقال من علاقة الجسد - عقوبة، إلى الانغماس في جانب الحساسية والشهوة، أعني الجنس، وعلاقته بالسلطة.
2- الجنس والسلطة:
أ- الجنس كموضوع للاعتراف:
نكتفي في هذا الجانب من التحليل بالوقوف، فقط، عند الجزء الأول من الثلاثية الموسومة بتاريخ الجنسانية: إرادة العرفان. وقراءته في ضوء العنوان الذي وسمنا به هذا المقال. وإذا تغاضينا عن ذكر أفكار تجيب عن سؤاله المحوري: - لماذا أصبح السلوك الجنسي، والأنشطة والمتع المتعلقة به، موضوع انشغال أخلاقي؟ - فهذا راجع إلى الخطوات المنهجية التي رسمناها لهذه الورقة.
ننطلق في هذا التحليل من القرن السابع عشر، باعتباره اللحظة الذي عرفت فيها الجنسانية تحولا من الصراحة التي كانت سارية، والخطابات المباشرة غير المخجلة، إلى تكتم مفرط على مستويات الممارسة والخطاب. إنه تكتم تسوده ثنائية المحظور واللاشرعية. لذا يجب أن نقيم تساؤلات مبدئية للانطلاق في التحليل:
- لماذا ارتبط الجنس بالخطيئة في عصر البورجوازية؟
- كيف تم هذا الربط؟
- ما علاقة المؤسسة الزوجية في حظر الجنسانية؟
إن طرح هذه الإشكاليات، لا يهدف إلى تقديم إجابات واضحة حولها، بقدر ما يتغيا تسليط الضوء على الأساس الذي يجمع بين هذه الأسئلة، وتجاوزها لجعل الأساس الذي يشكلها هو الجانب الذي نسعى إلى تحليله؛ الحديث هنا عن السلطة القمعية التي أحاطت بمركب الجنسانية، والمعرفة التي نشكل حولها؛ إذ إن "قضية الجنس - قضية تحرره، ولكن أيضا قضية المعرفة التي يمكن أن تكون لنا عنه، وقضية الحق الذي لنا في الكلام عنه - تجد نفسها، بهذا الشكل، مرتبطة بكل مشروعية بشرف قضية سياسية: فالجنس ينخرط هو أيضا في المستقبل."[13]
فلما كانت قضية الجنس، قضية يجب أن يسكت عنها في مستوى الخطاب، لكي تندثر على مستوى الواقع، كان على السلطة أن توفر من خلال آلياتها، والعمل من خلال استراتيجياتها على توفير أمكنة تسمح فيها بالحديث عن الجنس، حتى تُقلص من التوتر المقيم حوله.
عملت السلطة في العصر الكلاسيكي، على إقامة ميدان الخطاب ومنهج يسهل من تنميطه، إذ أصبحت الكنيسة المكان الذي يعمل بطريقة السلب، بحيث يحث على الحديث حول الجنس، ويحافظ على سريته، من خلال تقنية الاعتراف؛ فالإصلاح الديني المضاد اهتم في كل البلاد الكاثوليكية، بتسريع وثيرة الاعتراف السنوي؛ ولأنه حاول فرض قواعد دقيقة لفحص الذات من قبل نفسها....فهذا المشروع لتخطيب الجنس، كان قد تكون، منذ زمن بعيد، داخل تقليد نسكي ورهباني محدد، إلا أن القرن السابع عشر كان قد جعل منه قاعدة عامة يلتزم بها كل الناس.[14]
إن اشتغال السلطة عبر تقنية الاعتراف، كان لغرض واحد وأساسي، يتمثل في إقامة خطاب متكامل حول الجنس، والبحث عن جعل كل الرغبات خطابا، ينتج حقيقته؛ حقيقة الجنس. لم تقتصر آليات السلطة في الحث على الحديث حول الجنس، بل اشتغلت على معجمه حتى يتسنى للخطاب حوله أن يبدو تقنيا، نافعا ومقبولا.
إن الحديث عن خطاب حول الجنس، هو حديث عن حقيقته؛ هذه الحقيقة التي تجعل الرغبة لا خارج السلطة، بل هي حقيقة تقيم الرغبة داخل السلطة، وتجد مشروعية لها من داخلها. لذلك لم يكن الحديث عن حقيقة الجنس، هو "مسألة فضول أو حساسية جماعية، ولا كانت مسألة ذهنية جديدة، ولكنها كانت قضية آليات للسلطة جعلت من الخطاب حول الجنس آلية أساسية بالنسبة إلى اشتغالها."[15]
وعليه، فإن اشتغال السلطة لتأسيس خطاب حول الجنس، لم يشتغل فقط بإنتاج خطاب موحد ومتماسك حول الجنس، بل اشتغلت وفق استراتيجيات وآليات سمحت بإنتاج خطابات متعددة بتعدد الأمكنة والحقول التي تلامس موضوع الجنس وتصنفها وفق بحوث كمية أو سببية.
ب-الجنس رهان للدولة والفرد:
لم يعد الخطاب حول حقيقة الجنس، مختزلا في آلية الاعتراف، بل عرفت حقيقة الجنس انتشارا داخل كل القطاعات أو الحقول المعرفية الأخرى. فمنذ القرن الثامن عشر، لم يعد الجنس قضية دولة فقط، بل أصبح رهان يشترك فيه الفرد والدولة. فقد عقد المجتمع مستقبله حول الاهتمام بالاقتصاد السياسي للساكنة، والتحكم في قضية الإنجاب، وتنظيم الأسر.
أما على المستوى المعرفي، فقد انبثق خطاب حول حقيقة الجنس، سواء على المستوى الأدبي أو المستوى العلمي؛ إذ لم تعد الرواية الأدبية تهدف إلى السرد الخيالي والاعتماد على اللغة الجميلة، بقدر ما أصبحت تثير حقيقة الجنس، وتصور ممارساته. أما على مستوى العلوم، فقد "تفجرت خطابات متمايزة، وجدت أشكالها في الديموغرافيا والبيولوجيا والطب والتربية والنقد السياسي (....) للحث عن الكلام عنه، وللحصول منه على أن يتكلم عن نفسه، للاستماع والتسجيل والنقل وإعادة توزيع ما يقال عنه."[16]
إن إقامة خطاب أدبي علمي حول الجنس، لا يدعي تأسيس خطاب خارج بؤرة السلطة، بل تم إقامة حقيقته داخل مجال ممارسة السلطة، إلا أن ما يجب التأكيد عليه في هذا الجانب هو إعطاء مشروعية علمية للخطاب حول الجنس، أدت إلى تقييد الحديث حول قوانين طبيعية للزواج، وفتحت باب الحديث عن جنسانيات أخرى؛ جنسانيات الهامش المتطرفة والمفروضة؛ إذ أصبح الرهان هو الحديث عن جنس الأطفال والمراهقين، وعالم الشدود، حيث "أمكنها أن تصير منذ فترة معينة لا موضوع تعصب جماعي فحسب، ولكن أيضا موضوع عمل قضائي، وتدخل طبي، وفحص عيادي دقيق، وبلورة نظرية كاملة."[17]
من هنا، فإن الحديث عن الجنسانية، إذا كان قد حمل معه محظورات، فإنه ثبت بطريقة أو أخرى انغراس تغاير جنسي كامل حول الجنسانية: يخضع لمعيار الطبي، يصنف عبر ملفات وأرشيفات، ينظم وينمط علاقات، ويكشف أكثر مما يخفي.
لقد استلهم التحليل النفسي تقنية الاعتراف، لاستكناه حقيقة الجنس، من خلال حث المريض على الحديث، واستماع الطبيب إليه، لا لقول المريض الحقيقة حول الجنس فقط، بل لقول الجنس أيضا حقيقة الفرد الذي لا يعرفها عن نفسه. من هنا لم تعد السلطة عند من يتحدث، بل لمن يستمع، لا لمن يملك اجابات، بل لمن يطرح تساؤلات. "فالقرن التاسع عشر بدمجه للاعتراف في مشروع خطابي علمي، قد حوله: فالاعتراف لم يعد ينصب على ما يود المرء إخفاءه وحسب، ولكن على ما يخفي عليه هو نفسه، والذي لا يمكنه أن ينجلي إلا شيئا فشيئا بعمل اعترافي يشارك فيه كل من جانبه، السائل والمسؤول."[18]
من هذه الوجهة، يمكن القول إن المجتمع الذي كان يتطور رأسماليا أو صناعيا، لم يكن يجابه الجنس بالرفض والقمع، كما كان الحال في القرن السابع عشر الذي فرض على الجنس تقنينا مؤسساتي يتجلى في المؤسسة الزوجية، وصادر كل الأشكال الأخرى من المركبات الجنسانية. وبالتالي، فإن التحليل يجب أن ينكب بشكل عام، لا على البحث عن أدوات الحضر التي أقامتها السلطة، بل يجب أن يتقصى على الأجهزة والآليات التي وظفتها السلطة لإنتاج خطابات حقيقية حول الجنس.
بعبارة أخرى: "يجب الانطلاق من هذه الآليات الإيجابية المنتجة للمعرفة، المكثرة للخطابات، المحثة على المتعة والمولدة للسلطة، يجب متابعتها في شروط ظهورها واشتغالها، والبحث عن كيف تتوزع، بالعلاقة معها، وقائع الحظر والطمس المرتبطة بها. وبالإجمال، فإن الأمر يتعلق بتعريف استراتيجيات السلطة المحايثة لهذه الإرادة المعرفية. وفي الحالة الخاصة بالجنسانية، تشكيل اقتصاد سياسي لإرادة المعرفة."[19]
خاتمة:
صفوة القول، إن البحث عن السلطة واختلاقها للاختلاف، لا يهدف إلى خلق نظرية مؤسسة حول نظام قائم يرعاه الأمير/ الملك، وتسهر عليه مؤسسة الدولة، أو البحث عن مشروعية الحاكم وكيفية حكمه، بقدر ما نتغيا البحث عن تحليلية للسلطة، في انتشارها داخل مختلف الميادين، وسبر الآليات والاستراتيجيات التي تشتغل من خلالها، وعبرها، لخلق اختلاف يجعلها تسلط الضوء على ميدان دون الآخر متى تطلب الأمر ذلك، بهدف إخضاع الشعب لآلياتها.
إنه حديث، ليس عن سلطة ثابتة، في الزمان والمكان، تسعى إلى فرض أسلوب واحد في اشتغالها، بقدر ما تتحرك وتتوسع وتنتشر في نظام من المؤسسات العديدة، ابتداء من الدولة، وصولا إلى المؤسسات الإدارية والاجتماعية والدينية، انتهاء بمؤسسة الأسرة.
ويبدو أن الميكانزمات التي توظفها السلطة لخلق حقيقة معينة تساعدها في أن تستهدف الجسد، وكذلك الروح والحساسية، والشهوة، والإرادة، والفكر، من خلال التوسل بحقول معرفية تساعدها على إنتاج حقيقة سوسيو- ثقافية، وتوطن عبرها لا شرعيات متعددة ومختلفة الأشكال.
وأخيرا، إن خلق السلطة للاختلاف، يتأتى من خلال تأسيس السلطة لميدانها، وتجديد مناهجها، والعمل على استراتيجيتها، والتكفير على فشلها، ومراعاة السياق التي تشتغل من خلاله، حتى يتسنى لها مراقبة الجسد تارة، واستهداف الفكر وخلق هامش من اللاشرعيات المحكمة من طرف المركز تارة أخرى.
[1]- أستاذ مادة الفلسفة، طالب باحث بسلك دكتوراه: جامعة ابن طفيل القنيطرة-المغرب.
[2]- فوكو (ميشيل)، تاريخ الجنسانية: إرادة العرفان، ترجمة محمد هشام، دار النشر إفريقيا الشرق، طبعة 2004 ص، 74
[3]- ارتأينا أن نحافظ على التعريب المتداول للكلمة ميكانيزم، بدل مصطلح "إواليات" الذي يستعمله المترجم "علي مقلد" للتعبير عن مفهومmécanisme في النص الفرنسي.
[4]- فوكو (ميشيل)، المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، ترجمة علي مقلد، مراجعة وتقديم، مطاع صفدي، مركز الانهاء القومي، بيروت 1990، ص: 53
[5]- المراقبة والمعاقبة، مرجع سابق، ص: 57
[6]- نفس المرجع، ص: 103
[7]- نفس المرجع، ص: 115
[8]- المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، مرجع سابق، لمزيد من التفصيل، أنظر من الصفحة 199 إلى 123
[9]- مرجع سابق، ص: 258
[10]- مرجع سابق ص: 264
[11]- نفسه، ص: 270
[12]- نفسه، ص: 273
[13]- فوكو (ميشيل)، تاريخ الجنسانية، الجزء الاول: إرادة العرفان، ترجمة محمد هشام، دار النشر، إفريقيا الشرق، طبعة: 2004، ص: 8
[14]- تاريخ الجنسانية، مرجع سابق، ص-ص: 17-18
[15]- نفس المرجع، ص: 21.
[16]- نفس المرجع، ص-ص: 30-31
[17]- نفس المرجع، ص: 37
[18]- تاريخ الجنسانية، مرجع سابق، ص: 57
[19]- نفس المرجع، ص: 62