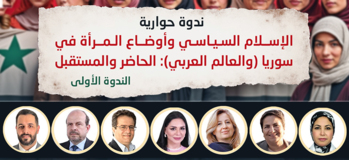السلفية الشامية: آفاق وإمكانات؟
فئة : مقالات

السلفية الشامية: آفاق وإمكانات؟
تخوّف بعض السوريين من الاتجاه السلفي، ولا سيما الجهادي، الذي سيطر على كثير من المتدينين في سوريا، خصوصًا في المناطق المحررة قبل سقوط الأسد. وقد كان لهذا الاتجاه جاذبيته؛ إذ أسهم في صياغة هوية صلبة تتيح للمنتمين إليه مقاومة السلطة الأسدية مادّيًا من جهة، ومقاومة التغلغل الشمولي للدولة الحديثة من جهة أخرى، حيث باتت الدولة لدى بعضهم مرادفة للسلطة الأسدية، في حين رأى آخرون فيها التزامًا بها. وقد تجلّت هذه المقاومة الثقافية في اللافتات الطرقية التي انتشرت في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة ذات الطابع السلفي، والتي نصّت على أن الديمقراطية تارةً تُعدّ شركًا، وتارةً أخرى تُوصَف بأنها طريق إلى التخلف، وفي أحيان أخرى تُسمّى صنم العصر.
ويتخوّفون اليوم أكثر بعد سقوط السلطة الأسدية، وتدفّق الجماعات الإسلامية الجهادية من إدلب إلى جميع أرجاء سوريا.
بالنسبة إليّ، فإنني لا أتخوّف من هذه الاندفاعة للأسباب التالية:
أولاً: فيما يخص السلفية الجهادية، فنحن أمام حالة رفض مجتمعي لها؛ إذ يُنظر إليها على أنها حلٌّ بائس ويائس لتجاوز الواقع. وقد أطلقت الدولة الإسلامية في العراق والشام رصاصة الرحمة على هذا النموذج القتالي، مما أدى إلى انغلاق مساره بوصفه نموذجاً جاذباً للسلفية الجهادية.
ثانياً: إن المعقل الأساسي للسلفية في السعودية يشهد تحوّلات هائلة ندرك جميعاً أبعادها ومضامينها. ومن أهم هذه التحولات انكفاء السعودية عن دعم هذا الاتجاه وتمويله في البلدان الأخرى، مما سينعكس على جميع التيارات السلفية ويدفعها إلى إعادة النظر في كثير من أفكارها وممارساتها. بالطبع، هذا لا يمنع استمرار وجود بعض جيوب الدعم من مؤسسات خاصة، وقد رأينا آثارها في افتتاح بعض المكتبات في الشمال السوري التي توزّع المطبوعات والكتيّبات السلفية مجاناً.
ثالثاً: إن الأداء الذي توصف به هيئة تحرير الشام بالبراغماتية لا يمكن تفسيره بالبراغماتية وحدها؛ فمن جانب آخر، لا يمكن إنكار أن كثيراً من الأفكار والتصورات تتشذّب وتتهذّب حين تمرّ عبر مبرد الممارسة العملية، وتعبر الجسر من النظرية إلى التطبيق. ونحن هنا، وإن كنّا ندرك مشكلة التفاوت في تقبّل هذا التحوّل لدى أتباع هيئة تحرير الشام، بسبب اختلاف رؤاهم الدينية وفهومهم لطبيعة الدولة المأمولة، فإننا نعي في الوقت ذاته أنها لا تضمّ أجنحةً متنافسة. إننا أمام تحوّلات فكرية شاملة داخل الجماعة، ويبدو أن قائد الهيئة يُحكم قبضته على خيوط اللعبة داخل تنظيمه بقوة واستمرار، مما يجعل الانقلاب عليه في المدى المنظور غير وارد.
وبناءً على ذلك، فإن على هيئة تحرير الشام خصوصاً، وعلى السوريين عموماً، إعادة اكتشاف السلفية الشامية، والتي يمكن تسميتها بـ"السلفية الشامية الإصلاحية"؛ إذ كانت أساس نهضة بلاد الشام على مختلف الأصعدة؛ وذلك في مقابل السلفيات المعاصرة التي يُتداول الحديث عنها اليوم. لقد تميّزت السلفية الشامية بمبادرتها إلى الانفتاح على العلوم غير الدينية، وعلى الصحافة والإعلام، وكان روّادها أول من مدّ الجسور إلى الشخصيات السورية التي لا تنتمي إلى طبقة العلماء، كما كانوا السبّاقين إلى تفكيك الطابع النخبوي الصارم لهذه الطبقة.
إن إعادة هذا اكتشاف يسهم في تسهيل مهمة القائمين على إدارة دفة الدولة في سوريا اليوم، ويحدّ من غلواء الاتجاه اليميني في صفوفهم.
ويأتي على رأس هؤلاء العلماء الشوام الشيخ عبد الرزاق البيطار (1837–1916)، والشيخ محمد الشطي (1832–1890)، وأحمد الجزائري (1833–1902)، وهو أخو الأمير عبد القادر الجزائري، والشيخ بكري العطار (1834–1903)، والشيخ طاهر الجزائري (1852–1920)، والشيخ عبد الفتاح الإمام الدمشقي (1870–1963 أو 1964)، والعلامة جمال الدين القاسمي (1866–1914)، وسليم البخاري (1884–1928)، ومحمد بهجة البيطار (1894–1976)، وأحمد مظهر العظمة (1909–1982)، وعلي الطنطاوي (1909–1999)، ومحمود مهدي الإستانبولي (1909–1998)، ومحمد ناصر الدين الألباني (1914–1999)، ومحمد زهري النجار (1920–؟)، وجودت سعيد (1931–2022)، وخير الدين وانلي (1933–2004)، والشيخ محمد بهجت البيطار.
وقد امتازت سلفية الشيخ القاسمي على سبيل المثال، بما أجمله الأستاذ حسان القالش في كتابه (سياسة علماء دمشق) في النقاط الأربع التالية:
1 ــ الرفض القاطع للتكفير.
2 ــ محاولة بناء الجسور بين السنة والشيعة والتخفيف من الخلاف بينهما.
3 ــ رفض تكفير ابن تيمية لابن عربي، وتصنيفه ضمن الفلاسفة كالفارابي وابن رشد.
4 ــ مخالفة القاسمي ابن تيمية في الهجوم على المنطق والفلسفة([1]).
وأضيف إلى ذلك:
5 ــ عدم معاندة العلم واكتشافاته وعدم استخدام النصوص الدينية لتأييد هذه المعاندة.
6 ــ الانفتاح الحقيقي على المخترعات العصرية وعدم رفضها رفضاً مبدئيًّا أو التوجس منها، أو محاولة تجاهلها وكأنها غير موجودة.
7 ــ إقامة شراكات مع أبناء الطوائف الأخرى على مبدأ المواطنة.
وإذا تابعنا أداء السلفيين الإصلاحيين بعد القاسمي، أمثال الشيخ محمد بهجت البيطار، وأحمد مظهر العظمة، ومحب الدين الخطيب، ومحمود مهدي الإستانبولي وغيرهم، فسنجد أن ممارساتهم تميّزت بما يلي:
1 ــ الاعتراف بالدولة الوطنية الحديثة والمشاركة في مؤسساتها.
2 ــ المشاركة السياسية بالانخراط بالأحزاب والانتخابات البرلمانية.
3 ــ دعم المرأة وإيصال صوتها أدبياً على أقل تقدير.
4 ــ السمة النقدية لواقع الإسلام والمسلمين والدعوة المتكررة إلى الإصلاح.
5 ــ رفض الطائفية رفضاً قاطعاً. (رفض قانون الطوائف الفرنسي).
فروقات بين السلفية الشامية والسلفية النجدية:
لعلّ أهم فرق بينهما هو أن السلفية الشامية كانت تتقبّل التعددية بجميع تجلياتها، وتتحلّى بقدر من التسامح، خلافاً للسلفية النجدية. ومن هذا الفرق تحديداً، يمكن أن تتفرّع جميع الفروق الأخرى.
نجد في السلفية النجدية كتاب "كتب حذّر العلماء منها"، تصنيف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وتقديم الشيخ بكر عبد الله أبو زيد، الذي يُعدّ من أبرز علماء الاتجاه السلفي النجدي المعاصرين.
يعبّر هذا الكتاب عن منهج السلفية النجدية في التعامل مع الكتب التي تراها مخالفة لفهمها أو رؤيتها، بل حتى لمزاجها. ففي جزئه الأول فقط، يتناول المؤلف أكثر من 400 كتاب، يراها مناوئة أو مقلقة، فيحذّر منها مبيّناً فسادها وانحرافها. وتشمل هذه الكتب رسائل إخوان الصفا، وبعض رسائل الجاحظ وأبي حيان التوحيدي، وكتباً لداود بن خلف الأصبهاني، وأبي القاسم البلخي، والبيروني، والمجريطي، والسيوطي، وغيرهم.([2])
إننا هنا أمام بوليس المعنى الواحد المرضي عنه، الذي يتتبع كل معنى مغاير فيزجّ به في قفص الاتهام!
هل يمكن مقارنة هذا التوجه بصنيع محب الدين الخطيب الذي أسس، مع صاحبه عبد الفتاح قتلان([3])، المطبعة السلفية في القاهرة، فغدت من أهم منابر الاتجاه السلفي؟ ولكن عندما نتتبع عناوين إصداراتها، ندرك بحق ما نعنيه بالسلفية الشامية، وما تتميّز به من مرونة واستيعاب للآخر المختلف، وانفتاح عليه وتفاعل معه. ولذلك، لن نتفاجأ حين نرى هذه المطبعة تطبع ترجمات لغوستاف لوبون، وغليوم الثاني، ورينيه ديكارت، وإيمانويل كانط، وبول بورجيه، أو تطبع كتب الفلسفة مثل كتاب مبادئ الفلسفة القديمة الذي جمع بين دفتيه كتابين لأبي نصر الفارابي، الأول: ما ينبغي أن يُقدّم قبل تعلّم فلسفة أرسطو.
والثاني: عيون المسائل في المنطق ومبادئ الفلسفة. كما تطبع مسند الإمام الربيع بن حبيب الأزدي، وهو من مصادر المذهب الإباضي المعتمدة، أو تطبع الرسائل المتبادلة بين أبي العلاء المعري وداعي الدعاة الفاطمي أبي نصر بن أبي عمران. كما تطبع رسالة الملائكة للمعري، وكذلك أبو العلاء المعري وما إليه لعبد العزيز الميمني الراجكوتي. وتطبع أيضاً للأدباء العرب على اختلاف صنوفهم، مثل مصطفى صادق الرافعي، أو أحمد زكي أبو شادي، أحد مؤسسي مدرسة أبولو الشعرية.
ويمكن أن نتلمس هذه السلفية الشامية كذلك، في تجربة الأستاذ أحمد مظهر العظمة ورفقائه الذين حملوا معه عبء إنشاء جمعية التمدن الإسلامي سنة 1932 (محمد حمدي السفرجلاني، عبد الفتاح الإمام، عبد الرحمن الخاني، عبد الحكيم المنير، وأحمد حلمي العلاف). كان لهذه الجمعية نشاط ثقافي واجتماعي خدمي، فأصدرت مجلة التمدن الإسلامي سنة 1935، وأسست مدرسة سنة 1945، ومستوصفاً خيرياً سنة 1959. كما كانت الجمعية منفتحة على جميع الأديان والمذاهب، فاستعانت في المدرسة بأساتذة مسيحيين، وفي المستوصف بطبيب مسيحي، وافتتحت فرعاً لها في قرية بيت الشيخ يونس في مصياف سعياً للتواصل مع العلويين.
وتعكس مجلة التمدن الإسلامي روح هؤلاء السلفيين بشكل أوضح وأجلى؛ فمؤسسوها سلفيون تقليديون دينيًّا وعقديًّا، وإصلاحيون ديمقراطيون فكريًّا وسياسيًّا، يؤمنون بالتعددية الفكرية والسياسية، ونرى ذلك واضحاً في كتاباتهم، وفي استعراض أسماء الكتّاب الذين نشروا لهم في المجلة، حيث نجد فيها سلفيين كمحمد ناصر الدين الألباني الذي نشر في المجلة 155 مقالاً، ومحمود مهدي الإستانبولي الذي نشر 406 مقالاً، ومحب الدين الخطيب وعلي الطنطاوي، ومحمد نسيب الرفاعي، وعبد الفتاح الإمام، وعبد العزيز بن باز، وعبد الرحمن الدوسري، وسواهم، ونجد فيها صوفيين وأشاعرة كعبد الله الصديق الغماري، ومحمد سعيد رمضان البوطي، وعبد الفتاح أبو غدة، وأحمد عز الدين البيانوني، ومحمد أبو اليسر عابدين، وصالح الفرفور، وعبد الغني الدقر، وكذلك قادة الإخوان المسلمين كحسن البنا، وسيد قطب، ومحمد قطب، ومصطفى السباعي، ومحمد الحسناوي، وعصام العطار، وأنور الجندي، ومحمد المبارك. هذا بالإضافة إلى شخصيات مسيحية كإميل الغوري، وإميل جبر ضومط، وجورج شدياق، وحليم دموس، ونظمي لوقا وشبلي ملاط، وخليل جرجس خليل، ونيكولا حنا، وميخائيل عواد، وشخصيات نسائية كألفة الإدلبي وألفة الصواف، ومي نخلة، ونزهة العظمة، ونديدة العقاد عابدين، وشخصيات شيعية كمحمد الخالصي، ومحمد جواد مغنية، ومحمد رضا الشبيبي، وأحمد الصافي النجفي، ومحسن الأمين، وتعرّفه المجلة بقولها: سماحة العلامة الأستاذ الشيخ السيد محسن الأمين.
في السلفية الشامية، نرى كيف يتحول الفكر السلفي إلى واقع اجتماعي، فإذا هو فكر يتجاوز الأطر الضيقة التي رسمتها السلفية النجدية لنفسها. فها هو أحمد مظهر العظمة يرشّح نفسه لانتخابات عام 1947 البرلمانية ضمن قائمة الأمة، التي ضمّت شخصيات مسيحية ويهودية، وحازت تلك القائمة يومها على تأييد علماء الدين في مدينة دمشق.
ويمكننا هنا أيضاً أن نشير إلى تجارب سلفية انطلقت في اجتهادها إلى آفاق بعيدة، مثل تجربة الشيخ جودت سعيد الذي بدأ مسيرته الفكرية متأثراً بالسلفية. لكن تلك الروح السلفية التي امتاز بها لم تلبث أن تتكشف عن تطوّر يفرّق بينه وبين رموز هذا التيار، دون قطيعة أو موقف متشنّج. وسوف تثبت مسيرته المستقبلية أنه تحلّى بالجانب الإيجابي من السلفية في كونها دعوة للاجتهاد، وأنه تخلّى عن الجانب السلبي منها في كونه يرى في الماضي مثالاً يجب تقليده بلا نقد أو تمحيص. ولذلك، سنراه فيما بعد لا يقتصر على إعمال العقل والفكر في أقوال السلف والخلف فحسب، بل في مواقفهم أيضاً.
لقد كانت سلفيته مشرَّبة بالمرونة والانفتاح الذهني والوداعة التي لا تعرف تسرّع الحنق الفقهي ولا احتدام الغيظ العقدي. ولعل صحبته للشيخ محمد زهري النجار أكسبته تلك المرونة والانفتاح، فعلى الرغم من نزعة الشيخ زهري السلفية، فإنه لم يفقد جسور التواصل مع أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، حتى تلك التي تُوصف عادةً بالانحراف. ويحدثنا السيد مرتضى الرضوي عن لقائه بالشيخ محمد زهري في القاهرة سنة 1950، ومناقشته إياه في مفهوم التقيّة ومواردها، ويصفه قائلاً: "وجدته يتحلّى بالمرونة والسماحة واتباع الحق، وله جهود وجهاد في سبيل تدعيم وحدة صفوف المسلمين في مواجهة أعدائهم"([4]).
خلاصة:
إنّ ما عرضناه في هذا النص هو تكثيف شديد لبحر متلاطم من شخصيات عديدة تتوافق في كثير من النقاط التي أشرنا إليها بوصفها تجسيداً للسلفية الشامية، وتختلف في نقاط أخرى. وقد يندّ بعضها في موقف أو أكثر عن السياق العام الذي نحاول أن نثبته ونؤكده، كما تندّ موجة من موجات البحر، ولكن ذلك لا يؤثر على هذا السياق بالنقض.
سياق قبول التعدد بوصفه أحد مكونات الوجود: قبول التعدد الحضاري، وقبول تعددية المواقف والتقييمات، وقبول تعددية الخطاب وتعددية المعنى بجوانبها الحسنة والسيئة التي تُراقب وتُروّض، ولكن لا تُنفى ولا تُقتلع. فهذا ما لا ينبغي، بل ما لا يمكن.
[1] حسان القالش، سياسة علماء دمشق: أسئلة الإصلاح والهوية والعروبة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2024، ط 1، ص 234
[2] انظر: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، كتب حذّر العلماء منها، تقديم بكر عبد الله أبو زيد، دار الصميعي، الرياض، ط 1، 1995
[3] عبد الفتاح قتلان شخصية دمشقية مغمورة تستحق أن تُدرس. ويُقال: قتلان نسبة إلى مقاطعة كاتالونيا في الأندلس، وأن أجداد الأسرة هاجروا منها بعد سقوطها إلى دمشق.
هاجر عبد الفتاح إلى مصر، وشارك محب الدين الخطيب الذي تربطه به صلة قرابة افتتاح المطبعة السلفية. وألّف بعض الكتب كفهرست المؤلفين بالظاهرية وشواهد لسان العرب مرتبة على حروف المعجم. نشاهد اسمه على مطبوعات المكتبة السلفية جنباً إلى جنب مع محب الدين الخطيب، ولكن بعد وفاته مباشرة تصبح مطبوعات الدار باسم محب الدين الخطيب فقط. استقلّ عبد الفتاح بتأسيس مطبعة سلفية أخرى في السعودية سنة 1928 أو 1929 مع الصحفي والسياسي السعودي محمد صالح نصيف وشركاء آخرين غير مذكورين، توفي سنة 1933، وربما لو عاش كما عاش محب الدين حتى سنة 1969 لكان ذكره وحضوره مختلفين.
[4] انظر: سيد مرتضى الرضوي، مع رجال الفكر في القاهرة، ط 1، (بيروت ــ لندن، الإرشاد للطباعة والنشر، 1998)، ص 330