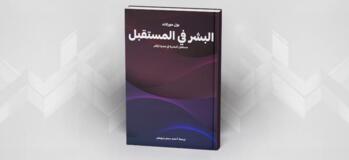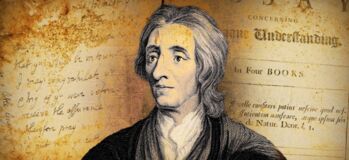الصين قديما، أية وظيفة للتربية؟
فئة : مقالات

الصين قديما، أية وظيفة للتربية؟
مقدمة:
إن فعل التربية يتطلب وجود حالة أولية، وجب تطويرها لاحقا لتصبح في حالة أفضل من التي سبقتها؛ أي كل الممارسات الفعلية التي يقوم بها كل من المدرس ورب الأسرة من أجل توجيه سلوك الأطفال للدخول في غمار الحالة الاجتماعية للراشدين. وهنا تختلف أنواع التربية من حيث أهدافها التي تتراوح بين المحافظة والتجديد؛ أي المحافظة على حالة المجتمع والحكومة تتطلب منا استعمال أنظمة تربوية تساهم وتقود إلى ذلك، كما أن هناك نظماً تربوية تؤدي إلى التجديد حسب السياقات المستجدة على المستوى الوطني والدولي؛ لأن هذين الاتجاهين يظلان يحكمان مسار النظم التربوية منذ زمن طويل، ومن بينهم النظم التربوية الشرقية التي شكلت مرحلة انتقالية بين مرحلة التربية لدى الشعوب البدائية وبين التربية عند الغرب؛ لأن التربية البدائية لم تتعدّ نطاق العائلة ونطاق رجال الدين؛ أي العمل على ترسيخ عادات ووظائف للأشخاص داخل الجماعة التي ينتمون إليها.
أما في المجتمع الشرقي، فنجد انتشارًا للغات المكتوبة، كما هو الحال بالنسبة إلى كتبهم المقدسة التي تعبر عن أساس التربية النظرية والراقية على اعتبار أن الجانب الأدبي هو الجانب الأهم في التربية الصينية عند صياغتهم لمقالات أدبية، وهو ما شهد نشأة وتطور نظام المدارس المستقلة على أيدي رجال الدين كما هو الحال في الصين. والواقع الذي لا مفرّ من الاعتراف به هي أن الصين تمثل حالة من النمو المحدود للفكر التربوي؛ لأننا نجد أن العملية التربوية قد تعدت مرحلة تعلم عادات وظيفية لدى العائلة، لكنها ما زالت أساس البناء الاجتماعي للمنظومة التربوية الصينية التي استمدت من نظم تقليدية تهدف إلى المحافظة على نظمها الاجتماعية والسياسية.
أولا: الصين والتربية
تعد التربية الصينية من النماذج الشرقية عامة التي تتصف نظمها التربوية بالمحافظة؛ أي إنها تشكل استمرارًا لحياة الفرد في الماضي من خلال ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية على كل عادات التنشئة الاجتماعية على كل عادات السلف الصالح، سواء الفكرية أو الأخلاقية دون أن تحاول تقوية أي ملكة لديهم، أو تغير عادة ما وفق مقتضيات الظروف المستجدة في العصر الحالي؛ لأن التربية الصينية تهدف إلى خلق واستمرار السكون داخل المنظومة الأخلاقية والتربوية والسياسية للبلد. لذلك، نرى الحضارة الصينية في تاريخها الطويل واحدة في معظم صفاتها؛ بمعنى أنها تتميز بالسكون والجمود؛ لأنها تعود دوما للتقاليد الموروثة في كل وهلة، حيث تعمل على ربط الحاضر بالماضي بشكل يضمن الاستمرارية؛ «كأن الحياة حفلة حددت طقوسها تحديدًا دقيقاً واتبعت بحرفيتها، فلا حرية ولا عفوية ولا مجال لأي وثبة. حتى لنلمس في الفن الصيني آثار هذا الخضوع والعبودية؛ إذ نلمس فيه الإرهاف المسكين والجمال الذليل، ولا نرى السمو والجلال الحقيقي».[1] فهذه التربية بالخصوص لا تهتم بأخذ المستجدات بعين الاعتبار إلا في سبيل ربطها بالماضي، وإلا سيتم رفضها بكل تأكيد. فهي تربية منظمة ومحددة سلفا ولا تقبل أي تغيير خاصة على مستوى الجوهر الذي تتبناه الصين في أنظمتها التربوية، وهو الكونفوشيوسية، والتي اتخذت غاية محددة لهذا الفعل، وهو فعل التربية من أجل «تدريب كل فرد على سلوك "طريق الواجب" هذا حيث توجد جميع تفاصيل مهام الحياة وعلاقاتها مفصلة بدقة تامة»؛[2] لأنه عبر التعليم يتلقى الأطفال كل السلوكيات التي تهم جميع نواحي حياتهم، سواء علاقة الأب بابنه أو علاقة الزوجة بالزوج أو علاقة كل من الابن الأصغر والابن الأكبر بوالديه، فالتربية الصينية ليست مجرد تربية مدرسية، بل هي أسلوب حياة متكامل يساعد في سلوك "طريق الواجب" «الذي يحتم علينا الاحتفاظ بما هو كائن فعلا دون أن يلحقه التغيير والتبديل: ومهمة التربية هي تدريب القادة على معرفة جميع التعاليم القديمة الخاصة بنظام المجتمع والعلاقات المناسبة في الحياة وتدريب جميع أفراد الشعب على أساليب السلوك الصحيحة من حيث النشاط ومواضع الاهتمام في نواحي الحياة المختلفة».[3] فعبر التربية يتم تدريب القادة والشعب على معرفة التعاليم الأخلاقية الشاملة لجميع نواحي الحياة كما هو الحال بالنسبة إلى الكونفوشيوسية كأساس لتعلمهم، فهو اتجاه تربوي محافظ يمجد التقاليد السائدة قديما، لتضمن استمراريتها بفضل التربية ونظمها؛ لأن التعليم الصيني هو أساس اختيار حاكم البلاد الذي يعمل هو بدوره أيضا على نشر تلك التعاليم؛ أي تصبح إمكانية حدوث تغير أو التخلص من تلك النظم ضئيلة جدًّا وشبه مستحيلة. فالحكومة لا تهدف إلى حدوث التغيير، بل تسعى إلى خلق الجمود عبر توظيف "أرستقراطية علمية" بغاية حكم وتوجيه البلد والحياة الاجتماعية نفس المنحى القديم، فبعد اجتياز طلاب السياسة امتحاناتهم بنجاح يصبح من موظفي الهيئة السياسية، وتصبح لهم هيمنة كاملة على تنظيم الحياة الاجتماعية ككل، والعمل على التأثير في سلوك الآخرين بغاية تبني كل تلك التعاليم الدينية القديمة التي توجه سلوك الصينيين؛ أي اعتبار هذه الهيأة السياسية مثلهم التربوية العليا، وهي في الوقت نفسه نسيج منهم ومع حياتهم؛ لأنها انبثقت منهم ومع حياتهم التي تأسست على نظم اجتماعية خاصة.
ثانيا: الكونفوشيوسية كأساس للتربية الصينية
تعدّ الأسرة وسطا أساسيًّا للتربية الصينية؛ لأنها تقوم بتحضير نقطة ارتكاز وتمهيد أساسي للتعليم الذي يكون في معهد خاص هو "المدرسة"، وإن تعددت مصادر التعلم بين المدرسة والأسرة فهي واحدة؛ لأن كلاًّ منهما يعتمد أو يتخذ التعاليم الكونفوشيوسية أساسا لذلك. فهي تجمع بين الآداب السياسية والاجتماعية وبين الأخلاق؛ لأنها قد تكون في حد ذاتها فلسفة أكثر مما تكون نظاما دينيا أو نظاما للعبادة نظرا لتقاطعها مع بعض التصورات الفلسفية؛ لأننا إذا نظرنا لتعاليم كونفوشيوس نجدها تتطابق نوعا ما مع تعاليم الفلاسفة الذين جعلوا "الفضيلة وسط بين التفريط والإفراط"؛ أي إنها وسط بين رذيلتين، وهو ما يسميه بـ "قانون الوسط". كما أن تعاليم مينشيوس تتقاطع مع تعاليم اليونان أيضا خاصة حديثهم عن الطبيعة الخيرة للإنسان، حيث تكون وظيفة الأخلاق والتربية هي الاحتفاظ بطبيعة الإنسان وتوجيهه، ويقول مينشيوس في هذا الصدد، "إن الإنسان يميل إلى الفضيلة كما يميل الماء إلى الأسفل، وكما يميل المتوحش من الحيوانات إلى البحث عن الغاية". فبالرغم من ارتباط الكونفوشيوسية بالفلسفة، إلا أن هذا لا ينفي طابعها الديني المقدس؛ لأنها تعتبر مادة أساسية ومصدر لبزوغ الفكر الصيني ومرجعا معتمدا في النظم التربوية؛ لأنهم يحرصون على حفظ واستظهار الآداب المقدسة عند امتحانهم؛ من أجل تعزيز الارتباط بهذه الكتب المقدسة؛ لأن «تربية الفرد تتضمن قبضة على ناصية الآداب المقدسة حتى يتمكن من أن يعيش طبقا لقوانين الطبيعة التي سبق أن أشرنا إليها. وسيطرة الفرد على الآداب المقدسة تحتم عليه استظهار هذه الكتب المقدسة وهضم ما عليها من التعليقات الكثيرة».[4] فكلما كان الطالب متمكن من حفظ واستظهار هذه النصوص المقدسة، وكان قادرا على تحليلها جيدا ضمن مقال، كلما بلغ أفضل مراحل التربية في حياته الدراسية والاجتماعية؛ فالاتصال بالنصوص المقدسة هي محطة عبور من حالة أولية نظرية إلى مرحلة ممارسة الفعل الأخلاقي الصحيح عبر مسار تربوي أساسه النص المقدس. و«لكي تتحقق الناحية الاجتماعية للأهداف التربوية الكونفوشيوسية، نجد الحكومة لا يضطلع بها لهؤلاء الذين يظهرون تفوقا عظيما في استيعاب محتويات هذه الكتب المقدسة وقدرة فائقة على تقليدها فكريا وعلى الاحتفاظ بشكليتها وبنمطها القديم وهذا يتحقق بوساطة نظام الامتحانات أساسها المطالبة بتحرير المقالات».[5] إذن أساس التربية في الصين هو التمكن من هذه الكتب المقدسة حفظا واستيعابا، وتحليلا من أجل النجاح في المهمة المنتظرة وهي كتابة المقال.
ثالثا: نظام الامتحانات الصيني
كما ذكرت سابقا الامتحانات في الصين تتخذ الكتب المقدسة كمادة أساسية، والقدرة على استيعاب تلك المضامين وحفظها واستظهارها هي الطريقة التي يتوج بها الطالب بالنجاح في هذه الامتحانات؛ لأن نظامها يعتمد على تحرير مقال انطلاقا من هذه الكتب المقدسة؛ أي بالرجوع إلى التراث الماضي والتقليدي؛ وذلك نظرا لأهمية هذه النصوص وقدسيتها فهو رجوع نبيل وشريف في نظرهم، وهو ما أكده Smith الذي يقول عن أهمية هذه الامتحانات «إذا اتخذنا المستويات الصينية كمعيار للقياس، وجدنا أن كتابة المقال الجيد هو من الأعمال النبيلة جدا التي تليق بالعقل البشري، فإن الإنسان الذي لم يلم إلماما واسعا لا بالموضوع فحسب، بل الموضوعات المماثلة-أن مثل هذا الشخص لا يستحق فقط المثول أمام الملوك بل هو جدير بالمثول بين الآلهة».[6] فنجد هناك تمجيدا هائلا لمن يجتاز هذه الامتحانات لدرجة أنه قد يوضع حاكما لذلك البلد، ومن مظاهر هذا التبجيل أيضا هو اعتبار Smith أنه جدير بالمثول بين الآلهة، وليس فقط المثول بين الملوك؛ لأنه قام باستيعاب أقدم النصوص وأشرفها مرتبة. فالتعليم الصيني مرتبط بإحياء الماضي وربطه بالمستقبل فيما يساعد على ضمان استمرارية هذا التراث؛ وهنا نقصد التراث الديني طبعا.
رابعا: النظام التربوي الصيني
تقوم النظم التربوية الصينية على أساس تقليدي يعتمد على حفظ واستظهار الكتب المقدسة وكتابة مقالات بخصوصها. فهذه النظم التربوية لها تاريخ طويل بدأ منذ القرن 23 قبل الميلاد «فإن قليلا من الأمور التي يمكن أن تكتشف لا ترجع إلا إلى ما قبل القرن السابع قبل الميلاد-وبعد فترة من الحروب الأهلية والفوضى ظهر "كونفوشيوش" فأعاد نفود الآداب المقدسة وأتقن وأحيى هذه التعاليم وأبقاها بين ثنايا كتاباته الخاصة ونسب إليها قدما طويلا ووجه الشعب إلى اقتداء ذلك السلم الذي ميزهم كشعب والذي أثر فيهم لقبول ودراسة هذه الآداب وتقديسها، وبذلك صار الصينيون "أهل كتاب" أي أمة تأسست على نظم دينية وتربية دينية-وصار مينشيوس Mencius معبرا جديدا عن الأدب وزاد عليه بإتقان مماثل».[7] وهذا يبرر هذا الارتباط الوثيق بين الصينيين وبين الكتب المقدسة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ منهم، ومن تاريخهم الطويل خاصة بعد ترسيخ كونفوشيوس المبادئ الدينية لديهم.
ترتبط الامتحانات الصينية بهذا التراث الديني، بالرغم من خضوعها لعدة تحولات، لكنها لم تصل تلك التحولات التي طرأت على النظم التربوية الغربية، فنظام الامتحانات الحالي الذي ينظم من أجل ملء وظائف الحكومة بدرجاتها المختلفة ظهر حوالي سنة 617 ق.م عند تنصيب أسرة "تانج" العظيمة للعرش، حيث كانت أهمية أنظمة الكليات كما هو الحال بالنسبة إلى نظم الامتحانات عدة قرون، ولكن أسرة مانشو Manchu أعلت من شأن نظم الامتحانات في القرون الثلاثة الأخيرة، قبل سنة 1898 الذي ظهر فيه نظام الامتحانات القديم بمقتضى مرسوم إمبراطوري وحل محله لاحقا نظام الكليات الغربية، فكانت الإمبراطورة "دواجر Dowager" زعيمة حركة الإصلاح ابتدأت بنفسها في سنة 1909 تدخل إصلاحات على النظام القديم، عبر إصدار مرسوم بإلغاء النظام الأدبي التقليدي في الامتحانات، واستبداله برسائل قصيرة ومقالات عن الأساليب الحديثة والقوانين الغربية والدساتير وإلى غير ذلك. لكن من الواضح أن هذه التغيرات بالنسبة لمجتمع يحافظ على تراثه وخاصة الديني؛ أنه لن يتحمس لهذه التغيرات؛ لأن هناك فئات لا تؤمن بها، ولكن مع اتضاح رؤيتها وسيادة هذا النظام الجديد للامتحانات داخل البلد أدى إلى تحمس الطبقات المثقفة.
«ويتألف الجزء الأعظم من التعليم الأولي ومن التعليم العالي من استذكار هذه الأساليب اللغوية والأدبية بغير أي ضرورة لمعرفة أهميتها الحقيقية: ويمكن معرفة مميزات هذا المجهود الجبار من دراسة خصائص كل من اللغة والأدب»؛[8] وذلك يرجع إلى أصل اللغة الصينية على اعتبار أنها "لغة ذهنية" ورموزها الكتابية لا تشكل أصواتا فقط، بل أفكار بشكل خاص، ومع توفر هذه اللغة على آلاف الحروف التي وجب على التلميذ أن يحفظها عن ظهر قلب، إضافة إلى تنوع الكتابة اليدوية التي تشبه الكتابة الرومانية والكتابة المائلة... هي ثقل على كاهل المتعلم نظرا لارتباط امتحانه بإنشاء مقال من الكتب المقدسة التي لا تتجاوز خمسة آلاف رمز في حين يحفظون الرموز جميعها (ستة وعشرون ألف رمز).
أما بالنسبة إلى المراحل التي تنتظم عليها الامتحانات هي كالتالي: بداية بـ «امتحانات الدرجة الأولى: وتجرى كل ثلاثة أعوام. ويطلب من الطالب فيها أن ينشئ ثلاث رسائل في موضوعات مختارة من كتاب كونفوشيوس ويوضع في حجرة خاصة منفصلا عن غيره يمكث 24 ساعة، وهو يجهد عقله في كتابة الموضوعات. ونسبة النجاح في هذه الامتحانات ضئيلة جدا لا تتجاوز 4 فالمئة. أما امتحانات الدرجة الثانية: وتقام بعد مضي أربعة أشهر على امتحانات الدرجة الأولى وتجرى مرة كل ثلاثة أعوام وتدوم ثلاثة أيام وتشبه في نهجها الامتحانات الأولية سوى أنها أعم منها وأكثر صعوبة. ونسبة النجاح فيها ضئيلة أيضا لا تتجاوز 1 فالمئة. وتليها امتحانات الدرجة الثالثة: وتقام في العاصمة وتدوم ثلاثة عشر يوما، ونسبة النجاح فيها أكبر منها في الامتحانات السابقة».[9] فهذه الامتحانات تجرى بشكل صارم وتحت إشراف الحكومة التي تؤلف لجنة من كبار العلماء الذين سبق لهم أن اجتازوا هذه الامتحانات نفسها.
خاتمة:
خلاصة القول إن هناك عدة أنماط من التربية تختلف باختلاف أهدافها. فبالرغم من اختلافها، فهي تنتظم على نحوين هما المحافظة والتجديد؛ فاتجاه المحافظة يحاول دوما بقاء كل النظم السياسية والحياة الاجتماعية على حالها دون أن يتزعزع استقرارها، وهي بالتالي تعتمد طرائق تربوية تقليدية أساسها الحفظ والاستظهار للكتب المقدسة (عند الصين مثلا) بوصفها نقطة أساسية تستقر حولها النظم التربوية، بخلاف النظم التي تهدف إلى التجديد ومواكبة التحولات التي تحدث في الحياة الاجتماعية فور إلحاق تغير على مستوى النظم الاجتماعية؛ أي إنها تحاول خلق انسجام وترابط بين المجتمع ومتطلباته، وبين النظم التربوية الخاصة بتلك الدولة، ومنها نجد النظم التربوية المغربية التي دوما ما تنتج مستجدات تربوية مواكبة لتطورات المجتمع وخدمة له.
وتتجلى المحافظة في النظام التربوي للصين في كونه يتجه نحو المحافظة على النظم الاجتماعية؛ وذلك من خلال الطرق التي يسلكها نظامهم في إجراء الامتحانات الذي يكون بشكل صارم جدا المتكون من ثلاث مراحل متدرجة في الصعوبة مع وجود فواصل زمنية بينهم، وفي نهاية الامتحان الأخير يمكن للناجحين فيه (والتي تكون نسبهم قليلة) خاصة طلاب السياسة أن يتولوا تسيير الدولة وفرض النظام التربوي القديم الذي مروا منه، فهي سيرورة تربوية متكررة تهدف إلى المحافظة واستقرار النظم والحياة الاجتماعية داخل الدولة.
وعلى الرغم من القول إن هذا النظام التربوي تقليدي ورجعي فهو يظل رأيا نسبيا؛ لأنه نظام يعتمد طرائق تقليدية، لكنها فعالة في خلق نخب تربوية في المستوى؛ أي تكوين مثل سياسية وتربوية للاقتداء، والتي تملك القدرة على مزاولة ذلك العمل حقيقة، وكذلك هناك نقطة إيجابية لهذه النظم التربوية الصينية هي الحرص على تعميم التعليم على صفوف جميع الصينيين والإعلاء بقيمته عبر مكافأة الناجحين في تلك الامتحانات. لذلك، يجب أن نعيد النظر في وظيفة المحافظة في التربية على أنها مبتذلة وتقليدية.
المراجع المعتمدة:
- عبد الله عبد الدايم، التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، الطبعة الخامسة، 1984
- بول مترو، المرجع في تاريخ التربية، ترجمة: د. صالح عبد العزيز، وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، الجيزة، جمهورية مصر العربية، 2022
[1] عبد الله عبد الدايم، التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، الطبعة الخامسة، 1984، ص 33
[2] بول مترو، المرجع في تاريخ التربية، ترجمة: د. صالح عبد العزيز، وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، الجيزة، جمهورية مصر العربية، 2022، ص 21
[3] المرجع نفسه، ص24
[4] المرجع نفسه، ص26
[5] المرجع نفسه، ص26
[6] المرجع نفسه، ص27
[7] المرجع نفسه، ص 28
[8] المرجع نفسه، ص 31
[9] عبد الله عبد الدايم، التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، ص 25