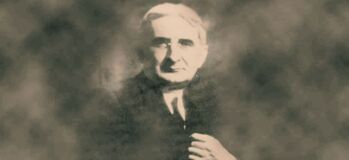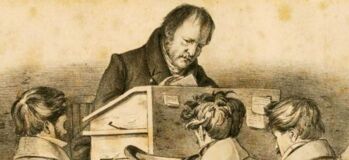العقد العنصري وفلسفة العقد الاجتماعي
فئة : مقالات

العقد العنصري وفلسفة العقد الاجتماعي
ملخص تنفيذي
تصدّى الجامعي والفيلسوف الأمريكي من أصول جامايكية تشارلز ميلز لمسألة العقد العنصري Contrat Racial[1] بوصفها من صميم التعاقد الاجتماعي، وليست إحدى نتائجه غير المقصودة للبشر. أسس الفيلسوف ميلز مع العقد العنصري لقواعد تحليل العلاقات البينعرقية، وديناميات الهيمنة التي تجعل منها موضوعا حارقا من المواضيع الجديرة بالبحث في الفلسفة السياسية. لقد حاول ميلز، من خلال كتابه ذلك، نزع البياض ""déblanchir عن الفلسفة السياسية التي يهيمن عليها العرق الأبيض؛ وذلك من خلال مساءلته للعقد العنصري وإحياء جدوى السؤال حوله بما هو من صميم فلسفة العقد الاجتماعي.
*****
تشكل مسألة العرق أساسا لنمط التفكير السياسي والحقوقي الذي يطبع المجتمعات المعاصرة، وإذا ما لاحظنا واقع المجتمعات الغربية المعاصرة، سواء في أوروبا أو أمريكا، نرى وبجلاء أن العقد الاجتماعي بوصفه "تعاقدا بين أفراد متساوين" لتحقيق "مجتمع عادل"[2] ضرب من ضروب اليوتوبيا. وإذا ما وُسم "بالعقد العنصري" فذلك للأسباب التي نذكرها فيما سيأتي من الفقرات؛ فالتفاوتات الاجتماعية الصارخة، والمعاملات التفضيلية بين المواطنين، على أسس "عرقية" أو "دينية" لا يكاد يخلو منها مجتمع، فالأفارقة السود[3] في أمريكا، يعيشون في أحياء خاصة بهم، أقل ما يقال عنها إنها "des ghettos"، والسياسة العامة للدولة حيال هذه الطبقة إقصائية وممنهجة، اللهم إلا بعض الاستثناءات لبعض الأفراد الذين يبذلون جهدا مضاعفا لبناء مستقبلهم المهني، سواء في الرياضة أو السياسة أو الفن. ونجد مشكلا مماثلا في فرنسا، مهد "ثورة حقوق الإنسان"، حيث إن معظم المواطنين ذوي السمرة السوداء أو العرب، بل وحتى فرنسيين ممن اعتنقوا ديانات أخرى، يعانون من التمييز، سواء على مستوى الوظائف، فضلا عن المناصب العليا، بل ويعانون حتى من المعاملة العنصرية ومضايقة قوات حفظ الأمن في الفضاء العام.
ليس العقد العُنْصُريّ نقضاً لتاريخ الفكر السياسي والممارسة السّيَاسية في الغرب وحسب، ولكن يشكل نقدا صريحا على وجه التحديد للتصور التعاقدي الراولزي ولتاريخ نظريَّة العقد الاجتماعي نفسها[4]، وهو مستلهم من العقد الجنسي، ويروم إبراز فكرة مفادها أنَّما دون البيض تربطهم علاقات مشابهة بالعقد الاجتماعي، يتشابهون في ذلك مع النساء. وَبناء على هذا التصور؛ يمكن من خلاله-أي من خلال العقد العنصري- مساءلة الوصاية المزعومة للفرد الليبرالي بوصفه وكيلا لنظريَّة العقد الاجتماعي.
ثمة دليل أساسي-حسب ميلز- يفيد وجود "عقد عِرْقي" أكثر مبدئية للمجتمعات الغربية من العقد الاجتماعي. يميز هذا العقد العرقي على وجه التحديد من يمكن وصفهم أشخاصًا كاملين أخلاقيا وسياسيا، وبالتالي، يحدد معايير ما يتماشى مع الحرية والمساواة التي يتعهد بها العقد الاجتماعي. مع التأكيد أنَّ بعض الأشخاص، وخصيصا النّاس البيض، يعدّون أشخاصا كاملين تبعا لفلسفة العقد العنصري، يكونون بذلك هم المخولون لإبرام العقد الاجتماعي، ولإبرام المواثيق القانونيّة الخاصة. يُعاملون بوصفهم بشرا كاملين[5] ومن ثم، فهم يتمتعون بالمساواة والحرية الكاملتين. يعطيهم وضعهم هذا امتيازا وسلطة اجتماعية أكبر. ويمكنهم من إبرام العقود، وصياغة مضامينه، بينما يُنتزع هذا الحق من الأشخاص الآخرين، ويعاملون بوصفهم موضوعات للعقود. ينسجم هذا العقد العرقي مع بشر محدّدين من دون سائر البشر، ويرسم ملامح الشخصية ومقاييس القبول والإقصاء في كافة المواثيق الأخرى التي تتبعها؛ تتجلى فعالية ذلك من خلال إجراءات ضمنية رسمية وغير معلنة.
تبلور هذا العقد في أصله بين الأوروبيين في بواكير العصر الحديث، لتقديم أنفسهم بوصفهم عرقا "أبيض" وبصفتهم جنسا أعلى وبشرًا كاملين، واعتبار ما سواهم، ولا سيما السكان الأصليون للمستعمرات التي احتلوها، وبدأوا بالاتصال بسكانها، على أنهم ذوات أخرى، غير بيضاء وليسوا، تبعا لذلك، بشراً كاملين. وتجلي ذلك واضح وصريح إذا ما نظرنا في سياقنا المعاصر، فإن بعض الفئات من أفراد المجتمع يعيشون باستمرار تحت رحمة الحكم القيمي للآخرين[6]، والذي يفضي بدوره إلى ممارسات اجتماعية إقصائية، تجاه طبقات من المجتمع بعينها[7]. لذا، فإن مسألة العرق ليست مجرد تمثل اجتماعيٍّ، كما يحاول بعض المفكرين أن يختزلوها، بل هي بشكل أكثر دقة بناء سياسي، تم بناؤه واعتماده تاريخيا رجاء تحقيق أهداف سياسية محددة، لمجموعة من الأشخاص. يخول هذا العقد لبعض الأشخاص، اعتبار أشخاص آخرين، وكذلك الأراضي التي يمتلكونها، موارد يمكنهم حيازتها واستغلالها. وما استعباد ملايين الأفارقة السود والاستيلاء على الأمريكيتين ونزعها من أصحابها، إلا خير مثال على هذا العقد العرقي في تاريخ البشرية[8]. إن هذا العقد ليس حالة افتراضية كما يذهب إلى ذلك فلاسفة العقد الاجتماعي، بل هو عقد حقيقي، تلته حلقة من العقود، أبرمها رجال تاريخ حقيقيون، وعُثِرَ عليها في وثائق مثل كتابات جون لوك عن الأمريكيين الأصليين، وتم الاعتماد عليها في الغزوات والرحلات التاريخية الاستكشافية التي قام بها الأوروبيون، ومن خلال مضمونها والتبريرات المنطوية عليها، قاموا باستعمار إفريقيا وآسيا والأمريكيتين. هكذا، خول العقد العنصري لبعض الناس، ولاعتقادهم بتفوقهم على غيرهم؛ احتلال أراضي واستعباد شعوب واستغلال موارد أعراق أخرى.
إن الوضع الاعتباري لفئات من المواطنين بعينها في المجتمع مرتبط بإرث تاريخي عريق ترسخ في ذاكرة الشعوب، وجعل ثقلها ينعكس على الممارسات والعلاقات البينذاتية (les relations intersubjectives)، بل وجعلها رهينة لصور نمطية كرسها الإعلام والإشهار والصناعات الثقافية، التي هي نتاج العقل الرأسمالي، والذي يخدم ايديولوجيات بعينها[9].
يرى ميلز أن العُنصرية لا تمثل حالة عرضية أو حادثا مؤسفا عابرا للقيم الديمقراطية والسّياسية في الغرب، ولا يتعلق الأمر أيضا بكوننا قد عملنا على تشييد وامتلاك أنظمة سياسية مصممة بشكل مثالي، ولم نستطع تنزيل مضامينها بشكل فعال ومكتمل، وإنما يتعلق الأمر بفلسفة العقد العنصري الأولى المؤسسة، وهو ما يجعلنا نتمثل معضلة العنصرية في الغرب بشكل سطحي ونسبي، ونأمل في تحقيق توافق سياسي واجتماعي مثالي. إن الاعتقاد في مثالية العقد الاجتماعي وفي نجاعته، وفي مبادئه التي يدعو إليها؛ من مساواة بين الجميع وفي استقامة المؤسسات الاجتماعية والسياسية المنبثقة عنه ضرب من ضروب الوهم. فالممارسات التفضيلية السائدة تاريخيا وحتى في سياقاتنا المعاصرة تكذب دعوى هذا القول. إن الحقيقة التاريخية التي لا يمكن إنكارها، هي أن الآباء المؤسسين للعقود الاجتماعية، لم يكونوا ملتزمين حقيقة بالمساواة بين الجميع وبالتعاطي مع الأفراد بنفس الكيفية أمام القانون وبمبدأ الحرية للجميع، مما يدفعنا إلى القول إن نظريات العقد الاجتماعي تروم إضمار الواقع السياسي الحقيقي عن كل متتبع للشأن السياسي والحقوقي – يكرس الواقع السياسي والحقوقي المعاملة التفضيلية التي تمنح بعض الأشخاص حقوقا وحريات بوصفهم أشخاصا كاملين، بينما يعامل البقية كأشخاص أو مواطنين من درجة ثانية دون أن تكون لتلك الإجراءات صفة معلنة، وكنه هذا التصور مرتبط بالعبودية وله جذوره التاريخية مند اليونان[10].
إن الأحداث الجارية في المجتمعات الغربية المعاصرة، تنبئ عن تحكم العقد العنصري في بنية الأنظمة السياسية، فسيادة "العرق الأبيض" على ما سواه من الأعراق أمر مشهود في العديد من الدول الأوروبية. تفيد دراسة اجتماعية عن التوظيف في فرنسا؛ أن المواطنين الفرنسيين (ذوي الأصول الفرنسية) يحظون بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالوظائف[11]، والأمر يزداد حدة حينما يتعلق الأمر بالمناصب السياسية والمناصب العليا في الدولة. يكرس هذا الوضع فلسفة العقد العنصري، ولا يمكن، وفقا لميلز، أن نعالج الوضعية الراهنة بإدماج نسبة من غير البيض في المؤسسات السياسية والتمثيلية، بل وجب إعادة فحص ومساءلة السياسات العمومية بشكل جوهري، مع تشخيص لعلل ومكامن الإقصاء المنهجي العنصري لبعض الأفراد من الفضاءات ذات التأثير القوي كالسياسة والثقافة.
إن فلسفة العقد الاجتماعي بوصفه آلية للتوافق واحتضان الأفراد في إطار كيان سياسي موحد يضمن الحقوق والحريات بنفس الكيفية؛ على المحك إذا ما نظرنا في حقيقة ما ذهب إليه تشارلز ميلز في العقد العنصري، وإذا ما رُمنا تفنيد ما ذهب إليه من حجج وقياس مدى صحة طرحه؛ وجب قياس الهوة السحيقة بين التنظير الفلسفي والحقوقي وواقع الفعل السياسي والحقوقي المعاصر.
[1] عندما نشر ميلز كتابه العقد العنصري في عام 1997، أصبح على الفور من أكثر الكتب مبيعًا أكاديميًا وفاز بالعديد من الجوائز؛ يُنظر،
Charles W. Mills, The Racial Contract (Ithaca and London: Cornell University Press, 1997)
[2] "في الحقيقة، إن يوتوبيا المجتمع العادل، مجتمع لا يعترف إلا بالتفاوتات "الطبيعية"، مع استبعاد جميع أشكال عدم المساواة الاجتماعية أو السياسية، يتطلب الخضوع لنظام يضع اللامساواة من صميم التنظيم الاجتماعي"، يُنظر،
Guéhenno, Jean-Marie, L’avenir de la liberté: la démocratie dans la mondialisation (Paris: Flammarion, 1999), p. 44
[3] "يتضمن تاريخ القرن العشرين، الذي ورثناه إيديولوجيًا، حلقات استعمارية عززت هذا الانقسام، وزادت من حدتها المطالب بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة. تساهم كل هذه الحلقات بشكل غير مباشر في التحيزات الموجودة في اللاوعي الجماعي لأي ثقافة وتجعل أي شكل من أشكال مراجعة التحيزات أمرًا صعبًا للغاية"؛ يُنظر،
Keslassy, Eric, Tous égaux, sauf: les discriminations, un état des lieux (Paris: Cavalier bleu éditions, 2006), p. 47
[4] Esther Cyna, « Œuvre et héritages de Charles W. Mills, philosophe du « contrat racial » », Transatlantica [En ligne], 2 | 2021, mis en ligne le 01 décembre 2021, consulté le 10 décembre 2021. URL: http://journals.openedition.org/transatlantica/17735; DOI: https://doi.org/10.4000/transatlantica.17735
[5] إن أزمة أوكرانيا كشفت حقيقة هذا الطرح وانبرت وسائل الإعلام الغربية للدفاع عن الشعب الأوكراني بوصفه شعبا يستحق ذلك، وذهب الكثير من السياسيين والإعلاميين الأوروبيين والفرنسيين على وجه الخصوص؛ لإجراء مقارنة صريحة وعلنية بينهم وبين السوريين واعتبار الأوكرانيين جنسا كاملا وأرقى، وبالتالي فهم يستحقون دفاع المؤسسات الدولية عنهم، وإنزال العقوبات اللازمة بالدولة الروسية إذا ما لم تتراجع عن عملياتها العسكرية وعمليات التهجير.
[6]التحيز هو "حكم مسبق" مرتبط بالصورة النمطية. هذه الصورة النمطية هي قائمة من المعلومات والتصورات التي نربطها بمجموعة اجتماعية. يمكن أن تأخذ هذه المعلومات شكل الخصائص الفيزيائية ... أو السمات الشخصية ... أو حتى الممارسات الاجتماعية. هذه المعلومات ليست بالضرورة إيجابية أو سلبية. ولكن بمجرد أن يصبحوا كذلك، نتحدث عن الحكم المسبق”، يُنظر،
Keslassy Eric, Tous égaux, sauf: les discriminations, un état des lieux, Op. Cit. p.46
[7] "من المستحيل فصل التحيز عن الممارسات التمييزية؛ لأن العنصرين مرتبطان تمامًا. لا يمكن أن يكون هناك تمييز دون تحيز، وتحامل بدون قولبة نمطية. العناصر الثلاثة موجودة في نفس السلسلة المنطقية التي تنتقل من الإدراك إلى الحكم الاجتماعي"، Ibid, p. 46.
[8] يدعي جون لوك أن السكان الأصليين لأمريكا لم يمتلكوا الأرض التي سكنوها؛ لأنهم لم يزرعوها ويستغلوها، وبالتالي فلا يمكن اعتبارهم مالكين لها.
[9] "التحيزات هي في الغالب نتاج التراث الثقافي. يتم نقلها مباشرة عبر (الأسرة، المدرسة، البيئة المهنية، إلخ) وبشكل غير مباشر من خلال وسائل الإعلام مثل السينما أو الإعلان. إنها تتعلق بأي نوع من المجموعات الاجتماعية ولكنها قوية بشكل لافت عندما يتعلق الأمر بالمجموعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهويتنا. الجنس (رجل أو امرأة) والعرق (الجنسية أو الدين أو مكان الإقامة) هما أهم بُعدين للهوية، وبالتالي هما العاملان اللذان يولدان أكبر قدر من التحيز. وبالتالي، فهي أيضًا الأكثر ثباتًا ثقافيًا والأكثر مقاومة لأي شكل من أشكال التطور. كونك ذكر أو أنثى يشبه أن تكون أبيض أو أسود. هذا يستجيب لانقسام الواقع الاجتماعي الذي "يجد" كل إنسان نفسه فيه"، Ibid, p. 47.
[10] المعايير التي تحدد وضع "المواطن" مقيدة للغاية أيضًا. في أثينا، على سبيل المثال، يمكن فقط للرجل المولود "حرًا" ومن أبوين من أثينا أن يصبح مواطناً. لذلك لم تحصل ثلاث فئات من البشر على الجنسية أبدًا: النساء والأجانب والعبيد"، يُنظر،
Delacampagne, Christian, La philosophie politique aujourd’hui: idées, débats, enjeux (Paris: Seuil, 2000), p.82
[11] Cf: Bilan annuel sur l’insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants en 2011, Département des Statistiques, des études et de la Documentation, Ministére de l’intérieur de la République Française (Secrétariat general à l’immigration et l’intégration).