الفعل الإنساني بين النزعة الآلية والشرط الحيوي عند برجسون
فئة : مقالات
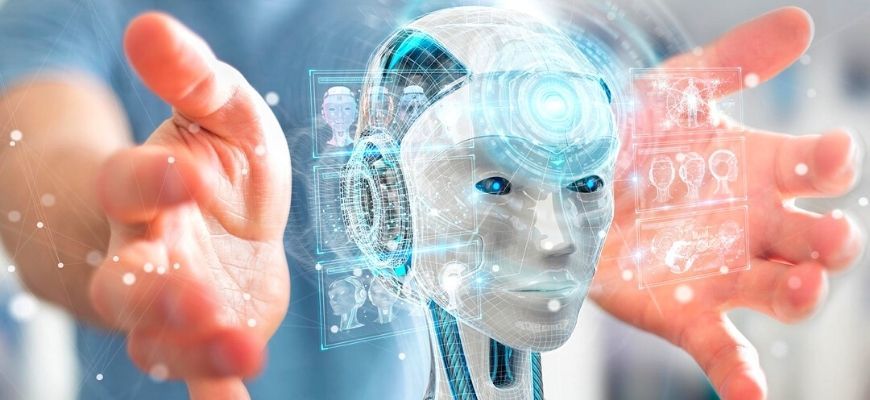
الفعل الإنساني بين النزعة الآلية والشرط الحيوي عند برجسون
سكو زهير
أستطيع الزعم بفكرة مفادها أن "فلسفة الفعل"، كمبحث تتداخل فيه تيارات فكرية كثيرة، تعود جذوره إلى تلك الفلسفات والأبحاث العلمية المعاصرة المنصبة على دراسة وفهم: ما هي العمليات التي تحدث قبل وأثناء الفعل الإنساني. والحقيقة إنها فلسفات جاءت على نقيض الفلسفة الحديثة التي ألّهت العقل، وأعلت من مكانته على حساب كل ما هو مادي في الإنسان[1]. ولما تبيّن أن حياة هذا الأخير لا تتوقف على مجرد التفكير، بل تتحدد من خلال أعماله، أدركنا، بشكل ملموس، كيف أن البحث في الذكاء الصناعي شكل أساس ما سمي بالثورة المعرفية، حيث كان بذلك الحقل المعرفي الأساس الذي أفضى بالبحث الفلسفي إلى الانتقال من فلسفة اللغة إلى فلسفة العقل، ومنها إلى فلسفة الفعل[2]. لذلك يسعفنا القول، مع المفكر المغربي "حسّان الباهي"، إن الإنسان فكر وعمل؛ بمعنى أنه ذات ليست قادرة على التفكير فحسب، وإنما قادرة على الفعل والعمل.
اعتبارًا لذلك، يتبين لماذا تجاوز الباحثون والمهندسون في مجال "الذكاء الصناعي" التصورات الفلسفية والعلمية التي تلصق خصائص التفكير والفهم والإدراك والخيال والإبداع والتمثل فقط بالإنسان، وإنما زعموا أن كل هذه الخصائص، يمكن أن نُضمّنها في آلة تستطيع القيام بأفعال تحاكي كل المميزات الفعلية والانفعالية التي هي حبيسة على الكائن الإنساني. والواقع أن هذه الرغبة الشامخة يبقى منبعها، بشكل أو بآخر، من صميم الذكاء الإنساني الطبيعي. يقول الباهي: "إنها الرغبة في صنع آلة تفهم وتتصرف بشكل ذكي؛ أي آلة قادرة ليس فقط على محاكاة الأنشطة الذهنية عند الإنسان، بل أن تتصرف كما يتصرف، وسلك كما يسلك".[3]
نُقّر، على غرار هذا القول، أن هناك إشكالات كبرى تفرض ذاتها بذاتها، هي في العمق تثير قلق الإنسان، حيث تجعله يستشعر أنه منزوع عن عرش الإنسانية التي لطالما تباهى بها عبر التاريخ وعلى مر العصور، ويمكن بسطها على الشكل الآتي:
أليس من شأن الإفراط في تهيئ الشروط النظرية والعملية للدفع بالتكنولوجيا إلى الأمام أن يقضي على النوع الإنساني؟ ألم يظهر لنا التاريخ[4] كيف أن التقدم التقني، المؤسس على نظريات ومرجعيات فكرية وأنساق منطقية، جعل البشرية تنزاح عن القيم وروح الإنسانية؟ إن سلمنا بإمكانية خلق آلة تحس وتشعر وتفكر وتتخيل وتتصور وتثبت وتنفي، ما الضامن لنا بأنها لن تخون ولن تكذب ولن تخدع ولن تزيف المعطيات والبيانات... والحال أن هذه خصائص وصفات يتفنن فيها الكائن الإنساني؟ ألا يمكن القول إن هناك إمكانية أن تنقلب الآلة على الإنسان، وأن تنتقم منه؛ لأنه أخرجها إلى الوجود من دون أن تكون لها إرادة ورغبة وحرية في ذلك، والواقع نحن نعرف كم عانى الإنسان ولازال تجاه ذلك؟
تلكم إحدى الإشكالات الفلسفية التي تطرح عندما نكون بصدد التفكير في آلة يمكن وسمها بـ "الآلة الإنسانية". لكن بالنسبة إلي، سأحاول مقاربة مشكلة الوعي بين الإنسان والآلة الإنسانية، بناء وعي مماثل للوعي الإنساني وزرعه داخل آلة يمكن أن تتصرف وتسلك كما يتصرف ويسلك الإنسان. هل يمكن تحقيق ذلك بالفعل؟ إذا كان هناك من يزعم بذلك نطرح سؤال كيف؟ وهو سؤال يربطنا بالواقع الفعلي مباشرة. وإذا كان ذلك مستحيلا تحقيقه، فما هي هذه العوائق التي تحول دون تحقيقه؟
سأحاول من خلال هذه الورقة مناقشة القضية من خلال الوقوف عند بُعد الحرية كمشكل ميتافيزيقي عمر كثيرا ولازال يُطرح إلى حد الآن؛ وذلك من خلال ربط المسألة بالآلة الإنسانية. لو شئنا التسليم بأن الباحثين المهتمين بهذا الأمر قد نجحوا إلى حد بعيد في تحقيق وبلوغ آلة تتصرف وتسلك كما يسلك ويتصرف الإنسان، هل تصرفها سيكون نابعا من إرادة حرة؟ أليس الإنسان هو أكثر الكائنات تعقيدا، حيث من بين إحدى خصائصه نجد "النزعة الحيوية"، والتي اعتبرها "برجسون" أساس وقوام الحياة؟ هل هناك إمكانية لخلق هذه الخاصية في الآلة؟ لنقارب المشكلة من خلال فلسفة "برجسون".
تعدّ الحياة النفسية في نظر "برجسون": اتصال مستمرّ وديمومة حية خالصة، ليس فيها، ولو درجة أدنى لعناصر ثابتة قد تتكرر هي نفسها في مجرى الشعور، حيث إن الديمومة تحيلنا إلى القول، بأن حياتنا العميقة والباطنية هي في صميمها «تعدد كيفي» لا علاقة له تمامًا بالتعدد الكمي الذي يخص مجال المادة، كما ليس هناك تجانس مطلق تتداخل فيه حالاتنا النفسية، فيتحقق عن طريق تداخلها ذلك الترقّي المستمر لشخصينا الحرة.
والحال، أن نظرية الديمومة هي التي اقتادت "برجسون" إلى طرح مشكلة الوعي ومدى تداخلها مع خصائص إنسانية أخرى كخاصيتي الحرية والتذكر. وأن نقده للنظريات الميكانيكية وللتصورات الترابطية قد أدى به إلى إقامة ضرب من التعارض بين النزعة الميكانيكية "mécanisme" والنزعة الديناميكية dynamisme في النظر إلى الشخصية. فهما من دون أدنى شك، نزعتان يقوم عليهما سؤالا الحرية والوعي اللذان يعدان من بين المشكلات الفلسفية التي وقفت في وسط الطريق بين علم النفس والميتافيزيقا، والهدف الذي يرمي إليه "برجسون" من دراسته للوعي والحرية، هو أن يبين لنا أنه إذا كان الخلاف قد ظل مستعصيا بين أنصار الحرية ودعاة الحتمية déterminisme، فلأن المشكلة لم توضع وضعا صحيحا، وما يوضح ذلك هو قوله:
«لقد اخترنا من بين المشاكل، مشكلة الحرية، وهو المشكل نفسه الذي تتقاسمه كل من الميتافيزيقيا وعلم النفس، وسنحاول أن نثبت أن كل نقاش بين أنصار الحتمية وخصومهم ينطوي على التباس مسبق لكل من الديمومة مع الامتداد، وللتتابع مع التزامن، ثم للكيف مع الكم: ومجرد زوال هذا الالتباس سنشهد ربما انتفاء الاعتراضات المرفوعة ضد الحرية، ولكل التعريفات التي نقدمها بشأنها بمعنى من المعاني لمشكل الحرية في حد ذاته».[5]
فلا شك بهذا، أن طرح "برجسون" لمشكلة الحرية بهذه الطريقة قد ساهم إلى حد كبير في تغيير مجرى المشكلة، ولربما تحديد الملامح الكبرى للفلسفة البرجسونية بكاملها. فبهذا الكلام، قد يتبادر إلى ذهننا لأول وهلة، أن "برجسون" يريد تحليل وتفسير مكامن الخلط والالتباس بين النسقين المتضادين للطبيعة في مواجهة مشكل الحرية. نسق الآلية ونسق الدينامية، فهذه الأخيرة تنطلق، حسب "برجسون"، من فكرة النشاط الإرادي المقدم من قبل الوعي، وعن طريق ذلك تستطيع أن تصل إلى فهم وتمثل المادة الجامدة؛ وذلك من خلال محاولتها إفراغ هذه الفكرة شيئا فشيئا، مما يؤهلها إلى إدراك قوة حرة من جهة، ومادة تحكمها قوانين من جهة أخرى.
وعلى العكس من ذلك، فالآلية تتبع منحى مغايرا تماما للدينامية، على اعتبار أن المواد التي تحاول القيام بتركيبها وتجميعها وتوليفها تفترض خضوعها لقوانين الضرورة. ورغم ما تصل إليه من نتائج منطقية ميكانيكيا، إلا أنها لا تتجاوز ولا تخرج من دائرة هذه الضرورة الضيقة. هكذا، فكلّما حاولنا تعميق النقاش والتفسير والفهم لهذين التصورين الخاصين بالطبيعة، كلما أدركنا أنهما يحتويان على فرضيتين مختلفتين إلى حد كبير. يخصان علاقة القانون مع الواقع الذي يحكم. فبقدر ما تستطيع الدينامية، رفع نظرها إلى مستويات عالية، بقدر ما تعتقد أنها أدركت وقائع تتوارى وتهرب أكثر فأكثر من قبضة القوانين.
اعتبارا لذلك، فهي بهذا تعلي من الواقع وترفعه إلى مستوى الواقع المطلق، كما تقوم بتغيير رمزي للقانون الذي تفترض أنه المتحكم في هذا الواقع. هذا من جهة الدينامية، أما فيما يخص الآلية، فإنها تميز داخل الواقع الخاص عددا معينا من القوانين، حيث تشكل فيها، بصورة من الصور، نقطة التقاطع؛ وذلك باتخاذ القانون داخل سياق هذه الفرضية الواقع الأساس. انطلاقا مما سبق، يظهر أن "برجسون" اكتشف في سياق "تصور الآلية" أننا، لا محالة، نريد فهم لماذا شيء ينسب إلى الواقع والشيء الآخر إلى القانون؛ مما يؤدي إلى اعتقاد أن هذا الأخير هو الواقع الأكبر. وبذلك سيوجه نقدا تحليليا لموقف هذه الآلية التي هي في صميمها تجسيد للحتمية الفيزيائية التي كانت سائدة في عصره، والتي ترتبط بخصائص ومميزات المادة والعالم الملموس، حيث نتمثل العالم، حسب الرجل:
«كركام مادة تحلّلها المخيلة إلى جزيئات وإلى ذرات. وهذه الجزيئات تنجز من دون توقف حركات من مختلف الأنواع، ترتج تارة وتنتقل تارة أخرى، والظواهر الفيزيائية والأفعال الكيميائية وكيفيات المادة التي تدركها حواسنا، من حرارة وصوت وضوء، وربما حتى من جاذبية ستختزل موضوعيا إلى حركاتها الأولية».[6]
هكذا، فإذا كانت المادة التي تدخل في تركيب الأجسام العضوية تخضع لنفس القوانين، فإننا لن نجد شيئا آخر، في الجهاز العصبي، سوى جزيئات وذرات تتحرك وتتجاذب ويدفع بعضها بعضا. يشدنا هذا الطرح، بصورة أو بأخرى، إلى طرح السؤال الآتي: كيف لنا خلق جهاز عصبي، باعتباره مجموعة من الجزيئات والذرات التي تتحرك وتتجاذب ويدفع بعضها بعضا؟ يخلص "برجسون" من ذلك إلى أن الحتمية الفيزيائية تبغي أن تطبق على كل ما في الكون من جمادات وأحياء وكائنات بشرية، مبدأ قانون بقاء الطاقة: le principe de la conservation de l’énergie، والذي يعني أن القوة لا تفنى ولا تخلق، كون أن هذه الحتمية ترى أن هذه الظواهر يمكن تحديدها سلفا بموجب معرفتنا الأوضاع التي تتخذها كل ذرة من ذرات مادة الدماغ المخية.
لكن، إذا تساءلنا عن مدى انطباق مبدأ بقاء الطاقة على الحياة عموما، كان رد "برجسون" أنه قد يكون من الخطأ أن نغالي في تقرير أهمية الدور الذي يقوم به هذا المبدأ في تاريخ العلوم الطبيعية. والواقع، أن هذا المبدأ يمثل مرحلة من مراحل تطور بعض العلوم، حيث من الخطأ الجسيم أن نجعل منه مسلمة ضرورية من مسلمات كل بحث علمي. والظاهر، أن هذا المبدأ في الوقت الراهن، إنما ينطبق على مجموع الظواهر الطبيعية والكيماوية؛ إلا أنه ما يجب أن يفهم هو أن هذا الاعتقاد الملصق بدراسة الظواهر الفيزيولوجية عموما، والظواهر العصبية خصوصا، سوف لن يمنعنا من أن نكشف يوما عن طاقة أخرى من نوع جديد، ويكون من الممكن تمييزها عن غيرها بعدم قابليتها للحساب. ولعل هذا ما يكشف عن تلك النزعة الحيوية التي سادت فلسفة "برجسون" والمتجلية في قوله:
«في عمق المذاهب التي تجهل الجدة الجذرية في كل لحظة من التطور، هناك الكثير من سوء الفهم، الكثير من الأخطاء، ولكن بالأخص فكر الممكن الذي هو أقل من الواقعي، ولهذا السبب إمكانية حدوث الأشياء تسبق وجودها، قد تكون بذلك متمثلة مسبقا، قد يكون تم التفكير فيها قبل وقوعها».[7]
وبهذا فسؤال الحرية كواقعة، واضح في هذا الطرح الحيوي للحياة. ولتطبيق قانون حفظ الطاقة الذي تنادي به الحتمية الفيزيائية، يفترض "برجسون" أنه حتى لو وصلت إلى معرفة ممكنة، واستطعنا بذلك أن نحدد أوضاع تلك الذرات المادية على مستوى الدماغ، واتجاهها وسرعتها في كل لحظة من لحظات الديمومة[8]، فإن هذا لا يعني أبدا بأن حياتنا النفسية تخضع لنفس القضاء؛ لأنه ليس هناك ما يؤكد أن كل حالة مخية معينة يترتب عليها ضرورة حالة نفسية محددة. وإذا كنا نلاحظ في بعض الحالات توازيا بين بعض الظواهر الفيزيولوجية والحالات النفسية، فإن مثل ذلك التوازي يقتصر على حالات نادرة، وبصدد وقائع يعترف الجميع أنها مستقلة تمام الاستقلال عن الإرادة. ومن ثمة، لا يحق لنا أن نعمّمه على جميع الحالات النفسية. والحق أن الوعي، حسب "برجسون"، يعطي لنا ومضات كثيرة على إثرها تكون جل أفعالنا مفسرة انطلاقا من مرجعيته ودوافعه.
ولكن لا يجب أن نفهم هنا على ضفاف هذا المعنى، أن ما نسميه بالحتمي يدل على الضرورة، طالما أن الحس المشاع والمشترك بين عامة الناس يؤمن بحرية الاختيار. وبذلك نقر مع "برجسون" أن هذا المفهوم العلمي ((الحتمي)) يخدعنا انطلاقا من آراء الديمومة والسببية. وطبعا، هذا تصور سيوجه له الفيلسوف النقد، باعتباره ينطلق من فكرة مفادها: وجود ضرورة لوقائع الوعي بعضها مع البعض الآخر، وهذه الضرورة، حسب هذا التصور، هي ضرورة مطلقة. ولربما هذا هو الطريق الذي نشأت عنه الحتمية الترابطية، الذي نادى بها كل من "جون سيتورات ميل"، و"ألكسندر بان" وغيرهم. فحتمية من هذا النوع، يقول "برجسون"، لا يمكنها أن تدعي الدقة العلمية في نقاشها عن حرية الحياة، فهي حتمية تسعى إلى أن تستند إلى الآلية نفسها والمدعمة لظواهر الطبيعة.
والواقع، أن الحتمية الطبيعية عامة، ليست نظرية علمية، فهي في نظر "برجسون"، مذهب فلسفي تولّد عن أصل ميتافيزيقي، فالذي يقول بها، لا شك أنه يهدف إلى محاولة تقوية حجة الحتمية السيكولوجية، وذلك بالالتجاء إلى علوم الطبيعة:
«ويجب أن نعترف بالرغم من ذلك، أن الحصة التي ستتبقى لنا من الحرية بعد تطبيق جدي لمبدأ حفظ الطاقة هي محدودة جدا؛ لأنه إذا كان هذا القانون لا يؤثر بالضرورة على مسار أفكارنا، فإنه سيحدد على الأقل حركاتنا، إن حياتنا الداخلية ستتوقف إلى حد بعيد أيضا على أنفسنا إلى غاية نقطة محددة، ولكن بالنسبة إلى ملاحظ موجود في الخارج، فإنه لا شيء يميز نشاطنا عن الآلية المطلقة».[9]
وهكذا، فأيّ تطبيق لقانون حفظ الطاقة سيكون في صميمه، تاركا ومهملا لتأثير الزمن. فإذا كنا نعتقد أن ليس للزمن أي تأثير في ميدان المادة الجامدة، فإن هذا التأثير أمر وارد ولا شك فيه في ميدان الحياة، حيث تعمل الديمومة في الكائن الحي كما تعمل العلة. ويستحيل أن يعود الكائن الحي بعد أن مضى فترة من الزمن إلى ما كان عليه من قبل، وهذا ما اتضح في قول "برجسون" بشكل دقيق: «...ما أحس لن يكون مرتبطا بالموقف الذي أتبناه عن الشيء، ما دمت سأكون داخل الشيء نفسه، ولا حتى بالرموز أو الدلالات التي تمثل بها هذا الشيء، طالما سأتمكن عن التنازل أو التخلي عن كل تمثل من أجل تمثل آخر أصلي لهذا الشيء». ولعل هذا الأمر ينجلي بكل تأكيد حينما نكون بصدد الشعور.
فهنا يستحيل أن يظل الإحساس هو نفسه، أو أن يرتد إلى الوراء، وإنما هو يقوى ويتضخم بسبب ماضيه. لهذا، لا ينبغي أن نعمم قانون بقاء الطاقة على الحياة النفسية؛ لأنها في تغير مستمر وتقدم متصل، من شأنه أن يضيف الماضي إلى الحاضر الجديد، فيمتنع مع هذه الإضافة أن يظل الشعور كما هو، أو أن يرتد إلى الوراء. وبالتالي، فالخطأ الذي وقعت فيه الحتمية الفيزيائية، حسب نظر "برجسون"، هو خلطها بين العالم المادي الخارجي، وبين العالم النفسي العميق. فالأول يحتمل أن نطبق فيه قانون بقاء الطاقة؛ لأن الزمن ينزلق فوقه دون أن يبدل فيه أو يطبعه بشيء منه. أما العالم الثاني، فلا يحتمل إطلاقا هذا التطبيق؛ لأن المحرك فيه هو الزمن، ويطبعه بأثره على نحو متجدد متصل، و"برجسون" يوضح هذا الخطأ في قوله التالي:
«إن الزمن ليست له سلطة على العالم المادي، والاعتقاد المبهم والفطري للإنسانية في حفظ الكمية نفسها من المادة، والكمية نفسها من القوة، يعود ربما وبشكل أساسي إلى كون المادة الداخلية لا تبدو لنا دائمة، أو على الأقل بأنها لا تحتفظ بأي أثر من الزمان المنصرم».[10]
لكن بالرغم من ذلك، هذا لا يبدو بالنسبة إلى "برجسون" أنه مطابق ومناظر لمجال الحياة، إذ تكون الديمومة هنا ممارسة لعملها بطريقة مشابهة للسببية. ومن ثم، تكون فكرة إعادة الأشياء إلى مكانها بعد لحظة معينة من الزمن تتضمن نوعا من اللامعقولية. ولما كنا في العادة لا نميل إلى ملاحظة ذواتنا بطريقة مباشرة، بل نحن ننظر إلى أنفسنا من خلال تلك الصورة المستعارة من العالم الخارجي، فإننا كثيرا ما نتوهم أن الديمومة الحقيقية التي نحياها في باطن شعورنا هي نفسها تلك الديمومة الآلية، التي تنزلق فوق الذرات دون أن تدخل عليها أدنى تغيير:
«من هنا ينتج عدم إحساس باللامعقولية، حينما نقوم بإعادة الأشياء إلى مكانها، مباشرة بعد انقضاء الزمان، ونقوم بافتراض أن الدوافع نفسها تمارس تأثيرها من جديد على الأشخاص أنفسهم، ونعتقد في الختام أن هذه الأسباب نفسها ستؤدي إلى النتائج نفسها».[11]
وهكذا، نندفع إلى تعميم مبدأ بقاء الطاقة، فنجعل منه قانونا كلّيا ينطبق على الظواهر النفسية كما ينطبق على الظواهر الطبيعية سواء بسواء. وبذلك نوحد بين العالم الباطن والعالم الخارجي، أو بين الديمومة الحقيقية والديمومة الظاهرة، دون أن تكون تحت أيدينا أية أدلة علمية تؤيد مثل هذا التوحيد. ومعنى هذا، أن العلم غير مسؤول عن تلك الدعاوى الميتافيزيقية التي يريد أصحابها أن يطبقوا مبدأ بقاء القوة على كل ما في الكون من ظواهر، بما في ذلك الظواهر السيكولوجية. والمقصود هنا، يشير الرجل إلى تلك الحتمية الترابطية التي تختزل الأنا إلى ركام من وقائع الوعي، ومن الإحساسات والعواطف والأفكار، وهنا سيستحضر "برجسون" أحد الفلاسفة الأكثر عمقا، السيد فوييه [12]Fouillée
«الذي لا يتردد في أن يجعل من فكرة الحرية في حد ذاتها دافعا بإمكانه أن يعادل دوافع أخرى».[13]
والمعنى من هذا، حسب الرجل، هو أنه بالإمكان أن نعرض أنفسنا مرة أخرى للوقوع في التباس خطير، مرده إلى كون اللغة ليست مؤهلة للتعبير عن كل الفروق البسيطة كحالاتنا الداخلية. لكن، لو كان الأمر عكس ما تقول به الحتمية الترابطية، ولو أخذت بالإحساسات النفسية من خلال اللون الخاص الذي تكتسيه عند شخص محدد، والتي تأتي لكل واحد منهم، انطلاقا من انعكاس كل الحالات النفسية الأخرى، فلن تكون هناك، في رأي "برجسون"، حاجة إلى ربط الكثير من وقائع الوعي، بغية تشكيل وتكوين شخصية حياة الإنسان. إذ هذا الأخير كامل في كل واحد من هذه الحالات. وهكذا فالتمظهرات الخارجية لهذه الحالات، ستكون بالتحديد هي ما نسميه بالفعل الحر، طالما الأنا هو الذي سيكون الفاعل؛ لأنه سيترجم لحظات الأنا بأكمله:
«وبهذا المعنى، فإن الحرية لا تقدم الخاصية المطلقة التي تمنحها إياها الروحانية في بعض الأحيان، إنها تقبل بالتدرج؛ لأنه غير مكترث لكون حالات الوعي تأتي لتتدخل في تجانسها، مثل قطرات من المطر فوق حوض من الماء».[14]
من هنا، فكلما استبقى "الأنا" في إدراكه انطلاقا من المكان المتجانس، كلما بقي في إدراكه هذا بسيط وسطحي. وعلى هذا الأساس، فإن تلك الاقتراحات التي تستقبل في حالة التنويم المغناطيسي لا تمتزج بكتلة وقائع الوعي. لكن، ولأنها ذات حيوية خاصة، فإنها ستحل محلّ شخصية حياة الإنسان. وبالتالي فمجموع الإحساسات والأفكار التي تأتينا من تربية غير مفهومة بشكل جيّد، تلك التي تتوجه إلى الذاكرة وليست إلى الحكم. يقر "برجسون" بصدد هذه المسألة، أن هناك أنا داخليا وأساسيا يتكون يسميه بالأنا الطفيلي الذي سيتطاول باستمرار على الأنا الآخر. وعلى غرار هذه الطريقة، يقول "برجسون" إن هناك:
«... كثيرون يعيشون هكذا، ويموتون من دون أن يكونوا قد عرفوا الحرية الحقيقية. ولكن الاقتراح سيصبح إقناعا إذا قام الأنا بأكمله باستيعابه، فالأهواء حتى المفاجئة، لن تقدم أبدا الخاصية المحتومة نفسها لو أنها انعكست عليها، وبذلك، فإنه في شخص ألسيست (*)ALCESTE، كل تاريخ الشخص والتربية الأكثر تسلطا لا تقتطع شيئا من حريتنا لو أنها أبلغتنا فقط بأفكار وعواطف قادرة على أن تطبع النفس برمته بطابعها».[15]
هكذا، فما يفهم من ذلك، هو أن من نواة النفس بأكملها واعتمادا عليها ينبع القرار الحر، إذ الفعل سيكون بهذا القدر أكثر حرية من السلسلة الدينامية التي يتمسك بها، ويسعى باستمرار إلى أن يتعرف إلى نفسه من خلال الأنا الأساسي. ولكن إذا ما حاولنا أن نعرف الفعل الحر، ونقول: إنه الفعل الذي كان يمكن ألا يحدث، فحسب "برجسون"، هذا التعريف يستلزم وجود تكافؤ مطلق بين الديمومة الحقيقية ورمزها المكاني، ولا شك أن هذا التكافؤ لا بد أن يسقطنا مرة أخرى في فخاخ النزعة الحتمية الصارمة. وعليه، نطرح السؤال: هل نعرف الفعل الحر بالقول إنه ذلك الفعل الذي لا يمكن التنبؤ به، حتى ولو قدر لنا أن نعرف مسبقا سائر شروطه؟. ولكن القول بأن كل شروط الفعل متوفرة في الحاضر، معناه أننا قد نفذنا عبر الديمومة إلى تلك اللحظة التي فيها يتحقق ذلك الفعل:
«وبذلك، فإن الفعل قد يتبع الانطباع من دون أن تهتم شخصيتي بذلك، أن هنا رجل آلي محتفظا بوعيه، وأتبعه لأن مصلحتي أن أقوم بذلك».[16]
اعتمادا على ذلك، يزعم "برجسون"، بأننا سنرى أن أغلب أفعالنا اليومية تحدث بهذه الطريقة؛ لأنه واستنادا إلى ما يبقى مثبتا في ذاكرتنا من إحساسات وعواطف وأفكار، تبزغ انطباعات من الخارج تثير من جانبها حركات، والتي هي شعورية، بل متعلقة تشبه في الكثير من جوانبه حركات ردود الفعل. هكذا، فالنظرية الترابطية تنطبق على هذه الأفعال الكثيرة جدّا: والتي لا معنى لها بكاملها، فهي اعتمادا على "برجسون"، تشكل تجميد وتسكين لمجموع نشاطاتنا الحرة، إذ تقوم بصدد هذا النشاط بالدور نفسه الذي تقوم به وظائفنا العضوية مقارنة بمجموع حياتنا الواعية.
فنحن بهذا، نتنازل مرة أخرى للحتمية عن حريتنا في ظروف أكثر خطورة، وأنه ومن منطلق الجمود والليونة، نترك هذه الصيرورة المحلية نفسها تتجسد؛ في حين يفرض بشكل قهري على حياتنا وشخصيتنا بأكملها أن ترتج، حينما يقرر مثلا أصدقاؤنا الأوفياء أن يشيروا علينا بالقيام بفعل مهم، فإن العواطف التي يعبرون عنها بكثير من الإلحاح، تأتي لتستقر فوق سطح ذواتنا. وبهذا، بطريقة ترابطية، نرضخ لطلب أصدقائنا: «إذ نقطة نقطة تتشكل قشرة سميكة ستغلق عواطفنا الشخصية[17]». لكن رغم ذلك، نعتقد أننا نتصرف بكل حرية، حيث انتباها مركزا قد نقوم به سينقشع لنا، لا محالة، الخطأ الذي وقعنا فيه.
إلا أنه رغم ذلك فـ "برجسون" يرى: أنه في اللحظة التي سيتحقق فيها الفعل، ليس مستبعدا أن يحدث تمرد، حيث يتغلب الأنا الموجود في الأسفل على الأنا السطحي. قد نقول إنها القشرة الخارجية هي التي انفجرت متراجعة أمام زحف لا يقاوم، حيث يحدث ذلك إذن في أعماق هذا الأنا، وتحت حججه المتجاورة بشكل معقول. وانطلاقا من ذلك، يحدث أيضا توتر متزايد للعواطف والأفكار، ليس من دون شك لا واعية. ولكن لا نريد بشأنها أن نأخذ حذرنا، ومن خلال التفكير بشكل جيد، وجمعنا بعناية لذكرياتنا سنلاحظ بأننا شكلنا بأنفسنا هذه الأفكار، وأننا عايشنا بأنفسنا هذه العواطف. ولكن انطلاقا من إرادة منفردة قمنا بدفعها نحو الأعماق المظلمة لذاتنا، كلما كانت تطفو على السطح. ولذلك، فنحن نحاول من دون جدوى أن نفسر التغير المفاجئ في قرارنا من خلال الظروف العابرة التي تسبقه. إننا نريد أن نعرف السبب الذي اتخذنا من أجل قرارنا، وسنجد أننا اتخذنا قرارنا من دون سبب، وربما حتى ضد كل منطق.[18] وبهذا تظهر في النهاية من دون شك، أفضل الأسباب المعبرة والمحددة لتلك الأفعال المقررة. لكن ضد إرادتنا وحريتنا، والتي لا تبين البتة عن تلك الفكرة السطحية الخارجية عنا تقريبا والمتميزة.
خاتمة:
يبدو من خلال مقاربتنا لقضية القدرة على الفعل بحرية عند الإنسان، تطرح من المشاكل والالتباسات ما لا يمكن حصره وما لا يمكن عده. والواقع، أن ذلك يعود إلى مدى التعقيد والتركيب الذي يطال الإنسان، حيث تعدد المحددات والأبعاد التي هي محط جدل واختلاف إلى اليوم، بل أكثر من ذلك، وكما يصرح المنطقي المغربي الأستاذ "حسّان الباهي" في كتابه فلسفة الفعل، أن فكرة خلق آلة تسلك وتتصرف كما يسلك ويتصرف الإنسان، جعلت العلوم الإنسانية وعلوم الأعصاب والفيزيولوجيا والفلسفة إلى حد بعيد تعيد طرح مشكلة الإنسان من حيث إنه وعي وإنه قدرة وإرادة، وأيضا من حيث إنه يقصد أفعاله.
هكذا، فالعديد من الإشكالات العالقة التي يمكن إرجاع مجملها إلى الإشكال الآتي: إلى أي حد استطاعت هذه العلوم أن تقرر بإمكانية بناء آلة تتسم هي أيضا بالتعقيد والتركيب اللذين يميزان الإنسان؟
[1] نقصد، على وجه التخصيص، فلسفة ديكارت، باعتبارها الفلسفة المؤسسة لعصر الحداثة، حيث مبدأ الذاتية المؤصل على الكوجيتو: "أنا أفكر إذن أنا موجود".
[2] حسّان الباهي، فلسفة الفعل اقتران العقل النظري بالعقل العملي، أفريقيا الشرق، ط 2016، ص 139.
[3] نفس المرجع، ص 139
[4] نستطيع أن نشير بصدد هذه النقطة إلى القول الهيغلي الذي يقّر بأن "التاريخ محكمة للحقيقة".
[5] Henri Bergson; Essai sur les données immédiates de la conscience; P.U.F, 9édition «Quadrige» 3e tirages: 2011; presses universitaires de France; 1927 bibliothèque dephilosophie contemporaine 6, avenue Reille, paris, PP: VII, VIII
[6] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, P.U.F, 9édition «Quadrige»3e tirages: 2011; 1927 bibliothèque dephilosophie contemporaine 6, avenue Reille, paris, P: 107
[7] Henri Bergson; la pensée et le mouvant; P.U.F, 9édition: 1985, P: 109
[8] إنها مفهوم يمثل نواة الفلسفة البرجسونية بكاملها، وهي تعني الزمان، إذا أطلقت على الزمان المحدود سميت مدة، وإذا أطلقت على الزمان الطويل الأمد، الممدود سميت دهرا؛ لأن الدهر هو الأمد الدائم، أو مدة العالم، وهو باطن الزمان، وبه يتحدد الأزل والأبد (تعريفات الجرجاني)، ومنه الدهري، وهو الذي يقول: العالم موجود أزلا وأبدا لا مانع له، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن معاني الديمومة أنها تطلق على جزء من الزمان المطلق، فتكون حينئذ زمان فعل، أو زمانا فاصلا بين فعلين، ويكون الزمان المطلق محيطا بها إحاطة الكل بالجزء، ولكن للديمومة في فلسفة برجسون معنى خاصا، هي الزمان النفسي أو الزمان الداخلي وتسمى بالديمومة الخالصة، أو الديمومة المشخصة، وهي تدخل في مقولة الكيف لا مقولة الكم، والفرق بينهما وبين الزمان أنها لا تقاس كما يقاس الزمان الرياضي أو الزمان الطبيعي، وأن لحظاتها تتجدد دون انقطاع، وأنها مستقلة عن المكان، وأن لحظاتها المتتالية تدخل بعضها في بعض حتى تشكل كتلة واحدة، فهي إذن زمان مشخص، لا زمان مجرد بخلاف الزمان العلمي والرياضي المنقسم إلى وحدات متساوية. (آعتمدت في شرح هذا المفهوم على المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا، الجزء الأول، ص: 571).
[9] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, P.U.F, 9édition «Quadrige»3e tirages: 2011; 1927 bibliothèque dephilosophie contemporaine 6, avenue Reille, paris, PP: 112 - 113
[10] Henri Bergson; la pensée et le mouvant; P.U.F, 9édition: 1985, P: 178
[11] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, P.U.F, 9édition «Quadrige»3e tirages: 2011; 1927 bibliothèque dephilosophie contemporaine 6, avenue Reille, paris p: 116
[12] ألفرد فوييه: فيلسوف فرنسي ولد سنة 1838 وتوفي سنة 1912، له عدد من المؤلفات في مجال الفلسفة وعلم النفس ومن بينها
«la liberté et le déterminisme».
[13] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, P.U.F, 9édition «Quadrige»3e tirages: 2011; 1927 bibliothèque déphilosophie contemporaine 6, avenue Reille, paris, P: 120
[14] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, P.U.F, 9édition «Quadrige»3e tirages: 2011; 1927 bibliothèque dephilosophie contemporaine 6, avenue Reille, paris, p: 125
* هي ابنة بيلياس ملك إحدى المدن الواقعة وسط اليونان القديمة بحسب الميثولوجيا الإغريقية، وهي أيضا زوجة "أدمت"، ويقال إنها قبلت أن تفدي زوجها من الموتـ وتم إنقاذها من النار من طرف هرقليس، وتقول الأسطورة اليونانية أيضا إن الساحرة الشريرة ميدي قطعت خروفا إلى أجزاء وألقته في قدر ماء يغلي، فخرج منه حملا صغيرا، وقد أرادت إخوات ألسيست أن تعدن للتجربة مع أبيهن لكن ألسيست رفضت المشاركة في التجربة، وقتل بلياس بعد أن ألقت به الساحرة في القدر الكبير، ولم يخرج منه أبدا، وقد أوحت أسطوراتها المتعددة الأوجه "لأوريبيد" بكتابة تراجيدياته سنة 430 قبل الميلاد.
[15] Ibid, P: 125
[16] Ibid, P: 126
[17] Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, P.U.F, 9édition «Quadrige»3e tirages: 2011; 1927 bibliothèque dephilosophie contemporaine 6, avenue Reille, paris p: 127
[18] Ibid, PP: 127 - 128







