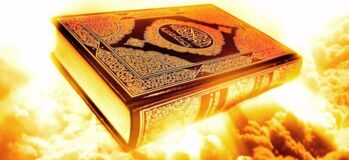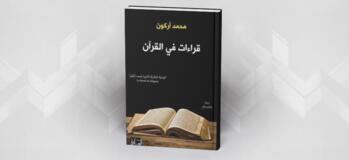الفقيه وقرآن إبليس: فتنة الشعر والشاعر
فئة : مقالات

الفقيه وقرآن إبليس: فتنة الشعر والشاعر
المقدّمة
لا نهدف من وراء هذه الدراسة إلى تبيّن موقف الإسلام من الشعر والشعراء، كما أنّنا لا نسعى إلى رسم حدود العلاقة بين الفقيه والشعر في تراثنا العربيّ؛ ذلك أنّ كثيرًا من الدارسين قد نظروا في هذه المباحث[1]، وانتهوا إلى نتائج متفاوتة؛ إذ تبدو العلاقة بين الشعر والإسلام علاقة ملتبسة يتردّد فيها الباحث بين ثناءٍ على الشعر مشروطٍ بالفضيلة ووصمٍ للشاعر مقرونٍ بالإغواء، فتنفتح معان متداخلة طورا متباينة طورا آخر تقود بعضهم إلى الاحتفاء والإباحة، وتنتهي ببعضهم الآخر إلى الذمّ والتحريم.
ومن الواضح أنّ الموروث الدينيّ ممثّلا في القرآن والسنّة هو ما احتكم إليه الفقهاء، وهم يتقصّون موقف الإسلام من الشعر والشعراء. وللوهلة الأولى يبدو النصّ القرآني واضحا في تأييده للشاعر المؤمن المبشّر بقيم الخير والفضيلة، صريحا في حملته على الشاعر الفاسق الذي يقود الغاوين إلى متاهات الضلالة. لكنّ ما استقرّ في الأذهان أو كاد أنّ الإسلام يقف من الفنون بوجه عام، ومن بينها الشعر موقف ارتياب يصل غالبا إلى الرفض؛ إذ إنّ مسار التفكير الغالب يميل إلى تغليب الاعتماد على كثير من الأقوال المنسوبة إلى الرسول محمّد (ص)، وهي أقوال/أحاديث اعتمدها كثير من الفقهاء، وهم يتفحّصون الموقف من الشعر والشاعر. وملخّص هذا الموقف أنّ الشعر عنوان غواية وإفساد، وإذن فإنّه ضرب من الضلالة مآلها الجحيم.
الشعر في القرآن والحديث
من المفيد أن نذكّر بأنّ لفظة (شاعر) وردت في القرآن الكريم مفردةً في أربع آيات[2]، وفي صيغة الجمع مرّة واحدة[3]، وكذلك لفظة (الشعر)[4]. وفي كلّ هذه المواضع وردت مقترنة بالجنون والغواية والسحر إلى غيرها من الألفاظ التي تحيل إلى دلالات الافتراء والتيه والضلال. ولعلّ هذا الاقتران هو ما برّر لبعض الفقهاء اتّخاذهم لموقف مُعادٍ للشعر والشعراء، رغم أنّ القرآن لم يقف موقفا رافضاً، أو معادياً بشكل مبدئيّ مطلق للشعر.
ومن الإنصاف أيضا، أن نذكر أنّ كثيرًا من العلماء والمفسّرين والفقهاء وقفوا موقفاً متوازناً، وهم يشرحون طبيعة العلاقة بين الإسلام والشعر؛ فالعلاّمة ابن عاشور (1393هـ/1973م) خصّص صفحات في تفسير الآيات المعروفة من سورة الشعراء، ليبيّن احتفاءَ الإسلام بالشعر الخيّر الذي يحضّ على الفضيلة، وذمَّه للشرّير الذي ينطوي على الكذب ويروّج للفسق والمجون. إنّ الشعراء المذمومين هم الذين "يقولون في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس، ومن نسيب وتشبيب بالنساء، ومدح من يمدحونه رغبة في عطائه، وإن كان لا يستحقّ المدح، وذمّ من يمنعهم وإن كان من أهل الفضل. وربّما ذمّوا من كانوا يمدحونه، ومدحوا من سبق لهم ذمّه"[5]، بل إنّ ابن عاشور في تفسيره للآية الكريمة ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾[6] نزّه الرسول (ص) عن قول الشعر، لكنّه أقرّ بترديده وإنشاده له، وهو ما يدلّ على أنّ للشعر وجهاً مشرقاً طيّباً يمكن الاستئناس به. يقول ابن عاشور: "ليس المراد أنّه (أي الرسول) لا ينشد الشعر؛ لأنّ إنشاد الشعر غير تعلّمه. وكم من راوية للأشعار ونَقّاد للشعر لا يستطيع قول الشعر. وكذلك كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد انتقد الشعر ونبّه على بعض مزايا فيه، وفضّل بعض الشعراء على بعض، وهو مع ذلك لا يقرض شعرا"[7].
وعلى الرغم مما بدا في تفسير النصّ القرآنيّ من إقرار بقبول مشروط للشعر، ورغم ما أظهره الرسول (ص) من احتفاء بالشعر الذي يذبّ عن الدين الجديد، ويهجو أعداءه من المشركين، فإنّ كثيرًا من الفقهاء ركّزوا على أقوال منسوبة إلى الرسول تحطّ من شأن الشعر، وتحدّد الجحيم مأوى للشعراء. وينخرط في هذا المنحى أغلب الفقهاء الذين كتبوا في "نصائح الملوك"؛ إذ تستوقف الباحثَ في مظانّ كتب الفقه والحديث أقوالٌ كثيرة يسوقها المؤلّفون على أنّها أحاديث نبويّة، ومن بينها: "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا"[8]، وكذلك: "مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ"[9]، إضافة إلى الحديث الذي يذكر فيه الرسول الشاعر امرؤ القيس بقوله: "ذَاكَ رَجُلٌ مَذْكُورٌ فِي الدُّنْيَا مَنْسِيٌّ فِي الْآخِرَةِ، شَرِيفٌ فِي الدُّنْيَا خَامِلٌ فِي الْآخِرَةِ، بِيَدِهِ لِوَاءُ الشُّعَرَاءِ يَقُودُهُمْ إِلَى النَّارِ"[10]، وهي أقوال تضع الشعر في خانة المدنّس وتهوي بالشاعر إلى مزالق الضلالة المؤدّية إلى الخروج من الملّة. ورغم أنّ أغلب هذه الأحاديث صُنّفت بوصفها ضعيفة غريبة منكرة بل موضوعة[11]، فإنّ المفسّرين والفقهاء دأبوا على اعتمادها في حملتهم على الشعر والشعراء، وكأنّهم يعلنون الحرب على خصم لا يمكن هزمه دون الاعتماد على نصوص مقدّسة تغلب سطوتها وجاذبيّتها كلّ ما عداها من النصوص.
الفقيه شاعرًا
يهمّنا أن نوضّح أنّ هذا البحث يقتصر على النظر فيما أبداه بعض الفقهاء في هذه المسألة، وهم يتوجّهون بخطابهم إلى السلطان في تآليفهم التي صُنّفت ضمن الآداب السلطانيّة. والباعث على هذا الاختيار أنّهم جميعا خصّصوا حيّزا مهمًّا (بابا أو فصلا) للحديث عن فضل الأدب وعلاقة السلطان بالعلم والعلماء وأهمّيّة مخالطة الحكماء وحسن اصطفاء الجلساء[12]. ونضيف إلى ذلك، أنّ ملوك ذلك العصر لم يكن لهم موقف سلبيّ من الشعر؛ إذ إنّ كثيرين منهم احتضنوا الشعراء وأنصتوا إلى مدائحهم على غرار صلاح الدين الأيّوبي (589هـ/1193م) الذي مدحه كثيرون وتغنّوا بخصاله وأثنوا على فتوحاته[13]، بل إنّ أسامة بن منقذ (وهو شاعر) كان أحد أبرز مستشاريه الحربيّين[14].
وهذا يعني أنّ الشاعر ظلّ يحافظ على منزلة خاصّة حتّى إن كنّا ندرك حقيقة فقدانه لذلك البريق المتفرّد الذي يجعل القبيلة تتلقّى التهاني كلّما نبغ فيها شاعر، وتصنع الأطعمة، وتجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، ويتباشر الرجال والولدان[15]. لكنّه في كلّ الأحوال ما زال رأس الحربة في حماية الأعراض والإشادة بالذكر وشحذ الهمم والتحريض على الجهاد.
يصحّ القول إنّ أهمّيّة الشعر تراجعت لصالح الخطابة، بل "صار الخطيب أعظم قدرًا من الشاعر"[16]. ويبدو أنّ هذا التحوّل في مكانة الشاعر يعود إلى أسباب قيميّة بالأساس، بفعل فقدانه لمصداقيّته وسعيه إلى التكسّب بشعره وتحويله إلى بضاعة يفوز بها كلّ من يدفع. يقول الجاحظ (255هـ/868م): "...لما كثر الشعر والشعراء، واتّخذ (الشعراء) الشعر مكسبة، ورحلوا به إلى السوقة وتسرّعوا إلى أعراض الناس صار الخطيب [...] فوق الشاعر"[17].
وعلى الرغم من انحدار منزلة الشاعر، فقد ظلّ الشعر حاضرًا داخل بلاطات السلاطين والأمراء، كما ظلّت الحاجة إليه قائمة؛ لأنّ المعرفة به وبقواعد اللغة العربيّة ضروريّة لفهم كتاب الله وسنّة رسوله وتتبّع معانيهما وتجنّب الخطأ في الألفاظ والمباني. وللاستدلال على هذا الرأي يمكن أن ننقل قول أحد أشهر الفقهاء الحنابلة، وهو ابن قدامة الحنبليّ (620هـ/1223م): "ليس في إباحة الشعر خلاف، وقد قاله الصحابة والعلماء، والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية، والاستشهاد به في التفسير، وتعرّف معاني كلام الله تعالى وكلام رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ويُستدلّ به أيضاً على النسب والتاريخ وأيّام العرب"[18].
وهذه الغاية النفعيّة هي التي قادت الفقهاء إلى اعتبار المعرفة بالشعر فرض كفاية: "قال جمهور الفقهاء: [...] معرفة شعر أهل الجاهليّة والمخضرمين (وهم من أدرك الجاهليّة والإسلام) والإسلاميّين رواية ودراية فرض كفاية عند فقهاء الإسلام؛ لأنّ به تثبت قواعد العربيّة التي بها يُعلم الكتاب والسنّة المتوقّف على معرفتهما الأحكام التي يتميّز بها الحلال من الحرام. وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في المعاني فلا يجوز فيه الخطأ في الألفاظ وتركيب المباني"[19]. وإذن، فإنّ تعلّم الشعر ضرورة لا غنى عنها، بل إنّ كثيرًا من الفقهاء تجاوزوا مسألة التعلّم إلى الانخراط في قرض الشعر. ونحن نجد نماذج عديدة لعلّ أبرزها الإمام الشافعي (204هـ/820م) الملقّب بــ"حبر الأمّة وإمام الأئمّة" الذي يقول في الحضّ على طلب العلم: [الطويل]
وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ
وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْـــهِ أَرْبَعًــا لِوَفَاتِــــهِ[20]
كما كتب ابن القيّم الجوزيّة (751هـ/1350م) الشعر، وهو المعروف بتبحّره في الفقه والحديث والتفسير. وممّا قاله عن نفسه معبّرًا عن تقصيره وخوفه من أن يكون علمه حجّة عليه أمام الله: [الطويل]
بُنَيُّ أبِي بَكْرٍ جَهُولٌ بِنَفْسِهِ جَهُولٌ بِأَمْرِ اللهِ أنَّى لَهُ الْعِلْمُ
بُنَيُّ أبِي بَكْرٍ غَدَا مُتَصَدِّرًا يُعَلِّمُ عِلْمًا وَهْوَ لَيْسَ لَهُ عِلْمُ[21]
ويمكن أن نذكر في السياق ذاته ابن حجر العسقلاني (852هـ/1449م)، وهو أحد كبار المحدّثين؛ إذ لُقّب بــ"شيخ الإسلام" و"أمير المؤمنين في الحديث"، وقد خاض في أغلب أغراض الشعر العربي، من ذلك وصْف رحلته إلى الحجّ وتعريجه على مشهد التلبية قائلا: [الطويل]
وَلَبُّوا فَبَلُّوا بِالنَّسِيمِ غَلِيلَهُمْ وَحَيَّوْا فَأَحْيَوْا لِلنُّفُوسِ كَمَا لَهَا
يَمِيناً بِهَبَّاتِ النَّسِيمِ بِسُحْرَةٍ لَقَدْ فَازَ مَنْ مَدَّتْ إِلَيْـــهِ شِمَالهَاَ[22]
ولا ينبغي أن نتوقّف طويلا عند ذمّ صريح أو خفيّ للشعر يبديه بعض الفقهاء لأنّنا عند تفحّصنا لمؤلّفاتهم وعلاقتهم بالشعر في جانب الممارسة نجد أنّهم يحتفون بالشعر في مستويات متعدّدة. ولعلّ من الأمثلة الساطعة على سطوة الشعر وجاذبيّته أنّ أبا حامد الغزالي (505هـ/1111م) الملقّب بـ(حجّة الإسلام) قد استشهد في كتابه (إحياء علوم الدين) بــ 421 بيتا من الشعر[23]. كما أنّه ترك ديوانا ضمّ 587 بيتا[24]. ورغم ذلك، فإنّه حين يتحدّث عن شروط الكتابة ويرتّب معارف الكاتب الضروريّة لا يجد أيّ حرج في وضع الشعر في ذيل قائمة العلوم واجبة التعلّم. يقول: "ينبغي أن يكون الكاتب عالما بعشرة أشياء: الأوّل قرب الماء وبعده تحت الأرض [..] ومسير الشمس القمر والنجوم [..] وحساب الهندسة والتقويم [..] ومعرفة الطبّ والأدوية [..] ومعرفة علم الشعر والقوافي"[25].
لكنّ استخفاف الغزالي بالشعر لم يواكبه إعراض عنه أو قطع مع الاستشهاد به في مختلف الفصول والأبواب التي ضمّها كتابه (التبر المسبوك في نصيحة الملوك)، بل لعلّ العكس هو ما يستنتجه الباحث المطّلع على المؤلّفات السلطانيّة؛ إذ يكاد لا يخلو أيّ من هذه المؤلّفات من حضور للشعر يفوق أحيانا حضور أجناس وأنواع شتّى من القول.
حاجة الفقيه إلى الشعر
إنّ تناول حضور المدوّنة الشعريّة في المؤلّفات السلطانيّة يستمدّ شرعيّته من أسباب ثلاثة: الأوّل وفرة الشواهد الشعريّة، رغم عدم انتظام حضورها في كلّ المؤلّفات، والثاني أنّ المدوّنة الشعريّة تفيض -من حيث الحجم- على ما عداها من أجناس القول وأنواعه، والثالث أنّه لا غنى للأديب السلطانيّ عن الشعر بما يتضمّنه من حكم تحضّ على الفضيلة.
ولا تخلو مقدّمات الأدباء السلطانيّين من إقرار بالاعتماد على الشعر إلى جانب أجناس وأنواع أخرى من القول شأن المثل والحكمة والخبر والموعظة. يقول الشيزري (590هـ/1094م): "أودعته (أي كتاب النهج المسلوك) من الأمثال ما يسبق إلى الذهن شواهد صحّتها ومعالم أدلّتها مع نوادر من الأخبار وشواهد من الأشعار. وفصّلته أبوابا تتضمّن حكايات لائقة ومواعظ شائقة وحكما بالغة"[26]. وفي حين يتّفق الباحثون على وفرة الشواهد الشعريّة في كتب نصائح الملوك[27]، فإنّ هذه الوفرة رافقها حرص بيّن على حجب أسماء الشعراء[28]. ولا شكّ أنّ المدوّنة الشعريّة العربيّة حافلة بالحكم غنيّة بالعظات والعبر. وهي من هذه الزاوية تصلح أن تكون مادّة خصبة يجد فيها الفقيه ضالّته، خصوصا إذا كان يريد الاستدلال على قيم الفضيلة شأن الشجاعة والعدل والحِلم والأناة.
لكنّ هذا الفقيه لا يبدو منشغلا بمعرفة الشاعر أو ذكره على خلاف ما يفعل عادة في الحكايات والأخبار. ولعلّ ذلك يعود إلى أسباب منها أنّ الخبر يكتسب قدرًا كبيرًا من المصداقيّة والواقعيّة عندما تُذكر أسماء الشخصيّات والمواضع، في حين أنّ اسم الشاعر لا يضيف إلى البيت/ الأبيات قيمة من نوع ما. ومنها أنّ الشعر ظلّ يحمل وزر الوصم الأوّل؛ إذ هو عنوان غواية[29]. ولهذا، فإنّه من العسير على الأديب السلطانيّ أن يقبل مجاورته للنصّ القرآنيّ أو الحديث النبويّ والاحتجاج به.
وهكذا يبدو الموقف من الشعر والشعراء سلبيًّا، إذا أخذنا هذا المعطى بعين الاعتبار، دون أن نغفل أنّ بستان الشعر لا غنى عنه لسبب وجيه، أفصح عنه الماوردي عندما دعا إلى اطّلاع الولد على الشعر العربيّ لدوره في تعلّم اللغة. لكنّه نبّه إلى ضرورة تعلّم أشعار الحكمة والزهد والعلم وغيرها ممّا جاء إنصافاً للشعراء في سورتهم[30]. يقول الماوردي متحدّثاً عمّا يجب على الإنسان أن يتعلّمه ولا سيّما أبناء الملوك: "يحتاج في الاستعانة على تعلّم اللغة إلى رواية أشعار العرب وأيّامها وأخبارها، والصواب في تدبير ذلك أن تُروى له ويُعَلَّم ويُحَفَّظ الأشعار الحكيمة التي ضمّت الحكمة والتوحيد والدين، والبعث على العلم والزهد والشجاعة والجود ومكارم الأخلاق دون التي يُذكر فيها الزنى والتجميش[31] والعشق والفحش والأهاجي التي فيها قذف المحصنات وذكر العورات"[32].
ولعلّ الماوردي أكثر من حَمَل على الشعراء دون أن يمنعه تحامله عليهم من الالتجاء إلى ما نظموه كلّما كان في حاجة إلى دعم رأي أو دحض موقف أو بيان أطروحة. وقد وصف الشعراءَ ومَن في "طائفتهم" بــ"الطبقة الفاسدة من المخانيث والمغنّين وأشباههم"[33]، وإذن "فإنّ الملك الفاضل والسائس العاقل لا يغفل أحد عن أن يدنس عرضه ومُلْكه وعقله بالفواحش وذكر عورات الناس والتواجد على الغلمان والنسوان والعشق والمعشوق، فإنّ كلّ هذا سخف وركاكة يجب على البعيد الهمّة أن يترفّع منها ويربأ بهمّته عنها، ولا سيّما ما أحدث شعراء هذا الزمان، فإنّهم يودعون أشعارهم الفحش والكفر، ويدسّون فيها من مذاهبهم الفاسدة ويُغْرون فيها بطلب اللذّات واتّباع الشهوات على سبيل الأمن والطمأنينة والجسارة والجرأة والاستخفاف بالدين وشرائعه والملّة ووظائفها. فإنّ ذلك كلّه مضرّ بأصل الاعتقاد وأمر الديانة"[34]. وليس خافياً ما في هذه الفقرة من تعريض بالشعراء والمغنّين ودعوة إلى الترفّع عن "سخفهم" و"فحشهم". أمّا اللذّة التي قد يتوق إليها الملك، فتكمن في مجالسة العلماء والفقهاء: "قرأنا لسابترم ملك الهند في عهد له إلى ابنه: فإن كنتَ شاغلا نفسك بلذّة، فلتكن لذّتُك في محادثة العلماء ودراسة كتبهم"[35].
وهكذا يبدو انتصار الماوردي للفقه والفقهاء واضحا في مواضع متفرّقة من كتابه (نصيحة الملوك). لكنّ حاجته إلى قيم شتّى يتضمّنها الشعر تُلجئه إلى دواوين الشعراء، بل قد يكون الشاهد الشعريّ مقدَّما أحيانا على النصّ القرآنيّ كما فعل الشيزريّ، وهو يستدلّ على أطروحته في ذمّ الكذب[36]. ومن الواضح أنّ الأديب السلطانيّ؛ إذ يدعو الملك إلى التحلّي بالفضائل، فلإيمانه أنّ الأدب الصالح طريق إلى الملك الدائم: "يُكتسَب من الأدب الصالح العقل النافذ، ومن العقل النافذ حُسْن العادة، ومن العادة الحسنة الطباع المحمودة، ومن الطباع المحمودة العمل الصالح، ومن العمل الصالح رضا الربّ، ومن رضا الربّ الملك الدائم"[37]. وطالما أنّ قيمة الأدب ليست بالضرورة مرتبطة بقائله فإنّ غضّ الطرف عن ذكر الشاعر لا يقلّل من قيمة المقول. وتنطبق هذه القاعدة على الأبيات التي ذاع صيتها كما تنطبق على ما سواها. والحقّ أنّنا لا نجد تفسيرا لتغييب القائل سوى ما ذكرنا من نظرة سلبيّة إلى الشعراء تتناغم مع ما ورد في القرآن الكريم. وإلاّ فكيف نفسّر إغفال ذكر الشاعر الجاهليّ عديّ بن زيد العباديّ التميميّ (600م) عند الاحتجاج ببيته: [الطويل]
عَنِ المرْءِ لا تَسألْ وسَلْ عَنْ قَرينِــهِ فكُــلُّ قَريــنٍ بالمُقَـــارِنِ يَقْتَــــدي[38]
أو إغفال ذكر الشاعر الأفوه الأودي (570م) إذ يقول: [البسيط]
لا يَصلُحُ الناسُ فَوضَى لا سَراةَ لَهُم وَ لا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم ســَــادُوا[39]
أو إغفال ذكر الشاعر الحطيئة (45هـ/665م) القائل: [البسيط]
دَعِ الْمَكارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِها وَاقْعُدْ فَأَنْتَ لَعَمْري الطَّاعِمُ الْكاسِي[40]
أو تجنّب الإشارة إلى أبي العتاهية (211هـ/826م) في قوله [الرجز]:
إنَّ الشَّبابَ وَالْفَراغَ وَالْجِدَهْ مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَهْ[41]
أو التغاضي عن ذكر ربيعة بن عامر بن أنيف المعروف بــ"مسكين الدارمي" (89 هـ/708م) إذ يقول: [الطويل]
أَخــاكَ أَخــاكَ إِنَّ مَــنْ لا أَخــا لَهُ كَسَــاعٍ إِلى الْهَيْـــجَا بِغَيْــرِ سِلاحِ
وَإِنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَرْءِ فَاعْلَمْ جَنَاحُهُ وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَازِي بِغَيْرِ جَنَاحِ[42]
أو إغفال ذكر الشاعر الجاهليّ زهير بن أبي سلمى (609م) وهو يستشهد ببيت من معلّقته: [الطويل]
وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْروفَ في غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ ذَمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ[43]
إنّ الشواهد في هذا الباب أكثر من أن تُعَدّ، ولا يُستثنى منها أيٌّ من المؤلفّات السلطانيّة؛ إذ السمة الغالبة على تعامل المؤلّفين مع النصّ الشعريّ ترجّح الاستفادة من المقول دون أن تلقي بالا إلى القائل. ولهذا، فإنّ الصيغ الدارجة هي من قبيل: "قال الشاعر": [البسيط]
لَنْ يُدْرِكَ الْمَجْدَ أَقْوامٌ وَإِنْ كَرُمُوا حَــــتَّى يَذِلُّـــــــوا وَإِنْ عَـزُّوا لِأَقْــــــــــــوَاِم[44]
أو: "قال بعض الشعراء": [الطويل]
إِذَا قُلْتَ فِي شَيْءٍ (نَعَمْ) فَأَتِمَّهُ فَإِنَّ (نَعَمْ) دَيْنٌ عَلَى الحُرِّ وَاجِبُ[45]
الشعر مقاوما للفناء
إنّ صيغ الاستدلال بالأبيات الشعريّة متعدّدة على غرار: (كما قيل) و(أنشدني بعض أهل العلم) و(أنشدني بعض أهل الأدب) و(قال بعض الفضلاء) و(أنشدني بعضهم) و(قديما قال الشاعر) و(قال بعض الشعراء المجيدين) و(قديما قيل)...إلخ. لكنّ القاسم المشترك بين هذه الصيغ هو الاكتفاء بالشاهد دون صاحبه، وهو الأمر الذي يعزّز ما ذهبنا إليه من أنّ الأمر ينطوي على موقف أغلب الأدباء السلطانيّين من الشعر والشعراء؛ إذ يستهويهم المعنى، ويصدّهم ما اجتُمِع عليه من مناوأة الشعر والارتياب منه.
وقد يجد الباحث مبرّرا لهؤلاء المؤلّفين عندما يهملون ذكر الشاعر إذا كان موسوماً بالمجون والتهتّك مثلا، لا سيّما أنّهم يكتبون "دستورا يُتَّبَعُ في إدارة الحكم والدولة وتسيير الأمور بالعدل والحقّ والعزم والحزم"[46]. ووفق هذه الرؤية نستطيع أن نفهم كيف أنّ الماوردي لا يذكر الشاعر أبا نواس (198هـ/813م) في موضعين متتاليين، بل يكتفي بوصفه بأنّه مجرّب للحبّ مكثر للقول فيه. يقول: "لا شيء أغلب على قول ناقصي العقول والحزم من إفراط الحبّ عشقا، وقد قال فيه أحد من جرّبه وأكثر القول فيه والوصف له: [الكامل]
الْحُبُّ ظَهْرٌ أَنْتَ رَاكِبُهُ فَإِذَا صَرَفْتَ عِنَانَهُ انْصَرَفَا
وقال آخر: [البسيط]
قَدْ عَذَّبَ الْحُبُّ هَذَا الْقَلْبَ مَا صَلُحَـا فَلَا تَعُدَّنَّ ذَنْباً أَنْ يُقَالَ صَحـــَـا
أَبْقَيــْـــتَ فِيَّ لِــتَقـْــوَى اللهِ بَاقِيَــةً وَلَمْ أَكُنْ كَحَرِيصٍ لَمْ يَدَعْ مَرَحَا"[47]
إنّ الماوردي في سياق استراتيجيّات الحجاج التي يتّبعها يحرص على التوسّع في الفكرة وتوضيحها وتحصينها بما أتيح له من شواهد وقصص وأخبار وأشعار. ولهذا، فهو -كغيره من المؤلّفين- يولي الفكرة ما تستحقّه من عناية، لكنّه في المقابل يعزف عن ذكر صاحب البيت الشعريّ، فهو مثلا لا يذكر الشاعر أبا نواس (198ه/813م)، وإنّما يكنّي عنه بنقص العقل ويكتفى بوصفه بأنّه "أحد من جرّبه (ويقصد الحبّ) وأكثر القول فيه والوصف له". ولعلّ مبحث الحبّ والعشق دون منزلة المؤلّف وهو فقيه، وكذلك دون منزلة المتلقّي، وهو سلطان، وإذن فإنّ منزلة القائل دونهما معا خاصّة والأمر يتعلّق بشاعر شاع عنه أنّه لاه عابث ماجن كأبي نواس. على أنّ هذا التفسير - وإن كان يمتلك قدرا من الوجاهة في مثال كالذي سبق- فإنّه لا ينطبق على كثير من الشواهد الشعريّة الأخرى التي لا يذكر فيها الأديب السلطانيّ اسم الشاعر حتّى إن كان هذا القائل في مكانة أبي الأسود الدؤلي (69هـ/688م) الذي جمع فضائل التابعيّ والفقيه والمحدّث والنحويّ وصاحب الإمام عليّ بن أبي طالب (40هـ/661م). فالماوردي يستشهد بشعره مكتفيا بعبارة "نّقال آخر" [الطويل]:
تَعَـــوَّدْتُ مَسَّ الضَّرِّ حَـــتَّى أَلِــفْتُــــــــهُ وَأَسْلَمَني مُرُّ اللَّيَــــــــــالِي إِلَى الصَّبْــــــــرِ
وَوَسَّعَ صَدْرِي لِلْأَذَى كَثْرَةُ الْأَذَى وَقَدْ كُنْتُ أَحْيَانًا يَضِيقُ بِهِ صَدْرِي[48]
ومن جهة أخرى، لا يجد المؤلّف غضاضة في نسبة هذين البيتين إلى الخليفة عثمان بن عفّان (35هــ/656م): [الكامل]
وَإِذَا غَنِيتَ فَلَا تَكُنْ بَطِــــــرًا وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَتِهْ عَلَى الدَّهْرِ
وَاصْبِرْ فَلَسْتَ بِوَاجِدٍ خُلُقًا أَدْنَى إِلَى فَـــــــــــــرَجٍ مِنَ الصَّبْرِ[49]
في حين أنّ أغلب المصادر تنسبهما إلى محمد بن جرير الطبري (310هــ/923م).
كما أنّ الشيزري ينسب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب أبياتا يكتنف الغموض والاختلاف قائلها: [السريع]
مَنْ حَاوَلَ النِّعْمَةَ بِالشُّكْرِ لَمْ يَخْشَ عَلَى النِّعْمَةِ مَا اغْتَالَهَا
لَوْ شَكَــــــرُوا النِّعْمَةَ زَادَتْــــــــــهُمُ مَقَالَـــــــــــــــةَ اللهِ الَّتِي قَالَهــــــَا
لَئِنْ شَكَـــــــــــرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكــــــــــُمْ لَكِنَّ أَكْفَــــــــــــــرَكُمْ غَالَهــــــــَا
وَالْكُفْـــــرُ بِالنِّعْــــــمَةِ يَدْعُو إِلَى زَوَالِهَـــــــا وَالشُّكْرُ أَبْقَى لَهَــــــا[50]
كيف نفسّر هذا التردّد بين الإفصاح عن الاسم وحجبه ونسبة شعر إلى غير صاحبه؟ من الصعب الاطمئنان تماما إلى أيٍّ من التفسيرات السابقة، وإن كانت مجتمعةً يمكن أن ترجّح ميل الأديب السلطانيّ إلى مثل هذا الضرب من الاستشهاد؛ لأنّ الشعر ظلّ يمتلك سطوة على النفوس وقدرة على التأثير، رغم الاعتقاد الشائع بأنّ الذائقة الأدبيّة قد تحوّلت عنه إلى غيره من أصناف القول.
ونضيف إلى ذلك أنّ الغرض الأساسيّ من التدوين في هذا الباب، إنّما هو تحصين المملكة ودوام الملك لا التوثيق. كما أنّ التوجّه إلى السلطان بالخطاب المباشر لا يقتضي ترصّد مسالك القول؛ لأنّ قيمة الشعر تكمن في مضمونه إضافة إلى قيمته الفنّيّة، وهو ما يحتاج إليه الفقيه خلال مسار الحجاج. ولا يجب أن نتغافل عن خصائص الطابع الشفويّ الغالب على كثير من الأبواب، ويظهر ذلك خاصّة في استخدام بعض العبارات على غرار (أنشدني) و(حدّثني) و(خطب) و(قيل) وغيرها. وهي مشافهة لا تحفل بالتفاصيل بقدر ما تركّز على تكثيف المعنى بغرض التأثير والإقناع.
الخاتمة
على الرغم مما يبدو من خصومة الفقيه مع الشعر والشعراء، فإنّ حضور القوافي كان لافتاً، بل طاغياً في بعض مؤلّفات الآداب السلطانيّة، وهي خصومة تستند إلى تفسيرات لا نجد لها وجاهة مطلقة في النصّ القرآني، وتعتمد على أقوال منسوبة إلى الرسول (ص) تصنَّف باعتبارها ضعيفة ومنكرة. وتتجلّى هذه الخصومة الظاهرة في الإعراض عن نسبة الشعر إلى قائله، واستسهال نسبة الشعر إلى غير قائله.
لكنّ هذا التعامل مع النصّ الشعريّ لا نجد له صدى حقيقيّا في متون هذه المؤلّفات؛ بمعنى أنّ الفقيه السلطانيّ لا يجد أيّ حرج في التعامل مع النصوص الشعريّة من مشارب مختلفة ولشعراء من عصور شتّى ومن مدارس شعريّة متمايزة.
إنّ الفقيه يقف أمام خزّان من الحِكم التي تتميّز بكثافة المعنى وإيجاز العبارة، وهو ما لا يمكن الاستغناء عنه، فيجد نفسه مشدودا إلى هذا الديوان عاجزا عن الإفلات من سطوته، فهو في حالات كثيرة لا يجد بديلا لما ينطوي عليه الشعر من مضامين ولا سيّما في الأبواب المتعلّقة بالمثُـل والقيم الأخلاقيّة. وهكذا ظلّ الشعر ملجأ للفقيه يفتنه فينقاد ويسحره فيستجيب. وينتهي الأمر بالفقيه الذي كان لحظة البدء محذّرا من الشاعر مقرّعا له إلى طرف منبهر بنصّه مأسور ببيانه واقع تحت سلطانه، بل لم يعد الشاعر عنصر "غواية" للعامّة فحسب، وإنّما للفقيه أيضا. واستحال قرآن إبليس إلى مصدر معرفة وحكمة يرد منه الفقيه على قدر ظمئه دون تعالٍ أو حرج.
قائمة المصادر والمراجع
*- القرآن الكريم
- البخاري، محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع الصحيح (الشهير بـ: صحيح البخاري)، تح، محمّد زهير بن ناصر الناصر، بيروت، دار طوق النجاة، ط1، 2001، ج8
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، الجامع لشعب الإيمان، تح، مختار أحمد الندوي، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 2003. ج7
- التوحيدي، أبو حيّان، الإمتاع والمؤانسة، تحقيق، أحمد أمين، أحمد الزين، بيروت، دار مكتبة الحياة، د.ت، ج3
- الثعالبي، أبو منصور، آداب الملوك، تحقيق، جليل العطيّة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1990
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تح، عبد السلام محمّد هارون، بيروت، دار الجيل، د.ت، ج4
- ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي، الديوان، تح، فردوس نور علي حسين، القاهرة، دار الفضيلة، د.ت.
- ابن حنبل، أحمد، مسند ابن حنبل، تح، شعيب الأرناؤوط، محمّد نعيم العرقسوسي، إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، بيروت، مؤسّسة الرسالة، ط1، 1999، ج28
- ابن رشيق، الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، محمّد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الجيل، ط5، 1981، ج1
- ابن رضوان المالقي، أبو القاسم، الشهب اللامعة في السياسة النافعة، تح، علي سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1984
- الشافعي، محمّد بن إدريس، الديوان، تح محمّد عبد المنعم خفاجي، القاهرة، مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، ط2، 1985
- أبو شامة المقدسيّ، عبد الرحمان بن إسماعيل، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، تعليق، إبراهيم شمس الدين، بيروت، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، ط1، 2002
- الشيزري (عبد الرحمان): النهج المسلوك في سياسة الملوك، تحقيق: محمد أحمد دمج، بيروت، مؤسسة بحسون، دار المنال، ط1، 1994
- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، أعيان العصر وأعوان النصر، تح، علي أبو زيد، نبيل أبو عشمة، محمّد موعد، محمود سالم محمّد، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ط1، 1998، ج4
- الغزالي، أبو حامد، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، تح: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط1، 1988
- الغزالي، أبو حامد، الديوان، تح، أحمد الطويلي، تونس، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، ط1، 2011
- ابن قتيبة، أبو محمّد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، تونس، ليبيا، الدار العربيّة للكتاب، ط3، 1983، ج1.
- ابن قدامة، أبو محمّد عبد الله بن أحمد، المغني، تح، محمود عبد الوهاب فايد، مصر، مكتبة القاهرة، 1970، ج10
- القرطبي، أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السنّة وآي الفرقان، الشهير بـ(تفسير القرطبي)، تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي، كامل محمّد الخرّاط، غياث الحاج أحمد، بيروت، مؤسّسة الرسالة، ط1، 2006، ج18.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، نصيحة الملوك، تح الشيخ خضر محمّد خضر، الكويت، مكتبة الفلاح، ط1، 1983.
- المبرّد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، بيروت، مؤسّسة المعارف، د.ت، ج2
- المرادي الحضرمي، أبو بكر محمد بن الحسن، الإشارة في تدبير الإمارة، تح، محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط1، 2003
- الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط1، 1991، مج2
- الشاعر، صالح، المختارات الشعريّة للإمام أبي حامد الغزالي من كتابه (إحياء علوم الدين)، القاهرة، مكتبة مدبولي الصغير، 2009
- ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسيّة للنشر، 1984، جج19/23
- العاني، سامي مكّي، الإسلام والشعر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، عدد66، 1983
- ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط5، 1992، ج6
- الموسوعة الفقهيّة، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، ط1، 1992، ج26
[1]- يمكن على سبيل المثال مراجعة كتاب، العاني، سامي مكّي، الإسلام والشعر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، عدد66، 1983
[2] - هذه الآيات هي: ﴿أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِـشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾، سورة الصافّات، الآية36، ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾، سورة الأنبياء، الآية5، ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ﴾، سورة الطور، الآية30، ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، سورة الحاقّة، الآيات40-43
[3] - ﴿والشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ سورة الشعراء، الآيات 224-227
[4] - ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ﴾ سورة الصافّات، الآية69
[5] - ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسيّة للنشر، 1984، 19/209. ويمتدّ شرح ابن عاشور للآيات المذكورة من الصفحة 207 حتّى الصفحة 212
[6] - سورة يس، الآية69
[7]- ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 23/63
[8]- البخاري، محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع الصحيح (الشهير بـ: صحيح البخاري)، تح، محمّد زهير بن ناصر الناصر، بيروت، دار طوق النجاة، ط1، 2001، 8/36، الحديث رقم 6154
[9]- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، الجامع لشعب الإيمان، تح، مختار أحمد الندوي، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 2003، 7/104، الحديث رقم 4737. ويردف المؤلّف هذا القول بآخر روته عائشة حيث قالت: "كان الشعر أبغض الحديث إلى النبيّ (ص)". المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
[10]- ابن حنبل، أحمد، مسند ابن حنبل، تح، شعيب الأرناؤوط، محمّد نعيم العرقسوسي، إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، بيروت، مؤسّسة الرسالة، ط1، 1999، 28/356-357، الحديث رقم 17134
[11]- القرطبي، أبو عبد الله محمّد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السنّة وآي الفرقان، الشهير بـ(تفسير القرطبي)، تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي، كامل محمّد الخرّاط، غياث الحاج أحمد، بيروت، مؤسّسة الرسالة، ط1، 2006، 18/511
[12]- من الأمثلة على ذلك أنّ أبا حامد الغزالي وضع الباب الثالث من كتابه "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" (في ذكر الكتّاب وآدابهم)، والباب الخامس (في الحكمة وما قالته الحكماء)، والباب السادس (في شرف العقل والعقلاء)، أمّا عبد الرحمان بن نصر الشيزري فقد عقد الباب الثاني من كتابه "النهج المسلوك في سياسة الملوك" لـ(بيان فضل الأدب وافتقار الملك إليه)، وخصّص الباب الثالث لـ(معرفة قواعد الأدب)، والباب الثاني عشر لـ(ذكر أدب صحبة الملوك).
[13]- من بين الشعراء الذين مدحوا صلاح الدين مهنّئين بانتصاراته ومحرّضين على مواصلة القتال وتحرير كلّ الأراضي الواقعة تحت سيطرة الصليبيّين يمكن أن نذكر، سعادة بن عبدالله الحمصيّ الضرير (591هـ/1195م)، وعماد الدين الكاتب (597هـ/1201م)، وفتيان الشاغوري (615هـ/1218) إضافة إلى أسامة بن منقذ.
[14]- أسامة بن منقذ (488هـ/1095م-584هـ/1188م)، أمير وفارس من بني منقذ، شاعر وأديب ورحّالة، خاض حروبا كثيرة ضدّ الصليبيّين، من أشهر مؤلّفاته (كتاب الاعتبار)، انظر، أبو شامة المقدسيّ، عبد الرحمان بن إسماعيل، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، تعليق، إبراهيم شمس الدين، بيروت، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، ط1، 2002، 4/35، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط1، 1991، مج2، ص100 وما بعدها.
[15]- راجع، ابن رشيق، الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، محمّد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الجيل، ط5، 1981، 1/65.
[16]- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تح، عبد السلام محمّد هارون، بيروت، دار الجيل، د.ت، 4/83
[17]- المصدر نفسه، 1/241، والتكسّب بالشعر ليس ظاهرة حديثة، إذ يذكر ابن رشيق أنّ النابغة الذبياني (604م) هو أوّل شاعر "مدح الملوك[...] فسقطت منزلته". ومن الشعراء الجاهليّين الذين اتّخذوا الشعر وسيلة للارتزاق زهير بن أبي سُلمى (609م) والأعشى (625م). انظر، ابن رشيق، العمدة، 1/80-81
[18]- ابن قدامة، أبو محمّد عبد الله بن أحمد، المغني، تح، محمود عبد الوهاب فايد، مصر، مكتبة القاهرة، 1970، 10/158.
[19]- الموسوعة الفقهيّة، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، ط1، 1992، 26/115
[20]- الشافعي، محمّد بن إدريس، الديوان، تح محمّد عبد المنعم خفاجي، القاهرة، مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، ط2، 1985، ص60
[21]- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، أعيان العصر وأعوان النصر، تح، علي أبو زيد، نبيل أبو عشمة، محمّد موعد، محمود سالم محمّد، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ط1، 1998، 4/69
[22]- ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي، الديوان، تح، فردوس نور علي حسين، القاهرة، دار الفضيلة، د.ت، ص142
[23]- راجع، الشاعر، صالح، المختارات الشعريّة للإمام أبي حامد الغزالي من كتابه (إحياء علوم الدين)، القاهرة، مكتبة مدبولي الصغير، 2009
[24]- الغزالي، أبو حامد، الديوان، تح، أحمد الطويلي، تونس، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، ط1، 2011
[25]- الغزالي، أبو حامد، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، تح: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلميّة، ط1، 1988، ص90
[26]- الشيزري (عبد الرحمان): النهج المسلوك في سياسة الملوك، تحقيق: محمد أحمد دمج، بيروت، مؤسسة بحسون، دار المنال، ط1، صص62-63
[27]- تجدر الإشارة إلى تفاوت بين الأدباء في الاعتماد على المدوّنة الشعريّة العربيّة، من ذلك مثلا أنّ الشيزري والماوردي قد ضمّنا كتابيهما (النهج المسلوك) و(نصيحة الملوك) عددا كبيرا من الشواهد الشعريّة، في حين أنّنا نكاد لا نعثر سوى على بضعة أبيات في كتاب نظام الملك (سير الملوك).
[28]- من المفيد الإشارة إلى أنّ الاكتفاء باستحضار الشعر دون الشاعر أمر درجت عليه كتب التراث العربيّ شأن كتب الأخبار. بل إنّنا نجد الظاهرة نفسها في كثير من كتب الأمثال، وحتّى في كتب الأدب كذلك، وإن بدرجة أقلّ. يمكن أن تراجع على سبيل المثال، الثعالبي، أبو منصور، التمثيل والمحاضرة، تحقيق، صلاح الدين الهواري، صيدا، بيروت، المكتبة العصريّة، ط1، 2011، ص293، ابن قتيبة، أبو محمّد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، تونس، ليبيا، الدار العربيّة للكتاب، ط3، 1983، 1/228. وكذلك، المبرّد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، بيروت، مؤسّسة المعارف، د.ت، 2/18، وكذلك، التوحيدي، أبو حيّان، الإمتاع والمؤانسة، تحقيق، أحمد أمين، أحمد الزين، بيروت، دار مكتبة الحياة، د.ت، 3/50-51
[29]- المقصود بالإشارة الآيات الكريمة "وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ*" (سورة الشعراء، الآيات 224-225-226).
[30]- يستثني الله من الغاوين الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول تعالى: ﴿والشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (سورة الشعراء، الآيات 224-227).
[31]- التجميش أي المغازلة، انظر، ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط5، 1992، 6/275، مادة (جمش).
[32]- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، نصيحة الملوك، تح الشيخ خضر محمّد خضر، الكويت، مكتبة الفلاح، ط1، 1983، ص169.
[33]- المصدر نفسه، ص128
[34]- المصدر نفسه، صص128-129
[35]- المصدر نفسه، ص127
[36]- الشيزري، النهج المسلوك، ص 163-166
[37]- الماوردي، نصيحة الملوك، ص173
[38]- المرادي الحضرمي، أبو بكر محمد بن الحسن، الإشارة في تدبير الإمارة، تح، محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط1، 2003، ص30. وهذا البيت استدلّ به الماوردي، ونسبه إلى طرفة بن العبد (569م)، انظر، الماوردي، نصيحة الملوك، ص131
[39]- الماوردي، نصيحة الملوك، ص64؛ إذ يكتفي بقول: "وقال آخر".
[40]- المصدر نفسه، ص182. وقد ورد البيت على هذا النحو.
[41]- المصدر نفسه، ص181
[42]- المصدر نفسه، ص175
[43]- المصدر نفسه، ص240. وفي بعض المصادر يرد البيت على النحو التالي: وَمَن يَجعَلِ المَعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ يَفِرهُ وَمَن لا يَتَّقِ الشَتمَ يُشتَمِ
[44]- ابن رضوان المالقي، أبو القاسم، الشهب اللامعة في السياسة النافعة، تح، علي سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1984، ص104. والبيتان للشاعر العبّاسي إبراهيم بن العبّاس الصولي (243هـ/857م).
[45]- الماوردي، نصيحة الملوك، ص143. والبيت الذي يليه: وإلاّ فَقُلْ لا، تسترحْ وتُرِحْ بها لِئلاَّ تقـول النـاسُ إنك كاذبُ. وهما للشاعر العبّاسيّ محمّد بن حازم الباهليّ (195هـ/810م).
[46]- نظام الملك، سير الملوك، ص9 من مقدّمة المحقّق.
[47]- الماوردي، نصيحة الملوك، ص57. والأبيات الثلاثة لأبي نواس.
[48]- المصدر نفسه، ص59
[49]- المصدر نفسه، ص 146
[50]- الشيزري، النهج المسلوك، ص136. ونشير إلى أنّنالم نعثر على هذه الأبيات في ديوان عليّ.