الفكر السياسي الإسلامي في ضيافة الليفيتان: قراءة في كتاب حسن فراث
فئة : قراءات في كتب
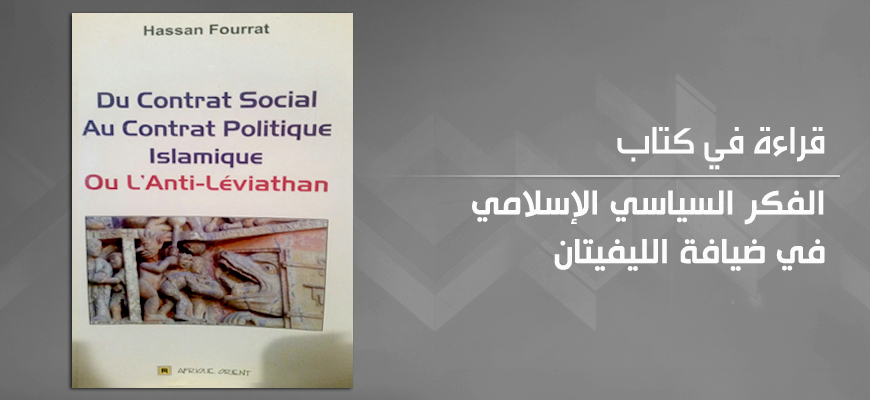
الفكر السياسي الإسلامي في ضيافة الليفيتان
قراءة في كتاب حسن فراث([1])
عنوان الكتاب:
Du contrat social au contrat politique islamique, ou L’anti-léviathan
المؤلف: حسن فورات
دار النشر: Afrique orient / Casablanca
الطبعة: 1، سنة 2015م
سيجدُ المهتم بالفكر السياسي الإسلامي المعاصر، في كتاب حسن فرات، من العقد الاجتماعي إلى العقد السياسي الإسلامي، ما يُفيده في رسم صورةٍ معقولةٍ لمسارات هذا الفكر، لمنطلقاته النظرية، ورهاناته الاستراتيجية والسياسية؛ بل ولطموحاته الوجودية، كما لأعطابه، ومفارقاته الذاتية، ومحدوديته النظرية.
يُريد الرجلُ لكتابه، أن يكون قولًا مجددًا في العقد السياسي الإسلامي، يتجاوز عثرات التصور الحداثي، لمفهوم العقد الاجتماعي، على نحو ما تبلور عند فلاسفة التعاقد، منذ القرن السابع عشر في أروبا، في الآن ذاته، الذي يجُبّ فيه هفوات الذين سبقوه، من مجددي القول الإسلامي والعربي في السياسة، لاسيما منهم؛ أولئك الذين صدروا عن مقدماتٍ حداثيةٍ، لم يتردد الباحث في الإعراب عن امتعاضه منها، وعن انزعاجه من حضورها المزمن في خطاب الفكر السياسي العربي المعاصر، لذلك؛ ينبغي التنبيهُ، إلى أن الكتابَ يتقدمُ إلى مشهد الفكر السياسي، في صورة برنامجٍ دعويٍ، يقومُ على أساس نقد الاختيار الحداثي، وتشخيص أورامه القاتلة: التي جعلت الإنسان الغربي، يعيش أزمةً، صدع كثيرٌ من فلاسفة ما بعد الحداثة بضرورة جبهها، من أجل استرجاع المعنى الأصيل للإنسان، كما للوجود الذي سقط في طي النسيان، على حد قول هيدجر. ويبدو أن ما يميز مقاربة فراث من غيرها، من مقاربات مفكري الاختيار الإسلامي في السياسة؛ انطلاقه من نقد الفكر السياسي الحديث، بدلًا من الاكتفاء ببلورة نظرية في السياسة، من داخل قواعد التراث السياسي الإسلامي، على نحو ما جرت عليه عادة مجددي القول الإسلامي في السياسة، في الفكر المغربي المعاصر.
تتجاورُ، في كتاب فرات، مفاهيمٌ ومرجعيات، خرجت من جوف سياقاتٍ، تاريخية وفكرية مختلفة؛ بل ومتقابلة في كثير من الأحيان، بلغ التقابل ذاك ذروته، عندما صارت رؤية الكاتب محكومة، برمتها، بثنائياتٍ منغلقة؛ كثنائية العقد السياسي/ الميثاق الإسلامي، النسيان/ التذكر، الإيمان/ العقل، الخلافة/ الدولة المدنية، الدين/ العلمنة والإلحاد، وهو، بذلك، يُكرس خضوع الفكر السياسي الإسلامي لهذه الثنايات، بما يستتبعُه ذلك من تعميقٍ للمفارقات الحاكمة للوعي السياسي الإسلامي، والمكرسة لغربته عن مكتسبات الفكر الحديث من جهة، وعن واقعه المأزوم من جهة ثانية. اقتضى الدفاع عن الاختيار الإسلامي من فرات، إنجاز نقد مزدوجٍ للمرجعيات المتاحة أمام الفكر السياسي الإسلامي، اليوم؛ مرجعيةُ التراث الليبرالي، كما جسدته فكرة التعاقد في صيغتها الكلاسيكية، وكما في مناولتها المعاصرة مع رولز، ومرجعية القراءات العربية الحداثية للدولة والسياسة، ولعله يشير، بذلك، إلى دعاة الدولة المدنية، المتحمسين للاختيار الحداثي في مجال الاجتماع السياسي.
لا مرية في أن حيزًا كبيرًا من قيمةِ مقاربة فرات، يكمنُ في النقد الذي شَهَرتهُ في وجه الحداثة السياسية، طالما أن ذلك، يمكن أن يفسر الطابع الباهت لنقده مقالةَ الدولة المدنية، عند كبار ممثليها في الخطاب العربي المعاصر؛ من لطفي السيد، إلى عبد الله العروي، وعلي أومليل، وغسان سلامة، انطلاقًا من القول: إن نقد أسسها، وتسفيه منتحليها، يقضي بفساد فكرتها بالضرورة، لذلك؛ لم يكتف الرجل بالتبشير بدولة إسلامية، ولا هو ادعى تقديمَ نظريةٍ فيها؛ إنما انصرف إلى البحث في أساس الاجتماع السياسي، إلى الميثاق الذي يقوم عليه كل شيء (190)، فكان أن خاض مواجهته مع الآخر، على جبهة الحداثة السياسية، خلافًا لكثير من دعاة الاختيار الإسلامي؛ الذين اكتفوا بالتأصيل لمفهوم الدولة الإسلامية، من داخل دوائر التراث السياسي الإسلامي.
أ- سيكون من باب مجانبة الصواب، القولُ: إن كتاب فرات، مجرد مقالة في السياسة؛ بل إنه، في ظني، قولٌ في الحداثة وموقفنا منها. ينضح توصيفه للحداثة الغربية، بمعالم رفضٍ مهووسٍ بوجهها المتوحش؛ فهي قرينة العلمنة، أفرغت الإنسان من بُعده الروحي والديني، بترته من وجوده الأصيل، وكرست تَيْههُ وغربتَه في عالمٍ لا يفهمه، وزادتْ غفلته عن هم التناهي المحدد لمعنى الكينونة حدةً؛ بل إن الحداثة اقترنت، عندنا، نحن بالاستعمار، ومحنتنا التاريخية معه، من الطبيعي أن يجد فرات، في نقد نيتشه وهيدجر وفوكو، منبعًا، ينتهل منه كثيرًا من عناصر نقده للحداثة الغربية؛ بل ومن المفهوم، أيضًا، أن يستدعي استراتيجية التفكيك، لمواجهة فكرة العقد الاجتماعي، والكشف عن مفارقاتها وأعطابها، طالما أن الاستراتيجية تلك، سليلة النقد الجذري للميتافيزيقا الغربية، الذي يمتد؛ من نيتشه إلى فوكو ودريدا، مرورًا بهيدجر وآراندت، بذلك، يكون فراث قد أدرج نقده للعقل السياسي الغربي، ضمن الإطار العام لمراجعة الفكر المعاصر لتراثه الحداثي؛ تراث العقلانية الأنوارية، ومشروع السلم الدائم، والتحرر من الاستبداد، بفضل دولة الحق، وهو المشروع الذي انكسرت طموحاته على شط مطلع القرن العشرين، باندلاع الحرب العالمية الأولى، وتصاعد الأنظمة الشمولية[2]، واكتساح الجماهير وثقافتها الفضاء العام[3].
ينبغي أن ننتبه، إلى أن لهذا الاختيار أسبابُ نزولٍ تُفسره؛ التقاطعُ الظاهري بين موقف فرات من الحداثة الغربية، وموقف هؤلاء الفلاسفة منها أولًا، وتوظيفُه لنقدهم على نحوٍ يخدمُ أغراضه ثانيًا. نقول: إن تقاطعًا ظاهريًّا، يجمعُ بين الكاتب ونقاد الحداثة، جعله يُقدم الحداثة للقارئ العربي، في صورة مآلٍ كئيبٍ، انتهى إليه الإنسان الغربي؛ فاستحقت، بذلك، ما طالها من نقد وتسفيه من خصومها[4]، الأمر الذي يبرر لنا القول، نحن الذين لم نتجرع بعد ما يكفينا من عقلانيتها: إن في الحداثة من الأعطاب، ما يدفعنا إلى تنكبها، ويُجنبنُا شرورها، التي يتخبط فيها أهلها، ولم يجدوا للإفلات منها سبيلًا، "وهكذا، تكون الحداثة قد أورثتْ أهلَ الغرب، ضعفًا روحيًّا فاحشًا، على قدر هذه القوة المادية الساحقة"[5]. وعندما يتعلق الأمر بالوجه السياسي للحداثة؛ فإن الأمر يصبح أكثر خطورةً؛ إذ نُقدم الحداثة السياسية في صورة خطرٍ ما يزال يهدّد الإنسانية، بعد أن فعل فعله في الغرب، لذلك؛ لا يكتفي الكتاب بالإعلان عن رهان معرفي صرف، ينهض به، وهو: رهان التقعيد والتأصيل المعرفي، للاختيار الإسلامي في مجال السياسة؛ بل يُقدم نفسه في صورة مُخَلصٍ يضطلع بدورٍ رسوليٍ، لإنقاذ الحداثة السياسية الغربية من تيهها الأصيل والجذري، ومن الشر السياسي، الذي قامت عليه فرضية حالة الطبيعة الوهنة، ومن ضعف الإيمان الذي فتح الباب، إبان أفولِ العصورِ الوسطى، أمام تصاعد النزعات الوضعية المتنكرة للدين (64)، وإنقاذ العالم العربي من مأزقه السياسي؛ الذي استفحل عقب أحداث الربيع العربي، التي زادت تيه الوعي السياسي الإسلامي حدةً، كل ذلك، جعل من عقد كتاب فرات مسألة عاجلة؛ بل وضرورية، ونقرأ له في هذا المعرض، قوله: "ومهما يكن من أمر؛ فإن العدول عن العقد الاجتماعي إلى العقد المدني، غدا من منظورنا، أمرًا عاجلًا؛ بل ومُلِحًّا، إن لم نقل ضروريًّا. يتعلقُ الأمر باختزال العقد الاجتماعي، ورده إلى بعده الحقيقي، الذي ما كان عليه أن ينقطع عنه مطلقًا.
نهجر، بذلك، النسخة، لنتصل بالأصل من جديد، ونخرج من المتعدد، حيث تتيهُ خطوات الإنسانية، لنعود إلى الوحدة، إلى الواحد" (40). واضحٌ أن الخروجَ من أفق العقد الاجتماعي، والحداثة السياسية برمتها، يبقى شرطًا قبليًّا لتحقيق الميثاق الإسلامي، غير أن ذلك لا يتم إلا برد عقل، المتعدد والمختلف، إلى الوحدة والواحد؛ أي بردّ مجال السياسة[6]، إلى مجال الإيمان والعقيدة، وفرات مؤمنٌ حتى النخاع، وهذا من حقه، بأن سبيل الواحد هو منقذنا من الضلال، وأن المتعدد أقرب إلى المُهلكات التي أنستنا هم تناهينا.
ولم يكن صدفةً؛ أن يجد في حسرة هيدجر على تواري، هم التناهي والموت من الأزمنة المعاصرة، وفي امتعاض شتروس من غفلة هوبس عن هذه الحقيقة الأصلية، ولهثه وراء حالة الطبيعة وقانونها، ما يُقيم به الدليل على أن سبيل العقد الاجتماعي، كانت سبيلًا ضل أصحابها، وأضلونا نحنُ، عندما اقتفينا أثر الدولة المدنية في صيغتها الحداثية، وعندما تناسينا أن الحداثة كانت، عندنا، قرينة الاستعمار، لذلك؛ يبشرنا الكاتب بأزوف ساعة ميثاقٍ إسلاميٍ، يهدينا إلى وجودنا الأصيل، وينجينا من مُهلكات الحداثة السياسية، كما فن واقع حالنا السياسي؛ المرفوض معياريًّا، والمفروض بمقتضى التبعية والحداثة الجارفة.
ب- لا نُبالغ إذ نقول: إن كتاب حسن فرات، ينتمي إلى دائرة ما، كان أركون يسميه "إيديولوجيا المواجهة" (83)؛ فهو يتموقع في دائرة الـ"نحن"، لمواجهة الـ"هُم"، ويختارُ موقعَ نقد الآخر، وتسفيه منجزاته على مستوى الحداثة السياسية، لكن من داخل موقع "الأنا" الإسلامية الأصيلة، كما جسدها الميثاق القرآني العابر للتاريخ، والمتعالي على الزمن، وهو ميثاق الذر الذي جمع الله بالبشرية جمعاء، وكانت الشهادة علامته الفارقة، وهو، بذلك، يتقدم إلى مشهد الفكر العربي، في صورة ناقدٍ للحداثة الغربية، مُتبرمٍ من المنظور الذي فرضته على الوعي الإسلامي، كلما حاول مقاربة ذاته وتاريخه، والداعي إلى الافلات من قبضة المركزية الغربية، ونظرتها السلبية إلينا. نقرأ له، في هذا المقام، قولَهُ: "بقبولنا منظورَ الغير؛ فإننا نقبل، كذلك، ما يؤسس هذا المنظور؛ عقله، وروحه وثقافته، وتكوينه الجينيالوجي، وتاريخه الشخصي الخاص به (خطابه، وكلماته، وتمثله للأشياء، وإيبستيمه [الخاص به]. إننا ننظر إلى أنفسنا، في نهاية المطاف، انطلاقًا من تاريخ الغير؛ بل إننا نكتب خطابات عن أنفسنا، انطلاقًا من لغته، إنه لمن الأسهل والمناسب لنا: أن ننظر إلى أنفسنا، وإلى الغير، انطلاقاً من تاريخنا الخاص، من باراديغمنا، كما من تصورنا لأشياء العالم، بما نملكه من كلمات ولغةٍ خاصةٍ بنا" (91).
يكفي هذا الموقفُ، مبدئيًّا على الأقل، لاتخاذ مسافةٍ نقديةٍ، (إن لم نقل سلبية)، من التراث السياسي للحداثة الغربية، ومن باب الإنصاف، القول: إن الرغبة التي يصدر عنها فرات، في نقده ذاك، تكشف عن طموح مشروع في تحصيل أسباب الاستقلال عن الآخر، والقطع مع مظاهر تبعيتنا له، لذلك؛ لا يعسر على القارئ في كتابه، أن ينتبه إلى أنه؛ استمراريةٌ لنقد طه عبد الرحمن للحداثة الغربية، ولكن هذه المرة على مستوى نقد وجهها السياسي، ويحضر عند فراث، كما عند طه، هاجسُ الاستقلال عن الآخر، عن الغرب، بما يستلزمه ذلك من انخراطٍ في موجة نقد التراث الغربي، والعقل الثاوي في تضاعيفه، كما يحضرُ، عندهما، هاجسُ الارتفاع بالأمة الإسلامية، إلى مستوى الأمة الفاعلة، المحصلة لأسباب الإبداع، والانخراط القوي والفعال في الحداثة والكونية، من دون تضحية بالخصوصية[7]؛ بل ويصدر فراث عن المنظور الأخلاقي والمعياري نفسه، الذي أقام عليه طه نقده للحداثة الغربية، وتمييزه بين روحها وواقعها[8]، لذلك؛ نجده يضفي على مفاهيم سياسيةٍ، وأخلاقيةٍ، ومعرفيةٍ، في أساسها، طابعًا دينيًّا، قد لا يُناسب، دائمًا، مقاصدها السياسية، وكثافتها الأنطولوجية؛ بل ويمكن أن نتفهم، انطلاقًا من هذا المعطى، سبب تجاهل فراث لأهمية التاريخ، واستلاله للمفاهيم السياسية، كما لو أنها نبتتْ صدفةً خارج سياقاته، ولا يعني هذا؛ أن الباحث لا يحتفل، مطلقًا، بالسياقات التي خرجت من رحمها مفاهيم العقد الاجتماعي، غير أنه ينسف مفعولها التأويلي، عندما يكتفي بإظهار المضمون الديني لفكرة العقد عند هوبس (50)، وكأن مشكلة هوبس، يمكن أن نختصرها، كلها، في مجرد استقدامه مفهومًا كثيف الدلالة الدينية (الليفياتان)، وتأسيس نظرية في السياسة على مقتضياته، وتتضح غفلة فراث عن التاريخ، كلما انتقلنا من لحظة قراءته للفكر الغربي، صوب مناولته للفكر السياسي الإسلامي، عندها يختار تطليق التاريخ وصراعاته نهائيًّا، بحثًا عن ميثاق الذر؛ الذي حصل في لحظة سرمدية، سرعان ما يعود ليطل منها على أحداث التاريخ من جديد.
كان من المفترض، بدل الانزلاق بسؤال التراث الليبرالي، إلى إشكاليةٍ أعم؛ هي إشكالية نقد العقل الغربي في تيار ما بعد الحداثة، أن يتعقب فراث نقده للحداثة السياسية، في متون الفكر السياسي المعاصر، وتأويلاته الفسيحة لليبرالية[9]، عند جون ديوي، كما عند رولز، وهارت، ودروكين، وصن، وعند هابرماس ومدرسته، كما عند ساندكولر، والفلسفة العبر- ثقافية (transculturelle)، التي أعادت قراءة التراث السياسي الغربي، وزجت به في أتون الانفتاح على السياقات الثقافية؛ بل وعند مدرسة التعددية الثقافية، مع تايلر وكميلكا، كما عند فلاسفة القانون المحدثين، منذ كلسن وشميث، إلى بيرلمان ومدرسته.
لو انفتح الكاتب على هذه المتون؛ لأدرك أن التراث السياسي الليبرالي، ليس على هذا القدر من العقم والدوغمائية (70)، وأنه فتح آفاقًا كبيرةً أمام الوعي السياسي الغربي، عندما دفعهُ إلى التفكير في الوجود السياسي للإنسان، من مدخل العدالة، والحق، والحرية، والدولة، وأن مراجعات الفكر الغربي المعاصر لتراثه الليبرالي، لم يكن دعوةً إلى التنكر لمنجزاته، بقدر ما كان تعميقًا لمفارقاته، وتكريسًا لمكتسباته. هذا ما كشفت عنه أعمال روزانفلان، التي حاولت فهم تلك المفارقات، من طريق تحليل دقيقٍ لعملية تشكل مفاهيم الليبرالية ومآلاتها، من خلال تحليل نموذج الديمقراطية، وتشكله التاريخي والمفاهيمي في التجربة الفرنسية[10]، وهذا ما من شأنه أن ينبهنا؛ إلى أن مفاهيم الفلسفة السياسية، ليست مفاهيما مجردة تتعالى على التاريخ، وتتناسل على مستوى الذهن؛ إنما هي سليلة التاريخ ومخاضاته، لذلك؛ لا يكفي التحليل المنطقي واللغوي وحده في فهمها، وإنما ينبغي أن نقرأها على ضوء تاريخيتها، وهذا، تحديدًا، ما لم يراعه فراث كثيرًا في كتابه، وتعامله مع ثنائية المعرفة والجهل عند رولز، خير دليل على ذلك.
يتكلم الفيلسوف الأمريكي عن حجاب الجهل[11]، التجاهل أو الغفلة، في إشارة منه إلى شرط قبلي للوضع الأصلي، يكون الأفراد، بمقتضاه، في تجاهل لكل الاعتبارات غير السياسية، التي يمكن أن توجه تأسيس اجتماعهم السياسي، من قبيل الدين والعرق، حتى يتسنى له بناءُ المجالِ السياسي، من حيث هو مجالٌ متمايز عن هذه الاعتبارات، ومحكوم بالعلاقة بين الدولة والمواطن، ولكن فراث يربط الجهل، هنا، بالتناهي: الذي يشرط الحالة الإنسانية، متسائلًا عما إذا كان حجاب الغفلة، يشمل مسألة التناهي والموت أم لا؟ (81)، والملاحظة عينها تنطبقُ على تعامله مع مفاهيم هيدجر؛ كمفهوم الوجود، والتناهي، والموت، عندما عمد إلى إفراغها من بعدها الأنطولوجي، وشحنها بحمولةٍ دينيةٍ، مجافيةٍ لمعناها الأصيل عند هذا الفيلسوف. هل كان هذا الانزلاقُ في التأويل مجردَ عرضٍ طرأَ على قراءة فراث؟ لا يبدو أن الأمر على هذا القدر من البساطة؛ فأينما ولّينا وجهنا في صفحات الكتاب، باغتتنا هذه التأويلات الدينية لمفاهيم العقل الغربي؛ السياسية منها، كما الأنطولوجية والتاريخية، وليس مردُ ذلك إلى تضخم الهاجس الديني في ذهن الكاتب فقط؛ بل، أيضًا، إلى إهماله تاريخيةَ المفاهيم، التي أقدم على تأويلها، ولعل تعامله مع مفهوم العقد الاجتماعي، الذي كان سليل مخاضٍ سياسيٍ وتاريخيٍ عسير، يبقى الدليل الأوقع على ذلك.
ج- يُعلنُ فرات عن موقفه النقدي من فكرة العقد الاجتماعي، ولا يتردد في اعتبارها من أمارات انزلاق الحداثة السياسية، صوب الهيمنة على الإنسان، وإخضاعه لمقتضيات الترويض والتنميط، مستدعيًا لتعضيد رأيه، هذا نقد فوكو، للدولة والسلطة، في زمن الحداثة، علاوةً على ما قاله نيتشه عن الدولة، من حيث هي: تجسيدٌ لإرادة الإخضاع والقهر (27). يُموقع الباحثُ نقده للعقد الاجتماعي، في خانة نقد هذين الفيلسوفين للسلطة والدولة، ويدفع به صوب بيان فساد فكرة العقد، من وجوه ثلاثة؛ قيامُها على فرضية وهمية، لا وجود لها في التاريخ الفعلي (الوقائعي)، وعدمُ مطابقة العقد الاجتماعي لمقتضيات العقد المدني وانتقائيتُه إزاءها، طابعُه الأحادي؛ الناجم عن نَفَسه اللاديني (الملحد)، الذي يجعله غير قابل للانعقاد مع الآخر المتدين (المؤمن) (28). ليس هذا النقد إلا تعبيرًا عن موقفه المبدئي من العقل الغربي الميال، في اعتقاده، إلى التقسيم والاختلاف والتجزيء، والنابذ للوحدة والواحد (27). من حق الباحث: أن يستلهم نقد أي فيلسوفٍ غربيٍ، لدعم تصوره هو، لكن ذلك لا ينبغي أن يتم بمعزل عن الرهانات والمقاصد، التي حكمت فكر هؤلاء وغابت، بمقتضى الشرط التاريخي والسياسي، عن أفق فراث، نيتشه وفوكو، سليلَيْ النقد الغربي، لوعيٍ تشبع بقيم العقل والعقلانية، وحديثُ أولهما عن هدم الأصنام وأفولها، عن الإنسان الأعلى وإرادة القوة، لم يكن في باب الهروب من الواقع والشرط الإنسانيين؛ بل كان صيحةً في وجه عقلانيةٍ صارمةٍ، أحكمتْ قبضتها على الوعي والوجود معًا، لذلك؛ كان تقويضها عمليةً تتم من داخل دوائر العقل الغربي نفسه، وليس بالانسحاب من تاريخه، لذلك؛ كانت الجينيالوجيا، عودةً ترمي إلى الكشف عن إرادة القوة. والملاحظة عينُها، يمكن أن تقال عن أركيولوجيا فوكو؛ التي زجت بالفلسفة في مدارات التاريخ والأرشيف، بحثًا عن الوجه المتوحش للحقيقة، على نحو ما أفرزها العقل الغربي، في مختلف مستوياته ومتمفصلاتها؛ في الجنون (الحُمقة)، كما في الجنس والانهمام بالذات، وفي المراقبة والعقاب، وعلاقة الحقيقة بالسلطة، ...إلخ، ولو استلهم فراث منطق نقد فوكو للسلطة، ولو بحث في علاقة الحقيقة بالسلطة، في التجربة السياسية الإسلامية، ولو استنطق أرشيف العقاب (كُتب المحن، وكُتب الفتن، وموسوعةُ العذاب في الإسلام، ...إلخ)، وكتب الرقابة (الحسبة)، والضريبة (الخراج)، لو فكر في سيرورة إنتاج المعنى داخل دوائر السلطة، في التجربة السياسية الإسلامية، ..إلخ، لتبين له: أن قيمة عمل فوكو، لا تنحصرُ في ما أنجزه من تبرمٍ من منظور العقل الغربي؛ بل في ما تمدنا به كتاباتُه من آلياتٍ، لفهم إعضالات تراثنا السياسي.
إني أُلح على هذه المسألة؛ لأنها تشكل، في اعتقادي، جوهر معضلة علاقتنا بمتون نقد الحداثة الغربية عمومًا، والسياسية، منها، على وجه التحديد؛ فكلما زدنا تعرفًا على متون الفكر الغربي وعقلانيته، إلّا زادنا ذلك إمعانًا في اللاعقل. كلما تعرفنا أكثر على نماذج معاصرة في السياسة، والدولة، وتدبير السلطة، إلا وتضخم، شقاءً وعينًا، بسبب شعور بالمسافة التاريخية، التي تفصل تجربتنا نحن، في الماضي كما في الحاضر، عن تجارب الغرب في هذا الشأن، نقارن بين منظومة الحقوق هنا وهناك، وبين مستوى الحرية، وممارسة الفعل السلطوي؛ فيغشانا الغُبن من هول الفارق القائم، وبدلًا من تشخيص الأعطاب الاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، التي لا تزال تكبل تحديث اجتماعنا السياسي، نلهث وراء نموذج ما انفك يغرينا، وكأننا لا نتعلم من دروس التاريخ مطلقًا.
يقرأُ المرء كتاب فراث فيتيه في المفارقات، هل يتعلق الأمر بفكر استوعب منطق العقل السياسي الغربي، وكتب بلغة من لغاته، أم بموقفٍ عبّر عن أزمة وعيٍ شقيٍ، بالتاريخ والراهن، بمفاهيمِ قاموسٍ ينتمي إلى ذلك العقل نفسه؟ يدعونا الباحث إلى الانطلاق من ذاتنا، ومن تجربتنا، لكنه يفكر فيها من داخل مفارقات، يطرحها علينا الفكر الغربي نفسه. هل يكفي الانزواء إلى الذات، إلى (الأنا) و (النحن)، لمواجهة نموذجٍ في الحداثة السياسية، بات يتقدم إلى مشهد جغرافيا السياسة في صورة النموذج الكوني؟ هل يكفي أن نغلق أبوابنا في وجه قوته الجارفة، ونتعامى عن درس التاريخ الحديث، في اليابان، والهند، والصين، ومصر، والمغرب، منذ القرن الثامن عشر، وما تمخض عن صدمة اللقاء بالغرب، من تمزقات على مستوى الذهن والفعل معًا[12]؟ هل يكفي استقدام مفاهيم من اللحظة التأسيسية الرمزية، من عهد ميتافيزيقي يتعالى على المكان والزمان لمحو مكتسبات الحداثة السياسية والقفز عليها؟ "إن عبارات الرفض تجاه الثقافة الغربية، لا يمكن أن تشكل ثقافة، بحد ذاتها، والشطحات على آثار الذات السليبة، لا تعيدها إلى الحياة"[13]، وعندي: أن كتاب الأستاذ فرات، يدخل في هذا الباب، تحديدًا؛ فهو لا يرى، تحت وطأة هوسه بالتحرر (73)، في الحداثة السياسية، إلّا نسيانًا للمعنى الأصيل للوجود، لكنه يتعامى عن كثير من مكتسباتها الكونية؛ عن دفاعها عن حقوق الإنسان، ودولة المواطنة والحق. صحيحٌ أنه قد يعلن، هذا الطرف أو ذاك، نقده لهذه المكتسبات بين الفينة والأخرى[14]، في هذا المكان أو ذاك، لكن مَنْ مِن هؤلاء يقبل بأن يضحي بمبادئ تلك الحقوق ونسفها من أُسسها؟ إن خطورة هذه المواقف السلبية من الفكر السياسي، الحديث والمعاصر، تكمن في الصورة الحالكة التي ترسمها عنه في ذهن المتلقي العربي؛ فتكون النتيجة مزيدًا من الإمعان في التشرنق على الذات، والانسحاب من مدارات الثقافة الكونية، والتنكر لمكتسباتها، التي لم نظفر بعد بما يكفينا منها.
ثانياً: في تأويل تراثنا السياسي
ينقلنا الكتابُ، كما يوحي بذلك عنوانه، من مقام العقد الاجتماعي، في صيغته الحداثية، إلى مقام العقد السياسي الإسلامي، وهذا يعني؛ أن رغبةً جامحةً في التأسيس لعقدٍ/ ميثاقٍ سياسيٍ إسلامي، تحكمُ وعي الكاتب.
ملاحظتي الأولى على فكرة "العقد السياسي الإسلامي": أنها تعيد إلى الأذهان طموح الإسلام السياسي، وما يعضد قولي هذا، النفَسَ الدَعَوِي للكتاب؛ الذي يُخرجه من دائرة البحث الأكاديمي، عندما يُقدم الميثاق الإسلامي كبديلٍ يجُب كل مكتسبات العقد الاجتماعي، ويطوي صفحته. يشعر القارئ أن ما يرمي إليه فراث؛ هو إثباتُ وجود علاقة تلازم بين الإسلام، كإيمان وعقيدة، والسياسة، وهو، بذلك، لا يحتفل بالتقابل الحاصل بين طرفيْ المعادلة؛ الإسلام والسياسة[15]؛ بل ويمضي قدمًا في طريق البحث عن أُسسٍ دينية للسياسة، من داخل اللحظة التأسيسية التي جسدها ميثاق الذر، تحت وطأة شح النص القرآني، على مستوى النصوص المقعدة للأحكام السياسية (الأحكامُ السلطانيةُ بلغة الماوردي). ملاحظتي الثانية على العنوان: أنه يرسم صورةً حالكةً عن التقليد الغربي الحديث، عندما يقدم الكتاب على شكل انقلابٍ عليه، كما يُشتمُ من مفهوم L’anti-Léviathan؛ إذ الخلافةُ، كما يصفها الكاتب: نظامٌ مثالي، قادر على تكرار مشهد ميثاق الذر، عبر مختلف فترات التاريخ وحقبه، من خلال تجسيده في مؤسسات النظام السياسي والاجتماعي (164)؛ فلا غرابة أن يجد فيه جوابًا عن مختلف الأسئلة المقلقة، التي ما انفك الواقع، السياسي والاجتماعي، يطرحها على الوعي السياسي الإسلامي، وهذا ما يمثل "انتكاسةً" على مستوى تلقي الوعي العربي، الحديث والمعاصر، لمنظومة الفكر الغربي عامةً، والليبرالي منه على وجه التحديد؛ فإلى أي حدٍ يمكنُ القولُ: إن نظام الخلافة، كما قدمهُ فراث، قادرٌ على تجاوز أعطاب الحداثة السياسية؟ وهل يُمكن أن نرسيَ عليه دعائم مفهومٍ للدولة، يستجيبُ لمقتضيات وإكراهات وضعنا التاريخي والسياسي المأزوم؟
أ- رغم تبرم فراث من تقديم نظرية في الدولة الإسلامية؛ فإن دعوته إلى التقعيد للاجتماع السياسي الإسلامي، على مقتضى ميثاق الذر، يكشف عن مقاصده ورهاناته في هذا الباب؛ فهو لم يكتف بنقد التراث الغربي السياسي؛ وإنما دعا إلى إعادة قراءة التجربة السياسية الإسلامية، على ضوء ذلك الميثاق، ولم يكن مرجعه، في هذا النقد، التجربة السياسية الإسلامية، التي وصفتها كتب التاريخ، والفقه السياسي، والفلسفة، والآداب السلطانية؛ إنما النص القرآني وآياته، التي كان عليه أن يخوض غمار تأويلها من جديدٍ، قصد تعقبِ آثار الميثاق الأصلي، الذي أسقطه التاريخ في طي النسيان، وسيكون علينا أن ننتبه، إلى أن الكاتب أسس تصوره للخلافة، على اعتبارها تجسيدًا لهذا الميثاق الأصيل؛ فهي عهدٌ بين الخليفة والمؤمنين، يتجاوزُ الأغراض الدنيوية للسياسة المادية الحديثة، ويربط الموجود بالواجد؛ فيخضع عالم الإمكان لمنطق الضرورة والمطلق، ويكرر نفسه في مشهد التاريخ؛ فيجسد اختراق الميثاق الأصيل، للزمن والوجود معًا (164)، وقد وجد في نموذج إمارة المؤمنين، في التجربة السياسية المغربية، ما يُقيم به الدليل على نجاح مثل هذا النموذج الديني في الحكم، كما يلاحظ الباحث: أن القرآن كان شحيحًا، فيما يتعلق بأحكام السياسة والدولة، لكن ذلك لم يدفعه إلى المضي قدمًا، في تعقب ما سيفرزه التاريخ السياسي من مصادر أخرى للتشريع والتسويغ (La justification)؛ من سُنةٍ، وإجماع، وفقهٍ؛ إنما فضل القفز على الزمن، والعودة إلى اللحظة التأسيسية الرمزية التي جمعت الله بالبشرية جمعاء، في ميثاقٍ شهد به الجميع، وسرد القرآن كثيرًا من تفاصيله.
بذلك يكون للسكوت القرآني عن الأحكام السياسية، دلالتُه السياسية في نظر فراث؛ فهو نصٌ يربط الإنسان بالله، ويُخرجه من تيْه سؤال التناهي والجهل، ليجدَ بذلك حلًّا لمشكلة الجهل؛ التي شكلت أس مشكلة العقد الاجتماعي الحديث، في نظره، ونلاحظُ أن إعمال مفهوم الجهل/الغفلة، هنا، كان بقدر من "الاشتراك في الاسم"؛ فالجهل، عند رولز، ليس محصورًا في بعده الديني قسرًا، والغفلة عن هم التناهي، عند هيدجر، لا تتخذ دلالةً دينيةً؛ إنما أنطولوجية، لها صلةٌ بتصوره الخاص للإنسان والوجود، في حين أن الشهادة، التي يُفصح عنها ميثاق الذر، تُعرب عن معرفة الإنسان بالله وحقيقة الوجود، فتُحدد وجوده، من حيث هو؛ عبدٌ يسعى إلى خلاصه الفردي في الدار الآخرة، وفراث لا يتردد في القول: إن خلاص الفرد ومصيره الأخروي، يأتي قبل الهم السياسي، من منظور الدين الإسلامي (138)، مما يضعنا أمام تصور قبل سياسي للسياسة (Pré-politique)؛ بل ومعادٍ للسياسة، أيضًا، (antipolitique).
لقد فطن فقهاء السياسة، منذ الماوردي، إلى هذا التخارج بين الهم الديني الأخروي، والأغراض الدنيوية في السياسة؛ فجعلوا الإمامة "موضوعةً لحراسة الدين، وسياسة الدنيا"، على حد تعبير هذا الفقيه[16]؛ بل وانتهى بعضهم إلى حصر معنى السياسة، في عملية تدبير أهل الإسلام، كما هي الحال عند ابن جماعة، يعني هذا؛ أن السياسة فعلٌ، الغايةُ منه تدبير مصالح الدنيا وصراعاتها، إنها: فن تدبير الممكن وتقديم التنازلات؛ لذلك تجد نفسها عاجزةً، كلما حاولنا جرها إلى مجال الضرورة والمطلق، فكيف يمكن أن ندعي تأسيسها على ميثاقٍ سرمديٍ، يكرر نفسه في التاريخ، ويجعل منه مجالًا ثابتًا ومطلقًا؛ بل ويصهر مسؤولية الفعل السياسي في تبعية العبد لله؟ أولًا: يفتح هذا البابَ أمام نسف فكرة الفعل السياسي، من حيثُ هو فعلٌ حر، قوامه؛ التعددية، والاختلاف، والمبادرة، يصنع مستقبل الجماعة، ويتحمل مسؤولية مآلاتها، ألا يُكرس ذلك فينا ثقافة الاتكال والانسحاب، بدلًا من تحفيزنا على التشبع بثقافة الفعل والمبادرة والمسؤولية؟
ب- تضعُنا الإجابة عن هذه الأسئلة، في صلبِ إشكالية علاقة السياسي بالديني، التي بدا موقفُ فراث بديهيًّا إزاءها في كتابه؛ فهو يصطف إلى جانب من يعتقدون، بأن الشريعة هي سبب وجود الدولة في الإسلام (185)، وينظر إلى الخلافة، كدولة دينية تجمع بين الخليفة والمؤمنين، محكومة بهاجس الإيمان؛ الذي صار، عنده، مقياسًا لقياس مدى مشروعية النظام السياسي، ومقبولية سلطة الخليفة (189). أجدُ، شخصيًّا، صعوبةً في فهم ما يرمي إليه الكاتبُ بهذا القول؛ كيف يمكن قياس مشروعية الدولة بمعيار الإيمان؟ من ذا الذي له الحق في تحديد معيار صارم ومضبوط لمفهوم الإيمان؟ وعلى أي أساسٍ سنبني السلطة، من حيث هي حقٌ في الأمر، وجدلية صراعٍ بين الحق والواجب، عندما سنجعل من الإيمان مصدر المواطنة ومقياسها، بدلًا من الحق والواجب؟ ألا يُعيدنا ذلك إلى زمن الحق والتفويض الإلهيين؟ وبأي معنى يمكن اعتبار مؤسسات الدولة تجسيدًا لهذا الإيمان؟ أوليس من الأفضل لتلك المؤسسات؛ أن تتسم بالحياد تجاه العقيدة والإيمان، ضمانًا للحق في التعدد والاختلاف، واستيعاباً لمختلف أشكال الصراع التي تقتضيها سيرورة تطور الاجتماع السياسي، وأيلولته إلى وضعية التعدد الثقافي؟
تتضحُ خطورةُ هذه الأسئلة، عندما نستحضرُ الصراع المرير الذي خاضته الفلسفة السياسية الحديثة، مع فكرة التفويض الإلهي، ومتى استحضرنا، أيضًا، ما جره إقحامُ الدين في السياسة، وتحويله إلى آلية لتبرير صراعاتها، على التجربة السياسية للمسلمين؛ فهمنا مقدارَ حاجتنا الملحة إلى إعادة ترتيب أوضاع تلك العلاقة، على مُقتضى التمييز بين طرفيها، واحترام المنطق الخاص الحاكم لكل واحدٍ منهما، والغريبُ: أن يُعرض الباحث عن كل هذه المعطيات التاريخية، وأن يقدم تجربة الخلفاء الراشدين في صورةٍ مثاليةٍ، تكادُ أن تخلوَ من أية إشارة إلى ما نضحت به فترتها من صراعاتٍ سياسيةٍ، بدأت باندلاع حروب "الردة"، وانتهت بطعن عمر بن الخطاب، ومقتل عثمان بن عفان، واشتعال فتيل الفتنة الكبرى[17]، والأنكى من ذلك كله: أن يذهب الباحثُ إلى أمثلة تلك الحقبة، بأن يطابق بينها وبين قدسية القول القرآني؛ فيستشهد بآياتٍ تثبتُ قدسيتَه وتعاليه في سياق دفاعه عن نظام الخلافة (169/173)؛ بل إن "النجاح التاريخي" لنموذج الخلافة، والذي تأتى من قرب الخلفاء الراشدين من الوحي وحقيقته، يفرض علينا أن نُحاكي هذا النموذج ونرنو إليه (137)، الأمرُ الذي يجعلُ مشهدَ التاريخ، خارج مدارات الزمن السياسي، زمن العفوية واللاتوقع والقابلية للخطأ، لذلك؛ وجب التنبيه إلى أن فهم فراث للسياسة، يبقى فهمًا غير سياسيٍ في جوهره؛ فالذاتُ الفاعلة في الزمن، الصانعة للتاريخ، تندثر من قاموس الباحث، ليحل محلها الإنسان العبدُ، المذعنُ والمتكل على ما قُضي وتقررَ في الأزل؛ فأي معنى يتبقى للفعل السياسي، في حضرة هذه الذات المنسحبة من التاريخ والمنصهرة في المطلق؟
لا شك في أن أمثَلة مرحلة الخلافة الرشيدة، تبقى من مقتضيات التصور الإسلاموي للسياسة[18]، غير أن "حالة" فراث، تبعث على كثير من الاستغراب؛ فنحن لسنا أمام باحثٍ عديم الصلة بالثقافة النقدية ومستجداتها، والمجهود الكبير الذي بذله في رسم صورة بهية عن تلك الحقبة، يشي بأنه كان على بينة من أمر المأزق المعرفي؛ الذي يضع فيه نفسه، عندما يقدم على تجاهل معطيات التاريخ الوقائعي، بحثًا منه عن صورةٍ مثاليةٍ تنُعش آماله في التأسيس لميثاق إسلامي، وهو بخطوته هذه، يبقى وفيًّا للرؤية المعيارية التي صدر عنها، والتي تُعرض كليًّا عن الإنصات للتاريخ، وتقفز عليه صوب لحظة سرمدية متعالية عنه، ومتى أقدم الباحث على استقراء مسار تفاعل الفكر السياسي الإسلامي، مع وقائع التاريخ، انتبه إلى أن التاريخ في الإسلام، كان عصارة السياسة، أكثر مما كان تجليًّا من تجليات ميثاق الذر، وفهم سبب إلحاح كبار الباحثين في الفكر السياسي الإسلامي، عربًا ومستشرقين، على اعتبار التاريخ مُختبرًا للنظريات السياسية، التي بلورها أهل النظر السياسي في الإسلام بمختلف مشاربهم؛ بل وسيدرِك، ذاك الباحثُ، أن انفتاح فقهاء السياسة على الواقع السياسي وطوارئه، كما هي الحال عند أبي يوسف القاضي، والماوردي، والجويني، وابن تيمية، كان بسبب وعيهم المأزوم، بأن للسياسة منطقًا يجافي كل نزعةٍ إرادوية أو طوباوية[19].
خاتمة: يُمثل كتاب فراث، منعطفًا في مسار الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، وهو بمقدار ما يُعرب عن آمال هذا الفكر وهواجسه، وبمقدار ما يتشبث بمقدماته وثوابه؛ فإنه يمضي بعيدًا في تكريس مفارقات الإسلام السياسي، وتضخيم أوهامه، ولعل الجديد في الكتاب، تشبُعه بموقف طه عبد الرحمن، على مستوى؛ نقد الحداثة، والاختيار الديني والأخلاقي، بما يقتضيه ذلك من مراجعةٍ للعقلانية الغربية، واستنجادٍ بالمواقف الناقدة لها في الفكر الغربي المعاصر، وهو يضعنا، بذلك، في صلب مأزق صلتنا بالغرب وعقلانيته، ويستفز وعينا للحسم في مآل هذه الصلة.
يتقدم الغربُ إلى مشهدِ وعينا، في صورة نموذجٍ في الحداثة السياسية، استطاع فرض نفسه بمنطق القوة حينًا، والمنفعة أحيانًا، والكونية في أحايين أخرى، خَلْف الدولة الحديثة، يثوي منطق عقلانيٌ[20]، يقتضي استقدامُه خلخلة كثيرٍ من ثوابت التقاليد السياسية، الراسخة عندنا؛ مأْسسةُ الدولة بدَلًا من شخْصنتها، وصهرِها في إرادة الحاكم، والتمييزُ بين الشرعية والمشروعية، والارتفاع بالإنسان ليصيرَ منبع الحقوق، بدَلًا من النظر إليه كرعية، وبالتالي؛ اعتباره ذاتًا قائمة الوجود، وهنا، الحاجة إلى فكرة الحق الطبيعي، والنظرُ إلى العدالة، من حيث هي إنصافٌ (رولز)، ودفْعٌ لمظاهر الجور (أمارتيا صن)، بدلًا من اعتبارها مجرد تنزيلٍ لمقولاتٍ متعالية على الإنسان، تُطبقُ عليه من دون مراعاة طبيعته، وشرطه الإنساني: اعتبارُ المواطنة هويةً سياسيةً للأفراد، بدلًا من الروابط العصبوية، الحاكمة للاجتماع السياسي العربي الإسلامي، بما يقتضيه ذلك من وعي بحجم المعيقات، التي يطرحها هذا التشكل التاريخي لاجتماعنا السياسي، وهو: الوعي بتمفصلات علاقة السياسي بالديني في تجربتنا التاريخية، والانطلاق منها لتحديد موقفنا من حضور الدين في السياسة، بدلاً من اللهاثِ وراء أوهامٍ يزيدُنا تضخمُها غربةً عن الواقع.
هذا ما يمكن أن نستفيده من درس الحداثة السياسية الغربية، وهو الدرس الذي يبغضه خصومها، ولكن ما العملُ، إذا كان الدرس ذاك شرًّا لابد منه؟ ألا يكون الوعي بالأوهام، أول خطوة في طريق الانسلال من قبضتها؟
[1]- Hassan Fourrat, Du contrat social au contrat politique islamique, ou L’anti-léviathan, Casablanca, Afrique orient, 2015.
[2]- H, Arendt,la philosophie de l’existence, Paris, Payot, 2015, p 316.
[3]- خوسه أوتيغا إي غاسيت، تمرد الجماهير، ترجمة: علي غبراهيم أشقر، بيروت؛ دار التكوين، 2011م، ص 48.
[4]- J, Habermas, Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1988, p 397.
[5]- طه عبد الرحمن، روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، بيروت؛ المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2013م، ص 57.
[6]- H, Arendt, qu’est ce que la politique?, Paris, Seuil, 1995, p 31.
[7]- طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 2009م، ص 27.
[8]- طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص 55.
[9]- Catrine Audard, qu’est ce que le libéralisme ? Etique, Politique, Société, Paris, Gallimard, 2009, p 269.
[10]- P, Rosanvallon, Le sacre du citoyen, Paris, 1992, p 511.
[11]- يُفضل الأستاذ محمد هاشمي استعمال عبارة حجاب الجهل، كمقابلٍ للعبارة الإنجليزية veil of ignorance، وقد أورد في شأن تعريفه، وفق معجم مصطلحات جون رولز؛ الذي أعده صامويل فريمان، ما يلي: "حجاب الجهل: هو شرط حيادي صارم للاختيار في إطار الوضعية البدئية؛ حيث يجهل أطراف التوافق الحقائق الجزئية، المتعلقة بهم وبمجتمعاتهم، كما لا يعرفون وضعيتهم الطبقية، ولا عرقهم، أو دينهم، أو إثنيتهم التي ينتمون إليها، ولا جنسهم، ولا تصورهم الخاص للخير، ولا موارد مجتمعهم أو تاريخه؛ إنما يعرفون، فقط، حقائق حول الطبيعة الإنسانية العامة، والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية". انظر: محمد هاشمي، نظرية العدالة عند جون رولز، دارتبقال، البيضاء، 2015م، ص 303.
[12]- عبد الله العروي، الإيديولوجيا العربية المعاصرة، بيروت؛ المركز الثقافي العربي، 1999م، ص 35.
[13]- المصدر نفسه، ص 86.
[14]- نقد حنة آرندت لمفهوم حقوق الإنسان، يبقى خير مثال على ذلك؛ فهي ترى أن الإنسان الذي تتحدث عنه تلك الحقوق، غير قابل لأن يتجسد على أرض الواقع، لكن من يمكنه أن يزعم؛ أنها أنكرت قيمة المبادئ التي بنيت عليها منظومة تلك الحقوق؟ أو أنها دعت إلى نسف أسسها الإنسانية؛ من حرية، وحق في التعددية والاختلاف؟
[15]- انظر في شأن هذا التقابل: عبد الإله بلقزيز، الإسلام والسياسة؛ دور الحركات الإسلامية في صوغ المجال السياسي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2001م، ص 13.
[16]- الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 5.
[17]- راجع، تحليلًا لهذا الموضوع: عبد الإله بلقزيز، الفتنة والانقسام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2012م.
[18]- محمد جبرون، مفهوم الدولة الإسلامية؛ أزمة الأسس وحتمية الحداثة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، بيروت، 2014م، ص 18.
[19]- انظر تحليلًا لموقف فقهاء السياسة: نبيل فازيو، دولةُ الفقهاء؛ بحث في الفكر السياسي الإسلامي، منتدى المعارف، بيروت، 2015م.
[20]- عبد الله العروي، مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة السابعة، 2001م، ص 69.






