الفلسفة فنّ للعيش قراءة في كتاب "التّداوي بالفلسفة" لسعيد ناشيد
فئة : قراءات في كتب
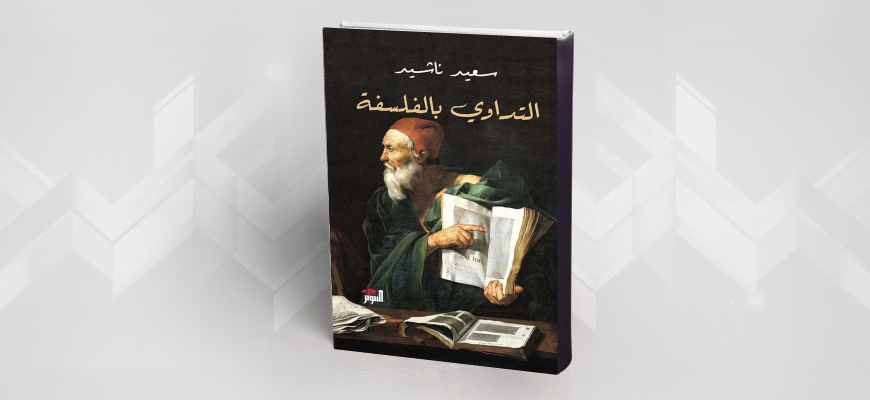
الفلسفة فنّ للعيش[1]
قراءة في كتاب "التّداوي بالفلسفة" لسعيد ناشيد
"الفلسفة مواجهة مفتوحة ضدّ الوهم الذي يلازم العقل، وضد الشقاء الذي يلازم الحياة، وضد العنف الذي يلازم الحياة المشتركة".[2]
يُمَثِّلُ كتاب "التداوي بالفلسفة" فرادة في التأليف العربي، سواء من جهة شكل الكتاب، أو من جهة مضمونه؛ فهو من جهة الشكل يخرج عن التقاليد الأكاديمية وما تفترضه من تبويب وتقسيم وإغراق في الإحالات المرجعية، وفي ذلك كلفة على الكاتب والقارئ على حدّ السواء، ولعل هذا الفضل كما يشير صاحبه في مقدمة الكتاب يعود إلى أساتذة التعليم الجامعي الذين لم يرحّبوا به بالدراسات العليا، فجعل كتابه هدية إليهم. أما من جهة الموضوع، فهو ينظر في مواضيع من صميم فلسفة اليومي، وهو رهان سبق أن طرقه فلاسفة كبار من حجم فولتير وجيل دولوز، وهو ما تشهد عليه مقالات الكتاب من نظر في الحب والأمل والشيخوخة والموت والملل والجسد وغيرها من المواضيع التي تشغل الناس في يومهم، وهم يقاسون عوادي الزمان ونوائب الدهر، غير أن الكاتب لا يعيد إنتاج بداهات الحسّ المشترك إزاء هذه الموضوعات التي طرقها، وإنما يعمل على تفكيكها، والكشف عن اللامفكر فيها، مستعينا بتاريخ الفلسفة الذي هو تاريخ العقل والتنوير والحكمة، ضدّا على تاريخ الجهل والظلام والتفاهة، مستحضرا في ذلك حِكم أبيقور، ومحاورات أفلاطون، وشذرات فريدريك نتشه، وخواطر آلان، فضلا عن نصوص جيل دولوز وباروخ سبينوزا وآخرين.
لا شك أن الفلسفة فنّ للعيش وأسلوب للحياة، وهو ما تحقق لدى كثير من الفلاسفة، إلى درجة أن واحدا من الفلاسفة المعاصرين، وهو بيير أدو كتب كتابا بعنوان: "الفلسفة باعتبارها طريقة للعيش"[3]، لكن ألا يثير عنوان الكتاب الشبهات؟ ألا يوحي التداوي بالفلسفة التداوي بالأعشاب؟ أطرح هذا السؤال، وقد وجدت أن بعض المحسوبين على الفلسفة اختلطت عليهم الأمور، ولم يستسيغوا عنوان الكتاب، ولو تدبّروا في متنه لكان لهم رأي آخر. لكن إذا كان هذا هو الانطباع الذي يُخَلِّفُهُ عنوان الكتاب لدى المتخصص والمحسوب على الفلسفة رأسا، فماذا سيكون بالنسبة إلى عموم الناس؟ ألن يختلط عليهم بـ "الرقية الشرعية" أو ما جاورها؟ أليس العنوان الذي اخترناه لمقالنا أنسب للكتاب، مادامت الفلسفة فنّا للحياة وأسلوبا للعيش، وهو ما يظهر بوضوح في المقالات التي تشكل متن الكتاب؟ وكيف يمكن للفلسفة أن تكون أسلوبا للحياة وطريقة في العيش؟ كيف لها أن تكون تداويا وعلاجا؟ وما مدى فعالية هذا العلاج؟
ينطوي كتاب "التداوي بالفلسفة" على أطروحة أساس، مفادها أن دور الفلسفة لا ينحصر في فهم النصوص الفلسفية فحسب، بل دورها الرئيس هو فهم الحياة وإبداع أسلوب لعيش متحرر من أوهام البذخ والرفاهية والسلطة. إنها، إذن، دعوة لعيش حياة بسيطة يتصالح فيها الإنسان مع ذاته، ويعي قدراته، ويقبل قَدَره، دون مقارنة بينه وبين الآخرين؛ إن رهان الكتاب، باختصار، هو كيف تكون أنت ما ذا تريد وليس ما يريده لك الآخرون؟ أنت واحد، والآخرون كثر؛ ومن ثمة فطريقك نحو السعادة هو طريق من إبداعك أنت، ولا يملى عليك قط من طرف الآخرين؛ أي أولئك الذين تختلف طرائق عيشهم باختلاف إمكاناتهم وقدراتهم وأنظارهم ومعتقداتهم...إلخ.
إن مهمة الفلسفة، على سبيل الاختصار، تعليم الحياة وليس حفظ نصوص الفلاسفة والتباهي بعرضها على الرغم من أهميتها؛ إذ لا معنى للفلسفة دون حل إشكالات الحياة الفعلية التي نحياها؛ ومن لم تسعفه الفلسفة في حل ما يتخبط فيه من مشاكل الحياة، فوجب أن يعيد النظر في طريقة تحصيله للفلسفة[4]؛ فلا معنى للفلسفة دون ثلاث من ركائزها: الحكمة والتأمل والتفلسف[5]؛ ذلك أن غض الطرف عنها يبعدنا عن الفلسفة وعن الحياة على حد السواء؛ فما معنى الحياة دون محبة الحكمة واقتفاء أثرها؟ وهل يقوم لها معنى دون التأمل فيها؟ أ وليست الحكمة والتأمل هما طريقانا نحو حياة فلسفية؟
أن نعيش على نحو فلسفي إذن، معناه أن نبدع طرائق خاصة في العيش تنأى عن التقليد الذي تكرسه تمثلات الحس المشترك؛ فعادة ما يكون هذا الحس العام والسائد هو علة شقائنا، وفي ذلك يحكي سعيد ناشيد قصة توضح هذا المراد؛ فهذا أحد النبلاء في نهاية القرن السادس عشر، لم ينتصب عضوه الذكري، ولما كان ما وقع له يسمى في التقليد السائد عجزا جنسيا، فقد أقدم النبيل على قطع عضوه؛ فعندما نتدبر في هذه الواقعة تدبر الفلاسفة، نجد أن عدم الانتصاب يمكن أن يكون مرده إلى مسألة عضوية أو نفسية، وهو ما يمكن تجاوزه من خلال استشارة طبيب، أو التخفيف من العمل؛ وهو ما يعني أن العجز على الحقيقة هو العجز عن التحرر من التقليد السائد والحسّ العام، أي العجز عن إبداع أسلوب خاص في العيش، نعبِّر فيه عن فرادتنا، ونقبل فيه بقَدَرِنا، ونتصالح فيه مع إمكاناتنا وأجسادنا؛ إذ ليس هناك من شقاء، كما يؤكد بوثيوس، إلا فيما تُعِدُّه أنت كذلك[6]؛ فَلِمَ، إذاً، الحزن والحقد والغضب، بينما حقيقة الكون، كما يقول عمر الخيام في رباعياته، ليست سوى مجازا؟[7]
بناء على ذلك، فقد كان من رهانات كتاب "التداوي بالفلسفة" إعادة الاعتبار للجسد[8]، وهو اعتبار نجده في نصوص فريدريك نتشه وباروخ سبينوزا وموريس ميرلوبونتي...إلخ، ضدّا على الثنائيات الميتافيزيقية بين العقل والجسد، كما نجدها عند أفلاطون أو ديكارت على سبيل الذكر؛ أي تلك الثنائيات التي تجعل العقل يحظى بمنزلة الشرف، بينما الجسد لا يعدو إلا سجنا للروح، أفلاطون نموذجا، أو غشاوة بالنسبة إلى العقل، ديكارت نموذجا؛ وبالتالي فكلما تم عقل جماحه عن الهوى، كلما كان الإنسان عاقلا وراشدا وحكيما؛ كلا، فهذا الطرح الميتافيزيقي للإنسان لا يمثل كينونته في شيء؛ ذلك أن الجسد هو عقلنا الكبير على حد قول فريدريك نتشه، والتفكير هو عمل باليد على حد قول مارتن هايدجر؛ ليس هناك، على سبيل الاختصار، تقابل بين الجسد والعقل، مادام العقل السليم في الجسم السليم؛ إذ كلما حظي الجسد بنظام غذائي متوازن، وأطلق العنان لمشاعر الفرح والمرح، وأخذ قسطا من الراحة دون خمول أو كسل، كلما تحقق ذلك، كان تفكيره أكثر حيوية، وأبلغ تعبير عن الحياة؛ إذ مثلما ليس هناك شيء أعمق من الحياة نفسها، هذه الحياة السيالة والبدالة، فليس هناك بالمثل شيء أعمق من الجسد، مصدر كينونتنا، وآية وجودنا، وعلامة فكرنا؛ ففي البدء كان الجسد، لكن كانت التصورات حوله متعالية، وتنهل من الميثولوجيا. أما وأننا صرنا نحيا في الزمن المعاصر، ونستهدي بمكتسبات الفكر الحديث، فقد آن الأوان لتحرير الجسد، وإطلاق العنان لقواه الخلاقة، لكي يبدع خارج ثنائيات الخير والشر، والطهر والخطيئة، والحق والباطل؛ أي نعم، لقد آن الأوان أن يبدع على شاكلته شعرا أو نثرا أو رقصا أو غناء أو عزفا.
قد لا نتوفق في تغيير الواقع ومجرى الأحداث، لأن قدراتنا الذاتية أو الموضوعية لم تسعفنا، لكن بإمكاننا أن نغير أفكارنا عما وقع وحدث، فنكون بذلك صنعنا لأنفسنا قَدَراً آخر؛ ذلك أن هذا الذي حَدَثَ ولم نستطع إزاءه من حيلة، قد حدث في الماضي؛ فلماذا إذن يعكر علينا صفو الحاضر، وهو أعز ما نملك؟ نعم، إن الأحداث، مهما كان وقعها في النفس، فهي إلى زوال، وكل شيء متوقف على طرائق تفكيرنا؛ إذ كيف نرى الأشياء هي سبب سعادتنا أو علة شقائنا، مادام أقصى ما نملك إزاءها هو أفكارنا عنها؛ إن حياتنا، في المحصلة، هي تأويلنا لهذه الحياة؛ إذ نحن الذين نجعلها سعيدة أو تعيسة، وبالتالي فمن الحكمة اختيار تأويل ينتصر للحياة، مادامت هذه واحدة، وقَدَرُنَا أن نحياها. يجمل سعيد ناشيد ما أتينا على تفصيله في القول: "الوقائع تمحي وتنتفي، ولا تبقى سوى أفكارنا عنها وتأويلنا لها. هذا ما قد يسعدنا أحيانا، وقد يتعسنا أحيانا أخرى".[9]
قد نستغني عن الفلسفة لتحقيق التقدم في الواقع. لكن لا يمكن الاستغناء عن المفاهيم الفلسفية للتفكير في الواقع؛ فهل من الممكن، على سبيل المثال، التفكير في دولة الحق والقانون دون مفهوم فصل السلط لمونتيسكيو؟ وهل يمكن التفكير في الاجتماع البشري دون مفهوم العقد الاجتماعي لجون جاك روسو[10]؟ وهل يمكن الحديث عن العيش المشترك دون مفهوم التسامح كما أصَّل له كلاَّ من فولتير وجون لوك[11]؟[12]؛ هذا ما يجعل من الفلسفة تفكيرا كونيا، ومجالا رحبا، بعيدا عن النزعات المحلية الضيقة التي تذكي نار التعصب، وتشل حركة الفكر، وتنكر الاختلاف، وتعادي الآخر، وتحرِّم الإبداع، وتَحُولُ دون الاجتهاد، أو قل، باختصار، تعادي الفلسفة.[13]
قد يعترض معترض، وله كامل الحق في الاعتراض، كيف يمكن للفلسفة أن تكون دواء، ونحن نعلم أن أهلها المخلصين ألمت بهم نوائب الدهر، من مرض واعتقال وإعدام واعتقال ونفي وإفلاس وجنون؟
الجواب على هذا الاعتراض، هو أن المؤهل لتعليم الناس فن الحياة هو من اكتوى بنارها، وتذوق مرارتها، وفي هذا الصدد نفهم قول فريدريك نتشه: "الوقوع في ضراوة المرض قد يجعل المرء أكثر إقبالا على الحياة بكثافة مما حين يكون معافى ويتمتع بظروف حياة مريحة"[14]؛ فبناء على هذا الطرح، يصير حتى مرض الإنسان مغلوبا على أمره، ما دامت "الضربة التي لا تقتلني، كما يقول فريدريك نتشه، تقويني"[15]؛ أي نعم، فليس المرض مناسبة للشكوى، ولعن الأقدار، وتجنيد الانفعالات الحزينة، وإنما مناسبة للتعلم، تعلم قبول القدر دون زيادة أو نقصان amor fati[16]، وإدراك مدى قدرات الجسد في التحمل، واكتشاف قوى لديك لم يكن لك بها علم من ذي قبل؛ فلا نستغربن إذن، أن جون جاك روسو في كتابه عن التربية أراد أن يعلم ابنه إميل كيف يمرض[17]؟ مادام المرض كما أثبتنا مناسبة حقيقية لتعلم كيف نحيا أصحاء ومعافين ومبتهجين وفرحين ومتصالحين مع ذواتنا وأجسادنا وأقدارنا ومع العالم من حولنا.
لا شك أننا نحيا في عصر أفول السرديات الكبرى، اليمينية منها واليسارية، وهو ما يعني أن الإنسان مهدد بفراغ روحي، والطبيعة، كما يقول أرسطو، تخشى الفراغ، فهل الفلسفة مؤهلة لملء هذا الفراغ المرعب؟ بعبارة أخرى، إذا كانت الأيديولوجيات الخلاصية خيبت آمال الإنسان، وجعلته يعيش في الشقاء، وفريسة لمشاعر الحزن، فهل يمكن للفلسفة أن تكون خلاصا بديلا للإنسان؟
يجيب الكاتب مرة أخرى: نعم؛ وحجته في ذلك أن الأيديولوجيات الخلاصية، اليمينية واليسارية، كانت تَعِد الإنسان بشيئين أساسيين: "سعادة الإنسان وانتصار الخير على الشر"[18]، غير أنها سرعان ما تحولت إلى نزعات شمولية جعلت سعادة الإنسان شقاء، وما يتطلع إليه من خير شرّا مستطيرا؛ إن شر الأيديولوجيات الخلاصية يكمن في الأصل في كونها تعدنا بالآمال الكبرى التي من شأنها أن تخلص الناس مما هم فيه من هَمٍّ وغَمٍّ وكرب وغيرها من المشاعر الحزينة بلغة باروخ سبينوزا، وبينما هم ينتظرون، أيا كان موضوع الانتظار، المهدي، أو المسيح، أو المجتمع الشيوعي...إلخ، فإنهم ينسون الحياة، بل ينسون الحاضر، وهو أعز ما يملك الإنسان، فينعمون في الشقاء؛ وكلما كانت الآمال عظيمة، كان الشقاء أعظم، وهو ما يجعل سعيد ناشيد يعنون أحد مقالات كتاب "التداوي بالفلسفة" بعنوان محكم لا مجال فيه للتشابه، وهو "قد لا نحتاج إلى الأمل"[19]، وفي ذلك يقول: "تعلمنا الحياة أن الاعتراف بانعدام الأمل قد يكون عامل إبداع وتحرر وإثبات للذات. يكفي أن يتصالح المرء مع قَدَرِهِ الخاص من دون أن يقارن قَدَرَهُ مع أقدار الآخرين".[20]
لكن كيف للفلسفة أن تربأ هذا الصدع، وما خلفه في الإنسان المعاصر من خيبة أمل كبيرة جعلته يَعْدِمُ قيم الحياة، ويمجد قيم الموت؟
يجد سعيد ناشيد جوابا في تاريخ الفلسفة، بما هو تاريخ عقل الإنسان الذي يسعى لتجاوز الكبوات لما فيه الخير والسعادة. وفي هذا الصدد، نجد فلاسفة أحدثوا انقلابا داخل النزعات الخلاصية السائدة؛ إذ في الوقت الذي تتأسس فيه هذه النزعات على مشاعر الخوف والحزن والموت، نجد فلاسفة قلبوا هذه القيم وعوضا عنها مجدوا قيم القوة والفرح والمرح والحياة والحب[21]؛ الأهواء المبهجة عند باروخ سبينوزا مقابل الأهواء الحزينة؛ وقوى الحب عند سيغموند فرويد مقابل قوى الموت؛ وغرائز الارتقاء عند نتشه مقابل غرائز الانحطاط.[22]
يتبين إذن، أن الفلسفة هي عنوان الحضارة والمدنية وأساسهما الذي لا تقوم لهما قائمة دونها؛ فكيف للإنسان أن يكون متحضرا ومتمدنا دون فلسفة؟ فهي التي تجعله يعيش على نحو متمدن، فيقبل الاختلاف والنقاش والحجاج؛ لذلك لا نستغربن أن نظام الدولة المدينة كان أحد مقومات نشأة التفكير الفلسفي[23]؛ أي ذلك النظام الذي يتيح للناس حرية الكلام والتداول والمحاججة بخصوص قضايا الشأن العام؛ فما من فكرة أو رأي أو اقتراح، كيفما كان، ومن أي كان، يخضع للسجال والجدال والأخذ والرد، وهو ما يعني تنسيب أفكارنا ومعتقداتنا والقبول بالعيش المشترك الذي لا يعني في نهاية التحليل إلا القبول بالاختلاف، باعتباره سلوكا وفعلا، وليس مجرد شعار في الظاهر وتعصب في الباطن.[24]
تنهض الفلسفة، فضلا عما تقدم، بدور جذري يتمثل في كونها تعلمنا كيف نموت، دون أن يعني ذلك تناقضا مع الدعوة إلى الحياة؛ فقد سئل دريدا في آخر لحظات عمره، وقد بلغ منه المرض مبلغا، فقال: "المهمة الأساسية للفلسفة أن تساعدنا على تقبل الموت كخسارة مطلقة بلا تعويض وعزاء"[25]، وما قول دريدا هذا في الواقع إلا استئناف للدرس السقراطي، وهو القائل: "أن نتفلسف معناه أن نتعلم كيف نموت"[26]، وهو ما استعاده كذلك مونتين في خواطره بالقول: "منتهى الحكمة أن نتعلم كيف نموت"[27]، وهو ما لخصه أبيقور في القول: "الموت لا شيء بالنسبة إلينا، إذ عندما نكون، فالموت لا يكون، وعندما يكون فنحن لا نكون"[28]؛ ولأن الخوف من الموت هو أصل كل المخاوف التي تعكر على الإنسان صفو الحياة، وتجعلها لا تطاق، فإن من وصايا كتاب "التداوي بالفلسفة" التي يبلغ مجموعها عشرة وصايا، تتراوح صيغها بين الأمر والنهي، نجد الوصية الآتية: "لا تخف من الموت"[29]؛ فضلا عن "ليس ضروريا أن تكون مؤمنا أو ملحدا"[30]؛ "وأنت تمارس قناعتك لا تنس أن تسائلها"[31]؛ "ليس الغنى بما تملكه، لكن الغنى بما تستغني عنه"[32]؛ "تحرر من الخوف"[33]؛ "لكي تفكر يجب أن تشك"[34]؛ "احكم نفسك بنفسك"[35]؛ "اجعل ذاتك تحقق نموها"[36]؛ وأخيرا المبدأ الديلفي "اعرف نفسك بنفسك".[37]
يستفاد من الوصايا العشر من كتاب "التداوي بالفلسفة" أن الفلسفة بحق طب للحضارة، وشفاء للجهل، وخلاص للروح، ونور للعقل، وصحة للجسد، ومعرفة للذات، ومقاومة للملل والضجر والخوف...إلخ. إنها علاج، في المحصلة، من الغرائز البدائية المتجذرة في اللاوعي الجمعي، من غضب وغيرة وحقد وضغينة وطغيان...إلخ، لأنها تعلمنا شيئا رئيسا هو التحكم في الذات الذي هو أساس التحكم الحق في الأشياء، وفي ذلك يقول بوثيوس: "من يرد أن يكون ذا سلطان حقيقي، فليبسط أولا سلطانه على نفسه"[38]؛ حاصل القول، إن الفلسفة بحق فن للعيش؛ ذلك أنها تحمل الذات على إبداع فرادتها وتميزها مستحضرة إمكاناتها وقدراتها، وهذا مقتضى المبدأ الدلفي الذي يدعو لمعرفة الذات؛ فمبدأ "اعرف نفسك بنفسك"[39] هو دعوة للعودة إلى الذات، لكن ليس لمغازلة كبريائها، وإنما لمعرفة إمكاناتها الحقيقية، وما تستطيع إليه سبيلا، بعيدا عن التقليد واتباع الآخرين، وهو تقليد يلقي بصاحبه إلى الجحيم، أَلَمْ يقل جون بول سارتر إن الآخر جحيم؟ بلى، ونضيف أن تقليد الآخر جحيم لا يطاق؛ إذ لما كان للمصادفة دور في وجودنا، وحيث إننا وجدنا على حين غرة ولم نختر وضعية الوجود هذه، فلا يسعنا إلا أن نحيي قدرنا الوجودي كما هو دون مركب نقص، وها هنا تصير الفلسفة عزاء يتيح لنا قبول هذا القدر الوجودي[40]، قبول يمكِّننا في نهاية التحليل من تحصيل السعادة، أي الخير الأقصى والأعظم، دون أن يبقى في حكم الإرجاء كما تكرس ذلك الأيديولوجيات الخلاصية التي تسعى للتحكم في مصير الناس، وسلب قواهم الخلاقة، وجعلهم عرضة للمشاعر الحزينة التي تجعلهم لا يطيقون الحياة، فيلقون بأنفسهم إلى التهلكة وبئس المصير.
لائحة المصادر والمراجع:
المصادر:
- ناشيد سعيد، التداوي بالفلسفة، التنوير، لبنان، ط 1، 2018
المراجع:
- فرنان جون بيير، بين الأسطورة والسياسة، ترجمة جمال شهيد، دار دمشق، 1999
- لوك جون، رسالة في التسامح، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، 2011
- Pierre Hadot, La Philosophie comme manière de vivre, Livre de Poche, Paris, 2003
- Platon, Alcibiade, Livre de Poche, Paris, 1998
- ROUSSEAU JEN-JACQUES, DE Contrat Social, CF-Flammarion, Paris, 1992
[1]- مجلة ذوات العدد57
[2] سعيد ناشيد، التداوي بالفلسفة، التنوير، لبنان، ط 1، 2018، ص 140
[3] Pierre Hadot, La Philosophie comme manière de vivre, Livre de Poche, Paris, 2003
[4] سعيد ناشيد، التداوي بالفلسفة، مصدر سابق، ص 8
[5] المصدر نفسه، ص 10
[6] المصدر نفسه، ص 30
[7] المصدر نفسه، ص 89
[8] خصص سعيد ناشيد مقالا لموضوعة الجسد ضمن الكتاب، وحسبنا في هذا المقال التعليق عليه، وبيان رهاناته ومسوغاته. ص 47-52
[9] المصدر نفسه، ص 40
[10] JEN-JACQUES ROUSSEAU, DE Contra Social, CF-Flammarion, Paris, 1992
[11] جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، 2011
[12] سعيد ناشيد، التداوي بالفلسفة، مصدر سابق، ص 18
[13] المصدر نفسه، ص18
[14] المصدر نفسه، ص 28
[15] المصدر نفسه، ص 65
[16] المصدر نفسه، ص 78
[17] المصدر نفسه، ص 64
[18]المصدر نفسه، ص 21
[19] المصدر نفسه، ص 53
[20] المصدر نفسه، ص 57
[21] تجدر الإشارة إلى أن الحب لا يحيل في كتاب "التداوي بالفلسفة" على التناسل والتوالد والنكاح، وإنما هو ذلك الشعور العميق الذي يجعلنا في حضرة الأبدية، ولعل هذا ما يجعل باروخ سبينوزا يصنفه ضمن المشاعر المبهجة. المصدر نفسه، ص 69
[22] المصدر نفسه، ص 23
[23] جون بيير فرنان، بين الأسطورة والسياسة، ترجمة جمال شهيد، دار دمشق، 1999، ص ص 67-68
[24] أنظر المقال الموسوم بعنوان "العلمانية كسلوك مدني" من كتاب "التداوي بالفلسفة"، مصدر سابق، ص 129-136
[25] المصدر نفسه، ص 108
[26] المصدر نفسه، ص 108
[27] المصدر نفسه، ص 109
[28] المصدر نفسه، ص 111
[29] المصدر نفسه، ص 126
[30] المصدر نفسه، ص 124
[31] المصدر نفسه، ص 123
[32] المصدر نفسه، ص 121
[33] المصدر نفسه، ص 120
[34] المصدر نفسه، ص 119
[35] المصدر نفسه، ص 118
[36] المصدر نفسه، ص 116
[37] المصدر نفسه، ص 115
[38] المصدر نفسه، ص 39-91
[39] Platon, Alcibiade, Livre de Poche, Paris, 1998, 97
[40] سعيد ناشيد، التداوي بالفلسفة، مصدر سابق، ص 98






