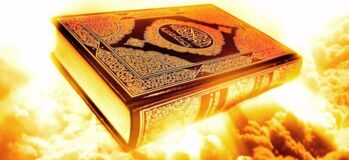القرآن بين القراءة التعبدية والقراءة المعرفية
فئة : مقالات

القرآن بين القراءة التعبدية والقراءة المعرفية
السردية الوحيدة التي يشترك فيها العالم الإسلامي اليوم، هي سردية نص القرآن الكريم، بالرغم من كل الإشكالات والمحن والأزمات... منذ زمن الأحداث التي سميت بالفتنة الكبرى، اللحظة التي افترقت فيها الأمة إلى فرق، فليس هناك إلا قرآن واحد حتى هذه اللحظة؛[1] لكن مع الأسف حال عموم المسلمين اليوم مع القرآن الكريم، إما أنهم يأتونه وهم خالو الوفاض، فقراءتهم له لا تتجاوز التعبد، ولا نقلل هنا من قيمته التعبدية، وإما يأتونه بعد أن يطرحوا جانباً كل فهمهم لإشكالات الواقع والعلم ونظم المعرفة والحياة، فقراءتهم تكون قراءة من أجل القراءة فقط دون وعي بالمقروء، وحتى إن طرأت عليهم حالة سؤال ما على القرآن، يعودون إلى المفسرين أو إلى من يروا أنهم مختصون في علوم الشريعة، ليسمعوا رأيهم الذي يكرر ما قال به الأقدمون، بدل البحث عن رأي القرآن حول المسألة المبحوث فيها، من النادر بما كان أن تجد من يقرأ القرآن قراءة تتجاوز ما هو تعبدي إلى ما هو معرفي من قبيل قراءته قراءة معرفية داخلية لآياته وسوره.
فالقراءة الداخلية للقرآن الكريم تتجاوز المعيقات المنهجية التي جعلت جلّ المتقدمين [مفسرين وغيرهم] يقعون تحت سلطة الفهم الذرّي لسور وآيات القرآن، ومن أبرز تلك المعيقات المنهجية نذكر: اعتمادهم في الفهم على كل ما هو خارج عن القرآن، ويطعن في وحدة البنائية، من قبيل مقولة الناسخ والمنسوخ في القرآن، والتي ترتب عنها اعتقاد بأن بعضاً من آيات القرآن تلغي البعض الآخر، فلا نسخ في القرآن بحجة القرآن ذاته، وتجزيئهم القرآن إلى آيات محكمات وأخرى متشابهة... بينما القرآن كله محكم. أما تشابهه، فيعود إلى خارجه وليس إلى داخله... كما أنهم اعتمدوا كل ما تضمه مختلف معاجم اللغة العربية في فهم مفردات القرآن دون الوعي بأن مفردات القرآن تأخذ دلالتها بدرجة أولى من خلال مداراتها من داخل الحقل الدلالي للقرآن، فمشكلة العرب الذين اعترضوا على القرآن الكريم، أنهم اكتفوا بوعي مفردات أشعارهم، ونظروا إلى القرآن بأنه يصدق عليه ما يصدق على الشعر ودلالة مفرداته، وهذا من الأسباب التي دفعتهم إلى القول إن القرآن مماثل للشعر، وردّ القرآن عليهم بقوله قال تعالى: "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ (69)" (يس) ومن هنا يسقط الأثر الذي مفاده؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس قوله: "إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب. وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً".[2]
ومن أبرز تلك المشكلات المنهجية عند المتقدمين [مفسرين وغيرهم] اعتمادهم وتوسلهم في الفهم على الكمّ الهائل من الآثار والروايات التي اسقطت على القرآن الكريم من خارجه وشكلت حاجزا يحجب الدخول إليه، وهو أمر فتح الباب على مصراعيه ليفهم القرآن من خارجه من خلال مختلف الروايات والآثار التي تعود في جذورها، إلى ما بين يدي أهل الكتاب من حمولات ثقافية تلبست لبوس الوحي في كثير من جوانبها، وغطت عن النور الذي في تلك الكتب التي بين أيديهم. وقد حدد القرآن علاقته بما سبقه من الكتاب في دائرة منهج التصديق والهيمنة قال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ (48)"[3] التصديق، الاعتراف قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)﴾ (الأعلى) قال تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)"(المائدة). الهيمنة في القرآن من باب الرحمة وليس من باب التسلط والقهر والإلغاء والنفي.. فرحمة الله وسعت كل شيء. فمفردة وردت مرتين في القرآن إحداها تعود على الله جل وعلا وأخرى تعود على كتابه القرآن الكريم.
القارئ لمدونات التفسير سيجد أن الأقدمين قد أخذوا بمبدأ التصديق وأسقطوا مبدأ الهيمنة، وليس من الغريب أن نجد مثلا قصة آدم كما فهمها الطبري تتوافق مع ما هو وارد في مختلف نصوص العهد القديم... بوعي منهم أن ذلك أحاديث قالها الرسول الكريم. ونتيجة تفريطهم في معرفة منهج التصديق والهيمنة في القرآن، ظن البعض منهم أن القرآن ينفي ويقصي ما سبقه من الكتاب، في عمد فيه القرآن إلى المراجعة النقدية لما سبقه من الكتاب [أي إرث النبوات] قال تعالى: "واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق."[4]، وقال تعالى: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"[5] قال تعالى: "طسم تلك ءايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون."[6] قال تعالى: "نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية ءامنوا برهم وزدنهم هدى."[7]
اعتماد منهج التصديق والهيمنة كما هو في القرآن، كفيل بحلّ مشكلة منهجية مزدوجة، تتعلق بالثقافة الإسلامية [العقل المسلم] وتتعلق بالثقافة الغربية [جزء كبير من الدراسات القرآنية في الغرب]. فمنهج التصديق والهيمنة سيحرر العقل المسلم من مختلف الآثار التي اعتمدت تحت مسمى الحديث في فهم القرآن، كما يحرره من مختلف الحمولات الثقافية التي تخص الثقافة العربية زمن النزول وبعده... ويؤهله لقراءة القرآن قراءة معاصرة.
ومن الغريب أن نجد بعض المثقفين يسقطون على القرآن، خلفيات التراث البابلي الديني، أو التراث المصري الفرعوني، ظنا منهم أنهم يقومون بقراءة معاصرة للقرآن، في غفلة منهم أن القراءة المعاصرة تتعارض مع ما يقومون به. ونتيجة لجهلهم بمنهج التصديق والهيمنة في القرآن، ودون وعي منهجي منهم أن القرآن نفى عن نفسه شبهة تكرار ما كان عليه الأولون من أقوال وتصورات، قال تعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24)" (النحل) قال تعالى: "إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15)" (القلم).
الأخذ بمنهج التصديق والهيمنة، سيعري الاتجاه المتغطرس في الغرب الذي يدعي أن القرآن مستعار في مجمله من الكتاب المقدس[8]، وهو ادعاء تم القول به بدءاً من أواخر القرن 19م مع أبراهام غايغر (1810م-1874م) في كتابه: "اليهودية والإسلام" ومع تيودور نولدكه (1836م - 1930م) في كتابه "تاريخ القرآن"[9] وغيرهم كثير مروراً بالقرن 20، ووجد ذلك الادعاء صداه مجدداً بشكل عنيف مع لوكسنبورغ، في كتابه حول "الأصول السريانية للقرآن" 2004م، رغم أنه لم "يورد لسورة قرآنية ولو قصيرة مقابلاً لها بأصلها السرياني المزعوم"[10] ووجد صداه كذلك في مؤلف: "قرآن المؤرّخين" الذي صدر سنة 2019م، دون أن يمنح هذا الصنف من الباحثين الذين أشرنا إليهم سابقاً أنفسهم فرصة قراءة القرآن، والكشف عن منهجه في علاقته بما سبقه من الكتاب، بالرغم من أنه هو موضوع المنازعة، فالقرآن يضم بداخله منهج التصديق والهيمنة على ما سبقه من الكتاب، فقد عمد إلى تحرير ما سبقه من الكتاب، مما تم إخفاؤه ومما تمت إضافته، ومما تم تحريفه عن موضعه وعن مواضيعه.
كل ما في الأمر هو أن هذا الاتجاه من الدراسات الغربية حول القرآن، بذل ويبذل جهداً جهيداً ليخرج النقاش ويبعده عن سياقه المنهجي الذي وضعه فيه القرآن؛ فالقرآن لا ينكر بكونه يشترك مع الكتاب المقدس في الكثير من المواضيع، وليست له أيّ نية مسبقة في إلغاء الكتاب المقدس، وإنما يتضمن نقداً تحليلياً يعرّي الكتاب المقدس ويكشف عن ثغراته كما هو الآن، ثغرات التعارض والاختلاف وإضافات ما ليس منه... وفي الوقت ذاته يكشف عن الهدى والنور الذي يضمه ما سبقه من الكتاب، قال تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)" (المائدة) قال تعالى: "وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46)" (المائدة) وفي الوقت ذاته يقرّ القرآن في أكثر من موضع بأن الكتب السالفة عليه قد سبقته لكثير مما يتضمنه ويدعو ويهدي نحوه، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)﴾ (الأعلى).
يقول القرآن عن نفسه: "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً (82)" (النساء)، وهو بهذا القول يدعو كل القراء إلى تبني الصورة المتكاملة، والتي لا اختلاف ولا تعارض فيها، لكل ما يشترك فيه من مواضيع مع الكتاب المقدس، فبدل أن يشتغل الغربيون وغيرهم بالبحث عن الصورة الأكثر تماسكاً والخالية من التعارض والملتحمة مع الكون والعلم والقيم والأخلاق الإنسانية لتلك المواضيع المشتركة بين القرآن والكتاب المقدس، فهل تلك الصورة المتماسكة نجدها في الكتاب المقدس أم تكمن في القرآن الكريم؟ فبدلاً عن هذا السؤال، شغلوا أنفسهم بقضية مصطنعة مفادها البحث عن تاريخ المصحف/ القرآن، سواء من حيث أصله أو ترتيب آياته وسوره، وهي قضية تخفي بشكل مباشر وغير مباشر، انزعاج العقل الغربي من القرآن وبالأحرى من نور القرآن الذي يسع الآفاق والأزمنة.
[1] رضوان السيد، المستشرقون الألمان النشوء والتأثير والمصائر، دار المدار، بيروت، لبنان، ط.2، 2016م، ص ص 101-102
[2] أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ تحقيق؛ محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل؛ ط. 5، 1981م، ج.1. ص. 30
[3] المائدة/ 48
[4] المائدة/ 27
[5] البقرة/ 42
[6] القصص/ 1-3
[7] الكهف/ 13
[8] انظر: اليهودية والإسلام، أبراهام غايغر، ترجمة نبيل فياض، دار الرافدين، بغداد، بيروت، ط1، 2018م
[9] تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، تعديل، فريدريش شفالي، ترجمة، جورج تامر، منشورات الجمل، بغداد، العراق، (د.ع. ط) 2008م علق الدكتور رضوان السيد على ترجمة كتاب، تاريخ القرآن، لنولدكه إلى اللغة العربية لأول مرة سنة 2004م، بالقول: "وهي ترجمة جيدة، لكن الفيلولوجيا المشرذمة لنولدكه تستثير النفور، وما عادت ملائمة أو صالحة لتقديم جديد مفيد للقارئ العربي وللدراسات القرآنية" أنظر: المستشرقون الألمان، النشوء والتأثير، دار المدار، بيروت، لبنان، ط.2، 2016م. ص90
[10] المستشرقون الألمان، النشوء والتأثير، م. س. ص104